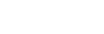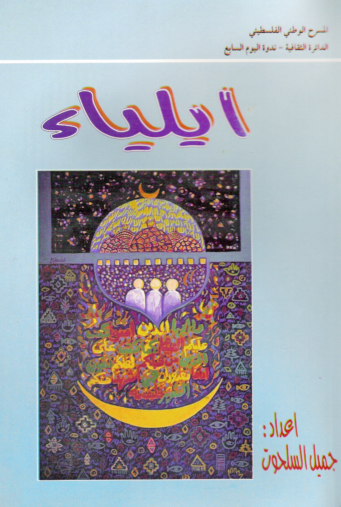جميل السلحوت:بناء الانسان من خلال التراثبداية دعونا نعرف أن التراث هو كل ما يرثه المرء أو الجماعة من الآباء والأجداد، وبهذا فان الحضارة بأشكالها كافة وفي مقدمتها الدّين تراث، وفن العمارة وبناء المدن والقرى والزراعة والصناعة والأدب الرسمي والأدب الشعبي التي أنتجتها الأجيال السابقة كلها تراث، وهذا يعني أن التراث نوعان عملي: كفنّ العمارة والمساجد والكنائس والمدن والأدوات الزراعية والمنزلية وغيرها كلها تراث عملي، أي مادة أنتجها الانسان.والتراث القولي كالشعر والأدب والشعر العاميّ والمثل والحكاية وغيرها من الفنون القولية.ولا بدّ هنا من التوقف قليلا عند التراث الديني، فذات يوم وعلى أحد مدرجات احدى جامعاتنا المحلية فوجئت بأستاذ جامعي يهاجم من يعتبرون الدين تراثا، ويعتبر ذلك كفرا وإساءة للدين! وبعد أن انتهى من كلمته استأذنته بمداخلة قلت فيها: دعونا نرى في البداية معنى التراث، فالتراث مصدر مشتق من ورث يرث، والميراث هو كل ما تركه الآباء والأجداد، والأديان السماوية أوحى الله بها الى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فموسى جاء باليهودية، وعيسى جاء بالمسيحية، وخاتمهم محمد جاء بالاسلام، وقد مرّ على ذلك آلاف السنين، والانسان المعاصر ورث هذه الديانات من الآباء والأجداد، والوحي لم ينزل على أيّ إنسان منّا، فأين الكفر في ذلك؟ فاقتنع صاحبنا بذلك.ولو أخذنا التراث الديني كنموذج لبناء الانسان المعاصر- وسيكون حديثي هنا مرتكزا على الاسلام كونه دين الغالبية العظمى لأبناء شعبي وأمتي- وحاولنا تطبيق ذلك على تعليمنا لطلابنا في المدارس لكان في ذلك دور تربوي مهم وفاعل، فمناهجنا التعليمية في مادة”التربية الدينية” تعتمد تدريس الدّين كعبادات، وتترك أن”الدّين المعاملة” وتبتعد عن مفاهيم الدين وأساساته، و”أنّ الاسلام بني على خمس:شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجّ البيت لمن استطاع اليه سبيلا” وهذه أساسات الاسلام، أما الاسلام فهو فوق هذه الأساسات، وهو يتمثل في قوانين الاسلام ومعاملاته وأخلاقياته وتنظيم العلاقات بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غيرهم وهكذا، فالمسلم الحقيقي هو”من سلم الناس من يده ولسانه” أي أنه غير مؤذ للآخرين بغض النظر عن معتقداتهم وجنسهم ولونهم، وعلينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى عندما امتدح نبيه الكريم قال”وإنك لعلى خلق عظيم” وبما أن الرسول قدوة فهل نقتدي بأخلاقه؟ فعندما كان قومه يؤذونه لم يردّ الأذى بمثله، بل كان يدعو لهم بالهداية، بينما نرى في مجتمعنا المشاجرات التي تبدأ على أمر تافه بين اثنين، ثم لا تلبث أن تمتد الى عائلتيهما أو أكثر تعصبا للعائلة وقد يسقط فيها ضحايا بدلا من محاصرتها، ونتناسى قول الرسول عليه السلام:(روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ليس منّا من دعا إلى عصبية، أو من قاتل من أجل عصبية، أو من مات من أجل عصبية”). فهل نربّي طلابنا على هذه القيم الأخلاقية ونعمل على اخراجهم من دائرة التعصب القبلي؟ وأن المعلمين وادارة المدرسة هم القادرون على حصر المشكلة فيمن افتعلوها وبالتالي حلّها. القيم الحميدة:إن غرس القيم الحميدة في ذهن أبنائنا الطلبة عنصر فعال في بناء الانسان السّويّ القادر على مواصلة تعليمه لخدمة شعبه ووطنه.وهناك حوادث جرائمية تحصل في مجتمعنا يمكن استغلالها لتوعية الطلاب بمخاطرها وضرورة الابتعاد عنها، بل ومحاربتها ومنها ما يسمى “القتل بدافع الشرف” وهي جرائم حرّمها الدين الاسلامي، فقد نشرت وسائل الاعلام يوم 23-9-2013 البيان التالي:” اجتمع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة سماحة رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي القائم باعمال قاضي القضاة لبحث تداعيات ظاهرة جرائم القتل بحق النساء والتي ترتكب تحت ما يسمى “دفاع عن الشرف”. وأكد المجلس في اجتماعه على أن جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في أمور كثيرة منها: إقامة الحدّ بغير بيّنة التي أمر بها الشرع الإسلامي لإقامة الحدود، كما أن فيها القتل بغير حق ومخالفة للشريعة الإسلامية خاصة، كقتل الفتاة العزباء إذا وقعت في الخطأ، بالإضافة إلى أن الحدود تنفيذها مناط بولي الأمر أو الدولة المسلمة”.وقد وقعت جرائم قتل كهذه بناء على إشاعات كاذبة أيضا، وهنا يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية دور في توعية الطلاب بخطورة هذه الجرائم، وضرورة العمل على وقفها، ويجب مطالبة السلطة التشريعية بوضع قوانين حازمة لردع من يفكر بارتكاب هكذا جرائم.وهناك جرائم قتل بشعة وخطيرة ترتكب بناء على أسباب تافهة، فقد قتل شخصان وأحرقت ممتلكات في احدى مناطق القدس بسبب القاء طفل حجرا على كلب، فأين نحن من الدّين” من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا”؟وتجري في مجتمعاتنا سياسة التكفير والتخوين، وكلها تتم عن جهل وعدم فهم صحيح للدين الصحيح، وهناك جماعات دينية تعتبر من ليس معها كافرا، وكثيرا ما نشاهد أناسا متفرغين للدعوة ويجوبون التجمعات السكانية، ويسكنون المساجد، ويطرقون بيوت الناس لدعوتهم الى المساجد، ويحاضرون فيهم في أمور لا يفقهونها، وغالبية هؤلاء”الدّعاة” جاهلون في أمور دينهم ودنياهم، وبعضهم أشباه أمّيين، ويجب توعية الطلاب وغيرهم من خطورة استقاء العلوم الدينية من هكذا اشخاص.صراع الحضارات أو الصراع الديني:لا خلاف بأن الاسلام آخر الديانات قد أقرّ الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية، بل إنه أباح للمسلمين الزواج من نساء يتبعن هاتين الديانتين، لأنّه يقرّهما، وصراعنا مع اسرائيل يجب أن لا يعمينا عن حقيقة أن صراعنا هو مع الفكر الصهيوني ومع الاحتلال، وليس مع اليهود كيهود، ولنتذكر تاريخنا، فأوروبا عندما اضطهدت رعاياها اليهود، هرب اليهود الى الأندلس حيث كان الحكم العربي الاسلامي الذي وفّر لهم الحماية، وعندما تمّ اخراج العرب والمسلمين من الأندلس-اسبانيا- خرج اليهود معهم الى الشمال الافريقي، وفي كلتا الحالتين مارس اليهود عباداتهم بحرّية تامّة، والمسلم الذي ينكر نبوّة ورسالة موسى وعيسى عليهما السلام كافر بدينه الاسلامي.لكن من المؤسف أن نرى اعتداءات على مسيحيي الشرق، علما أنّهم عرب، وأنهم توارثوا الدّين المسيحي عن آبائهم وأجدادهم قبل نزول رسالة الاسلام، وهم مواطنون كاملو الحقوق، لهم ما على المسلمين وعليهم ما عليهم، “فالدّين لله والوطن للجميع” وقد شاهدنا عبر الفضائيات خلال السنوات القليلة الماضية حرقا لكنائس وأديرة تاريخية في مصر والعراق وسوريا، كما تمّ قتل مسيحيين في هذه البلدان فقط لأنهم مسيحيون، فهل هكذا جرائم من الاسلام؟ وهل يعلم المسلمون في عصرنا هذا أن الفاتحين المسلمين قد أقروا أصحاب الديانتين السماويتين على دينهم، وحفظوا لهم دور عبادتهم؟ بل إن الدولة العربية الاسلامية أقرّت التراث الحضاري لما قبل الديانات مثل تماثيل الفراعنة والأهرامات في مصر، وتماثيل بوذا في جنوب شرق آسيا وغيرها.وعندنا في فلسطين وبلاد الشام فإنّ العهدة العمرية نظمت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا نصّها كما وردت في موسوعة وكيبيديا : “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نص العهدة العمرية: هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملّتها… أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.
وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحبّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخلفاء وذمّة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان.”ولا يفهمنّ أحد هنا الجزية فهما خاطئا، فهي ليست ضريبة، بل هي مبلغ مالي يدفعه المواطن غير المسلم في الدولة الاسلامية مقابل اعفائه من الخدمة العسكرية، وهذا القانون موجود في غالبية مختلف دول العالم حتى أيامنا هذه، ويدفعها من لا يريد الخدمة العسكرية من المسلمين في الدول العربية والاسلامية.فلماذا لا نربّي أبناءنا وطلبتنا على روح المواطنة الصادقة التي تقوم على المؤاخاة والمساواة بين مواطني الدولة الواحدة بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو اللون؟وعلينا أن ندرك أن دور العبادة الموجودة في الوطن هي ملك حضاري للشعب وللأمّة وللانسانية جمعاء، فعلى سبيل المثال كنيسة القيامة في القدس والمهد في بيت لحم وغيرهما، هي دور عبادة للمسيحيين، مثلما هو المسجد الأقصى وغيره دور عبادة للمسلمين، لكنها في نفس الوقت ارث حضاري لشعبنا ولأمتنا وللانسانية جمعاء، وهي شهادة على حضارة الآباء والأجداد، والحفاظ على هذا الارث الحضاري فرض عين على كلّ شخص، وعلى الشعب بمجموعه. ونحن هنا لا نأتي بجديد، وإنّما نذكّر بتراث الآباء والأجداد. ومن أمثالنا الشعبية:”أبرك السنين عيد النصارى مع المسلمين” أي أن الأعياد بما فيها الدينية هي أعياد للشعب مشتركة لأتباع الديانتين، وهذا لا يفسد في الود قضية و”كل واحد على دينه الله يعينه” وهذا المثل ترسيخ للثقافة الشعبية بحرية الديانة ووحدة الشعب، وحتى المثل القائل:” قالوا إن أسلمت سارة لا زوّدت المسلمين ولا نقّصت النصارى” فهو يدلّ على التسامح الديني اللامحدود، ويستهزئ بمن يفاخر باسلام أحد المسيحيين، أو يغضب لذلك، مع أن الديانة الاسلامية لا تبيح اعتناق المسلم للمسيحية، بل تعتبره مرتدا، مما يعني أن المسيحيين هم من يردّدون هذا المثل أكثر من المسلمين.ويلاحظ هنا استعمال وصف المسيحيين بالنصارى أي نسبة الى مدينة الناصرة التي احتمى فيها السيّد المسيح عليه السلام، وهو تعبير مسيحي حيث يطلق على السيد المسيح”الناصري”.ويجب توعية الجميع بهذا خصوصا طلاب المدارس، ولا علاقة للمسيحية ولا لمسيحيي الشرق بالحروب الاستعمارية التي يشنها الغرب على شعوبنا ودولنا. وبالتأكيد فان أجدادنا أدركوا هذه الحقيقة في حينها فسمّوها “حروب الفرنجة” والذي سماها الحروب الصليبية هم الفرنجة أنفسهم لاستغلال العاطفة الدينية لفقراء أوروبا كي يشاركوا في هذه الحروب، ولنتذكر أن مسيحيي أنطاكية قد قاوموا هذا الغزو الأوروبي، الذي كان هدفه اقتصاديا للسيطرة على الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب.كما أن أعدادا من المسيحيين العرب قد شاركوا صلاح الدين الأيوبي في محاربة الفرنجة وطردهم من هذه البلاد، تماما مثلما شاركوا ويشاركون في حروب التحرر الوطني في هذا العصر.فلماذا لا يتمّ تثقيف أبناء أمّتنا خصوصا الطلبة على هذه القيم؟ ولماذا لا يتم تزويدهم بالمعلومة الصحيحة؟ ولماذا يسمح لأئمة المساجد الذين يعتلون المنابر ويهاجمون أتباع الديانات الأخرى ويغذّون الطائفية بين أبناء الشعب الواحد؟ وهل ننتبه أن تغذية الطائفية ليست في مصلحة أحد؟ وأن إجبار مسيحيي الشرق على هجرة أوطانهم خدمة لأعداء الأمّة وكارثة وطنية على المستوى الوطني والاقليمي.؟
التعايش بين أتباع الدّياناتومن المثير للجدل أن بعض من يغذّون الطائفية هم من يدعون الى “الحوار بين الديانات” فهل الحوار بين الديانات سيجعل أتباع ديانة معينة يغيرون دينهم ومعتقداتهم ويحولون الى ديانة أخرى؟ ومع علمهم المسبق بـ”لا اكراه في الدّين”.ولماذا لا يتم التثقيف على التعايش بين الديانات؟ فهذه الامكانية واردة وناجحة ومجرّبة،ولدينا عدّة أمثلة من التاريخ فكريستوفر كولمبوس “عبر المحيط الأطلسي ووصل الجزر الكاريبية في 12 أكتوبر 1492م لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام 1498 م. بعض الآثار تدل على وجود اتصال بين القارة الأوروبية والأمريكية حتى قبل اكتشاف كولومبوس لتلك الأرض بوقت طويل. من شخصيته وحي اسم بلد: “كولومبيا” والولايات المتحدة الأمريكية استقلت في 4 تموز-يوليو- 1776. واستطاعت بعد الحرب العالمية الثانية”1993-1945″ أن تفرض نفسها كأغنى وأقوى دولة في العالم، مع أنها دولة حديثة العهد، وشعبها خليط من كافة الأعراق والأجناس والألوان ومن أتباع الديانات السماوية والوثنية، ومع ذلك فإنهم يعيشون في وئام، ويقيمون دور عبادتهم كما يشاؤون، ولا أحد يعتدي على أحد، وذلك لوجود قوانين رادعة تنظم العلاقات بينهم، وهذه القوانين أصبحت ثقافة وسلوكا سائدة، وهم يشاركون –بمن فيهم المسلمون-في حروب دولتهم ويحتفلون بانتصاراتها وأفراحها ويوم استقلالها، ولنتوقف عند الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، فهو أسود وابن مهاجر كيني مسلم أسود الى أمريكا، وتزوج من أمريكية، وحصل على جنسيتها، ولكونه-أي باراك حسين أوباما- ولد وترعرع في أمريكا فقد وصل بالانتخاب الديموقراطي الى رئاسة الدولة–وهي الدولة الأعظم في العالم-. فهل توقفنا عند ذلك وتساءلنا عنه؟ وهل لو هاجر حسين أوباما الى احدى الدول العربية كان بامكانه أن يعيش، وأن يحصل هو وابنه باراك على حق المواطنة العادية ليحصل على قوت يومه بكرامة؟ كتب ذات يوم أحد المقدسيين السود والذي ينحدر من أصول تشادية بمرارة أن الفلسطينيين يصفون السود بـ “العبيد” وهم لا يعلمون أننا سادة أبناء وأحفاد سادة، ولم نكن يوما عبيدا، بينما ربما أصول من يصفوننا بالعبودية تعود الى سلالات عبيد. بينما تراثنا الديني يقول:”لا فرق لأبيض على أسود إلّا بالتقوى” و”أنّ البشر جميعهم عيال الله”.وفي الدّول الأوروبية هناك مهاجرون من دول وأعراق مختلفة حصلوا على حق المواطنة الكاملة فيها، والكل يحترم الكلّ، بينما في دولنا العربية هناك مواطنون يعيشون في دولنا يطلق عليهم”البدون” أي بدون جنسية! مع أنّهم مولودون في الدولة من عشرات الأجيال، بل ويخدمون في جيشها، ويشاركون في حروبها دفاعا عنها، وبعض الدول العربية لا تزال ترفض منح حق المواطنة والجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من جنسية أخرى. فأين الخلل؟ بالتأكيد الخلل فينا وفي ثقافتنا السائدة بهذا الخصوص، وفي القوانين المعمول بها في بلداننا، ولا علاقة للدّين الاسلامي بذلك. وقصة ابن عمرو ابن العاص والي مصر عندما لطم قبطيا لأنه سبقه في سباق للخيول شهيرةوهو يردّد:”أتسبق ابن أكرم الأكرمين” فلما اشتكى القبطي لعمر، أحضر المعتدي وقال للقبطي”الطم ابن أكرم الأكرمين” وكذلك عندما مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعجوز نصراني يتسول، فاستغرب ذلك وتذكر أنهم أخذوا الجزية منه وهو قويّ ويقدر على العمل، ولا يجوز تضييعه وهو عجوز هرم وأمر بصرف مخصصات له من بيت مال المسلمين، الذي هو بمثابة وزارة المالية حاليا.إن غرس الأخوّة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم ولونهم في عقلية الأجيال الناشئة لترسيخها كثقافة وكسلوك لهم، هي الكفيلة بمحو أي مخالفة طائفية مستقبلا.المجتمع الذّكوري:
معروف أن مجتمعاتنا مجتمعات ذكوريّة، فالذّكور مميزون في كلّ شيء، وتبدأ التربية الذّكورية حتى والطفل جنين في رحم أمّه، فهي تفاخر بانّها حامل بجنين ذكر، وتحمد الله ليل نهار على ذلك، بل وتؤكّد المرأة الحامل بأن حملها خفيف لا يؤثر عليها شيئا لأن جنينها ذكر، وعندما يولد يستقبل استقبال الفاتحين، وتهدهده والدته بأغان شعبية فيها تنمية للثقافة الذكورية، وتقليل من شأن الأنثى، بل انها تغني له مفاخرة بعضوه الذكري مثل:يا جاره ظبي بنتك هذا ربي اللي عطىوالزبرة زبرة عطــــــــــا نايمة تحت الغطـــــا ولا تحسدي يا حاســـــــده وهذا ربي اللي عطـى والزبرة زباريــــــــــــــها والرحمن امباريهـــــا والدار اللي هي فيهــــــــا بتطب البركه فيهـــــــاوالزبرة زبرة قنفد بتخزق الحيط وبتنفدوالزنبور لا شاف سروربطلع ساغ وبرجع مقعوروالأمّ تعتني عناية فائقة بمولودها الذكر” الاولاد بدهم دلال”، بينما البنات الإناث لا يحظين بهذه الرعاية، يقول المثل:” البنات مثل خُبّيزة المزبلة” أي يكبرن بسرعة وبدون عناية، وهناك تحذير من تدليل البنت”دلّل ابنك بغنيك، ودلّل بنتك بتخزيك” وليت ثقافتنا الشعبية تترك البنت لتعيش بدون دلال، بل تدعو الله ليميتها رحمة بذويها” اللي بتموت وليته من حسن نيته”! بينما تدعو الأمهات بطول العمر لأبنائهن الذكور، فتقول لابنها الذكر” ان شاء الله بتدفنّي بيديك” وتردّد نفس القول للابن الذكر عندما يتشاجر مع شقيقته” ان شاء الله بتدفنها بيديك”. وثقافتنا الشعبية لا تعتبر البنات خَلَفًا، وليس من الصعوبة أن تسمع أناسا يخاطبون امرأة أنجبت عددا من البنات بدعاء” الله يعوّض عليك” والمقصود بالعوض هنا الأبناء الذكور. وقد يتزوج الرجل من امرأة أخرى لأن الأولى لم تنجب أبناء ذكورا، مع أنّه ثبت علميا أنّ انجاب الذكور والاناث هي مسؤولية الرجل وليس المرأة، وقد أدرك العرب الجاهليون ذلك، فإحدى الزوجات ردّت على زوجها عندما لامها لأنها أنجبت بنتا:” مثلما تزرع تحصد” وقد جاء في الأثر، ونقله الدكتور عواد أبو زينة:”هجر أبو حمزة خيمة امرأته وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمرّ يوم بخيمتها فإذا هي ترقصها (البنت) وتقول:مال أبي حمزة لا يأتينايظل في البيت الذي يلينـــاغضبان أن لا نلد البنيناوالله … ما ذلك بأيدينــــــاوإنما نحن لزارعينا كالأرض نحصد ما قد زرعوه فينــافدخل الرجل وقبل رأس امرأته وابنته.”وعقّب عليه” فهل تغيّر حال أبو حمزة اليوم وهو يحمل أعلى الدرجات العلمية ويركب أحدث الطائرات ويزور أعرق الجامعات؟ بقي أبو حمزة كما كان، واستكانت أمّ حمزة لقدرها وأصبحت تحمل معه على الطفلة المسكينة وتتمنى الخلاص منها، وحين تكبر نشعر بأنها العبء الذي نحمله على كاهلنا، ونقرّر لها وعنها في غيابها، ونحكم عليها حكماً غيابياً قابلاً للتنفيذ الفوري. استبدلنا الوأد القديم بوأد من أنواع أخرى أكثر حداثة. الزواج القسري أو الحرمان القهري، التصور أن هذه الأنثى شيطان يرافقها إبليس كلما خرجت من تحت أبصارنا أو أيدينا، حرمانها من التثقف والتعلم، حرمانها من تشكيل شخصية إنسانية ذات كرامة … وهكذا تعطلت كثير من الطاقات وتبدّدت كثير من الجهود فيما لا طائل لا تحته ولا فوقه ونظل ندور كثور الساقية . تبقى أستاذاً عظيما أخي جميل، وتبقى أطروحاتك البناءة التي تدق على هذا العصب التالف في المجتمع، وتفتح العيون لعلنا نبصر ولو قدراً معقولاً من الحقيقية.” فلماذا لا نعلم أبناءنا في المدارس العلم الصحيح حول الذكر والأنثى. ويربّى الطفل الذّكر في مجتمعاتنا على التعالي في التعامل مع الإناث، بمن فيهم والدته التي أنجبته، وهي تكون سعيدة وراضية بذلك. وأمّه هي أول من يغرس في ذهنه هذا السّلوك.وفي فلسطين تحرص مدارس الاناث على تعليم الاناث “التدبير المنزلي” وهذا أمر جيّد، بل هناك أقسام للتدبير المنزلي في بعض المدارس الثانوية، وغالبا ما يتم الحاق الطالبات ذوات التحصيل العلمي المتدني في هذه الأقسام، ويبقى السّؤال لماذا لا يتم تعليم الطالبات في أقسام التدبير المنزلي المواد العلمية الأخرى؟ أم أنّنا حكمنا عليهن أن يكن محاصرات ومحصورات في مطبخ البيت سواء كنّ عازبات أو متزوجات؟ ولماذا نكرّس تعليميّا أن العمل المنزلي تخصص أنثوي؟ ولماذا لا يكون حصة تدبير منزلي للطلاب الذكور أيضا؟ وماذا يضيرنا لو علمنا الطالب وعودناه بأن يعمل لنفسه أو له ولأسرته كوب شاي أو فنجان قهوة؟ أو أن يساعد والدته في شؤون البيت، تمهيدا لمساعدته لزوجته مسقبلا، في الدول المتقدمة هناك معاهد جامعية لتعليم فنون الطبخ والطبيخ، وروّادها ذكور وإناث، يفنون أعمارهم بعد تخرجهم يعملون في مطابخ المطاعم والفنادق وغيرها. ومن الأمور المألوفة أن تشاهد رجلا يساعد زوجته في اعداد الطعام وتقديمه للضيوف، ومن المألوف عندنا أن المرء اذا ما زار صديقا له، ولم تكن ربّة البيت أو إحدى البنات موجودة أن يعتذر صاحب البيت عن عدم قدرته على تقديم فنجان قهوة لضيفه لعدم وجود أحد يعمله! فهل صاحب البيت أحد أم لا؟ومن المألوف في بلادنا أيضا أن تجد ذكورا يعملون طباخين أو غسّالي صحون، أو عمّال نظافة في مطعم أو فندق أو غيرها، وعندما يعودون الى بيوتهم يمارسون سيادتهم على الإناث في بيوتهم سواء كن أمّا أو زوجة أو أختا..الخ. وعليهن أن يقدّمن له كلّ ما يريد، مع أن هذه الأنثى قد تكون عاملة في مهنة أخرى كطبيبة أو مهندسة أو ممرضة أو معلمة..الخ. ولا خيار أمامهن سوى تلبية طلبات”السيد المطاع” فهكذا تربّى وتعلّم، وهنّ أيضا تربين على الدّونية وعلى السمع والطاعة.واذا كانت العادات والتقاليد والثقافة السائدة تنمّي فوقيّة الذكور منذ ولادتهم، تماما مثلما تربّي الأنثى على الدّونية وطاعة الذكر في الأحوال كلّها، فلماذا لا تقوم المدرسة بتهذيب وتقويم العلاقة بين الجنسين من خلال التعليم؟”فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر”.التعليم حق للجميع:يقول خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام:اطلبوا العلم ولو في الصّين” والصين في وقته هي أكثر البلدان بعدا حسب معرفتهم وقتئذ، وقد دعا عليه الصلاة الى العلم بالأمر، وهي دعوة للذكور وللاناث، بل إنه خصّ الأنثى بالتعليم في حديث آخر بقوله:”من كانت له ابنة فعلمها وأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها كانت له سترا من النّار” كما أنه حثّ على المعاملة الحسنة للزوجة فقال:” خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي” والأهل هنا هم الزوجة والأبناء ذكورا وإناثا، فلماذا لا تقوم المدرسة بتعليم هذه القيم؟والاقتناع بتعليم البنات والأبناء يقضي على قضايا الزواج المبكر خصوصا للبنات.ومعروف أن أسباب تخلفنا عن الشعوب الحيّة هو سبب علمي، ولن يمكننا اللحاق بهم إلّا بالعلم. والعلم هو الكفيل بتطوير الاقتصاد والصحة والمجتمع ومناحي الحياة كافة. واذا كانت بيوت كثيرة تفتقد ثقافة التعليم، فإن المدرسة مطالبة بغرس قيمة التعليم في عقول طلابها، واذا ما نجحت المدرسة بذلك، فانها تعالج قضايا أخرى مثل كبح جماح التسرب من المدارس، والزواج المبكر وغيرها.احترام الكبير وملاطفة الصغيرهذا ما تقوله ثقافتنا الموروثة، حيث أنها تأمر”احترم الكبير ولاطف الصّغير” وقد اختلت هذه القيم الحميدة، فقد بات منظورا للجميع أنّ الصغار لا يحترمون الكبار، تماما مثلما لا يلاطف الكبار الصّغار، ونحن في وقت نفاخر فيه بعاداتنا وأخلاقنا الشرقية التي نتربى عليها، ونقول في الأخلاق الغربية “ما لم يقل مالك في الخمر” ولا ننتبه الى أنّ هذا الغرب يحترم الكبير ويحنو على الصغير، فمن السهل جدّا أن تشاهد في وسائل النقل العامّة فتاة حسناء تخلي مقعدها ليجلس مكانها رجل كبير السن، ومن السهل جدا أن ترى الجميع في الشوارع يهبون لمساعدة كبير في السّنّ لقطع الشارع مثلا، ونراهم يبتسمون في وجه طفل ويحاولون مداعبته، وهذا ما لا نراه في بلداننا إلّا نادرا، وترسيخ ثقافة الملاطفة ومساعدة المحتاج موجودة في ثقافتنا الدينيّة “ابتسامتك في وجه أخيك صدقة” و”إماطة الأذى من الطريق صدقة” وإذا ما نشرنا ثقافة التعامل الحسن، فإن مردودها سيكون كبيرا فالبن سيحترم والديه في البيت، وسيتعامل بمحبة مع أشقائه وأبناء جيرانه، وسيحترم معلمه وزملاءه في المدرسة أيضا.ثقافة الطخطخةفوضى السلاح تشكل عبئا وخطرا على المواطن الفلسطيني نفسه قبل غيره، وتضعف من هيبة السلطة الوطنية أمام هذا المواطن، بل إن تعدّد “السلطات” التي تفرض هيمنتها على الشارع تحت تهديد السلاح أوقعتنا ولا تزال توقعنا في “مطّبات” سياسية تبعدنا عن الاستقلال والتحرر الوطني، وتضعنا أمام العالم وكأننا غير قادرين على حكم أنفسنا. ومواطننا الذي هو الضحية الأولى لهذا الانفلات الناتج عن “فوضى السلاح” هو نفسه يحب المظاهر المسلحة و”الطخطخة” اذا ما ابتعدت عنه وعن مكان سكناه، وحبّ اقتناء السلاح الناري واطلاق الرصاص ليس حكرا على الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل هو موجود عند الشعوب العربية الأخرى، حتى أن التقارير الصحفية أفادت أنه في اليمن وحدها يوجد تسعة ملايين قطعة سلاح بين أيدي المواطنين، وأنها تستعمل في النزاعات الشخصية والعائلية والقبلية، ومن السهل جدا مشاهدة أشخاص في العواصم والمدن العربية يتمنطقون بالمسدسات أو البنادق بمختلف أنواعها كمظهر من مظاهر “الوجاهة” حسب المفاهيم العشائرية والقبلية، ومن السهل جدا على أي مشاهد في مختلف أرجاء المعمورة أن يشاهد على الفضائيات العربية بعض الأغاني الشعبية التراثية ومقدموها يتوشحون بالمسدسات او يرفعون البنادق وهم يرقصون ويدبكون ويغنون، وهذه المظاهر لا تشاهد في الأراضي الفلسطينية بشكل علني نظرا لوجود الاحتلال الذي يطلق جنوده النار على كل حامل للسلاح. وحبّ اقتناء السلاح واطلاق الرصاص في “الهواء” هو ظاهرة تكاد تكون تخصصا يعربيا في مختلف المناسبات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا ما تعذر وجود السلاح الناري القاتل كما هو الحال في بعض المناطق الفلسطينية فإن المفرقعات هي البديل الجاهز والمتوفر في الأسواق وفي متناول أيدي الجميع. ومن المناسبات التي يطلق فيها الرصاص حفلات الأعراس، والنجاح في الجامعة وحتى النجاح في الثانوية العامة “التوجيهي” وعند ولادة طفل ذكر عند بعض الأسر التي تأخرت في الانجاب، أو أن أبناءهم من الاناث فقط وولد لهم ابن ذكر، وعند الختان، وعند النجاح في الانتخابات كانتخابات المجالس الطلابية في المعاهد والجامعات، أو انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات المجالس النيابية، وعند عودة الغائبين من سفر بمن فيهم عودة حجاج بيت الله الحرام الذين لا تزيد غيبتهم عن أسبوعين، أو عند زيارة قائد سياسي أو حزبي لمنطقة من المناطق، أو صباحية العرس لانتصارات العريس على العروس ولعذريتها، وهذه جميعها مناسبات مفرحة حسب ثقافتنا الشعبية، أما اطلاق النار بين الاخوة المتخاصمين – والذين قد يتخاصمون على أمور تافهة –أو استعمال السلاح للسطوس فهذه قضية يطول الحديث فيها. ولكن القاسم المشترك بين جميع هذه المناسبات هو وقوع ضحايا بين قتيل وجريح من مختلف الأعمار، ومن الجنسين ذكورا واناثا، فحوادث كثيرة قتل فيها العريس أو العروس أو الخريج أو المختون أو أحد الحضور، فينقلب الفرح الى مأتم ونودع الضحية بالزغاريد والأهازيج واطلاق النار أيضا، ونعتبر مصرع الضحية قضاء وقدرا-إن لم نعتبره شهيدا- ونشرب القهوة “السادة” عن روحه و”نبوس” لحية وليّ أمره الذي يبدي تسامحا كبيرا نتغنى به في الصحافة، لتتكرر فعلتنا مرّات ومرّات، وليقع ضحايا جدد أيضا. أمّا ما تتسبب به ثقافة “الطخطخة” من رعب وازعاج للنساء والأطفال والشيوخ والمرضى فحدّث ولا حرج؟ وحتى سلاح “المقاومة” واطلاق الرصاص في الهواء فهل هو من أجل الاستعراضات أمام ووسط المواطنين المسالمين أم لأسباب أخرى؟؟ يبقى أن نقول أن النتائج السلبية المترتبة على ثقافة “الطخطخة” كثيرة وخطيرة جدا، ويجب العمل عليها بالتوعية والتثقيف لايقافها، حفاظا على حياة الناس، وعلى راحتهم وهدوئهم.30-10-2013