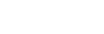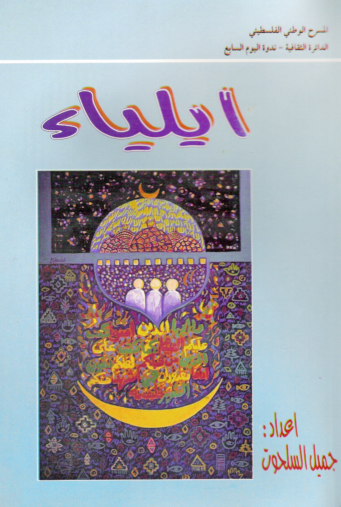القدس: 21-7-2016 من رنا القنبر: ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس رواية “معيوف” للأديب المقدسيّ عبدالله دعيس، وتقع الرّواية الصّادرة قبل أسابيع قليلة عن دار الجنديّ للنّشر والتّوزيع في القدس في 388 صفحة من الحجم المتوسّط، ويحمل غلافها لوحة للفنّانة التّشكيليّة جيهان أبو رميلة.
ويجدر التّنويه هنا أنّه صدرت للأديب دعيس من قبل رواية “لفح الغربة” التي تشكّل الجزء الأوّل لهذه الرّواية، وفي كلتا الرّوايتين يستفيد الأديب من سيرة قريته بيت حنينا إحدى أبرز قرى القدس.
بدأ النقاش ابراهيم جوهر فأشاد بالرواية، وبتطوّر الأدوات الكتابيّة لكاتبها.
وقال جميل السلحوت:
ويتّضح من هذه الرّواية أنّ هاجس الغربة الذي اشتهر به أبناء بيت حنينا، وكانوا السّباقين إليه لا يزال يشكّل كابوسا يؤرّق أديبنا. لكنّه في رواية “معيوف” يعود إلى جذور مواطني هذه القرية الرّابضة بين مدينتي القدس ورام الله. مستذكرا شيئا من بعض العادات والتّقاليد من خلال شخصيّة معيوف بطل الرّواية الرّئيسيّ .
اسم الرّواية: معيوف هو الشخصيّة الرئيسة في الرّواية، واسمه الحقيقيّ رضوان، لكنّ اللقب “معيوف” طغى على الاسم الحقيقيّ.
زمن الرّواية: تمتد الرّواية على طول القرن العشرين، وإن ابتدأت أحداثها بشكل جدّي منذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى.
عادات وتقاليد: من يتابع أحداث الرّواية سيجدها تعجّ بمسمّيات وعادات وتقاليد سادت في مرحلة ما من مسيرة شعبنا الفلسطينيّ، وواضح أنّ الكاتب مطّلع بشكل واسع على تاريخ قريته، وما فيها من عادات وتقاليد. وتبدأ هذه العادات من اسم بطل الرّواية الذي حملت الرّواية اسمه وهو معيوف، ومعيوف الشّخص الذي يعافه النّاس، أيّ يرفضونه ولا يتقبّلونه، وقد لقّبوه بهذا لدرء العين الحاسدة عنه، بعد أن مات أشقّاؤه الأكبر منه سنّا نتيجة للفقر وسوء الرّعاية الصّحّيّة. وطغى اللقب معيوف على الاسم الحقيقيّ رضوان. ومن هذه العادات أنّ المولود الذي يخاف ذووه عليه من العين الحاسدة فإنّهم لا يحمّمونه في السّنوات السبعة الأولى من ولادته، كي تكون رائحته نتنة، تجعل الآخرين يتقزّزون منه، وبالتّالي لا ينتبهون له ولا تصيبه العيون الحاسدة. ومعروف أنّ العين الحاسدة تصيب الأبناء الذّكور دون الاناث حسب المعتقد الشّعبيّ في المجتمعات الذّكوريّة.
ومن الأمور التّراثيّة التي وردت في الرّواية ما جاء حول تصنيع “القطّين” – التّين المجفّف- و”الزّبيب”- العنب المجفّف- وهذا يعني أنّ أراضي بيت حنينا كانت تعجّ بكروم التّين والعنب. و”العلّيّة” وهي البيت المرتفع وكانت تستعمل كمضافة لأبناء القرى، وغالبا ما كان يملكها المختار.
وورد وصف لموسم النّبي موسى، ويأتي مصاحبا لعيد الفصح عند النّصارى، وقد ابتدع في العصر الأيّوبي بعد تحرير القدس من الفرنجة في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، وأعاد احياؤه الحاج أمين الحسيني بقوّة زمن الانتداب البريطاني على فلسطين. كما ورد ذكر للكتاتيب التي كان يتعلّم فيها الصّبيان “أصول القراءة والحساب“.
وورد ذكر لأسماء بعض الأماكن في بيت حنينا مثل ساحة”ورا الجامع” وجبل دعاس وغيرها.
وممّا جاء أيضا هو التأريخ لبعض الأحداث مثل : تأسيس مدرسة بيت حنينا عام 1928، وافتتاح مقر لجماعة الاخوان المسلمين في القدس عام 1944. وتأسيس شركة باصات لبيت حنينا القدس. وعودة أحد المغتربين في أمريكا من أبناء بيت حنينا عام 1932 بعد غياب عشرين عاما، وكان قد اغتنى بشراء العقارات في نيويورك أثناء الأزمة الاقتصادية في أمريكا عام 1928، وباعها بعد انتهاء الأزمة، فاغتنى وعاد إلى بلاده ليفتح باب الهجرة الواسع لأبناء قريته.
أبو حمار: وهو شخصيّة تراثيّة، كانت معروفة في القرى الفلسطينيّة حتى النّصف الأوّل من ستّينات القرن العشرين، حيث كان يأتي بائع متجوّل بضاعته على ظهر حمار، يبيع “الحامض حلو والحلاوة” للأطفال، وأبر الخياطة وخيطان التّطريز، والمناديل وبعض الأقمشة للنّساء، غير أنّ أبا حمار “بيت حنينا” كان شخصا مختلفا ظهر زمن الانتداب، ولم تكن هذه مهنته الحقيقيّة، وإنّما كانت وسيلة لتحقيق مآربه، فهو يهوديّ من أصول فلسطينيّة، يتمسكن في القرى ومنها بيت حنينا، ويكسب ودّ أهلها، ويشتري أراضي لا تصلح للزّراعة منهم بأسعار زهيدة، وواضح أنّه كان يشتريها لصالح المنظّمات الصهيونيّة الاستيطانيّة. وقد ظهر مع مجموعة من السّيّاح في أسواق القدس بعد قيام دولة اسرائيل، ولمّا تعرّف عليه معيوف، ترك كاميراته في يد معيوف وأخبر الشّرطة بأنّه سرقها، وكانت النتيجة الحكم على معيوف بالسّجن لمدّة عامين.
معيوف: هو بطل الرّواية الرّئيس، شخصيّة استثنائيّة مضطربة منذ طفولته الأولى، فوالدته منعت تحميمه بالماء في سبع سنوات عمره الأولى، حظي بحبّ والديه كون اخوانه الأكبر منه سنّا كانوا يموتون، شخصيّته انطوائيّة، يعرف الصّحيح ولا يستطيع البوح به، زوّجوه من ابنة عمّه اليتيمة “خضرة” التي كانت تكبره عمرا، لم يقبل بالّزّواج لكنّه لم يستطع الاعتراض، أنجب منها طفلين، وهرب منها وهي حامل في الطفل الثاني، أكمل تعليمه الثّانويّ في المدرسة الرّشيديّة، كان تائها، فهو متديّن بالفطرة، تأثّر بمعلّمه صالح، الذي كان من جماعة الاخوان المسلمين، ارتاد أماكن اللهو مع بعض أصدقائه ولم يستسغها، التزم الصّلاة في المسجد الأقصى، وحضر حلقات الذّكر، عمل في دير اللطرون، وتعرّف على أولغا الفتاة الحلبيّة التي جاؤوا بها إلى الدّير؛ لحمايتها من ذويها بعد أن حملت سفاحا، اتهموه بها ولم يدافع عن نفسه، عمل مدرّسا في مدرسة صورباهر، واعتقل هناك بتهمة الانضمام إلى الاخوان المسلمين، سافر إلى مصر لتكميل دراسته الجامعيّة، وهناك التقى بجماعة الاخوان المسلمين، واستمع لخطابات حسن البنّا مؤسّس الجماعة، واشترك معهم في حرب فلسطين عام 1948، وعاد إلى القدس، وشارك من قرية صورباهر مع معلمه صالح وغيره من جماعة الاخوان في الهجوم على التّجمعات اليهوديّة خارج أسوار القدس، كما شارك في الدّفاع عن القدس القديمة ومقدّساتها. وبعدها عمل مدرّسا في دار المعلّمين في بيت حنينا، ولم يتعرّف عليه أبناء بلدته لطول غيابه عن القرية، ولانتشار اشاعة عنه بأنّه قتل قبل ذلك بسنوات، وهناك رأى ابنيه من “خضرة” ولم يتعرّف عليهما. وفي تلك الفترة تزوّج من المقدسيّة سميرة التي رفض والداها تزويجه منها قبل ذلك لأنّه قرويّ! وسجن لمدّة سنتين بعد أن تعرّف على أبي حمار الذي دخل القدس القديمة مع فوج من السّيّاح، وخرج من السجن ليجد سميرة قد ماتت، سافر إلى أمريكا والتقى هناك بأخيه الأصغر مصطفى، والذي وفّر له عملا معه لا غير، وهناك سجن وأبعد إلى الأردنّ.
شخصيّة معيوف كما جاءت في الرّواية شخصيّة حائرة متقلّبة، لم تعرف طريقها بشكل واضح إلا في الفترة التي كانت فيها تحت راية جماعة الاخوان المسلمين، لكنّها كانت شخصية خاسرة باستمرار، مثلها مثل غيرها من الفلسطينيّين الذين تكالبت عليهم أمور أكبر من قدراتهم.
البناء الرّوائي: الدّور الرّئيس في السّرد الرّوائي جاء على لسان “معيوف” الذي كان يسرد بلغة الأنا، ممّا يوحي بأنّ الرّواية تقترب من سرد الذّكريات، فقد جاءت مجموعة حكايات وقصص وأحداث متشابكة ومتداخلة، لخدمة الهدف الرّئيس.
وقال عماد الزغل:
قصة معيوف.. والذاكرة الحيّة للقريّة الفلسطينيّة
الكثير من النقاد سيتناولون قصة معيوف بالتحليل لشخصيّة معيوف الذي تتقاذفه الأحداث، فيبدأ طفولته “نجوسيّا” لحفظ حياته، وتنتهي به الأمور مناضلا، لكنّه متردد دائما لا يستطيع حسم الأمور، حتّى أنّ رصاصته تتلكّأ في لحظة الحزم ولا تقتل عدوه. وتلك هي شخصية الفلسطيني ورصاصته الحائرة، وبندقيته الثائرة التي حرفت السياسة بوصلتها؛ فغدت مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لا، لن أحلل معيوفا ولن أغوص في نفسيته، ولكنني سأتتبّع خيط المكان في الرواية، لأن القصّة مكانيّة، والكاتب مسكون بالمكان، كما كان نجيب محفوظ مسكونا بأحياء القاهرة التي عنون بها الكثير من رواياته.
ما زال الكاتب في روايته الثانية بعد (لفح الغربة) يؤرّخ لبلدته (بيت حنينا) التي يعشق ترابها، ويحنّ لماضيها يوم كانت بلدة واحدة لا يفصلها جدار، بل إنّي ومن خلال معرفتي الشخصيّة بعبد الله دعيس، أعلم تمام العلم أنّه يعلم تاريخ كلّ بقعة فيها وسبب تسميتها وتاريخ عائلاتها، بل واختلاف لهجاتهم ومنابعهم وأصولهم، حتى كأنك تتحدث إلى شخص طاعن في السن مع أنه ما يزال شابا لم يتجاوز الخمسين.
ولعلّه في هذه المرة قد خرج من بيت حنينا قليلا؛ ليطوّف في البلدة القديمة بالقدس، ويرتحل جنوبا إلى صور باهر، ويعاصر شيئا من اختلاف الحياة الماديّة في أواسط وبدايات القرن العشرين، فهو يؤرخ لقرن من الزمان مرّ على بلدته التي أضحت اليوم من أجمل ضواحي القدس.
إنّها بيت حنينا ذات البيوت المقبّبة، والعليّات ذات الإطلالة على الخضرة الدائمة حيث الدوالي وأشجار الزيتون والمشمش، حيث الفرح يجتاح القرية من أولها إلى آخرها فرحا بعريس، حيث السحجة والفرح، والحزن والسواد الذي يعمّ القرية إذا فقدت عزيزا من أبنائها، وحيث الهجرة التي فتكت بالقرية وخيرة أبنائها بعد نجاح تجربة الراحل عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي.
وانظروا إلى لغته الموغلة في الفلاحة والأرض عندما يقول:
“ثم تقوم خضرة منفردة بالتقاط الذّبيل، ونشره في المسطاح، وتقوم بتقليب القطّين في المسطاح وتنظيفه من التراب.” ولهذا فهو يلجأ إلى شرح هذه الألفاظ التي لن يفهمها إلا أهل القرية.
والكاتب مغرق في الميثولوجيا الفلسطينية، والأساطير والأمثال الشعبية وأحاديث الجدات، وهو جزء من ثقافة الكاتب، فالقصة تبدأ بالعين والحسد وهو التعليل الساذج لموت الأطفال، وحرق القماش لدفع العين، وتدثير المصاب بالحصبة بالغطاء الثقيل. والمثل الشعبي: “صاحب العمر الطويل ما بتهينه الشدّة.” وتسمية الطفل بالأسماء السيئة لحفظ حياتهم وهو سر تسمية “معيوف” بهذا الاسم. “وعمر النعجة ما بتصير ناعوق.” وهو مثل يقدح بالإناث، وحكاية المارد، وألقاب الرجال التي تلازمهم طيلة حياتهم، والموسى الملجوم، والكبّانيّة، ومواسم النبي موسى والنبي صمويل، والأساطير التي حاكها الناس حول مقامه الذي يتربّع على قمّة بيت حنينا، ثمّ قبة الصخرة وقصة العطر المنبعث من الصخرة ومصارين الكذاب. وقد قرأت قبل فترة كتاب “الحياة الاجتماعية والثقافية في القدس خلال القرن العشرين” للدكتور صبحي غوشة فوجدت تقاطعا بين ما قاله الكاتب وما جمعه الدكتور صبحي غوشة.
لقد أجاد الكاتب في تصوير قرية بيت حنينا، وأرّخ عن قصد أو دون قصد لشكل قريته في أوائل وأواسط القرن العشرين، ودخول أول خط للحافلات إلى قريته، فالقصة حديث جميل وسرد واقعي رائع لعلاقة القرية بالقدس.
وكتبت نزهة الرملاوي:
قراءة في رواية معيوف
إلى المتمسكين بعرى الحق، الذين يكتوون بجمر الجهل والخيانة والتضليل، وهم يحملون الشعلة لتضيء لغيرهم طريق الحرية والكرامة.
بكلمات الإهداء الجميلة، بدأت رواية “معيوف” للأديب المقدسيّ عبدالله دعيسظن الراوي (معيوف) أن العالم ينتهي عند أطراف قريته بيت حنينا، وهي إحدى قرى القدس، وقد ركز الكاتب بإبراز جمال قريته، حين وصفها ووصف محيطها بلغة أدبية راقية، أخرجته من عالمه الصغير، ليبدأ رحلة التفكير والتساؤل، عما يختبئ خلف الوادي المجهول، ووراء الجبال المحيطة بها.
لقد تجسدت مفردات الخوف والجهل والإشاعة والخرافة، في صفحات الرواية الأولى، حيث أبدع الكاتب في اختيار زاوية يدخل منها الى الزمن الذي ساد به الجهل والتخلف، ورافق حياته الصغيرة، عن طريق الحكايا و( الخراريف ) التي حكتها له أمه فتأثر بها، وراح ينسجها في خياله، بلغة تعبيرية شيقة، وهنا يحاول الكاتب إيصال رسالة الى القارئ مفادها، أننا كنا نصنع الحزن والخوف والجهل بأنفسنا، فضاع الأمان والفرح من حياتنا، وبالحكايا التي كانت شائعة في القرى والمدن الفلسطينية في أوائل القرن الماضي، صور جسده الصغير بين ضخامة المارد والغولة والوحوش الضارية، إلا أنه اكتشف في كبره، أن العالم مملوء بالوحوش الآدمية، ولم تكذب عليه أمه، ولعل شخصية (أبو حمار) الذي كان يتودد إلى القرية بحجة بيع أهلها والشراء منهم لصالح المنظمات الصهيونية، واكتشاف ذلك من قبل معيوف أثناء تجوله في البلدة القديمة، جعله أحد تلك الوحوش.
سيطرت مشاعر الحزن في الرواية على فقد الأم، فقد كانت ملاذ الراوي ( البطل) في أوقات خوفه، وإن كانت من اصطنعت الخوف لحمايته، سواء عن طريق حرمانه من الاغتسال لسنين طويلة، أو تجريده من ملابسه العفنة، أو حتى من اسمه الحقيقي (رضوان)، ظانة أنها ستبقيه على قيد الحياة، فاغتال الموت الحق أنفاسها وهو صغير، صعد الجبل ليلحق بها في السماء كما قالوا له، فقد كانت قمته قريبة منها، وعندما وصل القمة هربت السماء منه.
تطرق الكاتب إلى ظاهرة الإغتراب في قرية بيت حنينا، وخاصة إلى أمريكا للعمل فيها، وتحدث عن ظروف القهر التي تحياها النساء هناك مع أبنائهن في ظل أبوة مفقودة، أبوة في عداد الموتى، والموتى المغتربون لا يعودون، وهذا حاله مع زوجته (خضرة ) وأبنائه.
امتازت تعدد الأماكن والسفريات في الرواية، فقد سافر معيوف إلى مصر وتعرف إلى “أولغا” وبيروت وباريس، حتى وصل أمريكا للعمل.
سيطرت العاطفة الدينية على الرواية، وحملت في جعبتها الكثير من العادات والتقاليد التي تميز بها المجتمع القروي في بلادنا، والكتاتيب وشيوخ العلم في المساجد، وقد أجاد الكاتب وصف العرس، والمآتم، ومجالس العلية، وما يتداوله كبار القوم والشيوخ في تعليلة المساء، وقد رافقت النزعة الدينية، مواقف عدة في الرواية، أهمها تلاوة القرآن والأدعية للمرضى، وعدم الأخذ بالمسببات، وتولية عمه الشيخ أمين دورا كبيرا في أحداث الرواية، لأنه مزار أهل القرية، وعنده شفاؤهم، إضافة إلى انخراطه بالجماعات الإسلامية مما أدى إلى اعتقاله.
تطرق الكاتب إلى وصف القدس ودخوله إليها لأول مرة، فقد أحسن الكاتب وصف الأمكنة والشخوص المتحركة في الرواية، كوصفه لابنة عمه خضرة وسميرة، وقسوة أبيه على أخيه، ووصف الحزن والدموع في عيون أمه إثر موت أولادها لأسباب مختلفة.
تجلت المشاكل والسلوكيات المجتمعية في الرواية، حيث حاول الكاتب بأسلوبه، وضع الكثير منها تحت مجهر القارئ، ليتسنى فهمها ومعالجتها، فالكاتب ابن بيئته، وهو أعلم الناس بما يدور حوله، سلبا وإيجابا، فقد لوحظت البساطة والاحترام في المجتمع سابقا، مقابل القسوة والوحشية في الوقت الحاضر.
والتخلف والجهل في الماضي، مقابل التعلم والتطور في عصرنا الحاضر، فقد رأى ناطحات السحاب في أمريكا، والقوة الإقتصادية التي تتمتع بها، مما جعلها محطة للمغتربين الفلسطينيين في قريته، إثر إغرائهم من قبل أحد أبناء القرية الذي أصبح من الأثرياء، وقد حثهم على العمل هناك.
امتازت الرواية بالإثارة والتشويق، وانتقاء المفردات الجميلة ذات البلاغة بسلاسة، إضافة الى تسلسل زمني واضح.
أما شخوص الرواية كشخصية البطل معيوف شخصية مسالمة، لا أعتقد أنه كان غامضا، بقدر وضوح شخصيته التي تتمتع بالطيبة، فقد وصف نفسه بالإنطوائية المنعزلة، وبالرغم من الصفات التي ألصقت به، إلا أنه يتحين الفرص لإلقاء الأسئلة الكثيرة،التي تتمخض عن حب الاستطلاع والقراءة التي جعلت من بيته مكانا مكدسا للصحف المقروءة.
ولا أدري لماذا ادعى الإنطوائية، وقد أكمل تعليمه وأصبح معلما، وانخرط في العمل السياسي مما أدة إلى اعتقاله، وعاش أياما من الحب والزواج، وسافر إلى مدن كثيرة.
لوحظ الترتيب الزمني لأحداث ومحطات مهمة في حياة القرية، وأحداث مهمة تعرضت لها فلسطين كالاستعمار البريطاني، ووعد بلفور، والحكم الأردني الذي لم يكن مرتاحا له، لكنه بدى منافقا أمام الملك وهو يسلم عليه، لمعيوف آراؤه السياسية تجاه العرب ودورهم في الدفاع عن فلسطين، والاحتلال الاسرائيلي وأثره على تقطيع البلاد وتهجير أهلها.
الرواية ذات أبعاد إجتماعية وسياسية ودينية، بنيت على أساس متين من الحبك والسرد، وتعددت الأساليب في عرضها، فقد استخدم الكاتب المنولوج ( الحوار الداخلي )، من خلال سرد الأحداث، وإثارة الأسئلة، كذلك أسلوب الحوار بين شخصيات الرواية، فقد عبرت الرواية عن سيرة ذاتية للبطل والقرية.
أكثر الراوي من استخدام أساليب الاستفهام والأسئلة الإستنكارية، التي تقحم القارئ بكل سهولة في أحداث الرواية، ولوحظ التطور في شخصية معيوف، متطرقا إلى الأسباب التي جعلت منه شخصية لافتة، تنظر إلى نفسها باستهتار وأنانية، وتحكم على نفسها بالجنون والهروب من المشكلات التي تواجهها.
زخرت الرواية بعواطف عدة، كعاطفة الحزن والاغتراب النفسي التي سيطرت بقوة على صفحات الرواية، افتقاد الوطن وموت سميره وطفله، ودخوله السجن ظلما وتعسفا على يد أبناء جلدته، وكذلك ظهرت عاطفة حب جياشة، حيث أحسن الكاتب اخيار المفردات لاخراج تلك العواطف المتدفقة حينما افتقد أمه، وحين التقائه بسميرة التي أحبها بعد سنين من الفراق، وحينما رجع إلى القرية كمعلم هناك، متقمصا شخصية مدني، أراد أن يندفع إلى صبي ذكي، يضمه إلى صدره، ويخبره أنه أباه الميت المغترب الذي عاد، ليشهد حسرة اليتم في أبنائه، وقسوة الرملة في زوجته خضرة، ولكن سرعان ما نلاحظ هبوطا في درجات الغليان العاطفي عنده، عندما التقى بأولاده ولم يضمهم، أو يكشف عن شخصيته كأب لهم، كانوا وأهل القرية يحتسبونه عند الله شهيدا، وعندما احتضن الملك وأخذ صورة تذكارية معه، ولم يفصح له عما يريد، فشعر بعدم الالتزام بمبادئه واهتزاز شخصيته.
أثار الكاتب مشاكل واجهته في أمريكا مثل العنصرية والتحايل على الآخر في البيع والشراء، ورؤية أجناس مختلفة من البشر، وطريقة إخراجه من أمريكا واتهامه بالشيوعية، واعترافه بالذنب لأنه لم يدافع عن استاذه د.بيل وتجاربه بالبحث العلمي.
تطرق الكاتب بأسلوبه السردي الممتع إلى الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة، وحرق المسجد الأقصى، ونظرته نحو الأمة الاسلامية التي لم تحرك ساكنا لما يحدث في القدس.
عرج الكاتب نحو محطات تاريخية تعرضت لها فلسطين عامة والقدس خاصة، بعد نكبة 1967، كالانتفاضة ومؤتمرات السلام، والاعتقالات، ولازم في سرديته للأحداث التتابع الزمني والتاريخ للأحداث، وواجه بكلماته الجريئة استياءه من عروض السلام غير المجدية، والتي زادتنا ذلا ومهانة، والساسة الذين تبنوها، وصنعوا لانفسهم كيانا في أرضنا ثمنه كرامتنا ودماؤنا.
يتساءل معيوف عن العدالة، وأنه يعاقب على خذلانه لبعض شخصيات القصة، لكن من يستحقون القصاص العادل لم تنلهم يد العدالة بعد، فمن خان الوطن يقلد المناصب العليا، وتضرب له التحية، وشر البلية أن الخائن الحقيقي أخذ يدافع عن أراضي المغتربين في بيت حنينا ويدافع عن هجمات المستوطنين.
يكرر الكاتب في كل أزمة ومشكلة يمر بها معيوف، ابتعاده عن الناس، ومعاقبته لنفسه، وذلك بحرمانها الإغتسال أو التنظيف أو تغيير ملابسه، فيطفوا عليه الدرن والأوساخ، مما يجعل الناس تعافه وتهرب من رائحته النتنه.
عقد الكاتب في نهاية الرواية مقارنة جميلة بين الحق والباطل من خلال شخصياته، وأثار الأسئلة كعادته، لتدخلنا كقراء إلى رحلة حب وطهارة وأمل، على أدراج مدينتنا، وفي رحاب أقصانا تتجدد في نهاية الطريق، نرى فيه أن الله ينتظرنا كمذنبين، يتقبل توبتنا فيغفر لنا ما اقترفته أيدينا، نبدأ بالصلاة والدعاء، فتنتشر على قبابها وقراميدها، وتقف تحت سمائها مؤمنة بعدالة الله.
أمّا نمر القدومي فقد قال:
إذا ما كانت الرّواية تستدعيك وتلح على قراءتك النقديّة لها، فذاك يعني أنها جد مؤثّرة، معبّرة، مصوّرة وآسرة لمُتلقّيها القارئ. كما أنك حقًا استمتعت بواقعيّة وعمق أسرار مضمونها، وحُسن آليات شكلها ولغتها، فتتولّد لديك رغبة أكيدة للغوص في أغوار دلالاتها، وسبر طيّات رموزها الدّفينة، وتكون متعطّشا لاستكشاف هذا المنتوج الفكري والإنساني. لن ننسى مقولة الجاحظ بأنَّ الأفكار كلّها موجودة في الطّرقات، لكن الأديب المقدسيّ “عبد الله دعيس” كان متميّزا في سبكها بذوقه، ووضعها في قالب تهوي بها القلوب جمالا وبلاغة. فبعد روايته “لفْح الغربة”، إستمرّتْ الأفكار تعلو قلم أديبنا لتستقطبها أوراق رواية جديدة، تلثم حروفها، تتعانق وكلماتها، وتُعطّرها لنا روحه الغنيّة فكانت “معْيوف”.
سأدخل مباشرة من العتبة العجيبة التي تفتح الباب على مصراعيه وتجعل المرور يسيرا إلى سرداب هذه القراءة. إنه العنوان “معْيوف” منارة في شط بحر القارئ، وطُعم متمكّن جاذب له، فيأسره للاهتمام كليّا. هكذا لقّبته أمه، ويعني أنْ يعافه النّاس ولا يقتربون منه خوفا عليه من الحسد. وقد وُظِّفَ لشخص “رضوان الشيخ” المصابة باضطراب الإرادة والتّحكم بين الذّات وبين العالم. شخصيّة تنتابها صراعات فِكريّة، دائمة التّعاسة، تعيش بين المثاليّة والعجز، وذلك من عمر المهد إلى اللّحد في حكايات متتالية، تتصدّع لها القلوب شفقة ورحمة. صفعته الحياة، وتنقّلت بجسده وما يحمل من هموم لا طائل لها، فجابت به بلدان وشعوب، تارة يهتدي إلى سبيله، وتارات أخرى تسرقه أفكاره المتضاربة العجيبة، أو تهوي به إلى أسفل سافلين ودربَ مَن مسّهم الجنون، ولحست عقولهم الخيانة العربيّة، وسذاجة وتخاذل الكثيرين من شعبه.
إنَّ زمان النّص يُعَدُّ كتوأم للمكان، وإن كنّا نُدرك بالعقل ونلمس آثاره، فقد حدثت هذه الوقائع في نهاية العهد العثماني الظالم وبداية الإنتداب البريطاني الأشدُّ ظُلمًا على فلسطين. أمّا السّارد هنا فيوظِّف تقنية استرجاع ما حدث في رواية اجتماعيّة سياسيّة، ظهر فيها الزّمان والمكان منسجمين، وقد خدما بقوّة الحكي والمعاني والدلالة. كانت نشأة “رضوان المعيوف” في قرية “بيت حنينا” الواقعة شمال غربي مدينة القدس في مجتمع يؤمن بالخرافات والخزعبلات وقادة الشّعوذة والدّجل، والتي بدورها أثّرت على مسار حياته. أُجبرَ على الزّواج المُبكّر فكان له ولدان، إلاّ أنه ترك القرية هاربا لوحده دون سابق إنذار، مخلّفا وراءه كل ما يملك. هنا سطّر الكاتب من خلال روايته تفاصيل آلام رجل مُشرّد، يدّعي الجنون، مهمّش، يئنُّ شجنا ورفضا من المجتمع، وعزلة تتبعها لعنة قاتلة. توغّلَ “المعْيوف” في الحياة، وخاض تجارب تعرّف فيها على أماكن ورجال ونساء، أحبَّ وعشقَ وسار في خطّين متوازيين، قدمٌ في الجنّة وأخرى في النّار. والكاتب يبرز لنا جليّا مدى احتدام الصّراع الدّاخلي لدى بطلنا، وتوالي أزمات النّفس المعذّبة، إذ يعاني أمرّ الأوضاع الإجتماعيّة والنّفسيّة.
عاش “رضوان” حياة متناقضة جدا، فأحيانا يكون ذلك الثائر المغوار الذي يحيا طريق الإيمان واليقين، وأحيانا أخرى ينهزم أمام المغريات والشّهوات. ويبقى عنده حساب النّفس من أصعب مشاق الحياة، فيدخل في اكتئاب مصيريّ يخرجه عن وعيه. التردد داخل شخصيّته تقوده إلى حيث لا يشاء، كما أنها تثير الغضب، وتوقد نيران الحيرة داخل القارئ. الكاتب “دعيس” لم يتوانَ في تبيان ذكاء رضوان، فهو مَن عرف عدوّه “يعقوب صموئيل النّجار” اليهودي الأصل الملقب بأبي حمار، الذي كان بائعا متجوّلا في قريته، لكنه كان يشتري الأراضي هناك لتكون بعد ذلك مستوطنات صهيونيّة! كان يرى الحقيقة بعينيه ويعلمها، وبإمكانه أنْ يغيّر مجرى الأوضاع والأحداث. أمّا أصابعه المرتجفة، فقد منعته من الضّغط على الزناد في أكثر الأوقات حاجة، ولسانه الذي ينعقد عن الكلام في أحرج المواقف خطورة، وأفكار وهميّة تباغته وتتغلّب على ما يضمره قلبه من نوايا طيّبة. بيدَ أنَّ امتهان الصّمت عنده كمن يعترف بجرم لم يقترفه، وبالتالي أوْدى به إلى جحيم الدنيا والسّجن خلف القضبان سنين طويلة جدا.
لا يخفى علينا الجانب الجماليّ والفنيّ، فالرّواية خطاب أدبيّ وفكريّ. فبعد وفاة أمه، خلق لنفسه أسطورة يعيشها فقط في خياله وجوفه، ويستمتع فيها للحظات ولا يُطلع عليها أحد. “لطيفة” بطلته القريبة البعيدة الموجودة في عالمه الخاص، يحِنُّ إليها ويستحضرها كلما عانى الوحدة والحزن. وبقيت شخصية “رضوان” لسان حالها كما رسمها لنا الكاتب، يلدغها الإحباط، يفترسها الخذلان، ويشملها الظلم في كل الأرض. روحه متعبة وتلوكه ألسنة المجالس دون اكتراث بحقه وحتى الشّعور بشيخوخته. أمّا الحبكة في الرّواية فكانت تماما ككرة الثلج المُتدحرجة، تكبر مع مرور السنين، بحيث أبقى أديبنا تلك الغصّة في القلب حين ترك “رضوان” عائلته ولم يعُد إليهم من الموت، مع أنه كان قريبا منهم، وقد وَهَنَ العظم لديه واشتعل الرأس شيبا. الكاتب اختار وبأسلوب شيّق، السّرد الرّوائي مع بعض الحوار بين الشّخصيات دون حشو أو ملل في النصوص الكثيفة، ونجح كذلك في تأجيج العاطفة في خاتمة الرّواية، فقد أثقلت الحكايات كاهلنا، وحبست دمعتنا، وزادت من وتيرة خفقان قلوبنا.
أحسن الأديب المقدسيّ “عبدالله دعيس” ربط الجمل بالمعاني وتحاشى التّصنّع، كما كانت عيناه كاميرا متحرّكة في كل الإتجاهات، تلتقط وتترجم وتقارن المواقف، وتكتب ما يبدو على ملامح الأبطال، بل تخترق دواخلهم أيضا، وذلك ببساطة لا متناهية وإنسيابيّة متدفّقة وتسلسل متين. لو كان هناك مَن يحمل الشّعلة ويضيء لغيره طريق الصّواب والحق والعيش الكريم، وكان هناك مَن يقدّم المساعدة في انفتاح التّفكير والبحث عن الحقيقة، لكنّا أسياد هذا الوطن آمنين مطمئنين.
وقالت رنا القنبر:
تدور أحداث الرواية حول رضوان الشخصية المهزوزة، والضعيفة، التي تعاني من اضطرابات عقلية واضحة، تقاذفته الرياح كالريشة من مكانٍ إلى أخر، ومن بلاد إلى أخرى، يحاول الهرب من ماضيه وعائلته؛ ليجد نفسه في أماكن وواقع أشدّ بؤسا مما كان عليه، لم يكن رضوان الشيخ في الرواية إلا بطلا وهميّا ضعيفا قاده ضعفه وتردده إلى حياة رمادية صنعها بيده، بطلها الخوف، والتردد.
يبدأ رضوان رحلة الصراع مع الذات حين يلتقي بأحد أقربائه في البلدة الذي جاء من أمريكا يحمل ثروة طائلة، ويساعده في الالتحاق بالمدرسة الرشيدية في القدس، وهناك يلتقيي بمعلمه صالح النوباني، صاحب المبدأ كما كان يرى، والمرشد له فيعجب بشخصيته أكثر فأكثر، ويتقرب منه فيصبح قدوته، أمّا عبدالله الذي أصبح يأخذه إلى يافا ومقاهيها حيث الترف والبذخ وحياة التجار والمدن الساحلية، فكان جلّ همه جمع المال وتوسيع أعماله فقط ، لكن رضوان يجد ملاذ قلبه هناك في يافا، فيرى الأمر ممتعا في بادئ الأمر؛ ليكتشف أن “أبا حمار” البائع المتجول في القرية، كان يرتاد المقهى وهو صديق عبدالله في التجارة، ولكن بثياب أخرى، ويتضح بعد ذلك بأنه يهودي يقوم بخداع الناس؛ ليشتري الأراضي البور لصالح هجرة اليهود وبناء المستوطنات، ولا يحرك ساكنا حتى بعد أن وصل أبا حمار أو يعقوب صمويل إلى عقر داره، فيخدع عمّه الذي اتهم بالخيانة وبيع أرضه لليهود فيموت قهرا. نجح الكاتب في أن جعل كلتا الشخصيتين بداية صراع لا ينتهي داخل معيوف بين قناعاته ورغباته وبين مبادئه وتردده.
فمنذ طفولته كان ضعيفا هزيلا تائها، فيبدأ بنكران العادات والتقاليد السائدة في ذلك الوقت والتنكر لها دون أن يجرؤ على البوح بذلك، فيجد نفسه قد تزوج خضرة ابنة عمه التي تكبره بعدة أعوام، رغما عنه وعنها بأوامر من عائلته، فيبقى صامتا معذبا إلى أن تنجب خضرة طفله الأوّل عزام، وتحمل بطفله الآخر عدنان فيقرر الهرب .
يسرد الكاتب روايته بأحداث تاريخية اجتماعية متسلسلة، يصف العادات والتقاليد السائدة في قريته، ودور المرأة القوي في تلك الحقبة من الزمن والذي ساهم في تعزيز صمود أهل القرى، فكانت المرأة تقوم بالزراعة والقطف وبيع المحاصيل في الأسواق، ويبدع أيضا بوصف معالم المدينة بجبالها ووديانها وأعيادها الموسمية، وشهامة أهلها وبساطتهم بلغة جميلة وسلسة .
وقد وجدت أن بعض الأحداث غاب عنها المنطق مثال صفحة 133.
فأخر مكان تواجد فيه رضوان قبل أن يغيب عن الوعي حسب ما ذكر كان ” العلية” وكان مضرجا بدمائه التي لم يوضح لنا سببها حتى أو مصدرها، لنفاجأ في صفحة 136 بأنه استيقظ وهو في المستشفى الفرنسي، وعلى ما يبدو أنه مكث به طويلا حتى توطدت علاقته مع الراهبات اللواتي حاولن طرح الأسئلة عليه، ومعرفة كيفية وصوله إلى المستشفى، فنستنتج أنه لم يقم أحد من أفراد عائلته باحضاره إلى المستشفى، ولم يقم أحد بزيارته، ولنفترض جدلا أنه سقط في طريق البلدة، فهل يعقل بأن يتجاهل الكاتب المارة من أبناء القرية الذين يعرفونه هناك؟ والطوق الأمني الذي فرضته القوات الانجليزية على البلدة؟
أوجد الكاتب الكثير من المطبات والعقبات في كل مرحلة من المراحل التي عاشها معيوف، ولكن بعضها لم يكن غير مقنع، ولعل أبرزها هروبه من بيت حنينا الى القدس، وتنقله بين الناس دون أن يعرفه أحد أو يسأل عن عائلته وأصله، أو حقيقة هروبه، وكأنها بلاد أخرى. فالقرى الفلسطينية لا أعتقد أن أهلها غريبون إلى هذا الحد عن المدينة، والعكس صحيح أيضا ويعود الكاتب ليناقض نفسه وبالدليل ..صفحة 300 .. حين تعرف رضوان على شاب في أمريكا، فيتردد بأن يقول له عن اسم قريته إلا بعد أن فكر ماليا بنفسه قائلا” ما الفرق إن قلت له من القدس أو بيت حنينا فهو من ترمسعيا”. وهنا يعرف الكاتب بشكل أو بآخر أنه لو كان هذا الشاب من القدس لأخفى عليه الحقيقة! فإن عادات أهل القدس وقراها بالسؤال عن الغرباء والتحقق منهم، فكيف بالذي يعيش بينهم قرابة العام، ويعود مجددا بعد غياب؟ وكيف يصبح رضوان عاملا بالفرن وبشكل مفاجئ يصبح مجنونا ومن ثم زاهدا وبعدها أستاذ مدرسة في صورباهر، ودار المعلمين في بيت حنينا، وكل هذا في القدس في مدينة واحدة، دون أن يساور الناس الشك والريبة؟ ولا يمكن لذلك أن يدوم طويلا إلى هذا الحد وإن حصل. ولا أعتقد بأن الكاتب قد نجح في تبرير ذلك الأمر.
يبني رضوان أفكاره من خلال تعرفه على تلك الجماعة، وانتمائه إليها، وهنا يبدأ بأخذ واجهة حقيقية في حياته، وسرعان ما ينهار هذا كله أثناء لقائه أولغا فتاة الدير، التى كانت تعمل على متن الطائرة كمضيفة” ولا أدري لماذا تذكرت مارتا في رواية عزازيل للكاتب يوسف زيدان، والتي تعلق بها هيبا لشدة جمالها، وينتهي المطاف برحيلها من الدير، فلم تكن هي أيضا راهبة بل هاربة من تقاليد المجتمع” التقى رضوان بأولغا في دير اللطرون، وكانت هي الأخرى هاربة من عائلتها في ريف حماة، وفرت هاربه بعد أن شاع بالدير خبر حملها، وتقوم هي بدورها بغوايته وتجرده من مبادئه، فيعود ويستجمع قواه بعد عراك طويل مع ذاته المتأرجحة والخائفة؛ ليعود إلى الانتماء مجددا للجماعة، ويتعرف على حسين في جامعة القاهرة، ويقاتلان جنبا إلى جنب الاحتلال الاسرائيلي في سيناء، ويسقط مرة اخرى أمام ضعفه وتردده فلا يقوى على حماية حسين من الموت، ويعود مجددا حبيس تردده واضطراباته .
يجد الكاتب في كل مرحلة في حياة معيوف نهاية تراجيدية بطلها الهرب أو السجن، وينتقل بنا من محطة إلى أخرى، وكأن شيئا لم يكن، ويعود ليتلاعب بالشخصيات الثانوية بشكل لافت ويعيدها جميعهاإلى الرواية بعد اختفائها، وجدت بعضها غير منطقي حد المبالغة، كالتقاء رضوان بأخيه مصطفى في أمريكا في أحد الشوارع العامة، حين كان يبيع الساعات المقلدة هناك، فيتعرفان على بعضمها البعض. ويذكر أن مصطفى كان قد هجر القرية منذ أكثر من ثلاثين عاما، ويجد له عملا في بيع القماش في شركته الخاصة.
تعرف رضوان على “محمود العفن” تلقائيا حين زار قريته بيت حنينا وهو بالمقابل لم يعرفه، وأيضا لم يعرفه أحد هناك .
يهرب بلا أوراق ثبوتية وبطاقة تعريفية، ويتعلم ويصبح أستاذا، ويسافر للدراسة في مصر وأمريكا؟ وأستطيع الاستناد على ما ذكره الكاتب ” وضعت مجموعة الصور، التي احتفظ بها بعناية، ومفتاح العلية في كيس قماشي وربطتها في خاصرتي حتى لا ينتبه إليها أحد، لا أدري لماذا أحمل هذه الأشياء معي كلما فكرت بالهرب؟” فكيف استطاع أن يتنقل بحرية تامة في الدول الأجنبية؟
وأتساءل كيف يتجاهل الكاتب الاعاقة السمعية التي تعرض لها رضوان في المدرسة الابتدائية إثر ضربة تلاقاها من استاذه؛ مما أفقده السمع بأذنه اليسرى، فهل يعقل أنها لم تشكل عائقا ولو بسيطا في حياته؟ وكيف استطاع بعقليته المضطربة وعمله وتواجده في المساجد وانتمائه السياسي، وذهابه للبيت ويستحضر خياله وفتاته الافتراضية “لطيفة” إلى أن يغلبه النعاس بسرعه، فكيف يكون متفوقا في دروسه إلى هذا الحد كما ذكر؟
يستطيع القارئ أن يضع احتمالين للنهاية بكل سهولة قبل قراءتها، فإمّا أن يلتقي بخضرة وأولاده كما التقى بسميرة بعد عشر سنوات وبالحاج حسين، وإمّا أن يعود لبؤسه وخيبته مجددا ويمارس جنونه في الطرقات، كما فعل سابقا لذلك لم تكن النهاية مدهشة بالنسبة لي، ففي كل مرحلة نهاية لا تحتلف كثيرا عن ما قبلها، لأن الكاتب استمر على نفس الوتيرة، فلا يكاد رضوان يدخل مكانا ويمكث فيه حتى يهرب أو يسجن أو يعود لاضطراباته العقلية.
يزج بالسجن بتهمة سرقة كاميرا تصوير بعد أن رأى أبا حمار يتجول مع مجموعة من السائحين في القدس، فيحاول أن ينقض عليه، فيتهمه الآخر بسرقته، يحاول أن يبرر للضابط ما حصل، وبأنه استاذ محترم في دار المعلمين، وبأنه قاتل الاحتلال فكيف يمكنه السرقة؟ لكن الظابط لم يصدقه،وهنا أيضا يثبت أنه لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية بأنه أستاذ، أو بطاقة تدل على ذلك، ولنفترض أنه كان بحوزته، لم يكن على الضابط تكذيبه؟ فكيف يخفى على ضابط الشرطة أمرا كهذا فمهنة التحري هي أساس عمله، ولماذا لم يستعن بمحامي على الأقل؟ ولِمَ لمْ تحاول سميرة مساعدته .
ولنفترض جدلا أنه ممكن أن يحصل ذلك كله، ونحاول تقبل كل ما ذكر سابقا ولكن اذا ما أخذنا شخصية رضوان من الناحية السيكولوجية والبعد الاجتماعي لمكان الحدث، أي القدس فسنجد أنه لا يتناسب مع الأحداث التي ذكرت، فشخصية مضطربة لن تستطيع اخفاء أمرها كثيرا، ومكان الحدث لا يوفر الأرضية الخصبة للتشكل كيفما يريد .
ربما نستنتج أن رضوان لم يكن يعاني من اضطرابات عقلية فحسب، بل من انفصام جعل منه شخصية ازدواجية بلا وجه حقيقي ، أطاحت بمبادئه أوّل امرأة جميلة التقى بها، فهو يتشكل حسب الزمان والمكان، وحتى في انتمائه وعقيدته كان مشككا يأبى التفكير خوفا من الالحاد، يترك عائلته دون الشعور بالذنب، يتخلى عن أصدقائه في ساحة المعركة، ويفر هاربا أو يقف متفرجا كما وقف متفرجا امام ” يعقوب صمويل” الذي اشترى أرض عمّه؛ لتقام عليها مستوطنات، وهذا يعني أن خياناته أكثر من بطولاته إن وجدت، أوليس الصمت والهروب خيانة كبرى أيضا؟ فحتى النهاية لم تخلُ من الانفصام، فنجده ينادي بالمقاومة والأمل ويلوم الناس على اتهامه بالخيانة، ويحلم بمدينة فاضلة يسودها الطهر والعدالة؟ فقد أوصلنا الكاتب لفكرة أنه لو بقي في أمريكا ولم يتم ترحيله، لما عاد إلى القدس يبكى في أحضانها، ويبقى السؤال كيف استطاع الكاتب جمع تلك الشخصيات في شخصية واحدة بهذه البساطة دون أن يراعي عقلية القارئ والمنطق ؟
وكتبت رائدة أبو صويّ:
رواية من العيار الثقيل …ذهب 24 قيراط .
اسم الرواية لافت وجذاب .أما مضمونها فحدث ولا حرج …ابداع وتميز وتشويق واثارة .
رواية لم نحظ برواية اجتماعية تاريخية تشبهها .استطاع الكاتب أن يضع بين دفتي الرواية قرية بيت حنينا بأدق التفاصيل .نقل الينا بطريقة ممتعة جدا العادات والتقاليد والمعتقدات الجاهلة .
ومن التقاليد السلبية عدم الاستحمام حتى تذهب العين والحسد ،والعطبة “قطعة من القماش بالغالب سوداء قطنية تحرق ويرقى بها الأطفال والكبار، قال شو: بتبعد الحسد والعين.
عشنا أحداث الرواية من خلال مونولوج الراوي معيوف، صراع نفسي داخلي ألقى به بطل الرواية [رضوان ] على الأوراق البيضاء ليتخلص من ماض مؤلم .
من منا لا يوجد في حياته جانب مظلم يتمنى أن يتخلص منه .
تصوير للمكان في غاية الدقة والجمال، فترة الحكم الأنجليزي والفرق بين الحكم التركي والحكم الأنجليزي لفلسطين .كتب الكاتب، رغم قسوة الأتراك وحبروتهم لم يدخلوا القرية ولم يعيثوا فيها فسادا كما يفعل خلفاؤهم الأنجليز .
دقة في التصوير وجمال عندما كتب “فجعتني قسوة الدنيا قبل أن تتفتح أزهار عقلي” حكم قوية موجودة في الرواية عندما كتب “عمر النعجة ما بتصير ناعوق“ دلالة على أن الضعيف يبقى كذلك ولا يصبح قائدا .
ظاهرة الجهل والتخلف التي كانت سائدةفي تلك الحقبة الزمنية .
ومن صور الجهل تعامل بعض الأهالي مع مرض الحصبة، وتغطية أطفالهم بالحرامات، ارتفاع درجة حرارة الاطفال كانت تقتلهم، وغيرها من الأسباب مثل المواد السامة التي كانت توضع في متناول يد الاطفال .
رواية توعوية اضافة إلى كونها رواية أدبية من الدرجة الأولى، بعض المواقف جعلت الدموع تتساقط من عينيّ .
موت فاطمة …..ذهاب معيوف إلى الجبل؛ ليلمس السماء الزرقاء؛ اعتقادا منه أن والدته تعيش في السماء، ذهب ليرجوها أن تعود معه الى الأرض أو تصطحبه إلى السماء، لا يستطيع العيش دون حنانها وحضنها الدافيء، صور جميلة جدا وضعها بين أيدينا أمام أعيننا من خلال الوصف الرائع ،أشجار الزيتون الرومية والتين والخروب وقرص الشمس والعديد من الصور الرائعة.
وجه اصبع الاتهام الى بعض الآباء الذين كانوا يتعاملون بالقسوة مع أبنائهم، مما دفع الأبناء للتمرد والهجرة، وترك أوطانهم والعيش بعيدا .صورة كانت تتكرر في معظم القرى الفلسطينية.
ومن الأمثال المحبطة التي كان يكررها الآباء على مسامع أبنائهم”عمر النعجة ما بتصير ناعوق.”
الأنسان هو الوحش الحقيقي في هذا الكون وليست الغولة ولا الضبع. في الرواية صورة من صور العنف والظلم والأستبداد التي كانت تمارس ضد المرأة، مجتمع ذكوري ظالم .
الرواية أدبية ثقافية اجتماعية من الطراز الأول .
وكتب طارق السيد:
معيوف ذلك الكائن الذي يبدو أن له من اسمه نصيب، فاسمه لم يكن محض صدفه ليقيه من الموت، ويبقيه على قيد الحياة كما ظن أهله، بتغيير الاسم من رضوان الملاك إلى معيوف الذي عاف بهارج الدنيا وقنع بقليلها، حياته كانت عبارة عن مطبات وانزلاقات تترجم حظه العاثر، بدأ الكاتب الرواية بخط اجتماعي جميل للريف الفلسطيني، وتحدث عن الخرافات والعادات والموروث الشعب،ي والطبيعة والملابس بوصف جميل، ولكن جاء انحرافه عن السكة سريعا بالوقوع بالفخ الفلسطيني، وهو السياسة والوقائع التاريخية التي باتت تتشابه في جميع الأعمال، الانجليز والحاج أمين والثورات، وكان الأعمال الفلسطينية تحولت الى درس تاريخ مكرر، اعتدل قليلا الكاتب في مشهد القرية ووصف مشاهد موسم النبي موسى، وبعدها بدأت رحلة عذاب معيوف .فأصابه الاكتئاب الذي لم يوضح الكاتب سبب له، واتهم بالجنون أيضا من قبل الناس، وغاب عن الكاتب أن يرينا بعضا من هذه المظاهر، فكيف يتهم بالجنون دون أيّ ربط منطقي، حتى أن الموضوع لازم معيوف في هواجسه طول حياته .
التناقض في الشخصية فالكاتب لم يوفق باستعمال أبعاد واضحة للشخصية أدبيا أو دراميا، فبطل الرواية صار كدمية الماريوليت بيد الكاتب، فتارة نراه أنانيا بتركه بيته دون أدنى احساس بالمسؤولية تجاه زوجة حامل ووليدها، وتارة يرينا معيوف بطلا صنديدا يحارب الانجليز، وتارة أخرى نرى معيوف المتعلم، ومعيوف الجاهل المجنون، معيوف المزارع، معيوف المغامر الفنتازي، معيوف الأسطوري الذي التقى بالملك حسين، والتقى بحسن البنا والتقى بجماعة أمّة الاسلام في أمريكا، وذهب إلى جزر كوبية، معيوف الذي يشارك في بيع الأراضي للمستوطنين من خلال صمته .
أرى أن التناقض في أبعاد الشخصية صنع اضطرابا واضحا في الشخصية، حتى باتت تصرخ لتقول من أنا؟ وماذا يريد مني الكاتب ؟
الحبكة والمنطق كانتا الطامة الكبرى بالنسبة للرواية، فنحن نعلم أن الحبكة هي عنصر اساسي من عناصر اكتمال أيّ رواية، سواء كانت رواية تسجيلية أو واقعية أو أيّ نوع آخر، لذلك سأستعرض بعضا من الفجوات في الحبكة والمنطق .
أولا: يتهم معيوف بالجنون دون أيّ مظهر من مظاهر الجنون، بل ويتكرر المشهد في زاوية المتصوفيين بنفس الطريقة، يقع فيقع عليه الجنون وبعدها يزول، وكأننا أمام فيلم هندي يصدم البطل رأسه فينسى، ويصدم راسه مرة أخرى فيتذكر .
ثانيا: هروبه من بيت حنينا لم يكن منطقيا أو مبررا، والأدهى من ذلك تواجده بالقدس لمدة ثمان سنوات دون أن يصادف أحدا من بيت حنينا، أو يتعرفوا عليه ونحن نعلم ما هي المسافة بين بيت حنينا والقدس، فبالنهاية بيت حنينا والقدس ليستا ولايات أمريكية، فهما متجاورتان وعدد السكان القليل في ذاك الزمن، فكيف يعقل أن يختبأ ولا يراه أحد بالمطلق، وفي وقت لاحق هو من يتعرف على الجميع، ولا يتعرف عليه أحد، بل ويذهب الكاتب بأخذه فيما بعد ليدرس في بيت حنينا، فهل كان معيوف يلبس طاقية الاخفاء؟
ثالثا: سفره وتنقله ودراسته، دون وجود تمويل والجميع يعرف أن الدراسة بالكليات والجامعات والسفر بحاجة إلى المصاريف الباهظة، فكيف لصبي فران أن يدفع هذه التكاليف، ويسكن ويأكل ويشرب بل ويسكن الفنادق كما حدث في مصر .
رابعا: استئجاره لبيوت بالبلده القديمة بمبالغ زهيدة، ولكن الاغرب غيابه لسنوات وعودته في كل مرة ببساطة ليفتح الباب، كما حدث في غرفته في حي السرايا، سجن طويلا ولسنوات وعاد ببساطة يحمل المفتاح ليفتح باب الغرفة، هل كان أصحاب البيوت، ليتركوا بيوتهم لسنوات بلا ساكن .
خامسا: تناقضات شخصية أولغا، من فاسقة إلى راهبة إلى مضيفة طيران .
سادسا: معيوف كان هدفا جنسيا ومستغلا في كل مرة سواء من قبل نايفة أو أولغا، حتى سميرة كانت تشتهييه بنظراتها المكبوتة، وفي هذا نرجسية واضحة غير مبررة لبطل الرواية .
سابعا: حبسه بذريعة انتزاع الكاميرا لعامين .
ثامنا: غيابه لمدة عشرين عاما في المرة الأولى، ولم يتجاوز ولده الصف السادس.
أما بالحديث عن الخط السياسي، فكان واضحا تمجيد الاخوان المسلمين في فلسطين ومصر على حساب القوميين، وكان الاخوان هم المخرج من سيأخذون البلاد من الظلمات إلى النور .
شخصية معيوف كانت أحيانا قيادية وأحيانا انقيادية، إلى أين أراد الكاتب أن يأخذ معيوف؟ وماذا أراد من الحياة ؟
التناقضات كثيرة من الشك الديني في كل مرة، إلى الاكتئاب، إلى الانحراف عن المسار، حتى دراسته في البداية لم تكن واضحة، وبنهاية الأمر حصل على دكتوراة بالاحياء .
قام الكاتب بزج المعلومات بطريقة الاقحام وبشكل غير مبرر، وصنع لبطل الرواية زاوية في كل حدث سياسي أوتاريخي ، وعلى الرغم من ذلك وفق الكاتب بمشهد مسرحي درامي في صفحة رقم 203 بعد خروج معيوف من عند أولغا، فكان مشهدا قمة في الروعة، وكم تمنيت لو شاهدت العديد من هذا المشهد بالرواية .
اختتم الكاتب الرواية بمعيوف الهزيل الذي رضي بقدره في هذه الرحلة، وكأن الحل الديني أو الدخول إلى الأقصى هو التسليم بالأمر الواقع، اختار الكاتب أن يبقي بطله بمازوكية عالية من تعذيب الذات، واهمال النفس وتعنيفها بدلا من العودة والالتفاف حول الأسرة.
وقالت نزهة أبو غوش:
اللغة في رواية معيوف
عندما أمسك الكاتب قلمه ليكتب روايته ” معيوف”، اختار لغة تناسب تلك الرّواية وطوّعها؛ كي تخدم المعنى الّذي أراده، استخدم الكاتب اللغة الفصحة البسيطة وغير المعقّدة القريبة من القارئ .
استخدام ضمير المتكلّم ” أنا” ساهم في سلاسة اللغة، فكانت واضحة ومعبّرة كشف بها المتحدّث بطل الرّواية عن مكنوناته الدّاخليّة، وما يجوب نفسيّته من آلام وحزن وفرح ومآسي. إِنّ استخدام الكاتب لضمير المتكلّم ساهم في تدرّج اللغة وسلاستها وسهولة التّعبير عند المتحدّث، كذلك عند استخدام أُسلوب الاسترجاع، والحوار الذّاتي ،وغيره ” أحسست بنفسها يتسارع إِلى وجهي، وشعرت برعشة في جسمي لم أشعر مثلها من قبل“.
الوصف في رواية الكاتب عبد الله دعيس نجد أنّه دقيق غير مبالغ فيه، ممّا يخدم الفكرة الّتي أرادها الكاتب في النّص، في ص 78″ دهشت من مرأى السيّارة الغريب…كانت عربة فخمة حمراء اللون، أمّا سقفها فكان مصنوعًا من الجلد لابيض الّذي يميل لونه إِلى الاصفرار، وفي مقدمتها عدد من المصابيح وبوق…الخ
نلحظ أنّ الكاتب دعيس قد استخدم في روايته اللغة التّقريريّة، أو الاخباريّة الّتي أضعفت قليلا من قوّة النّص. في ص 84″ ساءت الأوضاع كثيرًا في في أمريكا1928 وأغلقت البنوك أبوابها، وخسر معظم رجال الأعمال أموالهم وأفلست شركاتهم.”
في روايته معيوف عمد الكاتب أن يدخل المحسّنات اللفظيّة والتّشبيهات والاستعارات، ممّا أضفى جمالا ورونقا ملموسين على شكل الرّواية.
.” إِنّ وصفي لألمي سيكون تماما كما تصف المرأة ألم الولادة لرجل لم ولن يخبر هذا الألم، فأنّى له أن يدركه؟“
لغة الحوار في الرّواية ساهمت في التّعرّف على بعض الشّخصيّات الثّانويّة، وقلّت في معرفة الشّخصيّة الرّئيسيّة.
استخدم الكاتب عبدالله دعيس اللغة الايحائيّة، حيث لم يعمد إِلى وصف العلاقات بين الرجل والمرأة بشكل صريح ، وإِنّما الايحاء كان كافيًا لفهم المعنى، وهو ربّما أقوى من التّصريح المباشر.
امتلات لغة الكاتب بالعبارات والمعاني الوطنيّة الّتي أضافت زخمًا ملحوظًا للرّواية .
” ها أنا انال شرف الجهاد في قلب المدينة الّتي أحببتها بعد أربعين عامًا من الهجران والحرمان” ص357.