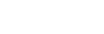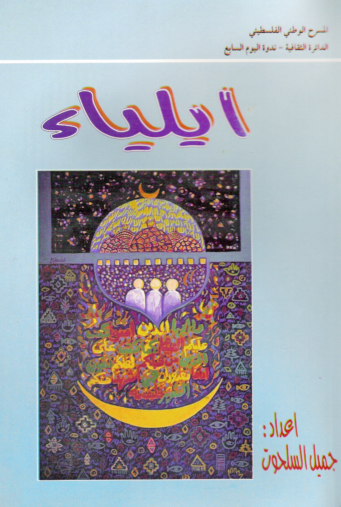القدس: 14 -7-2016 ، ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، رواية “زغرودة الفنجان” لللأسير المقدسي حسام شاهين، وتقع الرّواية التي صدرت عام 2015 عن دار”الأهليّة للنّشر والتّوزيع” في العاصمة الأردنيّة عمّان في 310 صفحات من الحجم المتوسّط. ويحمل غلافها الأوّل لوحة للفنّان التّشكيليّ الفلسطيني خالد نصّار.
بدأ النقاش ابراهيم جوهر فأشاد بالرّواية.
وتحدّث بعده الأسير المحرّر رائد السلحوت:
زغرودة الفنجان وقصة عشق قديمة
بداية أشكركم من صميم قلبي على الاستضافة وهذا شرف لي أن أكون بينكم ومنكم، وإن شاء الله سأكون من رواد هذه الندوة ما استطعت ذلك .
حسام الانسان صديق عزيز ورائع، وشخصية قياديّة متميّزة، مثقف استقى ثقافته من تجاربه العملية في العمل بين أبناء شعبه، ومن خلال مطالعاته المتعدّدة، صاحب حسّ مرهف وعاطفة جياشة، وفي نفس الوقت حازم ولا يتردد في قول الحق مهما كانت النتائج .
للكتاب في قلب حسام مكانة خاصه يقتطع ساعات من يومه ليكون جليسا له ومعه، يبحر في دهاليزه باحثا في ما بين السطور، فهناك زبدة الكلام كما يقال .
عدا عن أنه انسان شهم وكريم ومبادر، يحوز حب فلسطين على قلبه وعقله، ورغم الصعوبات التي تلم بالقضية الوطنية بشكل عام، وبحركه فتح بشكل خاص، إلا أنّه متفائل بشكل غير اعتيادي، وهو مؤمن بحتمية انتصار الشعب الفلسطيني الولّاد، والذي سيبرز من بين أبنائه من يعمل على تحقيق الخلاص، والنهوض بحركه فتح التي باعتدال حالها اعتدال لجميع المشروع الوطني .
الأسر أضاف لحسام الكثير من التجارب التنظيمية التي يتقن التعامل معها أصلا، والتجارب الانسانية التي تهمه أكثر، وإذا ما فرضت مشكلة ما، فإنه يعالجها من كافه جوانبها بقدرة واقتدار، ويتألم إذا ما واجه أحد الأسرى مشكلة ما، فلا يهدأ إلا بعد أن يحلها، وتجاربه في هذا المضمار كثيرة جدا.
الرواية حلم يراود حسام، فمنذ أن بدأ الكتابة وهو يطمح بكتابة رواية، ولا أنسى كيف كان يقص عليّ عرضه لأوّل كتاباته على العم الشيخ جميل السلحوت، وتشجيعه له بأنه سيكون ما يريده، تجربة الأسر صقلت لدى حسام توجهاته في الكتابة، فانخصر بين المقالة السياسية والقصة القصيرة، إلى أن قرر كتابة رواية تتضمن تجارب من عايشهم، وتجاربه الشخصية، وقصصا كان شاهدا عليها، وأكثر دافع حسب رأي الشخصي الشعور بالإجحاف والظلم الذي لحق بكتائب شهداء الأقصى، والتي لم يسلط الضوء عليها كما يجب، فحجم التضحيات كان هائلا، والفرق بين العمل وتسليط الضوء كان كبيرا جدا .
هذا من جهة أما من الجهة الأخرى التي لا تقلل من أهميه انغماس حسام الانسان بمشاكل هؤلاء المناضلين الذين سوادهم الأعظم إرتقى الى الأعالي شهيدا، والقسم المتبقي إما جريح يعاني شدة الألم والعزلة، أو أسيرٌ حكم عليه بالمؤبدات والسنوات الطويلةة .
الرواية مميزة ككاتبها، فهو كاتبها الذي يحيط بحيثياتها، وأما عمر بطلها الرئيسي فقد جمعت شخصيته قصصا، كثيرة وتجارب عديدة وحسام ككاتب أراد أن يظهر أن الصراع مستمر، والاحتلال يعمل على إسقاط بعض أبناء شعبنا لتحييدهم، أو ليكونوا براثن له، وسلط الضوء على العلاج المجتمعي الصحيح، وركز أيضا على أننا شعب في مرحلة تحرر ويجب علينا إلتزام القواعد الأمنية التي تقوينا وتجعلنا عصيين على الكسر تحت ضغط المؤسسة الاستخباراتية الاسرائيلية، التي تعمل ليل نهار لقتل روح النضال الوطني لشعبنا .
أخيرا حسام الانسان لا أستطيع وصفه بهذه السطور، ولو حدثتكم عنه عشرات الساعات لن أوفيه حقه .
قال جميل السلحوت:
اضاءة لا بدّ منها
أدبيّات السجون:
الكتابة عن التجربة الإعتقالية ليست جديدة على الساحة الفلسطينيّة والعربيّة وحتى العالميّة، وممن كتبوا بهذا الخصوص: خليل بيدس صاحب كتاب”أدب السجون” الذي صدر بدايات القرن العشرين، زمن الانتداب البريطانيّ، وكتب الشّيخ سعيد الكرمي قصائد داخل السجون العثمانية في أواخر العهد العثمانيّ، كما كتب ابراهيم طوقان قصيدته الشهيرة عام 1930تخليدا للشّهداء عطا الزير، محمد جمجوم وفؤاد حجازي، وكتب الشّاعر الشّعبي عوض النابلسيّ بنعل حذائه على جدران زنزانته ليلة إعدامه في العام 1937 قصيدته الشهيرة” ظنيت النا ملوك تمشي وراها رجال” وكتب الدكتور أسعد عبد الرحمن في بداية سبعينات القرن الماضي(أوراق سجين)كما صدرت مجموعة قصص(ساعات ما قبل الفجر) للأديب محمد خليل عليان في بداية ثمانينات القرن الماضي، و”أيام مشينة خلف القضبان” لمحمد احمد ابو لبن، و”ترانيم من خلف القضبان” لعبد الفتاح حمايل ، و”رسائل لم تصل بعد” لعزت الغزاوي ، و”قبّل الأرض واستراح” لسامي الكيلاني، و”نداء من وراء القضبان، “و(الزنزانة رقم 706) لجبريل الرّجوب، وروايات “ستائر العتمة” و “مدفن الأحياء”و”أمّهات في مدفن الأحياء”وحكاية(العمّ عز الدين) لوليد الهودلي،و”رسائل لم تصل بعد”ومجموعة”سجينة”للرّاحل عزت الغزاوي و(تحت السماء الثّامنه)لنمر شعبان ومحمود الصّفدي، و”أحلام بالحريّة”لعائشة عودة، وفي السّنوات القليلة الماضية صدر كتابان لراسم عبيدات عن ذكرياته في الأسر، وفي العام 2005صدر للنّائب حسام خضر كتاب”الاعتقال والمعتقلون بين الإعتراف والصمود” وفي العام 2007 صدرت رواية “قيثارة الرمل” لنافذ الرفاعي، ورواية”المسكوبية” لأسامة العيسة، وفي العام 2010 صدرت رواية”عناق الأصابع” لعادل سالم، وفي العام 2011 صدر كتاب “ألف يوم في زنزانة العزل الانفراديّ لمروان البرغوثي، و”الأبواب المنسية” للمتوكل طه، ورواية “سجن السّجن” لعصمت منصور،وفي العام 2012 صدرت رواية”الشّمس تولد من الجبل لموسى الشيخ ومحمد البيروتي” كما صدر قبل ذلك أكثر من كتاب لحسن عبدالله عن السّجون ايضا، ومجموعة روايات لفاضل يونس، وأعمال أخرى لفلسطينيين ذاقوا مرارة السجن. وفي العام 2013صدر كتاب”الصمت البليغ” لخالد رشيد الزبدة، وكتاب نصب تذكاري لحافظ أبو عباية ومحمد البيروتي”، في العام 2014 رواية”العسف” لجميل السلحوت، وفي العام 2015 زغرودة الفنجان لحسام زهدي شاهين.
وأدب السجون فرض نفسه كظاهرة أدبية في الأدب الفلسطيني الحديث، أفرزتها خصوصية الوضع الفلسطيني، مع التذكير أنها بدأت قبل احتلال حزيران 1967، فالشعراء الفلسطينيون الكبار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم تعرضوا للاعتقال قبل ذلك وكتبوا أشعارهم داخل السجون أيضا، والشاعر معين بسيسو كتب”دفاتر فلسطينية” عن تجربته الاعتقالية في سجن الواحات في مصر أيضا.
كما أن أدب السجون والكتابة عنها وعن عذاباتها معروفة منذ القدم عربيا وعالميا أيضا، فقد كتب الروائي عبد الرحمن منيف روايتي”شرق المتوسط” والآن هنا” عن الاعتقال والتعذيب في سجون دول شرق البحر المتوسط. وكتب فاضل الغزاوي روايته” القلعة الخامسة” وديوان الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم”الفاجوجي”.ومنها ما أورده الأستاذ محمد الحسناوي في دراسته المنشورة في مجلة”أخبار الثقافة الجزائرية” والمعنونة بـ”أدب السّجون في رواية”ما لاترونه”للشاعر والرّوائي السوري سليم عبد القادر وهي (تجربة السجن في الأدب الأندلسي- لرشا عبد الله الخطيب ) و ( السجون وأثرها في شعر العرب.. –لأحمد ممتاز البزرة ) و( السجون وأثرها في الآداب العربية من الجاهلية حتى العصر الأموي- لواضح الصمد ) وهي مؤلفات تهتم بأدب العصور الماضية ، أما ما يهتم بأدب العصر الحديث ، فنذكر منها : ( أدب السّجون والمنافي في فترة الاحتلال الفرنسي – ليحيى الشيخ صالح ) و( شعر السّجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر – لسالم معروف المعوش ) وأحدث دراسة في ذلك كتاب “القبض على الجمر – للدكتور محمد حُوَّر”
أما النصوص الأدبية التي عكست تجربة السجن شعرا أو نثرا فهي ليست قليلة، لا في أدبنا القديم ولا في الأدب الحديث: نذكر منها ( روميات أبي فراس الحمداني ) وقصائد الحطيئة وعلي ابن الجهم وأمثالهم في الأدب القديم. أما في الأدب الحديث فنذكر: ( حصاد السجن – لأحمد الصافي النجفي ) و (شاعر في النظارة : شاعر بين الجدران- لسليمان العيسى ) و ديوان (في غيابة الجب – لمحمد بهار : محمد الحسناوي) وديوان (تراتيل على أسوار تدمر – ليحيى البشيري) وكتاب (عندما غابت الشمس – لعبد الحليم خفاجي) ورواية “خطوات في الليل – لمحمد الحسناوي”.
كما يجدر التنويه أن أدب السجون ليس حكرا على الفلسطينيين والعرب فقط ، بل هناك آخرون مثل شاعر تركيا العظيم ناظم حكمت، وشاعر تشيلي العظيم بابلو نيرودا، والرّوائي الرّوسي ديستوفسكي في روايته”منزل الأموات” فالسّجون موجودة والتّعذيب موجود في كلّ الدّول منذ القديم وحتى أيامنا هذه، ولن يتوقف الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
عودة إلى زغرودة الفنجان
قبل الدّخول في الرّواية يجدر التّعريف بشيء من سيرة كاتبها.
– ولد حسام زهدي شاهين في عرب السّواحرة-القدس عام 1972 في أسرة كادحة ومناضلة.
– انخرط في صفوف حركة فتح وهو طالب في المدرسة، حيث ظهرت شخصيّته القياديّة والمرحة في سنّ مبكّر، ممّا أهّله أن يتدرّج في صفوف الشّبيبة الفتحاويّة، إلى أن وصل إلى قيادتها بقدرة واقتدار، وهذا ما لفت انتباه زعيم حركة فتح الرّئيس الرّمز ياسر عرفات فقرّبه منه.
– عرف عنه حبّه لتطوير وتثقيف نفسه بنفسه، فانكبّ على المطالعة في مختلف المجالات، وهذا ما يشهد له به معارفه قبل وقوعه في الأسر وأثناءه. وهذا ينعكس من خلال المقالات السّياسيّة والفكريّة التي كتبها ولا يزال يكتبها.
– وقع في الأسر في 28- 1- 2004، وحكم عليه 27 عاما.
– واصل كتابة آرائه وهو قابع في الأسر رغم قساوة الحياة والامكانيّات القليلة وراء القضبان، إلى أن كتب روايته هذه “زغرودة الفنجان.”
اسم الرّواية
التقط حسام شاهين اسم روايته من الصّوت المنبعث عن صبّ فنجان القهوة من الدّلّة النّحاسيّة، والذي يشبه صوت الزّغرودة.
الاهداء
يهدي حسام شاهين روايته إلى شهداء الحركة الأسيرة ومناضليها، وهو بهذا يؤكّد وفاءه لدماء الشّهداء وأنين وعذابات الأسرى كونهم “خير من فينا” على رأي الرّاحل محمود درويش.
المضمون:
ترتكز أحداث الرّواية على الصّراع مع المحتلّ، فهناك مقاومون وهناك محتلّ يحارب المقاومة بجبروته وقوّته وتعدّد أساليبه، ومنها تجنيد عملاء لرصد حركات ومخطّطات المقاومين، وللاحتلال أساليبه في اسقاط المتعاونين معه، ترتكز في غالبيّتها على المال والجنس وحبّ الانتقام في التّربية العشائريّة.
البناء الرّوائي:
اعتمد الكاتب أسلوبا سرديّا يطغى عليه عنصر التّشويق، فرغم طول الرّواية وتعدّد شخصيّاتها إلا أنّ الكاتب استطاع السّيطرة عليها، معتمدا على السّرد، الحوار، تعدّد الحكايات والأحداث، اللغة المحكيّة عندما يكون لها ضروروة لا يمكن الاستغناء عنها. كما اعتمد على أسلوب الاسترجاع لتكون شخصيّات الرّواية متكاملة ومتداخلة دون الاثقال على القارئ.
وممّا يحسب للكاتب ولروايته هو الجرأة في طرح المواضيع، والحديث عن بنية الشّعب الفلسطينيّ كما هي، وكأنّي بالكاتب يريد أن يقول بأنّ الشّعب الفلسطينيّ شعب كبقيّة الشّعوب، فيه الصّالح والطالح، الصّادق والكاذب، المناضل والخائن، الجاهل والمثقف…إلخ. فهكذا هي الشّعوب، فقضيّة العملاء موجودة، وإن كانت لا تشكّل ظاهرة. والمقاومة موجودة بشكل ظاهر، وقدّمت آلاف الشّهداء والأسرى.
وماذا بعد؟
تشكّل هذه الرّواية إضافة نوعيّة للمكتبة الفلسطينيّة والعربيّة، وهي ليست تكرارا لأدبيّات السّجون التي نشرت. وبهذه الرّواية يدخل حسام زهدي شاهين مجال الأدب الرّوائي من أوسع أبوابه.
وكتب محمود شقير:
والرواية مكتوبة بلغة سردية جميلة، وبأسلوب بالغ العذوبة والتشويق، بحيث ينطبق عليه وصف السهل الممتنع. وهي، أي الرواية، نتاج أكيد لمعاينة النضال الوطني عن قرب ضد الاحتلال وللانخراط الفعلي في هذا النضال، وهي كذلك نتاج لثقافة عميقة متنوعة اكتسبها الكاتب قبل الوقوع في الأسر، واثناء المكوث في قسوة هذا الأسر لسنوات طويلة ما زالت ممتدة حتى الآن.
ولا يختار حسام زهدي شاهين الجنس في روايته من أجل التسويق أو الترويج كما جرت العادة في بعض الروايات التي تصدر تباعًا هذه الأيام، بل إن الجنس في الرواية جاء باعتباره العنصر الأساس الذي انبنى عليه السرد المتشعب، الذي يكشف مصائر رجال ونساء وقعوا في فخ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضمن مقولة ” الإسقاط” التي استخدمتها هذه الأجهزة لتجنيد العملاء الذين خانوا وطنهم، وقدموا خدمات استخبارية للعدو كانت عونًا له لتصفية مناضلين كثيرين من أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية.
وحين يتعامل حسام زهدي شاهين مع هذه المقولة فإنه لا يتركها في نصه الروائي لتفعل فعلها السلبي في نفوس الجيل الجديد من الشابات والشباب، بل إنه يشخص الداء ويصف الدواء لهذه الظاهرة المقيتة، بحيث يصح القول إن “زغرودة الفنجان” رواية تربوية بامتياز، وهي تذكرنا بالأعمال الأدبية السردية الملتزمة التي ظهرت في آداب الشعوب الأخرى إبان فترات النضال ضد الغزو الأجنبي وضد الظلم والطغيان.
تبدأ الرواية بمشهد مختزل يشكل عبر تداعياته الكثيرة اللاحقة عصب الرواية ومحتواها الأساس. ونكون هنا وجهًا لوجه مع عمر المنخرط في النضال ضد المحتلين، المطلوب لهم لاغتياله أو اعتقاله، وهم الذين جندوا صديقه مازن لكي يتعقبه ويرصد كل حركاته وسكناته لإنهاء حياته في اللحظة المناسبة. لكن ضمير مازن يستيقظ لأسباب عدة منها خوفه على أسرته التي باتت في دائرة الخطر، وحرصه على صديقه عمر الذي كان يثق به ويحترمه حين كانا زميلين في العمل. وأما المشهد المختزل الذي تبدأ به الرواية فهو متعلق بعملية “الإسقاط” التي تتخذ من الجنس وسيلة للضغط على الشباب والشابات، لكي يصبحوا عملاء للعدو تجنبًا للفضيحة ولرد فعل المجتمع الذي لا يرحم في مثل هذه الحالات، “لدرجة أن جزءاً من العادات والتقاليد البائسة أصبح أقوى من الدين، والدين نفسه تتلاعب فيه الفتاوى المتناقضة الخاضعة لرغبة ومصلحة المفتي” (الرواية ص243 ).
يستيقظ ضمير مازن ويخبر صديقه بحقيقة أنه يعمل لمصلحة العدو، وأنه مكلف بالإيقاع به، ويخبره عن عمليات الإسقاط التي مارسها ضد شباب وشابات، بحيث أسّس شبكة واسعة من العملاء امتدت لتصل بعض طالبات وطلاب الجامعة، ما يجعل عمر متفاجئًا مما يكمن تحت سطح مجتمعنا من آفات.
وما يلفت الانتباه أن الكاتب بعد أن مهد لروايته بهذا المشهد الافتتاحي الصادم، فقد دخل في ما يشبه السرد التوثيقي ليتحدث بلغة مباشرة عن اغتيال حسين عبيات وهو أحد قادة الانتفاضة الثانية في منطقة بيت لحم.
وحيث تصبح اللغة في مثل هذا المقام لغة تقريرية إخبارية لغايات نقل الخبر بأمانة وصدق، فإنها، أي اللغة، تتلون بتلاوين المجاز حين تصبح وصفًا لدواخل عمر ورفاقه ولرصد مشاعرهم جراء اغتيال المناضل عبيات. بل إن عمر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو يدخلنا على نحو ملائم في إطار السيرة الشخصية حين يشير إلى السنوات التي قضاها في السجن وما زال فيه، وهي الحالة نفسها التي تنطبق على كاتب الرواية، بحيث يصبح واضحًا أن عمر هو حسام زهدي شاهين إلى حدّ ما. وهو لا يكتفي هنا برصد مشاعر الحزن جراء استشهاد عبيات، بل ينصاع لمنطق الحياة التي لا تبقى على وتيرة واحدة، فيشركنا معه في بعض مشاعره الخاصة بالحب، وهو بوح إنساني صادق ومشروع.
ولكي يضفي الكاتب على روايته بعدًا محليًّا معبرًا بصدق عن شخوص الرواية وعن ثقافتهم ووعيهم، فهو يستخدم الحوار باللهجة العامية في كثير من المواقع إلى جانب الحوار الفصيح، ويحتفي ببعض المصطلحات الشعبية ذات الدلالات المحددة. فها هي رحاب المتعاونة مع العدو تردّ على ليلى التي اغتصبت بالخدعة، وهي تصفعها وتجلس على صدرها: “إياك والتمادي يا كلبة، فإذا كنت تعتبرين نفسك أهم منا جميعاً، ودائماً “رافعة مناخيرك في السما”، الآن أنت عاهرة “ومدعوس عليك بالشبشب”. (الرواية ص182)
من هنا، ورغم أن الرواية معنية في الدرجة الأولى بهذا البعد التربوي التثقيفي للأجيال الناشئة كي لا تقع فريسة في أيدي الأعداء جراء انعدام الخبرة وقلة التجربة، فإن الكاتب يعرج على الظرف الاجتماعي الذي يفرز هذه الحالات من الانحراف عن التوجهات الوطنية، ولا يكتفي بذلك، بل يسلط الضوء على ما في هذا المجتمع من عناصر خير كثيرة، بحيث تبدو عمليات الإسقاط، وما يتبعها من تجنيد عملاء لخدمة العدو مجرد زوبعة في فنجان، وهو غير الفنجان الذي تحتفي به الرواية. فنجان الشيخ داود، المصلح المتمسك بكل ما هو إيجابي من تقاليد المجتمع، ومن بينها حفظ كرامة الناس والمحافطة على النسيج الاجتماعي من التفسخ، متمثلا في إيجاد الحل المنطقي المعقول لحماية طالبة جامعية، تم الإيقاع بها، من الفضيحة والسقوط في أيدي عصابة العملاء.
هنا، وبعد صفحات كثيرة من تواتر النص الروائي، نلتقي ثانية مع السيرة الشخصية للكاتب حسام زهدي شاهين. ذلك أن الجد الذي زاره عمر غير مرة في قرية يبوس، وهو مختف من وجه الأعداء، هو نفسه جد الكاتب: داود علي شاهين، الذي كان شيخ عشيرته، وواحدًا من رجال الإصلاح في القرية.
وحين يذهب عمر لزيارة جده بين الحين والآخر فإنه لا يقوم بزيارات عادية يطمئن فيها على أهله بعد غياب، بل هو يستثمر هذه الزيارات للتزود بالحكمة وبخبرة الأجداد، حيث يروي له جده حكايات تراثية لها مغزاها ودلالاتها، وهي تصب في المنحى العام الذي تقصده الرواية، وفي هذا تعبير عن التواصل بين الأسلاف والأحفاد، وبخاصة أن عمر نفسه مكلف بتفكيك شبكة خطيرة من العملاء. ولذلك، يتضافر جهده مع جهد جده لإخراج الطالبة الجامعية سلمى من المأزق الذي أوقعها فيه العملاء.
ومن أجل ذلك، وبتدبير من عمر، يبدي فراس رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة، تفهمًا لما جرى لسلمى، ثم يرتبط بها غير آبه للاعتبارات البالية التي من شأنها تدمير شخصية الفتاة وتركها فريسة لأنياب الأعداء. وهنا، حين تنتصر حكمة الجد داود ومثابرة الحفيد عمر، وشجاعة سلمى وخطيبها فراس، وتصميمهما على مواجهة محاولة الإسقاط التي وقع ضحيتها كثيرون، فإن عمليات الإسقاط لا يعود لها تأثيرها المدمر أمام المواجهة الفعالة وصدق الإنتماء.
وهنا أيضا يحق لعمر ولجده الذي تزعم الجاهة التي ذهبت إلى أهل سلمى لخطبتها لفراس، أن يشربوا القهوة، وهي التقليد الملازم لمثل هذه المناسبات، وأن يسمعوا زغرودة الفنجان أثناء صبّ القهوة فيه، للتدليل على الموافقة على المصاهرة، وعلى انتصار الإرادة الخيّرة للناس على تواطؤ العملاء الذين سيلقون عقابهم العادل إن لم يتوبوا ويتراجعوا عن غيهم الذي هم فيه يعمهون، مثلما تراجع مازن عن تورطه، وأعيد إليه الاعتبار بعد استشهاده إثر العملية التي قام بها.
بقي أن أقول إن حسام زهدي شاهين يستفيد في سرده الروائي من بعض تقنيات الرواية البوليسية التي تعتمد الحبكة المتقنة بحيث لا يتم البوح بتفاصيل الحدث إلا على جرعات، وبحيث يكون بين هذه الجرعات فواصل لا تخرج عن السياق، وفي المحصلة نجد أنفسنا أمام سرد مشوق يدفع القارئ إلى متابعة الرواية حتى السطر الأخير، وفي الوقت نفسه إزاء غوص في أعماق المجتمع لرصد مظاهره التي يطفو بعضها على السطح ويبقى بعضها الآخر غائرًا في الأعماق.
عبدالله دعيس:
زغرودة الفنجان وفضح العمالة
يزغرد فنجان القهوة السادة معلنا عن وجوده في جميع مناسباتنا الاجتماعية، في الأفراح والأتراح وعند الملمّات، فهو رمز للعادات السّائدة في بلادنا وشاهد عليها. فهل هذه العادات خير مطلق، أمّ أنّها قد تقود إلى الخطيئة؟ وهل ما يطفو على السطح من مقاومة وبطولة وما يقابلها من صراع ومشكلات هو صورة هذا المجتمع، أمّ أنّ هناك جمرا يتّقد تحت السطح لا نراه وإن كنّا نكتوي بحرارته؟ يزغرد الفنجان في يدّ صابّه معلنا الزواج أو الصلح أو حتّى الحزن على فقيد، أمّا فنجان حسام زهدي شاهين فيزغرد بما هو أكثر من ذلك!
لا يمهّد الكاتب لما سيكتبه في كتابه، ولا يترك القارئ يسترسل في خياله ثمّ يصدمه بأحداثه الفاجعة، بل يبدأ كتابه مباشرة بلغة قويّة صادمة يتلقّاها القارئ كصعقة كهربائيّة، ما يلبث أن يستفيق منها لتتنبّه أعصابه ويستعدّ للاستماع إلى ما هو أكثر قسوة منها. وكلما قرأ أكثر توالت الصدمات، لكنّ هذا الألم لا بدّ منه لتجلية الأمور وتوضيح كثير من الأحداث التي دارت وتدور حولنا. ففي الفقرة الأولى من الرواية يقول الكاتب: (قال عمر: لو لم ألتق مازن في ذلك المكان لربما اتخذت الأمور مسارا آخر. ولم لم يبح لي مازن بأنه أقدم على تجنيد فتى قليل التجربة، أغراه بمبلغ من المال لتصوير أخته وهي عارية في الحمّام، لربما بقيت غافلا عما تحت السطح، سطح مجتمعنا من الآفات.)
هذه الرواية، من أدب السجون، تكاد تنحصر أحداثها على دور العملاء القذر في الإيقاع بالمقاومة الفلسطينيّة، والعمل الذي تقوم به شبكات العملاء، وكيفيّة تجنيدهم ومدى تفانيهم في خدمة جهاز المخابرات الصهيوني، الذي يستغلّهم أبشع استغلال، ويجعل منهم سيوفا مسلّطة على رقاب أبناء شعبهم. ومعظم الأحداث هي عبارة عن اعترافات لأحد العملاء الذي يبدو أنّه ندم على تعاونه، وكشف عن شبكات العملاء لأحد أبطال المقاومة خلال انتفاضة الأقصى التي بدأت عام 2000. فالعملاء يتمّ تجنيدهم عن طريق بعض ضباط المخابرات، ثمّ يقومون هم أنفسهم بتوسيع الحلقة والإيقاع بأناس آخرين وتجنيدهم للعمل لصالح العدو، فهؤلاء يعيشون في أوساط المجتمع ويرصدون المقاومة وتحركاتها عن قرب دون أي يحسّ أو يشكّ بهم أحد. ويتم اختيار العملاء من بين الذين قد يغريهم المال وفرصة العمل داخل الأراضي المحتلّة أو ممّن ينساقون وراء الجنس والرذيلة، أو من أولئك الذي يعانون من مشاكل اجتماعيّة في أسر مفكّكة.
يحاول الكاتب في أكثر من موضع أن يوحي أنّ العادات والتقاليد والحرص الشديد على الحفاظ على شرف العائلة، وحصر هذا الشرف في عفّة الفتيات، وعدم التسامح مع النساء اللواتي يقعن ضحيّة اغتصاب أو يقعن في زلّة، يدفع هؤلاء النساء إلى السقوط في مستنقع العمالة، ويتحولن إلى مخبرات للعدو حتى لا يفتضح أمرهن ويتسببن بفضيحة لعائلاتهن فينتهي أمرهنّ بالقتل دفاعا عن شرف العائلة. اعتقد أنّ العادات ليست هي السبب في وقوع ذلك، وإنّما انعدام الحسّ الأمنيّ لدى الكثيرين، وعدم الوعي الكافي، يجعلهم يقعون ضحايا بسهولة تامّة ويتم استغلالهم. وكذلك فإن ضعف الاتصال والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وقيام العلاقة بينهم على أساس من الخوف والكبت والتمييز بين الذكور والإناث، يجعل الضحيّة غير قادرة على الافصاح عمّا حدث معها لعائلتها خوفا من ردّة فعل لا يحمد عقباها. فالعلاج الناجع لهذه الظاهرة ليس التخلّي عن العفّة والطهارة، والتسامح مع من يصرّ على الرذيلة ويجاهر بها، وإنّما زيادة الوعي لدى الأطفال لهذه الأمور، ومتابعتهم من آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم حتّى لا يقعوا فرائس سهلة للعملاء والمفسدين، وإن حدث وأن تورّط أحدهم، فعلى العائلة أن تستوعبه وتحميه، لا أن تعاقبه على شيء خارج إرادته أو على زلّة قد لا تتكرّر.
نلحظ في أحداث هذه الرواية الدهاء والحنكة التي يمتاز بها رجال المخابرات الصهاينة، وكذلك اتخاذهم كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على حياتهم وحياة مواطنيهم، وبالمقابل نرى كثيرا من المقاومين الفلسطينيّين يتحلّون بالشجاعة ولكنهم يفتقدون هذا الحسّ الأمنيّ، ويظهرون أنفسهم ويتفاخرون بمنجزاتهم؛ ليقعوا ضحايا سهلة في يد العملاء والأعداء. وكذلك نلاحظ أن الكاتب ركّز على العملاء من الفقراء، وأصحاب المشاكل الاجتماعية، أو الضبّاط الصغار في قوّات الأمن الفلسطينية، ولم يشر إلى التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والعدو، ولا إلى دور السلطة في اعتقال المقاومين وتسليم بعضهم إلى الصهاينة أثناء نقلهم أو التسبب في استشهادهم، وإنما حاول أن يظهر أن السلطة الفلسطينية عملت على حماية المقاومة! أعتقد أن التصدي لدور العمالة والعملاء يجب أن يكون أوسع من التركيز على شبكات العملاء في مخيّم أو مدينة ما دون إبراز الصورة الأكبر.
يقوم العميل مازن بكشف شبكة العملاء التي يعمل معها، ويقتل ضابط المخابرات الذي عمل لديه لسنوات عديدة وقدّم له المعلومات التي تسببت في استشهاد العديد من أبناء المقاومة. فهل كانت هذه صحوة ضمير؟ وأين كان هذا الضمير على مدار السنوات والأيام الخالية؟ يبدو لي أن ما قام به مازن ما هو إلا ردة فعل على سحب البساط من تحت قدميه، عندما شعر أن دوره أصبح ثانويّا وأن المصير المحتوم لمن يخدم الأعداء سيكون مصيره قريبا، فانطلق إلى مصيره بنفسه.
يستخدم الكاتب أثناء الحوار بعض الألفاظ المبتذلة والألفاظ غير اللائقة، وإن كانت هذه الألفاظ مناسبة لهؤلاء العملاء الذين انحطّوا إلى القاع، إلا أنها قد تكون غير مناسبة للقرّاء خاصّة وأن ما ورد في هذه الرواية من أساليب الإسقاط يجب أن يعلّم للناشئة حتّى يتجنّبوه.
يطعّم الكاتب روايته ببعض الحكايات الشعبية ذات المغزى؛ ليدلل أنّ هذا الشعب أصيل ذا تاريخ وثقافة وقيم ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وأن الأحداث والشخصيات التي ذكرها في روايته ما هي زبد خبيث لا يلبث أن يزول.
وقال نمر القدومي:
“زغرودة الفنجان” .. رواية رياديّة وجريئة
أضافت الظّروف القاسية أدبًا مميّزًا حديث العهد، يكتبه أشخاص بواسل ذوو عزم وقوّة، إقدام وشجاعة، وفكر وإرادة؛ القضبان هم شرط الحكاية، والمحفور في الوجدان هو عقدة القصّة، أمّا السّجان فهو الموسيقى الدّراميّة القاتلة. الكاتب المناضل الفلسطينيّ “حسام شاهين” جسّد ما نعلمه وما لا نعلمه على أرضيّة واضحة، وجعل دلّة القهوة تُشاكس فنجانها وتُحدث صوتًا ذا مذاق سماعيّ نطرب عليه في الأفراح، ويواسينا في الأتراح، ونرتشفه على نشوة الإنتصار. “زغرودة الفنجان” رواية جريئة جدًا، وُلدت من داخل جدران مقفرة، كشفت عن فداحة أعمال الإستخبارات الإسرائيليّة “الشاباك” في حق شبان وشابات الإنتفاضة الفلسطينيّة الثّانيةالرّواية إجتماعيّة دراميّة في إطار سياسيّ تستعرض المناورات القتاليّة بين التنظيمات الفلسطينية المحليّة وبين الإحتلال الإسرائيلي. ترتكز مجرياتها على عملية إسقاط فئة الشّباب من جانب “الشاباك” من أجل التعاون والتخابر معهم، وذلك في إشارة مَقيتة من الكاتب إلى خطورة تفكك النّسيج الإجتماعي الفلسطينيّ، بسبب الفقر والحاجة والضغوطات الحياتيّة. يُسهب “شاهين” في رصد التفاصيل الدقيقة لأساليب الإسقاط، ويُحدّثنا عن الكيفيّة التي تجري بها تجنيدهم؛ إما عن طريق الإغراءات المالية، أو مستمسكات جنسيّة فيها المذلّة بين الأهل والعشيرة، والتي قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى القتل. وصَفَ لنا بالكلمات والصّور، وفي بلاغة إباحيّة فاقت التخيّلات، تورّط مجموعات من طبقات وفئات متفاوتة من شرائح الشّعب، تورّطهم في مستنقع العمالة بطريقة الخداع والتّنويم والتّصوير ومن ثم الإبتزاز. كما يُظهر لنا واقع المخيّم السّوداوي وظواهر تقشعر لها الأبدان، وترفضها كل معايير الأخلاق.
“مازن” تلك الشّخصيّة التي اضطرّت، بسبب الحاجة ودناءة النّفس البشريّة، إلى العمل مع الإستخبارات في جمع المعلومات عن المقاومة، وكذلك تجنيد أكبر قدر ممكن من العملاء من خلال ما أعطوه مشغّلوه من أدوية تخدير وأجهزة تصوير وفيديو. كما أوقع “مازن” أو توهّم أنه أوقع بابنة المخيّم “رحاب” تلك المرأة الرّهيبة والشّهوانيّة، وهي بدورها ساعدته في إسقاط آخرين وأخريات. وقد اكتشف لاحقًا أنها خدعته، وأنها كانت عميلة نشيطة من قبله وصاحبة علاقات حميمة مع الكابتن “مودي”. هذا الميجر جنرال هو رأس الأفعى الصهيوني ورجل “الشاباك” التي تلطّخت يداه بدم الأبطال الشهداء، تفوح رائحته النتنة عبر صفحات الرّواية، ويعمل كالسرطان في خداع الفلسطيني الموجود في تحوم صلاحيته ونفوذه، ويتمادى في الشتائم ونصب المكائد والإغتيالات لأفراد المقاومة.
إستخدم الكاتب “شاهين” اللغة البسيطة في روايته وأحيانًا المحكيّة منها لضرورة النّص، وقد غلب عليها أيضًا لغة الحوار بين الشّخصيات. احتوى مضمون الرّواية العديد من الحكايات المترابطة، إلاّ أنَّ الكاتب استطاع أن يسيطر على مجريات أحداثها الزمانيّة والمكانيّة وكذلك دَور أبطالها. أمّا تقاطع الأحداث، فقد خلق من تلقاء نفسه الحبكات المتلاحقة، وتأجّجت لدى القارئ عاطفة الحقد والكراهيّة وحُب الإنتقام، وبات ينتظر بين السّطور المشاهد التي تشفي وتثلج صدره. لم يكن للخيال وجود، سوى بعض الأمور اللا منطقيّة التي أحاطت بتحركات بعض الشّخصيات، وكأنَّ المخيّم “الوهمي الإسم” هو وكر، وكل غرف النّوم فيه عبارة عن استوديو بتقنيات عالية. ومما لا شك فيه أنَّ كاتبنا قد أغفل عينًا عن التّفاصيل الإباحيّة الجريئة والسّاخنة، فأعطى بذلك تلك الفكرة السيئة جدًا أن حياة الشّعب الفلسطيني ونسيجه الإجتماعي المتهتك. فمن خلال الرّواية طُرحت أفكارًا ثوريّة وأخرى فلسفيّة ونفسيّة، تشدُّ من أزر المقاتل وطُرق التّعامل مع العدو. ومن ناحية ثانية، فضح جميع الآفات الإجتماعيّة وطبيعة تفكير الفرد، ومستوى الإنحطاط والتردّي الذي وصلت إليه فئات من هذا الشّعب. لقد طرح على مائدة النّقاش مشاكل وقضايا خطيرة تراكمت على مرِّ سنين الإحتلال، وأحدثت هوّات وفجوات عميقة على أرض الواقع.
“مازن” يستنجد بصديق قديم له من المقاومين، ويعترف لمنقذه “عمر” بكل أعماله القذرة طالبًا التوبة، وذلك بعد أن شعر بأنّ الخطر يتهدّد زوجته وأولاده، وأنَّ المياه باتت تجري من تحته. نظّف صحيفته وضميره بقتل الكابتن “مودي” وإستشهاده. إلاّ أنَّ حساباتنا للأسف تسير وفق قاعدة مُتعفّنة بأننا نهدر أرواحًا كثيرة مقابل خنزير واحدا، ولا نُولي قيمة لحياة شعبنا. أمّا هذه الرّواية الجريئة من نوعها، فهي صدى لما يجول في خاطر الكاتب “حسام شاهين” وجوارحه، وما سكن قلبه من تأثير ظروف السّجن، ليخرج للملأ كإنفجارٍ مدوٍّ أصاب البعيد والقريب.
وتحدثت رشا السرميطي قائلة:
عندما يبرِّر الخائن خيانته بذريعة أنَّه الضًّحيَّة
زغرودة الفنجان من أجمل أدبيات الواقع التي قرأتها مؤخرًا، إذ عرَّى بها الكاتب الأحداث الفلسطينية إبَّان اندلاع الانتفاضة الثَّانية، وكشف السِّتار عن فشل تلك الثَّورة التي نخر أركانها العملاء وفساد الأجهزة الرَّسميَّة والحزبيَّة، ممَّا أدى لتأخر في انتزاع الحريَّة لهذا الشعب المناضل حتَّى يومنا هذا.
بدأ حسام الرِّواية منوِّهًا بأنَّ أحداثها مزيج من الحقيقة والخيال، وإنَّني قد لا أبالغ إن قلت الرِّواية واقعيَّة بلا خيال، يستظل به الكاتب ليبرر بشاعة بعض أحداثها غير الانسانيَّة، يتضح من الإهداء بأنَّ هذا العمل الأدبي جاء وفاء لأرواح الشهداء، الذين قدموا أرواحهم لأجل قضية كبيرة وعميقة في نفوسنا، ألا وهي الوطن، ذلك الوطن الذي بترت جسور الوصول إليه، وتقطعت الأوصال بين أراضيه.
الكاتب حسام شاهين أسير لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، محكوم عليه بمدة (27) عاما، وعمله الأوَّل- رواية زغرودة الفنجان – استغرق عشر سنوات لهذا الانتاج الأدبي الذي بني على مهل، وكان به يستنهض وجع الحرية المسلوبة منه، ومن كافة الأسرى القابعين تحت جنح الظلام والذُّل، بل ومن أرواح الراحلين من شهداء فلسطين، وكأنَّه يعتب على الوقت والواقع؛ ليقرر أن يتكاشف معنا بهذه الأحداث القاسية، وكما كتب في تقديمه زاهي وهبة:” من ذا الذي يستطيع اعتقال كتاب سطر بالحبر المقاوم المضيء”، فكانت تلك الرواية بمثابة إضاءة على كثير من الأحداث المخفيَّة تحت ظل الفشل الذي أحرزه الفلسطيني بعد هذه الأعوام الطويلة من العيش تحت الاحتلال وظلمه.
البناء الروائي عند حسام مكتمل، حيث صور لنا الكاتب أحداثا مختلفة من خلال شخصياته المتعددة في أمكنة وأزمنة متعددة، انتقل بقارئه في زوبعة فنجان خلال ثلاثمئة صفحة؛ ليحكي عن وجع كبير أصاب الأماكن التي بنيت روايته فيها، سواء كانت المدينة، المخيم، أم القرية، ولكنه حرص على الاحتفاظ به من خلال لغة الرواية الرشيقة والعالية، عنصر التشويق، الواقعية وملامسة أحداث مجتمعية لا تخفى على من عاشها، نوافذ الألم والجراح التي فتحها على مهل وأقفلها على غير الصَّمت؛ لتبدو كسنابل تحترق على صفحات روايته.
ورغم قوة الرواية في بنائها، وتماسكها من حيث تسلسل الأحداث زمانيا ومكانيا، لم يرق لي تطرف الكاتب في بعض من أحداثها، التي وجدت مبالغة في الوصف وادراج التفاصيل ” الغبية ” كما أراها، ولم أدرك ما فائدة تصوير وحشية المرأة المشتعلة بالجنس، وهي تمارس خيانة الوطن تحت ذريعة الاسقاط، لقد كانت شخصية رحاب صورة بشعة جدا لامرأة ساقطة، كانت ضحية وأصبحت وحشًا يضحي بأي شيء بلا مبدأ، ولا رادع ديني أو أخلاقي سواء على أفراد مجتمعها أم على الأرض ذاتها، وقد تساءلت حقا: هل يلقي الكاتب اللوم على المرأة؟ المرأة التي بدت في الرواية ضعيفة هشة متساقطة في مشهد مقاومة مشوّه، وهذا ما لم يعجبني في الرواية خاصة مع غياب الدور الايجابي للمرأة في الحرب والانتفاضة، ربما شعرت بحاجة للتوازن في دور المرأة الفلسطينية هنا.
نوع الرواية حسب تقديري كقارئة واقعي بوليسي.
الحدث: تمتعت الرواية ببداية قوية جًا في حديث عمر عن اغتيال القائد حسين عبيات، والمقاطعة الغامضة من مازن بأن يلتقي به، هذه البداية المشوقة تنبئ بمهارة كاتبها، وقدرته العالية على جذب قارئه لفنجان غريبة قهوته المرة، تزغرد فرحا أو وجعا، تزغرد لمدة قصيرة بعد فورتها، لتهدأ وتعود الأشياء لصمت تأملاتها.
الشخوص: اعتمد الكاتب شخوصا رئيسية مثل: مازن، عمر، رحاب، الكابتن مودي، وأخرى ثانوية مثل: سميرة، علي، نادر، سمير وغيرهم.
الزمان والمكان: أحداث الانتفاضة الثانية، مخيم العودة، قرية يبوس، الزيتونه، بيت لحم وما حولها، الحاجز العسكري، وقد ركز الكاتب على الاسقاط الذي بنيت أحداث الرواية عليه في البيئات المغلقة من مجتمعاتنا التي تحكمها العشائرية، ومجموعة متناقضة من العادات والتقاليد والموروث الثقافي والديني، وخلط الحلال والحرام بالعيب، فهي بمعظم علاقاتها تقوم على نمط القبيلة بنوعيه: الطائش والمكبوت، والملتزم المنفتح، وهنا تساءل الكاتب من خلال شخصية مازن، بعد ما قام سمير بتصوير أخته عارية: هل هو الجهل؟ هل هو المال؟ هل هو الخوف من المجتمع؟ أم هل هي التربية الخاطئة؟ وفي هذه التساؤلات لخص لنا الكاتب العناصر الرئيسة التي تهدم المجتمع وتجعل أفراده شياطين في زي إنسيّ يظهر بطبيعته الفطرية، ويخفي الشر والرذيلة والغدر والخيانة لكافة أعماله الأخرى، مبرّرا ذلك بالحاجة والفقر والذل والمهانة في العيش تحت الاحتلال.
السرد والحوار والوصف: بدا الكاتب متمكنًا من سرد أحداثه، سواء في المونولوج الداخلي لنصوصها خاصة في شخصية مازن، وضميره المتقلب على مر الأحداث جميعها، عندما سقط في وحل الخيانة وحتى خروجه لطريق الشهادة؛ ليغتسل من هذا العار الذي دمر به العديد من الأسر في المخيم، وأودى بها إلى حتف الهاوية بالرذيلة، أم بالديالوج الخارجي بين حوارات الشخصيات الأخرى، بدا السر مشوقا، والحوار غامضا، يستدعي استقراء الصفحات بنهم لمعرفة الفكرة التي أرادها الكاتب، نجح حسام في الوصف والحديث عن المشاعر والأماكن، إذ كانت لديه لغة عالية رشيقة وأدبيَّة غنية بالصور والمعاني ما يعكس للقارئ أنَّ الكاتب مثقف وصاحب فكر.
الهدف: هدف الرواية أن نضع حدًا للخطأ الفلسطيني الذي نمرُّ به منذ أكثر من ستين عامًا.
لخّصت الرِّواية في أسطرها الأولى النصر بتحقيق ثلاثة أهداف: تجنيد الشباب، تحديهم عن المشاركة بالعمل الوطني، وتدميرهم سلوكيًا واجتماعيًا. وهذا تمامًا ما قامت به اسرائيل خلال سنوات عديدة هشمت أبناء هذا الوطن وشوهت صورهم النضاليَّة سواء محليا أم عالميّا. وأتبع يداوي جراحه في ظل العتمة ليقول كاتبنا:” من الممكن أن يخطئ الإنسان في حياته، ويرتكب حماقات، .. لكن مهم أن نعترف، ونضع حدا للاستمراريّة في الأخطاء.” لقد شعرت بكثير من الحزن والألم والحسرات المتطايرة كما الفراشات بعد موت الزهرة، تحوم حول جثتها، ولم ينطو على القارئ أبدا ما كشفه الكاتب من حقائق بدلالات وكذا وقائع من البؤرة الفاسدة الملطخة بالدم والخيانة، والعارية من الأخلاق والانتماء، رغم التورية بظل الضحية للمحتل الذي بدا شعارا يردده الكثير من أبناء هذا الشعب، ولم يعترفوا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه الفجائع التي تحدث، بل لولا تعاوننا مع المحتل لما حدثت، وما استطاع اختراق صفوفنا وهدم سبل الدفاع؛ لينتهي بسفينة قضيتنا مآل الغرق. كانت رواية زغرودة الفنجان للكاتب حسام شاهين بمثابة قشة كي لا نموت غرقا، ربما.
لقد خطَّط حسام شاهين لصيرورة روايته بشكل متميّز، وقد حاور شخصياته عن تناقضاتها سواء كانت وطنية أم متخاذلة تعمل لصالح الاحتلال، ألقى الضوء على التقدم التكنولوجي وخطورته في تزوير المشهد الحقيقي، باين بين الهدم الداخلي لمجتمعات المناطق المغلقة، سواء كانت مدينة قرية أم مخيم، كما حذر من الانفتاح الكبير والفساد الذي ينعم به القادة وذويهم من أبنائهم وبناتهم الذين يعيشوا بذخهم على حساب إراقة دماء الآخرين من ضحايا المجتمع من جلدة شعبهم. حسام صاحب فكر، وروائي ناجح أعجبني عمله الأوَّل وأنتظر منه المزيد من الأعمال الأدبية ذات المعنى الفلسطيني بواقعه الايجابي والسلبي، وأسأل الحرية له قريبا.
وكتبت هدى خوجة:
القهوة العربية والدّلّة النحاسيّة والفنجان ينتظر الزّغرودة، نعم إنها زغرودة الفنجان قريبة لا تنتظر، فلحن الوفاء والشّجاعة والاقدام والتّضحية في الأعالي، وحرّية الفكر برغم قيود السّجان تنتشر بين النّشامى والغيورين على وطنهم الحبيب.
تساؤلات في ثنايا الرّواية هل هو الجهل؟ هل هو المال؟هل هو الخوف من المجتمع؟ ام هي التّربية الخاطئة؟
يشير الكاتب حسام “شاهين” إلى أهمية التّحصّن الفكري والثّقافي والاجتماعي والدّيني، ويبين كيف يتوصل العميل ” الضّحيّة ” لمشغله من خلال المال والمرأة والجنس والمخدرات وحب الانتقام، مع التركيز على الشباب والشابات الصّغار، لنجد مازن ” الضّحيّة ” يلوم نفسه قائلاص35 “فأنا كنت ضحية شرور نفسي ومطامعها عندما نصبت الشّبك لنفسي وألقيتها فيه”
وكانت المرأة بارزة في الرّواية مع طرق متعددة لحل المشكلات، لنجد سلبية سميرة في التكتم على الخديعة والرذيلة، أما ليلى الّتي اختارت قتل نفسها وجعلها في سبات مع عدم معرفة السبب الرّئيسي، وهو التعرض لاغتصاب ولعبة دنيئة. أما سلمى فلقد اختارت المقاومة ومصارحة عمر وهو جهة تثق بها مهما كان الثّمن، حيث كان موقفه شهما ومتوازنا وقال:
“إن ما يترتب على عدم المواجهة للمشكلة، يؤدي إلى التورط في مشاكل أكثر وأصعب”
أما رحاب فقد اختارت الانغماس والتللذ بالرذيلة والفواحش، بشكل غير بشريّ تشمئز منه النّفس الإنسانيّة السّويّة.
التّركيز على الخلل في بعض العائلات والأخوة والأصدقاء وأهالي الحيّ، فبعض الثّغرات أدّت إلى انهيار أسر كاملة وشباب وشابات.
تتسمم الرواية بالبساطة وتعاقب الأحداث وتسلسلها، ولكن تمّ استخدام ألفاظ غير مناسبة على لسان العملاء، حبّذا لو لم تكن صريحة.
تمّ التّركيز أسوأ الأشخاص والأحداث ولكن يفضل أن يكون هنالك توازن أكثر بين السلبيات والايجابيات من خلالل عرض الأحداث، وهذه الأمثلة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا.
تجربة أدب السجون تجربة متميّزة يكن لها كل الاحترام والتقدير، لنجد أنّ همجية السّجان لا تستطيع تقييد الفكر برغم السّجان والقيود .
وقال سليمان شقيرات
رواية الاسير حسام شاهين زغرودة الفنجان تستحق القراءة من الأجيال الشابة؛ لأنها تظهر مدى خساسة أجهزة الاحتلال، ونذالة الانحطاط الأخلاقي للعملاء وخطورة دورهم واستغلالهم البشع لبيئتنا الاجتماعية المحافظة، وخاصة ما يتعلق بالسمعه والشرف، وأبرز الكاتب مثلا واحدا للتعامل العقلاني مع ضحية واحدة، ومع حالة أخرى كان الحل بالانتحار، وهو حل سلبي بالضرورة، إن الأستخلاص الأبرز برأيي وهو لم يكن واضحا بما يكفي أن سلاح الابتزاز له حل وحيد وهو عدم الخضوع له، وليس معقولا أن يكون خيار الأغلبية الساحقة من الضحايا استسهال القبول بالعمالة خوفا من المجتمع، وردّة فعله لدرجة الرهاب هو ليس بالضروره واقعيا تماما كما توحي به الرواية، وأن هناك نموذجا واحدا اقتصر على أحد المناضلين والذي أوجد حلا لواحدة من الضحايا من خلال زواج أحد المناضلين منها، ويظهر بالتالي أن هذا هو الحل الوحيد، والحل الحقيقي يتمثل بتعميم موقف رفض الخضوع لهذا الابتزاز، وبالتالي يفقد قوته كسلاح ضغط وابتزاز، ودعوة المجتمع للتمييز بين هذه الحالات وحالات السقوط الأخلاقي الاجتماعية الأخرى التي يجري التعامل معها أحيانا بالقتل، وهو أمر مدان وخطير، ويساعد عمليا مخابرات الاحتلال في صيد ضحاياها، والحل الآخر والذي ينفذ بصورة أوسع من خلال الزواج لمن وقعوا في هذا المطب، وهو الخيار الأفضل موضوعيا، خاصة عندما تقع الضحية عنوة أو جهلا لدى الشباب والشابات، وفيه حماية لنسيجنا الاجتماعي ولشبابنا من السقوط في شباك الاحتلال وعملائه الذين هم يستحقون العقاب وليس ضحاياهم.
وكتب الدكتور عادل الأسطة:
رواية زغرودة الفنجان لحسام زهدي شاهين
يجدر أن تدرس في تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس في جامعاتنا
(1) جرأة في الموضوع: أثارت، رواية “زغرودة الفنجان”للأسير حسام شاهين، ابن القدس، لدي سؤالا مهما: هل كتب روائيونا رواية أتوا فيها بهذا القدر من الجرأة في موضوع العملاء ودور الشاباك في تدمير النسيج الاجتماعي والعائلي للمجتمع الفلسطيني؟ ربما كتب روائيو المنفى، مثل سامية عيسى في روايتيها “حليب التين” و “فسحة في كوبنهاجن” عن تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني في المنفى، بسبب الحرب اﻷهلية في لبنان وحرب 1982 وما نجم عنهما من اتساع رقعة المنفى.
ما كتبه حسام لا أذكر أنني قرأت ما يشبهه في رواية اﻷرض المحتلة، على الرغم من أن المرء كان يصغي إلى حكايات تشبه ما يقرأ، ولكن ما كان يستمع إليه لم يكتب ولا يدري المرء اﻷسباب ولا أدري لِمَ لم نكلف أنفسنا مساءلة عدم كتابته؟ هل كان القراء سيقولون في اﻷمر مبالغة وأن هذا لا يمكن أن يحدث؟
هناك قصص لمناضلين تخلوا عن زوجاتهم ﻷنهم، كما قيل، عرفوا أنهن مرتبطات بالموساد. أحيانا كانت القصص لا تصدق أو لم يكن كثيرون يقفون أمامها.
في الرواية قصص ربما لا تصدق. ربما. هناك اختراق للمجتمع وهناك ساقطون يقررون التوبة فيبوحون ويعترفون ويقولون أشياء مذهلة. هكذا يعترف مازن للمناضل عمر ويروي قصة تعامله مع اﻷسرائيليين. لم يكتف بالسقوط بل أخذ يسقط غيره: المال والجنس والحاجة إلى تصريح، ورويدا رويدا يتساقط آخرون ممن يحتاجون إلى المال يساعد على هذا بنية اجتماعية هشة. الرواية التي تلامس موضوعا مهما وخطيرا لها قيمة اجتماعية كبيرة، وقد لا تكون قيمتها الفنية بالمقدار نفسه، ويدرك حسام هذا، وهو يقر بأنه ليس روائيا محترفا، ولكنه رضخ لطلب أصدقاء فكتب ما ينبغي أن يكتبه، وقد لا يكون غيره قادرا على كتابة ما كتب. إنها تجربته الغنية والمثيرة هو الذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال منذ 12 عاما. وأعتقد أن روايته التي لم تخل من خلل في الإخراج، يجب أن تعمم وأن توزع وتناقش على مدى واسع، ففيها من التنوير والتبصير بأساليب المخابرات الإسرائيلية الكثير والمهم أيضا. الرواية لو التفت إلى إخراجها لكانت أفضل للقراءة. أعني لو فصل بين كلام الساردين بإشارات. وهي عموما رواية مهمة لمن يهتم بمرايا الفلسطيني واليهودي وتصور كل طرف لنفسه وللآخر، ويجدر أن تدرس في أقسام علم الاجتماع بل وعلم النفس في جامعاتنا. إنها رواية جريئة في معالجة موضوع حساس لو التفتنا إليه وناقشناه لكنا أنقذنا كثيرين ممن وقعوا في التعامل مع العدو بسبب الجهل. غالبا ما كنت أقول: لو عرض علي ضابط مخابرات صورا لي حقيقية أو مدبلجة لابتزازي لقلت له: وما له. اعرضها وانشرها كما تريد. ولكن هل كانت سميرة ستجرؤ على فعل هذا؟ لو كان مجتمعنا يغفر خطايا، أو لو كان يتفهم أمرا مثل هذا، لربما ما وقعت فيم وقعت فيه. كنت أحيانا أصغي إلى قصة أحد رفاق الجبهة الشعبية وما جرى معه وكنت أتساءل: أصحيح ما يروى؟ حسام شاهين يجرؤ ويروي قصصا تكاد تكون خيالية. إنها رواية مهمة لموضوعها.
(2) طرد شعب وتدمير نسيجه الاجتماعي: ما قامت به الصهيونية لم يقتصر على اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فعدا هذا، وفوقه طرد شعب كامل من ارضه ليتشرد ويقيم في الشتات، دمرت اسرائيل بنية المجتمع الفلسطيني وخربت النسيج الاجتماعي له، وجعلت من بعض أبنائه لصوصا وفاسدين أخلاقيا ودمرت أسرا بأكملها، وحرمت شبابه من العيش بحرية وكرامة. الرواية الفلسطينية ترصد هذا، وأنا اقرا “زغرودة الفنجان” ألاحظ هذا بامتياز. هذه رواية مهمة لدارس الأدب دراسة اجتماعية. مهمة لأقسام علم الاجتماع وأقسام علم النفس، ومثلها روايتا سامية عيسى “حليب التين” و”فسحة في كوبنهاجن”.
(3) صورة المخيم: تبدو صورة المخيم سوداء. هناك الفقر والتخلف والعملاء والفساد اﻷخلاقي، وهذه كلها تقود إلى التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، ومن ثم إلى تصفية المقاومين. بنية اجتماعية هشة يخاف أفراد المجتمع من الفضيحة اﻷخلاقية فيقعون في شرك المخابرات. أبناء المخيم قسم منهم: فقراء وضعفاء أمام المرأة الجميلة والمال، وأحيانا يبدون سذجا أو بلا تجربة. يوقعهم رجال المخابرات ويسقط هؤلاء بعض أبناء المخيم ممن تساقطوا. يغرر بهم/ن وسرعان ما يقدمون خدمات كبيرة لرجال المخابرات: الصور والشهوة و دبلجة الصور وسرعان ما ينهارون. من مازن أول الساقطين من أجل تصريح عمل وحفنة شواكل، حتى سمير ونادر وسميرة ورحاب ومروان و.. سيصحو ضمير مازن الذي يكلف بمراقبة صديقه القديم عمر، وسيخبر مازن عمر بهذا، في لحظة صحوة ضمير، بعد موت الضمير، وإسقاط شباب وشابات، لبيئتهم الاجتماعية الهشة، وسيتحول هذا الساقط ليغدو عميلا مزدوجا. وكما تريد المخابرات الإسرائيلية منه أن يتابع زميله القديم يطلب منه صديقه أن يتابع ( مودي) الذي جنده. وسيبريء العميل نفسه وسيقدم على قتل (مودي) وسيغدو مازن شهيدا وبطلا. يعرف المجتمع الفلسطيني نماذج حقيقية مثل مازن الشخصية الروائية. وربما ذكر أسماء منها فكم من عميل قتل من جنده؟ الرواية كما ذكرت تبرز صورة سلبية ﻷبناء المخيم. هل هذه هي الصورة الوحيدة لهم؟ المال والجنس والضعف البشري كل هذه تقود إلى السقوط. أين هذه الصورة من الصورة التي برزت ﻷبناء المخيم في رواية غريب عسقلاني “الطوق”1980 حيث المقاومة الصلبة. كل شيء يتغير. في 70 و80 ق20 كتب محمد علي طه قصصا عن الفلسطيني في مناطق 1948. كانت الصورة إيجابية. في العقد اﻷول من ق 21 عاد وكتب عن البيئة نفسها والمجتمع نفسه وبدت الصورة أيضا مختلفة. هل ضجرنا من المقاومة؟ هل تعبنا؟ هل غدا كل شيء عبثا في عبث؟ انظروا فيما آل إليه مناضلون كثر وقارنوا. لماذا لا يجرؤ الشاب أو الشابة على السخرية ممن دبلج لهم صورا أو ممن التقط لهم صورا؟ مرة وقع في المصيدة شاب من نابلس، حدث معه ما حدث مع الشخصيات الروائية. تساقط خوفا من التشهير بصوره كما قال من على شاشة التلفاز، وتعامل مع المخابرات وزودها بمعلومات أدت إلى اغتيال قادة مهمين في الانتفاضة، وكان أن أعدم الشاب النابلسي. لماذا لم يواجه رجال المخابرات ساخرا: وما له: أنا رجل وهي ابنتكم. اعرضوا الصور وأعطوني نسخة منها أيضا؟
(4) التعالي على العرب واحتقارهم: يبرز حسام صورة لنظرة اليهود ﻷنفسهم وللعرب. حتى الفلسطيني المتعاون الذي يقدم للمخابرات معلومات جمة مفيدة يبقى عربيا. إنه مهم بقدر ما يقدم معلومات، ومقابل هذه المعلومات يأخذ أجرة، وإذا أخفق قليلا يشتم ويعود عربيا قذرا، لا فائدة منه، ولا يساوي شيئا، بل إنه زبالة، مجرد زبالة. يغدو كائنا عبئا على الاسرائيليين. هكذا يتعامل (مودي) مع مازن. إن قتل يهودي وأخفق مازن في إحضار المعلومة يشتمه (مودي) ويتعالى عليه، وإذا أمده بالمعلومات أمده بالمال. المال المال المال. هذا هو الإغراء ولا يساوي العربي إلا بضع مئات من الشواكل والدولة غنية وتدفع، وحياة اليهودي غالية وأما العربي فرخيص رخيص، ولا يهتم رجل المخابرات به. رجل المخابرات يهمه عمله والدم اليهودي وإسقاط الشباب من أجل إنقاذ اليهود. والعربي الذي يقدم المعلومات يأخذ المقابل: تصريح العمل وفرصة العمل ومزيد من الإغراءات. هذا ما تعززه “زغرودة الفنجان”. وهذه الصورة لا تختلف كثيرا عنها في اﻷدبيات الصهيونية التي كتب عنها غسان كنفاني في كتابه: في اﻷدب الصهيوني.
(5) الصورة المظلمة للفلسطيني: هل تعد هذه الرواية نموذجا للأدب المظلم في اﻷدب الفلسطيني، مثل روايتي سامية عيسى، ومن قبل مثل نصي” ليل الضفة الطويل “و “روايتي الوطن عندما يخون”؟. يخرج المرء وهو يقرأ الرواية بانطباع سلبي جدا عن المجتمع الفلسطيني. هناك مقاومون ولكن الحضور الطاغي هو للعملاء الساقطين، وتحديدا من أبناء المخيمات؛ ذكورا وإناثا. ولا يصحو ضمير مازن إلا حين يتعرض أهل بيته، كرأفت، للسقوط، أو التهديد بإسقاط زوجته وبناته. كل الذين أسقطهم مازن لم يكترث لهم، ولكنه حين يهدد بأن النار ستحرق بيته يثور ويصحو ضميره، ويقرر الانتقام والتحول والتفكير بقتل( مودي) -ايهود قدري- رجل الشاباك المسؤول عنه الذي أسقطه. حين يشاهد مازن أخاه رأفت في بيت رحاب التي أسقطها مازن، وحين يشاهد فيلما ﻷخيه وزوجته بأوضاع مشينة، يتعاطيان المخدرات، يهدد رحاب التي أسقطها هو وتبدأ هي بإسقاط كثيرين وكثيرات. عالم من السقوط رغم وجود مقاومين ومقاومة وأفلام الجنس التي صور فيها اﻷفراد لا ترحم وتجعلهم يتساقطون بسرعة. والمجتمع لا يرحم ويهرب هؤلاء من الخطأ إلى الخيانة. أما كان يمكن استيعاب اﻷخطاء.؟ هكذا يكون المجتمع أيضا وراء مزيد من السقوط ودفع كثيرين إليه. هذا مجتمع هش ضعيف وهذا مجتمع يقتل أبناءه أيضا، وكما أن من مارس الخطيئة يرتعب من صوره عاريا، فإنه يرتعب من المجتمع أكثر ويغرق في الوحل أكثر وأكثر. الرواية مظلمة وصورة الفلسطينيين فيها أيضا مظلمة، على الرغم من وجود المقاومة. كم نسبة الكتابة عن السقوط وحفلات الجنس والجواسيس، قياسا للكتابة عن المقاومة؟
وكم نسبة الكتابة عن النماذج الآيجابية قياسا للكتابة عن النماذج السلبية؟ أسئلة تخطر على البال والمرء يقرأ الرواية. أين صورة المرأة الفلسطينية منها في رواية كنفاني أم سعد؟ لكننا في زمنين مختلفين ومكانين مختلفين.
(6) الساقط /البطل او العميل حين يصحو ضميره، فيغدو بطلا: الشخصية المحورية هي مازن. غدا هذا عميلا للشاباك وقدم له معلومات جمة، وأسس شبكة مخبرين ومخبرات بعد أن أسقطهم في مستنقع الرذيلة وأوقعهم في عالم الشاباك وكلهم كانوا، في باديء اﻷمر، ضحايا ثم غدوا كلابا ضالة تضلل الآخرين وتسقطهم وتتلذذ بإسقاطهم ورحاب غدت سادية بامتياز. امرأة متزوجة لا تنجب أسقطها مازن الذي أسقط سميرا ونادرا وسميرة أخت سمير، وأرادت رحاب أن تحمي رأسها فأخذت توقع الكثيرين والكثيرات في شباك الشاباك، يدفعها أحيانا حقد طبقي وهو ما دفعها لتسقط ليلى المرأة المتزوجة التي انتحرت خوفا من الفضيحة. مازن الذي ألمت به صحوة ضمير بعد أن شاهد أخاه رأفت مع (مودي) ضابط المخابرات، وبعد أن رأى صور أخيه وزوجة أخيه، مازن يبدأ يبوح بقصته للفدائي عمر ويغدو عميلا مزدوجا ﻷنه يريد قتل (مودي) الذي أوصله والآخرين إلى هذا المستنقع من السقوط الفاضح والمذل والمهين. يتفق مازن مع عمر على التخلص مع مودي. هل سيغدو مازن بطلا بعد كل ما ارتكب؟ وهل رأس( مودي) رجل الشاباك يعادل كل هذا الخراب والسقوط والتدمير شبه الكلي لعائلات بأكملها؟ سيقدم مازن على قتل (مودي) ولسوف يقتل مازن. ولسوف ترفع صور مازن على أنه بطل. أنا شخصيا أتساءل إن كان حقا بعد كل هذا السقوط والإسقاط يعد بطلا. ربمافي اﻷمر وجهات نظر. ربما. هل علينا أن نغرق في الرذيلة والعمالة ثم نصحو؟ إنها ثقافة مجتمعنا الذي يرتكب فيه كثر الموبقات ثم يصحون ويحجون في آخر أيامهم، ويتقربون من الله بعد خراب البصرة. دمر صدام حسين العراق ثم بدأ يقرأ القرآن. ربما ذكره هنا يبدو غير عادل ولكن هذا ما يحدث غالبا. والله يحب التوابين. إن اﻷمر ليستحق الجدل. وعموما فان رواية حسام شاهين”زغرودة الفنجان”على ما فيها من هنات فنية رواية مهمة جدا، وهي رواية تربوية تستحق أن تقرأ وأن تناقش، فما زال الاحتلال قائما وما زالت المقاومة قائمة، وما زال الاسرائيليون يعملون على تجنيد فلسطينيين لخدمة المشروع الصهيوني.
وكتب عزيز العصا:
الإسقاطات ذروة الخيانة.. العدو ليس أسطورة.. التراجع عن الخيانة اصطفاف مع الوطن
حسام زهدي شاهين؛ أسير فلسطيني، في سجون الاحتلال منذ العام (2004)، مولود في العام (1972) في قرية السواحرة الشرقية. ولأن الأسرى الفلسطينيين اعتمدوا استراتيجية تحويل أقبية السجون إلى منارات للعلم والمعرفة، فإن الأسير يقبض على ناصية الثقافة بإحكام، حتى أنه أصبح المصدر الموثوق الذي لا ينضب لكل شأن من شؤون الثقافة والمعرفة، والتي طورها مئات منهم حتى الحصول على الدرجات العلمية المتقدمة؛ الدكتوراة، والماجستير والبكالوريوس.
الأسير “حسام شاهين” واحد من الأسرى الذين قفزوا، رغمًا عن المحتل وقيوده، من أقبية العزل ووحشتها وظلمتها، إلى ساحات الوطن وشوارعه وأزقته وحاراته وباحاته، لكي يتابعوا همومه وقضاياه؛ بالكلمة المكتوبة ذات العمق الفكري النابض بالحياة الحرة الكريمة التي قضى شهداؤنا من أجلها، ويربض أسرانا في سجون الاحتلال ومعتقلاته وفي الظلمة الحالكة لزنازينه من أجل أن تشرق شمس الحرية لتنير دروب الأجيال القادمة.
قصدت بذلك التقديم لقراءة رواية كتبها الأسير “حسام شاهين”، وهو على “البرش”، لكي يحيل الألم إلى أمل بمستقبل مشرق بعد أن نحاكم الماضي بما فيه من أخطاء و/أو خطايا. كما أنني، في قراءتي النقدية، أؤمن بأن الكاتب وما يحيط به من ظروف، وما يمتلك من ثقافة ومعرفة، هو جزء من النص الأدبي؛ يؤثر فيه ويتأثر به.
تبدأ بغلاف من إبداع الفنان التشكيلي الفلسطيني خالد نصار، يتمتع بسيمياء تعطي القارئ وعدا ينتظره من خلال نص سردي متميز، فاللوحة تحمل إشارة سيميائية، تختزل شيئًا من المضامين الثانوية في الحكاية، عندما يتآزر اللون مع الكلمة في تشكيل الرسالة التي يسعى الكاتب إلى نقلها للقرّاء من مختلف الأعمار، ومن مختلف الشرائح المجتمعية.
قبل أن تلج في الرواية ينبؤك “حسام شاهين” بأن روايته هذه “مزيج من الحقيقة والخيال”؛ فأسماء الشهداء “حقيقية”، وما عداها يتراوح بين الحقيقة والخيال. ولعل في ذلك إشارة إلى ما يؤمن به الروائي، بأن أسماء الشهداء هي الثابت، وهو العناوين العصي على التغيير وعلى العبث بها، وهي غير قابلة للاهتزاز أو التمايل مهما اشتدت وعصفت رياح الاحتلال التي تسعى إلى تحقيق انتكاسة فكرية وعقائدية في نفوس الأجيال، فتبقى دماؤهم منارة تذكر ببطولاتهم وتضحياتهم وبالثوابت التي قضوا دفاعًا عنها.
بقراءة متأنية لهذه الرواية وجدتُني أمام ثيمة روائية، جوهرها الصراع القائم على أرض فلسطين بين المحتل المغتصب المتغطرس، وبين الشعب صاحب الحق، وما يتم استخدامه من أدوات ومنهجيات وآليات عمل في هذا الصراع. كما أن هناك إشارة إلى أن “العدو”، وبالرغم مما يمتلك من قوة وسطوة وآلات بطش، إلا أنه يعجز “تمامًا” عن ليّ ذراع الإرادة الوطنية، عندما تستعر في نفوس أبناء الشعب المقاتل، مهما ساءت الظروف.
تتكئ هذه الرواية على بنيتين رئيسيتين، هما:
البنية الزمانية؛ وهي الفترة الزمنية التي استعرت فيها انتفاضة الأقصى، واشتد أوارها بين عامي 2000 و2004، وما شهدته من أحداث جسام، قدم خلالها الشعب الفلسطيني تضحيات كبرى تمثلت بآلاف الشهداء والأسرى والجرحى، من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، ومئات المنازل المهدومة فوق رؤوس أصحابها.
البنية المكانية؛ وهي القدس، حيث مقر مخابرات الاحتلال، والفندق الذي يتبعه والذي يتم استخدامه كمصيدة لتنظيم العملاء والجواسيس، والمدينة الملاصقة لها من الجنوب (بيت لحم)، وما فيها من قرى ومخيمات.
ووفق هاتين البنيتين قام “حسام شاهين” بـ (صهر) الأحداث للخروج بسرد نثري جميل، جاء بلغة عربية عميقة، تحمل ملامح الأصالة في مفرداتها ومعانيها، وجاءت الأحداث والمشاهد متسلسلة، وتتصاعد وتيرتها وتتأزم متسارعة نحو الذروة التي يبحث عنها القارئ، والتي ينبئ بها السرد، بما يجعل القارئ حريصًا على عدم مغادرتها حتى النهاية. وفي ذلك كله تكاد الرواية تخلو من الرمزيات، وإنما تراوح السرد بين الحقيقة والإيهام بالحقيقة، وفي كلتا الحالتين يجد القارئ نفسه مطمئنًا إلى أنه بصدد أحداث حدثت على الأرض، أو يمكن أن تحدث يومًا ما؛ عندما تتوفر لها الحاضنة الطبيعية لبذورها.
وأما بالنسبة لشخصيات الرواية، فقد قام “حسام شاهين” ببنائها، بشكل مقنن، ولم يفرط في تعدادها؛ ووزعها كما يلي: الشخصيات التي شكلت الخيط الروائي، وبقيت على طول النص، حتى النهاية، وأخذت دور البطولة التي قام بها “مازن أبو قمحة”، ويصاحبه فيها “رحاب” وعمر و”مودي”، والشخصيات الرئيسية الأخرى التي كانت شخصيات صلبة، اخذت مساحة واسعة من النص، مثل: سمير وشقيقته سميرة، والشخصيات الثانوية الهشة التي تم توظيفها لأغراض استكمال المشهد، دون أن تكون فاعلة في النص.
لقد تميز السرد الروائي في هذه الرواية، بأن جعل القارئ يتمايل في علاقته مع شخصيات الرواية، كمن يسير على خيط مشدود؛ فما عدا الشخصيات ذات الصلة بالعدو، يجد القارئ نفسه تارة يتعاطف مع شخصيات الرواية وتارة أخرى يشعر اتجاهها بالغضب والحنق. وفي ذلك اعتراف واضح وصريح بالأثر الذي يتركه النص في نفس القارئ.
أما من حيث النص، فإنني أبدأ بتسجيل “اعتراضي” على التفاصيل الخاصة بالمشاهد “الجنسية”، التي أسهب فيها الروائي دون أن تزيد شيئًا إلى النص سوى بعض الترف الزائد الذي يمكن الاستغناء عنه، كما جرى مع سميرة ورحاب وليلى… الخ. في حين أنه عندما أورد ما تعرضت له سلمى، أشار إلى ذلك بما يمكن تسميته “فلاش” خاطفة وسريعة أتت أكلها بأقل الكلمات والمشاهد، وجاءت حصتها في السرد ذات أثر رائع في نفس القارئ. وما أود الإشارة إليه هنا أن التفاصيل “الموحشة” تثير الذعر في نفس القارئ، وتجعله يوسع المساحة السوداوية التي قد تكون مستقرة في ذاته منذ زمن.
علمًا بأنني أسجل للروائي القدرة على توظيف المشاهد لتأزيم الموقف، وجعل القارئ جزءًا من النص، عندما يتفاعل مع المشاهد، بما يدور في هواجسه من عوامل الغضب والحنق على مسار الأحداث التي يتحكم فيها مخابرات “العدو”، التي تستخدم العميل-المريض، أو تجعل جاسوسها “مسكونًا” بضده وضد شعبه وضد كرامته الشخصية والوطنية، الذي يسيّره على مدى نحو عقد ونصف العقد من الزمن. لا سيما وأن الروائي لم يكن جزءًا من النص، وإنما كان يحرك الشخصيات، ويدير الحوارات بينها بخيط رفيع غير مرئي.
بقي القول أن الروائي ليس مؤرخًا، وليس واعظًا، إلا أن النص الروائي، وبعد أن تغادر الرواية المطبعة، وتصبح بين أيدي قارئيها، تخرج من يد الكاتب (الروائي)، وتصبح ملك القارئ؛ فإما أن يحتضنها ويعيد قراءتها؛ لاستقاء المزيد من المعرفة، أو يلقي بها في مهاوي مكتبته إلى غير رجعة.
أما رواية “حسام شاهين” هذه، فإنني أرى بأن “فنجانها” سيبقى “يزغرد” كلما حان الحديث عن انتفاضة الأقصى، وما جرى فيها من أحداث. ليس لأن ما كتبه هو كتاب تأريخ لتلك الانتفاضة، بل لأن ما كتبه يتراوح بين الحقيقة والإيهام بها، وما بينهما من خيط رفيع يدركه القارئ الحذق، مما يجعل الأحداث والمشاهد الموصوفة في النص الروائي، مصدرًا للمعرفة حول ما جرى في تلك الفترة.
ولا أعتقد أن مؤرخًا لتلك الحقبة الزمنية التي عالجت الرواية أحداثها، يمكنه الاستغناء عن هذه الرواية في قراءته “الدقيقة” والمتمعنة لكيفية تنظيم العملاء والجواسيس، وتأطيرهم في أطر “صلبة” شكلت خطرًا حقيقيًا على الثورة، وسبّبت خسارة لمقاتلين عنيدين محترفين، كان لخروجهم من المعادلة العسكرية بالغ الأثر على مسيرة تلك الانتفاضة. كما لا يمكن الاستغناء عنها في فهم، بل إدراك، الأثر الموجع والمؤلم الذي يتركه الإهمال الأسري للأطفال، والإلقاء بهم في أتون الفقر والفاقة، ليصبحوا صيدًا ثمينًا لمخابرات العدو تنهشهم أنيابه بسهولة ويسر. وكذلك، لا بد من الإشارة إلى ما صورته رواية “حسام شاهين” من تأثيرات الطابور الخامس من الانهزاميين والجبناء في نفوس الشرائح المختلفة من الشعب.
قبل أن أغادر، لا بد أن أترحم على الشهداء الأبرار الذين سقطوا على ثرى فلسطين الأبية دفاعًا عن الوطن، والذين تبقى أسماءهم حقائق راسخة ناصعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أتوجّه بالتحية إلى الأسير الروائي “حسام شاهين”؛ الذي تحلق روحه في فضائنا بحرية من خلال روايته هذه. وأما “مازن أبو قمحة”، فلا بد من الوقوف عنده بالكثير من القراءة والتحليل؛ لما تمتع به من قدرة على القفز من وحل العمالة المحيط به من كل الجهات، إلى عطر التضحية والشهادة، وما نجم عن ذلك من تحطيم “إمبراطورية” العملاء، مما شكل ثغرة “موجعة” في جدران الاحتلال الأمنية.