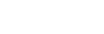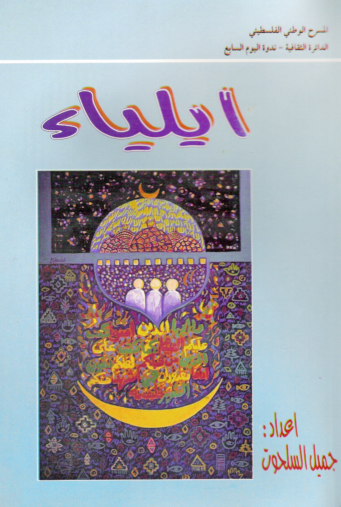في مستهل هذه القراءة نقول بأن كاتبها الروائي الفلسطيني الأصيل جميل السلحوت لم يخرج عن المسار الذي رسمه لكتاباته منذ بواكيرها وإلى حدود اليوم، فالقراءة للسلحوت هي في حقيقة أمرها متح من معين ذاكرة رجل عاش حقبا زمنية طويلة بذهن حاد، وبنظرة رجل حكيم يمارس قدرا كبيرا من التأمل إزاء ما يعيشه أو ما يعايشه من أحداث، وهذا بالضبط ما يفسر الأحداث والوقائع والقصص والأمثلة الشعبية الغنية التي تشهدها كتاباته المهمة. فمن أشواك البراري إلى المطلقة والأرملة والليلة الأولى ستجد نفسك في صحبة شيخ يحول كل ما يراه ويعايشه إلى عمل أدبي، وأعتقد أن هذا الزخم من السرد والتأريخ والنضال لن ينال حقه اليوم، لكنه سيكون شاهدا في المستقبل على رجل عاش فعل الكتابة كشكل من أشكال المواجهة والمكابدة، على أمل بناء مجتمع إنساني مستنير وقادر على خوض رهانات التقدم والارتقاء إلى مصاف الأمم العظمى.
ثانيا، لن أحلل الرواية كأحداث حتى لا أفقد القارئ لذة التعرف على النص بنفسه، لكنني سأحاول البحث في ما وراء كل تلك التفاصيل من وقائع وشخوص تكشف بجلاء عورة مجتمع يقتات على الخرافة، ويعتاش بالجهل والجهالات، وهي مراحل مرت منها مجتمعات أخرى قبل أزيد من عشرين قرنا، أمّا نحن فنقترفها اليوم على مرأى ومسمع من الاكتشافات العلمية الباهرة، فهل من مسوّغ لها؟ وكيف نفسرها؟
الليلة الأولى أو ليلة الدخلة وما يكتنف هذه الليلة من طقوس وتفاصيل مغرقة في الجهل، من حديث عن الفحولة عند الذّكر وأنوثة وعذرية عن الأنثى، وعبر هذه التفصيل تمر بنا الرواية إلى الكشف عن الايمان بالعرّافات وما يلي ذلك من طقوس لاعقلانية ولا أخلاقية ولا حتى إنسانية.
والحق أقول إن هذه الرواية عادت بي؛ لأتصفح عملا كنت قد اطلعت عليه قبل سنوات، وهو المنجز الرائع للدكتور مصطفى حجازي “التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور”.
دعنا نغضّ البصر عن التفاصيل وننظر من فوق، من أعلى قمة يمكن أن نرقب منها الأحداث. إن الخلفية الشاهدة من وراء على أغلب ما كتبه شيخنا جميل السلحوت، وبالأخص في هذه الرواية هي شتيت من الناس والذين يهيم عليه الفقر والجهل والتبعية والهوان، إن الخلفية هي دائما مجتمع خائر القوى لا يفكر ولا يريد أن يفكر، ولا يقوى على ذلك، هي بنية اجتماعية متخلفة وغارقة في الجهالات، بنية منظمة في عشوائيتها، تشكيلة تعاش كنمط حياة له دينامياته النفسية والعقلية والعلائقية. وهذا ما ظهر من خلال تظافر الأحداث والشخوص لأداء دور واحد؛ حماية التخلف والتأصيل له وزرعه في أعمق نقطة يمكن أن يصل إليها من الفرد، فيصبح الشخص المتضرر من التخلف هو أوّل من يحميه ويذود عنه بالغالي والنفيس، ويكون مستعدا لتخطيء العلم والعقل والمنطق:؛ حتى لا تتزعزع هذه البنية المقدسة.
وإذا كان القارئ البسيط قد يرى في ما كتبه السلحوت تشريحا للواقع، فأنا أعتقد أنه حجر الزاوية في أي مقاربة يمكن أن تصاغ لبناء مجتمع مستنير و ناهض، فالاستثمار في مجتمع متخلف يكون بمثابة إفراغ للماء في الرمل، كما يقوم المثل المغربي، و هذا الخطأ هو ما ارتكبته حكومات كثيرة راهنت على الاقتصاد ونسيت أن البناء الفكري والسيكولوجي للإنسان هو الأس والأساس، و هنا بالضبط تنجلي أهمية الأدب لتغيير الحالة النفسية للأفراد ووضعهم في سكة التقدم، ومدارج الرقي.
لا مراء في القول إن الانكفاء على قراءة شخوص الرواية وأحاديثهم والأحداث التي أسهموا فيها كفيلة بتقديم صورة شاملة لخصائص وسمات التخلف السيكولوجية، ولا أدلّ على ذلك من عائلة حمدان والمشعوذة مبروكة والدجال أبو ربيع، عائشة وربيحة، بل والقرية بأكملها كتعبير عن مجتمع عربي مختل ومأزوم حتى النخاع.
فالمجتمع في الرواية يعيش حالة من القمع والقهر والامتهان، قمع يردفه بالضرورة إهدار لقيمة الإنسان وقدسيته، يترتب عن ذلك فقدانه لقيمته التي يفترض أن تكون مطلقة لا تشرطها بكارة ولا انتصاب لعضو ذكري في لحظة محددة والناس شهود! أليست المشهدية التي صاغها بروعة السلحوت أشبه بحلبة ثيران تهيج الناس المتحلقين؟ كيف يمارس الحب المقدس في لحظة معدة سلفا؟ وكيف نطلب من الحب أن يثبت نفسه بقطرات من الدم؟ إن هذه ولا شك وثنية سلوكية سطحية تعبر على أننا حفرنا كثيرا وما زلنا لم نبلغ القاع!
عوالم الرواية مطبوعة بخاصية مركزية، وهي فقدان الكرامة الإنسانية، فقدان يتحول فيه الانسان إلى مجرد شيء وهو ما عبرت عنه النزعة الوجودية ب (التَّشْيِيءُ chosification)، حيث تنتفي استقلالية الفرد وقدرته على السلوك وفق ما يراه هو مناسبا له. لقد رأينا في هذا العمل ذوبانا تاما للذات داخل عقلية الجماعية، الجماعة بما تحوزه من قدرة على القهر والاخضاع عبر قوتها المادية والرمزية.
نكاد نقرأ من هذا العمل الظروف التي أورثتنا كل هؤلاء، فمن المؤكد أنهم ومنذ أن ولدوا وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم، كالتعبير عن الرغبات الخاصة والآراء الشخصية، ففي مجتمعات كهاته، في حاضنات قاسية كتلك لا مجال لعبارات “أنا”، وحتى إذا قيلت لا تقال إلا على استحياء، ومع الاستعاذة بالله من قولها. فماذا يتبقى للفرد بعدها؟ لا مناص من السير وراء الدهماء والخروج عن القطيع يعد انتحارا حقيقيا.
دعونا نتأمل حوارات الرواية من جديد، اندفاع الشخوص إلى أحضان الفتاحات والدجالين… ألا يتكشف من خلال ذلك وجود شبكة اجتماعية لهذا التخلف، شبكة تجسد طبيعة العلاقات المهيمنة على أفراد القرية والمجتمع بشكل أشمل. فنظام التخلف والجهل هو المسيطر وحده، والبقية عبيد خاضعين لهذا الاستبداد اللامرئي لكن ضحاياه هم حماته، فتتحول لغة القهر إلى لغة سائدة يتكلمها الجميع كل حسب موضعه ومكانته.
الآن فلنخرج قليلا من هذا لنفكر في ما يترتب عن هذا الوضع الموسوم بالقهر داخل الرواية، ويمكن أن نحدد ذلك في عقدتين مركزيتين، وهما عقدتي النقص والعار إضافة إلى حالة وجودية موسومة بالسوداوية وانعدام الأفق. يتمخض عن هذا حالة من الاستلاب والاستسلام والاستعداد التام للتسليم بكل ما هو خرافي حتى يعالج هذا الإنسان المقهور ندوب الواقع وأخطار تجربته الانسانية. إن هذا الشخص الذي جسدته الرواية عبر مشكلة الدخلة شخص غير قادر على تقبل الواقع ومواجهته بالعقل والعلم ومستعد بكل طاعة وأريحية وإذعان إلى الارتماء في أحضان الخرافة والأماني والأوهام والغيبيات، وهو ما أدرجه فلاسفة اليونان داخل مفهوم “الميتوس” كتعبير عن كل إيمان بوجود قوى مفارقة لما هو موجود الآن وهنا، قوى متحكمة في حركاتنا وسكناتنا، فأين “اللوغوس” فينا ومن اغتاله؟ من عتم شعلة النور التي أطلقها فلاسفة الإسلام من الكندي إلى ابن رشد؟ من أحرق مكتبة أبو الوليد وأطفأ فتيل الشك والنقد والتفكير، الذي كان بوسعه أن يرفعنا عاليا عاليا إلى مصاف العظماء لنكتب أسماءنا بمداد الكرامة والحرية والاستقلالية والتقدم، لا بحبر عار الجهل والتخلف والارتكاس والنكوص؟ وأي مسؤولية يتحملها الفرد فينا لبناء دينامية مج؛تمعية وسيكولوجية جديدة؟ وهل هي مهمة سهلة؟
أسئلة كهذه وغيرها قرعت رأسي وأنا أقرأ ما خطه السلحوت في هذا العمل وما قرأت له من قبل في أشواك البراري والمطلقة والأرملة… عن وضع امرأة الحال إنها نصف المجتمع وهي في الواقع المرّ لا تملك فيه حتى جسمها.
إن وضع القهر والشعور بالدونية والعار جعل الشخصيات في الرواية أسيرة المظاهر، سطحية لا تهتم ولا تدرك، أهمية الجوهر، فبالنسبة لأسرتي العريس والعروس ما يهم من كل تلك الليلة أن يسال دم على سروال لا أقل ولا أكثر، وهذا سيكون بالنسبة إليهم مدعاة للفخر والكبرياء، وفي الحقيقة هذا النزوع الشكلاني هو تعبير عن جهل تام بقيمة الانسان ذاته وقيمة أبعاد أفعاله. هو وضع معقد وليس كما نتصوره، فقطرات الدم ستكون خلاصا من العار في اعتقاد العريس والعروس، عار يرميه عليهم مجتمع غارق في العار حتى الركبتين.
اشتغلت الرواية على وضع سيكولوجي خطير جدا، وهو الاستسلام والانكفاء على الذات والحد من الرغبات الشخصية والإرادات الذاتية، فظهر البطل وهو مستسلم تماما لما يقرره الكبار، وما يعتبرونه صوابا، وهذا يعكس ما آلت إليه مجتمعاتنا من انعدام للمبادرة الفردية في التفكير بشكل ذاتي، وهو ما عبر عنه فيلسوف التنوير إيمانويل كانط “الجرأة على التفكير” باعتبارها مسؤولية فردية واجبة. فالمصير في الرواية متقبل ومستسلم له دون أدنى سعي لتغييره، وصناعة المصير مسألة تنتفي في مجتمع يحكمه التخلف، وهي بهذا دعوة صريحة من الكاتب إلى أن الخلاص الجماعي لا يكون إلا عبر بوابة الفرد، وعبر بناء أشخاص قادرين على اقتراف خطيئة التفكير كما تعتبرها القوى النكوصية حامية التخلف.
فقد قرأنا في الرواية عبارات عن المكتوب الذي لا يمكن أن نهرب منه، عن المصير المحتوم وعن كوننا مسيرين وغير مخيرين، وهنا تكون ماهية الانسان مصنوعة قبل وجوده حتى، فالمجتمع المتخلف يرفض التنوع والاختلاف ويثمن فكرة التشابه، فإذا أردت أنت تكون مقبولا عليك ألا تكون مختلفا. والفكرة التي يرعاها المجتمع هي مسلمات لا يجب الخروج عنها، وبالتالي تحدث حالة من إعادة تدوير لمظاهر التخلف وآثاره، وهي دوامة من العسير الخروج منها.
ومن الآليات السيكولوجية التي يحمي بها المتخلف تخلفه التمسك بالأعراف والتقاليد وما ورثه إجمالا من الأسلاف، فيستمد هويته الشخصية من قدسية هذا الماضي الذي تركه السابقون، ولا يستطيع أو لا يرغب في مرحلة لاحقة أن يتزحزح عنه قيد أنملة، فيكون بذلك عبارة عن مجتمع ميت لا يبدع الأفكار ولا الحياة. ينعكس كل هذا على طبيعة المجتمع والعلاقات حيث الميل إلى الافراط في التمسك بالعادة، والميل إلى تعنيف كل من يهدد هذا الصرح، الذي شيد على امتداد قرون.
أكتفي بهذا القدر و أهمس في أذن كل من سيقرأ هذا العمل بأن هذه الرواية تراهن على الأجيال اللاحقة؛ حتى تنزع عن نفسها هذا العار الشنيع وهو عدم التفكير وإبطال آليات العقل الجبارة التي من شأنها أن تمكننا من الانتفاض في وجه هذا التخلف، الذي التصق بنا، فكل واحد منا مسّه هذا التخلف بشكل أو بآخر لأن بناه وآلياته أقوى من إرادة الفرد الواحد، لذلك أفرد السلحوت لهذا الأمل الساطع مساحات واسعة لشخوص في الرواية وقفت ضد هذا التيار الجارف، وتجرأت على قول لا، وهي اللحظة الفارقة التي يقول فيها الفرد: لن أصغي إلا إلى ما يمليه علي عقلي، ولله در إيمانويل كانط حين قال: “إني أسمع من كل مكان صوتاً ينادي لا تفكر، رجل السياسة يقول لا تفكر بل نفذ، ورجل الاقتصاد يقول لا تفكر بل ادفع، ورجل الدين يقول لا تفكر بل آمن.”
وفي الختام يصحبنا الأمل كما يصحب شيخنا السلحوت أن تكون ليلته الأولى الليلة الأخيرة لظلام دامس، صرنا على إثره نخشى أن نغادر كهف تخلفنا؛ لننظر بالخارج إلى شمس الحقيقة ساطعة في كبد السماء، إن الحقيقة والخير والعدل والكرامة والحرية توجد دائما بالخارج، هنالك حيث تطلع السلحوت بناظريه، هنالك تقع جنتنا جميعا، جنة الخير والفضيلة والسلام والانسان الذي تكتمل إنسانيته، ولا يسعنا بلوغ ذاك المرام إلا عبر بساط من فكر وحكمة، وليس من ريح وأوهام.
6-7-2023