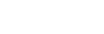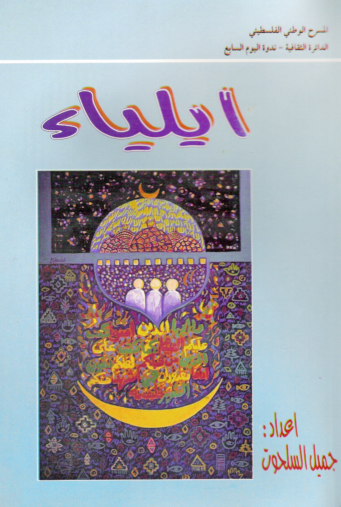القدس: 19-08-2021 من ديمة جمعة السمان: ضمن مخططها للإطّلاع على الأدب العربي وأدب الشّتات الفلسطيني، ناقشت ندوة اليوم السابع المقدسية الثقافية الأسبوعيّة عبر تقنية “زوم” رواية” “مدينة الله” للأديب الفلسطيني المعروف حسن حميد، والتي صدرت طبعتها الأولى عام 2009 عن “المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر”.
افتتحت الأمسية ديمة جمعة السمان فقالت:
صدرت الطبعة الأولى لرواية “مدينة الله”للأديب الفلسطيني حسن حميد عام 2009 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
قالوا أنه لا يتقن وصف المكان الا من عاش فيه.. ولم يدركوا حقيقة أنه لا يبدع في وصف المكان إلا من يعيش المكان فيه…. ولا يتقن وصف مشاعر الناس سوى من يشعر بهم حتى لو لم يعش بينهم.
ربما لم يشهد معاناتهم.. ولكن قلبه بكى على عذاباتهم، وربما لم ير بسماتهم، ولكنه ضحك من قلبه سعيدا على مسراتهم. فغذّى حبر دواته بمشاعر صادقة، بعيدة عن أي تكلف ينفر القارىء. تخرج كلماته مليئة بحسٍّ خاص يميزه القارىء دون جهد كبير، كلمات تنقل الواقع بعمق، توصل رسالته بحِرَفية المتمكن، الذي يعرف أين ومتى يضع الحرف، فيصيب الهدف.
وأديبنا الروائي الفلسطيني حسن حميد، صاحب رواية مدينة الله، حرمه الاحتلال البغيض من أن يسكن مدينة الله (القدس)، حرمه من وطن يعشش في أعماق أعماقه.. فلم يستسلم.
هو لم ير المكان بعينيه، بل رآه بقلبه وأحاسيسه ومشاعره، تفاعلت تخيلاته مع معلومات بحث عنها من مصادر معتمدة، تخيّل المكان فكتب عنه بقلم ينزف وجعا، كتب بصدق مجروح، خرجت آهاته صرخة، لم يبالغ ولم يتكلف فأجاد ووصلت الرسالة.
من يعرف أن صاحبنا لم تطأ قدماه وطنه، يتعجب من دقة وصف بعض الأمكنة مع وجود بعض الخلل هنا وهناكن لا يكشفها سوى من عاش في المكان، إلا أن الأخطاء مرت دون أن تؤثر على هدف الرواية.
انطلقت روايته من بيت الشرق الذي كان يحتضن المقدسيين ويشعرهم بالأمان، والذي أغلقه الاحتلال بأمر عسكريّ قاصدا أن يترك المقدسيين كاليتامى دون راعٍ.
كان الأديب حميد يذيل كل رسالة من رسائله بملاحظة تزيد من قناعات القارىء بأهمية ما كتب. يكرر المعلومة أحيانا قاصدا بها تثبيت معلومة يعتبرها بيت القصيد، يبني عليها ما سيأتي من رسائل أخرى، يمرر من خلالها حقائق وواقع أليم يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي البغيض.
رسم شخوصه بعناية.. كانت أشبه بالرمزية.. فلم يختر فلاديمير كاتب الرسائل روسي الجنسية من فراغ، ولم تكن زوجته فلسطينية صدفة.
ربما قصد بها علاقة الروس ودعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة وأن ملاحظاته كانت مباشرة فيما يخص نظرته للاحتلال وجنودهن فقال في إحدى ملاحظاته: “كم أنا خجل منك لتكرار كلمات البغال والكلاب والهراوات الغليظة، تصوّر يا صديقي العزيز بلادا مثل بلاد سيدنا تحرسها البغال والكلاب والهروات الغليظة. صلِّ لأجلي… كي تطيب إقامتي هنا”.
وعلمنا من الرسائل أيضا أن الحوذي جو (الايرلندي) قام بترتيب للقاء الأول بين فلاديمير (الروسي) وسيلفا (الإسرائيلية) دون رغبة من فلاديمير بذلك في بداية الأمر، وكان جو حلقة الوصل بينهما، إلى أن تطورت العلاقة بينهما وتوطدت.
كانت سيلفا تعيش صراعا نفسيا إنسانيا بين الواجب والضمير، خاصة وأنّها كانت تعمل باحثة اجتماعية في السجون الإسرائيلية، فكانت ترى فظاعة أساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيين على أيدي المحققين في السجون، إلى أن أصبحت لاحقا أكثر قسوة وغلاظة من زملائها السجانين مع الضحايا المعتقلين.
السؤال: لماذا اختار أن يكون جو الإيرلندي هو حلقة الوصل؟ لا شك أن معادلة ربط علاقة هذه الجنسيات مع بعضها البعض تحمل رمزية معينة قصد الأديب إيصالها للقارىء.
أجاد الكاتب في وصف السجون الإسرائيلية وأساليب التعذيب فيها، والتي جاءت على لسان سلفا نفسها، فمن فمه أدينه.
قالت سيلفا: “لا أدري كيف قادتني المقادير كي أكون في عالم لم أُخلق له. وأن أتعامل مع مخلوقات قهرها الزمان، وخانتها الحياة.. فالسجون مقابر حقيقية. ظلم وقهر، وإماتة، حياة مرفوعة إلى آجال غير مكتوبة، روائح، وقرف، وأذيات متكاثرة كالفطر، حيطان كالحة باهتة تقف ببلاهة وسذاجة، ونوافذ صغيرة عالية لا تعرف التلويح، ولا السلام، نوافذ جرداء، خرساء لا نباتات لها ولا عصافير، لا شيء يجاورها لا عشب ولا ماء، نوافذ مأسورة مشدودة إلى قضبان الحديد، وبشر رموا إنسانيتهم على أعتابها ودخلوا إليها، مكان لا قوانين له ولا ثوابت سوى سلب الآخرين آدميتهم.. مكان ملعون ورجيم”.
وعاتبت نفسها.. قالت: (هل درستُ وتعلمتُ كي أصل إلى هنا؟ وهل سأحمل أنوثتي كل صباح إلى هنا كي أجرّحها؟ وصممتً ألّا أبقى في هذا المكان أو ما يشبهه من أمكنة، ومع ذلك ماشيت المأمور مزراحي شابون، مررت بعنابر، وزنازين، وغرف تحقيق وتعذيب.. رأيت الأدوات الجهنمية، وأحواض الماء، والحبال التي يعلق بها السجناء، وأجهزة الكهرباء، والدواليب الكاوتشوكية، وأكياس الخيش، والشباك، وقطع الحجارة، والسلاسل الحديدية، والأقشطة والأحزمة، والكلاب المخيفة، والقطط المرعبة، والثعابين، والعقارب، والديوك).
وعلى صعيد آخر قام الأديب بأنسنة قضايا ضحايا التعذيب، من خلال تناول قصصهم الشخصية مع أسرهم وأحبائهم، ووصف علاقة المعتقلين الذكور الودية مع الباحثة الاجتماعية سيلفا. والذي دفع إدارة السجون بنقلها إلى معابر المعتقلات من النساء؛ لتصطدم سيلفا بأساليب تعذيب أكثر وحشية في عنابر النساء، اللواتي كن يضطررن للكذب والاعتراف بما لم يفعلن تجنبا للتعرض للتعذيب، وقد زاد هذا من حجم الصراع داخل سيلفا.
جاء كل هذا على لسان بني جلدتهم سيلفا.. ولا شك أن ذلك له تأثير أقوى ومصداقية أعلى من لو أن هذا الوصف خرج على لسان الضحية، بعدها نُفاجأ.. وإذا بسلفا تغلّب الواجب على حساب الضمير، وتصبح أكثر إجراما من زملائها السجانين باعتراف أحد المعتقلين (عارف الياسين)، وهي رسالة أخرى غير مباشرة من الكاتب، وكأنه يريد أن يقول: هؤلاء هم الصهاينة.
وفي النهاية قررت سلفا أن تضع حدا لحياتها بعد أن فقدت أنوثتها بل إنسانيتها.
وهذا حقا ما يحصل مع بعض الجنود الذين يعيشون أزمة الصراع بين الواجب والضمير.
وبعد أن التقى فلاديمير ثلاثة إسرائيليين في المقهى الصغير شعر بالقلق، وفكر بالعودة إلى بلاده.. وقد كانت إشارة واضحة منه يطلب النصيحة، بعد أن بدأ يفقد شعوره بالأمان قال:
“أعترف أمامك، أن الثقة المفرطة لهؤلاء الاسرائيليين الثلاثة أخافتني، إنها تعني المزيد من القتل، والدم، والحزن، والمقابر، والصبر، والظلم، وانتظار ما لا يدنو. صديقي الحبيب، أرسل إليك صورة لـسيلفا، وأخرى للحوذي جو، وثالثة لي.. راجيا منك أن تقرأ وجوهنا، فتكتب إليّ عما شعرت به. محبتي الدائمة أيها الصديق، ها هي ذي الحال، فهل أعد حقيبتي، وأغادر؟
وبعدها اقتحم البغّالة بيته واعتقلوه ليكون مصيره السجن، سألوه عن زوجته رشيدة الفلسطينية التي توفيت. وأخضعوه للتحقبق، فكتب من السجن ست رسائل جاء في آخرها:
“أنا حزين، كل خلية من خلايا جسدي تتألم، ليتني طائر الآن، كي أمر ولو للحظات فقط بـمقهى (أبو العبد) كي أراه، وإن أكرمني ربي أكثر سأنتظر كي أرى عارف الياسين، لأقول له إنني في المكان الذي عرفه طويلا.
أرجوك.. لا تكتب إليّ، فعناوين السجن ليست بعناوين.
هكذا انتهت رسائل فلاديمير الذي وجهها إلى أستاذه الذي علمه اللغة العربية، والتي لم تصل لصاحبها.
كانت رسائل قوية.. لغتها سلسة بسيطة وواضحة.. جمعت بين الماضي والحاضر.. وصفت دناءة الاحتلال.. وعكست معاناة الفلسطيني في وطنه المحتل.. على الحواجز وفي الأماكن المقدسة وفي المعتقلات… وفي كل مكان في فلسطين بهدف التنغيص والإذلال والنيل من كرامة الفلسطيني.
اتبع الكاتب أسلوب ذكي في كتابة الرواية.. جعله يتنقل من مكان إلى مكان.. ويقفز من فكرة إلى فكرة للوصول إلى هدفه دون أن يكون هناك عقدة واضحة.. تحد من حجم المعلومات التي أراد أن يوصلها للقارىء.
لا شك أن رواية مدينة الله هي إضافة نوعية للمكتبة العربية.
وقالت صباح بشير:
تشكل رواية “مدينة الله” للأديب حسن حميد، تجربة فريدة في لغتها الروائية، فقد جمعت بين براعة التصوير والسرد الساحر، والأحاسيس المختلطة التي تداخلت أمام قوة البقاء، والألم الذي لا توشك أن تنتهي منه حتى تعود إليه مرات عديدة، وبأسلوب الرسائل الأدبية والبناء السردي المتجانس، اعتمد الراوي على وصف الأمكنة وخصائصها بشكل مطلق، فقد كان المكان هو البطل الرئيسي في الرواية، بكل ما حَفل من تاريخ وحاضر، مرتبطا بالحدث وبنص ينتمي الى أدب الرحلة، هذا النوع من الأدب الذي يملك تأثيرا استثنائيا بما يحتويه من إبداع ومعلومات، ومشاهدة حية نثرها الكاتب حين أطلق العنان لخياله فأبدع ملحمة أدبية متميزة بعمقها ومحتواها.
بطريقة خاصة في التعامل مع الفكرة، وبمستوى لغوي فني رفيع، شكلت فلسطين حضورها في هذه الرواية بكل ما تحمله من معطيات، فتجلت القيم الاجتماعية والتقاليد، الطقوس والعلاقات، هكذا طَوَّع حسن حميد الشُخُوص والأحداث، وحرص على الربط بين الأماكن، حميميتها وتراثها، فأَخذنا معه إلى عالم أصيل، شبيه بالحلم مليء بالتناقضات، فقد بَيَّنَ البيوت… النوافذ والأبواب، الشوارع والدروب، الأحياء والمخيمات، الأقواس والأسوار، الأحاديث الوجوه والمشاعر، ووصف روائح البخور الغار والنعناع، أريج الريحان الحبق والعنبر وكأنها تتصاعد في الهواء، تطلقها النوافذ الشوارع والبيوت، أو كأن الطيور هي التي تطير بها فتنشرها هنا وهناك، كلها جاءت في سطوره ممتزجة بالتراجيديا الإنسانيّة والمعاناة، بتقنية فنية مدهشة.
أضافت الرواية نموذجا مختلفا إلى أدب المضطهدين، فانطوى النص على توصيف جمالية المُضطهد، وأمسك بِغَور المأساة الفلسطينية، ووصف مجموعة من الخيول والبغال التي يعتليها بعض الجنود، يتجولون فينشرون الخوف والذعر في قلوب الناس، فينقلب الجمال الى عذاب وألم، متجسدا في واقعٍ صعب، مسلطا الضوء على معاناة المقدسيين، صمودهم وما يجمعهم من ألفة رغم اختلاف أديانهم، فأصوات المآذن تجتمع مع أجراس الكنائس في مدينة الله، لتشكل بذلك رمزا ومظهرا حضاريا بارزا لهذا التآخي والعيش المشترك، فكنيسة القيامة لا تبعد عن المسجد الأقصى سوى عشرات الأمتار فقط، من هنا كانت العلاقة التاريخية والترسيخ لمظاهر التسامح التي يعيشها المقدسيون، مسيحيون ومسلمون، فتضمهم المحبة ووحدة المصير والعلاقات الأخوية، فهم جميعا سواء، يبرهنون على عمق تلك العلاقة التاريخية، التي تجمعهم في أرضٍ ما خلقت إلا للمحبة والسلام.
تبدأ الحكاية بزيارة الأستاذ الجامعي الروسي “فلاديمير بودنكسي” إلى مدينة القدس، حيث أشار عليه أستاذه “جورجي إيفان” بأن يقضي إجازته في بلاد السيد المسيح، واقترح عليه أيضا أن يُدَوِن كلّ ما يراه وما يسمعه، وتنمو لدى “فلاديمير” حالة من العشق والهيام لمدينة القدس، فيمضي هائماً مولعا بحبه لها.
تزور السيدة “عميخاي” الراوي في مكتبه حيث يعمل في بيت الشرق، وتودِعُه بعضا من الرسائل التي قام بكتابتها بطل الرواية “فلاديمير” بهدف ارسالها الى “إيفان”، هذه السيدة التي كانت قد خبأت تلك الرسائل لسنوات واحتجزتها أثناء عملها في البريد المركزي، أخبرت الراوي بأنها مصابة بمرض السرطان، وتريد أن ترتاح وتُكفّر عن ذنبها قبل أن تموت، فطلبت منه إيصالها الى اصحابها قائلة: كنت أراقب هذه الرسائل في مركز البريد، وهي لزائر روسي كان قد كتبها لأستاذه الجامعي في جامعة سان بطرسبورغ، وسبب مراقبتي لها هو أخبارها وقصصها، أما سبب احتفاظي بها فهو أسلوبها الأدبي الرائع، فقد سحرتني هذه الرسائل على الرغم مما فيها من أكاذيب.
يحاول الراوي جاهدا إيصال تلك الرسائل إلى أصاحبها، لكنه يفشل في ذلك، يستشير أصدقاءه، فيقترحون عليه نشرها في كتاب، وهذا ما قام بفعله.
كان فلاديمير متزوجا من سيدة فلسطينية، مَكّنَتهُ من معرفة تاريخ فلسطين، رافقه الحوذي جو في زياراته، فارتبط بشدة بكل الأماكن التي زارها، تعرف خلال زيارته على “سيلفا” التي أحبها، إلا أنه كان الفريسة التالية، فزُجَ به في السجن، كان يستذكر أبو العبد صاحب المقهى، وعارف ياسين، ظل يكتب رسائله حتى سكن الحزن قلبه وذبُلت روحِه، فطلب في رسالته الأخيرة من أستاذه إيفان عدم مراسلته فكتب: سأنتظر كي أرى عارف الياسين، لأقول له بأني في المكان الذي عرفه طويلاً، أرجوك لا تكتب لي، فعناوين السجن ليست بعناوين!
يعتبر السّرد نصا مرافقا للواقع، وذلك لارتباطه بالذاكرة الزمكانية التي تَعُج بالتناقضات، وهذا ما يدفع الكاتب لكتابة نصوصه المرتبطة روحيا ونفسيا بالأمكنة التي ينتمي اليها، من هنا يمكنه الكتابة عن أي مكان قد تأثر به، حتى لو لم يعش فيه، وهذا ما تجلى في رواية الأديب الفلسطيني حسن حميد الذي عاش في سوريا، وبقيت فلسطين حاضرة في أعماله، حيث جرت الأحداث في مكان وزمن غير بيئته وزمنه، إلا أن هذا قد ترك أثره على النصّ، فقد أضفى عليه الخيال ثوبا واسعا فضفاضا، فالروائي هنا قد قرأ عن وطنه الأم، وشاهده عبر الصور وشاشات التلفاز فقط، لكنه لم يعش فيه ولم يطأ أرضه بقدميه، وهذا ما يدفع القارئ للتفكير ملياً بأن المبالغة كانت جزءا لا يتجزأ من هذه الرواية، التي تكونت مما قرأ حميد وشاهد، ومما استخرجه من الحكايات والذاكرة الجمعية، فلم يستطع الانعتاق من تأثير ذلك على حواسّه وذهنه.
قد تُشكِل هذه ميّزة في حقه، إذ يحق للكاتب ما لا يحق لغيره، فله أن يبْتَدَعَ ويبْتَكَرَ ما يشاء من حوادث وقصص، دون أن يصطدم ذلك بالثوابت التاريخية، وهذا ما التزم به الروائي حميد عبر ما خطه بتفاصيله المدهشة وحبكته المتماسكة، فهو لم يتمكن من زيارة الوطن، إلا أنه مدَّ الروح إليه صَبْوَة وشوقا، فأبدع حكاية نابضة بالجمال والحياة.
وقال محمود شقير:
تنحاز روايات الدكتور حسن حميد ومجمل كتاباته القصصية ونصوصه الأدبية إلى فلسطين على نحو بالغ الوضوح؛ بحيث يجعل فلسطين همه الأكبر وهاجسه الدائم باستمرار.
وهو يعالج القضية الفلسطينية من مداخل شتى وبأساليب مختلفة ولا يكرر نفسه؛ فمن يقرأ “جسر بنات يعقوب” ويقرأ “النهر بقمصان الشتاء”، وكذلك “مدينة الله” و “الكراكي” سيجد تنوعًا في أساليب السرد وفي التقنيات الفنية، التي يعتمدها في كل رواية من رواياته، مع الاعتناء دومًا بلغته التي تتسم بقدر من الشاعرية التي بلغت شأوًا بعيدًا في رواية “مدينة الله”، وشأوًا أبعد وأجمل في رواية “الكراكي”؛ هذه الرواية الأخيرة الجميلة التي تأسست بذورها الأولى الجميلة في “مدينة الله.”
في هذا الرواية التي ناقشتها ندوة اليوم السابع مساء 19/08/2021 بحضور الروائي د. حسن حميد على منصة زووم، يتبدى السرد العجائبي والفانتازيا والتخييل في النص على نحو مقصود؛ بحيث يتم الاحتفاء بالقدس، بمقدساتها وأسواقها وأزقتها وأحيائها ورجالها ونسائه، وبحيث تظهر القدس وبقية الأماكن الفلسطينية، التي وردت في الرواية ذات عراقة في التاريخ وذات حضور بهي في الحاضر، وبحيث تبدو هذه الأماكن بطبيعتها الجميلة الخلابة أكبر من أن يستوعبها المحتلون الغزاة، ولا يمكن لها، وهي بهذه الصفات التي قصدت الرواية التوفّر عليها بكثافة لافتة، أن تستكين لهم؛ مهما استبدوا وبطشوا وألحقوا صنوف العذاب والتعذيب والاعتقال والقتل ضد الفلسطينيين؛ أهل البلاد الأصليين؛ مسلمين ومسيحيين.
لي ملاحظة واحدة؛ كنت أتمنى لو أن موظفة البريد التي حجزت رسائل فلاديمير المرسلة إلى أستاذه مدة أربعين سنة، وفيها وصف لجمال القدس وفلسطين ولمعاناتها، ثم أعادتها إلى راوي الرواية الموظف في بيت الشرق في القدس، بسبب إصابتها بالسرطان، أن تقدمها الرواية؛ أقصد تلك الموظفة، على نحو آخر، بحيث يصحو ضميرها ويؤنبها بسبب فعلها غير الأخلاقي جراء حجب الرسائل كل هذه السنوات، وبسبب صدمة الوعي التي جعلتها غير واثقة في المشروع الصهيوني الذي ينكشف تهافته أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على تحرير أرض وطنه من الغزو والاحتلال.
وقال جميل السلحوت:
عن الإتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيّين في رام الله صدرت في مجلّدين هذا العام 2021 الأعمال الرّوائية الكاملة للأديب حسن حميد. وبهذا فقد وصلت روايات د. حميد إلى القرّاء من أبناء شعبه في وطنه فلسطين.
والأديب الدّكتور حسن حميد الذي شرّدت أسرته من “أكراد البقارة” قرب مدينة صفد في نكبة الشّعب الفلسطينيّ الأولى عام 1948، وحلّت بها الرّحال في مخيّمات دمشق، حيث ولد في العام 1955. يعتبر واحدا من رموز الثّقافة الفلسطينيّة المعاصرة، وهو مبدع برز في القصّة والرّواية والأبحاث. وإذا كان اسم أديبنا الرّائع قد لمع في العالم العربيّ، فقد حجبت إصداراته عن أبناء شعبه الذين يعضّون على تراب وطنهم بالنّواجذ بسبب الحصار الثّقافيّ الذي فرضه المحتلون عليهم. من هنا تأتي أهمّيّة نشْر رواياته التي قام بها مشكورا الاتّحاد العامّ للكتّاب والأدباء الفلسطينيّين في رام الله، ضمن برنامجه بإعادة نشر الأعمال الكاملة لبعض الرّوّاد والرّموز الأدبيّة الفلسطينيّة.
سبق لي أن قرأت قبل سنوات رواية “جسر بنات يعقوب” للأديب حسن حميد، وها أنا أقرأ مجموعة رواياته كاملة، وسأتوقّف هنا عند رواية “مدينة الله”.
هذه الرّواية -كما هي روايات أديبنا السّابقة- تؤكّد من جديد أنّ كاتبنا مسكون بالمكان الفلسطينيّ، الذي شُرّد منه في النّكبة الأولى تسعمائة وخمسون ألف فلسطينيّ -حسب إحصاءات الأمم المتّحدة-، وأصبحوا الآن أكثر من ستّة ملايين شخص، عانوا ويلات التّشرّد والحرمان وشظف العيش. والأديب حسن حميد كفلسطينيّ أصيل مسكون بوطنه وطن الآباء والأجداد، لذا فقد كرّس مشروعه الثّقافيّ لهذا الفردوس المفقود.
وتأتي رواية “مدينة الله” في سياق المشروع الثّقافيّ لأديبنا، وقد استوقفني العنوان “مدينة الله” والمقصود بها مدينة القدس، فالقدس العاصمة السّياسيّة، الدّينيّة، الثّقافيّة، التّاريخيّة، الحضاريّة الاقتصاديّة للشّعب الفلسطينيّ، وهي بمثابة القلب في الجسد الفلسطينيّ، وهذه المدينة العربيّة التي بناها الملك اليبوسي ملكي صادق قبل أكثر من ستّة آلاف عام واتّخذها عاصمة لمملكته، لا يمكن أن تكون إلا عربيّة فلسطينيّة، وكأنّي بأديبنا يقصد عندما اختار هذا العنوان لروايته عن المدينة المقدّسة ” مدينة الله التي وهبها للفلسطينيّين”، أو أوحى للفلسطينيّين لبنائها لتكون مدينتهم التي اختارها لتكون مهدا للدّيانات السّماويّة. وكأنّي بأديبنا يقصد أيضا أن يقول بأنّ القدس مدينة التّعدّديّة الثّقافيّة. ومن خلال الرّواية التي اختصر فيها الكاتب مراحل تاريخيّة مرّت بها المدينة نلاحظ أنّه رغم أطماع الغزاة والمحتلّين السّابقين والحاليّين فإنّهم كما قال محمود درويش “عابرون في مكان عابر”، فالمدينة مدينة عربيّة فلسطينيّة ولن تكون غير ذلك رغم الليل الدّامس الذي مرّت وتمرّ به.
الأسلوب: بلغة أدبيّة ساحرة اختار الأديب حسن حميد أسلوب الرّسائل لبناء روايته عن المدينة المقدّسة، وهي رسائل كتبها بطل الرّواية “فلاديمير” لأستاذه “جورجي إيفان” في بطرسبورغ، لكنّها لم تصله؛ لأنّ موظّفة البريد اليهوديّة وديعة عميخاي أحتفظت بالرّسائل، ومنعت وصولها إلى صاحبها، وبعد أربعين عاما وعندما أصيبت بمرض عضال أفرجت عنها وسلّمتها لبيت الشّرق في القدس. وبيت الشّرق هو مركز أبحاث أسّسه الرّاحل فيصل الحسيني، واتّخذه مقرّا غير معلن لمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة.
و”فلاديمير” بطل الرّواية تزوّج من رشيدة مراد الفلسطينيّة، ومن خلالها تعرّف على المدينة المقدّسة، وعلى غيرها من الأماكن الفلسطينيّة، كما تعرّف على معاناة المقدسيّين بشكل خاص والشّعب الفلسطيني بشكل عام من عسف المحتلين والجرائم البشعة التي يرتكبونها. ويلاحظ ما جاء في الرّواية بوصف جنود الاحتلال بأنّهم يركبون البغال” بغّالة” وهذا الوصف ليس عفويّا، فالبغل لا يتّصف بالأصالة، وراكبه ليس فارسا ولا خيّالا، وهذا يتماشى مع المثل القائل” من قلّة الخيل شدّينا ع الحمير”، فـ “البغّالة” أصبحوا “فرسانا” لعدم وجود فرسان يردعونهم! وهؤلاء “البغّالة” طغوا وبغوا بحيث اعتدوا بالضّرب والإهانة على ركّاب سيّارة لأنّ سائقها قال لهم “مرحبا”، وفي صباح اليوم التّالي اعتدوا على ركّاب سيّارة لأنّ السّائق لم يقل لهم “مرحبا”! والمحتلون قلبوا حياة الفلسطينيين رأسا على عقب، فمثلا “أبو العبد” افتتح مقهى في قلندية الواقعة بين القدس ورام الله مع أنّه يحمل شاهادة بكالوريوس رياضيّات، وهذه إشارة إلى البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات في الوطن المحتل، وعشرات الآلاف منهم تحوّلوا إلى العمل الأسود في مطاردتهم لرغيف “الخبز المرّ” كي يواصلوا حياتهم، وهذه قضيّة لها تأثيراتها السّلبيّة على نواحي كثيرة في البناء الإجتماعيّ الفلسطينيّ.
وصف الكاتب الكثير من الأماكن في القدس مثل الصّخرة المشرّفة والمسجد الأقصى، كنيسة القيامة، درب الآلام، المغارة وغيرها. كما وصف بيوت القدس القديمة ونوافذ بيوتها. وقد توقّفت عند”المغارة”، وأعتقد أنّ الكاتب يقصد بها “مغارة سليمان” اللامتناهية في عمقها، والتي يقع مدخلها تحت سور القدس التّاريخي بين باب العمود وباب السّاهرة في الجهة الشّماليّة للمدينة القديمة الواقعة داخل سورها التّاريخيّ.
ملاحظة لها ما يبرّرها: لم يدخل الكاتب المدينة المقدّسة لظروف خارجة عن إرادته، بسبب الاحتلال الغاشم، لكنّ المدينة تسكنه مع أنّه لم يسكن فيها، وقد أظهر بعاطفة قويّة من خلال روايته مدى حبّه وتعلّقه بالمدينة، ولا غرابة في ذلك، فالقدس جنّة السّماوات والأرض، وهي عنوان عروبة فلسطين، وعدم معرفة الكاتب لجغرافيّة المدينة أوقعه في بعض الهفوات التي لا تؤثّر على البناء الرّوائي، وتمنّيت لو أنّ كاتبنا عرض روايته على مقدسيّ يعيش في المدينة قبل طباعتها، ومن هذه الهفوات، حديثة عن “الرّامة”، والرّامة بلدة فلسطينيّة في الجليل الأعلى وهي البلدة التي ولد وعاش فيها شاعرنا الكبير سميح القاسم، أمّا البلدة المقدسيّة فاسمها “الرّام”، وتقع شمال المدينة بين القدس ورام الله، وكذلك وصفه لما سمّاه “نبع سلوان” واسمها عين سلوان، وهي على بعد حوالي أربعمائة متر عن سور القدس من الجهة الجنوبيّة” وهذه العين لها مدخلان” بينهما نفق صخريّ يرتفع حوالي ثلاثة أمتار وبعرض حوالي متر واحد تنبع منه مياه العين، لتخرج من “العين التّحتا” كما يسميّها العامّة، ومنها كانت تروى أراضي حيّ البستان حيث كانت تزرع الخضار وتنمو أشجار التّين، وبعد أن استولى المحتلّون على العين ومياهها، أقام الأهالي بيوت سكن عليها، وصدر قرار احتلالي بمصادرتها لأنها تقع ضمن ما يسميّه المحتلون “الحوض المقدّس” ويزعمون أنّ ما يسمّى “مدينة داود” كانت قائمة عليه، ومن الهفوات التي وردت في الرّواية وجود أشجار أمام كنيسة القيامة وهذا غير صحيح أيضا، فأمام مدخل كنيسة القيامة ساحة صغيرة مساحتها أقلّ من مئة متر مربع تفصل بين الكنيسة ومسجد عمر.
وماذا بعد: تبقى الرّواية إضافة نوعيّة شكلا ومضمونا للرّواية الفلسطينيّة عن القدس، وهذه العجالة لا تغني عن قراءتها.
وقالت رفيقة عثمان:
قدّمت هذه الرّواية سردا شيّقا؛ لحياة الفلسطينيين وخاصّةً في مدينة القدس، حيث وصفت حياتهم اليوميّة السيّاسيّة، ومعاناتهم في ظل الاحتلال، كما وصف الكاتب حياتهم الاجتماعيّة، والاقتصاديّة لنفس المرحلة.
لعب المكان دورًا هامّا في أحداث الرّواية، وحضور القدس بارز للعيان، ومن الممكن استنباط الزّمان وهو طوال فترة الاحتلال، وخاصّةً بعد عمليات الحفر للأنفاق في مدينة القدس، واستمرار عمليّات الاستيطان في فلسطين.
نجح الكاتب في الوصف الدّقيق لحياة الفلسطسنيين بكافّة التفاصيل، خاصّة الصّراعات والصّدامات الدّائرة والمواجهة بين المواطنين الفلسطينيين والجنود على الحواجز والمعابر.
أبدع وصف المعاناة الفلسطينيّة اليوميّة وانعكاساتها على حياته اليوميّة، من خلال مشاهدات الراوي شبه اليوميّة عند مراقبته لها أثناء جلوسه في مقهى أبو العبد قرب حاجز قلنديا؛ ومن خلال حواره مع أحد الأسرى عباس الياسين، والدّليل فرج، والمرافق جو، ومن خلال جولاته المتكرّرة وزياراته لبععض السّكان الأصليين.
بينما ظهر جهل للأبعاد المكانيّة والمسافات الزّمنيّة، والتي ظهرت جليّا عند ذكر الكاتب لأسماء الأماكن التي تنقّل فيها البطل “فلاديمير” خلال فترات زمنيّة محدودة بين أماكن بعيدة، وخارج مدينة القدس بعيدة وتحتاج لساعتين سفر في سيّارة؛ للوصول الى شمالي فلسطين التّاريخيّة. بينما البطل سافر عبرعربة الحوذي جو.
ظهر في رواية “مدينة الله” التكرار جليّا عند وصف الأحداث ذاتها خلال النصوص كافّة، اعتقد بأنّ الراوي وظّف ظاهرة ” الموتيف Motive – أي ظاهرة التكرار في الأدب بمعنى “الدّالة وهي عبارة عن حدث أو موقف أو فكرة نمطيّة أو عبارة لغويّة أو نمط معيّن مماثلا ومتكرّرا في شتّى الأعمال الأدبيّة، وظيفته أن يثير حالة قد تؤدّي الى التّعرّف والكشف أو يكون شاهدا ورمزا على وضع معيّن” ويكبيديا.
في هذه الرواية وردت عبارات ” البغال – البغالة – الكلاب المتوحّشة – سيّارات الصّفيح” تكرّرت هذ العبارت مرّات عديدة لا حصر لها؛ تعبيرًا عن وجود الجنود المُعتدين، وكلابهم، وسيّاراتهم المصفّحة، والمُتسبّبة في تعكير صفو حياة الفلسطينيين اليوميّة، عند التفتيش وفحص الهويّات والتصاريح للداخلين والخارجين من مدينة القدس.
هذا الموتيف يرمز لأهميّة الموضوع الشائك في نفسيّة الكاتب، ورغب الكاتب أن يكون شاهدا ورمزا على هذا الوضع المؤلم. لذكر أمثال أخرى. كما ورد في نهاية كل رسالة ملاحظة من البطل “فلاديمير” لصديقه، يخبره عن مشاعره وتساؤلاته لمواقف معيّنة، ومشيرا إليه ان يراسله، وهو قلق عليه من عدم المُراسلة. أوردت مثالين فقط، لأنوع التّكرار أو الموتيف في الرواية، وهنالك متّسع لذكرعدّة أحداث ومواقف.
تحدّث الرّاوي عن عادات وتقاليد تخص الشّعب اليهودي بالتّفصيل؛ منها ما هو متّبع حتّى الآن ومنها ما اندثر، كذلك تطرّق حول معتقداتهم وأحلامهم ومخاوفهم، وعلاقاتهم؛ وكيفيّة انعكاساتها على حياة المواطنين الفلسطينيين.
اختار الكاتب شخصيّات لرّواية؛ لملاءمتها لأحداث الرّواية: الشخصيّة الرئيسيّة: السيد فلاديمير – وهو سائح روسي، حضر الى فلسطين؛ ليتعرّف عليها، بعد وفاة زوجنه رشيدة فلسطينيّة الأصل من عكّا.
الشخصيّة الثانية: السيّد جو وهوالحوذي المرافق – الشخصيّة الثالثة: سيلفا صديقة فلاديمير اليهوديّة، والتي انكشفت بأنّها تعمل في سجّانة داخل السّجن في المسكوبيّة؟
والشخصيّة الثّالثة: شخصيّة الدّليل فرج.- شخصيّة أم هارون.
من خلال استخدام تلك الشّخصيات، حرّك الكاتب الأحداث عن طريق الحوار الدّائم بين البطل “فلاديمير” ومرافقه الحوذي جو، كما أنّه استخدم الحوار الذّاتي خلال السّرد.
من قراءتي للرّواية اعتقد بأنّ زواج فلاديمير من رشيدة غير مقنع للقارئ إلى حدّ ما، كما أن ّعلاقة سيلفا مع البطل فلاديميرغيرمقنعة تماما؛ وذلك لطبيعة عمل سيلفا في السّجن وما تقوم بها من أعمال تنكيل وتعذيب للأسرى الفلسطينيين داخل السّجن، بنفس الوقت الذي يُظهر فيها فلاديمير تعاطفا قويّا مع القضيّة ، ومع معاناتهم في ظل الاحتلال، ولم تظهر علامات الصّراع النّفسي للبطل من طبيعة التناقضات القويّة لهذه العلاقة، خاصّةً بعد ان اكتشف طبيعة عملها الإجرامي. ظهر الصّراع عند نهاية الرواية تقريبًا، بعد أن التقى فلاديمير بفتاة أرمنيّة واسمها ميرنا، كانت تسقي السيّاح الشراب عند دخولهم ساحة القيامة، فأحبّ مظهرها!
اعتمد الكاتب في التقنيّة الفنيّة للأسلوب في الرّواية، تقنيّة الاسترجاع الفنّي – الفلاش باك (Flashback)؛ وذلك بواسطة استخدام الرسائل المُتراكمة، والمُرسلة من قِبل فلاديمير، لصديقه خارج البلاد (روسيا)؛ وهذه الرسائل احتجزتها موظّفة البريد، وأودعتها قبل وفاتها عند أحد الأصدقاء، والّذي بدوره نشرها في صفحات هذه الرّواية على لسان الرّاوي فلاديمير.
محتوى هذ الرسائل يصف زيارة فلاديمير لأماكن فلسطينيّة متعددة، القدس، وأريحا، والخليل، والرامة؛ حيث تكرّرت الزّيارات عدّة مرّات لنفس المكان، وخاصّةً في مدينة القدس.
بنظري كانت زيارت الأماكن خارج القدس إضافة غير موفّقة؛ حيث أثقلت على السّرد من ناحية الوصف والاستطراد فيه، حبّذا لوتقيّد الكاتب في مكان محدّد وهو القدس نفسها؛ للتّركيز على أحداثها، وذكر أماكنها ومقدّساتها، وتراثها وما إلى ذلك، خصوصا أنّ الكاتب أطلق اسم الرّواية “مدينة الله” مدينة الأديان السّماويّة والمُقدّسات.
هذا الاستطراد أطال في عدد صفحات الرّواية، لتصل الى 330 صفحة، والتي تبعث الملل في نفس القارئ، خاصّةً عند تكرار الأحداث والوصف الموسّع للأماكن والأشخاص؛ وذكر تفاصيل لا حاجة لها، وعدم ذكرها لا يشوّه النصوص، مثالا على ذلك، عندما وصف الكاتب دكّانا زاره، فذكر كل محتوياته من الإبرة للخيط، وقس على ذلك لأماكن أخرى.
بإمكان الرّوائي اختصار الرّواية للنصف تماما، مع الاحتفاظ بكافّة عناصرها، دون التأثير عليها.
وصف الكاتب النساء الفلسطينيّات والمقدسيّات، بأوصاف جميلة جدّا كما ورد صفحة 78 في وصف النساء في بيت لحم ” النساء الطويلات الجميلات بأثوابهن المُطرّزة بخيوط ملوّنة من فتحة الصّدر وحتّى القدمين، نساء يمشين بأثواب كأنّها الألوان.”. كما وصف النساء في الخليل: ” ها هي النسوة بثيابهن المطرّزة ومناديل رؤوسهن المُلوّنة. تشدّني إليها (الخليل) الشّرفات الدانية سحرنا بأزهارها وأخشابها الملوّنة، والصّبايا الجميلات اللّواتي يجلسن فيها وكأنّهن أميرات في المقصورات، يحضرن عرضا مسرحيّا. أراهن يدرن البصر في كل الإتجاهات”.صفحة 112. في الوصف للنساء المقدسيّات ” ظهرت النّساء المقدسيّات بأثوابهن السّود المطرّزة، وهنّ يقفن في الشّرفات، بعضهن ينشرن الغسيل على الحبال، وبعضهن يسقين النباتات، وأخريات يشربن القهوة وينظرن إلينا”. صفحة 125.
من الوصف أعلاه والمُتكرّر في وصف المرأة من الشكل الخارجي، كما أبرزها الكاتب، ولم يتطرّق إلى فكرها ووجهات نظرها بطريقة عميقة! أعتقد أنّ محدودية الوصف اعتمدت على الشكل الخارجي؛ من وجهة نظر سائح أجنبي.
استخدم الروائي الخطاب بضمير الأنا للسارد أي الراوي، عن طريق بطل الرواية فلاديمير، وتدخل بسيط للروائي. هذه التقنية أدخلت الصّدق في سرد الرّواية؛ لكن هذا الاختيار للشخصيّة السّاردة أفقدت بعض التّفاصيل للقارئ الفلسطيني، ولم تقنعه بها كما لو كانت شخصيّة فلسطينيّة تسرد الأحداث من وجهة نظر حقيقيّة داخليّة؛ كما حدّت من وصف بعض الأماكن المقدّسة والرّموز الإسلاميّة، كما حدث عند زيارة السائح فلاديمير للحرم الإبراهيمي بالخليل، لم يصفه بدقّة، من الدّاخل والخارج، ونفس الأمر عند زيارة المسجد الأقصى بالقدس، على الرّغم من تكرارا الزّيارات للقدس.
اعتماد الكاتب على عامل الصّدفة في الرّواية، كما ورد عندما صعد فلاديمير درج سلوان، وأراد أن يضع يده على كتف الحوذي جو، وبالصدفة طلعت سيلفا من بين آلاف الأشخاص المحتشدين!؛ مثال آخر: عندما اكتشف فلاديمير بأنّ عشيقته الرّقيقة، كانت هي نفسها التي عذّبت عارف الياسين الّذي كان أسيرا في المعتقل، وقامت ببتر أصابع يده.
وردت أحداث آخرى للصدفة في نصوص الرّواية، حسب رأيي هذه الصدف المستصدفة لا تقنع القارئ بمصداقيتها؛ وإنّما هي من صنع خيال الكاتب.
يبدو اعتماد الكاتب على عرض معلومات توثيقيّة من خلال سرده، والتي احتلّت حيّزا لا بأس به، من تفاصيل، والتي من الممكن الاستعانة بها بمصادر علميّة، دون الحاجة لذكرها بالرّواية.
قام الكاتب بوصف عادات اليهود في طلب المطر، والّتي ظهرت في وضع القطن فوق مسامير؛ لطلب المطر، وكان التباس بتشبيهه في صلاة الاستقصاء عند المسلمين صفحة 282؛ حيث لا توجد مقارنة بينهما بتاتًا، الأولى اعتمدت على العادات والمعتقدات، بينما الثّانية اعتمدت على اتّباع تعاليم دينيّة إسلاميّة.
طغت على الرّواية عاطفة الحزن، وعاطفة الغرام، عاطفة الانتماء والمؤازرة للقضيّة الفلسطينيّة، كما ذكرت سابقا استخدمت العاطفة في الرّواية لأهدافٍ آنيّة تخدم مصلحة خاصّة في نفس كل بطل من أبطال الرّواية؛ فمنها عاطفة صادقة ومنها غير ذلك.
لغة الروائي انسيابيّة وجميلة، وتزخر باستخدام المحسّنات البديعيّة، والتي أضافت تشويقا للسرد؛ إلا أنه ظهر التكلُّف فيها.
تعتبر هذه الرّواية غنيّة جدّا بالأحداث وبالمعلومات والتفاصيل للأماكن، عن الحياة الاجتماعيّة، والسّياسيّة والاقتصاديّة في فلسطين؛ وهي تبعث الشوق والحنين في قلوب المغتربين في كافّة بقاع العالم، ولكل إنسان عربي يتوق لزيارتها وزيارة الأماكن المقدّسة، وخاصّة مدينة القدس أو “مدينة الله” كما أطلق عليها كاتبنا.
برأيي القيام بتقسيم الرّواية من قبل الروائي، الى ثلاثة أجزاء، يساهم في قراءاتها المتعدّدة وخاصّة عند طلّاب المدارس؛ لأهميّتها في التطرّق لحياة شاملة ومتكاملة؛ وأنصح باقتنائها وتوفيرها في كافّة مدارس العالم العربي. بل تعتبر هذه الرّواية أرشيفا لحضارة تستحق الحياة.
وقال عبدالله دعيس:
عنوان الرّواية هو إحدى العتبات التي تقود إلى النّصّ، (ومدينة الله) تشير بوضوح إلى القدس، فأيّ مدينة غيرها اجتمعت عليها قلوب المؤمنين وهفت إليها أفئدة الموحّدين؟ فهي مقام المسيح عليه السلام ومسرى النّبيّ محمّد صلى الله عليه وسلّم، وفيها تتعانق المآذن وأبراج الكنائس، ويتداخل الأذان مع قرع نواقيس الكنائس، حتّى ليظنّ الناظر إليها أنّ قباب الكنائس تعلو المساجد ومنائر المساجد تعلو الكنائس، كما يشير الكاتب.
ويحتار القارئ للرواية أين يصنّفها: فهل هي رواية واقعيّة تصف المدينة وتحكي يومياتها في ظلّ الاحتلال، أم فنتازيا خياليّة تتخذ من المدينة المقدّسة مكانا للانطلاق إلى عالم خياليّ جامح. أعتقد أنّ الكاتب استطاع أن يجمع بين الصّنفين ويدمجهما بطريقة فنّية، حتّى أن القارئ لا يستطيع أحيانا التّمييز بين الحقيقة والخيال؛ فالأحداث واقعيّة تحدث في القدس كلّ يوم، والأماكن حقيقيّة، لكنّ المكان والزّمان متداخل بشكل خياليّ، فالأكمنة توصف أحيانا كما هي، وأحيانا أخرى تظهر كأنّها أماكن أخرى مختلفة تماما. أمّا الزمان، فبينما تتحدّث الرواية عن أحداث واقعية تدور في الزمن الحاضر وتحت الاحتلال، إلا أنّ الكاتب يغوص في أعماق التّاريخ ويستخرج منه صورا، حتّى لتظنّ أن الأزمان الغابرة اجتمعت واتحدت مع الزمن الحاضر.
الشخصيّة الرئيسية في الرواية هي لفلاديمير الرّوسي الذي أتى لزيارة المدينة المقدّسة، وكتب الرسائل المتتالية لمعلّمه في روسيا؛ يشرح له فيها ما يراه وما يشعر به كلّ يوم من أيام مكوثه. وهي حيلة فنّية جيّدة لصياغة الرّواية بطريقة مشوّقة ومقنعة للقارئ، وإن كانت الرّسائل أشبه ما تكون باليوميات والمذكّرات منها للرسالة.
ويبدو الكاتب متأثّرا بالكوميديا الإلهيّة لدانتي أليغييري حيث يصحب الشاعر الروماني فيرجيل الكاتب إلى العالم الآخر في رحلة خياليّة أسطوريّة. وفي رواية (مدينة الله)، وبشكل مماثل لرحلة دانتي، يأتي الحوذي جو الإيرلندي ليصطحب فلاديمير على عربته التي يجرّها حصان في أحياء القدس وفي مدن ومخيمات فلسطين، في رحلة أسطوريّة يدمج فيها الخيال والواقع بطريقة غريبة تحلّق بالمتلقي في عالم الخيال ثمّ تحطّ به على الواقع.
يصوّر الكاتب الإنسان الفلسطينيّ، بالشخص الصامد في وطنه الذي يتلوّع بظلم الاحتلال ويعاني على حواجزة ويقاسي في سجونه أسوأ ظروف الاعتقال والتّعذيب، ومع ذلك يبقى متشبّثا بأرضه صامدا عليها، ويبقى شوكة في حلق المحتلّين، وعقبة في وجه توسّعهم واستقرارهم في بلاده. أمّا الآخر فيرسم له صورا مغايرة، فهو مهزوز خائف مرعوب لا يشعر بالأمن مهما كانت قوّته ومهما وضع من حراسة، وهو عدواني يتلذّذ بسفك الدّماء وتعذيب الآخرين دون أن يرمش له جفن أو يندى له جبين. وقد أحسن الكاتب عندما وصف جنود الاحتلال بالبغال والبغّالة والكلاب الصّامتة، وكرّر هذه الصفة مرّة بعد مرّة على مدى صفحات كتابه؛ فالبغل حيوان هجين لا أصل له ولا نسل له، والبغّال الذي يمتطي ظهر البغل ليس كالفارس الذي يمتطى صهوة الحصان الأصيل، وأنّا للبغل أن يصبح كديشا عدا أن يكون أصيلا! وأنّا للمحتلّ أن يصبح أصيلا في أرض ترفض وجوده على ثراها!
أما شخصيّة (سيلفا) المجنّدة في سجون الاحتلال، التي تعذّب الأسرى والأسيرات بوحشيّة وساديّة، ثمّ تتحوّل إلى غانية عاشقة تهب جسدها لكلّ لامس، لا شرف لها ولا كرامة، فهي تجسيد لشخصيّة المحتلّ الدّخيل الذي يقتل ويعذّب بساديّة ونفسيّة مريضة، ثمّ يظهر للعالم بأنّه حمامة جميلة تحلّق في واحة الديمقراطيّة بينما تخفي تحت ريشها النّاعم جسد غراب خسيس.
وقد بالغ الكاتب في وصف العلاقة بين فلاديمير وسيلفا ولحظات العشق التي جمعتهما، ووصفها بصورة حسّية تخدش حسّ القارئ وتوصله إلى مرحلة كبيرة من الاشمئزاز. وقد كرّر الكاتب هذا المشهد مرّة بعد مرّة، وفي مواقع كثيرة في الرّواية، يشعر القارئ أحيانا أنّها مقحمة ومقصودة بذاتها، ولا يعقل أن تكون ضمن رسالة أرسلها تلميذ إلى أستاذه!
ويلحظ القارئ للرواية التكرار الكثير في الوصف وفي الأحداث، وهو جيّد أحيانا لأنّه يؤكّد على الفكرة التي يريدها الكاتب، ومثال ذلك ذكر البغال والبغّالة وتكرار أفعالهم في العشرات من المواقف، ولكن في أحيان كثيرة أثقل التكرار على القارئ وأفقد الرواية عنصر التشويق والمفاجأة، وكان يمكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر ذلك على بنية الرّواية.
الفكرة العامّة للرواية هي رفض الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني وإظهار بشاعة الاحتلال وضعف حجته التاريخيّة وتناقضه، ودعوة للحريّة والانعتاق من الظلم والحياة بسلام. لكن هناك تناقض كبير يشعر به القارئ عندما يختار الكاتب شخصيته الرئيسيّة؛ لتكون فلاديمير الروسي ويشير في الرّواية إلى الاتحاد السوفييتي السابق، ويصفه بالعظيم! وكأنّ الاتحاد السوفييتي وخليفته روسيا واحة للسلام والحريّة، بينما المستطلع البسيط للأحداث منذ بداية القرن العشرين يرى أنّ الاتحاد السوفييتي كان من أكبر القوى الاستعماريّة التي احتلّت شعوبا بأكملها وشرّدت الأمم وقتلت الملايين، وما تزال روسيا تقوم بهذا الدّور في كثير من بلدان العالم، وتهجير الشعب السوري وإبادته بالبراميل المتفجرة ما زالت قائمة. وهذا تناقض كبير، فلا يمكن أن أكون محبّا للحريّة وأمجّد سالبي الحريّة، ولا يمكن أن أتعاطف مع الشّعب الفلسطيني ومعاناته وأغضّ النظر عن معاناة الشعوب الأخرى. فهذا يفقد صاحبه المصداقيّة ويفقد عمله قيمته.
لغة الكاتب جميلة وأسلوبه بديع ممتع، وفي الرواية رحلتان: واحدة رائعة وهي رحلة فلاديمير في أرجاء القدس وعبر تاريخها، وإن كانت الكثير من الصور والأحداث ليست حقيقية، مثل الحلقات الصوفيّة في المسجد الأقصى، ورحلة أخرى شائنة، وهي رحلة فلاديمير في أحضان سيلفا، وفي المقاهي التي يتكرّر ذكرها، وذكر احتسائه للقهوة، بشكل يصل بالقارئ حدّ الملل. فحبّذا لو اكتفى الكاتب بالرحلة الأولى وأشار إلى الثانية بأسلوب لا يخدش مشاعر القارئ.
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
هي روحه تشتاق إلى حبيبته التّي لم يبصرها على أرض الواقع، فزاده الشّوق ولوعة الحنين؛ ليغزل من جنة خياله روايته “مدينة الله”؛ لنبصر وجه القدس
ووجوه أُخرى تحت الاحتلال.
في روايته”مدينة الله”ينتصر الرّوائي حسن حميد لوصف الأماكن والمدن من خلال شخصية فلاديمير الروسي، الّذي قام بإرسال رسائل إلى معلمه إيفان في سان بطرسبورغ، يخبره عن أوجاع المدن وحكاياها، هي رسائل صوت القلق والخوف، رسائل تبحث عن الأمان والحرّية من الظّلم الّذي وصل حدّ السّماء، رسائل فيها أيضا صوت الظالم ورؤيته الصهيونية الّذي يؤمن بالقوة وحقه بإمتلاك الأرض والمقدسات، هي رسائل حول عذاب المدينة وأخواتها، وهي رسائل فيها لمسات الحزن ووجه الغضب من قبل الفلسطيني المقهور، ووجه الشّارع الّذي لا يهدأ من مشاهد الإعتقالات والشّهداء.
الأُسلوب: استخدم الرّوائي أدب الرّسائل في سرد حكاية فلاديمير وكتابة مشاهداته الحيّة خلال تجواله في القدس وأحيائها وبعض المدن الفلسطينية برفقة صديقه جو. اختار الرّوائي أن تكون الرّسائل عادية عبر البريد، وليست حديثة عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، وهي من طرف واحد فيها غياب ردّ رسائل المرسل إليه.
تطرق إلى أسلوب الكتابة كعلاج نفسي، حيث بيّن الرّوائي النّاحية النّفسية وأثر المشاهد الصعبة والمؤلمة على فلاديمير التّي رآها وسمع عنها تحت سماء الإحتلال، فقد مارس فلاديمير الكتابة من أجل التّحرّر من آلامه. يقول فلاديمير:” أُصارحك بأن نفسي بعد الكتابة إليك ليست هي نفسي قبل الكتابة إليك، لقد بُتَ نافذتي وملاذي.”
وهو بحاجة إلى المزيد من التّواصل من أجل توازنه النفسي، لذا يرجو صديقه في نهاية كلّ رسالة أن يكتب له” أرجوك أن تكتب لي؛ كي تصفو روحي أكثر كي أشعر أنّك نافذتي”.ويقول في الكتابة” أمحو غمّ قلبي.”
استخدم أُسلوب التّفريغ العاطفي كوسيلة للتّحرّر من الضغوطات النفسية والمشاهد القاسية، كما في حالة سيلفيا السّجانة اليهودية التّي كانت تلجأ إلى حضن فلاديمير. تقول سيلفيا”: أرجوك أُغمرني بذراعيك أكثر فقد دمّر السّجن حياتي، أرجوك ضمني أكثر أكثر أرجوك.”
استخدام التّكرار كثيرا في ذكر الأعشاب وشرب القهوة والمقاهي ممّا خلق حالة روتينية للمشهد، تجعل القارئ غير متفاعل مع النّص، وقد كانت الرّواية طويلة ومرهقة للقارئ رغم الخيال الجميل بسبب الإكثار من المعلومات المكثفة.
استخدم وسيلة النقل القديمة العربة والحصان أثناء تجوال فلاديمر، ممّا أضفى على الرّواية لمسات الجمال والخيال، وأعادنا إلى الحكايات القديمة والأساطير.
استخدم أُسلوب المخاطبة في نهاية الرسائل “أُكتب لي”،واستخدم أُسلوب المفارقة في
رسالته الأخيرة من السّجن” لا تكتب لي.
استخدم الأُسلوب الوصفي التّصويري والتّعريف للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتصوير الأسواق باستخدمه لأسماء الإشارة من أجل تقريب المشهد للقارئ.
استخدم الرّوائي أُسلوب الحوار التّعليمي والّذي يشبه أيضا الأحاديث النبويّة الشّريفة، من أجل نقل المعلومات المكثفة ومحاولة إيصال فكرته، فقد ذكر الفعل قال وقلت كثيرا في الحوار الجاري بين الشخصيات.
جرّد المحتلّ من إسمه،ومن صفة الإنسان التي لا يستحقونها حيث منحهم لقب البغّالة.
يصورّ تأثير الأحداث المؤسفة والممارسات الإسرائيلية على حياة الفلسطيني حتّى في اختيار الأسماء التي تبرز معاني الصمود مثل: ثابت، صابر وغيرها.
جاءت لغة الرّوائي جميلة مشبعة بالمحسنات البديعية والخيال، وتصوّر الواقع، وكانت الرّواية منسقة كلّ مشهد فيه وصف، وثمّ يختمه إمّا بالإعتقال أو التّنكيل أو الشّهادة.
جاءت معظم أسماء الشّخصيات خيالية ما عدا شخصيتي الشّاعر ماجد أبوغوش وشخصية عارف ياسين.
ورد خطأ في بعض أسماء الأماكن: نبعة سلوان والصحيح عين سلوان، ذكر مدينة الرّامة التّي في الجليل وقد كان يقصد بلدة الرّام المحاذيّة للقدس.
وكتبت نزهة أبو غوش:
القدس مدينة الأضواء والأنوار والبهجة. القدس هي المدينة العجيبة ذات العبق التّاريخي. القدس مغسولة بماء الورد وبنور من عند الله، هي أصل المدن وأصل الحضارات، وجذور تاريخنا. القدس مهد المسيح ومسرى محمد. القدس هي بوصلتنا الأولى نحو الحريّة والمحبّة والسّلام، القدس هي مدينة الله. في القدس اولا ترى السّعادة والبهجة والمتعة البصريّة. في القدس أنت الأقرب إِلى الله سبحانه؛ حيث تتعانق كنائسها مع مساجدها. لكنّ هناك ما ينغّص عليك عيشك. لأنّ الاحتلال متسلّط عنيد لا يدع لك هناءة ولا راحة بال؛ فهو يعيث في الأرض فسادا لا حدود له.
لغة الرّواية: لغة غنيّة جدا بالمحسّنات البديعيّة، والاستعارات والتشبيهات الجميلة، والمبالغ بها، وخاصّة في حالة الوصف، فهو لا يترك ما يصفه حتّى يصوّره لك بأنالجنّة إِذا كان مكانا، وهي الحوريّة ذات الوجه المنير المبهج لو كانت امرأة. كلّ النّساء الفلسطينيّات في وصف الكاتب ساحرات ورشيقات ومبدعات، خجولات، مضحّيات.
وصف الطّبيعة بلغة تجعلك تشعر بأنّك تعيش في أجواء سحريّة فلم ينس الأنهار ولا الجبال ولا الأودية والهضاب والمنعرجات ولا الرّياح والهواء والأمطار,…
وصفه الدّقيق للأشياء جميل وفيه ابداع؛ لكنّ ما يفسد من هذا الجمال، كثرة التّكرار، والإطالة بالوصف؛ حيث يكون هذا على حساب الحدث في الرّواية؛ وأحيانا يدخل الوصف حتّى بأيّ ثمن، أي دون أن يكون مناسبا للموصوف أو يقلّل من شأنه. مثال في ص78″ والشرفات تدلّي الصبايا والنساء نحونا مثل القهوة حين تندلق من الدلاء اللامعة”.”
لقد خلط الكاتب في روايته ما بين الواقع والخيال فأضفى بعضا من الجمال للنّص، وهذا حقّه ككاتب يريد أن يشعل خياله؛ لكن هناك بعض التّمويه للقارئ في حالة اعتقاده بأنّ الكاتب يشرح أماكن جغرافيّة حقيقيّة فقط.
مثال على الوصف ” أعمدة حجرية زرقتها، تحت المطر الرّذاذي، تلمع وتبرق مثل خيوط الحرير، وأعمدة رخامية بيض ذات رهجة وردية تشبه ريش الأوز ملاسة ونعومة، أعمدة تعلوها تيجان حجرية متدلية مثل النباتات، حانية بظلالها على الأعمدة، تخترمها الرسوم والخطوط حفراً غائراً وآخر نافراً..” ص254.
نهج الكاتب في استخدام أسلوب “وحدة الخطاب” في روايته من أوّلها حتّى نهايتها، عدا ذلك الحوار الّذي كان يجري بينه وبين الأمريكيين في الفصول الأخيرة من الرّواية، حيث كان تركيزه على أهميّة حقيقتنا التاريخيّة وضعفها لدى الآخرين الّذين يدّعون أحقيّتهم في المدينة.
استطاع الكاتب أن يوصل فكرته للقارئ عن الاحتلال، عن معاملته القاسية والعنصريّة، والعشوائيّة، وغير الانسانيّة. في الحياة اليوميّة أو في السّجون، أو على المعابر والحواجز؛ وعن عصاب الخوف وهستيريا القلق اللذان يعتريانه دائما.
شخصيّات الرّواية الأساسيّة هي شخصيّات أجنبيّة:
فلادمير: الرّوسيّ الأصل المتزوّج من رشيدة الفلسطينيّة، الّذي عشق … السّجّانة الاسرائيليّة بعد ثماني سنوات لموتها. ترمز هذه الشّخصيّة لعلاقة الرّوس مع الحكومات العربيّة، وعهد لينين وأعضاء الجبهة الشّيوعيّة الموالين لهم في البلاد.
شخصيّة جو، صديقه الايرلندي القديم، ترمز للقادمين من الغرب الّذين سكنوا المدينة وبقوا فيها.
شخصيّة السّجّانة سيلفا اليهوديّة الأصل: ترمز للصّراع المرير الّذي يعيشه المحتلّ ما بين الانسانيّة وعدمها تجاه الشّعب المحتل.
شخصيّة المرأة العجوز أم أهارون: ترمز الى المحتلّ الّذي يعيش حياته بحوف وقلق وترقّب.
ومن شيكاغو كتبت هناء عبيد:
السرد الأدبي في هذه الرواية لم يكن متميزا بفيض وغزير كلماته النورانية فحسب، بل كان ساحرًا للروح، آسرًا للنفس، مبهجًا للقلب، مشعلا للمشاعر، موقدًا للأحاسيس، مدمعًا للمقل.
لم تكن رحلتي مع الرواية كغيرها من الروايات، إذ تفاجأت بروحي وقد غاصت بين كل هذا الكم الغزير من المشاعر والحب، والفرح والحزن والألم والغصة التي غمرت سطورها، فقد عشت بكل حواسي مع هذه المشاعر الفياضة في عشق مدينة النور؛ أنا الفلسطينية المولودة على أرض القدس، المبعدة قسرا عن طيب أرضها.
الأديب الدكتور حسن حميد شرّدت أسرته عن الوطن في النكبة الأولى، ليولد ويعيش غربته بعيدا عن مدينة الله، فلم تطأ قدمه القدس، لكن ذلك لم يستطع أن يخلق المسافات بين قلبه وأرض القداسة التي تسكنه، وليس ذلك بالأمر المدهش أو المذهل لكل من تأصلت جذوره بهذه الجنة المحروسة بالعشق، فالحبال التي تربط قلوبنا بمدينة الله، متينة بقدر عشقنا الأزلي لها. لهذا استطاعت هذه القطعة النورانية الهابطة من الجنة على الأرض، أن تكون حاضرة في عين الروائي، ومحفورة في قلبه، فباحت أحاسيسه بكل ما دفق به قلبه من دفء وحب، وأدركت روحه مواسم المشاعر المتقلبة في المدينة الموشومة بالسحر، حيث الفرح والسعادة والطيبة والحب والحزن والألم والصبر.
وحدثتنا مشاعره المتأججة بعشق الأرض عن أجمل خيراتها؛ تلك التي تحتاج إلى كتب وكتب كي تستطيع أن تحتويها، فغزارة الخيرات لا تنعتق عن غزارة عشق الأرض، كأنهما يرتويان من نهر واحد؛ لينتجا لنا أطيب الثمار، حيث التين والزيتون والرمان والبرتقال والليمون واللوز والسرو والتفاح والبقوليات والزعتر والميرمية، خيرات تغرق الجبال بخضرة أبدية، تغري من يراها بالالتصاق بها.
ننتشي بهذه الألحان والموسيقى العذبة التي تعزفها مشاعر الروائي لوهلة، لندخل في دوامة تحيل نشوتنا إلى صحوة مؤلمة، فقد شاءت الأقدار أن يطأ أرض الطهارة لصوص شوهوا التاريخ، ومرتزقة داسوا بأحذيتهم القذرة كل جميل،
وما أنسب مفردة البغالة التي اختارها الروائي بذكاء لهؤلاء اللصوص، فهي أبلغ وأدق مفردة تليق بوحوش لا تعرف غير القتل والتدمير والتعذيب وتشويه الجمال.
لقد تمكن الروائي بكل أريحية أن يدخلنا في سراديب التاريخ، لتتضح الصورة وينفضح الكذب الذي اختلقه هؤلاء العابرون، هؤلاء الذين فصلوا أديانا تتناسب مع مصالحهم، وافتروا قصصا تتماشى مع مطامعهم، متناسين أن تلك المدينة الساحرة تستطيع التمييز بين من يحنو عليها ويرأف بها، وبين من داس أرضها اغتصابا وحاول تشويه قدسيتها، التي تعانقت في رحابها كل الأديان السماوية بكل تعاون ومحبة ومودة، فالسارق جبان يعيش الخوف الدائم، يسرد التاريخ الكاذب، يخرب الأرض التي تنبذه ولم تلده يوما، بينما ابن الأرض يروي تاريخه بفخر، يسرد قصصه من جذور الأرض المرتبطة فيه بحروف تراصت بكل عشق، بل ويوثق بطولته بدمائه التي يسترخصها من أجل تراب الوطن وطهارة القدس.
تبدأ الحكاية بالسيدة وديعة عميخاي العاملة بمركز البريد، التي يؤنبها ضميرها بسبب احتفاظها برسائل كان من المفترض أن تصل إلى أصحابها، لكن السيدة وديعة تحتفظ بهذه الرسائل نظرا لحبها لقصص وأخبار هذه الرسائل، وإعجابها بأسلوبها الأدبي البديع، وعشقها للغة العربية، تصاب بمرض عضال وتقرر أن تسلم الرسائل إلى زميل لها كان قد التحق معها بدورة تأهيل بالأرشفة قبل أربعين عاما، تذهب إليه في مكتبه في بيت الشرق لتسلمه الرسائل التي كانت بين السيد فلاديمير وأستاذه باللغة العربية إيفان الذي يعمل بجامعة سان بطرسبورغ. يستلمها زميلها ويحاول أن يتواصل مع كل من ذكر اسمه في الرسائل، لكنه لا يعثر على أحد منهم، لهذا يقرر أن ينشر هذه الرسائل في كتاب كما أشار عليه البعض.
الرسائل خطها فلاديمير الى أستاذه باللغة العربية إيفان، كتب له من خلال عين عادلة، استطاعت أن تميز الصدق من الكذب، النقاء من الخبث، بل وتمكنت أن تستطلع ملامح الوطن في صدق المشاعر، وميزت كل أصيل في القدس من خلال ملامحه الملفوحة بشعاع نورها.
كما تمكنت تلك العين العادلة الثاقبة أن تدرك أن هؤلاء البغّالة ما هم إلا مجرد أجساد متنقلة، لا تستطيع العيش دون تلك البندقية التي تحمي وجودهم، فلا الأرض تعشقهم ولا باطن الأرض يحن عليهم.
تحدث فلاديمير لصديقه عن فاشية الاحتلال من خلال قصص عذابات السجن، والتناقضات التي تحملها الحبيبة التي تتحول من سجانة نهارا الى صاحبة أحاسيس وقلب مفعم بالحب ليلا، ولكن أي حب هذا وأي عناق هذا؟ ولكأنه عناق أفعى تتلوى لتفتك بالضحية.
الرواية لم تكن عملا أدبيا يحمل أحداثا فحسب، بل حملت في طيات عباراتها تاريخ فلسطين والقدس، وطبيعة الحياة الاجتماعية في فلسطين وعلاقة الناس ببعضهم، كما تحدثت عن مميزات الشعب الفلسطيني الذي مهما اطفئت في جسده أعقاب السجائر فإنه لن يستسلم ولن ينطفئ، إنها رواية الرحلات التي تنزهنا من خلالها في ساحات القدس وحدائقها الغناء، إنها القداسة التي جعلتنا نركع ونصلي في مساجدها وكنائسها، إنها الحكايا التي تنقلنا من خلالها بين مدن فلسطين وقراها، إنها ملحمة المأساة التي يعيشها الأسير الفلسطيني بكل أطيافه، فالطفل والمرأة والرجل سواسية في تلقي العذاب الذي لا تستخدمه إلا آلات وحوش، إنها سيمفونية الحب الذي يجمع أهالي المدينة، إنها الطهارة التي تتعانق فيها الديانات، انها جغرافية المكان والأرض بسهولها ووديانها وجبالها ودمعاتها الجارية بين أوديتها، إنها التوثيق التاريخي لسرقة أرض، ونضال أمة، وعشق تراب.
ولن تأخذني عاطفة عشقي لمدينة النور عن الإشادة بالإبداع الأدبي الساحر للرواية، إذ أن أسلوب السرد بتقنية الرسالات كان الأعمق وقعا على النفس، فهل هناك ما هو أكثر حميمية من معانقة ورق أشجار هذه الأرض المقدسة للحديث عن طهرها وبهائها وصمودها وصبر أهلها.
ولم تكن المفردات الثرية أقل حظّا من البراعة في اختيارها، فقد كان النص زاخرا بمعجم لغوي ثري يربطنا بجمال وعظمة لغتنا العربية.
لا شك أنها رواية أدبية تاريخية توثيقية عاشقة، تثري رفوف المكتبات العربية بقيمتها، وتزينها بكل فخر.
وكتبت نزهة الرملاوي:
جولة في مدينة الله
قرأت رسائلك إلى سيدك، ورافقتك مع الحوذي جو في رحلتك المتخيلة، وروعة المكان والإبداع في السرد، والفكرة المتميزة.. تمنيت وأنا أتجوّل فيها أن لا تفرط في وصف المدن وحاراتها وأسواقها، أتدري لماذا؟ لأنك ستشعل نارا ولوعة في قلب سيدك لا تنطفئ، وتكبله بسحر هذه الأرض فلا يبرأ من عشقها فيأتيها مغتصبا.
توقفت طويلا على شرفات رسائلك وتساءلت: ماذا ستكتب أيها البعيد لو وطئت أقدامك درجات باب العامود وعقبة التكية وعقبة درويش، وباب حطة وباب الأسباط وباب المغاربة، وحيّ الأرمن وحيّ الطالبية، وسوق الباشورة وسوق اللحامين في الواقع؟ هل ستأخذ من جرح تهجيرها وتهويدها مدادا يؤرخ الثبات رغم القهر المحفور في قلبها؟ ماذا ستكتب في عاشقة تنتظر من خلف شباكها الصغير فتاها، فيأتيها في ذات حلم محاطا بحوريات السماء؟ وماذا ستكتب حين يدوس البغال رقاب الفتية بحوافرهم فيبتسمون؟ ويدقون أضلاعهم ويهدمون بيوتهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا يرحلون؟
لن أرهقك بكتابة واقع أليم وأليم جدا.. رغم أنك كتبت وأجدت رسم السلب والمعاناة في الوطن.. حينها لن تقرأ تتخيل.. ستدق وحشية المغتصب أوتادها في حقيقة الرواية فتكتبك.
سأمضي معك في وصفك الروحي للأماكن، وأمنيات عودة متخيلة تتجلى في معانقة المكان وانتقاء المفردات الآسرة. بدت مدينة الله تعج بالحركة وأصوات الباعة، أذهلتك كما أذهلتني وسحرتك بالخيال كما سحرتني وأنا في حضرتها البهية، نراها عارية من البهجة فاقدة للأمان موشّمة بالقهر والألم، أذهلني الوصف والتشبيه في كتابة تاريخها القديم، خمر معتق أخذني في غيبوبة سحرية من الكلمات، لكن سرعان ما أيقظتني من غفلتي، وشدتني الحقائق المرة إليها.. حيث البغالة الذين يتبعون الحماقات لبتر الفرح والهيام الراقص في حضرة المدن.
أيها الحاضر الغائب سأمضي معك، أسافر في وحي خيالك، أشبعتني زخرفة الكلمات والتشبيهات، لكنها أفقدتني المصداقية والواقعية في بعض الأحيان..رغم روعة السفر في مدننا الجميلة، مدننا التي تتشابه بشوارعها وأسواقها ومبيعاتها. حبذا لو قللت من وصفها رغم جمالها وانسيابية الكلمات، حتى لا نصاب بالملل.
صورت في رسائلك المهمة سيلفيا العارية من الإنسانية ومن كل شيء رغم بكائها المزعوم، وهي تصف دورها كسجانة وما تلاقيه السجينات من تعذيب لا تتخيله العقول، ولا تتحمله المشاعر في السجون التي تعمل بها، ومن الملاحظ أن همّك الأكبر كان وصف جلوسك الخادش للحياء مع سيلفيا، لا أن تستمع إليها وهي تفصل وحشيّة المعتقلات، وهل يعقل أن يكتب في رسائل الاكتشاف ما يدور بين اثنين في غرف مغلقة؟
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى قد يكون واقعيا أن تكتب عن فترة زمنية قديمة، زمن الإستشراق والعربات وكتابة الرسائل، في الحين نفسه تشير الرواية إلى ممارسات الاحتلال القمعية في الأسواق والمدن والسجون في وقتنا الحالي؟ هل تعد ذلك الدمج اختزإلا لزمنين متفاوتين مهمته اطلاع المتلقي على ما كان وما سيكون؟
وسؤال آخر: لماذا اخترت أن يكون أبطال روايتك من الأجانب، ولم تتخذ من شخصيات عربية أو من رواية عربية مدخلا للقصة؟
ما مدى تأثرك بتلك الشخوص؟
وما مدى تأثير أولئك الأشخاص في توصيل رسائل وصفت معاناة الفلسطينيين للآخرين مع أنهم كانوا مسيطرين على الكثير من الدول؟
شكرا للكاتب الدكتور حسن حميد ولروايته الأكثر من رائعة، شكرا لمن سكنت القدس قلبه فكتب رسائل حنين لا تنتهي.
وكتبت ميسون التميمي:
اسم الرواية “مدينة الله ” يدل دلالة واضحة على أن الكاتب يقصد بها القدس الشريف، وهل يوجد غير القدس معشوقة نتغنى ونتغزل بها وننام بين أحضانها؛ لنحظى بالدفء والحنان، فالقدس مُلهمة الشعراء والكتاب.
اختار الكاتب أسلوب الرسائل لبناءً روايته مدينة الله، وهي رسائل كُتبت على يد بطل الرواية فلاديمير لأستاذه جورج إيڤان، ولكن للأسف هذه الرسالة لم تصل واحتجزت مدة طويلة تقارب الأربعين عاما من قبل موظفة البريد وديعه عثمان عندما أصيبت. وديعة عثمان بمرض عُضال خافت على نفسها من العذاب فقررت تسليم الرسائل لبيت الشرق في القدس.
إستطاع فلاديمير أن يغوص في أعماق القدس من خلال زواجه من السيدة الفلسطينية رشيدة، فزواجه بها فتح له أبواب معرفة القدس وأسرارها.
تحدث الكاتب عن المحتلين وظلمهم وكيف أنهم حولوا حياة الفلسطينيين إلى جحيم حيث إنهم اعتدوا بالضرب المبرح على ركاب سيارة؛ لأن سائقها قال لهم مرحبا! واعتدوا على ركاب سيارة أُخرى لان سائقها لم يقل له مرحبا، وتحدث أيضا عن الإنسان المتعلم المتمثل بشخصية أبو العبد صاحب المقهى، الذي أتم دراسته الجامعية، وحصل على بكالوريوس في مادة الرياضيات، ولكن للأسف يعمل نادلا في مقهى وشهادته تزين الحائط.
والملفت للإنتباه والمفرح أيضاً إنه وصف جنود الاحتلال بالبغالَ الذين يركبون البغال، وهذا وصف يثلج الصدر، ويشفي الغليل.
وصف الكاتب العديد من الأماكن في القدس الشريف مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ووصف أيضا بيوت القدس وصفا جميلا، وتحدث الكاتب أيضا عن صمود الشعب الفلسطيني، وكيف أنه يفسد كل مخططات العدو في الاستيلاء على أرضه ويبقي شوكة في حلق العدو الغاشم.
لغة الكاتب جميلة وأسلوبه لا ينقصه عنصر التشويق.