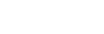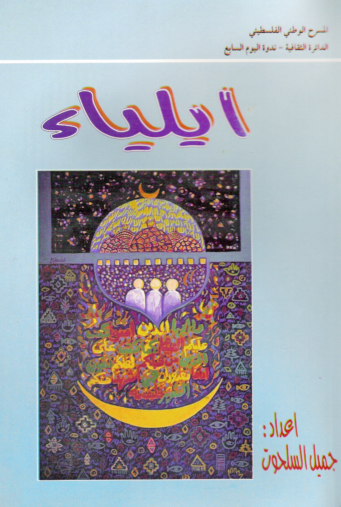المطالع لكتاب جميل السلحوت (حمار الشيخ) يكتشف, منذ الوهلة الأولى, أنه أمام نوع من كتابة مختلفة: حيث تبرز قدرة الأسلوب الأدبي, على الخوض في مسائل سياسية وثقافية واجتماعية شائكة, لا يجرؤ على خوض غمارها, إلا من امتلك ناصيتي النقد السياسي والنقد الإبداعي.
لقد قيل كلام كثير حول انفصال السياسة عن الإبداع, لكن كل هذا الكلام يتعرض للشطب على يد جميل السلحوت, بجرة قلم, عندما يقول:
“أما أنا وحماري, فلم تكن لدينا مشكلة على الإطلاق؛ فأينما وجدنا طريقاً سالكاً سرنا فيه, بغض النظر: على الرصيف, أو على جانب الشارع, أو في منتصفه. ولا أخفيكم سراً أنني كنت أشعر, وكأنني عنترة زماني, عندما نوقف السير, أو تهرب مجموعة من السياح مبتعدة عنا, لالتقاط الصور التذكارية لنا”( ).
إذا كانت هذه الحوارية نصاً غير مكتمل, وواقعة ثقافية, فإن علينا أن نحللها باعتبارها مادة خاماً, يجري استخدامها, مع مواد أخرى ذات علاقة بالنص, ومن خارجه. فالقصة في النص ما زالت بعيدة عن الاكتمال : بمعنى أن هناك فجوات في الحكي وتكتماً في النص, واستعمالاً متضارباً, إلى حد كبير, لسرد كل من المؤلف الضمني والراوي والمؤلف المدني:
فالمؤلف المدني, جميل السلحوت, شخص موجود, ويسكن في القدس, وله رقم هوية وعنوان محدد. لكننا ـ كمتلقين ـ لا نعرف آراءه السياسية, ولا موقعه الأيديولوجي, رغم أنه جزء جوهري من النص. كيف سنعرف ذلك؟. ليس أمامنا إلا أن نستكشفه من النص, عن طريق إعادة تكوين لحمة المؤلف, من خلال نصه.
لكن النص لا يبرز لنا جميل السلحوت بشحمه ولحمه, بل يبرز بدلاً من ذلك مؤلفاً معداً بعناية, على يدي جميل السلحوت الشخص المدني. وهذا المؤلف المقدم لنا بين السطور, سوف يكون هو المؤلف الضمني, الذي يتموقع وراء منظومة القيم ومواقف الأيديولوجيا( ).
إذن فالمؤلف الضمني هو الذي سنحاوره ـ كمتلقين ـ ونكتشف آراءه. يقول وين بوث:
“إن المؤلف عندما يكتب لا يخلق مثالاً إنسانياً عاماً فقط؛ ولكنه يخلق نسخة مضمونية من نفسه، تكون مختلفة عن المؤلفين الآخرين, والذين نقابلهم في أعمال مؤلفين آخرين… فمهما حاول أن يكون لاذاتياً, فإن قارئه لا بد أن يشكل صورة عن المؤلف الرسمي، أو المؤلف الثاني، أو الضمني، الذي يكتب بمثل هذه الطريقة”( ).
أضف إلى كل ذلك, شخصية الراوي, الذي ليس هو المؤلف الضمني, ولا المؤلف المدني؛ بل هو شخصية وهمية, مهمتها التنقل بين مفاصل النص, لتمارس الحكي نيابة عن واحد منهما, في أغلب الأحيان, أو عن كليهما في أحوال نادرة.
إن ابتداع شخصية الراوي أمر جوهري لعملية السرد. فلا يعقل أن يكون هناك سرد دون سارد. ثم لا يعقل أن نتصور أن جميل السلحوت هو الراوي ـ أو السارد ـ (فالمصطلحان يشيران إلى ذات المعنى). لذلك يلجأ السرد ـ ولا أقول المؤلف: فالقصة هي التي تبتدع راويها ـ لابتداع هذه الشخصية, التي يمكن اعتبارها مجرد تقنية, أو أسلوب لا يمكن الاستغناء عنه. وفي النقد الثقافي سوف يكون أمامنا مجال واسع, لمقارنة حقيقية, بين هذه الشخصيات الثلاث: المؤلف المدني, والمؤلف الضمني, والراوي, إضافة إلى كشف الانزياحات الأيديولوجية بين ثلاثتها.
سوف يبرز لنا المؤلف الضمني, في حمار الشيخ, منتقداً صلباً لكثير من الظواهر المجتمعية, في الأرض المحتلة, التي صارت أرض السلطة الفلسطينية. وعندما نتأمل المقطع المقتبس السابق قليلاً, فسوف نتساءل: أين حدود السياسة هنا من الإبداع, وأين هو الفارق بينهما؟.
لقد امتزجا في خطاب ثقافي, ينتقد كلاً من السلطة السياسية وثقافة المجتمع. ولنا أن نتساءل هنا: أي نوع من المجتمعات هذا الذي يستطيع فيه راكب حمار أن يوقف حركة المرور!. إن أول مظاهر التحضر وجود القوانين. وإن أول مظهر من مظاهر وجود القانون في بلد هو حركة المرور. وإن من أول ما درسناه, في مساقات القانون, هو أنه لا يوجد قانون حيث لا تتوفر له سلطة القهر. إن توفر القدرة على القهر, لدى أي تشريع, هو الذي يعطيه صفة القانون. دع عنك سخافات أناس يجلسون في السلطة, ثم يدعون الناس لاحترام القانون, فهذه مهمة المخاتير وشيوخ العشائر. ولا أظن أحداً منا انتخب رئيس السلطة ليحل محل كبير المخاتير!.
إن جميل السلحوت يبرز تخوف السياح, من حمار الشيخ, بالسخرية السوداء من هذه العجائبية, التي تحكم مجتمعاً يفترض أنه الآن على أبواب الاستقلال, بعد حرب طويلة خاضها طوال مرحلة من الثورة والانتفاضة, سعياً وراء هذا الاستقلال. أفلا يكون السؤال الثقافي المضمر في هذا الخطاب هو: هل نحن مؤهلون فعلاً لإنشاء مجتمع مستقل؟. وإذا ما أنشأناه, فهل سيكون على هذه الشاكلة؟. وهل يستحق مجتمع ما الاستقلال السياسي, لمجرد رغبته في العودة إلى الوراء؟!.
إن جميل السلحوت يدرك أن النص منظومة علاماتية ألسنية, وليس مجرد كلمات منفصلة عن الواقع, لمجرد أنها مطبوعة على الورق. وبذا فهو يخرج للنصوصية اليمينية المتطرفة لسانه: ساخراً من كل شعوذات منظريها السخفاء القائلين باستقلال النص عن خارجه. فقد أدرك جميل السلحوت مبكراً أن تلك النصوصية هي, في نهاية المطاف, خدمة ثقافية مجانية للاستعمار الثقافي, الذي يريد من المثقفين أن ينشغلوا بعلاقات متوهمة, بين حروف النص المطبوع, وطرق تنسيقها على الورق, وجماليات الفواصل والعتبات, بعد أن قتلوا التاريخ والمؤلف والعلاقات الإنسانية( ).
لقد تحول النص بين أيدي غلاة اليمين المتطرف في أمريكا ـ وعلى أيدي مدفوعي الثمن هنا ـ إلى (الله): الذي هو علة العلل, والمستغني بذاته عن سواه. لقد حدث كل ذلك, بهدف تحويل الدرس الأدبي إلى غرفة مظلمة, مقفلة الأبواب, لا يرى طلابها ما يحل بذويهم في الخارج, على يد علاقات القوة, تاركين كل ذلك دبر آذانهم!. ولا جرم؛ فهم مشغولون الآن بقراءة (الأرض الخراب), أو سماع باخ وبيتهوفن!.
والكاتب مدرك لطبيعة هذه العلاقة المرضية, التي أتاحت لكتاب أن يظهروا للمتلقين في صورة المدافعين عن الحقيقة, ثم نراهم في موطن آخر (واقعيين), مدركين بأن الحقيقة في هذه الأيام صارت (نسبية), وتحتمل وجوهاً عدة. لقد صار بإمكان بعض هؤلاء الكتاب, الظهور بمظهر (النيتشويين) المتحررين, من أي تصور مسبق لوجود الحقيقة الجوهر. وبذا فقد أصبح باستطاعة العدو ـ وفق هذا المنطق ـ إعادة تشكيل الحقيقة, وفق رؤيته , متذرعاً بقوة القوة, القادرة على فرض (حقائق جديدة), بغض النظر عن موافقتها لمنطق العدالة أم لا!.. وكأن الحقيقة, المستمدة قوتها من ذاتها, لم تعد موجودة!..
الكاتب ليس مدركاً كل هذا فحسب, بل إن حماره ـ حتى ـ يدرك ذلك ويتصرف وفقه, في منطق حماري مترفع عن شعوذات (المثقفين), فيقول:
“حتى أحد كتابكم الكبار يقدم التنازلات السياسية المجانية, ليس لوجه الله, وإنما من أجل وجه مقرري منح جوائز نوبل للآداب”( ).
وعندما يعترض الراوي, ويزجر هذا الحمار الحكيم, يأبى الحمار أن ينزجر, مواصلاً التحدي بإظهار الحقيقة, قائلاً:
“ولكنه تبرع بمساواة المستوطنين مع الفلسطينيين, الذين بقوا في ديارهم, في حدود إسرائيل”( ).
فلنعد الآن قليلاً إلى متشائل حبيبي, لنراه في موقف مماثل يقول: “فزجرني فانزجرت”( ). لندرك أن تناصاً من نوع خاص ينشأ, هنا, بين متشائل إميل حبيبي ـ الذي ينزجر فور زجره ـ وحمار جميل السلحوت الأكثر فلسطينية: فالأول شيء فقد كينونته واحترامه لنفسه, أما الثاني فمتمسك بهذه الكينونة, ومدافع عن احترامه لنفسه, في علاقة تبرز جماليات الموقف الحماري, ثقافياً وسياسياً, في الوقت الذي تلقي الضوء فيه على قبحيات ذلك النوع من الكتابة, المتماهية مع العدو. وتتأكد مثل هذه العلاقة عند ملاحظة التناص المفاجئ بين منطق حمار الشيخ ومنطق صاحب المتشائل. ولنقرأ هذين النصين دون تعليق:
يقول حمار الشيخ في معرض الاستنكار:
“شعبكم الفلسطيني, الذي لا يعترفون به كشعب, وإنما كتجمعات سكانية لا حقوق لها على الأرض”( ).
أما صاحب المتشائل فيقول:
“نحن لا نعترف إطلاقاً, بما يسمى حق تقرير المصير لعرب إسرائيل… إننا نقول بأن حق تقرير المصير هو لشعوب, وليس لمجموعات”( ).
سنعود الآن إلى اعتراض الراوي على منطق حماره (الحمار), في كشفه لهذا القبح, , لنكتشف أن هذا الخوف هو خوف أيديولوجي, ناتج عن شعور الكاتب بالقوة المضمرة لـ(بلدوزرات الثقافة) الذين يسميهم إدوارد سعيد, طبقة الإنتلجنسيا. يقول:
“لكن طبقة رجال الفكر (الإنتلجنسيا) هي ذاتها عنصر مساعد… وقد رُسم دور لهذه الطبقة, وصُنع لها ؛ بوصفها طبقة مُحدثِنة [من اسم الفاعل]: أي أنها تمنح الشرعية, والسلطة المرجعية, لأفكار حول التحديث والتقدم والثقافة, تتلقاها من الولايات المتحدة, بصورة رئيسية. ويقوم الدليل على هذا في العلوم الاجتماعية, وبما يفاجئ إلى درجة كبيرة [يقوم الدليل كذلك] من الجذريين [ اليساريين الراديكاليين] الذين أخذوا ماركسيتهم, بالجملة, من نظرة ماركس التسلطية إلى العالم الثالث”( ).
ومعلوم لنا جميعاً, أن تلك الطبقة قد استطاعت ـ بسبب عوامل تاريخية متعددة, أكثرها ينقصه الشرف ـ أن تتعاقد, مع المؤسسة السياسية, على صياغة مؤسسة الأدب, بما يخدم هذا التحالف, في وجه كل أنواع الثقافة المهمشة والشعبية, السائدة في أوساط البسطاء, الذين لا يعرفون لهم وطناً سوى فلسطين, التي عرفوها, وآمنوا بأنها تستحق منهم أكثر من هذا.
لكن هذا الخوف الأيديولوجي, الموظف إبداعياً على يد جميل السلحوت, لا يستطيع أن يرفد الراوي بقوة المنطق, إذ سرعان ما يجد الراوي نفسه صغيراً, أمام منطق هذا الحمار الحكيم, المتعالي بحمرنته, عن إنسانية أشخاص ينسبون أنفسهم إلى طبقة الإنتلجنسيا, ثم لا يشعرون بالعار من ” أن تُقرن قضية الأسرى بقضية العملاء المتعاونين”( )؛ لا في الأدب وحده, بل في الاتفاقات السياسية كذلك.
يواصل الراوي هذه السخرية السوداء, من علاقات ثقافية, في المجتمع الفلسطيني, بدأت تبرز أخيراً, من مثل هذا النوع من (ثقافة البلاغة), التي تتوسل بطنين الكلمات الكبيرة, لتخفي وراءها فراغاً موحشاً, وجهلاً مختبئاً وراء قعقعات الحروف. وهذا النوع من الخطاب السياسي الديماغوجي, الذي يستخدمه أناس مدفوعو الأجر, في أغلب الأحيان, وجهلة مغرر بهم في قليل من الأحيان, هو الذي يبرر للدكتاتورية السياسية, عقد اتفاقيات تحتاج منها إلى كل هذا العدد من المروجين الديماغوجيين. فتعال لنرى كيف يحلو للراوي أن يتزيا بزي واحد من هؤلاء الديماغوجيين, فيقول:
“كنت مزهواً بنفسي كالطاووس, وأنا أشرح للحضور المكاسب التي حققناها منذ بدء العملية السلمية… وقد زادني حماساً جمهور المستمعين, الذي كان في غالبيته من كبار السن, الذين لا يسمعون جيداً. بينما كان الباقون تنقصهم الثقافة السياسية, ويطربون للشعارات الرنانة, التي اعتدت على استعمالها… أخذت أهاجم كل فلسطيني وعربي ينتقد العملية السلمية… فهم مناضلو شعارات, جلبوا الويلات على شعبنا, ولم يستوعبوا العملية السلمية”( ).
لقد كان من الممكن لنا أن نتصور, للحظة, أن موقف الراوي هنا هو نفس موقف المؤلف الضمني, لولا أننا رأينا المؤلف الضمني يبرز لنا فجأة, من خلال تبنيه لمنظومة القيم, التي يؤمن بها الحمار؛ في تبادلية ذات مدلول أيديولوجي, تفضل منطق الحمار المتمسك بالثوابت, على منطق الإنسان المضحي بالثوابت, على مذبح احتياجاته الصغيرة. وهكذا كان لا بد للراوي ـ استجابة لموقف المؤلف الضمني ـ أن يبين الموقع الأيديولوجي للحمار, الذي هو نفس موقع المؤلف الضمني, فيقول, استكمالاً للموقف السردي السابق, ما يلي:
“وعندما انصرفت, وجدت حماري أبا صابر متكدراً غاضباً من حديثي واتهمني بالتهريج وعدم الوضوح في الموقف السياسي”( ).
وأخيراً:
نحن, كمتلقين, قد شكلنا للمؤلف الضمني في (حمار الشيخ) صورته التي انطبعت في أذهاننا, واستنتجناها من نصه. لكن ما يبقى هو سؤال من نوع جديد: هل جميل السلحوت هو نفس هذه الصورة, التي رسمناها له بتأثير نصه؟. أرجو أن يكون الجواب نعم. وأعتقد أنه كذلك.