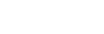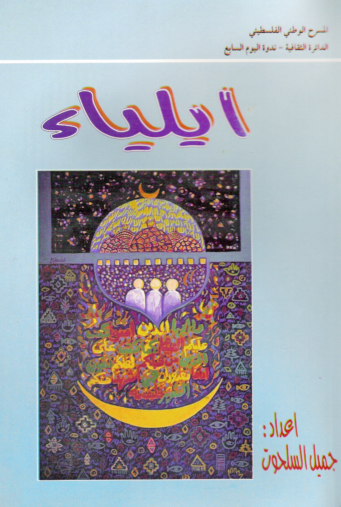القدس: 11-5-2023 ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية المقدسية رواية “طيور المساء” للكاتبة الفلسطينيّة أسمهان خلايلة، صدرت الرواية عام 2021 عن دار الهدى للطباعة والنّشر كريم 2001 م. ض. في كفر قرع وتقع الرّواية التي صمّم غلافها الفنّان مبدّا ياسين في 159 صفحة من الحجم المتوسّط.
افتتحت النقاش مديرة الندوة ديمة جمعة السمان فقالت:
مجزرة كفر قاسم التي سقط فيه 49 شهيدا بأيادي الغدر والإجرام الصهيوني غداة 29 تشرين 1956، تطلعنا على أحداثها الكاتبة خلايلة، على لسان شهود عيان، كتب الله لهم العمر ليرووا أدق التفاصيل والمشاهد الموجعة التي شاهدوها بأم أعينهم، وعاشوا رعب اللحظات التي تم فيها اغتيال أرواح بريئة مسالمة، كانوا يركضون خلف لقمة العيش.
جريمة تؤكد أن الاحتلال الصهيوني ما هو سوى دراكولا، يهتك الأعراض ويقتل الأرواح لينفذ مخططاته الاحتلالية دون أي وازع من ضمير.
وفقت الكاتبة باختيار أسلوب الرواية، فلم يكن تقليديا، وعلى الرغم من أن أحداثها كانت تتأرجح بين زمنين، أحدهما كان عام 1956 عام المجزرة، جاء بأسلوب الاسترجاع على لسان شخوص الرواية، الذين كانوا شهود عيان وعلى علاقة وثيقة مع ضحايا المجزرة، يروون الأحداث في السبعينات من القرن الماضي، وهم يعيشون قهر استغلال الاحتلال لهم، وتحويلهم إلى عبيد في أراضيهم التي صودرت ولا حول لهم ولا قوة، وتدخّلهم بشؤونهم الحياتية والاجتماعية والتعليمية، إذ كان الاحتلال يتصدى للمدرس الوطني، ويعزز التّابع لهم ولأنظمتهم التجهيلية إلخ من أمور حياتية أخرى، تعمل على إذلالهم وتزيد من مآسيهم.. وعلى الرغم من كل هذا التأرجح والانتقال من حدث إلى آخر.. ومن زمن إلى آخر إلا أن الرواية لم تفتقر إلى عنصر التشويق، بل استطاعت الكاتبة أن تربط خيوط الأحداث بطريقة ذكية حاكت من خلالها رواية محكمة متماسكة، قدمت من خلالها بعض التفاصيل التي غابت عن البعض، وأحيت الذاكرة عند البعض الآخر.
رواية وثقت لحظات يندى لها جبين الإنسانية، 49 شهيد سقطوا في مجزرة، تم اختيار تاريخها بعناية، قاصدون إخفاءها، إذ استغل الاحتلال توقيت العدوان الثلاثي على مصر، وانشغال العالم بهذا الحدث الكبير، ليمرروا جريمتهم تحت ذرائع مختلفة عنوانها أمن إسرائيل، بينما كان خطتهم تهجير أهل القرية، لكي يثبتوا روايتهم الصهيوتية، بأن فلسطين أرض بلا شعب.
وثقت الكاتبة التراث الفلسطيني من خلال الأمثال الشعبية والأغاني التراثيّة الأصيلة، في كل مناسبة، فأغنت العمل الروائي، وزادت من جماليته.
لفتني في الرواية اختيار الشخوص، ووصفهم الدقيق ليومياتهم وعلاقاتهم كأناس بسطاء يبحثون عن أرزاقهم، مما خدم أهداف الرواية، وأنسن قضية فلسطين العادلة.
أعجبني قلم الكاتبة الجميل، فقد كانت اللغة بسيطة غير معقدة، بدت طبيعية بعيدة كل البعد عن التكلف، وخدمت أهداف الرواية، إلا أنّني أعتقد أن استعمال اللهجة العامية لن يكون في صالح انتشارها في العالم العربي، إذ أنها لن تكون مفهومة لأشقائنا العرب.
كنت أتمنى لو أنّه تمّت مراجعة الرواية قبل نشرها؛ لتجنب الأخطاء المطبعية واللغوية، التي لم تكن في صالحها.
التركيز على التعايش الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن موفقا، بل بدا دخيلا لا يخضع للمنطق.. فهل ممكن أن يعيش الحمل والذئب تحت سقف واحد؟
أمّا الأجمل في الرواية كانت فكرة العرس الجماعي لتسعة وأربعين زوجا، وهو عدد شهداء المجزرة. كانت رسالة قوية مفادها أن الشعب الفلسطيني لا يهزم، لأنه يحب الحياة ويبحث عن الفرح في كل مكان وزمان، رغم كل مآسيه وأوجاعه.
أقترح ترجمة الرواية لكي يطلع العالم على تفاصيل واقعنا المرير، ويفضح الاحتلال ويعرّيه.
وقال جميل السلحوت:
أسمهان خلايلة كاتبة فلسطينيّة من مجد الكروم في الجليل الفلسطينيّ الأعلى، تكتب الخاطرة والقصّة والمقالة، وهذه هي رويتها الأولى -حسب علمي-.
مضمون الرّواية: تتحدّث الرّواية عن مجزرة كفر قاسم التي ارتكبها الجيش الإسرائيليّ في 29 اكتوبر 1956م غداة العدوان الثّلاث على مصر، والذي اشتركت فيه بريطانيا وفرنسا واسرائيل. وأزهقت في هذه المجزرة أرواح تسعة وأربعين شخصا بين رجل وامرأة وطفل. ومنهم نساء حوامل، وكان الهدف منها هو إجبار من تبقّى من الفلسطينيّين في ديارهم على الهرب من ديارهم إلى المناطق العربيّة المجاورة كالضّفّة الغربيّة.
الأسلوب: مهّدت الكاتبة لروايتها ببعض الحوادث والحكايات التي تحدث في كلّ قرية، مستعينة بعدد من الأمثال والأغاني الشّعبيّة، التي جاءت في مكانها الصّحيح، وكأنّي بالكاتبة هنا تريد أن تدلّل على الثّقافة الشّعبيّة، التي من خلالها يستطيع الباحث أو القارئ الحاذق أن يقف على طريقة تفكير أيّ شعب إذا ما اطّلع على ثقافته الشّعبيّة، وقد طغى الأسلوب الحكائيّ الإنسيابيّ على السّرد.
التّمهيد للحدث الرّئيس وهو المذبحة: مهّدت الكاتبة لروايتها بثمانية فصول، امتدّت على ثمان وتسعين صفحة قبل دخولها إلى مذبحة كفر قاسم، وهذا التّمهيد لم يكن نشازا، ولا غريبا عن الحدث الرّئيس، فهو يحوي حكايات عديدة ومريرة عن معاناة الفلسطينيّين الذين صاروا أقلّيّة في وطنهم داخل حدود إسرائيل التي قامت كدولة في 15 مايو 1948 على 78% من أراضي فلسطين التّاريخيّة، بعد أن تشرّد منهم 950 ألفا في أصقاع الأرض بسبب ويلات الحرب.
اللهجة المحكيّة: أغرقت الكاتبة في استعمال اللهجة المحكيّة، لأنّ شخوص روايتها ومنهم معلّم المدرسة مروان وابنه فارس الذي درس الهندسة الغذائيّة، هم أناس شعبيّون مندمجون في قضايا شعبهم وهمومه، فمروان كان عضوا في الحزب الشّيوعي الإسرائيليّ، رغم ما يعني هذا من معاناة أثناء خضوع من تبقّى من أبناء شعبنا الفلسطينيّين في ديارهم في النّكبة الأولى عام 1948م للحكم العسكريّ، الذي استمرّ من العام 1948 حتى 1965، والذي لم يكن يسمح للفلسطيني أن ينتقل من بلدته إلى أخرى دون تصريح من الحاكم العسكريّ. ومعروف أنّ من كشف المجزرة وفضحها هما عضوا الكنيست عن الحزب الشّيوعي الرّاحلين ماير فلنر وتوفيق طوبي، وهما من قادة الحزب الشّيوعيّ الذي لعب دورا رئيسيّا ومهمّا في الحفاظ على الهويّة العربيّة الفلسطينيّة، وعلى اللغة العربيّة من خلال صحافته” جريدة الإتحاد، ومجلّتا الجديد والغد”. واستعمال اللهجة المحكيّة يدخلنا في متاهات حول استعمالها في الكتابة أو عدمه، لسنا في مجال ذكرها في هذه المقالة، ومعروف أنّ “اللهجة استعمال خاطئ للغّة.” لكن يجدر التّذكير هنا أنّ اللهجات المحكيّة ليست مفهومة عند الشّعوب العربيّة كافّة، بعكس اللغة الفصيحة التي يفهمها العرب جميعهم.
الرّواية التّاريخيّة: عرف العرب الرّواية التّاريخيّة، ومن أشهر من كتبوا الرّواية التّاريخيّة الرّوائيّ والمؤرّخ والصّحفيّ اللبنانيّ جوجي زيدان”1861-1914″. ومن قبل الرّواية التّاريخيّة عرف العرب السّيرة الشّعبيّة، والتي كتبت باللهجات المحكيّة مثل سيرة “عنترة” و” الزّير سالم” و”أبو زيد الهلالي، وغيرها. وإذا كان جرجي زيدان كتب رواياته باللغة الفصحى معتمدا على البحث في كتب التّاريخ، فإنّ الرّوائيّين بشكل عامّ يستفيدون من التّاريخ ولا يؤرّخون، لكنّ كاتبتنا أسمهان خلايلة في روايتها هذه اعتمدت على مصادر الحدث الشّفويّة، فكتبتها كما سمعتها من أفواه من رووها، وهذا يقودنا إلى قضيّة أخرى هي: هل يُدوّن الأدب الشّعبيّ، كما يُسمع من رواته أم يجري تفصيحه؟
عنصر التّشويق: طغى عنصر التّشويق بشكل واضح من خلال السّرد الحكائي الإنسيابيّ، رغم مرارة المضمون.
عنوان الرّواية: تحمل الرّواية عنوان” طيور المساء”، والقارئ للرّواية سيجد أنّ المجزرة وقعت في المساء، أثناء عودة المزارعين من حقولهم، والعنوان في طيّاته يحمل مضمونا دينيّا فقد روى مسلمٌ في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسروق قال:” سألنا عبدالله عن هذه الآية ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ أما إنَّا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طيرٍ خضْرٍ لها قناديل معلَّقة بالعرش تسرح من الجنَّة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل”.
وماذا بعد: تعتبر هذه الرّواية بشكل وآخر رواية تسجيليّة توثيقيّة عن معاناة الشّعب الفلسطينيّ، بسبب الهجمة الصّهيونيّة على وطنه، كما تعتبر رواية توثيقيّة، عن مذبحة كفر قاسم، سردت أحداثها من أفواه من عاشوها وذاقوا ويلاتها، وهي تذكّر بمجازر أخرى مثل: دير ياسين، الدّوايمة، الطّنطورة وغيرها. وهذه المجزرة خُطّط لها بعناية على المستوى الرّسميّ؛ لتشريد من تبقّى من الشّعب الفلسطينيّ في ديارة، ظنّا من المخطّطين أنّ هذه المجزرة ستمرّ بهدوء، لأنّ حرب العدوان الثّلاثي على مصر التي صاحب المجزرة طغت على وسائل الإعلام، وعلى اهتمامات الرّأي العامّ العالميّ، وأكبر دليل على ذلك أنّ المحكمة الإسرائيليّة التي عقدت لمحاكمة القتلة أدانت قائد الوحدة العسكريّة القاتلة “شدمي” وحكمت عليه بقرش إسرائيليّ واحد، أيّ أقلّ من سنت أمريكي واحد.
العرس الجماعي: ورد في الرّواية أنّ أهالي كفر قاسم أقاموا عرسا جماعيّا، زفّوا فيه 25 شابّة على 25 شابّا في الذكرى الثّلاثين للمجزرة، ووقف العرسان والمحتفلون أمام ضريح ضحايا المجزرة، وهم بهذا يرسلون رسالة للقتلة مفادها:
“ كأنّنا عشرون مستحيل
في اللد، والرّملة، والجليل
هنا .. على صدوركم، باقون كالجدار
وفي حلوقكم
كقطعة الزّجاج، كالصّبّار
وفي عيونكم
زوبعة من نار
هنا .. على صدوركم باقون كالجدار”
الجمل التّفسيريّة: ورد في النّصّ الكثير من الجمل والفقرات التّفسيريّة التي لا حاجة لها، كما أنّه لا داع للخطابات التّفسيريّة التي وردت في أخر النّصّ، ولو انتهت الرّواية قبل السّطرين الأخيرين في صفحة 152 لكن أفضل لها.
وكتبت د. روز اليوسف شعبان:
تدوّن الرواية مجزرة كفر قاسم التي نفّذها بعض الجنود الإسرائيليين بحقّ تسعة وأربعين عاملًا وذلك في 1956/10/29، حين كانوا عائدين في ساعات المساء من عملهم، وكانت السلطات قد فرضت حظر تجوّل، لكنّ العمال لم يعلموا بذلك، فتعرّض لهم الجنود وأطلقوا النيران عليهم، وقد نجا من العمّال امرأة ورجل، قاما بسرد هذه المذبحة على سكان القرية.
فارس هو شابّ من قرية كفر قاسم، قرّر أن يكتب رواية توثّق المجزرة ويوزّع الرواية على الأهالي في العرس الجماعي الذي قرّرت القرية ان تقيمه في نفس تاريخ المجزرة، بحيث يزفّ في العرس الجماعي 49 عريسا وعروسا بعدد شهداء المجزرة، وذلك تخليدًا لذكراهم ولبث رسالة أنّ الحياة أقوى من الموت،:” بعد اليوم لن نحيي ذكرى المجزرة بالبكاء والرثاء، ولن نتذكّر شهداءنا بالدموع فقط. بل سنمضي قدما في طريق الحياة”. ص 147.
ذهب فارس إلى بيت هنا المرأة الناجية الوحيدة من بين أربع عشرة عاملة، كنّ في طريق عودتهنّ الى القرية بعد يوم شاق في مستوطنة بجانب قريتهم. في بيت هنا سجل فارس في آلة التسجيل كل ما حكته هنا عن المجزرة :” بعد العصر بقليل في حوالي الثالثة والنصف اقتحم العساكر القرية يتقدمهم بعض الضباط، توجهوا الى بيت المختار، طلب الضابط من المختار أن يعلم الناس بأمر حظر التجوّل وأن كل من يتأخر عن الساعة الخامسة مساء لن يتحمل الجيش مسؤولية تعرضه لأي مكروه وسيطلق الجنود النار عليه دون تردّد. طلب المختار من الأهالي تبليغ العمال بالعودة فورا الى القرية. ص 103-104.
توزع الجنود في القرية ثم سمع صوت اطلاق نار وحين خرج الشباب لرؤية ما حدث اتّضح لهم ان الجنود أطلقوا النار على أرملة كانت تخبز في الطابون بعد أن اغتصبوها بوحشيّة. ص 108-109.
تتابع هنا روايتها فتقول:” يومها كنا مروحات من الشغل طلب الجنود من السائق محمود أن يقف وطلبوا منا النزول من السيّارة وما أن أتّمت البنات نزولهن من السيّارة حتى صرخ أحدهم: انتباه كان صوته يشبه نهيق الحمار. اطلقوا النار! ولعلع الرصاص اهتزت الأرض كأنّها تنوح تحت أقدامهن وخيوط دمائهن القانية تنساب لتروي عطشها، واستمرّ زخ الرصاص ينهمر على الفتيات وقد شكّلن دائرة هي حلقة رقصهنّ الأخيرة “.ص 118 -119
وقد وصلت أحداث المجزرة الى مسامع عضوي الكنيست (ماير فلنر )وتوفيق طوبي من الحزب الشيوعي، فحضرا إلى كفر قاسم واجتمعا ببعض الأهالي، كتبا تقريرا مفصلا عن المجزرة وعمما التقرير على وسائل الاعلام. ص 149..
ورد في الرواية أيضا وصفا مفصلا لظروف الحياة الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها أهالي كفر قاسم، إضافة إلى ظروف تعليميّة صعبة ومجحفة، غرف مستأجرة صغيرة وأثاث قديم، أمّا المعلّم مروان(والد فارس) فقد تمّ تعيينه في مكان بعيد عن كفر قاسم بسبب انتمائه للحزب الشيوعي وكانت السلطات تلاحقه وقد اعتقلته ذات مرّة وعذّبته.
تتطرّق الكاتبة أسمهان أيضا الى دور المرأة الفلسطينيّة في حفظ الذاكرة الفلسطينيّة فتقول على لسان الراوي:” كانت هنا( الناجية الوحيدة من النساء في المجزرة) كثيرا ما تبكيهم، وهذا ما شجع فارس أن يتوجه اليها ولم يتوجّه إلى أحد الرجال الناجين من المجزرة، فهو يؤمن أن المرأة قادرة والذاكرة النسويّة غنيّة ولم تأخذ حقها في رواية قصص الأبطال والثوّار وغيرهم. فالرواة معظمهم كانوا من الرجال، وفارس كغيره من المثقفين وغير المثقفين يؤمن بصلابة المرأة الفلسطينيّة وقدرتها على الصمود والتعاون مع زوجها في الأعمال الشاقّة المضنية التي تقوم بها متنقلة بين الأرض وأعمال الزراعة المختلفة، وشغل البيت إضافة الى تربية الأولاد، “طاقة جبارة ومتفجرة هي المرأة”، هكذا كان فارس يؤمن”. ص 14.
يبدو في الرواية أيضا الفكر اليساري الذي يؤمن بإمكانية العيش المشترك والتعاون بين اليهود والعرب،:” التحق مروان بنقابة المعلمين وتمكن من التواصل مع بعض الزملاء اليهود في النقابة من الذين يؤمنون بحق العرب في المساواة والحياة الكريمة وهو بدوره تعاون معهم لاعتباره أن العمل المشترك أكثر نجاعة واقناعا”. ص 68.
لم تغفل الكاتبة ذكر سياسة جمال عبد الناصر وتأميمه لقناة السويس كما نرى في الحوار التالي بين مروان وابو العبد:” سمعت يا مروان انه عبد الناصر رح يشتري السلاح من الاتحاد السوفييتي. هذا زعيم بحق وحقيق شجاع وجريء الله يقّدره ويقف بوجه الاستعمار من ثلث شهور أمّم القناة ومن يومها وهني بترصدوله مش رح يسكتوا أكيد رح يدبروله اشي.
- افتح الراديو يا أبو العبد خلينا نسمع الأخبار. انبعثت الأصوات تهتف بحياة ناصر..”. ص 75-76.
المكان في الرواية:
يعتبر المكان واحدًا من أهمّ المكوّنات السرديّة؛ فإنّ أيّ نصّ سرديّ يحتمل الوقوع ضمن وسط مادّيّ يشكّل خلفيّة للأحداث، ويُسهم، إلى جانب بقيّة مكوّنات النصّ السرديّ، في إيصال الرسالة النصّيّة.
يدخل المكان في علاقات متعدّدة مع مكوّنات العمل الروائيّ السرديّة، من شخصيّات وزمن ورؤية وغيرها، تجعل كلًّا منها مؤثّرًا في الآخر. ففي حين يُسهم المكان في صياغة الشخصيّات وبيان اهتماماتها ومستواها الاجتماعيّ والفكريّ، تعبّر الشخصيّة في مستويَيْها الاقتصاديّ والاجتماعيّ عن مكان سكناها، من غير الحاجة إلى الإسهاب في وصْف مكانها وتعليله.( الطويسي، 2004، ص. 167. )
ويبرز البعد النفسانيّ للمكان داخل النصّ، فالمكان ليس أبعادًا هندسيّة وحسب، إنّما هو المكان المصوّر من خلال خلجات النفس، وتجلّياتها، وما يحيط بها من أحداث ووقائع.( النابلسي، 1994، ص. 16. ) إلى جانب الأبعاد الاجتماعيّة والتاريخيّة التي تكون وثيقة الصلة بالمكان، من دون أن تنفصل عنه. حتّى أنّ المكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، فهو يعكس حقيقة الشخصيّة، ومن جانب آخر فإنّ الحياة الشخصيّة تفسّرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها”.( قاسم، 1984، ص. 84. ).
وقد ظهرت في الرواية الأبعاد الاجتماعيّة والتاريخيّة للمكان وذلك من خلال الحوارات بين الشخصيّات ومن خلال الأغاني والأمثال الشعبيّة وكل ما يتعلّق بالتراث الفلسطينيّ وطبيعة الحياة في القرية. فنجد مثلا وصفا دقيقا للحياة الاجتماعيّة وللبيئة الزراعيّة في القرية كما في الاقتباس التالي الذي جاء على لسان هنا:” أيام الصيف نزرع خضرة وبأوّل الشتا قمح وشعير وسمسم وحمّص، وبآخر الصيف ننزل عكروم الزتون، نقضّي شهر في القطف وجمع الموسم، لا كان سيارات ولا ماكينات تجمع حبّ الزتون، وأخوي وحيد، مسكين لولا مساعدة اولاد عمّي وبنات خالتي ما كان ممكن نخلّص بشهرين…. كبرت وصار عندي صاحبات من هالقرايب وبنات الجيران، واشتغلنا سوا في السهول، نقطف البندورة ونجمع البطاطا، هالأرض أرضنا صرنا نشتغل فيها بالأجرة مثل عبيد السخرة”. ص 24.
:” كنا نجمع مؤونة البيت ونعبّيها بالجرار ونخزّنها. قمح وطحين وبرغل وفريكة وزبيب وقطين، البيتنجان والبندورة كنا نشّفهن كمان وندفنهن تحت التبن والقش والبامية والثومات إنشكهن قلايد ونعلقهن. ص 24-25.
وفي وصف الرواية للمكان في قرية كفر قاسم، نستدل على طبيعة القرية، وعمل سكانها والعلاقات الاجتماعيّة بينهم كما نرى في الاقتباس التالي:” كانت كفر قاسم موسومة بطابع الحقبة الزمنية التي تعيشها، خلو المساحات حول القرية، وتمركز السكان في بقعة واحدة، في بيوت متقاربة يتوسّطها مسجد صغير. على أطراف القرية خاصة من جهة الغرب يمتدّ سهل من الأراضي الزراعيّة الخصبة، يملكها معظم أهالي القرية والقرى المجاورة، يفلحونها ويعتاشون من خيراتها. وصباح كل يوم صيف شتاء ، كانوا مع بعض دوابهم، يتتبّعون خطوات الفجر إلى حقولهم.”.ص 52.
وفي وصف الساردة لقرية برطعة التي عّين أبو فارس ليعلّم فيها، نقف على ظروف التعليم الصعبة وسياسة الدولة في تقسيم برطعة الى قسم اسرائيلي وآخر أردني :” بدأ أبو فارس عمله كمعلّم مبتدئ عام 1954 في قرية برطعة وسط فوضى عارمة وضياع يحتاج إلى الكثير من التضحية والصبر. الكتب المدرسيّة شحيحة وكتب المطالعة نادرة الوجود ووسائل الايضاح المطلوبة لدعم الطلاب والمعلّم غير متوفرة. يمشي التلاميذ مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة، ملابسهم رثّة كثيرة الرّقع. معظم أهاليهم فقراء يعملون في البناء يبنون بيوتا للقادمين الجدد، بينما هم يعيشون في ظروف أقرب إلى القرن الماضي”. ص 59-60.
لقد اصطبغ مكان المجزرة بدماء الشهداء وجاء المكان هنا ليجمع الألم والحزن والقهر والنواح وليعكس مأساة قرية بأكملها :” لكن كومة الجثث ببشاعة منظرها أصبحت ماثلة أمامهم في ساحة القرية. الشهداء غرقى بدمائهم ، ونصبت النسوة حلقات النواح والندب والتصفيق للعرسان الذين ترجّلوا عن خيولهم قبل انتهاء مراسيم الزواج:” سبّل عيونه ومد ايده يحنونو” “خصره رفيّع وبالمنديل يضمونه”. ص 140.
اللغة في الرواية:
هي القالب الذي يصّب فيه الروائيّ أفكاره، ويجسّد رؤيته في صورة مادّيّة محسوسة، وينقل من خلاله رؤيته إلى الناس والأشياء من حوله( تاورتة، 2004، ص. 52. ). فباللغة تنطلق الشخصيّات، وتتكشّف الأحداث، وتتّضح البيئة، ويتعرّف القارئ إلى طبيعة التجربة التي يعبّر عنها الكاتب( عسيلي، 2012، ص. 287. ). هكذا فإنّه بواسطة اللغة يتعرّف المتلقّي، مثلًا، إلى أعماق الشخصيّة الروائيّة التي تحمل الأفكار والرؤى التي يهدف الكاتب إلى طرحها، ويتعرّف القارئ، قبل ذلك، إلى الصورة الخارجيّة لهذه الشخصيّة، وإلى مكانتها الاجتماعيّة ومواقفها من الأحداث والناس، وبالتالي إلى مدى إيجابيّة الشخصيّة أو سلبيّتها. كما يتعرّف القارئ، بواسطة اللغة أيضًا، إلى البيئة، وإلى الجوّ العامّ الذي يطرح من خلاله الموضوع في الرواية، أو في أيّ عمل أدبيّ يكتبه كاتب أو قارئ أو متلقٍّ.( تاورتة، 2004، ص. 52. ).
تنوعت مستويات اللغة في رواية طيور المساء، فقد جاءت باللغة الفصحى خلال السرد وباللغة المحكية خلال الحوارات بين الشخصيّات. كما عكست اللغة الجوانب الثقافيّة والاجتماعيّة والتراثيّة لسكّان القرية. فنجد الكثير من الأمثال الشعبيّة والاغاني منها أغاني الاعراس، الطهور وغيرها من الامثال الشعبيّة:” الدار دار أبونا وأجو الغرب طحونا” ص 74.:” شو اللي رماك على المرّ اللي أمرّ منه”. ص 94. . من أغاني الطهور:” يا مطهّر الصبيان يا قاعد ع السنسول لا توجّع فارس محبّة بالرسول “. ص 83. ومن الأغاني الشعبية:” جفرا ويا هالربع بين البصل الاخضر مكتوب ع جبينها كعكبان وسكر
هي يا راعي الجفرا والجفرا راعيها ومطرح ما كان الوعد وحياتك لاقيها”. ص 96.
بالرغم من الواقعية التي أضفتها اللغة المحكيّة في الرواية إلا أنها جاءت أكثر مما ينبغي مما قد يشكل ذلك خطرا على لغتنا الفصحى.
إجمال:
طيور المساء رواية الألم الفلسطيني، لمجزة نفّذت في مجموعة من العمال والعاملات، بدون ذنب اقترفوه، وبدون وازع من ضمير وإنسانيّة بمن نفّذ هذا العمل الاجرامي.
هي رواية تنزف ألما وتقطر حسرة على أرواح بريئة أُزهقت، وأرض اغتصبت، وحق طوي في صفحات التاريخ، لكنّ الذاكرة تأبى النسيان، فتستعيد المأساة وتتذكر المجزرة بتفاصيلها الدقيقة، لتبقى هذه الذكرى الأليمة خالدة في نفوس سكان كفر قاسم وكافة شرائح الشعب الفلسطيني، ولتبقى الطيور تحلّق في الآفاق باحثة عن أمل ونور يبدّد وحشة المساء.
المراجع:
تاورتة، 2004 تاورتة، محمّد العيد (2004)، “تقنيّات اللغة في مجال الرواية الأدبيّة”، مجلّة العلوم الإنسانيّة، الجزائر: جامعة منتوري، ع. 21، حزيران.
الطويسي، 2004 الطويسي، محمود (2004)، “الفضاء الروائيّ عند غالب هلسا رواية (سلطانة)”، وعي الكتابة والحياة: قراءات في أعمال غالب هلسا، مجموعة كتّاب، عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، ص. 166-195.
عسيلي، 2012 عسيلي، ثريا (2012)، أدب عبد الرحمن الشرقاوي، القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب.
قاسم، 1984 قاسم، سيزا (1984)، بناء الرواية: دراسة مقارنة لثلاثيّة نجيب محفوظ، القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب.
وكتب عبدالمجيد جابر:
أ.نوع الرواية
من أنواع الروايات بشكل عام:
روايات تاريخية. ب. روايات سياسية. ج. روايات وطنية. د. روايات اجتماعية.. وغيرها.
لكن الرواية التي بين أيدينا جمعت ما بين التاريخ والسياسة والوطن والاجتماع.
ب. قيمتها: تعتبر هذه الرواية سجلا تاريخيا توثيقا لأحداث جرت خلال النكبة وما بعدها، وخاصة مذبحة كفر قاسم، وتلقي الضوء على مأساة وطن ذبيح، صودرت أرضه، وشتت أهله، وتعرض لهول مجازر لا شبيه لها في التاريخ غير ما تعرض له الهنود الحمر… لكن الهنود الحمر أبيدوا أو ذاب من بقي من شتاته، بينما الفلسطيني صامد كالطود الشامخ… لقد فشل المحتل كما تصوره الرواية في مذبحته، حيث تعلَّم الناس في كفر قاسم معنى التشبث بالأرض، فلم يفارق الوطن، وكرَّم ويكرم من استشهدوا بإقامة نصب تذكارية وإقامة احتفالات وأعراس تخليدا لذكراهم كما صوّرتها عدسة الرواية.
ج.افتتاحية الرواية:
ففي روايتنا هذه نرى أن الشخصيات الرئيسة كالحاجة هنا وصويحباتها في العمل، وفارس وعائلته، وحورية وعائلتها، وليسوا هؤلاء فقط بل شعب بأكمله تحالفت كل قوى الشر في الأرض عليه، وأغلب الشخوص كلهم قد خرجوا وهاجروا من وطن مسلوب، والقليل منهم من عاد لمرابعه، وتشبث بتراب وطنه، ولاقى ويلاقي الظلم والعسف والتهميش والذبح والتعذيب، والوحدة الوظيفيّة في المقدمة دليل على جودة افتتاحيّة الرواية وتماسكها. فالوحدة الوظيفيّة، مهما يكن شكلها، قادرة على تحديد مسار الرواية، د.وطبيعة السرد فيها، فضلاً عن إثارتها شغف القارئ، وحفزه إلى القراءة، والتمهيد لبناء الشخصيات واختراق الأمكنة الروائيّة.
د. توظيف الكاتبة للتراث
وظّفت القاصة في نصِّها الأمثال الشعبية والألعاب والغناء التراثي بشكل لافت، فهو نبض الأمة.
هـ. امتهان كرامة العربي واستغلال العمال
تسلِّط القاصة الضوء على استغلال المحتل للعامل العربي بعدما نهب أرضه واستباح دمه .
و. هذه الرواية تصنَّف من ضمن الروايات الملتزمة.
فكاتبتنا شاركت الناس همومهم الاجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حدّ إنكار الذات في سبيل ما التزم به الشاعر أو الأديب، ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه الأديب فيها. وهذا الموقف الملتزم في الرواية جاء صريحاً واضحاً مخلصاً صادقاً واستعدادا من الكاتبة لأن تحافظ على التزامهاً وتتحمّل كامل التبعة التي يترتّب على هذا الالتزام، فالروائية أسمهان الخلايلة ملتزمة في روايتها هذه.
ز. توظيف خاصية المفارقة
وهنا المفارقة بين غريب همجي ماكر خبيث احتل وشرّد وذبح وتملَّك ما لا يستحق ملكيته، ويشعر بسيادته وينمّر، وبين وطن أهله كرماء طيبون إنسانيون شُرِّدوا وذبحوا، والقليل منهم من تشبث بوطنه ويُعامل كالعبد.
والمفارقات كثيرة، منها: بين ليلة فيها الطرب وفرحة الناس في كفر قاسم وتسلية أبي نجم لهم في الليلة التي سبقت مجزرة كفر قاسم، وبين الليلة التالية فيها الأسى والحزن والتقتيل، وكذلك المفارقة بين حال الناس قبل النكبة وهم يملكون أرضهم أحراراً، وما بعد النكبة، حيث استولى اليهود على أراضيهم وأصبحوا كالعبيد فيها، أو مطرودين منها ومن وطنهم.
فإنّ “أهميّة المفارقة في الأدب مسألة لا تحتمل الجدل، إنّ الأدب الجيّد يجب أن يتّصف بالمفارقة. وما على المرء إلا أن يسرد أسماء مشاهير الكتّاب الذين تتميّز أعمالهم بوجود المفارقة فيها، مثل: هوميروس، وآيسخيلوس، ويوريبيديس..إلخ” والمفارقة هنا تجسِّم هول المأساة والظلم الذي حاق بالفلسطينيين.
ما سبق يعتبر من مزايا الرواية.
أما هفواتها فسأذكر قسما منها، والغرض ليس التجريح وإنما لتتدارك الراوية تلك الأخطاء في طباعتها في المرة القادمة، ومن هذه:
ا.لعبة الرقلة
ا.لم تحسن القاصة وصفها الصحيح والدقيق، وهي عندنا تسمى بلعبة القال ص 37.
ب.الأخطاء
في الرواية أخطاء نحويّة ولغويّة، وعدم استعمال صحيح لعلامات التّرقيم.
وكتبت هدى عثمان أبو غوش:
“طيور المساء”عنوان لافت للقارىء،فالطيور عادة لا تحلّق في المساء بسبب عدم رؤيتها بالّليل، إلا أنّ طيور الأديبة أسمهان تحلّق في المساء الحزين بلا رحمة،”طيور المساء”هو عنوان مجازي يقصد به الشّهداء ال49 من قرية كفر قاسم الفلسطينية، من رجال ونساء وأطفال، الذين ذبحوا برصاص حرس الحدود المحتل في 29 اكتوبر 1956أثناء العدوان الثلاثي على مصر،وذلك من خلال فرض حظر تجوال في المساء.
الحاجة هنا في”طيور المساء”هي الشاهدة والناجية تروي لحفيدها فارس تفاصيل المذبحة من خلال شريط تسجيلي؛ ليقوم فيما بعد بكتابة رواية عن المذبحة، وتعتبر الرّواية تسجيلية واقعية،حملت بين أوراقها أسماء المجرمين والشهداء،هي رواية توثق حقيقة المجزرة لمنع محاولة تزويرها من قبل المحتلّ.
نجحت الأديبة أسمهان في تصوير الوجع والقهر والجراح التي أصابت كفر قاسم، فرسمت بقلمها الثائر صورالإعدام للعاملين والعاملات، الذين رجعوا إلى بلدتهم في المساء من خلال الوصف التصويري الدقيق المفعم بالأحاسيس والصور البشعة، صورت الصدمة عند الناس وصور النواح والأسى وصور العاطفة الحزينة، وصورالانتظاروالقلق والخوف والتوتر حول سرّ حظر التجوال وأثنائه” ولا شيء يضغط غير الوقت وصعوبة التّوقع والانتظار”صفحة117.استعانت بأحاديث الجرحى الناجين حول مشاهداتهم للمجزرة، نقلت لنا الكلمات التي رددها حرس الحدود حين أجمعوا على التخطيط للمذبحة التي تصور عدم الرحمة وعدم التردد في القتل”الله يرحمه” “احصدوهم”، “هذه الحبلى إياكم أن تتركوها، لا أُريدها أن تتنفس.اقتلوهن جميعا، أبيدوهنّ” صفحة 119. استعانت بالأغاني التراثية التي عبرت عن الجراح، وبالأمثال الشعبية التي ساهمت في تصوير الحالة الاجتماعية والنفسية والسياسية.
في هذه الرّواية تصور الأديبة خلايلة ظروف الحياة السياسية في كفر قاسم التي وقعت تحت الحكم العسكري حينها، وتبرز أثر الحكم العسكري على الحياة الاقتصادية والمناهج في المدارس، ومحاولة طمس ومحو الهوية الفلسطينية.
في”طيور المساء”طغت اللهجة العامية الفلسطينية في الرّواية على حساب الفصحى خاصة في الفصول الأولى للرّواية، وذلك من خلال الإسهاب في الحوار بين الشخصيات، ممّا يخلق عدم فهم لبعض المفردات عند بعض القرّاء، ولذا حبذا لو فسرت بعض المفردات من خلال فهرس خاص. يقول الكاتب الفلسطيني صبحي فحماوي: أن اللهجة المحكية هي أكثر صدقا وواقعيا من اللغة العربية الفصحى، وهي عاجزة عن الانتشار لأنها مرتبطة بالمكان ولا تغادره ولا نستطيع تصديرها إلى خارج منطقتها، ويرى الكاتب إلياس فركوح “بالنسبة للعامية نجاحها في بسط رؤية الكاتب في كيفية إنطاق شخصياته بحسب تكوينها وحدود معارفها”،.والجدير بالذكر أن اللهجة العامية في الرواية ساهمت كثيرا في تقريب نقل الأحاسيس والصور والحركات المختلفة للشخصيات، ونقل صدق الحوار وحرارته ممّا جعلتنا نتفاعل مع الشخصيات والحدث.وليس مجرد صدفة أن نجد الحيرة عند فارس في كيفية كتابة شكل الرّواية بالعامية أو الفصحى، وهذا يعيدنا إلى الحوار الذي جرى بين الحاجة هنا وحفيدها فارس،في حيرة فارس هل يكتب الرّواية بالعامية أو بالفصحى” كتبت كل ما قلتيه،الآلة تسجّل وأنا أكتب ما تسردين، لكن أحاول بالفصحى، لأنني ما زلت في حيرة يا حجّة،هل أكتب القصّة بالفصحى أم بالعامية”، تلك الحيرة تؤكد على أن الأديبة ساورها القلق أثناء الكتابة في حرصها على نقل تفاصيل المذبحة بأفضل صورة واضحة. إن اختيار الأديبة خلايلة لجعل ذكرى مجزرة كفر قاسم هو يوم فرح يتم فيه الاحتفال بتزويج ٤٩ من العرسان من البلدة ومن بلدات مجاورة ما هو إلا محاولة لانتصار التمسك بالحياة أو كما يقول درويش”ونحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا.”
لكنني أجد أنه من الناحية النفسية والعاطفية الاكتفاء بذكرى المجزرة كما هي، وعدم خلط المراسيم التي اقترحتها الأديبة، فكما للحزن ذاكرة فإن للفرح ذاكرة خاصة أيضا.
جاءت النهاية كحشد زائد،حيث أدخلت القارىء وهو في لحظات الحزن ومشاعر الغضب إلىالخطابات السياسية،وإلى التعايش العربي اليهودي، العرس في ذكرى المجزرة،رأيت النهاية في صورة الأمل عند مروان وهو يحمل صورة ابنه فارس ويردد أنا متفائل،لكن الأديبة اختارت أن تمنحنا كل التفاصيل قبل ولحظة المذبحة وما بعد ثلاثين عاما.
وقالت رفيقة عثمان:
طغى على ألوان الغلاف اللّون البنّي، الّذي يرمز إلى لون التّراب والأرض، واللّون البرتقالي يملأ الفضاء، بلون الغسق؛ ظهرت رسمة لضريح وعليه شاهدان، تنبت عليه شجرة متفرّعة الأغصان، كذلك تنبت نباتات حول الضّريح؛ وأمام الضّريح تقف امرأة مسنّة بزيِّ فلسطيني، ذات الثّوب المُطرّز بالتّطريز الفلّاحي، وغطاء الرّأس الأبيض، تحمل عصًا في يدها اليُسرى، ومفتاحًا كبيرًا معلّقًا بيدها اليُمنى.
دارت أحداث الرّواية حول “مذبحة كفر قاسم” في التاسع والعشرين من تشرين الثّاني لعام 1956، وذلك تزامنًا مع العدوان الثّلاثي على مصر؛ حيث تمّ إعدام تسعة وأربعين شخصًا (رجالًا ونساءًا) من أبناء القرية بدمِ بارد، عند عودتهم من العمل في المساء، وارتقوا إلى السّماء.
اختارت الكاتبة، عنوان “طيور المساء” عنوانًا مجازيًّا، فالطّيور ترمز للشّهداء الّذين ارتقوا بالمساء وزُهقت أرواحهم، وصعدت إلى السّماء.
ساهمت لغة الكاتبة الجميلة والسّهلة، في السّرد الجميل وإضافة عنصر التّشويق لهذه الرّواية؛ على الرّغم من المبالغة في استخدام اللّهجة العاميّة، والّتي حضرت؛ للتّعبير عن المواقف المختلفة للمُتحدّثين، مثل الجنود اليهود عندما استخدموا كلمات عربيّة مكسّرة مثل: روخ بيت وإلى آخره، بالإضافة للّهجة المحكيّة لأهالي كفر قاسم، والّتي تُميّز لهجتهم العاميّة بالذّات.
برأيي الخاص، أفضّل استخدام اللّغة الفُصحى في أغلبيّة الرّواية؛ ليفهمها القارئ من خارج فلسطين خاصّةً من الدّول العربيّة المختلفة، ومن المهم نشر هذه الرّواية وتعميمها على العالم بأسره.
أبدعت الكاتبة في وصف المأساة والمذبحة، ومعاناة الأهل جرّاء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، كذلك أبدعت في وصف ردود فعل الجنود بعد تنفيذ عمليّتهم النّكراء؛ بالتّعبير عن فرحهم وضحكاتهم، والتّنكيل بالجُثث تنكيلًا مقزّزًا تقشعر لها الأبدان.
برزت الفكرة الرّئيسيّة للرّواية، وهو خلق حدث مُفرح في ذكرى المذبحة؛ باقتراح أبي فارس، بإقامة أفراح جماعيّة في ذكرى خلود شهداء المذبحة، في ساحة القرية وأمام النّصب التّذكاري لهم. هذه الذّكرى تُخلّد أسماءَهم، وبنفس الوقت تغرس الفرح في قلوب الأبناء والأحفاد، وهذه رسالة لهم بأنّ الحياة والفرح مستمرّان رغم الألم والفُقدان. كما ورد صفحة 147 “بعد اليوم، لن نحيي ذكرى المجزرة بالبكاء والرّثاء، ولن نتذكّر شهداءَنا بالدّموع فقط، بل سنمضي قدمًا في طريق الحياة، فها هم أولاد الشّهداء وأحفادهم يحملون أسماءهم ويسيرون على دربهم؛ وهم شباب وعرسان يستحقّون أن نزفّهم ونفرح بهم”.
ظهرت العاطفة بالرّواية، مشبّعة بالحزن والألم والفُقدان، عاطفة مشحونة بالخوف والتّرقّب؛ عاطفة الانتماء للأرض والتّمسّك بها، مهما كانت محاولات الإبعاد والتنكيل. برزت عاطفة الفرح الممزوجة بالحزن معًا، كما بدت عندما أقيمت الأفراح الجماعيّة تزامنًا مع ذكرى المجزرة. لم تخلُ الرّواية من عاطفة الحب والعشق المُتبادل بين الجنسين.
اختارت الكاتبة عددًا محدودًا من الشّخصيّات مثل: فارس الباحث – السيّدة المُسنّة هناء – والد فارس السيّد مروان المُعلّم ورئيس نقابة المُعلّمين – أم فارس مريم. هذه الشّخصيّات حرّكتها الكاتبة خلايلة؛ بهدف تحريك أحداث الرّواية، من خلال الحوار العادي والحوار الذّاتي.
كانت بطلة الرّواية السيّدة هناء؛ الّتي سردت أحداث الجريمة على لسانها كراوية للاحداث بدقّة؛ وكشاهدة عيان للمجزرة؛ لنجاتها من بين الضّحايا المتراكمة جثثهم فوق بعضها البعض.
من المُمكن تصنيف هذه الرّواية كرواية واقعيّة – تأريخيّة، أو تحت مُسمّى السّيرة الذّاتيّة والسّيرة الغيريّة.
استعرضت الكاتبة أسمهان، عددًا لا يُستهان به من الأغاني الشّعبيّة المُستخدمة في الأفراح، والأحزان، والطّهور؛ ممّا أضفت تشويقًا ومتعةً مُميّزة، أثرت متن الرّواية بمصداقيّتها. مثل: “طالع من الحمّام وعيونه مكحولة – غسّلوا الغالي بالرواق العالي – عدّولو إمّو وتصيح يا ناري – الدّار داري والعلالي قبالي”. صفحة 8؛ كذلك ” جفرا ويا هالرّبع ريتك تقبريني – وتدعسي على قبري ويطلع ميرميّة” ص56. ” عالطّريق يا زارعات النّعنع ع الطّريق عبدالناصر يا زعيم وبحق وحقيق” ص 73. كما ذكرت الكاتبة بعض الأهازيج الشعبيّة الفلسطينيّة الّتي تردّدها النّساء أثناء طهور الأبناء كما ورد صفحة 83 ” يا مطهّر الصّبيان يا قاعد ع السّنسول لا توجع فارس محبّة الرّسول – خالتي يا اخت امّي خبّيني بالخزانة وإن سأل المطهّر قوليلو في الدّيوانة – خالتي يا اخت امّي خبّيني في العليّة – وإن سألك المطهّر قوليلو بالمُقريّة ( مكان قراءة القرآن).
وردت أيضًا أمثال شعبيّة فلسطينيّة أيضًا مثل: “هربنا من تحت الدّلفة لتحت المزراب” صفحة 71، “الدّار دار ابونا وأجو الغرب طحونا” صفحة 75 ” شو اللي رماك عالمر؟ إلّي أمر منه” صفحة 94. ووردت أمثال عديدة أخرى بالرّواية.
برأيي اكتملت أحداث الرّواية لغاية صفحة 152 ، عندما انتهى الغناء والرّقص أثناء تخليد ذكرى المجزرة؛ إلّا أن الكاتبة أضافت حدثين إضافيين؛ لم يضيفا قيمةً أدبيّة هامّة للرّواية، بل على العكس خفّفت من وطأة الأحداث السّابقة والمشحونة باشعور بالوطنيّة والألم. الإضافة الأولى الّتي سردتها الكاتبة: عندما اعتلى المنصّة أحد أصدقاء أبي فراس – السيّد مروان؛ قائلًا في خطابه: ” نعم للتّعايش العربي اليهودي، نعم للعيش بأمان دون كراهية وعنف، نعم لنبذ العنصريّة، لقد جاءت قوى السّلام للتّضان معنا، وتشاركنا فرحة أبنائنا”.
بينما الإضافة الثّانية: كانت عندما ذكر السيّد مروان بخطابه مرحّبًا برافضي الخدمة العسكريّة، كما ورد صفحة 145 “ولا يسعني الآن، إلّا أن أرحّب بإخوتنا رافضي الخدمة العسكريّة في الأراضي المُحتلّة. قد رفضوا الذّهاب إلى حرب لا يعرفون لها سببًا سوى حب الجنرالات للبطش والقمع، الجنرالات الّذين يدارون ذلّهم، بإذلال شّعب تجذّر في أرض آبائه وأجداده”.
برأي الشّخصي، حبّذا لو توقّفت الكاتبة عند سردها لأحداث مجزرة كفر قاسم، وأنهت روايتها دون الإضافتين المذكورتين أعلاه.
ظهر في متن الرّواية بعض – موتيفات – مثل: “أي ذنب كبير عند الله اقترفناه؛ ليحدث لنا كل هذا؟؟” ص 138كذلك كما ورد ص 122 ” ما الّذي اقترفناه بحقّهم؟ يقتلون النّاس، النّساء والرّجال. الّذين يكدحون من الفجر حتّى غروب الشّمس في مستوطناتهم”. هذه الموتيفات تدل على أهميّة تكرارها؛ نظرًا لأهميّتها ووقعها في نفس الكاتبة، وتقديرًا لهول المشاعر الأليمة بالظّلم والقهر.
لغة الرّواية سهلة وسلسة، وتعتبر الرّواية توثيقًا غنيًّا للتراث الفلسطيني الشّعبي في الغناء والأهازيج والأمثال الفلسطينيّة القديمة.
اختارت الكاتبة بأن يكون إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم، بإقامة أفراح جماعيّة لأبناء القرية؛ برأيي من الصّعب دمج مشاعر الفرح مع مشاعر الحزن في آن، والأفضل منح كل مناسبة بما يليق بها من مشاعر خاصّة، والتّمييز بين المشاعر، وإعطاء كل مناسبة حقّها من المشاعر. الفرح لماسبات الفرح، والحزن لمناسبات الحزن. إنّ خيال الإنسان وتفكيره كفيلان باختيار الفعاليات المناسبة؛ لإحياء الذكرى المأساويّة لمجزرة كفر قاسم؛ تمجيدًا وتخليدًا للشّهداء الضحايا.
خلاصة القول: رواية “طيور السّماء” تعتبر رواية تأريخيّة واقعيّة، لمجزرة، تعرّضت لها مجموعة كبيرة من الأشخاص في كفر قاسم؛ ومن الجدير توثيقها وأرشفتها؛ لتنتقل للأبناء والأجيال القادمة؛ مع مراعاة التعديلات اللّازمة والمذكورة سالفًا.
وقال عبدالله دعيس:
تتناول الكاتبة في هذه الرّواية واحدة من المجازر الكثيرة التي نفّذها الصّهاينة بأبناء الشّعب الفلسطينيّ، وهذا ديدنهم منذ أن وطأت أقدامهم هذه الأرض المباركة، وكأنّ الدم الفلسطينيّ رحيق الحياة الذي يمتصّونه؛ ليبقوا متربّعين على تراب هذه البلاد، التي ترفضهم وتلفظهم كلّما هبّت نسمة من بحرها أو برّها. يزرعون الحقد ويسقونه دماء طاهرة؛ ليقضوا على الرّوح الحرّة للشعب الفلسطينيّ؛ فتنمو أشجار وارفة تفوح أزهارها برائحة الشّهادة، وتكون ثمارها مزيدا من المقاومة والرّفض لذلّ العيش في كنف احتلال غاشم ظالم. ورواية “طيور المساء” تؤرّخ لمجزرة كفر قاسم التي حدثت عام 1956 وقتل الصهاينة فيها تسعة وأربعين من أبناء البلدة وهم عائدون من أعمالهم في عتمة المساء.
وقد وفّقت الكاتبة باختيار عنوان الرّواية “طيور المساء” حيث شبّهت أبناء كفر قاسم بالطيور التي تسعى لرزقها نهارا، ثمّ تؤوب إلى أعشاشها لتنعم بأمان الليل وهدوءه، لتجد صيّادا حاقدا يخترق عليها هدوءها ويحطّم أمنها ويقتلها دون شفقة أو رحمة.
وتجمع الكاتبة بين دفتي كتابها لحظات من الفرح ومشاعر الحزن الذي خيّم على القرية المنكوبة لعقود طويلة، حيث يتمّ عقد زفاف تسعة وأربعين شابّا وتسع وأربعين شابّة، بعدد شهداء المجزرة، وفي مكان حدوثها، لتكون هذه رسالة واضحة أنّ المحبة تنتصر على الحقد، وأنّ إرادة الحياة تنتصر على الموت، وأنّ هذا الشعب لا تزيده المجازر إلا إصرارا على الحياة بحريّة وعزّة وكرامة، وأنّ كل مجزرة يقوم بها الأعداء إنّما تقصّر من عمر إقامتهم في وطن لا يمتّون له بصلة، ويرفض أن تتغبّر أقدامهم الآثمة بأديمه الطّاهر.
استخدمت الكاتبة أسلوب الحكاية على لسان إحدى النّاجيات من المذبحة، لتسترجع ما دار في تلك الليلة البعيدة التي لا تنسى أحداثها، وكذلك شخصيّة فارس الذي يكتب رواية عن المجزرة ويسترجع ذكريات أبيه مروان؛ ليلقي الضوء على الحالة السّياسيّة التي كانت سائدة في العقد السادس من القرن الماضي. وقد استطاعت الكاتبة أن تنقل أحداث المجزرة ومشاعر من عايشها، وأضافت لبنة مهمّة في سبيل توثيق ما جرى للشعب الفلسطينيّ.
تسرد الكاتبة أحداث الرّواية بشكل أساسيّ عن طريق محاورة الحاجة هنا، التي أصيبت في المجزرة ونجت منها، وتستخدم الكاتبة اللهجة العاميّة الدارجة لكتابة الحوار؛ ربما لتكون أقرب إلى الواقع، ولتنقل مشاعر النّاجين بلغتهم وتعبيراتهم ذاتها. لكن، طريقة كتابتها للغة الدارجة تجعل من الصعب قراءتها وفهمها، خاصة للقراء العرب من خارج فلسطين، أما اللهجة التي تسختدمها الكتابة لإجراء الحوار، فهي مختلفة قليلا عن لهجة قرية كفر قاسم ومنطقة المثلث، فهي تستعمل الكثير من التعبيرات غير المستخدمة في تلك المنطقة.
ويلحظ القارئ أن الكاتبة على لسان شخصياتها تفرّق بين محتلّ ومحتلّ آخر، وكأنّ منهم العساكر والجنرالات المجرمين، وبينهم حمائم السلام! وتدعو إلى التعايش المشترك! (ص 152) فما أن يبدأ القارئ بالتعاطف مع مروان كضحيّة من ضحايا المجزرة، حتّى يراه يزور “صديقه” الصّهيونيّ عزرا ليحتفل بعيد ميلاده. وهل يمكن أن يكون المحتلّ الذي يستوطن بلادنا ويعيش على أرض منهوبة وفي بيت مسلوب صديقا! إن كان كذلك، فلينصرف إلى بلاده التي أتى منها، ولينكر على الاحتلال، أمّا أن يكون جزءا منه ويدّعي رفضه، فهذا ممّا لا يستقيم عند عاقل، كما لا يستقيم أن يكون شخص ضحيّة مجزرة مروّعة، كمجزرة كفر قاسم، ويهادن ويصادق أرباب المجزرة وصنّاعها. أرى أنّ دعوة التّعايش هذه ممجوجة خاصّة في ظلّ الحديث عن مجزرة مروّعة.
وتستخدم الكاتبة مقولة “حقّ الشّعب الفلسطينيّ في قيام دولته المستقلة إلى جانب “إسرائيل”” (صفحة 68) مردّدة كلام بعض السّياسيّين. إن كان هذا قول السّياسيّين فلا ينبغي أن يكون قول الأدباء الذين تنبض أقلامهم بضمير أمتهم، ويتمسّكون بحقّها، أليس في ذلك إقرار بحقّ الصّهاينة بالوجود في فلسطين أيضا؟ وكيف يقرّ أحد بهذا وهو يتحدّث عن مجزرة؟ أرى أنّ الآراء السيّاسيّة التي كانت في الرّواية، والتي لا يتفق عليها الشعب الفلسطينيّ، مع إغفال ما يشعر به الفلسطينيّون حقيقة وما يريدونه، أضعف الرّواية وأبعدها عن الموضوعيّة.
رواية موفّقة، وعمل طيّب، أما مجزرة كفر قاسم وغيرها من المجازر، فمهما كتب عنها، فلن يكون بمستوى الجريمة البشعة، لكنّه شعلة أخرى تنير درب السّاعين إلى الحريّة وتذكّرهم أنّ هناك جرحا غائرا لا زال ينزف.
وقالت نزهة أبو غوش:
حملت الكاتبة أسمهان خلايلة ريشتها؛ فقط من أجل أن تبدع، وأيّ ابداع صنعته في نسيج درامي تراجيدي ليس له مثيل. خيوط الرّواية وتشعباتها وأهدافها، شخصيّاتها، وأسرارها، وحبكتها، ونهايتها؛ كلّها حاضرة. المكان، قرية كفر قاسم، الزّمان: عام 1956. العنوان الرّئيسي: مجزرة كفر قاسم. مصمّمو الرواية: القائمون على تنفيذ للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين منذ 1948.
لا أحد يستطيع أن يكذّب التّاريخ، هكذا أثبتت لنا الرّاوية خلايلة في روايتها؛ لأنّها استخدمت وبذكاء تقنيّة اللقاء مع شخصيّة الرّاوي، فهي امرأة قويّة الشّخصيّة والذّاكرة، وحدها الّتي نجت من المجزرة ممرّغة بدمها وبالدّماء الّتي سالت من صديقاتها ال 13 العاملات العائدات من المستوطنة الّتي تبعد مدّة ساعتين عن بلدتهن كفر قاسم.
أرادت الكاتبة أن توثّق هذا اليوم الأليم، فجاءت الكلمات بسيطة وتلقائيّة دون تكلّف لغويّ؛ وقد عزّزت واقعيّتها وصدقها، الأمثال الشعبيّة الّتي يتداولها النّاس في القرية، والقرى الأخرى، كذلك الأغاني والأهازيج في أفراحهم المختطفة من براثن الظّلم والتّسلّط من قبل الاحتلال الجائر.
“بدنا يبرم هالدولاب بلكي تحوّل زمانو.يا ربّ يعودوا الغُيّاب.كل واحد ع أوطانو”
ومثال على تأثير المصيبة على أصحابها على لسان الرّاوية العجوز، هناء”: اللي بيوكل العصي، مش زي اللي بعدْها”.
تنوّع رتم الرّواية لعدّة أجزاء، ففي البداية كان الإيقاع السّردي بطيئا، تحدّثت فيه الرّاوية بهدوء دون توتّر، أو انفعال؛ حتّى أنها عقدت صداقة ما بينها وبين الشّاب فارس الّذي عمل على تسجيل صوتها. من خلال هذا السّرد، عرّفتنا الكاتبة أسمهان على حياة القرية في تلك الفترة الزّمنيّة 1956. تعرّفنا على العادات والتّقاليد الّتي لا تختلف كثيرا عن باقي قرى المثلّث، شمال فلسطين: الزّراعة للحبوب والخضار، ومساعدة المرأة لزوجها في الحقل دون كلل أو ملل. لعب الأطفال ومرحهم وشهوتهم للكعكبان، مشيهم حفاة في الحارات، ولعب الصّبيان بالكرة المصنوعة من القماش، سعادتهم رغم تلطّخهم بالطّين، رغم المطر والحر وقسوة الحياة. يقشّرون نبات القرّيص ويأكلونه بشهيّة، البنات يدهن شعورهنّ بسائل أغصان العنب. اللعب فوق لوح الدرّاس وقت الحصيدة. صناعة النّساء لأقراص (الجلّة) من روث الحيوانات وتجفيفها؛ لتدفئة الطّابون شتاء وغيرها وغيرها. الأهازيج والسهرات والمزاح والضّحك مع المهرّج أبو نجم وغيرها
وفي إيقاع أكثر سرعة أظهرت الكاتبة في روايتها الظّروف السّياسيّة الّتي كان تمرّ بها القرى العربيّة في كفر قاسم، وكفر برا وبرطعة؛ حيث تقسيمها وشرذمتها ما بين الأردن واسرائيل – حسب اتّفاقيّة سايس بيكو- التفرقة العنصريّة في المجالات المختلفة، خاصّة الوضع التعليمي، والفجوة الشاسعة ما بين اليهود والعرب، خاصّة في رداءة الصّفوف وقلّتها، ونقص الأدوات فيها، كما بيّنت ظاهرة الشّيوعيّة الّتي لجأ اليها معظم الشّباب العرب؛ فهي القشّة الّتي كانوا يتعلّقون بها هروبا من احتلال لا يرحمهم، معاداة الدّولة لهذه الفئة بشدّة وحزم، نحو اجراء التحقيقات المتتالية مع المعلّم مروان، وابعاده في منطقة نائية، ومراقبته. محاولة البعض لصنع شيء اسمه التّعايش غير الموفّق ما بين اليهود والعرب. تسلّط المقاولين اليهود على العمّال والعاملات العرب، حتّى بلغ حدّ محاولة الاغتصاب، الّذي هو أصعب من أيّة جريمة أخرى في مجتمع تعلّم”لاإِنّ شرف البنت مثل عود الكبريت، إِذا ولّعته انطفأ”
ظهر في الرّواية لغة الانتماء، ولغة الأمل بالقائد جمال عبد النّاصر، خاصّة وقد تزامن وقت الاعتداء الثّلاثي على مصر عام 1956م . الأغنية على لسان، أمّ العبد:
“عَ الطريق يا زارعات النعنع ع الطريق
عبد الناصر يا زعيم وبحقّ وحقيق.”
لقد علت لغة السّرد واشتدّت وتيرتها، حين دخلت الرّاوية في سرد أحداث المجزرة الّتي عاشتها وصوّرتها بعقلها وقلبها وأعصابها وكلّ مشاعرها. كثرت الأفعال، وقلّت الاستراحات اللغويّة:
” كان صوته يُشبه نهيق الحمار
أطلقوا النار ودقّت طبول جنائزية عالية الأصوات في قلوب الفتيات، بكين وانتحبن بأصوات مخنوقة، استغثن. امتدّ قرع الطبول في آذانهن وقلوبهن كأنّه صلاة الجنازة الجماعيّة على أرواحهنّ، احتمين ببعضهنّ البعض. الموت في حضن دافئ أسهل. ما أصعب أن تموت وحيدا! التصقت أجسادهن ببعضها ولسان حالهنّ يقول: “لا تمتن وحيدات، هيّا التصقن بعضكنّ ببعضكنّ”. ولعلع الرصاص. اهتزّت الأرض كأنّها تنوح تحت أقدامهنّ، وخيوط دمائهنّ القانية، تنساب لتروي عطشها.
هذه الحبلى إياكم أن تتركوها، لا أريدها أن تتنفس. اقتلوهن جميعا، أبيدوهن
صرخ الوحش وعاد الغراب ينعق:
أطلق النار.” ص174
لقت أبدعت الكاتبة خلايلة في وصف رقصة الموت الجماعي للفتيات العائدات من العمل وإِعدامهنّ بحجّة اختراقهنّ أوامر منع التّجوّل.
كذلك أبدعت خلايلة في وصف غليان البلدة بأكملها وذهولها، ورعبها، وخوفها على رجالها ونسائها الّذين يعملون خارجها ولا يعلمون بمنع التّجوّل. صورة المختار الّذي راح يدور كالثور في السّاقية، يصرخ وينادي: الحقوا أخبروهم أن يعودوا بسرعة، قبل بداية المنع؛ رغم أنّه أبلغ الضابط بغياب العمال خارج البلدة، فوعده بأن يتفهّم الوضع ويسمح لهم بدخول القرية.
لقد صوّرت الراوية لوحة الحزن الرّهيب لبلدة بأكملها، فكان حزنا يخترق حدّ السّماء؛ وينفذ إِلى أعماق سبع طبقات في الأرض ويخترق القلوب فيصهرها. هكذا إِذن أيّتها الكاتبة أسمهان، هذه هي طيورك العائدة مساء، والّتي ارتقت أرواحها هناك حيث بارئها عزّ وجلّ. طيورك أيّتها الكاتبة هم طيورنا جميعا، هي طيور الوطن الكبير بأسره، هي أغلى وأعزّ من فقدنا؛ سوف تظلّ ذكراهم عالقة في قلوبنا وعقولنا، وسيظلّون الشّهداء، أمام الله على الظّلم المسلّط على الشّعب الفلسطيني.
لقد هدأت وتيرة الخطاب عند نهاية الرّواية؛ فكانت نهاية موفّقة، صنعت فيها الكاتبة الفرحة مكان الحزن والألم، فكانت فكرة رائعة أن يحتفل أهل البلد.
ومن لبنان كتب عفيف قاووق:
طيور المساء للكاتبة الفلسطينية أسمهان خلايلة والصادرة عن دار الهدى للطباعة والنشر في كفر قرع عام 2021. جاءت لتوثق حقبة زمنية وتاريخية من تاريخ الشعب الفلسطيني ومعاناته مع الإحتلال وتحديدا ما جرى عليه من ارتكابات كان من جملتها مجزرة كفرقاسم التي حدثت في 29 اكتوبر العام 1956، هذه المجزرة التي اعتمدتها الكاتبة؛ لتكون مدخلا لروايتها، دون أن تغفل عن ذكر بعض العادات والتقاليد، وطرق العيش وشظفه للشعب الفلسطيني إبان الإحتلال، فجاءت هذه الرواية تحمل في طيّاتها ولو بشكل بسيط إشارات ومدلولات ذات أبعاد سياسيّة ووطنيّة واجتماعيّة عن تلك الحقبة الزمنية التي تتناولها الرواية.
وبلغة بسيطة زاوجت بين الفصحى واللهجة المحكيّة وبلسان الحاجّة هنا، وهي شاهد عيان استطاعت الكاتبة أن تقدم لنا رواية أشبة بالوثيقة التاريخية لتلك الفترة الزمنية، وجهدت للإحاطة بكامل تفاصيل الحياة اليومية آنذاك، وكيف أن المرأة الفلسطينية تعمل كتفا إلى كتف بجانب الرجل في سبيل تأمين لقمة العيش الكريم.
أبرزت الكاتبة الظلم والقهر الذي لحق بالشعب الفلسطيني جرّاء الإحتلال، والذي من تداعياته مصادرة الأراضي بحيث أصبح المواطن الفلسطيني أجيراً في أرضه عند المغتصب الصهيوني. كما أشارت إلى التمييز في الحقوق وأفضلية التوظيف بين المواطن العربي والمهاجر المستوطن، وهذا ما صرح به فارس عندما قال للحاجّة هناء أنّ فرص العمل متاحة للجميع، ولكن أسماء المهاجرين الروس والذين قدموا من أوروبا للإستيطان تكون في أوّل اللائحة، أمّا الشاب العربي فيدرج اسمه في آخرها. كذلك فقد أشارت الكاتبة إلى محاولة العدوّ طمس التاريخ العربي لفلسطين، من خلال تغيير المناهج التعليمية في المدارس، وهذا ما حاول المُعلّم مروان والد فارس التصدّي له بعد أن لاحظ أن الكتب المعتمدة للتدريس قلّما تتحدث عن العرب وتاريخهم وأدبهم، بل كلها تتضمن الحديث عن أدباء يهود وتاريخ الدولة العبرية والبطولات الوهميّة لليهود، وأمام هذا التشويه ومحاولة طمس التاريخ العربي قرر مروان ان يعلم تلامذته ما يتيسر له من تاريخ فلسطين أرض آباءهم وأجدادهم، سيّما وأنّ هؤلاء التلاميذ لم يشاهدوا أيّ معلم من معالمها. وفي سياق متصل أبرزت الكاتبة مظهرا من مظاهر التخاذل والخنوع الذي امتاز به بعض المستفيدين والملتحقين بالعدوّ، ومن هؤلاء مختار قرية برطعة الذي حاول ثني مروان عن المضيّ في مهمّته التوعويّة، متهما إياه بالكفر والإلحاد، كونه ينتسب الى الحزب الشيوعي، وطالبه بالتراجع عمّا يقوم به حتى “لا تجبلنا البلا ووجع الراس، وإذا بدّك خلّي وجع الراس إلك لحالك، أرجوك لا تلعب بالنار، ما بدّنا ندرّس ولادنا عن الشيوعية، ونعلّمهم الكفر والإلحاد، يا أستاذ اللّي بوكل من خبز السلطان بدّو يضرب بسيفه.ص88.
وفي موضع آخر تشير الرواية الى الشرذمة وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني من خلال ما ذكرته حول ما تعرّضت له قرية برطعة، وشطرها إلى قسمين يسكنهما إخوة وأولاد عمومة من عائلة واحدة، أحدهما تحت الحكم الأردني والآخر تحت الحكم الإسرائيلي.
أيضا أشارت الرواية الى العنفوان والحميّة التي يمتاز بها الشباب الفلسطيني من خلال ما أوردته حول ما تعرضت له حوريّة من محاولة تحرّش واعتداء من قبل المستوطن ديفيد، وكيف انتصر لها فارس مدافعا عن شرفها في مواجهة المعتدي.
كما أسهبت الكاتبة في ضخ العديد من الأمثال والأهازيح الشعبية التراثية التي تساهم في تسليط الضوء على التراث الفلسطيني، وأيضا لناحية طرق العيش للسكان، ومن هذه الأمثال والأهازيج مثلا:
“بدنا يبرم الدولاب، بلكي تحول زمانو، يا ربّ يعودوا الغيّاب، كل واحد ع أوطانو” في إشارة الى التشرد والشتات الذي طال الشعب الفلسطيني. وأيضا للدلالة على أحقية الفلسطيني بأرضه، شاع المثل القائل “الدار دار أبونا وأجو الغُرُب طحونا”.إلى جانب ذلك أشارت الكاتبة إلى البُعد القومي والعربي لدى الشعب الفلسطيني من خلال تعليق الآمال على الزعيم المصري جمال عبد الناصر، لدرجة ان الكثيرمن المواليد أطلق عليهم إسم جمال أو ناصر، كما حدث مع أمّ العبد ألتي أسمت وليدها جمال رغم أستنكار موظفة المستشفى التي قالت لها:” روخي من هون، روخي سميه هناك عند ناسر”.
أيضا لحظت الرواية وصفا دقيقا للمجتمع الفلسطيني فأشارت مثلا إلى سهرات السمر على البيدر في موسم الحصيدة والدراس، وكيف كان الاولاد يتجمّعون ويقفون بالدور؛ ليركبوا على النورج. كما تطرقت إلى مواسم الزرع وتجهيز المونة وتعبئتها بالجرار وغيرها.
وبالعودة إلى مجزرة كفرقاسم التي جاء ذكرها في الربع الأخيرمن الرواية، فقد أبدعت الكاتبة في توصيف المأساة والمذبحة، ومعاناة الأهل جرّاء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، كذلك في وصف ممارسات الجنود وتصرفاتهم بعد ارتكابهم لهذه المجزرة وما رافقها من أعمال التّنكيل بالجُثث بشكل مقزز، يظهر مدى الوحشية وانعدام الحسّ الإنساني لدى هؤلاء الجنود. لقد حدثت “مذبحة كفر قاسم” في التاسع والعشرين من تشرين الثّاني من عام 1956، وذلك تزامنًا مع العدوان الثّلاثي على مصر، اعتقادا من العدو بأنّ العالم ستتوجه أنظاره ناحية مصر وتداعيات العدوان الثلاثي عليها، ولا يلتفت إلى ما سيجري في كفرقاسم من إنتهاكات، حيث تمّ إعدام تسعة وأربعين شخصًا من الرجال والنساء والأطفال من أبناء القرية بدم بارد، عند عودتهم من العمل وارتقوا شهداء إلى السّماء واستحقوا بجدارة لقب طيور المساء. وعاشت القرية في مأتم كبير تساوى الجميع في المصاب والحزن، إلاّ أنّ هذا لم يمنع من انتصار ثقافة الحياة على ثقافة الموت، فالفلسطيني يؤمن بثقافة الحياة وأن الشهداء هم أحياء عند ربهم، على عكس الإسرائيلي الذي يعتنق ثقافة الموت والقتل، وكما قال مروان ” بعد اليوم لن نحيي ذكرى المجزرة بالبكاء والرثاء، ولن نتذكّر شهداءنا بالدموع فقط، بل سنمضي قدما في طريق الحياة، فأولاد الشهداء وأحفادهم هم اليوم عرسان يستحقّون أن نزفّهم بفرح، لذا كان الاقتراح بتنظيم عرس جماعيّ لتسعة وأربعين عريسا على تسع وأربعين عروس، بعدد شهداء المجزرة تأكيدا على أن الشهيد هو أيضا عريس في الجنّة، فالشهيد هو عريس الأرض التي رواها بدمه بل هو زين العرسان وأوّلهم.
ختاما لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات على هامش الرواية والتي أراها تشكل قضايا إشكاليّة وجدليّة وهي ما قد يُفهم منها وكأنها إقرار بشرعية الوجود الإسرائيلي من خلال الدعوة للتعايش بين الشعبين في دولة واحدة، هذه الدعوة ظهرت في كلمة عريف الحفل التي جاء فيها ” نعم للتعايش العربي اليهودي، نعم للعيش بأمان دون كراهية وعنف ولقد جاءت قوى السلام اليهودية لتتضامن معنا، وإن كانت دعوتهم بصفتهم أعضاء في حركة يهودية تؤمن بالتعايش وتدين الحكومة وتصرفاتها العنصرية، أيضا كانت لافتة تلك الصداقة التي نشأت بين مروان وصديقه اليهودي عزرا، هذه الأمور وإن كانت صحيحة وقائمة إلا أنّه كان من المُستحسن عدم الإتيان على ذكرها للإبقاء على المعاناة والمظلومية الفلسطينية راسخة في الأذهان، دون ان نشتتها في دعوات أثبتت عقمها لناحية إمكانية التعايش والإنصهار في دولة واحدة مع شعب محتل وغاصب.
أخيرا رواية طيور المساء لما تحمله من حقائق تاريخية توثيقية جديرة بأن تحفظ في كل مكتبة ليتسنى للأجيال معرفة ولو النزر اليسير من تاريخ بلادهم.
وكتبت خالدية أبو جبل:
قراءتي لرواية” طيور المساء”
تبدأ أسمهان روايتها من لوحة الغلاف والتي قام بتصميمها الفنان الطمراوي مبدا
ياسين لتقص علينا. اللوحة حكاية طيور اقتُحمت أعشاشها واُسْتُبيحت أرواحها فسكنت أجسادها ترابَ الشجرة التي امتدت وتكاثرت جذورها لتخترق جدار القبر
” حبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل”وحاجز الصمت، ليورق الأمل على أغصان الشجرة التي صارت أوراقها تحمل شكل مفتاح الأمل بالعودة… وعلى الجانب الآخر تقف إمرأة شاهدة على مجزرة الاصطياد وحُرمتِه، انحفرت تفاصيله في أخاديد وجهها ووعيها ولا وعيها، لم ينحن لها عود ولا انكسرت صلابة إرادتها،
تدق الأرض بعكاز السنين وتتحدى الأيام بمفتاح العودة والأمل.
منذ البداية تحاول أسمهان أن تُحمّل أعباء سرد الرواية لشخص لا زلنا نجهله ولكنّا
علمنا أنّ الساردة هي الحاجة هَنَا،وقد حددت الحاجة هنا مكان وزمان هذه الرواية
كفر قاسم 1956، زمكان أُغلِقَ على أبشع الجرائم دموية، ارتكبها الاحتلال ضد أبرياء عزّل.
ملمح التاريخ هذا الذي رافق البداية ساهم في فتح جرح المتلقي وحجرات ذاكرته المُشبعة بتراكم قضايا وطنية وقومية حساسة مرتبطة بوعي يحمل آثار سنوات
الخمسينات وما سبقها من عقود، والذي لم يستطع التخلص منها ومن ظلالها خاصة أن القضايا لا زالت مفتوحه على صراعات دامية وتحولات فادحة.
لكن أسمهان تنتقل بنا إلى بداية حوارية هي أقرب إلى مشهد مسرحي، وكأن ما قيل
سابقا كان تهيئة للجمهور لما يليه من مشاهد… فحيث بتبادر لذهن المتلقي انه سيكون الان وجها لوجه أمام مجزرة أبكت الصخر والشجر.
تأخذه الحاجة هنا لزغاريد ومهاهاة أمّ لطفلها ساعة حمامه وكأنها تُعدُه عريسًا لليلة زفافه- عادة الأم الفلسطينية.-
حوارية انصهرت في قناةٍ حكائيةٍ شكلت تمهيد يهيء المتلقي للرواية ويعطيه
انطباعا عن أشياء كثيرة قبْلّية حتى تتسّع رؤيته لاستقبال الآتي، تثير فيه الفضول
والاندهاش. لم يطُل بالمتلقي سؤاله عمّن ينقل له ما تسرده الحاجه هنا، فقد كشفت له المؤلفة في الفصل الثاني للرواية عن شخص فارس الشاب الجامعي، والمولود في يوم الأرض الأول، والذي عزم على كتابة رواية يوثق بها وقائع المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.
وهنا يلمس المتلقي حميمية هذا اللقاء بين من وُلد يوم معركة الارض- حفاظا على
هويّتها- كيف أنّها (اي معركة الارض) صارت جزءا من الزمكان في ذاته الشّاب
فارس، وبين الحاجة هَنا التي عاشت ويلات المجزرة التي اختصرت سمّات
مجموعة اجتماعية، فجاء صوتها وقد مرت عبره كلّ الاصوات، حافلٌ بالتوتر والغضب والتمزّق والألم ، حافلٌ بالإصرار والعزيمة والأمل.
وقد منح فارس هذا الصوت المساحة الواسعة، ليبوح بكل ما في صدر صاحبته ال
الذي سئم الصمت على تاريخ يجب ان تعرف سماته كلّ الأجيال القادمة. وما كان
اإلا أن جادت نفس هَنَا المجروحة بكل مكنوناتها، وبدات تسترجع الحكاية من أولها، وتنتشلها من بئر الذكريات، حيث بقيت ذاكرتها قادرة على التقاط أصوات الطبيعة
والانسجام مع حركتها وايقاعها، فسردت الحاجة هَنَا تفاصيل حياة قرية تقع تحت
نيّر الاحتلال، فكان المشهد الاول وإن بدأ بأغنية فرح وطرفة صبايا وضحكة، إلا
أنه حمل معه ضنك العيش والفقر والعوز، الذي يضطر الفتاة القاصر للعمل جنبا الى جنب مع المراة الحامل في شهرها التاسع الى جانب المرأة العجوز والصبية
في ظلّ قوانين عمل لا تمت للإنسانية بصلة من بعيد وقريب. والأمّر انهن يعملن في أرضي، من بعيد وقريب. بالامس القريب كانت ملكا لهم، “الدار دار ابونا واجوا الغُرب طحونا”. ولم يتردد فارس في اطلاع القارئ على قصة حورية
وما لاقته من تحرش والشروع في إعتداء من قبل اليهودي صاحب العمل.ص37.
ومن ناحية أخرى نرى البنت التي تبقى في البيت ترعى أخوتها الأطفال أثناء غياب
والدتها في العمل – اطفال يكبرون قبل الأوان، وقسوة مضاعفة تقع على كاهل المرأة. لم تترك الحاجة هنا قضية تعليم الفتيات والجهل ورواسب التخلف الفكري.
ووسط هذا الكم الهائل من الأسى لم يترك الفلسطيني نفسه للموت بل راح يعمل
ويتزوّج ويعيش الحياة بما استطاع اليها سبيلا من مرح ودعابة ، حكاية أبو نجم مع نسوانه ص53 على سبيل المثال لا الحصر، ومن خلال سرد هَنا لقصة ابي فارس (مروان) أطلعتنا على جوانب أخرى كثيرة من حياة القرية الاجتماعية، حثّ الرجل على الزواج بامراة اخرى بسبب عدم انجاب الاولى، صعوبة تعبير المرأة الأولى،
صعوبة تعبير المرأة عن عواطفها حتى لزوجها،! قصة مروان وزوجته ص76.
وعلى صعيد آخر كيف صارت سياسة الكيان الصهيوني تحدد الاقدار والمصائر، فالسياسة تحدد قول النعم واللا، تحدد الممنوع والمسموح، تحدد السفر أو لا، تحدد ان يكون الإنسان داخل السجن او خارجه، ( مثل الانتساب للحزب الشيوعي يُدخل صاحبه السجن) ، تحدد إمكانية أن يعمل أو أن يُحرم من العمل، أن يحصل على دخل كافٍ أو أن يبقى راكضا وراء الرغيف، أن ينام ملء جفنه او يُدق عليه الباب عند الفجر وينتزع من فراشه ولا يعرف لماذا؟ كلّ هذه الأمور مجتمعه قد يكون
المتلقي عاشها هو أو أحد من اقاربه، لكن على معرفته بها وعلى ألمها، لم يملّ
متابعة الرواية بل على العكس كانت عاملا محفزا لقراءة ذاته وتطهير ذاكرته.
وقد نجحت الكاتبة في أسلوبها الفني هذا الذي تمكنت من خلاله تأجيل الحدث الرئيسي حتى الفصل التاسع..وفي ذات الوقت تمكنت من شحن عاطفة المتلقي واستفزاز وعيّه الوطني.
وعودة على ما بَدأتْ به اسمهان روايتها”روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم” لا تطرقوا الطيور في اوكارها، فإن الليل أمان الله.”
كانت هذه وصية محمد “صلعم” ولا أشك في أنها وصية الأنبياء كافة، لكن كيف بمن فاوضوا ربهم على بقرة، أن يصغوا لكلام نبي، أو يذعنوا لما يسمى” حقوق الانسان” في مكيدة محكمة الإغلاق ، في زمكان أشد إغلاقا وحلكة وسوادًا،
تختلط حمرة الدماء الطاهرة بحمرة الغروب المبكر، وعلى قرع طبول الغروب الفزع” وطلعت يمّه وما ودعت خياتي.. وطلعت يمّه وما ودعت رفقاتي.” تعقد “
الصبايا حلقة الرقص الاخيرة لتتعانق أرواحهن على عتبة السماء، يتبعهن عامود م
من دخان شاهد على قلوب احترقت واخرى فُجعت، وذاكرة لا تنسى.
جثم الحزن على صدر كفر قاسم المفجوعة، كان لا بد من مرهم لمداواة هذا الجرح ولو من بعيد، فكان انتصار جمال عبد الناصر في العدوان الثلاثي ذلك المرهم
1956 لا يزال الدم الفلسطيني صارخا، مستباحا، وحيدا، الآني… فللأسف وللوجع
لا يملك الا إصراره وتمسكه بحقه في تراب هذا الوطن.
انهت الكاتبة روايتها بفصل كامل ، الفصل الثالث عشر، والذي روت فيه تفاصيل
تنظيم عرس جماعي يكون في الذكرى الثلاثين للمجزرة، ويتزامن مع إصدار رواية الحاجة هنا الشفوية بقلم فارس؛ لتنصر الكاتبة بذلك الحياة على الموت
والفكر السلمي على العدائي.
أحببت هذه الرمزية الجميلة بما حملته من دفق فرح وأمل وإصرار على بقائنا ووجودنا في هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه، لكن لم أر أي حاجة لهذا الفصل
بشكله، لأنه حسب رأيي أعطى برودا لذروة الرواية غير متوقع، بصيغته
التي اتخذت الاسلوب التقريري، أحببت أكثر لو انتهت عند ذكر العرس برمزيته دون تفاصيل.
ملاحظة أخرى لا بد منها، كصديقة تعرف أسمهان عن كثب، فقد وجدت جزءا من اسمهان خفي وموزع في جوانب الرواية كلّها، أسعدني في معظم تواجده الذي
القى بخفة ظلّه، أكان في أسلوب الحوار، أو في الأغنيات الشعبية أو بعض المفردات والعبارات، لكن هناك جزء كان ظاهرا للعيان مرتين ص12و ص95 حيث أبدى فارس حيرته وتساءل أي لغة يجب اختيارها للكتابة، الفصحى أم العامية؟ وكأني بها تعطي تفسيرا للقارئ عن السبب الذي جعلها تخلط العامية بالفصحى. كانت لغتك رائعة وسلسه اسمهان وموفقة كل التوفيق في سرد روايتك الجميلة. روايتك بدأت بالعرس وانتهت بالعرس.
وقالت نزهة الرملاوي:
يمكننا تصنيف العمل برواية سردية من واقع طغى عليه التأريخ الشفويّ، والذي عرفته الكاتبة روز ماري الصايغ في مجلة رمّان ” بالهادف إلى رفع الصّمت عن التاريخ الفلسطيني ومحو الذاكرة، وهو أحد أبرز أسباب بقاء فلسطين الماضي حاضرة ومستقبلية في وعيّ الأجيال اللاحقة لجيل النكبة، وتناقل الحكايات الشّعبية، وعدم غياب القرية والمدينة عن وعيّ أجيال من اللاجئين غالبيتهم العظمى لم تعرف فلسطين ولم تسكنها بسبب التهجير.”
ورد في الكتاب وصف لقرية كفر قاسم ومزارعها وعادات وتقاليد أهلها القرويين وأعمالهم قبل النكبة، وذكرت ما يحيط بها من مدن وقرى وطرق وشوارع، وذلك عن طريق السّرد الفنّي الاسترجاع الذاكرة (Flashback) وسردها من قبل الراوية الحاجة (هنا)، في لهجة محكية قروية، عرضتها في أحداث اجتماعية وتاريخية وسياسية متعددة.
الحاجة (هنا) الراوية الشاهدة على مجزرة كفر قاسم، ساهمت في إضاءة جوانب وقضايا كثيرة كقضية العمال والأراضي الزراعية المغتصبة، والعاملات المتوجهات للعمل وتحرش السيد اليهودي شلومو بهن، وعدم تعليم الفتيات وتهميش متطلباتهن، وإبقائهن بالبيت للاعتناء بأخوتهن أو قيامهن بالأعمال المنزلية والزراعية، وذلك بمباركة المخاتير وأصحاب النفوذ. وأطلعتنا على الحالة النفسية التي ترافق المرأة التي تتأخر بالانجاب، ولفتت انتباه القارئ إلى الحياة السياسية الاقليمية العربية ودورها في القضية الفلسطينية، ومشاركة الأحزاب العربية في الحياة السياسية الاسرائيلية، والمعاملة القاسية والعنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وما زال.
تميز الكتاب بعدد كبير من الأمثال والأغاني والأهازيج الشعبية التي كانت تردد في أوقات ومواقف مختلفة كالأفراح والأحزان والطهور، ولا شك أن الكاتبة تعمدت كتابة هذا العمل كي يبقى في ذاكرة الفلسطيني حتى لا ينسى ما تعرض له أجداده من مجازر وتهجير وتحمل لألم الفقد والغربة، وإن كانت بعض الشخوص تمكث في الوطن، إلا أن الحنين يفرش وشاحه على القلب المتيم من الوجع فيشعر بالاغتراب.
اعترافات ومداخلات وأقصوصات، أوحت بها الراوية الحاجة (هنا) إلى “فارس” الذي حمل على عاتقه تسجيل ما ترويه الحاجة من مواقف وأحداث وما جرى أثناء المجزرة، وإثبات لحق اللاجئين في أراضيهم المهجرة والمصادرة، وحقهم في الوجود، وذلك من خلال ذكر أسماء العائلات، وذكر أماكن سكنهم، وأراضيهم وحواكيرهم وطوابين الخبز هناك، وانواع المزروعات ومخابئ المونة والأدوات والملابس، بحث أدخلتنا إلى الريف الفلسطيني بتفاصيله، وأحاديثه، وحكاياته المطعمة بالخوف والشجاعة والبلاهة والسيطرة والذكورية، مما زاد من شوقنا للأحداث، فتارة تضحكنا المواقف، وتارة توقفنا لنتساءل، وتارة تمنحنا البكاء.
صورت الحياة الاجتماعية، والتي نتجت عن حياة عربية متجذرة، تماهت ما بين جلسات السمر والأعراس المقامة حتى الصباح، وتسلية الناس بالحكايا المضحكة، كحكاية ابو نجم زوج الاثنتين، الذي غنى ( مشحر يا جوز الثنتين، كل الناس بفرد هم وانت لحالك بثنتين) كما ورد في ص (56) إضافة إلى ما ذكرته الكاتبة من بعض الأهازيج الشعبيّة الفلسطينيّة الّتي تردّدها النّساء أثناء طهور الأبناء كما في ص. (83)
.( يا مطهّر الصّبيان يا قاعد ع السّنسول لا توجع فارس محبّة الرّسول)
تعتبر هذه الأهازيج والعادات والتقاليد اثباتا للهوية الفلسطينية التي كانت وما زالت تروى، حفاظا على الرواية الفلسطينية والعمل على نشرها، وهي بمثابة ردّ على الرواية الإسرائيلية المزيفة التي تحاول إثبات احتلالها للأرض معللة احتلالها بأنها كانت أرضا فارغة جرداء بلا شعب.
تميٌزت السردية بكثرة الأمثال الشعبيّة الفلسطينيّة ومناسبتها للحدث مثل
“حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس” ص 63
“الدّار دار ابونا وأجو الغرب طحونا” ص 75، ووردت أمثال عديدة أخرى بالرّواية لا مجال لذكرها.
صوّرت السردية أخبار المجزرة التي خلفت تسعة وأربعين شهيدا، قتلوا بدم بارد على مشارف القرية بعد عودتهم من عملهم، ووصفت مشاهد القتل وبشاعة مرتكبيها، وبكاء الأطفال والثكالى.. نقلت الكاتبة احاسيسها (الحاجة هنا) بصدق أثناء روي أحداث المجزرة، بحيث تتابعت صور المجزرة بوضوح وألم أمام القارئ، فأغرقته بمشاهد التحسر والألم والبكاء على من قتل بلا حول له ولا قوة ص 139، مشيرة إلى اسم الكتيبة والمسؤول عن تنفيذ المجزرة والمكان والزمان الذي نفذت فيه.
جاءت لغة الحوار بسيطة ومفهومة، ذات صبغة تقريرية اخبارية، تفتقر إلى التشبيهات والاستعارات.
أطلعتنا الكاتبة على أسماء القرى والمدن والمواقع الجغرافية وعدد السكان فيها، وكذلك أطلعتنا على حال التعليم على لسان مروان المعلم والد فارس، حيث قارنت بين حال التعليم في الوسط العربي والوسط الإسرائيلي، والى الصعوبات الاقتصادية التي واجهت الطلاب العرب للوصول إلى مدارسهم، ووصفت الغرف الصفية وملابس الطلبة، والمناهج المزيفة المراد تدريسها للطلبة والحكم المحلي الذي منعهم من الخروج، وكأنهم في سجن كبير. ص 60- ص 63، وكان ذلك لصالح العمل.
بينت الكاتبة أثر الحكم المحلي على الحياة والتنقلات وسياسة الإبعاد، وكان ذلك عن طريق حوار المعلم مروان والذي انتسب للحزب الشيوعي الاسرائيلي، وعيزرا اليهودي، وتطرقهما إلى مواضيع سياسية واجتماعية مهمة ذات احترام متبادل، مع ابداء امكانية عيش الشعبين بسلام .ص 70 و 72.
إضافة إلى تمرير أحداث تاريخية مهمة في فترة الخمسينات وإيمان الشعوب العربية بالقائد العربي جمال عبد الناصر، المناصر للقضية وحلمها بتحريره لفلسطين، كما ورد في قصة أمّ العبد التي تريد ان تسمي ابنها (جمال) مع الممرضة اليهودية والمشادة الكلامية بينهما، بحيث وظفت الكاتبة هذا النص لإظهار العنصرية وكره اسرائيل للزعيم المصري الذي أمم القناة، وقام بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي لمحاربتهم.
تطرقت الكاتبة إلى العدوان الإسرائيلي على مصر، ونكسة العرب وهزيمتهم، وأشارت إلى الأغاني التي رددت أثناء الحرب، وبيّنت أن أحداث المجزرة تزامنت مع العدوان على مصر لاخفاء المجزرة عن عيون العالم.
اتّسمت الرواية بمشاعر وأحاسيس صادقة أثناء روي الأحداث والمواقف مثل مشاعر الحزن والفرح، والخوف والقلق والقوة.
توجت الكاتبة عملها بنهاية جميلة، لتحقق ما هدفت إليه، نهاية سعيدة تخرج بحياة وأمل من تحت الموت والمجزرة.
إقامة عرس جماعي لأبناء كفر قاسم يعني إقبال على فرح وولادة حياة جديدة، وإصرار على البقاء، وقد تزامن هذا الفرح في ذكرى المجزرة، على أراضي كفر قاسم هوّدت أكثر أراضيها، مستوطنات غيبت شمس الحرية، عن شعب له أراض ومساكن وذكريات وحياة، له لغة وتراث، وعادات وأغنيات.
ملاحظات حول الكتاب:
نحن نعلم أن الطيور تهدأ وتنام ليلها في المساء، لماذا اختارت الكاتبة عنوان كتابها طيور المساء؟ كيف يكون هكذا عنوان عتبة للولوج إلى سردية مفعمة بالحركة والحوار والنشاط؟ ما سرّ اختيار الكاتبة لعنوان شاعريّ كتبت حروفه من الدم؟
هل قصدت لو أن القاتل ترك الناس آمنون مطمئنون في بيوتهم؟ أم قصدت غير ذلك؟
في الصفحة (77) روت الحاجة (هنا) حوارا دار بين أبي فارس (مروان) وأمّ فارس، حدثته عن حبهما وما دار في خلوتهما (بحبك يا مروان وبدي ولاد منك حتى ولو ولد)، و(عن حالة الكبت والتقلب في الفراش إلى الجهر) ص (78)، فهل يعقل أن تروي الحاجة (هنا) للابن ما دار من حديث بين والديه في خلوتهما في الحين الذي لم يخبرها أحدهما بذلك؟
جاء السرد والحوار باللهجة العامية للشمال الفلسطيني بشكل لافت ومكثّف، غطّى معظم الصفحات على حساب اللغة العربية الفصحى، وأظن أن ذلك يخدم التأريخ الشفوي ولا يخدم السرد الروائي بسبب اتساع الرقعة الحوارية المحكية.
من الملاحظ أن فكرة التعايش السلمي وردت أكثر من مرة في الكتاب، بالرغم من احتلال البلاد وتهجير العباد واقتراف المجازر بحقّ المواطنين العزل، فهل اعتبر الزواج الجماعي في ذكرى يوم النكبة وحضور ممثلي الأحزاب اليهودية لهذا العرس تأكيدا لهذه الفكرة؟ هل ترسخ فكرة التعايش الاعتراف بالوجود العربي كأصحاب قضية وحقهم بأراضيهم التي هجّروا منها؟ أم تمنعهم من الاعتراف بارتكاب المجازر أمام عالم غيّب الحقائق وألغى القضية؟ هل الاحتفال يُبقي الأجيال المتعاقبة في حالة تذكّر؟ أم المجازر المتكررة أمام أعينهم لن تنسيهم ما ارتكب بحقّ أجدادهم من مجازر؟
طوبى لمن روى وكتب حكايات غافية في أدراج النسيان، طوبى لمن عمل جاهدا في سردها ودوّنها في كتب الوفاء، ليُبقي الراحلين في دفء الذاكرة، وعدالة السماء.
وكتب الدكتور عزالدين أبو ميزر:
بداية، وتساوقا مع أحد الاقتراحات التي طرحت في اجتماع ندوتنا الأخير، سأجمل مداخلتي على شكل ملاحظات مختصرة وأترك مجالا لغيري ممن يحب التوسع والاطناب.
الرواية عنوانها جميل ومعبر
الرواية مكتملة فيها شروط الرواية وفيها من التشويق ما يلفت النظر، وفيها الحبكة الروائية المطلوبة. وهي رواية أدبية تاريخية توثيقية وطنية لفترة من الزمن معينة، بلسان من شهد أحداثها وما قام به العدو الاسرائيلي من إجرام ومجازر ضد شعبنا الفلسطيني المكافح، ولا يزال حتى اليوم هذا ديدنه وسبيله إلى الحياة بقتل الآخرين، بقلوب هي كالحجارة أو أشد قسوة كما وصفهم الله تعالى من بدء نشأتهم الأولى. وكما وصفتهم كاتبتنا بأصحاب العيون الزجاجية التي ليس بها حياة ولا إحساس ولا رحمة.
الرواية سردت بأسلوب سهل وسلس ليس به تعقيد وبلغة بسيطة، امتزج فيها اللسان الفصيح والمحكي بتزاوج لا يخلو من الجمال، بل وفيه ما يجذب القارىء إليه ولا ينفر منه، وقد أنهيت قراءة الرواية بجلسة واحدة وبلا ملل. وبما ضمنته من أغان وأناشيد وطنية وعاطفية.
برعت الكاتبة وعلى ألسنة شخوصها وخاصة من منهم الشاهد على عصره في وصف الحقد والخديعة والاجرام والبشاعة والتنصل من كل القيم الانسانية، التي تمثل بها المحتل الصهيوني لأرض وشعب فلسطين مستغلا الظرف الدولي والأقليمي والقوة، لما قام به من إجرام في قرية كفر قاسم وبشاعته بشكل مؤثر وواضح، يكاد يفوق الوصف في الفصل الحادي عشر، ثم اللفتة الجميلة منها مقابل هذه المأساة، صورة الفرح بالعرس الجماعي، لإظهار مَن طبعه الفرح ومن طبعه القتل والاجرام والتعطش لسفك الدماء.
وأخيرا عرضت أفكارا يختلف الكثير عليها على لسان شخوص روايتها، وأهمها القبول بالأمر الواقع والرضا به، والاعتراف بمن ليس له الحق بحق ليس له، والأمل بأن يمن المغتصب على صاحب الحق بشيء ممّا اغتصبه، ليعيش الشعبان بسلام وأمان.
وكتب المحامي حسن عبّادي:
زوّدتني الكاتبة الجليليّة أسمهان خلايلة بنُسخ من روايتها “طيور المساء” لتشارك في مبادرتي “لكلّ أسير كتاب”، وفعلاً شاركت في الحلقة (134) (31 آذار 2022)؛ وكتبت في حينه: “تروي الكاتبة حكاية مجزرة كفر قاسم، تلك المذبحة التي نفّذها حرس الحدود الإسرائيلي في 29 أكتوبر 1956، غداة العدوان الثلاثي على مصر، ضد مواطنين فلسطينيين عُزَّل راح ضحيتها 49 قتيلًا، منهم ثلاثة وعشرين طفلًا دون الثامنة عشر، ومنهم نساء حوامل، وحاولت حكومة الكيان التستر على المجزرة ومنع نشرها.
تنهي الرواية على لسان أبو فارس: “الحمد لله، شوفي يا أمّ فارس ما أحلى جَمعة أهل بلدنا وضيوفنا! أشعر الآن أنّ الشهداء ينامون مطمئنّين في قبورهم، ولن تغيب شمس كفر قاسم!”.
أخذتني قراءة الرواية ثانيةً للوحة تُزيّن حائط مكتبي بريشة صديقي الفنان ظافر شوربجي كُتِب عليها: “الموتى لا يرجعون إلى بيوتهم في المساء”.
سأتناول بدايةً “لوحة الغلاف“: يُعتبر الغلاف عتَبةً نصّية وعملًا موازيًا لمتن المؤلّف وأصبحت له وظائف ودلالات، وحين أمسك بكتاب أبدأ بتمعّن غلافه، ويجذبني ذاك الغلاف الذي يرتبط بالمضمون، وحين أنهيت قراءة الرواية ثانيةً تساءلت: هل قرأ الفنان مبدّا ياسين (صاحب لوحة الغلاف) النص قبل تصميمه للغلاف؟ هل يدلّ على المجزرة و/أو كفر قاسم و/أو طيور المساء؟؟
تمعّنت بها جيّداً ولم أشاهد صورة مجموعة للطّيور العائدة ولا مساء ولا كفر قاسم؛
وجدت صورة عجوز تتوكّأ على عكّازها وكأنّي بها من النّاجين من المجزرة وشاهدة على الجريمة، تحمل مفتاحها الّذي يتدلّى من يدها ينتظر عودة مشتهاة، وصورة لقبر يُنبت شجرة تغذّيها جثث الشّهداء الّتي روت دماءهم تراب القبر ترافقه رائحة الموت ِ
إنّها صورة معبّرة ولكنها تصلح لمقام ومكان آخر، رسم الفنّان مبدّا ياسين لوحة جميلة ومعبّرة، ولكنّها تفتقد الطيور العائدة بالفرح والأمل بمستقبل أجمل، والمفاتيح جاءت مبتذلة ونشاز.
التقيت يوم 18 نيسان في سجن نفحة الصحراوي بالأسير الرسّام جمال هندي وتناولنا فكرة رسم أغلفة الكتب، فكرة تصميم الغلاف وأهميّته كعتبة نصيّة، وتصميمه لغلاف كتاب “لماذا لا أرى الأبيض 2” للكاتب الأسير راتب حريبات، حيث قرأه كمخطوطة قبل التصميم وناقشناها معاً (إطّلعت على المخطوطة ولوحة الغلاف، والكتاب لم يصدر بعد) ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّه من الضروري للفنّان الإطّلاع على فحوى الكتاب وليس بندقة لوحة لغلاف كتاب؛ لأنّها راقت للكاتب أو الناشر أو كوسيلة تسويقيّة.
صِدقًا – لم استوعب بعد تلك العلاقة بين لوحة الغلاف والرواية!
أما المحور الثاني فعنونته “الرواية التاريخيّة”؛ تُعبّر عن واقع تاريخيّ في خيال الروائي؛ ليتحّذ من الأحداث ركيزة لإيصال رسالته بنصّ أدبيّ بعيد عن التكلّس في سرد الوقائع التاريخيّة التي تأتي جافة، فالرواية التاريخيّة عمل فنيّ يتّخذ من التاريخ مادة خامّة للسرد الروائي، يشوبها الخيال والإبداع دون الالتزام بحذافير الأحداث، حيث تحمل الرواية تصوُّر الكاتب عن المرحلة التاريخيّة وتوظيفه لهذا التصوّر في حديثه عن ذلك العصر، فيتخّذ من التاريخ مرجعًا وركيزة لحبكته الروائية. ممزوجة بالخيال والإثارة.
وهنا وفقّت الكاتبة باختيارها موضوع الرواية، موضوع لم يُطرق كثيراً، بقي مغيباً ومهمّشاً، فجاءت لتضيء زوايا معتمة من مجازرنا، وهن كُثر، ونكبتنا مستمرة، فالروايات ليست مجرّد كتب وأحداث خياليّة وتأريخ، والشعب الذي لا يملك أدبًا لا يملك تاريخًا ولا حضارة.
أما المحور الثالث فهو “العرس الجماعي” في الذّكرى الثّلاثين للمجزرة ووفاءً للشّهداء. دلالته رمزيّة، تولد الحياة من رحمها المقاومة، فالتجربة حارقة ومميتة، أهلنا لا ينهزمون تمامًا، بل يشحنوا طاقاتهم من أجساد وأرواح من رحلوا ليُعبّدوا طريق الأمل والحريّة… فهناك حياة بعد موتهم، وهنا تكمن القدرة على التجدّد والاستمراريّة والقيامة من الموت للشعب الفلسطينيّ؛ مثل طائر الفينيق، وليصرخوا في وجه السفّاح، قاتل الأجنّة والأطفال والنّساء والرجال، أننّا هنا باقون، شوكة في حلوقكم، سنكبر ونتزوّج ونُنجب وستعود الطيور لتتجدّد الحياة.
لغة الرواية سلسة وتتبيلها بالأمثلة الشعبية جاء موفّقاً؛”جاجة حفرت على راسها عفرت”، “الحكي مش مثل الشوف”، “اللي بوكل العُصي مش مثل اللي بعدّها”، “هون حكينا وهون طمّينا”، “هربنا من تحت الدلفة لتحت المزراب”.
ملاحظات لا بد منها:
كان من الحريّ تحرير الرواية وتنقيحها قبل النشر، فوقعت بعض الأخطاء المعرفيّة واللغوية/المطبعيّة وكان بالإمكان تجنّبها؛
- وقعت المجزرة يوم 29.10.1956 وليس في أواخر صيف عام 1956.
- استعمال مصطلح “الكيان الصهيوني” عدّة مرات جاء مبتذلاً.
- أخطاء مطبعيّة كثيرة: أملّا بدل أملاً (ص.16)، “فسحب” بدل “فحسب” (ص. 18)، سقى بدل ساق الله (ص.24)، “أن وافقة” بدل “موافقة” (ص. 59)، “وتَيف” بدل “وتضيف” (ص.82)، “تُرمي” بدل “تُرمى” (ص.93)، “قائق” بدل “دقائق” (ص.93)، “شعب بلا الأرض” بدل “شعب بلا أرض” (ص. 150).
- استعمال الهوامش أثقل النص؛ فإمّا أنّ الكاتبة مستهترة بالقارئ وفهمه أو أنّها تفتقد الثقة بنفسها، وهي، بمعرفتي بها، ليست كذلك. وعلى سبيل المثال لا الحصر: “الربى واللبا” (ص. 15)، “شرايط” (ص.29)، “لوح الدراس” (ص. 30)، “تعاليل الأعراس” (ص.53)، “خُشّة” (ص.65)، “المُقريّة” (ص. 83)
- استعمال اللهجة المحليّة للحوار لم يكن موفّقاً فغاب عن الكاتبة الفرق بين لهجة أهل المثلّث الجنوبي وأهل الجليل؛ خمستاش وليس “خمستاعشر” (ص.33)، “ساعة” وليس “سيعة”، “هسّا” وليس “إسّا”، “يا ستّي” وليس “يا جدّتي”، مدّ ايدو يحنونو” بدل “يحنولو”، “وبالمنديل يضمّونه” بدل “يلفّولو” وغيرها.
وهناك تساؤلات لا بد منها؛
لماذا استعانت الكاتبة باسم عائلة فاطمة صرصور وباقي الأبطال بأسمائهم الشخصيّة فقط؟ لماذا “الإرضاع” علانية على الملأ (ص.75)، لماذا أخطأت في ذكر قرية بير السكة، وكأنها مجاورة لكفر قاسم وهي تبعد عنها 37 كم!! (ص.100، ص.103) وغيرها.
وأخيراً؛ راق لي جداً ما جاء في صفحة 12: “الشهداء يستحقّون أن تُدوّن أسماؤهم الحقيقية لترسخ في ذاكرة الأجيال. ويحفظها التاريخ“. كنت قد قلت مراراً وتكراراً “الأسير ليس رقماً” وكذلك الأمر مع شهدائنا!
وكتب الدكتور محمد عبدالسلام كريّم:
كنت أبحث طيلة قراءتي لرواية طيور المساء، عن شجرة تختفي الطيور بين أوراقها أو تبني أعشاشها فيها، إلا أن البيئة التي حفرت فيها الروائية آباراً من الألم، لم يكن فيها حضور لطيور، وما أن تحاول ريّ عطشك، من أحدها حتى يفاجئك بمرّه ولزوجة طعمه. بحثت كثيراً حتى وصلت إلى الفصل الرابع عشر حيث عرفت أنّنا هم طيور المساء. أنّنا تلك العصافير البريئة التي كان عليها أن تقاوم مخالبَ وأنيابا وسموما.
رأيت كفر قاسم ودير ياسين والحرم الابراهيمي وغزة وعين الزيتون وغيرها الكثير، عصافير مساء أفزعها من اعتاد أن “يطرق الطيور في أوكارها”.
سيحبس من يقرأ الرواية والمكاني- نفَسَه طويلاً، ولعلّه سيؤخّر وجبة غدائه وأدائه لبعض الواجبات، كما حدث معي فعليا، حتى ينهي قراءة تلال الألم التي تحملها الرواية.
نجحت الروائية، عبر شخوص الرواية الرئيسية والثانوية، التي لم يكن فيما بينها فارق كبير في الحضور. فغدت بذلك معظم الشخصيات حاضرة في غالبية الرواية. ففارس وحورية وهنا وفاطمة ورجا وغيرهم الكثير كانوا حاضرين حضور النصّ وثبات دماء الشهداء.
كانت الرواية مفعمة بالواقعية والصدق، حتى عندما تتحدث عن مواطن فلسفية ما، كأن يتناول النص نقاط الضعف، فتقول: ” حقا لا يخلو أحدنا من نقطة ضعف يخفيها وراء بطولاته وتحدّياته، لكنها كبقعة الزيت لا تلبث بلحظة من أن تطفو على سطح الروح؛ فينفجر صاحبها وينكشف ضعفه” ص39.
تناولت الرواية،حدثاً حقيقاً إلا أنه متكرّر ويتكرّر حتى ونحن نكتب هذه السطور، إنّها مجزرة كفر قاسم، التي قرأنا عنها وشاهدنا صورها وشاهدناها فيلماً، وهو أمر لم يبهت صورة الرواية أو يقلّل من شأنها.
وكتبت فاطمة كيوان:
تنسج اسمهان خلايلة الحكاية من وحي الواقع ومن وحي الأرض والمكان، ومن وجع التراب الذي ارتوى بدماء الشهداء الزكية.
المكان: حكاية مجزرة لبلد من بلاد الوطن( كفر قاسم ) شأنه شأن البلدات الأخرى التي راح أهلها، ولكن الفجيعة هنا تكمن في كيفية ذلك، حيث تحولت الأرض لمكان يقطر دما جراء كومة الجثث وزهق الأرواح وانعدام الإنسانية. فقتل 49 شخصا فيها وذالك في 29 أكتوبر في 1956.
جاءت الرواية وحبكتها مفعهة بالحزن والألم وحرقة الفقدان بلسان الراوية الحاجّة هنا التي استعان بها مروان الطالب الجامعي؛ ليوثق التاريخ ويكون مادة لدراسة الماضي .. فهي تعتبر رواية تسجيليّة توثيقيّة عن معاناة الشّعب الفلسطينيّ بشكل عام.
امتلأت الرواية بالأمثال الشعبية بلغتها الحكائية وأسلوبها المشوق القريب من قلب القارئ، وبالعديد من الأغنيات خاصة تلك المتعلقة بمراحل الطفولة، فقد احتوت الرواية عللى فصل كامل تقريبا يتحدث عن عادات أهل القرية في استقبال المواليد .. وكذالك عادات الناس في الأحاديث والمناسبات العديدة وبعض القفشات والطرائف التي نسجت وحيكت بالنص بشكل جميل وظريف يشجع القارئ على متابعة القراءة. منها ما جاء في الفصل الرابع ( حكاية أبو نجم مع نسائه))، كما عرضت حال التعليم اليوم والمناهج غير المدروسة وكيفية محاولة ابعاد المعلمين ذوي لروح الوطنية عن سلك التعليم، بابعادهم عن قراهم والتضييق عليهم في المعاشات وفرص العمل جاء ذالك من خلال شخصية ابوفارس، الذي أبعد عن قريته ومحاولة اتهامه بالشيوعية وبث أفكار فاسدة للطلبة.
جاء الحديث عن المجزرة بشكل خاص في الفصل الأخير تقريبا، فسردت الكاتبة كيف تمت عملية الإبادة، وكيف نجا بعض الأهالي ..وكان هذا الفصل مليء بالألم والمعاناة .لكن الكاتبة أبت إلا أن تقول لنا أن هذه الأرض عليها ما يستحق الحياة، ولذالك جاءت لنا بفكرة الفرح الجماعي للعرسان، فمزجت الفرح بالحزن وخاصة في ذكرى المجزرة، لأنها تؤمن أن هناك ما زال من يحمل الشعلة ..ولسوف يأتي اليوم الذي يرسم أحلامنا فوق ما نهوى، فالأرض لنا وسنبقى هنا كاننا عشرون مستحيل.
الأسماء في الرواية: جميع الأسماء بالرواية مستوحاة من الواقع الذي تعيشه الكاتبة، بل من الأقارب، وللحظة معينة أحسست وأنا أقرأ أنها تدمج الرواية باحداث مشابهة في قريتنا، شأنها شأن باقي القرى وباقي العائلات ممّن هجر ورحّل ومات في بلاد الغربة.
اللغة السائدة في الرواية هي اللهجة العامية المحكية تقريبا خاصة الراوية هنا .. واستعمال عبارات مثل ( الأرض بتوحل ) وبعض الأمثال الشعبية والحكم كان لتقريب القصة من الواقعية.
لوحة الغلاف جميلة وقريبة من فحوى الرواية التي تتحدث عن الأرض والتراب بالغالب.
وكتب علي هيبي:
أخذتني الرواية إلى التّفكير باتّجاهيْن أو حول موضوعيْن، لأحدهما علاقة بهذه الرّواية بشكل عامّ، ولثانيهما علاقة بمضمونها بشكل خاصّ. الأوّل هو تلك الجهود الفنيّة والأدبيّة الّتي بذلتها وقدّمتها كوكبة من أدبائنا الفلسطينيّين المحلّيّين على طبق روائيّ وجماليّ، يشار إليه بالبنان وبكلّ أصابع اليد. والثّاني جعلني أتساءل فيما إذا كان ثمّة من كتب رواية فنّيّة محورها أحداث مجزرة “كفر قاسم” في المثلّث الفلسطينيّ الصّغير، في التّاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1956، أمّ أنّ هذا السّبق بقصبه وريادته كان من نصيب الكاتبة “أسمهان خلايلة” من قرية “مجد الكروم” في منطقة “الشّاغور”، في الجليل الغربيّ، والّتي شهدت هي الأخرى مجزرة بعيد النّكبة لا تقلّ إجرامًا ووحشيّة عن مجزرة “كفر قاسم”، الّتي راح ضحيّتها 49 شهيدًا برصاص قوّات الأمن الصّهيونيّة الاحتلاليّة، ومن بينهم 23 شهيدًا لم يبلغوا حتّى يوم المجزرة الثّمانية عشر ربيعًا، لقد كانوا حقًّا في عمر البراعم والورود في أوائل تفتّق أنوارها اليانعة ببرد النّدى، عندما قصفت أعمارهم الغضّة آلة الحقد والقتل الصّهيونيّة الوحشيّة الغادرة.
في السّنوات الخمس الأخيرة، أي منذ سنة 2017 أعتقد أنّ ساحتنا الأدبيّة الفلسطينيّة في الدّاخل قد غنيت بمجموعة من الرّوايات والسِّيَر بمستويات فنيّة متفاوتة، ولكن في جميع تلك الرّوايات والسّيَر جوانب جماليّة وتوثيقيّة، وذات مضامين وطنيّة وأساليب فنيّة متنوّعة، تدلّ على فهم معظم أدبائنا لأصول التّأليف الرّوائيّ وأسسه ومعاييره الفنّيّة، حتّى أولئك الّذين كانت رواياتهم في هذه السّنوات الخمس هي الأولى، كرواية “طيور المساء” للكاتبة أسمهان خلايلة موضوع هذه المداخلة النّقديّة الموضوعيّة قليلًا والاستقرائيّة الذّاتيّة كثيرًا.
ومن خلال بحثي العمليّ استطعت أن أجد كمًّا كبيرًا من الرّوايات، تناول معظمها بشكلّ كلّيّ أو جزئيّ القضيّة الفلسطينيّة أو أحد وجوهها أو صورها أو جوانبها، كقضيّة شعب شرّد من وطنه بالقوّة، وارتكبت بحقّه المجازر الوحشيّة، وما زال يملك الرّواية والذّاكرة والحلم بالعودة. وما بقاء الأقليّة الباقية من هذا الشّعب المميّز ضدّها بشكل عنصريّ سافر، وهي الّتي تشبّثت بترابها وشخصيّتها وهويّتها الوطنيّة الفلسطينيّة، ما بقاؤها إلّا شاهد حيّ على عمق الجريمة، بحقّ شعب سُلب وطنه وترابه وسماؤه ومياهه وهواؤه، وما زالت السّلطات الصّهيونيّة الكولونياليّة وحشًا لا يشبع، فما زالت تلاحقه لتسلب لغته وحضارته ورموزه ومقدّساته وشخصيّته، ولتغيّب حضوره وأذانه وقرع نواقيسه، بكافّة الوسائل الوحشيّة، وأبرزها المجازر الهمجيّة ومصادرة الأرض وهدم البيوت والحرمان من العمل وصور كثيرة من الإذلال، ولكنّ هذا الشّعب وبضمنه الأقلّيّة الفلسطينيّة العربيّة الباقية على ترابها، ورغم ما تعرّض له من أساليب وسياسات تريد تغييبه وموته ما زال يصرّ على الحياة والبقاء والصّمود والتّطوّر. ولعلّ أبرز صور هذا الإصرار الحفاظ على اللّغة العربيّة والأدب العربيّ وحفظ الرّواية الفلسطينيّة الصّادقة والذّاكرة الجماعيّة الأمينة لتراثها ولماضيها وأمجادها بالتّأليف الرّوائيّ خاصّة والأدبيّ عامّة، أمام زيف الرّواية الصّهيونيّة الملفّقة الّتي لا تملك لا كوشانًا ولا تراثًا ولا ماضيًا ولا مجدًا.
ومن المفيد في هذا المقام:
ذكر بعض تلك الرّوايات الأولى لبعض المؤلّفين صدرت في بضع السّنوات القليلة الماضية: “طيور المساء” لأسمهان خلايلة، سنة 2021، “جوبلين بحريّ” لدعاء زعبيّ خطيب، سنة 2021، “نجمة النّمر الأبيض” لمحمّد هيبي، سنة 2017، “مذكّرات معلّم” لتميم منصور سنة 2015، “نور في المنار” لأسامة مصاروة، سنة 2017، “بين مدينتيّن” لفتحي فوراني، سنة 2017، “دائرة وثلاث سيقان” لخالد علي، سنة 2019، “القبلة السّوداء” لتغريد حبيب، سنة 2021، “ذاكرة شخصيّة تجربة جماعيّة” لعادل أبي الهيجاء، سنة 2018. ونستطيع أن نعدّ العشرات بل المئات من الرّوايات والسّيَر الّتي ألّفها كتّاب من الدّاخل الفلسطينيّ في العقد الأخير، الأمر الّذي يجعلني أتساءل، على ضوء مقولة: أنّ أيّ أدب ينزع إلى التّأليف الرّوائيّ بعد فترة من الحياة الهادئة والاستقرار، على اعتبار أنّ هذا الاستقرار يخيّم عادة بعد اختمار التّجربة الحياتيّة واكتمالها بنواحيها المختلفة، ذاتيّة كانت أم جماعيّة، سياسيّة أم اجتماعيّة. فهل استقرّت حياتنا وأحوالنا نحن المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في إسرائيل الّتي تميّز ضدّ وجودنا صباح مساء، ولا تجعل حياتنا تهدأ لساعة واحدة! فحروب وهدم بيوت وعنصريّة يوميّة ومجازر وسلب حقوق وأرض وتمييز فاضح ومكشوف وعنف ودعم وإيواء لعصابات الإجرام في مجتمعنا وسلاح كثير ومنتشر، تحت شبح حكومات يمينيّة عنصريّة متطرّفة ومستوطنين وجنود يعيثون فسادّا في ديارنا ومقدّساتنا! العكس هو الصّحيح! فحياتنا لم تعرف الاستقرار ولم تشهده منذ النّكبة، ولأنّ حياتنا يوميًّا تشهد حالة من القلق والخوف على مصيرنا السّياسيّ والاجتماعيّ والثّقافيّ والمعيشيّ، هذا القلق والتّوتّر هما سيّدا الموقف في حياتنا كعرب فلسطينيّين في بلادنا هذه الّتي تحكمها إسرائيل الآن! ولذلك وعلى كثرة التّأليف الرّوائيّ سنجد أنّ معظم الرّوايات يغمرها ويكتنفها ويخالطها القلق وعدم الاستقرار السّياسيّ بالذّات والحياتيّ بكافّة جوانبه، وستجدها مفعمة بالمآسي والآلام والعذاب لأنّ القضيّة الفلسطينيّة ما زالت عالقة وتزيد تعقيدًا بشكل يوميّ، وبخاصّة في ظلّ الهجمة الصّهيونيّة وفي ظلّ ممارسة التّنكّر للحقوق القوميّة الفلسطينيّة والقمع الدّائم، وكذلك تحت شبح الانقسام الفلسطينيّ المدمّر والتّطبيع العربيّ الرّسميّ الخؤون. وما زالت النّكبة ترين بملابساتها ومخلّفاتها السّلبيّة، ولذا لن يكون ثمّة استقرار في حياتنا إلّا بإزالة آثار النّكبة بالعودة وبالاعتراف بحقوق شعبنا القوميّة بدولة وعاصمة وعلم وجيش، وبحقوق مجتمعنا العربيّ بالمساواة والحياة الكريمة بإلغاء كافّة السّياسات والممارسات الصّهيونيّة السّلطويّة والعنصريّة الّتي ارتكبت بحقّنا كبشر وعرب وفلسطينيّين نعتزّ بانتمائنا الفلسطينيّ والعربيّ والإنسانيّ.
كفر قاسم مجزرة ورواية:
والسّؤال الآخر، هل هناك مَن كتبَ رواية عن مجزرة “كفر قاسم”؟ لقد بحثت ولم أجد حقيقة! لكنّي أثناء بحثي وجدت الكثير ممّا كتب عنها، كتاريخ ووثائق وروايات شفويّة مدوّنة وتجارب وأبحاث ومقالات وقصائد وصوّرت كأفلام سينمائيّة توثيقيّة، كلّها تتناول المجزرة وآثارها بالتّحليل والشّرح والتّعليق، فالمخرج اللّبنانيّ “برهان علويّة” (1941 – 2014) هو صاحب السّبق السّينمائيّ الّذي وثّق المجزرة، وقصائد كتبت تعبّر عن شراسة المجزرة ووحشيّتها وألم النّاس الأبرياء وموت الأطفال والنّساء، لسميح القاسم قصيدة “ليد ظلّت تقاوم”، ولتوفيق زيّاد قصيدة “كفر قاسم” حيث صوّر المجزرة الوحشيّة “حيث يذبح النّاس ذبح البهائم”. وكتبت روايات كثيرة عن مجازر صهيونيّة ضدّ الفلسطينيّين في كلّ مكان وعلى مدى الزّمان منذ ما قبل النّكبة بل منذ “وعد بلفور” سنة 1917، وحتّى المجزرة في مخيّم “جنين” والّتي وثّقها الفنّان الفلسطينيّ “محمّد بكري” في فيلم “جنين جنين” وما زالت المجزرة ترتكب قضائيًّا ضدّه وضدّ وثيقته الصّادقة.
الكاتبة المصريّة “رضوى عاشور” (توفّيت سنة 2014) كتبت روايتها “الطّنطوريّة” سنة 1994 عن مجزرة قرية “الطّنطورة” المهجّرة سنة 1948، الواقعة على السّاحل الفلسطينيّ، على بعد 24 كم إلى الجنوب من “حيفا”. وكتب إميل حبيبي عن نكبة الشّعب الفلسطينيّ روايته “الوقائع الغريبة لاختفاء سعيد أبي النّحس المتشائل” وكتب غسّان كنفاني عن تشريد عرب “حيفا” في روايته “عائد إلى حيفا” وكتب إبراهيم نصر الله رواية “أعراس آمنة” عن حصار غزّة والانتفاضة الثّانية، وسحر خليفة كتبت رواية “صيف حارّ” صوّرت فيها اجتياح “نابلس”، وكتب جبرا إبراهيم جبرا عن الهدم الصّهيونيّ وصور الحرب والدّمار في “بيت لحم” و”القدس” في روايتيْه: “صيّادون في شارع ضيّق و”البحث عن وليد مسعود”، أمّا الكاتبة الفلسطينيّة الأميركيّة سوزان أبو الهوى فكتبت سنة 2010 روايتها “بينما العالم نائم” تناولت فيها المجازر في التّاريخ الفلسطينيّ والتّشريد وحياة البؤس في المخيّمات.
وكتب كتّاب من العالم العربيّ عن النّكبة والمجازر، الكاتب اللّبناتيّ إلياس خوري الّذي تعيش فلسطين فيه، كتب روايته الطّويلة “باب الشّمس”، ومن ثمّ تحوّلت إلى فيلم سينمائيّ، وكتب الرّوائيّ الجزائريّ “واسيني الأعرج روايته “سوناتا لأشباح القدس” صوّر فيه حياة الاغتراب وحياة الفلسطينيّ بلا وطن بعد التّشريد القسريّ، وكتب الكاتب الكويتيّ إسماعيل فهد إسماعيل وفاء لصديقه الفنّان الفلسطينيّ ناجي العلي “مرثيّة للغائبين” وهم من رموز فلسطين الأدباء والفنّانين: ناجي العلي، محمود درويش وإميل حبيبي. وكذلك كتب الكاتب الفرنسيّ، الإنسان والمناضل الثّوريّ “جان جينيه” روايته “أسير عاشق” سنة 1983، كتبها بأسلوب شاعريّ وفاء واحترامًا للثّورة الفلسطينيّة، صوّر فيها نشاط الفدائيّين في الغابات والمخيّمات، حيث عاش بينهم فترة من الزّمن. ولكنّي وللمرّة الثّالثة أقول إنّ رواية أسمهان خلايلة “طيور المساء” تعدّ سبّاقة في تناول مجزرة “كفر قاسم” ضمن عمل روائيّ فنّيّ، فيه كلّ مقاييس تأليف الرّواية الفنّيّة.
وفي لقاء لي مع ب. إبراهيم طه سألته عن الأمريْن، فأكّد لي وهو المطّلع على كلّ المؤلّفات الرّوائيّة الفلسطينيّة في الدّاخل، أكّد أنّه لم يعثر على رواية فنّيّة تناولت مجزرة “كفر قاسم”، وسألته ما سرّ الإقبال على التّأليف الرّوائيّ في أدبنا الفلسطينيّ المحلّيّ؟ فكان جوابه إنّ البعد عن الحدث يخلق جوًّا من الهدوء والنّظر إلى الحدث بموضوعيّة، فإثر النكبة لم تكتب إلّا عدّة روايات قليلة، ولكنّ بعد النكبة بعشرين عامًا كتبت عشرات الرّوايات، واليوم العدد فاق ذلك بكثير، بغضّ النّظر عمّا تعالجه الرّوايات من أحداث ومضامين، فالحياة تغيّرت ومجالات الاهتمام كذلك، وصعود بعض القضايا على سلّم الأولويّات كحقوق المرأة وظروف المعيشة وقضايا العلاقة مع الآخر اليهوديّ والعلاقات الإنسانيّة العامّة كالحبّ والخلاف بين القديم والجديد وكثير من الصّراعات الّتي أملاها الواقع على حياتنا وأدبنا وبخاصّة على مضامين مؤلّفاتنا الرّوائيّة.
“طيور المساء” لماذا:
ما تبادر إلى ذهني عندما قرأت عنوان هذه الرّواية “طيور المساء” هو سؤال: هل ستعود الطّيور المسائيّة ذات صباح، أليس “موعدهم الصّبح، أليس الصّبح بقريب”! فالطّيور مخلوقات رائعة وجميلة تملأ الدّنيا زقزقة ينعش القلوب فنقبل على رغد الحياة، وتغريدًا تستريح له الأرواح المتّقدة بالحبّ والخضرة وربوع الوطن، والطّيور مخلوقات ضعيفة واهنة لا تقوى على أحد ولا على شيء إلّا على إسعادنا بموسيقى تخلب ألبابنا شوقًا إلى عشق كلّ جميل، وربّما لجمالها ولضعفها ولحكمة ربانيّة جعلها الخالق تحلّق بعيدًا عن قسوة الأرض بإنسانها الظّلوم، وعن همومنا الّتي لا نرتاح إلّا بتحميل أسبابها للآخرين، فلا نجد من خروج من مآزقنا وانسجامًا مع مصالحنا الدّنيئة إلّا بالقتل والتّدمير وارتكاب الموبقات والشّرور بالاعتداء على الآخرين ممّن هم أضعف منّا، من إنسان وحيوان وطير، ليصل لسان هذه الأطماع حدّ ارتكاب المجازر الوحشيّة بحقّ أناس وطيور عائدة إلى أوطانها في المساء بعد أن غادرته بفرح في الصّباح.
والمساء نهاية اليوم، نهاية يوم عمل شاقّ للفلّاح العائد من حقله وللعامل الّذي أضناه التّعب العائد من مكان عمله، نهاية يوم تسجد فيه النّفس وتخلد للرّاحة والصّلاة، وتخلد الطّيور المسائيّة في وكناتها مع أبنائها، المساء نهاية العمر، خريف العمر الشّاحب والأصفر كصفرة الموت بعد ربيع حياة وشباب غضّ وبعد صيف ورجولة صلبة، إنّه نهاية الحياة وانسدال ستائرها السّوداء على ما كان من حبّ ووطن وحياة وقوّة ولقمة عيش كريمة وجهد وافر وعرق جبين شريف. فهل يكون المساء بداية من جديد ويكون مقدّمة لانبلاج صباح غد مشرق وعزيز! وهل ثمّة أمل بعودة الطّيور إلى الحياة بعد أن تغادر وكنانها اللّيليّة الّتي كانت همومها كموج ليل امرئ القيس! قد يستفيق العامل بنشاط بعد نوم ليوم عمل جديد، وقد يعود الفلّاح ليروي أو ليجني أو ليحلب أو ليطعم مع تنفّس السّحر وأذان الفجر ليصلّي ويمضي بمحراثه وفدّانه وأدواته إلى الحقل أو الكرم! ربّما! ولكن هل تعود الطّيور بعد هجرة طويلة! ربّما ثانية! وهل يعود النّاس بعد نكبة وتشريد! وهذه ربّما أخرى! ولكن هل تعود الطّيور والنّاس بعد مجزرة مساء نكبة طويل بلا آخر! وإلّا ماذا أرادت الكاتبة أسمهان خلايلة من وراء اختيار هذا العنوان المفعم بالمعاني والدّلالات لروايتها، والّذي يشكّل عتبة للنّصّ، ويرمز كإشارة سيميائيّة إلى بعض المضامين الّتي تتعلّق بحبكة رواية “طيور المساء”. لا تحيّرني الطّيور ولكن ما يحيّرني حقًّا هو المساء! وما يزيد في حيرتي هو ذلك الدّمج بأبعاده ودلالاته بين الحقيقيّ الواقعيّ والمجازيّ الرّمزيّ في “طيور المساء”.
لوحة الغلاف:
ومن المهمّ الانتباه للوحة الغلاف الّتي عبّرت تعبيرًا جيّدًا عن المجزرة ومعانيها ودروسها ودلالاتها الواقعيّة والرّمزيّة، رغم خلوّها من أمريْن هامّيْن: صورة مجموعة للطّيور العائدة وصورة لأطفال ويافعين يحملون راية الجيل القادم الّذي يحمل الأمل السّاطع للمستقبل الّذي نرسّخ فيه وجودنا بصمودنا وتحدّينا لآلات القتل والمجازر الصّهيونيّة الوحشيّة في كفر قاسم وفي كلّ مكان على ثرى فلسطين الطّاهر. ومع ذلك عبّرت صورة العجوز الّتي تتوكّأ على عكّازها عن النّاجين من المجزرة كشاهد على الجريمة، تحمل مفتاحها الّذي يتدلّى من يدها كعلامة سيميائيّة دالّة على العودة، وهي الوجه الحقيقيّ لحقيقة النّكبة والتّشريد والمجازر، وكأنّها تردّد مع الشّاعر الفلسطينيّ المقاوم، ابن مصمص راشد حسين:
“مهما صنعْتُمْ منَ النّيرانِ نخمدًها ألمْ تروْا أنّنا منْ لفحِها سُمّرُ
ولوْ قضيْتُمْ على الثّوّارِ كلّهُمُ تمرّدَ الشّيخُ والعكّازُ والحجرُ”
وصورة للقبر للوهلة الأولى يفوح منه الموت، ولكن بعد رؤية الشّجرة الصّغيرة الخضراء الّتي جذورها راسخة وأصلها ثابت في الأرض وفرعها شامخ إلى السّماء ندرك أنّ الرّائحة الّتي فاحت هي شذا الرّبيع والحياة المتدفّقة من صميم الموت المشرّف ومن جثث الشّهداء الّتي روت التّراب فانبثقت من التّراب خصوبة تفيض علينا تماسكًا وطنيًّا وصمودًا ثوريًّا، وقد ترمز الشّجرة الغضّة كنبات يبعث الحياة إلى جيل غضّ وحيّ وشابّ من الإنسان الفلسطينيّ الّذي: “ما يطيع اللي ييجينا بالعنادِ ولم يتعوّد على بوس الأيادي”.
ولا بدّ من الإشادة بالفنّان الطّمراويّ الشّهير مبدّا ياسين على لوحة الغلاف المعبّرة والجميلة، ولكن كان لا بدّ من أن تضمّ طيورًا صباحيّة عائدة وابتسامات الفرح تعلو مناقيرها وتمتلئ بالأمل عيونها.
البطل:
البطل كعنصر قصصيّ يتعالق بكثير من العناصر الرّوائيّة الأخرى، قد يكون أبرزها الأحداث وتسلسلها المتحرّك والمتصاعد، وفي صميم تلك الأحداث الحبكة الرّئيسيّة، دون إغفال لحبكات أخرى ثانويّة مرافقة تدعم الحدث المركزيّ وتعطيه تشكيلات متعدّدة، عندما تحتدم المواقف والشّخصيّات سواء ذات البطولة الفرديّة أو الجماعيّة. من هو البطل في رواية “طيور المساء”؟ لو أردنا أن نشير إلى بطل فرديّ بعينه فلن نجد مثل هذا البطل الدّائم الحضور وصاحب التّأثير الدّائم في الأحداث والأشدّ تأثّرًا منها، والّذي يشكّل قطبًا مركزيًّا تدور حوله الأحداث وتكمّل دوره الشّخصيّات الثّانويّة. فهل هو؟
مروان:
المعلّم الشّيوعيّ الّذي تعرّض للفصل من العمل والإبعاد والتّحقيق الأمنيّ المتتابع لمحاولة ثنيه عن المسار الوطنيّ وتثبيط عزيمته الكفاحيّة وإهانته وإذلاله، حتّى أمام أعين زوجته الّتي تحبّه ويحبّها كعاشقيْن رغم أنّه أنجب منها بعد خمس عشرة سنة من الزّواج! ومع ذلك ظلّ صابرًا صامدًا ويعلّم الأولاد خارج ما رُسم له أن يعلّم وفق تضييقات وزارة المعارف الإسرائيليّة الّتي كان أبرز ما يهمّها تجنيد المعلّمين والموظّفين للتّعاون الأمنيّ مع جهاز المخابرات، وظلّ “مروان” على مواقفه الوطنيّة والكفاحيّة ولا يأبه لتضييق الخناق على المعلّمين الوطنيّين الرّافضين للتّعاون، بل إنّه يمقت هؤلاء أذناب السّلطة العملاء كالمختار والملك الأردنيّ، ويعشق مصر الثّورة والمقاومة وجمال عبد النّاصر والاتّحاد السّوفييتيّ ويكره القوى الاستعماريّة: فرنسا وبريطانيا وذيلهما إسرائيل لعدوانيّهم ومحاولاتهم إسقاط النّظام العروبيّ في مصر، وظلّ يقيم الاجتماعات ويقود المظاهرات. أحبّ زوجته مريم الّتي لم تنجب له الأولاد، وكانت تدفعه للزّواج من أخرى ولكنّه لإباء في نفسه أبى أن يفعل ذلك، فتحوّلا إلى عاشقيْن، حيث كانت مريم تظهر له “كثمرة خوخ في الخريف” ويجهران بالمناجاة والغزل المشتهى في الفراش، انظر إلى هذه الصّورة من العشق، إذ عاد مروان بعد شهر من عمله في مدرسة برطعة: “استسلم كلاهما للحظة عشق كادت تفقدهما صوابهما تعانقا بعدها وراحا في غفوة لذيذة” لقد جعلت الكاتبة علاقة حبّ رومانسيّة رقيقة بين الزّوجيْن، ويشاء الله أن يهب للزّوجيْن العاشقيْن ولدًا فصار مروان أبا فارس ومريم أمّ فارس بعد 15 سنة من الزواج والعشق، وعاش مروان كأهل بلدته أجواء المجزرة الرّهيبة، وعاش بعض أحداثها وشهد بعضًا آخر، واتّهم واعتقل وجرح أثناء القيام بواجب الشّهداء، لقد كان مروان نموذجًا لجيل المجزرة، ومن ثمّ شهد احتفال العرس الجماعيّ الّذي سيقام لتسعة وأربعين زواجًا من أبناء القرية وأبناء القرى المجاورة، وكان ابنه فارس وخطيبته حوريّة من هؤلاء الأزواج، والأهمّ روائيًّا أنّ هذا الزّواج الجماعيّ خطّط له أن يكون يوم 29/10/1986 في الذّكرى الثّلاثين للمجزرة ووفاءً للشّهداء التّسعة والأربعين. فما هي دلالة ذلك؟ دلالته رمزيّة ووطنيّة تستشرف المستقبل المشرق من قلب الماضي المظلم، تستشرف الحياة من الموت، والفرح الأبيض من الموت الأسود، والأعراس والزّواج والإنجاب حتّى نعوّض الخسارة الّتي لا تعوّض، ونقول للمجرمين، السّفاحين، قتلة الأجنّة والأطفال والنّساء، أننّا هنا سنبقى وسنعيش ونكبر ونتزوّج ونخلّف وسنكثر وستعود الطّيور ذات صباح مشرق، انسجامًا وتأكيدًا لما قال شاعرنا الوطنيّ توفيق زيّاد في قصيدته “هنا باقون”:
“هنا، على صدوركم باقون كالجدارْ
وفي حلوقكم كقطعة الزّجاج، كالصّبّارْ
وفي عيونكم زوبعة من نارْ
نجوع .. نعرى .. نتحدّى
ننشد الأشعارْ
ونملأ الشّوارع الغضاب بالمظاهرات
ونملأ السّجون كبرياء
ونصنع الأطفال جيلًا ثائرًا وراء جيلْ
كأنّنا عشرون مستحيلْ”
فارس:
فارس هو الابن الوحيد لمروان ومريم، وهو سليل هذا البيت الوطنيّ المكافح، وهو يمثّل الجيل الّذي لم يشهد المجزرة، بل كانت بالنّسبة له حدثًا بارزًا في تاريخ الصّراع، خرّيج الجامعة الّذي يستعدّ لزواجه من خطيبته في ذلك العرس الجماعيّ الوطنيّ والاحتجاجيّ على سياسة القمع والمجازر. ولد بعد المجزرة في كفر قاسم، وهو من جيل الشّباب الّذي نما وترعرع وشبّ مع أحداث يوم الأرض سنة 1976 حيث ارتكبت مجزرة أيضًا بحقّ أبناء شعبنا، الّذين دافعوا عن الأراضي وطالبوا باسترداد ما صودر منها. فارس ينتمي إلى جيل جديد مثقّف ومتعلّم، يدرك أهمّيّة الذّاكرة والرّواية خاصّة في دولة قامت على رواية كاذبة، تحاول أن تبني شرعيّة وجودها على تغيير الوعي، ولذلك هي تسعى لطمس الرّواية الفلسطينيّة بالقتل والمجازر ومصادرة الأرض وتغييب المعالم والشّخصيّة الفلسطينيّة وعروبة هذا الوطن، يدرك فارس كلّ ذلك ويعي أنّ المجزرة المروّعة الّتي ارتكبت بحقّ أهل قريته ما هي إلّا جزء من سياسة صهيونيّة إجراميّة، غايتها اقتلاع الإنسان الفلسطينيّ وسلخه عن ترابه. أخذ فارس على عاتقه تسجيل الرّواية للمجزرة الّتي لم يعشها بل ولد بعدها، وهي مهمّة ليست سهلة بل هي ضروريّة، إنّها شكل من أشكال الوفاء للحقيقة والشّهداء ولإثبات زيف الرّواية الصّهيونيّة وإظهار جرائمها ومجازرها من أجل الحفاظ على هويّة الوطن بأجياله القادمة. أيكفي لبطولته، وهو العاشق الّذي سيتزوّج من حبيبته قريبًا يوم العرس الجماعيّ في اليوم الثّلاثين لذكرى المجزرة الّتي ارتكبت سنة 1956.
الحاجّة هنا:
الحاجّة “هنا” المسنّة ذات الذّاكرة المذهلة “كانت وقت حدوث المجزرة وهي النّاجية والشّاهدة الوحيدة الّتي ما زالت على قيد الحياة”، عايشت أحداث المجزرة الرّهيبة بأمّ عينها وعاشت المجزرة الوحشيّة بأمّ وجدانها وأحاسيسها وعاينت مرتكبيها المجرمين ورأت دماء الشّهداء تسيل وتسقي الأرض طهرًا، ورأت جثث الرّجال والأطفال والنّساء على جوانب الطّرقات والأزقّة. لقد اعتمدها فارس كمصدر أساسيّ حيّ على المجزرة، فالحاجّة رغم كبر سنّها ما زالت “تتمتّع بصحّة جيّدة وذهن صافٍ وذاكرة قويّة”، كانت إحدى أربع عشرة امرأة من العائدات من العمل “عند اليهود” ساعة الغروب، يوم المجزرة، اعتمدها كامرأة ولم يرد اعتماد رجل من النّاجين، لأنّ “الذّاكرة النّسويّة غنيّة، طاقة جبّارة ومتفجّرة هي المرأة”، وإلى جانب قدرتها على تفصيل أحداث المجزرة، كانت تمتلك روح دعابة للتّرويح عن النّفس من آلام المجزرة ورائحة الموت، ممّا يجعل حديثها على ما فيه من مرارة وحزن جذّابًا ومشوّقًا. وإلى جانب تفاصيل أحداث القتل والموت كانت تحفظ الكثير من الأحداث الّتي سبقت المجزرة، كالعمل في الحقول بعد النّكبة وأخبار الأعراس والزّواج والطّلاق، وكذلك حدّثت فارس عن زواج أبيه بأمّه وعن الحبّ الّذي ربط بينهما، وكيف لم ينجبا حتّى ولد فارس بعد خمس عشرة سنة من زواجهما وما رافق تلك المسيرة من آلام وآمال وعذاب وعذوبة. أوّلًا لموقف نسويّ يؤازر المرأة اختار الوجدان النّسويّ في الكاتبة الحاجّة هنا عمودًا أساسيًّا في رواية الرّواية كشاهد موثوق، وثمّة سبب آخر هو إبراز دور المرأة الأسريّ والاجتماعيّ والكفاحيّ إلى جانب الرّجل، في مختلف مناحي الحياة وبخاصّة في تحصيل لقمة العيش بشرف وكدّ وجبين كريم وشامخ، المرأة ولّادة، وهناك سبب ثالث هو تخلّي الكاتبة/ الرّاوي الكلّيّ عن مسؤوليّة السّرد بنقلها وإعطائها لأحد الشّخصيّات، فارس، وهو بدوره يعطيها لمن هو أحقّ منه، الشّاهد الحيّ الّذي عاش وعايش معمعان الحدث من صميمه، إنّ هذا التّخلّص من السّرد أسلوب قصصيّ معروف للابتعاد عن الذّاتية والظّنون ولإضفاء الموضوعيّة والشّرعيّة على الأحداث، خاصّة وأنّ لرواية “طيور المساء” بعدًا توثيقيًّا يرمي إلى هدف وطنيّ عظيم. هو تعزيز الموقف الكفاحيّ من أجل الحفاظ على عروبة هذا التّراب، وعلى الهويّة القوميّة للإنسان وإبراز شخصيّتنا الفلسطينيّة الّتي يبغي الجزّار الصّهيونيّ تغييبها بطمس الرّواية الحقيقيّة عن الوعي وزرع الرّواية الملفّقة مكانها.
الشّهداء القتلى والجزّارون القتلة:
لم تشهد ساحات المجزرة والقتل قتالًا متبادلًا بين الشّهداء القتلى وبين المجرمين القتلة ولا حربًا بين جيشيْن ولا معركة بين سلطة ومقاومة! بل ما شهدناه مجزرة وعمليّة قتل جماعيّة لأناس أبرياء عزّل، عمّال وفلّاحين مسلوبي القوّة، بعد أن كدّوا طوال يوم عمل شاقّ كالعبيد لتحصيل الرّزق ولقمة العيش، ليس في أكفّ أياديهم إلّا أروحهم البريئة والطّاهرة، إنّها جريمة نفّذها جنود آلة الحقد الصّهيونيّة الإجراميّة الدّنسة، المدجّجة بالسّلاح والنّار والوحشيّة المنقطعة النّظير، ولذلك من الصّعب الكلام عن صراع فنّيّ في هذه الرّواية، لأنّه لا يوجد طرفان في الحقيقة، فطرفا الصّراع واحد فعّال وقادر وآخر مسلوب القدرة ومشلول الحركة والفعل! في “الجبهة” الأولى من جبهات المجزرة مجموعة من الفتيات العاملات الباحثات عن لقمة العيش بشرف وبعرق الجبين وكدّ، المظلومات وشبه المستعبدات لأرباب العمل الجدد الظالمين من أجل لقمة الخبز “والسّترة”، كنّ عائدات مساء ذلك اليوم في تندر محمود السّائق الّذي ينقلهنّ إلى العمل صباحًا ومنه مساءً، “كنّ الخصم المدجّج بسلاح العرق وغبار يوم شاقّ من العمل في الحقول”، لم يكن مساء هادئ لذلك الصّباح، ولا رواح لذلك الغدوّ. على مدى فصليْن كامليْن كانت المجزرة، في الفصليْن: الحادي عشر والثّاني عشر صوّرت تفاصيل المجزرة كما روتها الحاجّة هنا وسجّلها فارس على آلته، ومن ثمّ دوّنها بكتاب وزّعه على الحاضرين يوم العرس الجماعيّ في ذكرى المجزرة. كان النّداء العسكريّ: “أحصدوهم لا نريد لا جرحى ولا أسرى، الله يرخمه”، وقتلوا الحامل والجنين والفتاة المقبلة على الزواج والأمّ فوق جثّة ابنها الّذي جاء ليخبرها بأمر منع التّجوّل، ظلّت آلة القتل تعمل وتحصد وتقصف أرواح النّساء “حتّى شكّلن دائرة هي حلقة رقصهنّ الأخيرة في هذا الرّقص الدّمويّ”، في دائرة الدّم الفلسطينيّة. أمّا “الجبهة” الثّانية ففيها الطّرف الصّهيونيّ الجزّار، فرقة من عصابات الإجرام وسفّاحي الدّماء، والطّرف الثّاني الخراف الوادعة الّتي لمّا تتناول لقمة العشاء الأخير، مجموعة من العمّال العزّل المرهقين حصدوهم بعد أن تعرّضوا للتّخويف والإهانة والإذلال بعد يوم عمل شبيه بعمل العبيد، أكمل “الشّيطان عرس الدّم”، أعداد القتلى لا تعدّ ولا تحصى، صار العدّ بأكوام القتلى، كومة من الفتيات وكومة من الرّجال العمّال وكومة خارج القرية وكومة في داخلها، وبالرّغم من ذلك نجا إسماعيل بدير وصالح العيسى وظلّا شاهديْن على الجريمة. و”جبهات” أخرى في كروم الزّيتون والحقول، استطاعت سدّ كلّ منافذ القرية، بين الآلة المدجّجة بالسّلاح والحقد الصّهيونيّ وبين العمّال العزّل العائدين من أعماله المرهقة متعبين جائعين، وجريمة أخرى وأخرى، وكلّها تنتهي بأكوام من جثث الضّحايا، “ألقوهم كما تلقى البضاعة الفاسدة”. و”عاش المجرم شدمي”! ويا لعار الصّهيونيّة الأبديّ!
لا مروان وحده ولا فارس وحده ولا الحاجّة هنا وحدها ولا مجموعات الضّحايا وحدهم وقد كانت مجموعات فرق القتل العسكريّة الصّهيونيّة مرتكبة المجزرة هي ما يصحّ أن يطلق عليها “اللابطل”، ليس واحد من أولئك هو البطل منفردًا، لا أحد منهم ولا أحد آخر من غيرهم وحده البطل! بل لكلّ طرف من هذه الأطراف قسط ودور في البطولة، ممّا يقول أنّ البطولة في هذه الرّواية جماعيّة، وهو اختيار مقصود من الكاتبة لدلالة رمزيّة عميقة، مؤدّاها أنّ مرتكب الجريمة هو سياسة تكشف نظام عنصريّ ودولة اضطهاد واحتلال وتشريد والضّحيّة 49 شهيدًا من قرية كفر قاسم، ولكن مصيبة المجزرة أنّ الموت غزا شبحه كلّ بيت وكلّ أسرة في القرية ذات ال2000 نسمة، بل غزا إحساس الخوف وارتدى ثوب السّواد والإحساس بجبروت العدوّ وعنصريّته وإجرامه كلّ المجتمع العربيّ، أولئك البقيّة الباقية في وطنها، حوالي ال200 ألف نسمة، الذين بقوا كالأيتام على مأدبة اللّئام، يتجرّعون كأس مرارة ضياع الأهل والأرض والصّبر على ظلم “الملّاك” الغرباء الجدد، والعمل في أراضيهم كعمّال وفلّاحين بشبه سخرة وتحت التّهديد بقطع لقمة العيش، والملاحقة والحرمان والطّرد من العمل والتّمييز العنصريّ والإبعاد والقتل والمجازر. لقد كان بطل الرّواية هم طيور المساء العائدة بكلّ ألوان همومها ومعاناتها. ولذلك يصحّ القول أنّ هذه الرّواية تحمل اسم بطلها.
الرّاوي والسّرد والحوار:
قلت في موقع سابق أنّ الكاتبة نقلت بذكاء وبأسلوب معروف روائيًّا مسؤوليّة الرّواية لإحدى شخصيّاتها، وهو تخلّص مشروع، فالرّواية مسؤوليّة ثقيلة، ومن العادة عندما تكون شخصيّة في الرّواية هي الرّاوي فإنّ القصّة تُروى بضمير المتكلّم. ليس الأمر كذلك في هذه الرّواية، لأنّ الرّواية مسؤوليّة كما قلنا ولأنّ للرّواية جانبًا توثيقيًّا هامًّا، ولكنّ كتابة الرّواية وبالرّغم من أهمّيّة جانبها أو وظيفتها التّوثيقيّة للفائدة التّاريخيّة والسّياسيّة والوطنيّة ليست كتابة تاريخيّة، فالمؤرّخ يهتمّ بما حدث وأسباب ما حدث حقيقيًّا، أمّا فارس الّذي “ينتابه في الآونة الأخيرة هاجس كتابة رواية يوثّق فيها أحداث المجزرة”، فقد جعلته الكاتبة على وعي لدوره ككاتب رواية فنّيّة تنطوي على السّرد الفنّي رغم اعتمادها بالأساس على الحقائق التّاريخيّة الحقيقيّة، ولم يستنكف فارس الرّاوي من التّدخّل في طرح آرائه كشخصيّة ذات دور هامّ في الرّواية و”ليبتعد في روايته عن أسلوب التّوثيق وجفاف لغته، يجب أن يكون أسلوبه شيّقًا يشدّ القارئ ويستفزّه”. كي تسرد يجب أن تحدّد اتّجاهك ومضامينك وأهدافك وأن تحدّد مصادرك لتعتمدها، ولذلك كان لا بدّ لفارس المولود بعد المجزرة بعقود قليلة أن يبحث عن شاهد حيّ، وقد أحسن اختياره للحاجّة هنا النّاجية الوحيدة من “جبهة” مجزرة الفتيات، وقد أحسن لأنّ الحاجّة امرأة عجوز ولكنّها ذات “صحّة جيّدة وعقل صافٍ وذاكرة قويّة”، ولذلك لا نستطيع القول أنّ فارس كان راويًا كليًّا عليمًا بكلّ شيء، بل هو راوٍ جزئيّ يبحث عن المعرفة، كما يبحث القارئ نفسه، وقد حاول أن يحافظ على موضوعيّة في السّرد، ولكنّ العلاقة الّتي نمت بينه وبين الحاجّة هنا من قبل اللّقاءات وأثناءها وبعدها، جعلت الذّاتيّة تهيمن بعواطفها وأحاسيسها لتغمر الموضوعيّة المنشودة، خاصّة وأنّ فارس هو شخصيّة لها علاقاتها مع الجميع، فهو ابن المناخ العامّ وابن مجتمعه وابن مروان المناضل الّذي تعرّض للكثير من التّضييقات في حياته العمليّة كمدرّس وشيوعيّ وبخاصّة تعرّضه للجروح أثناء إنقاذ الجرحى ونقل القتلى في المجزرة الرّهيبة، والحاجّة هنا هي “الأمّ الكبيرة الحاضنة للجميع”. ولذلك جاء السّرد مزدوجًا، اختلطت فيه موضوعيّة الحقائق للتّوثيق والتّاريخ وحفظ الذّاكرة الجمعيّة والوطنيّة والرّواية الحقيقيّة أمام رواية الزّيف الصّهيونيّة المزوّرة، اختلطت مع ذاتيّة المواقف لإبراز العلاقات العاطفيّة الأسريّة، والعلاقات بين الأحبّاء والأزواج والعلاقات الأخويّة بين أهل البلد الواحد، أصحاب الهمّ الوطنيّ الجماعيّ الواحد، والرّؤية الوطنيّة والمواقف السّياسيّة والقوميّة المتعاطفة مع ثورة 23 يوليو والزّعيم العروبيّ جمال عبد النّاصر، الّذي قهر العدوان الاستعماريّ الثّلاثيّ، وكانت إسرائيل ذيل الاستعمار المجرور، ونتيجة لخسارتها وخسارة القوّتيْن الاستعماريّتيْن: فرنسا وبريطانيا في العدوان، ولخسارة إسرائيل أمام المقاومة في غزّة ارتكبت المجزرة الوحشيّة الرّهيبة في كفر قاسم. ورغم الانسيابيّة في اللّغة وفي السّرد وتدرّج الأحداث، في كثير من المواقف والصّور والمشاهد الرّوائيّة وبجماليّة فنّيّة عالية وديناميكيّة متّزنة، أبرزها الحادثة الّتي بدأت بتحرّش المقاول اليهوديّ ديفيد، ومن ثمّ محاولة اعتدائه على شرف حوريّة خطيبة فارس وعروسه القادمة، والّتي انتهت بمقتله صدفة! وما رافق ذلك من إهانات ومخاوف وتحسّب وصراع نفسيّ بين الحفاظ على لقمة العيش والحفاظ على الشّرف والعرض (الفصل الثّالث) وكذلك صورة الصّراع بين تمييز السّلطة العنصريّة وحقوق المواطنين العرب في التّنقّل والتّعليم وأحوال المدارس المزرية والفقر وسائر الحقوق المدنيّة في هذه الدّولة الّتي صرنا مواطنيها وهي ترفضنا فأصابنا كما قال المثل: “رضينا بالهمّ/ البين والهمّ/البين مش راضينا فينا” (الفصل الخامس) وصورة الصّراع وتناقض المواقف بين الشّيوعيّين وسائر الوطنيّين وبين العملاء المتعاونين مع السّلطة ضدّ مصلحة شعبهم وقضاياه، يمثّل مروان الفريق الأوّل ويمثّل المختار الفريق الثّاني ومفتّشو الوزارة (الفصل الخامس) ولعلّ أجمل هذه الصّور وأكثرها تصويرًا للمشاعر تلك الصّورة الّتي قدّمتها الكاتبة لعلاقة الزّواج والعشق بين مروان وزوجته مريم، رغم عدم الإنجاب إلى أن جاء فارس ثمرة لذلك الزّواج بعد خمس عشرة عامًا ( الفصل السّادس) وكذلك لا ننسى الدّيناميكيّة الرّائعة في تصوير أحداث المجزرة الرّهيبة في أكثر من موقع أو “جبهة” (الفصل الحادي عشر والثّاني عشر) فصول وصور ومواقف دراماتيكيّة، ومع ذلك ورغم تلك الدّراماتيكيّة والانسيابيّة في تسلسل الأحداث إلّا أنّ الجانب التوثيقيّ والتّاريخيّ على الرّغم من أهمّيّته كرسالة لكنّه أساء للأحداث الدّراميّة وأبطأ من حركتها وأعاق من حيويّتها واندفاعها من مرحلة إلى مرحلة، وهذه تسجّل كعلامة سلبيّة في مبنى أحداث هذه الرّواية رغم كثير من الإيجابيّات الّتي أشرت إليها من قبل.
لا تخلو رواية فنّيّة من الحوار كعنصر مثير، حيويّ، متحرّك ونامٍ يسند السّرد، ليس فقط من ناحية أنّه يخفّف من رتابته، وفي هذه الرّواية يقوم بدور هامّ كون السّرد يأخذ منحًى آخر غير المنحى السّرديّ الرّوائيّ هو المنحى التّاريخيّ الّذي يرمي لغرض التّوثيق تطبيقًا للرّسالة الوطنيّة لهذه الرّواية. ليس هذا فحسب فالحوار بنوعيْه خارجيًّا (ديالوج) أم داخليّا (مونولوج) يجعلنا نستكمل صورة الشّخصيّة من خلال سماعها مباشرة، وإذا كان حوارًا داخليًّا فإنّه يظهر عواطفها وهمومها النّفسيّة الدّاخلية بطريقة الاستبطان الفنّيّ، وكثيرًا ما يعطينا البيئة الاجتماعيّة الّتي تضطرب فيها الشّخصيّات، ولذلك كان من الضّروري للكاتبة أن تختار الحوار باللّغة العاميّة كأسلوب أضفى المزيد من الحركة على الحبكة بتسلسل أحداثها وترابطها، وأضاف تشويقًا للقارئ لأنّه سيحسّ أكثر بالشّخصيّات وسيقتنع بها من حيث أنّها تتكلّم بلغتها الحقيقيّة والواقعيّة، وهو أمر يرفع من القيمة الفنّيّة للرّواية عامّة، وفي “طيور المساء” خاصّة.
المبنى الفنّيّ:
منذ البداية تلقينا الكاتبة مدفوعة برسالتها الوطنيّة في خضمّ النّكبة الفلسطينيّة، وما تمخّض عنها من احتلال واستيطان ومجازر وتشريد قسريّ، وأبرز صورها سلخ الإنسان عن الوطن تحقيقًا لمقولة الرّواية الزّائفة والملفّقة “جئنا شعبًا بلا أرض لأرض بلا شعب” هذه المقولة الّتي فنّدتها وكذّبتها الأيّام والحضور وبشكل يوميّ منذ 1948 حتّى 2022 وأبرزها الأحداث السّياسيّة، وفي صميمها كفاح شعبنا من أجل البقاء والصّمود والتّطوّر، متحدّيًا الممارسات الصّهيونيّة العنصريّة والإجراميّة حدّ ارتكاب المجازر الجماعيّة بحقّ الأبرياء والعزّل والفقراء من عمّال وفلّاحين يعملون بأراضيهم الّتي صادروها، وبظروف شبيهة بالعبوديّة لتحصيل لقمة العيش بشرف وكرامة، بغية بثّ مشاعر الخوف والإحباط واليأس لتستكمل جريمة ترحيل البقيّة الباقية من الفلسطينيّين، وقد كانت مجزرة كفر قاسم شاهدًا على تلك السّياسة الإجراميّة. وقد انتصرت الأيادي الخالية للفلّاحين على الأيادي المدجّجة للعسكر، وانتصر لقمة العيش الكريمة على لؤم الجلّاد والاستعباد.
الإطار العامّ للأحداث ينطلق من تلميح قد يبدو عاديًّا للوهلة الأولى، حيث كانت العاملات الفلّاحات تتجمّعن بفرح وأجواء يغمرها الفرح باللّقاء والهمّ، منذ الصّباح الباكر بين أذان الفجر وشروق الشّمس للذّهاب للحقول، في صباح ذلك اليوم الّذي بدأ بأنس وفرح وإقبال حلو على الحياة رغم مرارتها، وعندما انطلقت سيّارة “التّندر” الّتي تقلّهنّ للعمل في الأراضي الّتي سُلخت من كفر قاسم والّتي صادرتها حكومة اليهود، “خلّفت وراءها سحابة كثيفة من الغبار، تعالت بسرعة وأخفت معالم كفر قاسم”. أليست إشارة ذكيّة من الكاتبة على الغبار العنصريّ الأسود الّذي ستلفّ كثافته وسواده الضّحايا الأبرياء! ولكنّه انتهى بشؤم ومجزرة مروّعة وموت أولئك الصّابرات المعذّبات وغيرهنّ من أهالي القرية نساء ورجالًا وشيوخًا ويافعين وأطفالًا، في ذلك الصّباح قالت زغلولة إحدى العاملات لفاطمة صرصور، وهي عاملة حامل: “لا تخافي يا بنيّتي، الحبلى ما بتموت، الحبلى بتجيب حياة جديدة، والحمد لله، ما بموت جيل إلّا بيكبر جيل …”، إنّ هذا الموقف يعتبر نقطة الانطلاق الأولى في بداية الأحداث ولكنّه تلميح موظّف للنّهاية السّعيدة (الهابي إند) حيث انتهت الأحداث في الملعب البلديّ بعد ثلاثين عامًا، بالعرس الجماعيّ في الذّكرى الثّلاثين للمجزرة، تسعة وأربعون من الأزواج سيتزوّجون وسينجبون، فارس وحوريّة زوجان منهم، ممّن شبّوا كجيل يوم الأرض، معنى ذلك كما أعتقد أنّ الكاتبة قصدت هذا الرّبط الفنّيّ المحكم في المبنى وإطاره العامّ، معناه أنّ من ولد يوم المجزرة وبعدها الآن كبروا وصاروا رجالًا ونساء يتزوّجون وينجبون وسيعوّضون البلد عن ال49 ضحيّة بأعداد مضاعفة من الأعداد، بأجواء من الفرح الجماعيّ كما “تجمّعت مصيبة الواحد في الجميع والجميع في الواحد”. وبين المدماك الأوّل في هذا المعمار وبين المدماك الأخير جرت مياه كثيرة في أنهار الحبكة الرّئيسيّة وغيرها من حبكات ثانويّة، شكّلت خلفيّات سياسيّة واجتماعيّة ووطنيّة وتراثيّة أغنت النّصّ وجعلت منه نصًّا روائيًّا متنوّعًا. ولكنّ الحقيقة أنّ ما جرى بين الهيكل العامّ للمبنى الرّوائيّ ليست مياهًا بل دماء زكيّة طاهرة.
الخلفيّات:
استطاعت الكاتبة أن تنجح كما قلت قبل قليل أن تجعل من روايتها نصًّا متنوّعًا رغم أن الحبكة الرّئيسيّة هي المحور الأساسيّ، وانطلاقًا منها وحولها وخدمة لها كتب هذا النّصّ بتشعّباته وخلفيّاته الّتي أثرته بالصّور والمواقف الحياتيّة المتعدّدة. ولعلّ الخلفيّة الاجتماعيّة الّتي تعكس حالة المجتمع القرويّ الفلّاحيّ بشكل عامّ هي الأكثر بروزًا، دون التّقليل من أهمّيّة الخلفيّة السّياسيّة وطنيًّا وقوميًّا، إلى جانب استخدام صورًا فولكلوريّة من تراثنا العربيّ الفلسطينيّ وتوظيفها خدمة للمعمار الفنّيّ وأساليب بنائه وللغرض الأساس تاريخيًّا وتوثيقيًّا وللقيمة الجماليّة والرّسالة الوطنيّة والقوميّة.
وأبرز سمات المجتمع الفلسطينيّ أنّه مجتمع متكافل، مشارك تنبع قيمه من تراب الأرض، متمسّك بالدّين الحنيف، السّمح بالفطرة والتّربية، مجتمع يقوم على البساطة والطّيبة والعلاقات القرويّة المتينة، فالواحد يعرف الجميع أفرادًا وجماعات عائليّة وحمائليّة، والكل للواحد والواحد للكلّ، وبشكل خاصّ في وقت الرّخاء وبشكل أخصّ في وقت الشّدّة، فالعرس والفرح فرح الجميع والموت والتّرح أجواء تغمر الجميع، والإحساس بالحزن جماعيّ، والهمّ الاجتماعيّ واحد رغم أنّ لكلّ تميّزه في همّه الخاصّ ومعاناته الذّاتيّة، ولعلّ الصّفحات (24 – 34) من الفصل الثّاني هي الأصدق تصويرًا لحياة الفلّاحين وظروف معيشتهم، والّتي في صميمها الفقر والشّقاء في الأرض والرّضا والقناعة والاتّكال على الله. كما تصوّر تلك الصّفحات وغيرها عادات القرويّين في تقديس العِرض، وتصوّر كذلك ألوان مطاعمهم ومشاربهم ولباسهم وأغانيهم وأعراسهم وفكاهاتهم وحكمتهم الفطريّة المحبّبة. لقد كان كلّ ذلك خلفيّة للمجتمع المنكوب بالمجزرة، وكأنّ الكاتبة أرادت أن تقول، ألا يكفي هذا المجتمع ما فيه من الهموم من الشّقاء والهموم وما ينتابه من الظّروف المعيشيّة الثّقيلة والفقر، ألا يكفيه حتّى تحلّ عليه هذه المجزرة الرّهيبة بعد معاناة المصادرة والتّشريد والنّكبة!
ومن هذه الخلفيّة الاجتماعيّة تنبثق صور تراثيّة أخرى وموادّ من فولكلورنا الفلسطينيّ أغنت النّصّ بالكثير من المعاني والدّلالات أبرزها الأمثال والحكم والأغاني الشعبيّة. الأمثال منتج جماعيّ يعكس خلاصات تجارب حياتيّة وتدلّ عن حكمة فطريّة ولكنّها عميقة المعنى وبعيدة الأثر، ولقد أحسنت الكاتبة في هذا الجانب، وقد استطعت أن أسجّل لها أكثر من عشرين غناء شعبيًّا وأكثر من عشرين مثلًا وحكمة، والأكثر لفتًا للنّظر والاهتمام أنّ هذه الأغاني والأمثال منبثّة على طول الرّواية منذ صفحاتها الأولى وحتّى صفحاتها الأخيرة، وفي ذلك دلالة على أنّ هذه الموادّ الغنيّة بعمق معانيها ودقّة تصويرها تحوّلت إلى جزء من النّصّ الرّوائيّ فأغنته بخلفيّة من الحكمة القرويّة، الفلّاحيّة الّتي تسهم في إظهار الرّوح الوطنيّة بصدق روايتها وذاكرتها أمام الرّواية الصّهيونيّة الزّائفة.
العبرة السّياسيّة والدّرس الوطنيّ:
حتّى اللّيلة الّتي سبقت المجزرة، ورغم أنّ النّكبة السّوداء ما زالت ترين بكآبتها وآلامها على أهالي القرية وبعد ثماني سنوات “ظلّت كفر قاسم هادئة وادعة إلى أن أغرقها طوفان النّكبة”، وظلّت رغم التّشريد والاقتلاع والمصادرة والتّمييز العنصريّ تعيش في أجواء من الفرح والتّعاليل والأعراس وصوت الحادي “أبو نجم” يجلجل مطربًا المحتفلين وردّاته تردّ روح السّامعين بالنّشوة والفرح والاعتزاز، وظلّ صباحها “صباحًا عاديًّا من صباحات أواخر صيف عام 1956″، يوم المجزرة الوحشيّة المروّعة. لقد أرادت الكاتبة أن تحمّل روايتها درسّا وعبرة ورسالة وطنيّة وقوميّة وإنسانيّة، هي أنّ هذا الوجود الفلسطينيّ، ومن خلال قرية لا يبلغ عدد سكّانها أكثر من 2000 نسمة، لكنّ أهلها “كانوا يشعرون بكفر قاسم كأنّها قلب فلسطين الثّائر”، وهذه عبرة أخرى، فقد أرادت الكاتبة أن تجعل مجزرة كفر قاسم مأساة فلسطين كلّها وطنيًّا وكارثة الأمّة العربيّة كلّها قوميًّا، أرادت الكاتبة أن تقول إنّ قضيّة كفر قاسم هي القضيّة الفلسطينيّة بكامل آلامها ومواجعها وبكبر آمالها وإشراقات شموس استقلالها. إنّ أولئك الفلسطينيّين العرب الّذين تشبّثوا بترابهم وقراهم وهويّتهم في كفر قاسم نموذج لغيرهم من القرى، فقد كانت قرية من 2000 نسمة وصارت اليوم مدينة كبيرة “عامرة ثامرة” يصل عدد سكّانها إلى ما يزيد عن 25000 نسمة، أليس هذا تحدّيًا للسّلطات الصّهيونيّة الّتي تريد أن نتناقص ونذوب ونغيّب بالكامل، أليس هذا الوجود والحضور المتطوّر اجتيازًا للمحنة والمجزرة والموت بالفرح والأعراس والإنجاب والتّكاثر، أليس هذا الحضور الوطنيّ والقوميّ والحضاريّ شوكة في عيون الغاصب والمحتلّ الصّهيونيّ، أليس هذا ما يجعل الأرض حتّى الآن ومستقبلًا “بتتكلّم عربي” كما غنّى “سيّد مكاوي”! أليس هذه رسالة الكاتبة الوطنيّة! نعم لقد أثّر هذا الجانب على المستوى الفنّيّ، ولكن من يستطيع أن ينكر أن هذا الجانب على مقام وطنيّ رفيع من الأهمّيّة! وما هو الأدب بكلّ أجناسه وألوانه وفنونه إذا لم يطرح قضيّة ولم يحمل رسالة وطنيّة أو قوميّة أو إنسانيّة.
بعد فصل من فصول المجزرة الدّمويّة الخريفيّة كتب فارس: “خيّم الصّمت وتابعت الجروح الحيّة والميّتة نزيفها، وشربت الأرض الدّماء كأنّها تروي بذور موسم خريف قادم”، والموسم القادم هو الأمل الفلسطينيّ بالعودة، ولا أقلّ منها! والأمل العربيّ بانتصار أنظمة وطنيّة تحارب العدوان الثّلاثيّ وكلّ عدوان آخر مهما بلغ عدد المعتدين على أرضنا وشرفنا وكرامتنا القوميّة، أنظمة تحلم بحرّيّة الإنسان العربيّ وبالوحدة العربيّة كهدف أسمى، أنظمة كنظام جمال عبد النّاصر الثّوريّ، الّذي رفض أن يبيع كرامة مصر والعرب بحفنة من الدّولارات.
أكثرت الكاتبة من الكلام عن الوطن ومكوّناته المادّيّة وتفاصيله المعنويّة، فقد كتبت عن الأرض وقيمها والفلّاح وتشبّثه بها، عن الدّين والإيمان، عن الـتّقاليد والعادات، عن الفطرة والحكمة والبساطة، عن العلاقات والتّكافل الاجتماعيّ، عن الرّجل والمرأة والجيل القديم والجيل الحديث، عن الأطعمة والمشارب والطّبيخ وصنع الكعك، عن الغناء الشعبيّ والحداء والطّبّ الشّعبيّ، وعن القصص والخرافات، عن النّبات والحيوان، لم تترك لا كبيرة ولا صغيرة، لا شاردة ولا واردة من الجزيئيّات الصغيرة الّتي بتكاملها وانسجامها تعكس الوطن الكبير. فماذا أرادت من كلّ تلك التّفاصيل؟
لقد أرادت الكاتبة – وجميل وضروريّ ما أرادت – أن تعكس المجتمع الفلسطينيّ العربيّ من خلال واقعه المتميّز، وهو مجتمع قرويّ فلّاحيّ برمّته، أرادت الكاتبة – ومفيد ما أرادت – بكلّ ذرّة من ذرّات مداد في قلمها أن تعكس كلّ ذرّة تراب من ذرّات تراب الوطن، لانّها هي قيمة وجوديّة ووجدانيّة، فرديّة وجماعيّة، وطنيّة وقوميّة وإنسانيّة، قيمة توقد في النّفوس شعلة أمل وتوقظ الأرواح بنبض الحياة المتدفّقة برفض الظّلم والموت وبالتمسّك بالحياة والعدالة والحرّيّة والكرامة.
بدأت الكاتبة روايتها “طيور المساء” بصباح جميل بدأه الشّهداء بيوم عمل جديد وأنهتها بعرس جماعيّ جميل بعد ثلاثين عامًا والفرح يعمّ القرية/ فلسطين كلّها وفرح انتصار جمال عبد النّاصر يعمّ الأمّة كلّها. أنهتها بعبارة جاءت على لسان أبو فارس قالها لزوجته الحبيبة: “الحمد لله، شوفي يا أمّ فارس ما أحلى جمعة أهل بلدنا وضيوفنا! أشعر الآن أنّ الشّهداء ينامون مطمئنّين في قبورهم، ولن تغيب شمس كفر قاسم”. حبّذا لو أنهت الكاتبة عبارتها تلك بعبارة قصيرة أخرى ذات دلالة تتابع بها: “وعلى قبور الشّهداء أرى الربيع يبرعم ويزهر، وأشعر في هذه الأجواء من الفرح بأنّ أبناء طيور المساء ترفرف بأجنحتها عائدة بنشوة انتصار مع شذا نسائم صبح الوطن”، موعدنا الصّبح، “أليس الصّبح بقريب”!