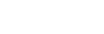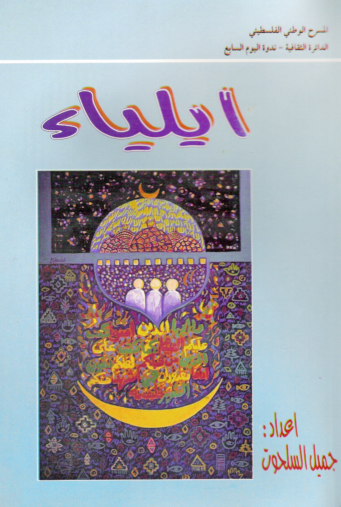غيّب الموت مساء الخميس 31 آذار 2016 الحاج يوسف علي دخيل أبو العمل، والموت حقّ على الأحياء كلهم، والرّاحل ليس شخصيّة سياسيّة، أو رسميّة، لم يُعرف على مستوى الوطن، لكنّه كان شخصيّة اجتماعيّة رائدة ومعروفة في البيئة التي عاش فيها، وترك بصمات لا يمكن نسيانها أو محوها من ذاكرة من عرفوه، ولد الفقيد في عرب السّواحرة قضاء القدس عام 1927م، في بيئة بدويّة فقيرة، عاش حياة اليتم وهو طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، لم يتعلّم في مدرسة، لكنّه جدّ واجتهد تحت رعاية عمّه الذي تزوّج أمّه، وعرف كشخصيّة قياديّة منذ نعومة أظفاره، كان طويل القامة وسيما ذا بشرة شقراء وعينين زرقاوين، ممّا أكسبه مهابة منذ بداياته، جعلته يجالس شيوخ القبائل ووجاهاتها منذ بداياته، فاكتسب منهم معرفة العادات العشائريّة، حيث أصبح يشار إليه بالبنان كواحد من أصحاب البيوت التي تشكّل مراجع عشائريّة لحلّ الخصومات بين النّاس، واكتسب احترام من عرفوه كونه يتحلّى بالنّزاهة، وعفّة النّفس، والجرأة في قول الحقّ، ونظافة اليد، والكرم العربيّ الأصيل.
كان الفقيد طويل القامة قويّ البنية، وقوّته لافتة، اشتهر بصدق انتمائه لعائلته وحامولته” الشقيرات” وبلدته “عرب السواحرة” ومدينته القدس الشريف، ووطنه فلسطين. تربّى على القيم الحميدة، وتمسّك بها حتّى اللحظة الأخيرة من عمره، استقبل استشهاد أحد أحفاده والحكم على شقيق الحفيد الشهيد بالمؤبد برضا تامّ، رغم حزنه الشّديد الذي احتفظ به لنفسه، حمد الله كثيرا ورضي بشهادة حفيده.
ومع أنّه كان أمّيّا لا يقرأ ولا يكتب مثل غالبيّة أبناء جيله، إلّا أنّه عرك الحياة وعركته، وكان مثّقّفا اجتماعيّا، ذا حكمة بائنة، بنى نفسه بنفسه، ونجح في تكوين نفسه، كان محبّا للعلم والمتعلّمين، يفاخر بالمتعلّمين النّاجحين في حياتهم، ويبني عليهم آمالا كبيرة بالنّهوض بشعبهم وأمّتهم، وينتقد بشدّة المنطوين منهم على ذواتهم، ومن أقواله في انتقاد عدم الفاعلين اجتماعيّا من المتعلّمين قوله السّاخر:” بعض المتعلمين –مع الأسف- شهاداتهم كجوهرة معلقة في رقبة كلب”!
ومع تربيته ونشأته العشائريّة، إلا أنّه لم يكن محبّا للشّر والمشاكل العشائرية، وكان يسخر بشدّة ممّن يعتبرون الشّباب الذين ينزلقون في مشاكل عشائريّة، بوصفهم أنّهم -ويقصد الشّباب- أولاد جهلاء، ويتساءل: متى سيصبحون رجالا؟ وفي أكثر من مرّة استشهد على ذلك من خلال البيئة التي عاشها بقوله: ” من المعيب أن نتعامل مع شبابنا مثل “جحش الغنم، كنّا نأتي بجحش صغير وندرّبه ليقود قطيع الغنم، وفي مراحل عمره المختلفة نتعامل معه كجحش، ويموت ونحن لم نطلق عليه يوما “حمارا” كأنّه لم يكبر! فهل نقبل بأن يبقى أبناؤنا أولادا ما دمنا أحياء؟ ولماذا لا نتعامل معهم كرجال؟
عندما دخل مرحلة الشّيخوخة، وهدّت جسمه الأمراض لم ينكسر، وبقي شهما كريما حكيما كما كان في عنفوانه. ورحل تاركا خلفه السّمعة الطّيّبة، وأبناء يحملون اسمه، فلروحه الرّحمة، ومثله بالتأكيد يُفتقد، لكنّها سنّة الحياة التي تختتم بالموت.
1 نيسان 2016