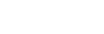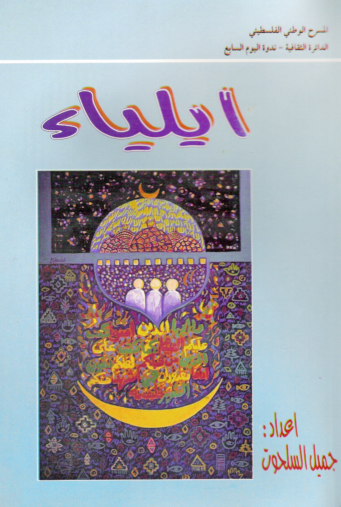القدس:22.9.2016 من رنا القنبر: ناقشت ندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس رواية ابو دعسان للكاتب ربحي الشويكي، وتقع الرواية الصادرة عن منشورات لجان العمل الثقافي في 341 صفحة من الحجم المتوسّط.
قال محمد يوسف القراعين:
إذا كان الكاتب ربحي هو المذكور في آخر الرواية، ربحي بن محمد زكي بن الحاج لطفي أبو دعسان، فهو ينقل عن أبيه الذي ينقل عن جده أخبار العائلة، وأحداث الخليل وعادات أهلها، مع أنه عاش معظم حياته على ما أعتقد في القدس.
على كل حال، فالرواية خليلية مئة في المئة، حيث دعس بنا الكاتب، مواكبا الخليل منذ نهاية العهد التركي، إلى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، أي ثلاثين عاما بالتمام والكمال، مبتدئا بمداهمة الكوليرا في نهاية الحرب العالمية الأولى لمدينة الخليل,التي تحولت إلى مدينة أشباح، بعدما هجرها أهلها إلى الكروم، ومنهم فاطمة زوجة أبو دعسان التي توفيت بعد أن نقلت الوباء إلى العريس دعسان أو حمادة، الذي توفي تاركا أباه دون وريث ذكر، وهذا غير مقبول في الخليل. فمن يرث أملاكه بوضعه الاقتصادي الأفضل بين أبناء عمومته، وكل سكان الحوش، وهو بالإضافة إلى ذلك يتاجر إلى الكرك ونابلس. ومن يهتم بابنتيه اللتين تعاونتا نتيجة لذلك مع زوجته الثانية وسيلة لإقناع أبيهما بالزواج، الذي يتم بعد تقديم ابن عمه أبو أحمد ابنته زكية، وهي في الثامنة عشرة زوجة للحاج لطفي ابن الستين حلالا عليه بثوبها هدية لا تُرد! عندما أصبح الأمر جدا، تلعثمت الأم وسيلة أو زينب ولكنها باركت له وخاصة أن زكية غير جميلة، وهي تعتقد أنها قادرة على السيطرة عليها أكثر من غيرها. وهنا تبدأ الحكاية التي يتابعها الراوي بالتفصيل الزائد، باستعمال أسلوب الحكواتي أحيانا.
هكذا كان الناس يعيشون في البلدة القديمة في أحواش، لكل منها بئر ماء، مثل حوش القنطرة في طرف حارة قيطون، حيث كان يسكن أبو دعسان في غرفة قسمها بحبل إلى قسمين، يعيش في أحدهما ابنه حمادة مع زوجته زهية، ويعيش هو في الثاني مع زوجتيه وابنتيه، غرف قد تكون متلاصقة في الحوش، مما شجع على ثقافة أن صوت المرأة عورة، يجب أن لا يسمعه الرجال، حتى فرحها يجب أن يكون بهدوء، وهل يجب على النساء أن يكفرن ليفرحن؟ أليست النساء حريما أجلكم الله؟ إنهن جاهلات. هذا مع العلم أن المرأة تقوم بالعمل الصعب، حتى في الحقل مع الرجل، بعد المخاض مباشرة، وعليها تحضير الدبس والعنب طبيخ مع نساء الحوش. أما الولد فيحتاج إلى ألعاب خاصة بالرجال- حسب رأي أبو دعسان- ويجب تربيته بدون دلع، كما علق عبد الحميد حتى يكون رجلا كما يجب، في حين يستنكر الحاج سلمان سؤال عبد الله في الزاوية عن رضيعه حمدان، فهذا حديث حريمي، وهذه زاوية لجلوس الرجال. ولإعادة النسب بين الأهل، كانوا يحجزون البنت حين مولدها لأحد الأبناء بخرزتين، مثلما فعل أبو دعسان، عند طلب صفية بنت عبد القادر لولده المدلل محمد زكي، وبعدها فتحية بنت عبد اللطيف، للطفي بن محمد زكي. أما عندما يكبر الولد, فإنهم يدعونه بكنيته، فمحمد زكي هو أبو لطفي، هكذا كان يناديه أبو دعسان.
في الخليل كان يكثر البلوط تيمنا ببلوطة أبونا إبراهيم، لذلك كنت تجد أن البلوط كستنا الغلابة، أما تحلية الرجال فالملبس والقطين والزبيب، والوجبة الرئيسية في الشتاء بطاطا مشوية وشرحات بندورة مجففة وحبات زيتون مع فحل بصل بجانب الخبز. والكرَم سهل في المناطق الشعبية مقدور عليه، مرقة عدس وقرعة صفراء، وفي الثلج الحطب أهم من الطعام.
الزواج يتم عادة بين الأقارب، والمهر عشرون جنيها بالإضافة إلى عشرة جنيهات زمن الحرب، على أن يكون الأثاث من أهل العريس، ومن مكوناته البيرو، بعد أن كان زمن تركيا صندوقا مزخرفا، مع ملاحظة أن البيرو كان من جهاز أمي في العشرينات، بينما ظهرت في الأربعينات الخزانة مع المرايا في القدس، وذلك في جهاز أختي. في السهرات التي تسبق العرس، تأتي الوفود حاملين اللوكسات متفاخرين بها، ثم تبدأ الدبكة وتغريبة بني هلال والحكواتي، والأهازيج الدينية، التي كنت ألاحظها في الأربعينات، لدى زفة العريس في الثوري المقابل لبيتنا بعد العِشاء، وهم يهزجون صلوا يا أهل الفلاح عالنبي زين الملاح، يا آمنة بشراك.. إلخ، وذلك على ضوء اللوكسات مساء الجمعة ليلة السبت، وقد سألت أحدهم لماذا ليلة السبت، فقال عشان تِسبت، قاصدا أن يثبت الزواج بلغة أهل المدينة. يطيل المؤلف في تحضير العريس لليلة الدُخلة، حيث يشارك الشباب في الحمام مع العريس، ويداعبونه بالإبر والمسلات أحيانا لإثارته والعدوى منه، وعند الدخول لمقابلة العروس يسير للخلف، وفي منتصف الليل يُطل بالخرقة البيضاء، كما لا ينسى أهازيج ليلة الحِنة للعروس، وهذه الشروحات التي تستغرق ثلاثين صفحة يمكن اختصارها بالوصف بدل الحوارات المطولة، وقس على ذلك أمورا أخرى.
هذا عن الأحوال الاجتماعية التي تعرفنا عليها الرواية، كسرد لواقع فرضته ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ هناك مثل كان سائدا: أن من يعيش في الخليل يرضى بالقليل. لذلك خرج النشيطون من أهلها للقدس أولا طلبا للرزق بالعمل في بيع الخضار والماء وبيع الخبز على البسطة، وكما تقول الرواية، بناءً على طلب الأفندية، حتى يحافظوا على الأراضي بشرائها حتى لا تتسرب لليهود. وهناك تتزامن هبة البراق في نهاية العشرينات مع المناوشات في الخليل، حيث يشارك شباب الرواية في العمليتين، يلي ذلك المقاطعة والثورة في منتصف الثلاثينات. وفي القدس يتكتل الشباب من جماعة أبو دعسان، ضد من يحاول الاعتداء عليهم، بشكل مفرط أحيانا بالفزعة التي تندرج تحت” انصر أخاك ظالما أو مظلوما”. وقد سكن معظم الخلايلة عند قدومهم للقدس في حي الثوري والبلدة القديمة زمن الانتداب، وقد نسي الكاتب أن يذكر أن الشباب الذين قدموا للقدس للعمل في بيع الخضار ونقل الأغراض بنوا في الأربعينات أجمل المباني على طريق الخليل غربي منطقة الثوري، مثل بناية العبيط وأبو سارة اللذين أصبحا من أكبر ملاكي شركة باصات الخليل الوطنية.
الرواية تسرد واقعا معاشا في الخليل، تقبله الجميع من شخصيات الرواية الذين يدينون بالولاء لكبارهم أبو دعسان وحماه سلمان أبو أحمد وتوجيهاتهما، اللذين يمثلان مجتمعا أبويا الكلمة فيه للكبير، يعيشون في أحواش مجمعة مثل حوش القنطرة وحوش إبراهيم الخامر في طرف حارة قيطون، ولم نجد من الشخصيات من يهدف إلى معالجة وتطوير بعض العادات السلبية، مثل قمع النساء وتزويجهن بدون استشارتهن، أو الفزعة، فليس للرواية مثل هذا الهدف. ومن الغريب أن أبو دعسان قضى ثلثي عمره ستين عاما، مكتفيا بتحديد النسل مع ولده حمادة وابنتيه رفقة وحنيفة، ثم دبت به الرغبة أن ينجب أربعة أبناء، كما يبدو أنه تزوج في السابق متأخرا، فدعسان توفي وهو عريس لم يكمل سبعة أشهر، ورفقة وحننيفة لم تكونا عندها قد تزوجتا بعد.
تعدد الشخصيات الذي يصل إلى أكثر من 35 يثقل على القارئ، إذ لا بد من رسم حلقة عنكبوتية مركزها أبو دعسان، فلا حاجة لهذا العدد إلا للمحافظة على شجرة العائلة. مثل ذلك يحدث عندما يتلقى أبو دعسان خبرا عن مرض زوجته فاطمة، حيث ينتقل من حوش القنطرة في حارة قيطون إلى زقاق الهيش في وادي التفاح على مهله، مرورا ببركة السلطان وانعطافا للدبويا، إلى عين دير بَحّه قرب الجلده، مرورا بدهدية الهيموني فنبع عين عرب، وأخيرا مربعة سبتة.
اللغة غير سليمة، وفيها أخطاء نحوية كثيرة ومطبعية، وكثير من المواقف فيها لغو زائد، وأنا استمتعت بقراءة الرواية؛ لأنها أعادت لي بعض الذكريات عن الخليل وأهلها.
وكتب جميل السلحوت:
رواية “أبو دعسان” والعودة إلى الجذور
صدرت رواية”أبو دعسان”للأديب المقدسي ربحي الشويكي في شباط 2016، عن منشورات لجان العمل الثقافي في القدس، وتقع في 341 صفحة من الحجم المتوسّط.
ربحي الشويكي:
ولد الأديب ربحي الشويكي في القدس عام 1945، درس علم الآثار في تركيا، وعمل في الصحافة المحلية الصادرة في الأراضي الفلسطينية، وهو عضو مؤسّس لاتّحاد الكتّاب الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة، وعضو هئيته الاداريةّ لأكثر من دورة، وهو أحد مؤسّسي ندوة اليوم السّابع أيضا، صدرت له رواية ” أنشودة فرح ” عام 1990 عن منشورات اتّحاد الكتّاب الفلسطينيين وروايات أخرى منها” خربة الأولياء”، “يارا” تغريبة يبوس”.
وها هو يصدر روايته هذه “أبو دعسان” و”معنى دعس في لسان العرب دَعَسَه بالرّمح يَدْعَسُه دَعْساً طعنه، والمِدْعَسُ الرمح يُدْعَسُ به، وقيل المِدْعَسُ من الرماح الغليظ الشديدُ الذي لا ينثني، ورمح مِدْعَسٌ والمَداعِسُ الصُّمُّ من الرّماح حكاه أَبو عبيد، والدَعْسُ الطعن والمُداعَسَةُ المُطاعَنَةُ،وفي الحديث فإِذا دَنا العدوُّ كانت المُداعَسَةُ بالرّماح حتى تُقْصَدَ أَي تُكْسَر ورجل مِدْعَسٌ طَعَّانٌ.”
والقارئ لهذه الرّواية التي يحمل غلافها صورة لمدينة الخليل، وللمسجد الابراهيمي، يجد نفسه أمام سيرة شفويّة لأسرة خليليّة، وكما يبدو أنّها سيرة والد الكاتب وجدّيه، وعلاقتهما بمحيطهما في مدينة الخليل، وكأنّها من خلال شخوصها تسجّل أيضا جانبا من التّاريخ الشّفويّ لمدينة الخليل، ولا ضير في ذلك، فكلّ كاتب يكتب شيئا من سيرته وسيرة آبائه وأجداده وبيئته، وإن لم يقصد ذلك، لكنّ كاتبنا في هذه الرّواية قصد ما كتب، وكأنّه يؤرّخ لأسرته، حتّى أنّه كتب الأسماء الحقيقيّة لوالده وجدّه، ولا ضير في ذلك.
وقد اتّحذت الرّواية التي يمتدّ تاريخها من بدايات القرن العشرين حتّى منتصفه، ودارت أحداثها في مدينتي الخليل والقدس ثلاثة محاور هي: وباء الكوليرا، “السفر بلّك” التعبئة العامّة التي أعلنتها الدّولة العثمانيّة في الحرب الكونيّة الأولى، وبداية انتقال عائلات من الخليل إلى القدس طلبا للعمل، وما لبثت أن اشترت أراضي وبيوتا، وعاشت في المدينة المقدّسة؛ لتشارك بدور فاعل في حمايتها من الغزو الاستيطاني اليهوديّ، ومعروف أنّ الحاجّ أمين الحسيني اتّفق عام 1932 مع وجاهات العائلات في الخليل، كي ينتقل الخلايلة إلى القدس للعمل والعيش فيها.
وقد جاء في الرّواية بعض التّفاصيل عن هذه البدايات، مثل معاناة الفلسطينيّين من الفقر والعوز والحرمان والجهل والمرض والأوبئة التي وصلت أوجها في أواخر العهد العثماني، وكذلك عن الصّدامات التي جرت بين الفلسطينيّين واليهود خصوصا في القدس، وكيف كان انحياز قوّات الانتداب البريطانيّ لليهود ضدّ العرب واضحا للجميع.
الموروث الشعبيّ: ورد في الرّواية وصف لبعض العادات والتّقاليد التي كانت سائدة في تلك المرحلة، فقد جاء وصف لكيفيّة الخطبة والزّواج وما يصاحبهما من طقوس وأغاني ودبكات شعبيّة وقِرى المدعوّين، كما تمّت الاشارة إلى موسم النّبي موسى وكيفيّة استقبال مفتي القدس الحاج أمين الحسيني لوفود المدن الفلسطينيّة الأخرى وحملة بيارقها في مدينة القدس.
الأخوّة المسيحيّة الاسلامية:
تطرّقت الرواية إلى الموسيقار واصف جوهرية، وهو موسيقار وعازف عود ومؤرّخ ولد في القدس سنة 1897، وتوفي في بيروت سنة 1973، وكيف كانوا خصوصا “محمد زكي” يستمعون لعزفه ويطربون، وكيف أرضعت عزيزة جورج بن واصف وفكتوريا عندما جفّ ثديا والدته، وهذه نقطة ذكيّة من الكاتب للتّأكيد على الأخوّة المتينة بين أبناء الشّعب الواحد بغض النّظر عن اختلاف الدّين. “انظر الصفحة 204-205”
الأسلوب: غلب على الرّواية طابع السّرد الحكائيّ، والتّكرار في بعض القضايا، مثل قضيّة آداء الصّلاة في المسجد الابراهيمي، حيث يجد القارئ في بعض الصفحات تكرار ذكر الصّلوات الخمسة، ويتكرّر ذلك كثيرا، مع أنّ ذِكر الصّلاة وردت من بدايات الرّواية ولا مبرّر لتكرارها بهذا الزّخم.
اللغة: اتخذت اللغة نسقا واحدا من البداية حتّى النّهاية، وقد وردت مئات الأخطاء اللغويّة والنّحويّة، وحبّذا لو تمّ الانتباه لها وتصحيحه، خصوصا مع وجود “مشرفة لغويّة”.
المونتاج والاخراج: مونتاج الرّواية واخراجها لم يكن موفّقا، فلم يتمّ الانتباه إلى كيفية عدم تناسق السّطور، وكيفيّة انزياح الكلمات من منتصف سطر لسطر جديد قبل انتهاء الجملة.
وقال نمر قدومي:
حكايات .. بذور .. وجذور متأصّلة
تدنّتْ السُّحب الكثيفة من فلسطين فأعاقت الحركة، ولا أرى إن كان قلمي يكتب ما يجول في خاطري من حقيقة، بالرغم أنَّ المسافة بيني وبين أرضي جدًا قصيرة. حبسوا أنفاسهم عميقًا لعلَّها تنقشع الغمامة، طال الإنتظار وطالت الظُلمة، وخَلَدتُ أنا إلى سبات أستعيد بعده العِبرة. زمن الحروب لن ينتهي، وحياة العامة من النّاس تسير كيفما يُديرها أصحاب بيوتها؛ حياة بؤس وفقر ومذلّة، وما يزيد على تعاستها تلك الكوارث التي تلحق بالإنسان والطبيعة. جاء إلى هذه الدنيا في الوقت الضائع من الزمن، وشاءت السماء أن تنصهر أنفاسه مع تراب الأرض كالطينة، وبرغم ضيق الحال فقد إستطاع أن يحمل قلمه ويزيد همّنا همّا بحكايات من التّاريخ هي مؤلمة. صفَّ الكاتب “ربحي الشويكي” حروفه من ثنايا الذّاكرة في رواية ” أبو دعسان” الإجتماعيّة السّياسيّة، وكأنها سيرة عائلته الذّاتيّة، الصّادرة عن منشورات لجان العمل الثقافي للعام 2016 والتي تقع في 341 صفحة من الحجم المتوسط. ويبقى في التاريخ فجوات زمانيّة وثغرات، إلاّ أنَّ الرواية تمثّل تعويضًا لهذا التاريخ، إنها تقول ما يمتنع الزمن عن قوله أو ما إندثر تحت رماده.
إنها فترة إنتهاء الدولة العثمانيّة وبداية الإنتداب البريطانيّ على الوطن، وقصّة عائلة الحاج “لطفي” الملقّب بأبي دعسان التي سكنت مدينة خليل الرحمن. هم أناس يهربون إلى المجهول في لحظات الغفلة، بحيث يتجمّد العقل والفكر عندهم في إتخاذ القرار، فيخاطبون من سذاجتهم الدّهر والقَدَر، ويصاحبون الخرافات، ولا يُزعلون الجنّ ولا العامورة ! كما أظهرت لنا الرواية بعض الأفكار والعادات التقليديّة المتوارثة من حُب الإنجاب للذّكور لحمل إسم العائلة، وإنتقال عاطفة الأب إلى الأولاد أكثر منها للزّوجة. أمّا في حال أنَّ البنت لم تتزوج أو فقدت زوجها أو والديها، فيكفيها أخًا لها تستظل بظلّه للحماية والسَنَد والدلال. كذلك شهدنا عادة حجز الصّغار لبعضهما وقراءة الفاتحة لربطهما حتى يكبرون ويتزوجون. ومن جهة أخرى، ظهرت بوضوح في الرواية آفة الإتّكاليّة التي يتّصف بها الكثيرون من البشر، وذلك عندما يخاف زعيم العائلة على أبنائه من مواجهة المُستعمر أو توزيع المنشورات الوطنيّة، فيتم تخويفهم الدّائم من السّجن أو الإعدام، وفي ظنّهم الخاطئ أنَّ هناك مَن يقوم بهذا الواجب الوطنيّ عنهم كفرض كفاية، وهذا بالتالي كان عاملًا مساعدًا ساهم في الهزيمة !!
ذكر الكاتب العديد من المناطق الجغرافيّة وأسماء مدن وحارات وزوايا وشوارع وأسماء عِلّيّات، وكذلك ذكر في روايته الحرم الإبراهيميّ والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتحدّث عن كارثة الزلزال في عشرينيّات القرن الماضي. أمّا الجد “أبو دعسان” كبير العائلة فكان يتنقّل على حماره بين الخليل وكلٍّ من نابلس والكرك للتجارة، في الوقت الذي كان يشغل النّاس التعبئة الإجباريّة في الجيش العثماني “السفر بلّك” وإنتشار وباء الكوليرا والفقر المُدقع، وأيضًا الثّورات والإحتجاجات من مساندة الإنجليز لليهود آنذاك. الكاتب “الشويكي” لم يُوثّق أو يفسّر لبعض الأسماء والتعابير المستخدمة قديما والتي يجهلها الجيل الجديد، إلاّ أنَّ اللغة المستعملة كانت سهلة. إنَّ عاطفة القارئ تجاه المُستعمر لم تتغيّر ، بينما تلك التي تلاحق أفراد عائلة “أبو دعسان” ومصيرهم، خلقت في الرواية بعض القفلات والحبكات ، لكنّها خَلَت من التشابيه البلاغيّة لجديّة الأحداث. إستخدم “الشويكي” الآيات القرآنيّة والأحاديث الشّريفة، وكذلك إستخدم الأمثال الشّعبيّة، كل ذلك بهدف تقوية النصوص. إعتمد الكاتب أسلوب السّرد الرّوائيّ مع بعض الحوارات بين الشّخصيّات، ناهيك عن فقر الإنتاج وسوء فن الطباعة للرواية بالإضافة إلى الكثير من الأخطاء النحويّة.
نستطيع أن نستشف من تاريخنا إلى السبب في وجود الكثير من عائلات الخليل في المدينة المقدسة، فالأمر يعود إلى ما قبل ثورة الثلاثينيات حين طلب مفتي القدس الحاج “أمين الحسيني” أهل الخليل إلى القدوم والرباط والتواجد فيها لحمايتها والدفاع عنها من الغزاة اليهود. وقد ألِفوا الحياة فيها وتمركزوا في كسب رزقهم وقوتهم في منطقة باب الخليل، حيث ميدان عمر بن الخطّاب، والذي كان أكثر المناطق تشاحنًا بين العرب واليهود والإنجليز. هناك مشاهد جميلة في الرواية تُحدّثنا عن مدى التسامح بين الأديان، عندما أرضعت “عزيزة” الطفل “جورج” إبن “ڤيكتوريا”، كذلك مشهد إنتظار الأهل للعروسين ليلة الدّخلة للمنديل الأبيض المُقدّس. يمكن القول أنه لا حصر لتلك القصص من التاريخ والشهادات التي تخرج من كل بيت فلسطينيّ أيّا كان موقعه على أرض هذا الوطن، وقد تختلف المسميّات أو البلدان، إلاّ أنَّ المصيبة واحدة والنكبة وقعت، وصداها لا يزال يهز كياننا وأجسادنا وقواعدنا. توفي “أبو دعسان” في التسعينات من العمر وهو قابض على يد حفيده كاتبنا “ربحي” ، وسيفتقد الأهل كرمه في توزيع المِلَبّس والقطين والزبيب عليهم في كل الأفراح والمناسبات السّعيدة.
وكتبت نزهة أبو غوش :
في عصر سيطر عليه الفقر والجهل والمرض، عاش بطل الرّواية أبو دعسان في مدينة الخليل الفلسطينيّة.
ماذا أراد الكاتب الشّويكي أن يقول في روايته؟
قال نحن شعب يحبّ الحياة رغم قهر المرض، رغم الكوليرا، رغم الفقر ، ورغم الاحتلال وعربدته.
قال نحن شعب يقاوم؛ من أجل الحياة. نزرع العود اليابس ليصبح أخضر يانعا. تتدلّى قطوفه، فنصنع منه الزبيب والدبس والملبن. لنضمن صيفنا، ونحمي شتاءنا.
قال ربحي الشّويكي: نحن مجتمع متآلف مترابط يحبّ بعضه بعضًا يحترم صغيره كبيره، ويعيل غنيّه فقيره ويساعد قويّه ضعيفه،
نحن شعب نكره الظلم وننصر المظلوم.
نحن شعب تهون علينا دماؤنا؛ من أجل الوطن.
نحن شعب نؤمن بالله ونتلقّى القدر بصبر .
قال : أولادنا هم امتداد لنا، نتزوج أُخرى وأُخرى؛ كي نتكاثر. لا نخجل من عاداتنا وثقافتنا. نكتفي بما قسمه الله لنا، ولا نتمرّد على عطاياه.
” التفّ الجميع حول مائدة كبيرة على الأرض مكوّنة من وعائين كبيرين من النّحاس، امتلأ الأوّل “بالرّوس” وامتلأ الثّاني “بالكرشات والفوارغ” ص299.
خطبة الأولاد منذ الطّفولة هي أيضًا كانت من العادات المتّبعة في زمن العثمانيين والانجليز. تجمّع العائلة والتفاف الأفراد حول بعضهم البعض، هي شيء ضروري ومقدّس.
حفظ القرآن والتّشجيع على حفظه مع اعطاء الحوافز للأطفال، هي أيضًا من العادات المتّبعة في ذلك الوقت.
الأفراح يفرح بها الجميع يشاركون بعضهم البعض يشاركون في الطّعام، ويبالغون في رقصهم وغنائهم، يرفعون السّيوف، ويشعلون المشاعل، يزفّون العريس بعد الحمّام. لا يتغيّب أحد عن الفرح إِلّا لعذر مقبول.
المباهاة بالفحولة مقابل شرف الفتاة، ويظهرون مناديل الشّرف على العلن.
أراد الكاتب ربحي الشّويكي أن يقول:
هكذا نحن. هذه هي عاداتنا وتقاليدنا نحترمها ونفتخر بها .
بلغته السّهلة البسيطة أراد الكاتب أن يقول لنا بأنّ شخصيّة البطل “أبو دعسان” شخصيّة متغيّرة وليست ثابتة، تطوّرت مع تطوّر الحياة. تزوّج من أُخرى بعد وفاة ولده دعسان؛ كي يخلّف غيره. علّم أبناءه، وآمن بأن العلم هو أساس النّجاح في الحيا؛ لذا قرّر أن يعلّم ولده محمد زكي، رغم رفض الجميع ومحاولة اقناعه بعكس ذلك.
شخصيّة محمّد زكي هي أيضًا شخصيّة متحرّكة متطوّرة.؛ حيث بدأت كشخصيّة موغوب بها من قبل العائلة كلّها كشخصيّة الطّفل المدلّل، الّذي وجد به والده تعويضًا عن ولده دعسان الشّاب الّذي توفّي اثر مرض الكوليرا.، ثمّ طفلًا ملتزمًا في الكتّاب يحفظ القرآن، ويتعلّم اللغة العربيّة والحساب، ثمّ شابًّا يافعًا يخجل ويحبّ، وشابًّا مجاهدًا في صفوف الثّوار
يساعد في توزيع المنشورات واخفائها، رغم معارضة والده خوفا عليه؛ وأخيرا شخصيّته كرجل متزوج ملتزم بعائلته حمل الرّاية عن والده بعد وفاته.
تحرّكت باقي الشّخصيّات في الرّواية في اطار الاجتماعات والوقوف للدّفاع عن الأقصى ومواجهة اليهود الّذين يحاولون دخول القدس.
الشّخصيّات الثّانويّة، مثل شخصيّة مصطفىى، أحمد، عبد القادر، عبد الحميد.، أبو لطفي…هي شخصيّات مكمّلة للشخصيات الرّئيسيّة، حيث أنّها ساهمت في بناء الاحداث. مثل الأفراح والعزاء والمقاومة، وغيرها.
شخصيّات النّساء في الرواية، شخصيّات تقليديّة ثابتة لم نلحظ بها أيّ تطوّر ملحوظ. هن نساء محافظات يتّبعن أزواجهنّ وأبناءهنّ واخوتهنّ وآباءهنّ؛ في كلّ شيء. لم نجد هناك شخصيّة معارضة لما يفرض عليها بالمجتمع، ربّما شخصيّة رحمة، حماة صفيّة تجرّأت على قول لا، حين عرفت بأنّ عروسة ابنها ستصبح عوراء، فرفضت حينها بأن تقبلها عروسا له الا حين تبيّن لها بأنها شفيت تمامًا.
شخصيّات الأطفال في الرّواية سلّط عليها الكاتب ربحي الشّوكي في أكثر من حدث، بل هي دخلت في معظم الأحداث: الأفراح والأتراح وتجمّع العائلة والسّفر والكتّاب، وأحداث اخرى. ممّا يوضح اهتمام الكاتب بجيل المستقبل، وعدم التصاقه بالماضي والحاضر فقط.
الحيوانات في رواية الشويكي لها دور مهمّ أيضا. الحمار، حيث أنّه وسيلة نقل في الكروم وفي الطّريق إِلى البيت، وفي السّوق…كذلك الجمل، أمّا الخاروف فقد قلّ التحدّث عنه، بسبب الفقر وقلّة شراء اللحوم، الا الأحشاء والرّؤوس منها.
وقال عبدالله دعيس:
(أبو دعسان) عنوان يدلّ على أصالة الحكاية، ويهيّئ القارئ لرحلة إلى أحضان التاريخ، يستقي من ينابيع الحياة في أكنافه، ويطّلع على حياة الناس العاديّين فيه بعيدا عن أحداث السياسة وتقلّبات الدول التي تزخر بها كتبه، ليسلّط الضوء على حياة أناس بسطاء، عاشوا حياة زاخرة لكنّهم غابوا في طيّات النسيان بعد أن ابتلعهم تراب الوطن. ولأنّ تأثيرهم في عجلة الحياة كان كبيرا وإن أغفلتهم الكتب؛ جاء من يحمل حكايتهم ويضعها على الصفحات، لتكون حكاية مدينتين تضرب جذورهما في أعماق التاريخ: حكاية القدس، وحكاية الخليل التي تكتسي هي الأخرى بهالة من القدسيّة وتنال دائما دورها من الصراع على هذه الأرض المباركة.
في هذه الرواية نعيش الخليل. نعيش مع ناسها الذين ما إن بدأوا ينفضون عن كواهلهم غبار عقود من الجهل والظلم والاضطهاد في كنف الحكم العثمانيّ، حتّى حطت عليهم غربان المرض والمجاعة والاستعمار الإنجليزي ثمّ أطماع اليهود الصهاينة. نعيش بحقّ آلام أهل الخليل وهم يعانون من انتشار وباء الكوليرا الذي حصد الأرواح، وحرم العائلات من فلذات أكبادها، وأظلّ المدينة بخيمة من الحزن والقهر زاد من شقاء أبنائها وأصابهم بالكآبة. وكذا حدث مع أبي دعسان الذي خسر وحيده وهو في سنّ الستين وبقي ليواجه الدنيا مهموما محزونا. لكنّ الحياة تستمرّ ويتزوج أبو دعسان في كبره ويرزق الأولاد ويعيش طويلا حتّى يرى الأحفاد، وكأنّ الفرح ينمو دائما في تربة الأحزان، والحياة مهما تقسو تمنّ أحيانا بأشعة السعادة التي تتسلّل من بين الركام.
ويبدع الكاتب ربحي الشويكي في وصف الخليل: فيصف أماكنها بدقّة ويرسمها بريشة فنان، ويذكر الأسماء القديمة للأماكن حتى ينقل القارئ إلى ذلك الزمان ويجعله يتجوّل في أزقة الخليل وحاراتها وحقولها مترامية الأطراف. ثمّ يدخل إلى بيوتها القديمة فيصفها بدقّة متناهية: بغرفها وعليّاتها وأثاثها وأماكن الجلوس والنوم واللهو وحتّى الأماكن التي يعتكف فيها الإنسان مهموما شاردا في دروب الأحزان. ثمّ يصف الملابس التي يرتديها الرجال والنساء والصبيان بأسمائها الشعبيّة محافظا على تراث بات يؤذن بالاندثار.
فالرواية مكانيّة اجتماعيّة بامتياز، فالحديث فيها يدور حول أدق التفاصيل في الحياة الاجتماعيّة في مدينة الخليل عبر عقود من الزمان، ومن ثمّ تتتبّع أهالي الخليل الذين انتقلوا ليعيشوا في مدينة القدس ويعملوا فيها. وتكتسب هذه الرواية أهميتها من أنّها تناولت موضوعا مهمّا وحيويّا ألا وهو الهجرة الداخلية لأبناء الخليل نحو القدس وتأثير ذلك على الحياة الاجتماعيّة في الخليل وفي القدس. وهنا تبرز الآثار الإيجابيّة لهذه الهجرة، حيث عادت بالمنفعة الماديّة على الخليل وأبنائها، ولكنّ الأهم من ذلك أنّ هذه الهجرة ساعدت القدس في صمودها بوجه الاحتلال ومنعت من تسرّب الأراضي والعقارات إلى الأعداء، وأغنت المدينة المقدّسة بالسكّان وتنوّع الثقافات، وأصبحت فعلا قلب فلسطين الذي ينبض بأهله الذين لهم مشاربهم المختلفة ويتكلّمون اللهجات المتعدّدة، لكن يوحدهم حبّهم لوطنهم ومناهضتهم لمحتلّيه. وأصبح هذا الكم الكبير من أهالي الخليل في القدس شوكة في حلق الاحتلال، وشجرة راسخة الجذور يصعب عليه اقتلاعها. والرواية تشير إلى بدايات هذه الهجرة حين طلب أهالي القدس من أبناء الخليل التوجّه إلى مدينتهم بدل من الهجرة خارج البلاد: فبينما جنح كثير من أبناء فلسطين إلى الهجرة خارج البلاد هربا من ضنك العيش، تنقل الخليليّون بين القدس والخليل ونشّطوا الحياة الاقتصاديّة في كلا المدينتين.
والخليل، في رواية ربحي الشويكي، جمعت بين حياة المدينة وروح القرية في توأمة فريدة نتج عنها حياة اجتماعيّة مميّزة، فقد أخذت عن القرية خشونة العيش وكدّ الرجال والنّساء وعن المدينة عنفوانها وعلاقاتها الاجتماعيّة وبعض عاداتها خاصة فيما يخصّ التعامل مع النساء؛ فكان مزيجا مميّزا فيه حنكة التاجر وشدّة ساعد الفلاح، أهّلت أهالي الخليل ليكونوا القوة الاقتصاديّة وشريان الحياة الذي حفظ الحياة في مدينة القدس عندما سكنوها.
ويتعمد الكاتب على أسلوب الحكاية، فالرواية مجوعة من الحكايات الشعبيّة المترابطة التي تسرد قصة ثلاثة أجيال من إحدى عائلات مدينة الخليل. ويلجأ الكاتب إلى المباشرة في السرد التفصيليّ، وإلى الحوار بين الشخصيّات عندما يرغب في تفصيل عادة اجتماعية ما ووصف التقاليد التي كانت سائدة في البلاد مثل الزواج واحتفالات الأفراح، ويقتضب كثيرا من الأحداث والسنوات أحيانا.
ومع أنّ الكاتب أسهب في وصف شخصيّاته الرئيسيّة لكنّه لم يبعث الروح فيها، ولم يسبر أغوار نفوسها، بل تركها لتكون شخصيّات كرتونيّة تتحرّك أمامنا دون روح أو حياة. ولم يعتنِ الكاتب باللغة كثيرا، بل ذهب على سجيّته يحكي عن هذه الشخصيّات بلغة بسيطة تخلو من الإبداع الأدبي والفنّي ولا تختلف كثيرا عن الكلام العادي الذي قد لا يرتقي إلى مستوى الأدب.
والرواية تزخر بالأخطاء المطبعيّة التي كان يمكن تجنّبها وتصحيحها أثناء المراجعة. لكن المشكلة الأكبر تكمن في العدد الهائل من الأخطاء اللغويّة، خاصة النحويّة، فهي أكثر من أن تحصى، ومنها هفوات كان يمكن تجنبها بقليل من الاهتمام والمراجعة. ويخلط الكاتب كثيرا، خاصة أثناء الحوار، بين صيغ التذكير والتأنيث ولا ينتبه إلى ذلك، وقد وقع في أخطاء “فيسبوكيّة” مثل إضافة الياء إلى تاء التأنيث (إنك أشفقتي) بدل أشفقتِ (بل بكيتي) بدل بكيتِ. هذه الأخطاء برأيي أساءت إلى الكتاب خاصة مع وجود مشرفة لغوية وإشراف عام على إصداره كما ذُكر في ص 2.
وكما هزّ الزلزال الكبير جدران القدس والخليل، وكما غمرت الثلجة الكبيرة شوارعهما وبيوتاتهما، غمرتنا هذه الرواية بشعور رائع أثناء قراءتها وأسدلت علينا حكاياتهما ثوبا جميلا أمتعنا وأفادنا، لذلك فنحن نتطلّع إلى طبعة جديدة بأسلوب جديد ينفض عن هذا الثوب ما علق به من شوائب كان تجنّبها سهلا يسيرا.
وكتبت رشا السرميطي:
من الحاضر إلى الماضي يعود بنا أبو دعسان
رواية أبو دعسان الصَّادرة عن منشورات لجان العمل الثَّقافي- 2016م، للكاتب ربحي الشوكي، وتقع في (341) صفحة من الحجم المتوسط، حملت القارئ إلى رحلة – أبو دعسان وعائلته عبر تاريخ قديم- وجاءت بنا اليوم لنفكّر من الحاضر إلى الماضي في زمن انتهى وعفت عنه الأيام، زمن ربما كان جميلا ببعض تفاصيله الطيّبة، والأكثر انسانيّة ومحبّة.
بدأ الكاتب روايته بسرد أحداث طالت شخصياته، وعبثت بمقاديرهم، ضمن سياق ثابت، أرهق قراءه، فمنذ انتشر وباء الكوليرا في حارة قيطون بالخليل وبدأ الناس يتساقطون، تساقطت تفاصيل حياة أبو دعسان وعائلته، على المتلقي تباعا بذات النسق، وبعد زواجه بفتاة تفرق عن عمره الأربعين سنة، لكي يعوّض وفاة ولده دعسان الذي التهمه داء الكوليرا، أخذ الفرح يتسلل لأجواء تلك العائلة قليلا، التي لم تنل الكثير منه بسبب الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة، التي أصابت منطقة الخليل في ذلك الوقت، حتى خرج الانجليز من المنطقة وسلموا القدس وانعكاسات ذلك على المناطق المحيطة أيضا. فانتهت الأحداث بمشهد يقبع به أبو دعسان في سرير المرض، يردّد الشَهادة وحوله أولاده وأحفاده ممَن بقوا هناك.
من أبرز المواضيع التي تطرق لها الشويكي- طبيعة الحياة البسيطة، الألفة الأسرية، تفاصيل العيش والألفة في الحي، المزروعات والزّي، وباقة من الموروث الثّقافي والتراثي، العادات والتقاليد أيضا. بأجواء اجتماعية قديما سادت في المنطقة آنذاك. الأكلات القديمة من زمن الطيبة، معاني الإنسانية العاطفية والايمان بالله وبتعويضه لعبده المؤمن الشاكر دائما، عادات الزواج والانصياع لأوامر الأب، حيث يخطب للأبناء وهم باللفة، مرّر الكاتب العديد من أخلاقيات التعامل وآداب المعاملة برزت بمواقف منها: صبر المؤمن على المرض، وعدم التَّخلي عن صفية حتى شفيت عينها. تطرق الكاتب لبعض التفاصيل الطريفة مثل موضوع العامورة وصفها وذكر أماكن وجودها، ولعنة من تحلّ عليه لعنتها، كمتخيل وهمي اعتقده الناس في تلك الفترة بأنه حقيقة خارقة، وقد برز الحمار كوسيلة نقل رافقت القارئ خلال أحداث الرواية جميعها، بوصف الطريق، والسرج، والبردعة، كما انسانية أبو دعسان واشفاقه عليه في بعض المواقف أيضا.
كانت ” أبو دعسان” بمثابة مخطوطة سردية لأحداث اجتماعية وحوارات تستقرئ الواقع الذي كان هناك، وهذا ما استغربته من كاتب النّص، لأنّه صوّر شخصياته تستقرئ ماض، فهذا الزّمان انتهى، وعرفنا حقيقته كقرّاء في حاضرنا اليوم، فما جدوى أن نكتب عنه بهذه الطريقة؟ ثمّ إن النّص ليس رواية ويصلح أن يندرج تحت بند يوميات ربما، وبحاجة لاعادة صياغة وتدقيق ومونتاج في الاخراج للطبعات القادمة، وإضافة لرشفة أدب في الوصف والتعبير تحمل القارئ لاتمام رحلته مع أبو دعسان، فلا يحملها على ظهره مشوارا ثقيلا.