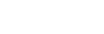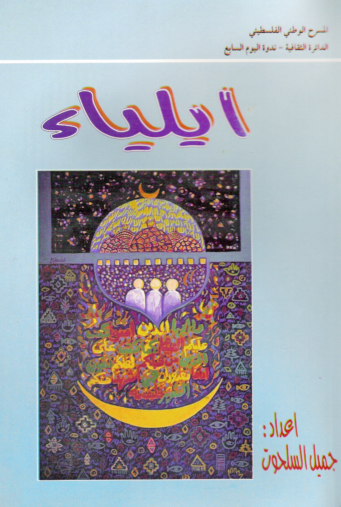تعيش الأمّة العربيّة مرحلة هزائم ماحقة، قد توصلها إلى الاندثار كأمّة، فهناك الاقتتال الدّاخلي لتكريس الطّائفيّة، وتقسيم المقسّم لتزداد ضعفا على ضعف، ومن غير العجيب أنّ الاقتتال العربيّ، وتدمير الأوطان، يتمّ بأيد عربيّة “مسلمة” وبمال عربيّ، وسلاح مدفوع الثّمن عربيّا، وقد يصبح قاتل الأمس قتيل اليوم بتمويل ودعم ممّن دفعوه لقتل الآخرين، والقتلة يتسلّحون بمفاتيح “الجنّة” وكأنّها بأيديهم. وعندما تصل الهزيمة نهايتها يُرجع القتلة الذين بقوا على قيد الحياة ذلك إلى “إرادة الله”. أي أنّهم يبرّؤون أنفسهم من الجرائم التي ارتكبوها، وألحقت الويلات بالأمّة. فما أسباب ذلك؟ وكيف الخلاص منه؟
في مقدمته تحدّث ابن خلدون (1332 – 1406م) عن عقليّة الصّحراء، ووحشيّتها وعدائها الفطريّ للحضارة، لكنّ العرب لم يتّعظوا ممّا كتبه ابن خلدون، تماما مثلما لم ينتبهوا حتّى يومنا هذا للثّقافة الوحشيّة الموروثة، والمغروسة في الأذهان. ومنها ثقافة شعبيّة قائمة على عقليّة القبيلة، لكن ما يهمّنا هنا هو الموروث المختبئ داخل عباءة نصوص ” دينيّة” أفرزتها عقول بشريّة، ومن خلالها استباحوا دماءهم ودماء اخوة لهم في الدّين، ونظرا للانغلاق الثّقافيّ، وعدم الاطلاع على التّطوّر العلمي والحضاريّ الهائل الذي تعيشه الشّعوب المتحضّرة، فإنّ البعض من العربان لم يجدوا ما يستأنسون به سوى العودة إلى نصوص بشريّة تكفيريّة؛ ظنّا منهم أنّها الدّين الصّحيح، والأدهى من ذلك أنّهم منقسمون إلى جماعات كلّ منهم تكفّر الأخرى وتستبيح دماء أتباعها ومناصريها. ويصل الجهل مداه عندما يقدّسون أقوال بشر مثلهم، مع ايمانهم أن لا مقدّس في الاسلام غير القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة الصّحيحة. بل إنّهم يخرجون نصوصا دينيّة عن سياقها وزمانها، فوجدنا منهم من عاد إلى احياء “العبوديّة والرّق” واستباحة حياة وأموال وأعراض غير المسلمين من شعوبهم. وحتّى من المسلمين الذين يخالفونهم الرّأي، مستغلّين بذلك جهل بسطاء المسلمين بدينهم ودنياهم.
ووجدنا مثلا من يؤمن بالقوى الخارقة “لبول البعير” في معالجة الأمراض على أنواعها، رغم التّقدّم الهائل في علوم الطّبّ. ووجدنا من يضيّع سنوات في البحث في “فقه الضّراط والطّهارة” حتى أنّ أحد مدّعي العلم فاخر في احدى الفضائيّات ” أنّ عدد الكتب الاسلاميّة في الطّهارة بلغت مئة ألف”! لكنّ أحدا من هؤلاء لم يسأل نفسه عن مدى مشاركة العرب والمسلمين في الاختراعات العلميّة الهائلة، أو تطوير الزّراعة أو الصّناعة، والبحث عن موارد الطّبيعة الدّفينة والظّاهرة؟ وما هي أسباب ذلك؟ وهم يعفون أنفسهم من هذا التّفكير، ولا يريدون غيرهم أن يفكّر، لأنّهم يكرّسون حياتهم “لليوم الآخر” ويخرجون من الحياة كما دخلوها، فهم لا يعطون الحياة حقّها، ومن يستمع لغالبية الخطب في المساجد يعتقد أنّ الله لم يخلق النّار والحساب إلا لتعذيب المسلمين، ومن يخالفهم الرّأي من المسلمين وغير المسلمين. وهم لا يفرّقون ولا يميّزون بين علوم الدّنيا، والمعتقد الدّيني، لذا فإنّ العالم جميعه يعتبر “الرّياضيّات” أساس العلوم، بينما يعتبر “جهابذة الدّين” “العلوم الدّينيّة” أساس العلوم، دون تمييز بأن الدّين عقيدة وليس علما.
وهنا نستذكر ما ينسب للامام محمد عبده الذي زار فرنسا في القرن التّاسع عشر وعاد يقول” وجدت فيها اسلاما ولم أجد مسلمين”! فما الاسلام الذي وجده الامام في فرنسا؟ لقد وجد الحضارة والنّظافة والنّظام والتّقدّم العلميّ، والصّدق. فلماذا لم يبحث العربان عن الاسلام الذي وجده الامام محمد عبده في فرنسا؟ ولماذا لم يتحلّوا به؟ ولماذا يعادون العلوم الدّنيوية، خصوصا وأنّ الرّسول الكريم قال في حادثة تلقيح النّخيل الشّهيرة ” أنتم أدرى بشؤون دنياكم”؟
فهل العلوم الدّنيوية تتناقض مع التّعاليم الدّينيّة؟ وهل كفر رئيس وزراء ماليزيا السّابق مهاتير محمّد عندما طوّر نظام التعليم في بلاده، وما تبع ذلك من تطوّر في مختلف مجالات الحياة، ونهض ببلاده من دولة مدينة إلى دولة لديها احتياطيّ ماليّ بمئات المليارات؟
لقد نجح “المتأسلمون الجدد” في تدمير بلدانهم، وقتل شعوبهم، ومنعها من التّطوّر، واستعداء غير المسلمين على الاسلام والمسلمين، حتى أنّ العلماء الألمان كتب قبل أكثر من عقدين” قد أرتاح بجوار مفاعل نوويّ أكثر من راحتي في السّكن بجوار مسلم، لأنّني أعلم متى يشعّ المفاعل النّوويّ وآخذ احتياطاتي، لكنّني لا أعلم متى يقتلني جاري المسلم”! فمن أوصله إلى هذا التّفكير؟ أليست تصرّفات المسلمين؟ وما الدّافع وراء تصريح الملياردير الأمريكي، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكيّة بأنّه”لن يسمح للمسلمين بدخول أمريكا في حالة فوزه”؟
إنّ الشّعوب العربيّة تحديدا، بحاجة إلى إعادة النّظر بثقافتها، وتطوير التّعليم فيها في مختلف مراحلة، وإعادة النّظر في الموروث الثّقافي الذي وضعه البشر، وأن ينتبهوا إلى أنّ “الدّين الصّحيح لا يتناقض مع العلم الصّحيح” وضرورة اعادة تفسير القرآن الكريم بما يتناسب والعصر وما يشهده من تقدّم علميّ، خصوصا وأنّنا نؤمن “أنّ الدّين يصلح لكل زمان ومكان.”
1 آذار –مارس- 2016