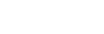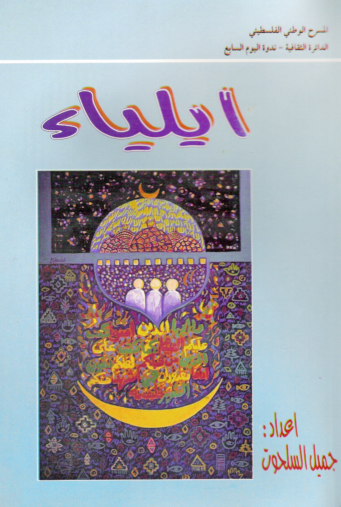لوحة الغلاف: للفنّان التّشكيليّ محمد نصر الله
منشورات مكتبة كل شيء-حيفا-2018
الاهداء
إلى والديّ-رحمهما الله- اللذين ربّياني صغيرا وكبيرا، وتعلّمت منهما الكثير.
قبل الدّخول:
تردّدت كثيرا في كتابة شيء من سيرتي الذّاتيّة، خصوصا عن مرحلة الطّفولة الذّبيحة التي عشتها أنا وأبناء جيلي. فأنا المولود بعد عام من نكبة شعبي الأولى في العام 1948، عشت وأبناء جيلي تبعات هذه المرحلة التي كانت السّيادة فيها للجهل والفقر والتّخلّف. لم يكن في طفولتنا ما يسرّ القلب، ولا ما يمكن أن يتمخّض عن ولادة تغيير نافع جديد، فآباؤنا الذين عاصروا نهاية العهد العثمانيّ، وما صاحبه من جهل ومظالم، عانوا الأمرّين في طفولتهم وشبابهم، وما أن تخلّصوا من العثمانيّين في نهاية الحرب الكونيّة الأولى، حتّى وقعوا تحت الاحتلال البريطانيّ، الذي مهّد لضياع فلسطين باتفاقاته” سايكس- بيكو”مع فرنسا على تقاسم المنطقة، وبوعد بلفور الذي استهدف فلسطيننا دون غيرها، واستمرّ اضطهاد آبائنا من قبل الاحتلال البريطانيّ الذي حاول “تجميل صورته” بتسميته انتدابا بدل احتلال، وهكذا كان آباؤنا وأجدادنا ضحيّة هم الآخرون لواقع فرض عليهم، فلم يعيشوا طفولتهم وشبابهم ولا حتّى شيخوختهم كبقيّة البشر، وبما أنّ “فاقد الشّيء لا يعطيه”، فقد عاش جيلنا من أبناء شعبنا حياة بائسة بكلّ المقاييس، وإن بشكل متفاوت.
توقّفت طويلا أمام طفولتي المعذّبة، فكّرت كثيرا متردّدا في كتابتها، تساءلت حول الفائدة المرجوّة من نشرها! وفي النّهاية قرّرت الكتابة والنّشر، لعلّ في ذلك ما يمكن أن يستفيد منه جيل أبنائنا المحرومين أيضا من طفولتهم؛ بسبب الاحتلال الذي أهلك البشر والشّجر والحجر. وأنا في تركيزي على طفولتي الخاصّة، لا أنقل معاناتي الشّخصيّة، بمقدار ما أكتب عن واقع اجتماعيّ عاشه الملايين من أبناء شعبي وأمّتي.
وأستطيع القول أنّني وغالبيّة أبناء جيلي قد عشنا رغما عن سنن الطّبيعة، فقد كانت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة جدّا، ومع ذلك عشنا؛ لنكون شهودا على واقع لا خيارات لنا فيه.
يمكنني القول أنّ منفذ الهروب الذي أتيح لبعض منّا –وأنا من هذا البعض- ولمن سبقونا بعقدين قبلنا هو بوّابة التّعليم، رغم كلّ التّحفظات على النّواقص التي صاحبت العمليّة التّربويّة من نواقص وعوائق في بداياتنا مثل: الأبنية المدرسيّة، الملاعب والسّاحات، المناهج، المختبرات، المكتبات، وسائل الإيضاح، تأهيل المعلّمين، قوانين التّعليم، قِصَر مرحلة التّعليم الإلزامي، وغيرها، ومع أنّ جيل أبنائنا يعاني هو الآخر من نواقص تعيق العمليّة التّعليميّة، إلا أنّ الفوارق شاسعة بين جيلنا وجيلهم. لكنّ تعليم جيلنا ومن سبقونا بقليل هو من انتشلنا ولو قليلا من واد التّخلف السّحيق، وهذا دفعنا إلى توفير متطلّبات التّعليم لأبنائنا أكثر بكثير ممّا توفّر لأبناء جيلنا، ومع ذلك فإنّ جيل أبنائنا لم يستغلّ فرصه التّعليميّة كما يجب.
ففي مرحلة جيلنا لم تكن هناك أيّ جامعة محلّيّة، وكثير من البنات لم تتح لهنّ الفرصة؛ لتكميل دراستهنّ حتّى المرحلة الثّانويّة. وقد اختلف الواقع في جيل أبنائنا، فالآن يوجد في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة المحتلّتين حوالي عشر جامعات في مختلف المدن، نسبة الطّالبات فيها تزيد على الثّلثين، وهذا أمر جميل ولافت، لكنّ السؤال يبقى حول تدنّي نسبة الأبناء الذّكور في الجامعات؟
مع التّأكيد أنّني لا ألوم جيل الآباء، بل بالعكس أنا فخور بهم، وأترحّم عليهم، فقد قدّموا لنا ما استطاعوه، ولم أكتب عن تجربتي الشّخصيّة إلا لتسجيل مرحلة عاشها أبناء شعبي، وللتّأكيد على قدرة الانسان على تحقيق طموحاته رغم كل المعيقات – إذا توفّرت لديه الرّغبة في ذلك-.
1 شباط- فبراير-2018
الجذور:
لا يمكن للمرء أن يتحدّث عن مسيرته الحياتيّة دون العودة إلى جذوره القريبة على الأقلّ، وإلى البيئة التي ولد فيها، وما صاحبها من واقع اجتماعيّ، اقتصاديّ، علميّ…إلخ. ومن هذا المنطلق فإنّني سأستذكر ما سمعته عن حياة جدّي لأبي ابراهيم حسين السلحوت، الذي توفيّ ومن تبقى من أبنائه “موسى، محمّد وحسين” ولم يكن كبيرهم”موسى” قد وصل الخامسة من عمره، فعمّي موسى المتوفّى في 8-8-1974 بكر والديه كان يقول لنا: “أذكر أنّ رجلا نحيفا له ذقن يكسوها الشّيب، كان يضعني في حضنه، لكنّني لا أذكر من ملامحه شيئا!”
وممّا كان يرويه الأكبر سنّا من المرحومين والدي وأخويه أنّ المرحوم جدّي لأبي ابراهيم حسين السلحوت، قد تزوّج في شبابه عند منتصف القرن التّاسع عشر من صفيّة سليمان سلامة شقيرات، وكان في رعايته خليل وحمدان ابنا أخيه أحمد الذي قتل على أيدي قطّاع طرق، والمرحومة “قاليه” ابنة أخيه الذي قتل أيضا بنفس الطّريقة، وذات يوم عاد مساء إلى بيت الشّعَر الذي يسكنه في براري السّواحرة، ووجد “قاليه” بنت السّنوات الأربع قد غفت على صحن العجين، وكبت برأسها عليه، فاحتضنها متسائلا عن أحوالها، فأخبرته بأنّ زوجته تضربها وتجبرها على عجن الطّحين، فأشفق على ابنة شقيقه، وطلّق زوجته؛ لأنّها تظلم أبناء أخويه الأطفال الأيتام. وأعلن أنّه سيتفرّغ لتربية هؤلاء الأيتام وسيكتفي بهم أبناء له!
عندما شبّ خليل ابن أخيه وجدّي هرم، خرج عن طوعه، فغضب من ذلك المرحوم علي شقير أحد وجهاء الشقيرات، وأقسم بأن يبحث عن زوجة لجدّي، وقام فورا وذهب لصديقه عليّان المصري كبير عائلة الهلسة، وطلب منه ابنته الأرملة صفيّة ابنة التّسعة عشر عاما حليلة لجدّي ابراهيم حسين السلحوت، فوافق والدها على طلبه، وتزوّجا، وأنجبا خمسة أبناء هم –حسب التّرتيب- “موسى، محمد، نوّارة، حسين وخضر”.ولأن جدّي كان هرما أشيبا، فقد أطلقوا على أبنائه”أبناء الشّايب” وهو لقب لا يزال يطلق على عائلتنا حتّى يومنا هذا. وكما يروى عن جدّتي لأبي صفيّة عليان المصري فإنّ الفارق العمريّ بين أبنائها لم يتجاوز الأحد عشر شهرا بين كلّ منهم على التّوالي، وعندما توفيّ جدّي كان أبي ابن أربعة عشر شهرا، وشقيقه الأصغر خضر ابن ثلاثة أشهر، وحسب وصف الجدّة فقد يكون أبي من مواليد العام 1902، لأنّ ما يروى عن الجدّة المتوفّاة عام 1946، أنّ حسين –الذي هو أبي- كان ابن خمسة عشر عاما، عندما احتل الانجليز فلسطين.
مات جدّي ولم يترك لأرملته وأبنائهما سوى خمس نعاج، وقطعة أرض ورثها عن أبيه. فعاشوا عيشة كفاف، حيث تكفّل كبار حامولة “الشقيرات” بتزويد جدّتي بالطّحين، وبعدد قليل من الأغنام؛ ليعتاشوا على حليبها وأجبانها.
عندما بلغ العمّ البكر موسى سبعة أعوام من عمره رعى الأغنام عند كبير عائلة أبو سرحان من العبيديّة مقابل ستّة خراف أجرة سنويّة، وكذلك فعل أخواه لاحقا.
أمّا بالنّسبة للعمّ خضر فقد مات عطشا قبل أن يبلغ الثّانية من عمره، عندما ظهر على حنجرته دمّل، فكووه عليه، وأوصوا جدّتي بعدم سقايته الماء كنوع من العلاج، وتوفّي والدي عام 1992 وهو يروي الحادثة باكيا فيقول :” مات خضر وهو يئنّ ويقول “امبو”.
العمّة “خضرة” توفيّت هي الأخرى غرقا في بئر “السّوق”، في براري عرب السّواحرة، عندما بعثتها والدتها وهي في السّابعة من عمرها؛ إلى البئر لتأتيهم بالماء في يوم عاصف، فقذفت بها الرّياح إلى جوف البئر فماتت غريقة.
عندما انتهت الحرب العالميّة الأولى بهزيمة العثمانيّين، تقاسمت بريطانيا وفرنسا المشرق العربيّ حسب اتّفاقات “سايكس بيكو”، فاستولت بريطانيا على العراق، الأردنّ جنوب الجزيرة العربيّة وفلسطين، بينما استولت فرنسا على سوريّا ولبنان، ولم يتمّ استعمار شمال اليمن لوعورة أرضه وعدم قدرتهم على السّيطرة عليه، وابتعدوا عن السّعوديّة لوجود الأماكن المقدّسة فيها، وخوفهم من نشوب حرب دينيّة، ولأنّ البترول لم يكتشف في ذلك الزّمن.
التّهريب بين الأردنّ وفلسطين:
فرض المحتلّون البريطانيّون ضرائب مرتفعة في فلسطين لتشريد شعبها، وفي الوقت نفسه قاموا بتسهيل الهجرات اليهوديّة إليها، والعمل على تنفيذ وعد بلفور بإقامة دولة لليهود عليها. بينما لم يفرضوا ضرائب على شرق الأردنّ، وهذا شجّع عمليّات تهريب البضائع كالأقمشة والسّجائر من الأردنّ إلى فلسطين. وعمل أبناء السّواحرة في التّهريب لاتّساع أراضيهم الممتدّة من جبل المكبّر إلى البحر الميّت جنوبا، وإلى نهر الأردنّ شرقا، ولمعرفتهم بطرق البراري التي لم تكن سيطرة للانجليز عليها.
وعمَلُ السّواحرة في التّهريب لم يتجاوز عمليّة نقل البضائع لصالح تجّار القدس، الذين كانوا يدفعون أجرة خمسة جنيهات لحمولة الحمار وصاحبه، وسبعة جنيهات لحمولة البغل وصاحبه، وهذا دخل مرتفع قياسا بأجور ذلك الزّمن، حيث كانت أجرة العامل تتراوح بين 3-5 قروش يوميّا. وكان التّهريب بقوافل من الحمير والبغال، تعبر نهر الأردنّ ليلا، يحرسها رجال مسلّحون، ولكلّ قافلة مسؤول، يعطي أجرة معقولة للرّجال الذين يعملون معه هم ودوابّهم، ومن مسؤولي “القوافل” في حامولتنا الشقيرات أبي حسين ابراهيم السلحوت، محمد عبدالله سلامة-استشهد في حرب العام 1948-، حسين ابراهيم شقير وعزّ حميدان شقير، وقد أثروا ثراء بائنا من هذا العمل، ولم يعمل منهم في التّجارة لاحقا سوى المرحوم عزّ حميدان شقير الذي افتتح محلا للصّرافة بالشّراكة مع تلحميّ في بيت لحم، وممّن عملوا في تهريب البضائع بين فلسطين وشرق الأردنّ من الحمايل الأخرى فهد الأعرج، والأخوان حسين وحسن صوّان.
بدايات التّعليم:
معروف أنّ عرب السّواحرة عشائر بدويّة كانت تسكن البراري طلبا للعشب والماء، وتأثّروا بتجّار القدس الذين عملوا لصالحهم في تهريب البضائع من الأردنّ إلى فلسطين، كما تأثّروا بالقائد عبد القادر الحسيني الذي كان يعسكر بين مضاربهم، ويجد الرّعاية والحماية منهم، شاركوه الثّورة، وكان يحضّهم على تعليم أبنائهم، ومن هنا بدأت عمليّة استقرارهم، وتعليم أبنائهم في المدارس قبل افتتاح أوّل مدرسة في جبل المكبّر أشهر جبال أراضي السّواحرة، لارتباط اسمه بالخليفة الثّاني عمر بن الخطّاب فاتح القدس، كانوا يرسلون أبناءهم إلى كليّة النّهضة في حيّ البقعة في القدس الجديدة، وإلى كليّة صهيون بجوار سور القدس قرب باب الخليل، وكان ذلك في أواخر عشرينات القرن العشرين، ونظرا لرغبتهم في تعليم أبنائهم فقد بدأوا ببناء البيوت الحجريّة على أراضيهم في جبل المكبّر؛ لتكون قريبة من المدارس، وأوّل بيت بني في المكبر كان عام 1928 للمرحوم أحمد الحصيني زحايكة، تبعه حسين أبو ننّه من العويسات، أحمد سرور ومشهور مشاهرة من المشاهرة، عليّان شقير وحسين مسلم جوهر من الشقيرات، الشّيخ محمد داود العلي عويسات مختار حامولة العويسات، عطيّة حسن عبده، كما بنى علي أحمد عبده عويسات بيتا في حيّ الشّيخ سعد. وكي يحافظوا على مصدر رزقهم الذي يعتمد على تربية الماشية وزراعة الأرض بالحبوب، انتشر عندهم الزّواج من اثنتين، واحدة تعيش مع أبناء المدارس في البيت الحجريّ في جبل المكبّر، والثّانية مرافقة لزوجها في البراري.
وهنا يجدر الذّكر بأنّ المرحوم الشيخ حسين السّرخي، الذي عاش في القرن التّاسع عشر إبّان العهد العثمانيّ، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصّة، تعلّم وأصبح فقيها مجتهدا له مؤلّفات، وقد بنى قصرا في منطقة “الحرذان” لا يزال قائما حتى يومنا هذا، وهو بحاجة إلى ترميم.
تزوّج أبي من المرحومة حمدة حسن نوّارة المصري قريبة والدته عام 1934، وأنجب منها ابنه البكر محمد عام 1936، محمود عام 1939، محمّد 1942، أحمد 1945، طه 1947، مريم 1950، نعيمة 1953 وجمال 1957. “وتسمية الابن الثّالث محمّدا رغم أنّ الابن البكر اسمه محمّد له حكاية ظريفة، فالابن الثّالث أطلقوا عليه عند ولادته اسم “حسن”، وعندما بلغ الثّانية من عمره مرض، فنصحتهم فتّاحة بتغيير اسمه إلى محمّد كي يشفى، فاستجابوا لنصيحتها.”
عندما توقّف التّهريب بين فلسطين وشرق الأردنّ اشترى والدي آلاف الدّونمات في منطقة الشّيخ سعد وبراري السّواحرة؛ ليفلحها بالحبوب، وكان وإخوته قد اشتروا بيتا عام 1944 من ثلاث غرف في جبل المكبّر، ليكون قريبا من المدارس، وبنوا أمامها ثلاثة مخازن، لكلّ واحد منهم غرفة واحدة ومخزن واحد، ولم يلبث أن اشترى أبي غرفة ومخزن وحصّة أخيه محمد من الأرض، والذي اشترى بدوره أرضا قريبة وبنى فيها غرفة يتيمة. كما اشترى أبي قطيعا من الأغنام البلديّة الحلوب. وقد حقّق حلمه بامتلاك الأرض والأغنام التي تشكّل مصدر رزق لم يعرفوا غيره في ذلك الوقت.
في العام 1945 تزوّج أبي من أمّي أمينة علان علي شقير، تزوّج للمرّة الثّانية؛ لينجب أبناء كثيرين؛ لتكون له “عزوة” لها دورها في المجتمعات العشائريّة!
أنجبت والدتي – رحمها الله ثلاثة عشر-، ستّة ذكور وسبع بنات، وهم :” ابراهيم 1948، جميل 1949، جميلة 1951، جملة 1953، سارة 1955، فاطمة 1957، يسرى 1960، داود 1963، خديجة 1964، عمر 1966، عرفات 1968، راتب 1970 وعفاف 1972. كما أجهضت باثنين.
حدّثنا أبي وأمّي –رحمهما الله- أنّ أمّي أنجبت بكرها ابراهيم “في اليوم الذي استشهد فيه البيك” والبيك هو الشّهيد عبدالقادر الحسيني، وهذا لقب أطلقه عليه أبناء جيله القرويّون، ومعروف أنّ القرويّين كانوا يمثّلون العمود الفقريّ لحركة الجهاد المقدّس التي كان يقودها الشّهيد الحسيني. حيث التفّوا حوله ووثقوا به، ويبدو أنّ هذه الحركة كانت حركة شعبيّة يقودها الحسيني مع بعض معاونيه أمثال بهجت أبو غربيّة، احمد علي العيساوي، عبدالفتّاح الزّبن من المزرعة الشّرقيّة، فؤاد نصّار وغيرهم، ولم تكن هذه الحركة منظّمة بمقدار ما كانت تعتمد على المتطوّعين. كان الشّهيد الحسيني ورفاقة من الثّوار يحلّون ضيوفا في بيتي الشّيخ حسين ابراهيم شقير –مختار حامولة الشقيرات-، وفي بيت المرحوم حمدان حسن سرور الملقب بالبلهيدي وهو من وجهاء حامولة المشاهرة.
عندما أصيب فؤاد نصّار،-الذي أصبح لاحقا الأمين العامّ للحزب الشّيوعيّ الأردنيّ- بجراح في إحدى المعارك مع قوّات الانتداب البريطاني عام 1937 في جبال الخليل، جاء به رجال الجهاد المقدّس إلى مضارب حامولة “الشقيرات” في بيت الشّيخ حسين ابراهيم شقير، وأمضى عندهم يوما لم يعلموا خلاله أنّه كان جريحا، وفي الليلة التّالية نقله أبي إلى الأردن-بناء على طلبه- وبتكليف من الحسيني، ولم يعرفوا له اسما سوى “أبو خالد” وممّا كان يقوله والدي وآخرون عنه: “مسيحي طويل، وسيم، قليل الكلام”، وعند نقله قال لوالدي بأنّه لا يجيد السّباحة، وطلب أن يوضع في “مشمّع” مضادّ للمياه؛ كي لا يبتلّ جسده وهو يعبر نهر الأردنّ، ولم يعلم والدي أنّه كان جريحا إلا في الضّفة الشّرقيّة، عندما وجد ثلاثة أشخاص منهم طبيب في انتظاره، حيث قام الطّبيب بالكشف الفوريّ على جراحه. وقد أمضى والدي العام 1939 كاملا معتقلا إداريّا في سجن عكّا.
نصف كيس رصاص:
كما أنّ المرحوم والدي هو من أرسله عبد القادر الحسيني قبل استشهاده بأيّام لجلب سلاح من الشّام، وعاد إليه بنصف” شوال رصاص”، عندها شعر الحسيني بخذلان العرب له، فكتب في 6 نيسان- ابريل- مذكرة لأمين الجامعة العربيّة جاء فيها:
” السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية -القاهرة
إني أحمّلكم المسؤولية بعد أن تركتم رجالي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح.
عبدالقادر الحسيني”.
وبعد يومين أي في 8 نيسان -ابريل-1948 قاد الحسيني معركة القسطل، إلى الغرب من مدينة القدس، وارتقى سلّم المجد شهيدا فيها.
المرأة
لم يكن للنّساء أيّ اعتبار في ذلك الزّمن، ولم يقتصر دورهنّ على الانجاب فقط، بل كنّ عاملات بكلّ ما يعنيه العمل الشّاق، فالمرأة كانت تزرع وتحصد، تحلب الأغنام، تعمل الحليب جبنا أو لبنا وتستخرج منه الزّبدة، وتصنع منها السّمن البلدي. وفي الرّبيع تخلع الأعشاب الضّارة من حقول الحبوب، وبعد الحصاد تعمل على إزالة الأشواك من الأرض وهكذا، عدا عن الحمل والولادة والرّضاعة للأطفال والعناية بهم، وما يترتّب على ذلك من غسيل وتنظيف وطبخ، وبعض النّساء من زوجات وبنات مربّي الأغنام كنّ يغزلن الصّوف، وينسجن منه “جرازي” للزّوج والأبناء في فصل الصّيف، وما يتبقّى ينسجن منه “النّول” البلدي بأشكاله وتسمياته وألوانه المتعدّدة، وممنوع على المرأة أن تقول “لا” حتّى ولو كانت مريضة! وكانت تتعرّض للضّرب بسبب وبدون سبب، فعندما كان تخرج الفتاة عروسا من بيت والديها، كانوا يقولون للعريس ولذويه:” لنا العظم ولكم اللحم”، أي اضربوها لكن لا تكسروا عظامها! بينما كان دور الرّجل يقتصر على بيع الحليب ومشتقّاته لتجّار القدس، ويلعب مع أقرانه “السّيجة” وهم يحتسون القهوة والشّاي متّكئين على جنوبهم، ويشتكون من الجهد والتّعب!
بعض الرّجال عمل في تهريب البضائع كالأقمشة والسّجائر من الأردن لصالح تجّار القدس، وبعض آخر كان يسطو على ملّاحات البحر الميّت، يحمّلون دوابّهم بالملح الذي كانوا يقايضونه في قرى رام الله، بالزّيتون والقطّين، العنب والتّين، ولاحقا عمل البعض بزراعة الخضروات المرويّة بمياه المجاري في واد الدّيماس، عندما عملت شبكة مجاري للصرف الصّحّيّ في القدس في بداية أربعينات القرن العشرين، لتترك مكشوفة في منطقة السّواحرة.
ولم يكن للنّساء رأي في الزّواج، فوالدها من يقرّر نيابة عنها، ولا يجوز لها الاعتراض أو الرّفض مهما كان فارق العمر بينها وبين من يطلب يدها، أو لأيّ سبب آخر.
النّساء والأطفال ممنوعون من ابداء الرّأي، بل ممنوع على الأبناء مهما كان عمر الواحد منهم أن يتكلّم في حضرة أبيه أو جدّه أو عمّه، وحتّى من كانوا آباء ووالدهم موجود ممنوع عليهم أن يتدخّلوا في زواج بناتهم، فالجدّ ما دام حيّا هو صاحب الرّأي والمشورة في زواج حفيداته، أو أيّ أمر يتعلّق بالأسرة، ” مش معقول ابن بولي يخالف شوري”!
ولم يكن للمرأة أيّ قيمة انسانيّة، بل إنّ وجودها مرفوض، وسعيد من يخلّف الذّكور ولا يخلّف البنات، لأنّ البنت ليست خلفا، لذا فإنّ من أنجبت بنتا أو أكثر يدعون لها ولزوجها بالخلف الصّالح، والمقصود ابن ذكر أو أكثر، وبناء عليه فإنّ من لم تنجب أبناء ذكورا تتحمّل مسؤوليّة ذلك! وقد تتعرّض للطلاق أو لزواج زوجها من أخرى. وهذه المواقف مدعومة من الثّقافة الشّعبيّة التي لا يزال بعضها سائدا حتّى يومنا هذا، لذا فإنّ شرط حماية استمراريّة الحياة الزّوجيّة للمرأة هو أن تنجب أبناء ذكورا، “الاولاد اوتاد”، وعدم انجاب البنات وحتّى وفاتهنّ أمنية اجتماعيّة،” اللي بتموت وليته من حسن نيته”! وإذا ما وُلدت البنت فإنّها لا تحتاج إلى رعاية كالابن الذّكر،” البنات مثل خبّيزة المزابل”! أي تنمو وتكبر بسرعة دون رعاية، وتدليل البنت من الكبائر” دلّل ابنك بغنيك، ودلّل بنتك تخزيك”! ومن المفارقات المحزنة ” ابنك لك وبنتك لغيرك”! و”خير ابنك لك، وخير بنتك لغيرك”!
زواج البدل:
زواج “البدل” كان شائعا في تلك المرحلة، حيث يتّفق رجلان على أن يزوّج كلّ منهما ابنته من ابن الآخر، وربّما كان ذلك بسبب الفقر، فزواج “البدل” غالبا كان يتمّ بمهر بسيط، ولزواج البدل سلبيّات كثيرة، منها أنّه إذا اختلف زوجان وتخاصما، فإنّ بديلتها تقع في المشكلة ذاتها دون ذنب منها، وأعرف حالات تمّ فيها طلاق الاثنتين، وإحداهما ضحيّة لا علاقة لها بالخلافات التي جرت بين أخيها وزوجته “بديلتها”. وكان يقولون:” بنتك أو أختك مش أحسن من بنتي أو أختي”.
زواج الأقارب:
ومن الزّواج الذي كان سائدا زواج أبناء العمّ والخال، والذي لا تزال بقاياه موجودة حتّى يومنا هذا، حيث يتزوّج الشّابّ ابنة عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته، وأعرف حالات تمّ فيها خطبة الفتاة من شابّ من عائلة أخرى، وبعد الخطبة يأتي شابّ من أبناء عائلتها ويعلن أنّه أولى بالزّواج من ابنة عمّه التي قد يكون عقد قرانها على الخطيب قد تمّ، تماما مثل حقّ الشّفعة في بيوع الأراضي، ويردّون للخطيب الأوّل تكاليف الخطبة، ويجبرونه على طلاقها إن كان قد كتب عقد زواجه عليها، فالقاعدة تقول :” ابن العمّ بِطَيِّح عن ظهر الفرس”، والمقصود أنّ له حقّ الأولوية بالزّواج من ابنة عمّه حتّى في يوم زفافها على خطيبها “الغريب”، حيث كانوا يحضرون العروس من بيت والديها إلى بيت الزّوج يوم الّزفاف “الفاردة” على ظهر فرس، ولا يؤخذ رأي العروس بمن تريد الزّواج منه. ومن الغريب أنّ النّساء كنّ يحبّذن الزّواج من ابن العمّ، ومن أغانيهنّ على لسان العروس في حفل زواج فتاة من شابّ من عائلة أخرى:
دبكة ما بعرف دبكة
هيلي ما علّموني
الله يجازي اولاد العمّ
على الغربة ودّوني
وقد ترك زواج الأقارب، خصوصا تكراره في أكثر من جيل مآسي كثيرة، منها العقم وأمراض أخرى.
التّعليم:
تأخّر تعليم بنات السّواحرة في المدارس كثيرا عن تعليم الأبناء، ففي حين بدأ تعليم الأبناء الذّكور في المدارس في أواخر عشرينات القرن العشرين، وأوّل مدرسة للذّكور افتتحت في جبل المكبّر عام 1944. ونظرا لاتّساع البلدة وأنّ من بنوا بيوتا من الحجر بنى كلّ منهم في أرضه، افتتحت عام 1946 مدرسة أخرى للبنين في الجزء الشّرقي من البلدة، لتكون قريبة من مضارب من كانوا يسكنون البراري، ولتمييز المدرستين عن بعضهما البعض، أطلق على الأولى “مدرسة السّواحرة الغربيّة للبنين، في حين أطلق على الثّانية “مدرسة السّواحرة الشّرقيّة للبنين”، ثمّ سحبت هذه التّسمية على المكان، فأصبح “السّواحرة الغربيّة” والسّواحرة الشّرقيّة، حتى بات البعض من الأماكن الأخرى يعتبرونهما قريتين، خصوصا وأنّ وادي قدرون “النّار” الذي تمرّ به مجاري القدس يقع بين الجانبين. مع التّنويه أنّ الجزء الغربي سبق الجزء الشّرقي تعليميّا بجيل، من خلال الدّراسة في مدرسة “النّهضة” و”كلّيّة صهيون”.
في حين افتتحت أوّل مدرسة ابتدائيّة للبنات في الجزء الغربيّ –جبل المكبّر- في العام الدّراسيّ 1954-1955 بمبادرة من: الدّكتور داود عطيّة حسن عبده، داود علي احمد عبده ومحمّد حسين مسلم جوهر، والتحقت بالصّفّ الأوّل الابتدائيّ بنات من أعمار مختلفة، لا تقلّ عن سبع سنوات، -حسب النّظام التّعليمي الذي كان معمولا به في تلك المرحلة-، ومن الطّريف أنّ إحدى “خرّيجات الأوّل الابتدائيّ تزوّجت في العام نفسه، وكانت في حوالي الخامسة عشرة من عمرها”. ويلاحظ أنّه عند افتتاح مدرسة البنات كان هناك أبناء تخرّجوا من الجامعات، مثل الدّكتور داود عطيّة عبده، والمرحوم داود علي احمد عبده. ومن المهمّ هنا أن نذكر أنّ الأبناء الذين تعلّموا وأدركوا أهمّيّة التّعليم هم من ضغطوا وساهموا في تعليم أخواتهم، وبنات عائلاتهم.
ويلاحظ أنّ الأهالي في تلك المرحلة لم يسمحوا للبنات بتكملة دراستهنّ بعد المرحلة الابتدائيّة؛ لسببين هما:
أوّلهما: أنّ البنت بهذا العمر يجب أن ترتدي الثّوب التقليديّ المطرّز، في حين تفرض عليها المدرسة ارتداء المريول المدرسيّ.
وثانيهما: هو عدم وجود مدرسة اعداديّة في البلدة، وهذا يتطلّب سفرها إلى قرية سلوان المجاورة للدّراسة في مدرستها، وفي المرحلة الثّانويّة إلى المدرسة المأمونيّة في القدس. عدا عن قضيّة الزّواج المبكّر التي كانت شائعة بين البنين والبنات.
واللافت أنّ الآباء وفي غالبيّتهم العظمى كانوا أمّيين، أو أشباه أمّيّين، بعضهم درس في كُتّاب المرحوم الشّيخ عطا السّرخي، حيث كان يعلمّهم الأبجديّة، ويحفّظهم القرآن الكريم. وبعضهم مثل المرحوم والدي لم تتجاوز دراسته في الكتّاب ثلاثة أشهر، وكان المرحوم الشّيخ أحمد علي منصور قد افتتح كتّابا في مسجد الزّاوية العلويّة، القائمة قرب بيته في “باطن الحرف” في جبل المكبر، وقد تمّ توسيعها وبناء مئذنة لها في ثمانينات القرن العشرين، واستمرّ هذا الكتّاب حتّى منتصف الخمسينات. ومع أمّيّة هؤلاء الآباء –رحمهم الله- فقد كانوا حريصين على تعليم أبنائهم لعدّة أسباب – كما أفادني بذلك عدد منهم- منها:
– قرب البلدة من القدس، وتأثّرهم بعائلات المدينة التي كانت تعلّم أبناءها، أي أنّهم قلّدوا أبناء العائلات في القدس.
– حثّ وتشجيع القائد عبدالقادر الحسيني لهم لتعليم أبنائهم.
– سكنهم بجوار القدس” 5 كيلومتر جنوب القدس”، وقرب المدارس الثّانويّة في المدينة منهم، وهذا يعني أنّهم يسكنون في قلب فلسطين، القدس مدينتهم التي يشترون احتياجاتهم من أسواقها، ويبيعون منتوجاتهم فيها، ويتعلّم أبناؤهم فيها، فهذا دفعهم إلى التّحضّر بشكل سريع. وفي إحصائيّة وزارة التّربية والتّعليم الأردنيّة عام 1956 عن تطوّر التّعليم في المملكة، كانت قرية بيت اكسا شمال غرب القدس هي الأولى، وفي العام 1964 كانت بلدة عرب السّواحرة هي الأولى.
ولادتي:
أمّا أنا فقد أنجبتني أمّي بعد أحد عشر شهرا من ولادتها لشقيقي ابراهيم، وهذا يعني أنّني ولدت في الثّلث الأوّل من شهر آذار –مارس- 1949، لكنّني أحمل شهادة ميلاد مكتوب فيها أنّني مولود في 5 حزيران-يونيو- 1949، حسب تقدير طبيب الصّحّة الذي قدّر عمري عند دخولي المدرسة في العام الدّراسي 1955—1956. وليته اختار يوما غير هذا اليوم، الذي أصبح لاحقا في عام 1967 ذكرى هزيمة ماحقة، وما ترتّب عليها من مآسي واحتلال أهلك البشر والشّجر والحجر، وبولادتي كنت الابن السّابع لأبي، خمسة أبناء أنجبتهم زوجة أبي وواحد أنجبته أمّي، في حين لم تنجب أيّ منهما أيّ بنت وقتئذ، ولاحقا أنجبت زوجة أبي ابنتين، وأنجبت أمّي سبع بنات؛ لتكون خلفة أبي 21 شخصا، 12 ابنا، و 9 بنات.
أنجبتني أمّي التي كانت “حردانة” في مغارة “بثغرة قصّاب” عند بداية منطقة الحرذان، حيث كان يسكن والداها في خشّبيّتين مسقوفتين بألواح الزّينكو، أمام حاجب حجريّ، حفر فيه جدّي لأمّي كهفا له مدخل طويل منحدر كرقبة جمل هرم، عندما أنجبتني كان والداها وبعض أخواتها وبقرة في المغارة. ولمّا خرجت إلى الحياة وأطلقت صرختي الأولى، فرحت بذلك جدّتي لأمّي كافية حميدان حسن شقير وقالت –كما روت لي أمّي-: “ولد يا أمينة ريته مبروك”، في حين عقّب جدّي “الله لا يردّك ولا يردّه”.
لم تكن الولادة في المستشفيات معروفة بين الأهالي، وحتّى الدّاية القانونيّة لم تكن معروفة أيضا، وكانت بعض المسنّات يساعدن النّساء في المخاض، حيث كانت المرأة في المخاض تجلس القرفصاء على قدميها، تساعدها بعض النّساء الشّابّات قويّات البنية بأن يمسكن تحت إبطيها؛ لتبقى مرتفعة عن الأرض، حتّى تنجب وليدها، وهذه الطّريقة ربّما تتسبّب بسقوط رحمها؛ لتعيش ما تبقّى لها في مأساة! تبدأ بطلاقها، وباستغابتها سوءا من الآخرين رجالا ونساء! ومن تتعسّر ولادتها تموت؛ فترتاح من عذابات الدّنيا! لكنّ اللعنة تطارد وليدها الذي ماتت عند إنجابه! فيصفونه “بقاتل أمّه” ممّا يسبّب له أمراضا نفسيّة تصل إلى درجة الجنون. وفي السّتّينات كانوا يحضرون داية من بيت لحم اسمها “كاترين” للمرأة التي تتعسّر ولادتها، ونادرا ما كانوا ينقلون المرأة متعسّرة الولادة إلى المستشفى الحكومي “الهوسبيس” في القدس.
عندما علم والدي بأنّ أمّي أنجبت ولدا، أرسل عمّي الأكبر موسى صحبة المختار حسين ابراهيم شقير ليردّاها، غير أنّ جدّي لأمّي أصرّ على عدم ردّها حتّى يحضر زوجها بنفسه، وهذا ما حصل.
وأنا لا أزال أتساءل عن ولادتي وأمّي “حردانة” فهل كان هذا بداية شقاء لي ولوالدتي، أم هي الصّدفة؟
أبي هو من اختار اسم جميل ليكون اسما لي، وهذا الاسم يحمله قبلي العمّ المرحوم جميل خليل السلحوت، المولود بدايات عشرينات القرن العشرين، ممّا أثار غضب والدته المرحومة عليا حسن مشعل شقيرات، فهدّدت بخنقي حتّى الموت! – لأنّهم كانوا يعتقدون أنّ اطلاق اسم على مولود جديد يحمل اسم ابن سابق في العائلة، يعني أنّ حامل الاسم الأوّل سيموت-. فهل ولادتي جاءت شؤما على العائلة الممتدّة؟
وهل كوني الابن رقم سبعة لأبي، يعني فأل خير، خصوصا وأنّ لهذا الرّقم دلالات دينيّة، ودلالات أخرى في الثّقافة الشّعبيّة؟ لكن بغض النّظر عمّا كان يعتقده جيل الآباء والأجداد فقد عشت طفولة شقيّة بالمقاييس كلّها، وهذا لم يكن مقصورا عليّ وحدي، بل هذا ما عاشه أبناء جيلي جميعهم، وإن بشكل متفاوت، فقد كان مولد شقيقي ابراهيم الابن البكر لأمّي، والسّادس لأبي مصاحبا لنكبة شعبي الفلسطينيّ في العام 1948، وما صاحب ذلك من تشريد حوالي 950 ألفا من أبناء هذا الشّعب من ديارهم هربا من ويلات الحرب، وما صاحبها من مجازر ارتكبت بدم بارد وبتخطيط من العصابات الصّهيونيّة، كمجازر دير ياسين، الطنطورة، الدّوايمة وغيرها، وجزء منهم لجأ إلى ما بات يعرف لاحقا بالضّفّة الغربيّة، وإلى قطاع غزّة. وهذه المناطق كانت تعيش على الاقتصاد العفويّ، المتمثّل بالزّراعة البعليّة التي تعتمد على مياه الأمطار غير المنتظمة، ومعروف أنّ دول شرق المتوسّط تحظى بمياه الأمطار التي تكفي للزّراعة البعليّة، خصوصا الحبوب، بمعدّل سنة من كلّ أربع سنوات. صاحب النّكبة أربع سنوات محل متتالية، 1948-1952م، ممّا جعل النّاس في ضائقة من العيش، ولولا مساعدات وكالة غوث اللاجئينUNRWA والتّمور العراقيّة، حيث أنّ العراق ألغى تصدير التّمور، وحوّل انتاجه منها إلى مخيّمات اللاجئين، وما بات يعرف بمناطق الخطوط الأماميّة، أي المحاذية لحدود دولة اسرائيل التي قامت في 15 أيّار –مايو-1948 على 78% من مساحة فلسطين التّاريخيّة؛ لحصلت مجاعات أهلكت البشر.
وأنا ولدت بعد تلك النّكبة بعام واحد، أي في الأزمة الاقتصاديّة التي عمّت المنطقة. مع التّأكيد أن أسرتنا كانت ميسورة قياسا بالآخرين، فوالدي كان يملك أموالا وفّرها من عمليّات التّهريب بين الأردنّ وفلسطين زمن الانتداب، كما كان يملك مخزونا من القمح يكفي أسرتنا لأكثر من خمس سنوات، إضافة إلى قطيع من الأغنام الحلوب، كان عدده يتراوح بين 150-250 رأس غنم.
أيتام في حياة الوالدين:
نظرا لسنوات المحل المتلاحقة، فقد رحل بعض مربّي الأغنام من عرب السّواحرة – ومن ضمنهم أبي- بأغنامهم إلى منطقة الكرك جنوب الضّفّة الشّرقيّة عام 1951، وبنوا خيامهم بجانب وادي الباذان قرب مضارب قبيلة الحمايدة الأردنيّة المعروفة، اصطحب والدي والدتي معه، تركاني أنا وشقيقي ابراهيم برعاية زوجة أبي-رحمها الله-، تركاني وأنا لم أكمل السّنة الثّانية من عمري، وشقيقي ابراهيم ابن السّنوات الثّلاثة، تركانا بلا والدين. أنجبت أمّي شقيقتي جميلة هناك، وعندما اغتيل العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الأوّل في ساحات المسجد الأقصى في 20 تموز -يوليو-1951، عادوا إلى البلاد بعد مضايقات من أبناء المنطقة؛ بسبب اغتيال الملك. وكما أخبرني والداي لاحقا فقد تركانا من باب الحرص علينا؛ كي لا نتحمّل مشاق السّفر مشيا على الأقدام لمسافات بعيدة، ولكونهم لا يعرفون أين سيكون المستقرّ! فهم بدو رحّل يتنقلون من مكان لآخر طلبا للعشب والماء.
ولكم أن تتصوّروا حياة طفلين بهذا العمر يتركان كالأيتام بلا أب وبلا أمّ، صحيح أنّ زوجة أبي رعتنا، لكن لا أحد يغني طفلا عن حضن والدته.
رعاية الأطفال:
لم تكن أيّ رعاية للأطفال وقتذاك يمكن ذكرها، كان “السماط” ظاهرا على من كانوا لا يستطيعون قضاء حاجتهم خارجا، علاج السّماط المتعارف عليه كان عبارة عن تراب أحمر ناعم بدل البودرة، وكان التّراب يلتصق بجلودهم الغضّة فيسلخها دون رحمة.
من الغريب أنّهم كانوا يلفّون الطفل الوليد بقطعة قماش “لفاع” يثبّتونها بقماط يلفّونه على الطفل، لا يتركون من جسده ما يظهر أو يتحرّك سوى رأسه، ويستمرّ على هذا الحال حتّى يحبو وينجو بنفسه. كانوا يعتقدون أنّ الطفل الذي لا يُلفّ بهذا “اللفاع” سيكبر كسيحا أو برجلين معوجّتين في أحسن الأحوال!
أمّا علاج من يمرض من الأطفال ومن الكبار فكان يتراوح بين الجعدة المغليّة وهي نبتة شديدة المرارة، وبين الكيّ بالنّار على البطن. وبطني لا يزال مليئا ببقايا تلك النّيران التي عولجت بها!
ومن علاج الأطفال عندما يصابون بالحصبة أو السّعال الدّيكيّ أنّهم كانوا يسقونهم ملعقة من حليب أتان “حمارة”.
ومن الأمور التي لا تصدّق أنّهم كانوا يكوون الطفل الرّضيع على نافوخه، عند الحدّ الفاصل بين عظم الجمجمة وعظم الرّأس، حيث لا يكونان متّصلين عند الولادة، كانوا يعتقدون أنّ هذا الفراغ لا يلتحم إلّا بالكيّ! وكان أخي طه-رحمه الله- وهو الابن الخامس لأبي آخر من كووه على نافوخه في الأسرة، ومن حظّ البنات أنّهنّ لم يخضعن للكيّ على النّافوخ، ولا أعلم كيف انتهت تلك العادة.
كما كانوا يكوون الطفل بمسلّة حديديّة تحت لسانه”، ويعتقدون أنّ من لا يُكوى سيكبر أخرسا! وقد حميت أبنائي من “اللفاع” ومن الكيّ تحت اللسان أو على أيّ مكان في الجسم، ومن “بودرة التّراب الأحمر”، وخاصمتني والدتي -رحمها الله- بسبب ذلك، وكلّهم كانوا ينتظرون أنّ ابني البكر المرحوم “قيس الأوّل” المولود في 20-4-1978سيكبر بساقين معوجّتين، وأخرس أيضا. بدأ قيس الكلام وهو في شهره الرّابع، ثمّ حبا في الشّهر السّادس، ومشى بعد أن أنهى عامه الأوّل، وقلّدني كثيرون بعد ذلك، حتّى انتفت هذه العادة بشكل شبه كامل مع بدايات القرن الحادي والعشرين.
من عادات تلك المرحلة هي “تبخير” الأطفال الذّكور لحمايتهم من العين الحاسدة! أمّا البنات فإنّهنّ لا يتعرّضن للحسد! وكانت الأمّهات والجدّات تملأ الواحدة منهنّ يدها بالملح، وتحوم بها حول الطّفل وهي تردّد تعويذات معيّنة، ومن تلك التّعويذات التي كنت أسمعها من والدتي وجدّتي:
“مين دار لك باله، يشغل باله في حاله
كرشته غطا عينيه
مانيش أقدر من ربّي عليه
عين الحسود فيها عود
وبكره ياكلها الدّود،
دخيلك يا ربّي.”
ومن تلك التّعاويذ أيضا:
“حوطتك بالله من عين خلق الله
من عين إمّك ومن عين أبوك
ومن عين عمتك ومن عين أختك
ومن عين الجيران ومن عين اللي حسدوك
عين الصّبي فيها نبي
عين الذّكر فيها حجر
عين الحسود فيها عود
وعين الجار مقلوعة بنار”
وأحيانا كانت الأمّ أو الجدّة منهن تشعل طرف ردنها وتبقيه مشتعلا كما السّيجارة، وتضعه أمام أنف الطّفل ليستنشق الدّخان المتصاعد منه، وهي تقرأ بعض التّعاويذ، ثمّ تأخذ الرّماد بين اصبعيها وتدهن به جبين الطّفل.
كانوا يضعون على فراش الطّفل بعض الأشياء كرقية تحميه من العيون الحاسدة! ومن هذه الأشياء:” كفّ فضّي صغير عليه كلمات من القرآن، خرزة زرقاء، شبّة بيضاء، قرنفل، أدوات مهملة وقديمة كالأحذية المهترئة، حذوة فرس، وأحيانا حافر حمار .
لم يكن حليب الأطفال معروفا لدى الأهالي في تلك المرحلة، وكذلك “الحفّاظات”، ومن لم يكن يرتوي من حليب أمّه كانوا يسقونه من حليب الأغنام.
تطعيم الأطفال ضدّ الأمراض الشّائعة ما كانوا يعرفونه أيضا، لذا فنسبة الوفيات كانت مرتفعة بين الأطفال، كذلك كانت هناك حالات شلل بين الأطفال، ويبدو أنّ فاقد الشّيء لا يعطيه، فلم تكن هناك رعاية صحّيّة للكبار ولا للصّغار، ومن يموت في أيّ مرحلة عمريّة، يردّون سبب وفاته للعين الحاسدة أو للقضاء والقدر-انتهى عمره-! وكانت هناك ظاهرة “الطّبّ الشّعبيّ” حيث وُجد من كانوا يجبّرون الأغنام التي تكسر إحدى قوائمها، وهؤلاء من كانوا يجبّرون الأطفال الذين تكسر إحدى أيديهم أو أرجلهم، بطريقة تجبير الأغنام نفسها، وقد تسبّب ذلك بأن خسر البعض يده أو رجله بالبتر على أيدي الأطبّاء في المستشفى الحكومي”الهوسبيس” عندما ينقلونه إليه بعد أن يصاب “بالغرغرينا”، ويشرف على الهلاك. والبعض كان يموت دون أن يصل إلى المستشفى، ولا مكان للتّشكيك بقدرات “المجبّر” الذي يشهدون له بالقدرات الخارقة، بدلالة أنّه قام بتجبير أغنام وشفي كسرها!
وقد شاهدت بأمّ عيني في طفولتي عمليّة خصي وحشيّة لجحش وليد كانوا يريدون تربيته ليكون “قائدا” لقطيع الغنم مع “المرياع” المخصيّ أيضا. فقد بطحوا الجحش الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين، ثبّتوه ثمّ ربط “الطّبيب” خيطا صوفيّا على خصيتيه اللتين ضغطهما حتّى النّهاية، وفرزهما بشفرة حلاقة صدئة استعملت عشرات المرّات، فرز كيس الصّفن واستخرج الخصيتين! والجحش المغلوب على أمره يئنّ ألما، ولمّا انتهوا من ذلك، أوقفوه على قوائمه. بقي المسكين واقفا مكانه، فاردا قائمتيه الخلفيّتين دون حراك لعدّة أيّام دون أن يستطيع رضاعة أمّه، حتّى خرّ صريعا! جرّوه بعيدا لعدّة عشرات من الأمتار؛ ليكون فريسة للكلاب.
وممّا شاهدته في طفولتي أنّهم كانوا يكوون من يشكو من البالغين وجعا في بطنه بمنجل على كعبي قدميه على شكل صليب، بعد أن يضعوا المنجل في النّار حتّى الاحمرار. كما شاهدتهم يكوون من يشكو ألَما في مفاصله أو في عموده الفقريّ، يكوونه بعشبة جافّة يسمّونها “القَدْحة”، يضغطون أوراقها الجافّة المبلولة ببصاق أحدهم على شكل مخروط بارتفاع يصل إلى 2 سم أو يزيد، ثمّ يشعلونها فتشتعل ببطء كما السّيجارة، حتّى تنتهي بعد ما لا يقل عن ربع ساعة، وتحفر في نهايتها جلده، وتتقرّح لأيّام عديدة، حتّى يجفّ مكان الحرق دون علاج، وليبقى مكانها ظاهرا على جسده مدى حياته.
الحِذْل:
لا أعرف من أين أتت هذه الكلمة، فالجذر اللغويّ لِـ “حذل لا يدلّ على المصطلح، فقد جاء في لسان العرب “الحَذَل مُثَقَّل في العين حُمْرةٌ وانْسِلاقٌ وسَيَلانُ دمع، وانسلاقُها حُمْرةٌ تعتريها”حَذِلت عينه حَذَلا فهي حَذْلاء وأَحْذَلها البكاء أو الحَرُّ” وجاء في مختار الصّحاح:” الحُذْلُ بوزن القُفْلُ حاشية الإزار.”
لكنّ “الحِذْلَ” الذي نتكلّم عنها كان عبارة عن نَوْل بطول وعرض متر تقريبا، وأحيانا كانوا يستعملون كيس خيش بدل النّول، ثمّ يوضع عند طرفيه جديلة من حبل توثق على جانبين متقابلين منه، ثمّ يربط بحبل من كلّ اتّجاه ويربط بشعبة من أعمدة بيت الشَّعَر من طرف، وبواسط البيت من الطّرف الآخر، وفي البيوت الحجريّة كان يربط بوتدين مثبّتين بحائطين متقابلين من الغرفة، ويوضع فيه الطّفل مرتفعا عن الأرض، يحرّكون هذا “الحِذِل” يمينا ويسارا، حتّى يسكت الطّفل الباكي وينام، وكانوا يضعون خشبة لتفتح “الحذل من عند رأسه، كي لا تضغط كثيرا على وجهه وكتفيه.
وعندما كان طفل يهزّ هذا الحذل بأخته أو أخيه الصّغير، كان يهزّه بقوّته كلّها ممّا يجعل الطفل معلّقا في الهواء، وقد يتعرّض للسّقوط على الأرض.
ومن الأمور الفظيعة التي حصلت جرّاء هزّ الحذل بقوّة، أنّ جدّا في بدايات ستّينات القرن العشرين كان يهزّه بحفيدته التي كانت بعمر حوالي ثمانية أشهر، كانت تحبو، ويبدو أنّها سقطت من الحذل، أو ارتطمت بقوّة بحائط الغرفة، فما عادت تتحرّك ولا تحبو، وبقيت دائمة البكاء، جسمها يذوب كشمعة تحترق، دون أن يأخذها أحد للطّبيب! وعندما وصل عمرها إلى حوالي الرّابعة، وصف لهم “مشعوذ” علاجا للطّفلة، وذلك بأن يحمّموها أربعين يوما مع صلاة الفجر! أي في ساعات الصّباح الأولى قبل شروق الشّمس في واد الدّيماس، أي في سيل مياه المجاري! لتخرج منها النّجاسة التي حلّت بها؛ لأنّ امرأة نفساء أو حائضا قد مرّت فوق الطفلة! وعندما مشت البنت تبيّن أنّها مصابة بكسر في العمود الفقريّ من بين الكتفين، والتحم عمودها الفقري بشكل غير صحيح، حيث كان بارزا كانتفاخ ظاهر بين كتفيها، على حساب عنقها الذي ظهر قصيرا بشكل لافت، وبقيت تعاني إلى أن توفّيت وهي في الأربعينات من عمرها.
النّظافة:
كانت النّظافة معدومة، والمثل الشّعبيّ “صابون العرب لحاها” كان سائدا، بعضهم كان ينظّف يديه بعد أكل المنسف بأن يفركهما بالتّراب، والمحزن أنّهم كانوا يغسلون الخضار المرويّة بمياه واد الدّيماس كالفجل، بمياه المجاري السّائبة في الوادي؛ ليزيلوا الوحل الملتصق بها، ثمّ يأكلونها ويطعمون الأطفال منها، كانت معداتهم وأمعاؤهم تمتلئ بالدّيدان، ممّا يستدعي أن يتوجّهوا إلى بناية في الشّيخ جرّاح قريبة من “الكولونيّة الأمريكيّة”، حيث كانت تعمل ممرّضات أجنبيّات؛ ليشربوا زيت الخروع، مضافا إليه بعض القطرات، فتنزل منهم عشرات أو مئات الدّيدان الطويلة “الاسكارس” التي يتراوح طول الواحدة منها بين 10-20سم. أمّا الخضار الأخرى التي تنمو فوق سطح الأرض كالقرنبيط، الباذنجان، السّلق، السّبانخ والسّبانخ فلا داعي لغسلها!
ومن المحزن أنّ الأطفال كانوا يلتقطون” Male condom “بالونات الواقي الذّكري من مياه واد النّار، ينفخونها ويلعبون بها أمام الكبار، ظّنّا من الكبار والصّغار أنّها بلالين سقطت من أطفال المدينة في المجاري.
انتعال الأحذية:
كان الرّجال ينتعلون البساطير المستعملة التي تباع في سوق الخردوات “الباشورة” أو صندلا نعله من الكاوتشوك الذي يستعمل في إطارات السّيّارات، ونادرا ما كان المرء يرى رجلا ينتعل “الكندرة”،
أمّا النّساء والأطفال فكانوا في غالبيّتهم حفاة، وحتّى بداية خمسينات القرن العشرين كانوا يستعيرون للعروس يوم زفافها حذاء موجودا في بيت المختار، تنتعله بغضّ النّظر إن كان على مقاس قدمها أم لا، وصباح اليوم التّالي يعيدونه إلى بيت المختار مع علبة حلقوم.
الملابس:
أمّا الأطفال قبل دخول المدرسة فقد كانوا حفاة، يرتدي الواحد من الأبناء ثوبا وأحيانا فوقه قمباز، دون ملابس داخليّة. أمّا البنات فكانت يُخاط للواحدة منهنّ قميصا كيفما تيسّر يغطّي جسدها كاملا، وملابس داخليّة أيضا، وإذا كان أبواها ميسورين فقد تطرّز لها والدتها ثوبا كما البالغات، لكن بطيّة واحدة.
عند دخول المدرسة كان البنون ينتعلون صندل “الكاوتشوك”، في حين تنتعل البنات “الوطا” وهو شبيه البسطار لكن نعله من الكاوتشوك. وعلى الطفل أن يحافظ عليه لعام دراسيّ واحد. تماما مثل بنطال وقميص”الكاكي” اللباس الموحّد للتّلاميذ حتى نهاية المرحلة الاعداديّة، وقبل انتهاء العام الدّراسي تكون “الرّقع” مختلفة الألوان قد غطّت البنطال والقميص، وكأنّها هي الأصل، أمّا البنات فكنّ يرتدين المريول المدرسيّ الموحّد، والذي يمتدّ من عنق الواحدة منهنّ حتّى قدميها، وتغطّي رأسها بمنديل، أمّا بناطيل البنات فلم تكن معروفة. وعندما ينتهي دوامهنّ المدرسيّ كنّ يستبدلن المريول بالقميص. في حين كان الأبناء يخلعون بناطيلهم، ويبقون بالسّروال الذي يصل الرّكبة، والمفصّل من قماش”المالطي” السّميك، – ثمن الذّراع منه قرش أردنيّ واحد- وكان البعض يخيطون سرواله من خريطة الطّحين الأمريكي الذي كانت توزّعه وكالة غوث اللاجئين على المخيّمات والقرى الأماميّة
– الواقعة على الحدود-، والمكتوب عليه بالعربيّة والانجليزيّة “هديّة من شعب الولايات المتّحدة الأمريكيّة، ليست للبيع أو المبادلة”.
عندما تزوّج أخي الأكبر محمّد في ربيع العام 1955، اشتروا لي مع كسوة العروس “قمبازا وثوبا” كوني الابن الأصغر “المدلّل” بين الذّكور! وكانت تصغرني أربع بنات، اثنتان أنجبتهما أمّي، واثنتان أنجبتهما زوجة أبي، اشتروا لكلّ واحدة منهنّ قماشا لتخيطه لها والدتها قميصا. – كانت إحدى نساء القرية تملك ماكنة خياطة صغيرة من طراز “سينجر” تضعها على الأرض، ولها يد تديرها الخيّاطة بيدها.
كيف فقدت عيني؟
أثناء سهرة زفاف أخي الأكبر محمد، وابني عمّي اسماعيل موسى في ربيع العام 1955، بنوا بيتا من الشّعَر للرّجال قرب بيتنا، كانت الإضاءة “فنيارا” حيث لم تكن الكهرباء قد وصلت البلدة،- تمّ ربط البلدة بالكهرباء عام 1971- كنت أجلس في حضن أبي، بينما نصبوا السّامر والدّبكة الشّعبيّة أمام بيت الشَّعَر، وبقرب المكان يوجد حاجب حجريّ، يقفز الأطفال عنه، يلعبون ويتمازحون، فرمى أحدهم حجرا على آخر، فأصابني الحجر فوق حاجبي الأيسر، آلمني الحجر، ولم تنزل دماء، وما أن أصابني الحجر حتّى قفزت من حضن أبي وهجمت على الطفل الذي رمى الحجر، وهو يكبرني بعامين، أمسكت به وأنا أصرخ باكيا: “لقد خلعت عيني”، أبعدونا عن بعضنا البعض.
كان الشّباب يطلقون الرّصاص من مسدّس، سقطت منه رصاصة على الأرض، فوضع أحدهم قدمه عليها كي يأخذها ليطلقها هو بنفسه، أتوا بالفنيار وبحثوا عن الرّصاصة، ولم يجدوها، فقمت من حضن أبي وقلت لأخي العريس:
الرّصاصة تحت حذاء هذا الرّجل.
تعجّب الحضور لأنّي رأيت الرّصاصة، علما أنّ المسافة بيني وبينها كانت أقلّ من خمسة أمتار.
صباح اليوم التّالي أي يوم الزّفاف، استيقظت وعيني اليسرى مغلقة لدرجة الالتحام بالقذى، تؤلمني ولونها أحمر، فشخّصوا الحالة بأنّها “حسد”؛ لأنّني رأيت الرّصاصة! وعالجوني بالبخّور والتّعاويذ! ولما ازدادت الحالة سوءا، أعادوا التّشخيص وقالوا بأنّني مصاب بالرّمد الذي كان منتشرا بين الأطفال نتيجة الأوساخ وانعدام النّظافة. بدأ العلاج بأن تحلب امرأة مرضع من ثديها عدّة قطرات حليب في عيني! لكنّ الوضع لم يتحسّن، فأحضروا حليب حمارة مرضعة وقطّروني منه أيضا! يضاف إلى ذلك “التّبخير” وقراءة التّعاويذ! ولمّا لم تتحسّن الحالة اصطحبتني جدّتي لأمّي إلى “فتّاحة” في قرية العيزريّة، كانت امرأة مسنّة. عندما دخلنا بيتها كان ابنها الشّابّ يحمل أرنبا من أذنيه، يريدون ذبحه ليأكلوه، فقالت لجدّتي:
إذا صرخ الأرنب فستشفى عين حفيدك! وأشارت لابنها الذي يحمل الأرنب، ففرك أذني الأرنب الذي صاح ألما، فقالت المرأة:
سيشفى حفيدك بإذن الله، لكن يلزمه علاج.
فسألت جدّتي: ما العلاج؟
فأجابت الفتّاحة: العلاج متوفّر بكثرة لديكم!
– ما هو؟
– خراء حرذون!
فسألت جدّتي متعجّبة: خراء حرذون؟
– نعم خراء حرذون، فالحراذين مؤمنة! ألا ترونها تصلّي؟
– وكيف سنعرف خراء الحرذون؟
– عندما يخرج الحرذون للصّلاة دعوا ولدا كبيرا يضرب عليه حجرا! عندها سيهرب إلى جحره، وهناك ستجدون خراء كثيرا.
دار هذا الحديث على مسمع ومرأى منّي أنا الطفل الذي لا حول ولا قوّة لي، بين تلك المرأة وجدّتي، دفعت جدّتي لها مبلغا من القروش لا أعرف عدده، لكنّه بالتأكيد لن يزيد عن عشرة قروش أردنية، وخرجنا من عندها عائدين إلى بيتنا مشيا على الأقدام كما ذهبنا.
في البيت صدرت الأوامر للفتيان بإحضار خراء حرذون، ولمّا أحضروه تمّ تثبيتي على الأرض أنا الطّفل الذي لم أكمل عامي السّادس، لم يرحموا طفولتي ولم ينقذني بكائي وصراخي، كانت حرّيّتي وحركتي مغتصبة، وضعوا في عيني براز الحرذون المخلوط بالتّراب، نهروني عن البكاء كي لا يخرج “العلاج” مع الدّموع! كان التّراب يدور في عيني ويؤلمني كلّما رفّ جفناي، نزلت دماء من عيني، وهم يحمدون الله ويشكرون “الفتّاحة”؛ لأنّ الشرّ يخرج من عيني!
استمرّ “العلاج” حوالي شهر، فازدادت حالة عيني سوءا، ازداد الاحمرار فيها، تورّم جفناي، عندها قرّروا اصطحابي إلى مستشفى العيون “الدريجات” في سوق الحصر في القدس القديمة مقابل سوق البازار.
كان أبي أو أخي العريس محمد يردفني خلفه على بغلتنا الشّهباء، بعد أن تلبسني أمّي –رحمها الله- “القمباز”! يربط البغلة في خان للدّواب في باب السّلسلة، نمشي إلى المستشفى، وفي زيارتنا الأولى للمستشفى سأل طبيب عربيّ- تعرفت عليه لاحقا بعد أن كبرت، وكان شخصيّة وطنيّة بارزة- عمّا جرى لعيني؟
فأجبته: فلان ضربني حجرا في سهرة عرس أخي، وذكرت له اسم الولد، وأشرت إلى المكان الذي أصابه الحجر، غير أنّ أبي – رحمه الله- نفى ما قلته، وأكّد أنّني مصاب برمد لا يعرف سببا له! عرفت سبب نفيه لروايتي، وعدم قوله الحقيقة للطبيب لاحقا عندما كبرت، فقد كانت الشّرطة الأردنيّة تريد فرض القانون وفرض هيبة الدّولة، فعمّمت على المستشفيات بضرورة تبليغ الشّرطة عن أيّ إصابة بسبب مشاجرة تصل المستشفيات، فتعتقل طرفي المشاجرة وتعاقبهم بالضّرب والسّجن وفرض الغرامات الماليّة، وأبي يردّد:
كيف سنكون سببا في اعتقال من جاؤوا؛ ليشاركونا فرحتنا؟ وواضح هنا أنّه لم يكن تمييز بأنّ الجاني طفل لم يتجاوز الثّامنة من عمره ولا يمكن اعتقاله.
عندما كان الطّبيب يعود لروايتي كان يقول: إذا كان كلام الولد صحيحا، فربما جرى نزيف داخليّ على عصب العين، وهذا أمر سهل، نستطيع سحب الدّماء من عصب العين، فتضعف الرّؤية فيها لعدّة أيّام، لكنها لا تلبث أن تعود ثانية، وإذا تركناها سيتجمّع النّزيف وستتجمّد الدماء النّازفة، وسيفقد الولد عينه، غير أنّ أبي بقي على اصراره، ولم يجد كلام الطبيب آذانا صاغية من أبي أو أخي الأكبر.
تردّدنا على المستشفى لأكثر من شهرين، بشكل شبه يوميّ دون جدوى، بعدها قرّر الأطبّاء أن أرقد في المستشفى لاجراء عمليّة جراحيّة.
في المستشفى وضعوا لي سريرا في غرفة واسعة، يرقد فيها ستّة مرضى عجائز، أعطوني منامة “بيجاما” ففرحت بها كثيرا وأنا لا أدرك ما أنا فيه، ولا ما ينتظرني. كانت وحدة الحمّامات خارج الغرفة، ثلاثة مراحيض أمامها مسافة تزيد على المتر، فيها مغسلة ويحيط بها سور له بوّابة حديديّة تغلق بزند من الخارج. كانت مهمّتي أن أقود المرضى العجزة في غرفتي إلى الحمّام ليل نهار. وذات ليلة كلّما غفوت كان يقوم أحدهم وهو عجوز كفيف، يخزني بعصاه كي أستيقظ وأقوده إلى الحمّام، وأنتظره حتّى أعيده إلى سريره، كرّر ذلك مرّات عديدة في ليلة واحدة، فقدته وأنا غاضب، وتصرّفت تصرّفا صبيانيّا، حيث أغلقت عليه الباب الرّئيس لوحدة المراحيض بالزّند من الخارج، وعدت إلى سريري لأنام على أمل أن أعود له بعد ساعة، لكنّ سلطان النّوم سيطر عليّ حتّى الصّباح والرّجل ينادي دون مجيب، وعند الصّباح فتح له أحدهم الباب وهو يشتم ويتوعّد، فخفت منه وهربت من سريري واختبأت تحت سريره، عندما دخل الغرفة اتّجه إلى سريري وانهال عليه ضربا بعصاه وسط شتائم مقذعة، ظنّا منه أنّني في السّرير، ولمّا تأكّد من عدم وجودي أخذ يبحث عنّي بعصاه تحت سريري، ولمّا جاء الأطبّاء والممرّضات، ضحكوا ممّا فعلت، وأخرجتني ممرّضة اسمها “ليلى” من تحت سريره، حملتني بحضنها وهي تقبّلني ضاحكة.
مكثت في المستشفى سبعة وعشرين يوما، عملوا لي الجراحة في الأسبوع الثّاني لرقودي في المشفى، كانوا يغيّرون لي اللفّافة التي على عيني يوميّا بعد أن يغطّوا عيني اليمنى بضمّادة مع أوامر بعدم فتحي لعينيّ.
في هذه الأثناء حاولت ببراءة طفولتي أن أهرب من المستشفى، كي تبقى لي المنامة “البيجاما”، وتركت لهم “القمباز”، وأثناء محاولتي فتح البوّابة الرّئيسة للمستشفى، رآني ممرّض ولحق بي، بقيت أركض حتّى وصلت “بير أيّوب” في سلوان” حيث أمسك بي أحد أبناء البلدة الذي كان يملك بقّالة في المكان، وسلّمني للممرّض الذي انهال عليّ ضربا، لم أوافق على الرّجوع معه، فكان يحملني بين يديه، وعندما يتعب يجلس ليستريح، وينهال عليّ ضربا من جديد.
وفي اليوم السّابع والعشرين، سقطت الضّمادة عن عيني، ففوجئت بأنّني لا أرى فيها شيئا، أخبرت الطبيب والممرضة بذلك وأنا أبكي، وبكت معي الممرّضة ليلى فقد أشفقت عليّ، أعادوا تغطية عيني مرّة أخرى، وبقيت أبكي حتّى وصل أخي محمّد، فنزعت الضّمادة لأريه عيني، ولمّا رآها وقد اكتست بالبياض، غضب وشتم الأطبّاء والعاملين في المستشفى وأعادني معه إلى البيت.
رضيت مرغما بالمصيبة التي حلّت بي، رغم الآلام الجسديّة والنّفسيّة التي صاحبتني لسنين طويلة، وكلّما حاولت الابتعاد عنها ونسيانها كانوا يذكّرونني بها من خلال حنان الجهل والهبل.
في صيف العام 1979 عادت عيني تؤلمني، فذهبت إلى مستشفى العيون في حيّ الشّيخ جراح في قدسنا الذّبيحة، فقرّر الأطبّاء استئصال عيني، واستبدالها بعين زجاجيّة اصطناعيّة، وبعد العمليّة التي جرت بتخدير موضعيّ، جاء الطبيب الجرّاح يحمل في يده وعاء زجاجيّا بداخله جسم أسود داكن شبه دائريّ، على شكل قطعة معدنيّة حادّة الأطراف، حمله بين اصبعيه السّبّابة والابهام وهو يقول: هذا دم متجمّد لدرجة التّحجر في عينك، بسبب نزيف دمويّ قديم كان سببا في خسارتك لعينك. وهو الذي كان يؤلمك في هذه المرحلة. أمسكته بيدي، تحسّسته وأعدته إليه دون كلام.
الختان:
في طفولتنا لم يكن ختان الذّكور يتمّ بعد الولادة مباشرة كما هو الحال في زمننا هذا، لأنّ الأمّهات كنّ ينجبن في البيوت، وكان “المطهّر” الذي كانوا يلقّبونه “بالشّلبي” حلّاقا يقصّ شعور الرّجال، ولا علاقة له بالطّبّ ولا بالتّمريض، ويتمّ الختان بشكل جماعيّ لأبناء العائلة والجيران، وربّما الحامولة، وينتظرون المرأة الحامل حتّى تلد، على احتمال أن تنجب ابنا ذكرا، ولا أزال وسأبقى أذكر يوم ختاني بشكل دقيق، فبعد خروجي من مستشفى العيون، جرى ختاني أنا وشقيقي ابراهيم الذي يكبرني بعام، وأخي طه الذي يكبرني بعامين، وابن عمّي صالح الذي يصغرني بأربعين يوما، وأحد أبناء الجيران الذي يكبرني بعامين، حيث جاؤوا بالحلّاق “أبو داود أبو غزالة” من القدس، أولموا شاة، اجتمع عدد من الأعمام والأخوال وبعض الأقارب، ألقوا القبض علينا وحشرونا في غرفة بعد أن ألبسونا ثيابا جديدة، كنّا نبكي لأنّنا مدركون تماما لما سيحدث، يخرجنا أحدهم واحدا تلو آخر إلى البرندة المكشوفة حيث يجلس الرّجال، يثبّت الواحد منّا أكثر من رجل، ويقوم الحلاق بعمليّة الختان، ومن يُختن ينقلونه إلى غرفة مجاورة، يسلّمونه لأمّه، التي تحتضنه بحنان زائد وتهدّئ من روعه، كما فعلت معي أمّي، في حين احتضنت جدّتي لأمّي شقيقي ابراهيم، في ذلك اليوم كنت أصغر اخوتي المختونين عمرا، وكان عمري خمس سنوات وبضعة أشهر. بعد الختان ببضعة أشهر التحقت بالمدرسة، في حين كان أخواي طه وابراهيم وابن الجيران قد أكملوا عاما دراسيّا كاملا.
إلى المدرسة
في تلك المرحلة كانت مدرسة السّواحرة الغربيّة الابتدائيّة للبنين تتكوّن من غرفتين مقامتين على أرض تملكها الأوقاف الاسلاميّة، وتستأجر أربع غرف مقامة بجانب بعضها البعض يملكها المرحوم الحاج عطيّة حسن عبده، الذي تبرّع بماء بئره الواقع بجانب المدرسة؛ ليشرب منه الطلاب، كما استأجروا غرفة أخرى من المرحوم حسين قاسم أبو دهيم، جرى هدمها وبناء بيت مكانها في ثمانينات القرن العشرين، في تلك الغرفة كان يدرس طلاب الصّفّ الأوّل الابتدائيّ، خرجت من مستشفى العيون مع افتتاح العام الدّراسيّ 1955-1966، لم أجد أطفالا ألعب معهم، فكنت أذهب مع أخي المرحوم طه، الذي كان راسبا في الصّفّ الأوّل، يدخل تلاميذ الصّف إلى الفصل، وأبقى أنا على النّافذة التي عليها شباك حماية حديديّة، لم يقبلوني في المدرسة؛ لأنّني لم أبلغ السّابعة حسب القانون وقتذاك.
المعلّم يدرّس التّلاميذ كلمات عربيّة حروفها غير متشابكة حسب كتاب “القراءة” لمؤلّفه المربّي خليل السّكاكيني مثل “راس- روس، دار- دور” ويركّز على الحروف ليتعلّموها، فحفظوا الحروف والكلمات من كثرة التّكرار، عندما كان المعلّم يقدّم حرفا أو يؤخّر حرفا آخر يلتبس الأمر عليهم ولا يعرفون الحروف، بينما كنت أجيب على أسئلته دون استئذان من خارج الشّبّاك، كان يطردني، ويخرج من الصّفّ محاولا الامساك بي، لكنّني كنت أهرب، حتّى يعود إلى الصّفّ، فأعود إلى مكاني عند الشّبّاك، وذات يوم عكس حروف الكلمات ليسأل عن الحروف، فأجبته بكلمات صحيحة حيث أجبت:” سار، سور، راد رَوَد” فانتبه لي وابتسم وهو يشتمني. وفي اليوم التّالي وكانت بداية شهر تشرين الثّاني –نوفمبر- علّم التّلاميذ جدول الضّرب للعدد “2” وطلب منهم أن يحفظوه، وفي اليوم التّالي جاء أغلبيّتهم وقد حفظوه بالتّرتيب، فسأل:
2×7 ولم يعرف الإجابة أيّ طالب، فأجبت أنا 14، وعاد فانتبه لي وسألني:
2×11 فأجبته 22، وواصل سؤاله لي: 2×15 فأجبته 30، وسأل مرّة ثالثة 2×50 فأجبته 100، فابتسم وشتم من خلفوني وهو يقول” الله يجعلك مية قطمة انت وللي خلفوك”، في حينها تعلم التّلاميذ 2×10، وما بينهما.
كان الجوّ عاصفا وباردا، يتساقط رذاذ المطر، أشفق المعلّم عليّ، وأخبر مدير المدرسة المرحوم محمد خليل حمادة من قرية صورباهر المجاورة، فقال له:
أدخله إلى الصّفّ مع التّلاميذ، فإن نجح سنسجّله في نهاية العام الدّراسيّ، وهنا تدخّل جارنا المعلم المرحوم محمّد حسين جوهر وقال للمدير وللمعلّم:
هذا الطفل الأذكى في حارتنا، وبالتّأكيد سينجح .
عندما سمح لي المدير أن أدخل إلى الصّف، طرت فرحا، لم تعد الدّنيا تتّسع لي، دخلت الصّفّ مختالا كالطّاؤوس، لأكون التّلميذ رقم 63 في غرفة صفّيّة لا تصل مساحتها 25 مترا مربّعا، والمقاعد الخشبيّة كانت متراصّة لا ممرّات بينها، في حين المقاعد الأولى منها كانت ملتصقة باللّوح، بينما توجد مساحة لا تزيد عن متر يقف فيها المعلّم. لم يكن لي مكان للجلوس، أمضيت عامي الدّراسيّ واقفا، مستندا على جدار الغرفة، بجانب أخي وعلى يساري شبّاك، وعندما يطلب المعلّم منّا كتابة شيء، كنت أضع دفتري على عتبة الشّبّاك وأكتب، وبتعليمات من المعلّم أصبحت شريكا لأخي في كتاب القراءة الذي استلمه من المدرسة، وعليه أن يعيده لها في نهاية العام الدّراسيّ؛ ليتسلّمه غيره في بداية العام الدّراسيّ القادم! كانت تحصل مشاجرات كثيرة يوميّا بين التّلاميذ بسبب الازدحام، فكلّما التطم طالب بآخر بشكل عفوي، يردّ عليه الثّاني بصفعة، وهكذا، دون أن يستطيع المعلّم فكّ المتخاصمين لأنّه لا يستطيع الوصول إليهم.
المعلّمون يحمل كلّ واحد منهم عصا بيده، يضرب بها التّلاميذ بسبب ودون سبب، معلّم الصّف الأوّل الابتدائيّ موسى الحسيني –رحمه الله- كان رجلا مسنّا أشيب، يضع حطّة وعقالا على رأسه، يحمل في يده عصا لا يزيد طولها عن 30 سم، كان حريصا جدّا على تعليم التّلاميذ، ومن يرتكب منهم مخالفة يُعاقب بالضّرب بنعومة على راحة يده، وكأنّي بذلك المعلّم يؤمن بضرورة التّاديب لكن دون عنف. في حين كان معلّمون آخرون يضربون التّلاميذ بقسوة ودون رحمة وبطرق عجيبة، أذكر أنّ معلم اللغة العربيّة للصّفّ الرّابع قد علّمنا ضمائر الرّفع المنفصلة، وكتبناها في دفاترنا، وفي اليوم التّالي سأل: من حفظها منكم ومتأكّد أنّه لن يخطئ يبقى مكانه، ومن لم يحفظها ليخرج كي يتلقّى أربع عصيّ على راحتي يديه، ومن بقي مكانه وثبت أنّه يخطئ بها سيجلد ثماني عصيّ، فخرج تلاميذ الصّفّ جميعهم، ضربنا وسط شتائم مقذعة، وعندما عدنا إلى مقاعدنا، طلب من البعض وكنت أوّل من طلب منه أن أسمّعها، فذكرتها جميعها دون أيّ خطأ، فسألني غاضبا:
لماذ لم تبق في مقعدك وخرجت للضّرب ما دمت حافظا لها؟
فأجبته: خوفا من العقاب المضاعف.
فزمجر الرّجل غضبا، وضربني ضربتين أخرتين؛ لأنّني لا أعرف أنّي أعرف! وهذا ما فعله مع عدد آخر من التّلاميذ!
لم يكن الضّرب مقصورا على راحتي اليدين فقط، فقد كان بعض المعلّمين يجلدون التّلاميذ “فلقة” على باطن قدميهم، أو يجلدونهم على قفاهم!
في الصّفّ لم أعد أرفع إصبعي عندما يسأل المعلّم، ولم أعد أجيب على أيّ سؤال إلا إذا طلب المعلّم ذلك منّي بالاسم.
لم يكن للمدرسة حمّامات، وكان الطّلاب يقضون حاجاتهم كيفما تيسّر في المنحدر الواقع جنوب المدرسة، حيث لم تكن مأهولة تلك المنطقة، وفي الواقع فإنّ الغالبيّة العظمى من بيوت القرية كانت بدون حمّامات، وعدد قليل جدّا منها كان له مرحاض خارجيّ.
كان في المدرسة “قِدْر” معدنيّ كبير جدّا، يغلون فيه يوميّا حليبا مجفّفا يأتي بشوالات كبيرة (كانت التّسمية الدّارجة لذلك الحليب هي “حليب اللاجئين”؛ لأنّ وكالة غوث اللاجئين كانت توزّعه على أبناء المخيّمات، وقرى الخطوط الأماميّة)، ودفع كلّ تلميذ نصف قرش ثمنا لكوب بلاستيكي، يعلّقه في حزامه؛ ليشرب فيه عندما يعطش، من خزّان له صنبور نصبوه على حجارة بجانب بئر الماء، وليجبر على احتساء كوب حليب مغليّ في ذلك الكوب، بعد محاضرات مكثّفة من المدير والمعلّمين عن أهمّيّة ذلك الحليب لدواع صحّيّة، ولأنّ الغالبيّة العظمي من أهالي التّلاميذ كانوا يقتنون الأغنام، ويشربون من ألبانها، فقد كانوا يتقزّزون من ذلك الحليب ويهربون من تناوله، ممّا دفع إدارة المدرسة إلى غلي كمّية قليلة من الحليب في طنجرة عاديّة، توضع أمام غرفة المعلّمين كي يملأ أيّ طالب كوبه منها إن أراد ذلك.
في تلك الفترة كان غالبيّة التّلاميذ يصابون بالقرع بسبب الأوساخ وانعدام النّظافة، فتتقرّح رؤوسهم المحلوقة بالشّفرة، وتنتقل العدوى من تلميذ لآخر، كما كانوا يفرضون على التّلاميذ حلق شعر رؤوسهم على الصّفر، لدواعي النّظافة، كي لا يكون الشَّعر مأوى للقمل والبراغيث.
كان لباس المدرسة موحّدا، وهو عبارة عن بنطال وقميص “كاكي” ذي اللون التّرابي.
وعلى كلّ تلميذ أن يحمل في جيبه “محرمة قماش” عليه أن يحملها بيده، ضاغطا عليها بإبهامه، ويقلب يده لينظر مربّي الصّفّ إن كانت أظافره طويلة أم لا، في الصّباح عندما يقرع الجرس إيذانا ببدء الدّوام. علما أن قصّ الأظافر كان بواسطة سكّين” شفرة الحلاقة” بعد أن تستهلك في حلاقة ذقن ربّ الأسرة.
قبل الدّخول إلى الصّفوف، ينشد الطّلاب بشكل جماعي أثناء الاصطفاف الصّباحيّ:
“دمتَ يـا شـبلَ الحسين قـائـدَ الجيـش الأبـيّ
وارثــا للنّهضـتين مجـدُ عـزٍ يعـرُبـيّ”
بين الصّندل والوطا
عندما دخلت الصّفّ الدّراسيّ الأوّل، اشتروا لي صندلا نعله “كاوتشوك” الذي يستعمل في إطارات السّيارات، واشتروا لأختي مريم التي تصغرني ببضعة أشهر “وطا”، فطمعت بنعل أختي ورفضت الصّندل، فوعدوني بأن يشتروا لي “وطا” مثله في اليوم التّالي، لكنّني رفضت ذلك بشدّة، وبقيت أبكي وأصرخ، ممّا اضطرهم لإعطائي”وطا” أختي مريم الذي كان أصغر من مقاس قدميّ، فحشوت قدميّ فيه، وأخذت أطارد بسعادة غامرة لأكثر من ساعة، عدت إلى البيت منهكا وقد تجلّط ظاهر أصابع قدميّ، خصوصا الإبهام في كلّ قدم، إضافة إلى مؤخّرة القدمين، فنمت محموما، لأستيقظ صباحا وقد تورّمت أصابع قدميّ، أمضيت شتاء ذلك العام حافي القدمين؛ لأنّني لم أعد قادرا على انتعال الصّندل بسبب تقرّحات قدميّ، وكان المرحوم الأستاذ داود عوّاد “الهايب” من أبوديس يشفق عليّ، ويطهّر لي التّقرّحات باليود، ويضع لي ضمّادة لا تلبث أن تسقط أثناء اللعب.
الحقائب المدرسيّة
كانت حقائبنا المدرسيّة عبارة عن خريطة من قماش “المالطي” رخيص الثّمن، أو من خريطة الطّحين الأمريكي، تخيط أمّهاتنا الخريطة على شكل مستطيل 30×25 سنتيمتر تقريبا، وفي طرفيها العلويّين “دكّة”، غالبا ما تكون دكّة سروال مهترئ للوالد، كي يعلّق التّلميذ حقيبته على كتفه، وعندما كانت الحقيبة تُمزع من أحد جوانبها، كانت الأمّ ترقعها بقطعة قماش.
أوّل حقيبة اشتروها لي عندما دخلت الصّفّ الاعداديّ الأوّل، وكانت من البلاستيك المقوّى والليّن.
ولائم للمعلّمين
حظي المعلّمون في تلك المرحلة بمكانة اجتماعيّة لافتة، وإمعانا من الأهالي في تكريم المعلّمين فقد كان العديد من أولياء أمور التّلاميذ -ومنهم المرحوم والدي- يدعون المعلّمين إلى وليمة في بداية كلّ عام دراسيّ، يذبحون لهم شاة، ويقدّمون لهم المناسف، ويوصون المعلّمين بأن يضربوا التّلاميذ كي يتعلّموا! “اللحم لكم والعظم لنا” أي اضرب ابني الطّفل الذي تدرّسه لكن لا تكسر عظمه! ولم يخيّب المعلّمون ظنّ أهلنا، فكلّ واحد منهم كان مسلّحا بخيزرانة، يضرب فيها تلاميذه بسبب ودون سبب.
يوم دراسي طويل
يجدر التّذكير هنا أنّ اليوم الدّراسيّ كان يوما طويلا يستمرّ من الثّامنة صباحا وحتّى السّاعة الثّالثة والنّصف بعد الظّهر، تتخلّله فسحتان الأولى بعد الحصّة الثّالثة ومدّتها 20 دقيقة، والثّانية بعد الحصّة الرّابعة وتمتدّ لساعة ونصف، وكانت تسمّى “فرصة الغداء” مع أنّه لا يوجد مع التّلاميذ ما يأكلونه! ومن كان منهم بيته قريبا كان يعود إلى البيت ليأكل ما يتيسّر له.
الحبس للرّجال!
من الغريب أنّ المعلّمين كانوا يعاقبون التّلاميذ الذين لا يحفظون درسهم، أو لا يقومون بواجباتهم المدرسيّة كنسخ درس المطالعة، بحبسهم في غرفة الصّفّ طيلة فرصة الغداء، حيث يمنعون من الخروج، والعجيب أنّهم كانوا يلتزمون بذلك خوفا من العقاب الجسديّ الذي يتعرّض له المخالف، وقد اعتاد الطّلبة الكسالى على هذا “الحبس”، بل ويفاخرون به بقولهم:”الحبس للرّجال”.
أنهيت الصّف الأوّل الابتدائيّ بتفوّق وحصلت على جائزة عبارة عن طابة ثمنها قرش ونصف.
إلى البقيعة وإن طال السّفر
كنت في الصّفّ الأوّل الابتدائي، وشقيقي ابراهيم في الصّفّ الثّاني، عند انتهاء دوامنا المدرسيّ في الثّالثة والنّصف من بعد ظهر كلّ يوم خميس، كنّا نذهب راكضين إلى البرّيّة؛ لننام ليلتنا في حضن أمّي، حيث كان السّكن في “جوفة إمّ دسيس”، وقبل الغروب بدقائق في ذلك اليوم الرّمضانيّ مررنا ب السيّدة “عليَة”علي سالم درجة التي كانت تسكن في “إمّ الرّتم” قبل مضارب أهلنا بحوالي 500 متر، وجدناها تنتظرنا عند بئر الماء بجانب الطّريق، فقالت لنا:
” أهلكم رحلوا بالأمس إلى البقيعة، وأمّكم أوصتني بأن أنتظركم لتناموا عندنا، وفي الغد ستعودون إلى أهلكم ومدرستكم”.
سمعنا هذا الكلام وواصلنا سيرنا ركضا وهي تركض خلفنا دون أن تتمكّن من اللحاق بنا، لم ندخل البقيعة من قبل، لكننّا كنّا نعرف بدايات أكثر من طريق إليها، كنّا نظنّ أنّ البقيعة مجرد مكان صغير لنا، رغم أنّ مساحتها تزيد على 50 ألف دونم، واصلنا طريقنا ركضا عبر واد الدّكاكين -سمّي بهذا الاسم لكثرة الكهوف فيه- وواصنا طريقا كأنّنا في سباق مراثونيّ مرورا بمنطقة “جوايف شرف” و”الزّرانيق” والأخيرة منطقة شديدة الوعورة، تكثر فيها الضّباع والذّئاب وبنات آوى والثّعالب، لكثرة صخورها وجحورها، هبطنا الجبال المرتفعة حتّي أشرفنا على البقيعة، فظهر لنا ضوء خافت بعيد، سمعنا نباح كلاب، واصلنا طريقنا راكضين باتّجاه الضّوء ونباح الكلاب، ظنّا منّا أنّه ضوء بيتنا، عندما اقتربنا من البيت هجمت علينا الكلاب، فصرخنا مرتعبين، وإذا بصوت صاحب البيت يصيح بأبنائه كي يحمونا من الكلاب، سمعناه وهو يقول:
هذا صراخ أطفال.
هرع إلينا أكثر من رجل من البيت وهم حفاة.
وفي البيت سألنا صاحبه وهو المرحوم عبد أبو خليل من العبيديّة عمّن نكون؟ واكتشفنا لاحقا أنّ البيت يقع على الحدود التي تفصل بقيعة السّواحرة عن بقيعة العبيديّة، ولمّا أخبرناه قال لنا:
أهلكم يسكنون بعيدا في منطقة “الطِّبِق” على بعد بضعة مئات من الأمتار عن مقام النّبي موسى. وهي بعيدة من هنا، ناموا ليلتكم عندنا، وسنوصلكم غدا لأهلكم، لكنّنا لم نقبل واستمرّينا بالبكاء، فأشفق علينا، امتطى حمارا له ليوصلنا، وضعني أمامه ودثّرني بفروته التي كان يرتديها لتقيه من البرد، في حين أردف شقيقي ابراهيم خلفه، كنت نائما في حضن الرّجل، وصلنا مضارب أهلنا فوجدناهم قد استيقظوا لتناول السّحور، فقام أبي وذبح للضّيف خروفا، دثّرتنا الوالدة بما توفّر من غطاء، ونمت أنا وشقيقي على غير هدى بينما كانوا يشوون اللحوم على صاج الخبز قبل بزوغ الفجر.
في اليوم التّالي شوت لنا الوالدة لحوما على الصّاج، فأكلنا حتّى شبعنا، ثمّ وضعت لنا لحوما مطبوخة باللبن ملفوفة بخبز الصّاج “الشراك”، في خريطة قماش، وودّعتنا باكية؛ لنعود إلى البيت في جبل المكبّر، استعدادا للذّهاب إلى المدرسة في صباح اليوم التّالي.
في البقيعة لم نشعر بالبرد، فهي منطقة منخفضة تقع تحت مستوى سطح البحر، لكنّ الأجواء كانت عاصفة وممطرة في المناطق الجبليّة، ما أن صعدنا المرتفعات الجبليّة، تاركين البقيعة خلفنا، حتّى واجهتنا الرّياح الغربيّة التي لا تحتملها أجسادنا الصّغيرة إلا بصعوبة، بلغت الرّياح ذروتها عندما وقفنا على قمّة جبل المنطار المرتفعة، وهناك صرنا نقاوم قدر استطاعتنا لنتقدّم في طريقنا، صارعنا الرّياح التي أخذت تتلاعب بنا كقارب صغير ثارت عليه أمواج البحر الغاضبة، واصلنا طريقنا غربا بأقصى سرعة نستطيعها وكلّ منّا يمسك بيد الآخر، وعندما انحدرنا من جبل المنطار غربا، ووصلنا منطقة “ثغرة رهوة” حيث الشّارع التّرابيّ الذي يربط العبيديّة بمنطقة الخان الأحمر، ومن تلك المنطلقة ينطلق شارع ترابيّ آخر غربا إلى الضّحضاح، فالسّواحرة الشرقيّة، توقّفت بجانبنا شاحنة صغيرة”بيك أب” كان بداخلها رجلان وبيد كلّ منهما بندقية صيد”خرطوش”، سألنا أحدهم:
من أين أنتم؟ إلى أين أنتما ذاهبان؟
– إلى السّواحرة.
أشفقا علينا، وطلبا منّا أن نركب في صندوق السّيارة الخلفي المكشوف.
فركبنا، ونظرة لسرعة الرّياح، فقد اختبأنا في مقدّمة الصّندوق، خلف “الكابينة” الأماميّة، لنحمي أنفسنا من البرودة والرّياح العاصفة كيفما يتيسّر لنا.
عند آخر السّواحرة الشّرقيّة، حيث يقع الآن حاجز الاحتلال المسمّى “الكونتينر”، اتّجه السّائق بالسّيّارة جنوبا باتّجاه العبيديّة، لم ينتبه الرّجلان لنا، ولم نستطع أن نوصل لهما إشارة بالتّوقف لإنزالنا، صعدت السّيارة “دبّة الخنزيرة، حتّى وصلت دير “أمّ عبيد”، ثمّ اتجهت إلى الجنوب الغربيّ باتّجاه بيت ساحور، صراخنا يتبدّد وسط الرّياح العاتية، ودموعنا تضيع وسط رذاذ المطر المتساقط.
توقّفت السّيارة في بيت ساحور، فنزل منها الرّجلان، سألنا السّائق الذي كان على رقبته سلسال ذهبيّ يتدلّى منه صليب ونحن نرتعد خوفا وبردا:
إلى أين أستطيع أن أوصلكما؟
فقلنا له ونحن نبكي:
نحن سواحرة من جبل المكبّر.
أبدى الرّجل أسفه وقال:
لا تخافا يا عمّي، أدخلنا في السّيّارة بجانبه بعد أن نزل رفيقه، وسار بنا إلى موقف باصات بيت لحم أمام كنيسة المهد، أوقف سيّارته وقادنا إلى الباص المتّجه من بيت لحم إلى القدس، مررنا ببائع هريسة، فاشترى لكلّ واحد منّا قطعتي هريسة بقرش، أعطى كلّا منا “شِلنا” –خمسة قروش- وصعد بنا درجات الباص، أجلسنا في المقعد خلف السّائق، بعد أن دفع قرشا أجرة الباص عن كلّ واحد منّا، أوصى السّائق قائلا:
هذان الطّفلان يعانيان من البرد والتّعب، ربّما ينامان في الطّريق، انتبه لهما وأنزلهما عند مقهى “أبو جوهر” في قمّة جبل المكبّر، لا تنس، وإن نسيت فإنّهما سيبقيان معك طيلة اليوم. وفعلا أنزلنا السّائق في المكان المحدّد، وعدنا إلى بيتنا.
ربنا أطعمنا في رمضان
عندما كنت تلميذا في الصّفّ الثّاني الابتدائيّ، جاء شهر رمضان في فصل الشّتاء، وذات يوم ماطر وبينما كان الأهل يسكنون في منطقة “مخسف النّجمة” في البقيعة، اشتدّت الأمطار، وانتشر ضباب كثيف، فظنّوا أنّ الغروب قد حلّ، وحانت ساعة الافطار، تناول الصّائمون افطارهم، وإذا بالجوّ قد اعتدل، فانقشع الضّباب، وظهرت الشّمس من جديد! فواصلوا الصّيام من جديد وهم يردّدون:
” ربنا أطعمنا”!
مظاهرة ضدّ حلف بغداد
في عامنا الدّراسيّ 1956-1957 جاء أحد شباب البلدة، وكان طالبا في المرحلة الثّانويّة في المدرسة الرّشيديّة، وزّع على الطلّاب عددا من صور الرّئيس المصريّ جمال عبد النّاصر، وأخذ يهتف بحياة الرّئيس، وبسقوط حلف بغداد، وتحرير فلسطين، وقاد التّلاميذ في مدرستنا الابتدائيّة في مظاهرة، والأطفال وأنا منهم نردّد خلفه ما يقول دون أن أدرك ما يقوله! سار بنا باتّجاه الشّارع الرّئيسيّ الذي يربط القدس وشمال الضّفّة الغربيّة ببيت لحم ومناطق الجنوب، سارت المظاهرة حوالي مئة متر، جاء شرطة مخفر البلدة، أمسكوا به واقتادوه وهم يحملون العصيّ في أيديهم، هرب التّلاميذ، بينما بقيت مكاني وبيدي صورة زعيم الأمّة مع ثلاثة من التّلاميذ، وعدم هروبنا ناتج عن عدم ادراكنا لما يحدث، اقترب منّا شرطيّ واقتادنا إلى المخفر. في حين اقتادوا الشّابّ إلى جهة لا أعلمها. في المخفر أجبرنا الشّرطيّون على تنظيف محيط المخفر، استدعوا أولياء أمورنا للتّوقيع على كفالة، وعدنا إلى البيت. علمت لاحقا أنّ ذلك الشّابّ سجن لمدّة ستّة أشهر.
شهادات الميلاد لمواليد العائلة الجدد
استأت جدّا من عدم تسجيل شهادات ميلاد لأبناء الأسرة بشكل دقيق عندما يولدون، لكن “ما باليد حيلة”، ومع ذلك انتبهت لهذه الأمور في سنّ مبّكرة، فعندما أنجبت زوجة أخي محمد ابنهما البكر كمال بتاريخ 27-4-1957، وكذلك عندما أنجبت زوجة أبي بتاريخ 5-5-1957، أخي جمال –آخر عنقودها-، قمت بتسجيل تاريخ ميلاد كلّ منهما بحجر جيريّ” حِوَّر” على حائط الغرفة غير المدهون، بعدها اشتريت دفتر جيب بنصف قرش- لا زلت أحتفظ به حتّى يومنا هذا- وسجّلت على صفحاته كلّ مناسبات العائلة من حالات ولادة، حالات وفاة، زواج وسفر، وعندما وصلت الاعداديّة وعرفت مكتب وزارة الصّحة الذي كان خلف الغرفة التّجاريّة في القدس-الآن تشغله مدرسة بنات- عملت لهم شهادات ميلاد، واستمرّيت بذلك، حتّى عرفوا الميلاد في المستشفيات في سبعينات القرن العشرين.
الجوع الكافر:
بعد نكبة الشّعب الفلسطيني في العام 1948 أصبح الفقر والجوع والحرمان ظاهرة لا يمكن اخفاؤها، أو التّستّر عليها، وتزداد هذه الظّاهرة ضراوة في سنوات المحل التي تنحبس فيها الأمطار. فالبطالة منتشرة، ومصادر الرّزق تكاد تكون معدومة، فكان العمّال يعملون في ورشات الأشغال العامّة لتعبيد الشّوارع وفتح شوارع جديدة بطرق بدائيّة، تعتمد على الجهد العضليّ، كانت أجرة العامل تتراوح بين 25-30 قرشا أردنّيّا في اليوم. لكن هذا العمل لا يتوفرّ إلا لثلاثة أو أربعة أشهر في صيف كلّ عام.
في بلدتنا كان الميسورون هم من يقتنون قطعان الأغنام، ومن يزرعون الخضار على جانبي واد النّار، ويروونها بمياه المجاري المنسابة من مدينة القدس. وأيضا من يزرعون الأراضي الشّاسعة بالحبوب، لكنّ الحصاد غير مضمون لاعتماده على مياه الأمطار غير المنتظمة، لذا فإنّهم لجأوا إلى تخزين القمح الزّائد عن حاجة الاستهلاك السّنويّ في سنوات الخصب، ليسدّ احتياجاتهم في سنوات القحط.
ومع ذلك كان هناك فقر مدقع وبشكل نسبيّ ومتفاوت، أعرف أسرة كريمة مستورة الحال، مكوّنة من أب مسنّ هَرِم، يعيل زوجته وأربعة أطفال، لم تكن له أرض ولا أغنام، يعيشون حياة الكفاف في خشّبيّة من ألواح الزّينكو الصّدئة ليست ملكا لهم، أحد أبنائهم مولود في العام 1945، طويل القامة ضخم الجثّة، وبسبب الفقر والحرمان يأكل كلّ ما يقدّم له، فاشتكت والدته –رحمها الله- ذلك لإحدى العجائز فقالت لها:
ابنك مصاب بجَرَبِ البطن”تقصد المعدة”! ضعي له في الطّعام “كبريت”،
– معجون كريه الرّائحة، لونه أصفر، كانوا يحضرونه من دائرة البيطرة، ويدهنون به وجوه الماشية التي تصاب بالجرب- كان ذلك الطّفل يستمع لحديثهما، فقامت والدته وحضّرت طنجرة من “شوربة العدس” وعملت له “فتيتا”، لكنّه رفض تناول الطّعام لتخوّفه منه، فأرادت والدته تشجيعه بأن وضعت في فمها لقمة واحدة؛ لتشجّعه على تناول “الفتيت”وهي تردّد لا تخف. فدبّت أوجاع لا تحتمل في معدتها، تمّ نقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها. وخرجت من المستشفى لتمضي بقيّة حياتها تلهث متألّمة، تعاني من صعوبة في التّنفّس، وآلام في المعدة.
وليت تلك الأسرة مستورة الحال ومثلها كثيرون أخذوا بنصيحة الصّحابيّ الجليل أبي ذرّ الغفاري –رضي الله عنه-:
” عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الإنس شاهرا سيفه” فالفقر عواقبه وخيمة، وممّا يروى عن الإمام عليّ –كرّم الله وجهه- قوله:
“لو كان الفقر رجلا لقتلته”.
يجدر التّنويه هنا أنّ الميسورين كانوا يعتمدون في طعامهم على الحليب ومشتقّاته مثل: اللبن، الزّبدة، السّمن البلدي، والجبن، وخبز القمح، واعتمادهم على نظام الغذاء الواحد قد يكون سببا في سلامتهم الصّحّيّة وطول أعمارهم، حيث وصلت أعمار بعضهم إلى أكثر من تسعين سنة. لكنّ التّخلّف الاجتماعيّ، جعلهم بعيدين عن الحياة الحضريّة، فلم تكن هناك نظافة أو تعليم، أو رعاية صحّيّة وغيرها من مستلزمات الحياة.
صيد الحيوانات لأكل لحومها
الواوي والويوي
كان جدّي لأمّي يمتلك مصيدة “فخّا” يصطاد به بعض الحيوانات البرّيّة، وذات ليلة كنت نائما عندهم في حضن جدّتي، كنت في الصّفّ الثّاني الابتدائيّ عندما قبضت مصيدة جدّي ذلك الصّباح “ثعلبا” وفور رؤية جدّي للصّيد، استلّ “شبريّته” وقطع رأس “الواوي” وأتى به، وقال – كما كانوا يعتقدون في تلك السّنين- : “إن كانت على ذنبه شعرة بيضاء فهذا “وِيوِي” وأكله حلال! وإن لم توجد شعرة بيضاء فهذا واوي وأكله حرام”! وطلب منّي أن أبحث عن شعرة بيضاء على ذنب ذلك الحيوان التّعيس، فأشرت إلى شعرة وقلت: هذه شعرة بيضاء.
فسلخه وقطّعه، ورمى به لجدّتي التي تلّثمت قرفا من ذلك “الواوي”، لكنّها لا تملك حقّ الاعتراض لتغسله، أشعل نيران الموقد، وشوى الثّعلب على صاج الخبز، فأكله جدّي وأكلت معه.
وأكل الثّعالب في ذلك الوقت كان شائعا عند الجميع بشرط أن يكون “وِيوِي” وليس “واويا”!
الضّبع
هناك من كانوا يأكلون الجانب الأيمن من الضّبع أيضا، اعتقادا منهم بأنّه حلال، أمّا الجانب الأيسر فحرام!
عندما كنت تلميذا في المرحلة الاعداديّة، أرسلنا أبي صيفا أنا وأخي طه؛ لنوصل طحينا، سكّرا، شايا و”صندوق خيار” لراعي أغنامنا عند “بئر العازمي” في البرّيّة، فامتطينا البغل وسرنا لآداء المهمّة، وهناك وجدنا راعي أغنامنا، ومعه راعيان آخران يسلخان ضبعا اصطاده أحدهم برصاصة من بندقيّة انجليزيّة، كان حريصا أن تكون إصابة الضّبع في رأسه، لأنّه يريد الجلد سليما دون ثقوب؛ ليهديه لشيخ قبيلته؛ كي يضعه على سرج فرسه، طلب راعي أغنامنا أن يكون نصيبه من جانب الضّبع الأيمن أكثر من نصيب رفيقيه، لأنّه سيطعمني أنا وأخي معه. بينما سيكون الجانب الأيسر من نصيب الكلاب؛ لأنّه حرام! فقلت لهم بأنّه إذا كان الجانب الأيمن حلالا، فبالتّاكيد أنّ الجانب الأيسر حلال أيضا، أمسكت شبريّة أحدهم وقطعت خصلة الفخذ الأيسر وسط استنكارهم –خوفا من الحرام-! وجمعنا الحطب وشوينا لحم الضّبع، ويبدو أنّه كان هرما، وضعت قطعة واحدة في فمي، وبقيت أمضغها لعدّة دقائق، لكنّها لم تكن قابلة للمضغ فلفظتها. بينما أكل الرّعاة الجانب الأيمن، ورفض أخي طه أن يأكل منه.
النّيص
النّيص “حيوان مسالم له رأس سميك خال من الأشواك الى الأذن. الأنف منتفخ، المنخران مشقوقان قليلا، الأذنان صغيرتان، تنتشر على معظم جسمه أشواك والبطن يكسوها شعر كثيف، وهو حيوان ليليّ يعيش في جحور صخريّة أو رمليّة .
طوله حوالي 65 سم، الذّيل 11 سم، ارتفاع كتفه 24 سم، جسمه مغطى بأشواك عارية مقلّمة بالأبيض البنّيّ، وهي تشبه قصبات ريش الطيور بطول 20 الى 40 سم”.
في بداية فصل الشّتاء، وبدء موسم الحراثة لزراعة الحبوب، كان عمّي محمّد يشارك أبي في حراثة الأرض، وموسم الحراثة على البغال كان يستمرّ لشهرين أو أكثر، فأبي اعتاد أن يفلح أرضنا جميعها دون حساب للخصب أو المحل، فإذا تساقطت الأمطار وأخصب الموسم، نحصد وندرس ونخزّن الحبوب والأتبان، وإذا أمحلت يتركون الأغنام لترعى الزّرع الأخضر.
ذات يوم شتويّ دافئ، كانت الشّمس تسطع على استحياء، كنت طالبا في الثّانويّة، عندما كنت وشقيقي ابراهيم عند الحاجب الصّخريّ الصوّاني لجبل المنطار من الجهة الشّماليّة، وإذا بنيص يمرّ راكضا ويدخل في جحر تحت الحاجب الصّخريّ، ركضنا خلفه والتقطنا من باب جحره عددا من أشواكه التي تشبه الرّماح الصّغيرة، التي يزيد طول بعضها عن 20 سنتمتر، وهذه الأشواك يدافع بها عن نفسه إذا ما طورد، فيطلقها من جانبي جسده، لكنّه لا يستطيع أن يطلقها أمامه وخلفه حسبما علمنا من ذوي الخبرة والمعرفة بهذا الحيوان، الذي يحبّ التقاط جذور “البُصّيل”- البصل البرّي-.
مرّ بنا عمّي محمّد، فأخبرناه عن النّيص، وأكّدنا له أنّه موجود في الجحر، فأبعدنا من المكان كي يطمئنّ النّيص بعدم وجود أحد قد يشكّل خطرا عليه، في حين جلس العمّ فوق الجحر مباشرة بهدوء تامّ، ينتظر النّيص حتّى يخرج، ليصطاده، وبعد حوالي نصف ساعة، مدّ النّيص رأسه يلتفت يمينا ويسارا ليتأكدّ بعدم وجود من يهدّده، فضربه عمّي بعصا غليظة على أنفه، وهجم عليه؛ ليذبحه بشبريّته، فصرخ النّيص صراخا يشبه صراخ الأطفال، لكنّ ذلك لم يشفع له، تمعّنت بالنّيص الذّبيح، رأيت أذنيه اللتين تشبهان أذني الانسان، وكفوف قوائمه وأصابعه قريبة الشّبه بكفّي الانسان، تعاطفت مع ذلك الحيوان سيّء الحظّ، بل حزنت عليه، وأثناء سلخه لم أستطع مشاهدة المنظر، الذي تجسّد لي على شكل طفل، طبخوه وأكلوه ولم أشاركهم ذلك، بل أمضيت يومي دون شهيّة بي للطّعام.
القنفذ
القنفذ كما ورد في موسوعة وكيبيديا: “حيوان صغير من الثّدييات ينشط صيفا، وينام شتاء، يستيقظ في الرّبيع ويعتاش على أكل الحشرات، يأكل الدّيدان والزّواحف والفئران الصّغيرة وبيض الطّيور التي تعشّش في البراري، كما يأكل النّباتات والثّمار. يسمّى الشّوك الذي يعتري جلد القنفذ بالحسك.
يلد ويرضع صغاره وله رأس بدون رقبة ظاهرة وأذنان صغيرتان وفم مستطيل، وذو أرجل قصيرة، تغطي كلّ جسمه أشواك حادة، وعند شعوره بأيّ خطر يكوّر جسمه على شكل كرة شوكيّة تقيه شرّ أعدائه.
يستطيع معاركة الأفاعي وذلك بتكوّره ومحاولة التقاط ذنبها بفمه المختبئ، وكلّ حركة للحيّة تزيدها ألما وضررا. ينشط ليلا في الأيام المقمرة باحثا عمّا يقتات عليه.”
والقنفذ من الحيوانات التي تأكل العقارب والأفاعي.
ذات يوم ربيعيّ، كنت في نهاية المرحلة الابتدائيّة، فمررنا أنا وشقيقي ابراهيم وأخي محمود بخمسة قنافذ، في وادي قدّوم قرب راس العامود في القدس، كانت المنطقة تخلو من الأبنية في ذلك الوقت، حمل أخي محمود الذي يكبرني بعشر سنوات القنافذ في كيس اسمنت فارغ، وعاد بها إلى البيت في جبل المكبّر، كانت متكوّرة على نفسها وتبدو ككرة من الأشواك، سكب على كلّ واحد منها قليلا من الماء، وما أن يحسّ القنفذ بالماء حتّى يمدّ رأسه، فيلتقطه أخي محمود ويذبحه، سلخها محمود وقطّعها، وقلاها بالزّيت، علما أنّ عظامها مكسوّة بقليل من اللحم، أكلها محمود وابراهيم، بينما تقزّزت أنا منها ولم أذق طعمها.
هريسة دير مارسابا
كنت في التّاسعة من عمري، عندما قرّرنا أنا وثلّة من أقراني أن نقوم برحلة إلى البحر الميّت سيرا على الأقدام! بعد أن سمعنا من الكبار بأنّ المياه السّائبة في وادي النّار الذي يقسم قريتي “السّواحرة” إلى قسمين يصبّ في البحر الميّت، مشينا مع الوادي نتراكض بصبيانيّة شقيّة، مشينا بجانب الوادي الذي كانت تزرع على جانبيه أنواع مختلفة من الخضار، التي كانت تباع في أسواق المدن مثل القدس وعمّان وغيرها، وتنتهي زراعة الخضار عند جسر الشّارع الذي يصعد منه الشّارع الجبل شديد الانحدار الذي يصعد إلى بلدة العبيديّة، وذلك المنحدر يسمّيه العامّة “دَبّة الخنزيرة” لوعورته، ذلك الشّارع الذي يربط شمال الضّفّة الغربيّة مع جنوبها منذ العام 1993، عندما أغلق الاحتلال مدينة القدس أمام أبناء شعبها الفلسطينيّ، مع أنّ هذا الشّارع لا يصلح لسير المركبات –حسب المواصفات العالميّة للشّوارع- لشدّة انحداره، ولتخفيف خطورة سير المركبات فيه، فقد عمل متعرّجا كما الأفعى العظيمة الأسطوريّة.
مشينا بعد جسر “أمّ عِراق” عند نهاية منحدر “دبَّة الخنزيرة”حوالي كيلو متر، وفي إحدى المنعطفات مررنا ببيوت حجريّة قديمة تظهر على يسار الوادي، عرفت لاحقا أنّها تعود لعائلات من “العبيديّة”، كانت تعتاش على تربية المواشي، وهناك يزداد الجبلان المحيطان بالوادي انحدارا، وتقلّ أو تتلاشى الأراضي الزّراعية على ضفّتي الوادي، واصلنا طريقنا مع الوادي نغنّي ونصرخ ونتراكض بشقاوة طفولتنا التّعيسة، كان الوادي يتعرّج هو الأخر مع تعرّج الجبلين المحيطين به، وفي انحناءة الجبلين المحيطين بالوادي، وبعد البيوت التي مررنا بها، ظهر على يميننا مجموعة أبنية متلاصقة، يحيط بها سور عظيم، فدهشنا من جمال ذلك المكان، وقرّرنا تسلّق الجبل لاستطلاعه، بقينا نصعد على أدراج حتّى وجدنا بوّابة حديديّة عند أعلاه، وأمام تلك البوّابة وجدنا راهبا يتمشّى أمامها، كنّا في فصل الرّبيع، رآنا ذلك الرّاهب نلهث ويسيل العرق من أجسادنا، سألناه عن ماء للشّرب، فأشار لنا بأن نتبعه، فتبعناه عبر ممرّ واسع فيه درجات متباعدة، وعند أوّل غرفة على يميننا أجلسنا على مقاعد خشبيّة، أحضر لنا ماء في كوب معدنيّ، فشربنا حتّى ارتوينا.
سألنا الرّاهب بعربيّة ركيكة: من أين أنتم؟
فأجبناه: من السّواحرة.
وعاد يسألنا: هل أنتم جائعون؟
فأجبناه: نعم.
فأحضر لنا خبزا، زيتونا، مربّى وجبنا، فأكلنا حتّى شبعنا. وبعدها عاد وسألنا: هل أنتم مسيحيّون أم مسلمون؟
فأجبته كاذبا بأنّنا مسيحيّون.
عندها أحضر لكلّ منا صحنا فيه مادّة لزجة حتّى التّجمد غرفها من “زير” فخّاريّ مجاور مع ملعقة صغيرة، التهم كلّ منّا صحنه بشراهة على اعتبار أنّها “هريسة فرنجيّة”، ولمّا ابتعد الرّاهب قليلا لسبب لا نعرفه، سطونا على الزّير مرّة أخرى، وعبّأنا صحوننا والتهمنا “الهريسة” بشراهة، جلسنا في الدّير أقلّ من نصف ساعة، وخرجنا نترنّح دون أن نعرف سببا لذلك، كنّا نضحك بشكل متواصل، جلسنا على تلّة فوق الدّير لحوالي نصف ساعة أخرى، وشعرنا بأنّنا لن نقوى على الوصول إلى البحر الميّت، فعدنا أدراجنا إلى بيوتنا ضاحكين متكاسلين، فظنّتني أمّي مريضا، لجأت إلى الفراش، نمت أكثر من عشرين ساعة، وتبيّن لنا من خلال الكبار أنّ “الهريسة” التي تناولناها في الليل ما هي إلا مجرّد نبيذ معتّق! ويبدو أنّ الرّاهب الذي لم يكن يتكلّم العربيّة بطريقة جيّدة قد ظنّ أنّنا مسيحيون من مدينة بيت ساحور، وهذا ما فسّرناه بعد أن كبرنا.
إخوتي المسيحيّون:
في طفولتي المبكّرة عمل شرطيّ أردنيّ من قرية “الحصن” قضاء اربد في شمال الأردنّ، شرطيّا في مخفر شرطة بلدتي، الواقع على قمّة جبل المكبر، وهدم المحتلون بنايته التي يملكها المرحوم الشّيخ حسين ابراهيم شقير مختار عشيرة الشقيرات بعد حرب حزيران 1967، كان اسم ذلك الشّرطيّ موسى ابراهيم، وله ثلاثة أبناء هم: طعمة، وليام وغسّان، استأجروا بيتا في بلدتنا من غرفة واحدة تحتها مغارة، كان ملكا للمرحومة حمدة أبو موسى من حامولة الخلايلة، كنت وطعمة في صفّ واحد، كنّا نلعب سويّة، نأكل ونشرب على مائدة واحدة سواء في بيتنا أو في بيتهم، وأحيانا كنّا ننام بجانب بعضنا البعض، كنت أخاطب أبا طعمة بعمّي، وأمّ طعمة بخالتي، وهكذا كان أبناؤه يخاطبون المرحومين أمّي وأبي، عندما كنا نتشاجر كأطفال ونحن نلعب “الاكس” أو “البنانير، أو السبع صرارات،” كان الكبار -وغالبا ما كنّ أمهاتنا- يقولون لنا:”العبوا خيوه خيوه” أي كالأخوة.
في عيدي الفطر والأضحى، كان أبي يدعو أسرة أبي طعمة على منسف، وفي أعياد الفصح المسيحيّة، كانت أمّ طعمة توزّع علينا البيض المسلوق الملوّن، وفي أعياد الميلاد المجيدة ورأس السّنة الميلاديّة كانت توزّع علينا الألعاب والحلوى. كنّا نعايدهم ويعايدوننا، حتّى حسبت وأنا طفل أنّ الأعياد المسيحيّة أعياد اسلاميّة، والعكس صحيح أيضا في مشاعرهم.
لم نشعر يوما ما بأنّ هناك فروقا في أيّ شيء بيننا وبينهم. تلك الأسرة الكريمة هي أوّل من عرفت من إخوتنا المسيحيّين، وعندما شببت تعرّفت على إخوة مسيحيّين آخرين وصرنا أصدقاء متحابّين، لم يخطر ببالي، أو ببالهم أنّ هناك فروقا بين المسلمين والمسيحيّين. فرّقتنا وأسرة أبو طعمة حرب حزيران 1967، ولم نلتق منذ ذلك التّاريخ، وعلمت من بعض الزّملاء أنّ طعمة ووليام قد تعلّما الطّبّ ويعملان في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
إلى البحر الميت مشيا على الأقدام:
في الصّيف الذي أنهينا فيه الصّفّ الرّابع الابتدائي، ذهبنا مع مجموعة من الكبار من “البقيعة” القريبة باتّجاه الجنوب من مقام النّبي موسى بين القدس وأريحا، لغسل الغنم عند رأس نبع الفشخة على شاطئ البحر الميّت، قبل جزّ صوفها، قطعنا سهل البقيعة الذي يمتدّ لعدّة كيلومترات باتّجاه الجنوب والغرب، عند نهاية السّهول طريق للمشاة يتّسع لشخص واحد فقط، يمتدّ متعرّجا من قمّة السّلسة الجبليّة الصّخريّة شديدة الانحدار والوعورة التي تحيط بالبحر من جهته الشّماليّة، ومن يسهو قليلا في تلك الطّريق سيسقط لا محالة، وسيكون مصيره الموت، مشينا أمام الأغنام التي أدركت بالفطرة خطورة الطّريق الوعرة الضّيّقة، فلم تتزاحم ولم تتدافع، مشت واحدة بعد أخرى، وصلنا شاطئ البحر، ولا زالت الأغنام تنزل الطّريق بانتظام لافت، فشكّلت لوحة فنّيّة لو رآها فنّان تشكيليّ لانفرد برسم لوحة يصعب على غيره تخيّلها.
لم تكن عين الفشخة وقتئذ تجد من يعتني بها، فهي مجرّد نبع مياه صافية تخرج من باطن الأرض على بعد عشرات الأمتار من شفاه البحيرة مالحة المياه، والتي تعتبر المنطقة الأكثر انخفاضا في الكرة الأرضيّة عن سطح البحر، لم يكن هذا الجفاف قد لحق بالبحر الميّت يومذاك، فمياه نهر الأردنّ العذبة التي تغذّيه لم تسرق في تلك الأيّام، كانت مياه البحر تصل إلى رصيف الشّارع الذي يمتدّ على طول شاطئه الشّمالي، وعين الفشخة كانت مجرّد نبع أمامه بركة صغيرة يحيط بها “البوص” الذي يسترها عن عيون المارّة، فتسدل ضفائرها وكأنّ بها حياء العذارى، تنساب مياهها بسيل بسيط تخفره نباتات البوص، حتّى تستحمّ في مياه البحر المالحة التي تلتهمها بهدوء.
غسل الكبار الأغنام لإزالة ما علق بصوفها من أتربة وغبار تمهيدا لجزّه، بينما كنّا نحن الأطفال نلهو، نستحمّ تارة في مياه العين العذبة، وتارة في مياه البحر شديدة الملوحة. لكنّنا استفدنا شيئا آخر غير الاستحمام من خلال تلك “الرّحلة”، فقد تعرّفنا على طريق البحر الميّت، وكيفيّة الوصول إليه مشيا على الأقدام، مختصرين طريق المواصلات الطّويلة، وهذا ما حصل، حيث عدنا إليه كمجموعات من الأطفال أكثر من مرّة، كنّا نخرج من بيوتنا في ساعات الصّباح بعدد لا يقلّ عن عشرة أشخاص، نواصل طريقنا المراثونيّ ركضا حتّى نصل البحر، حيث نستحّم ونلهو، في فصل الرّبيع كنّا نتوقّف في البراري لأكل بعض الأعشاب البرّيّة مثل “الذّبّيح، الحويرّة،المرو، الحمّيض، قرون الغزال، الكعفران وغيرها” وأحيانا كنّا نعود في فصل الرّبيع بالخبّيزة، ونعود طريقنا بتكاسل حتّى نصل بيوتنا عند المساء.
ذات رحلة مدرسيّة في العام التّالي، لم يتوفّر لنا عشرة قروش أجرة للباصات التي ستقلّ طلاب المدرسة إلى البحر الميّت، فاتّفقنا على القيام برحلتنا سيرا على الأقدام، كنّا أكثر من عشرين ولدا، استيقظنا مبكرين، ركضنا حتّى وصلنا البحر الميّت قبل وصول باصات الرّحلة المدرسيّة، التي مرّت بمدينة أريحا، تفاجأ بنا معلّمو المدرسة وطلابها عندما التقينا بهم، ولمّا شرحنا لهم عن كيفيّة وصولنا، قال لي معلّم اللغة العربيّة عبد الحميد المصري من حلحول:
أنت طالب مجتهد، ستعود معنا في أحد الباصات، بشرط أن تبقى واقفا لعدم وجود كراسي فارغة، وإذا ما أوقفنا شرطيّ سير عليك الاختباء عند الباب الخلفيّ للباص، لأنّ الشرطة لا تسمح بوجود راكب إضافيّ في الباصات، فوافقت فرحا، غمرتي السّعادة، وأكبرت بمعلّمي هذا الموقف النّبيل.
الإضاءة السّاطعة
من محاسن التّعليم في تلك السّنين، أنّ معلّم اللغة العربيّة كان يطلب من التّلاميذ في المرحلة الابتدائيّة أن ينسخوا درس المطالعة مرّة، ومن يخطئ في حصّة الاملاء عليه أن ينسخ الدّرس مرّة أخرى، وهذا النّسخ ساعدنا على تعلّم الكتابة الصّحيحة دون أخطاء املائيّة في سنّ مبكرة.
في بيتنا الصّغير لم تكن طاولات ولا كراسٍ، ولم تكن كهرباء، كلّ غرفة كانت تضاء بلامبة كاز، عندما ننسخ دروسنا ليلا ونحن في صفوف مختلفة، كنّا نقلب تنكة ونضع لامبة الكاز عليها، نتحلّق حول التّنكة، ننبطح على بطوننا متّكئين على الكوعين، كلّ منّا يضع دفتره وكتابه أمامه، وغالبا ما كنّا نرفع ساقينا من تحت الرّكبة، لتلعب في الهواء أثناء عمليّة النّسخ، كان أخونا أحمد المولود عام 1945، والذي يكبرني بأربع سنوات، يأتي “بطبق ورق أبيض، يثقبه من وسطه بشكل دائريّ، ويغطي به زجاجة لامبة الكاز حفاظا على أبصارنا، خوفا من أن تختطفها الإضاءة السّاطعة! -كما شرح لهم المعلم- لكنّ النّتائج جاءت معكوسة، حيث تضرّرت عيوننا من العتمة والظّلام وليس من الإضاءة. وأخي أحمد درس الصّيدلة في جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكيّة، وهو الآن رجل أعمال ناجح في نيويورك.
قَصَّةُ الرّعاة
لم تكن عطلة الصّيف المدرسيّة أيّام راحة للأطفال من أبناء جيلنا، فقد كنّا نشارك بالحصاد خصوصا حصاد “العدس والكرسنّة” كما كنّا أيّام العطلة الأسبوعيّة نشارك مع الأمّهات باقتلاع الأعشاب الضّارّة من حقول الحبوب، كنّا نشارك أيضا بموسم دراسة الحبوب على الدّواب، ولأنّنا نتعرّض لشمس الصّيف اللاهبة في فصل الصّيف، فقد كانوا يحلقون شعور رؤوسنا من محيط الرّأس، ويتركون الشّعور تنمو على أمّ الرّأس، كانوا يسمّون قصّة الشّعر هذه “طوف” لأنّها تطوف حول الرّأس، وإذا ما دخل واحد منّا أماكن حضريّة لا يفلح مواطنوها الأرض، ولا يقتنون الأغنام، كانوا ينتبهون لقصّة شعر رأسه، فيقولون ساخرين منّا بصوت مسموع “قَصّة رعيان”.
عندما حشدت أمريكا وحلفاؤها جيوشهم في الصّحراء العربيّة عام 1990، ورأوا قصّة شعور أبناء البادية، وفهموا أنّها تحميهم من ضربات الشّمس اللاهبة، قلّدتهم الجيوش الغازية، ومنها “المارينز” الأمريكي في تلك القَصَّة، فأصبح موضة في أمريكا وأوروبا وأسموها “قَصَّة المارينز”، ثمّ قلّدها شعوب العربان على اعتبار أنّها موضة أمريكيّة!
واللافت أنّ أبناء البادية الفلسطينيّة قد تخلّوا عن هذه القَصَّة “الموديرن”؛ لأنّ “الدّيموقراطيّة” الاسرائيليّة نهبت أرضهم للاستيطان، أو أغلقتها لاستعمالات الجيش، كما حصل مع أراضي براري السّواحرة.
الفتّاحة مرّة أخرى
صيف العام 1957 أنهى ابن عمّي موسى محمد- رحمهما الله- الثّانويّة العامة “المترك”، فزوّجه أبوه “زواج بدل”، وابن عمّي هذا كان متديّنا منذ طفولته، لكنّه لم يستطع معاشرة العروس، فأحضروا “فتّاحة” لحلّ مشكلته، تردّدت على بيت عمّي عشرات المرّات، وكانت نساء العائلة والحارة يتجمّعن حولها، فتعمل لهنّ التّمائم” و”الحُجُب”، وتوصيهنّ بأن يخطن عليها قماشا سميكا، وأن يعلّقنها في رقابهنّ، بعد أن تطويها على شكل مثلث، وتقبض ما تيسّر لها، وتتنازل عن بعض ما تطلبه إذا ما تأكّدت أن إحداهنّ لا تملك غير ما في جيبها من قروش! واستمرّت بضعة أشهر تتردّد فيها على بيت عمّي بشكل شبه يوميّ، حتّى عرفت أسماء كلّ النّساء، والرجال وحتّى الأطفال، وقد وجدت في ذلك بيئة مناسبة للكسب.
في النّهاية قرّرت “الفتّاحة” أنّ هناك سحرا للعروسين! وهذا يتطلّب عمل “مندل” لاستحضار أتباعها من الجنّ؛ كي يُحضروا السّحر، وعلى العريس ووالده أن يدفعا لها خمسة دنانير مقابل ذلك، فاستدانها عمّي ودفعها لها. عند تحضير “المندل” أحضروا لها صاج الخبز مقلوبا ومليئا بالجمر –حسب طلبها-، حيث كانت في الغرفة اليتيمة التي يملكها عمّي، وهي غرفة قديمة من عَقْد الصّليب، وبدأت ترشّ البخّور على الجمر حتّى امتلأت الغرفة دخانا، أغلقت نوافذ الغرفة الأربعة، وطلبت أن يخرج جميع من فيها حفاظا عليهم من الجنّ! وأمرت أن يبقى معها امرأة واحدة، وطفل ذكر لم يصل سنّ البلوغ، وأن يحضروا صحنين، وضعت في أحدهما بيضة طازجة، والثّاني وضعت فيه قليلا من الماء، واختارت المرأة، كما اختارتني أنا؛ لأنّني كنت أجلس بجانب أمّي صامتا بشكل دائم، ويبدو أنّها “استهبلتني”.
بعد أن خرج من في الغرفة جميعهم، باستثنائي أنا والمرأة التي اختارتها، أغلقت الفتّاحة باب الغرفة من الدّاخل، لم يكن في الغرفة شيء آخر سوى بطّانيّة واحدة، ثمّ أمسكت يد المرأة وقادتها حتّى وضعتها في زاوية من الغرفة ووجهها إلى الحائط، أوصتها بأن لا تلتفت إلى أيّ اتّجاه محذّرة إيّاها بأنّ الجنّ سيضربونها إن التفتت! فبدأت المرأة ترتجف وتقرأ ما تختزن ذاكرتها من تعاويذ، طلبت منّي أن أجلس في زاوية أخرى ووجهي إلى الحائط فرفضت، ولمّا يئست منّي وضعت البطّانيّة على جسدها بدءا من رأسها، كما العباءة، وهي تمسك بطرفيها بيديها الممدودتين على طولهما، وأخذت تدور حول الصّاج، وهي تصدر كلمات لا معنى لها، تحرّك عضلات وجهها وعينيها بطريقة مخيفة لترعبني، كانت تدفعني لأبتعد، لكنّني بقيت أدور معها وأنا منتبه ببراءة الطّفولة وعفويّتها لكلّ حركة من حركاتها، ولمّا يئست منّي، جلست القرفصاء وهي تتدثّر بالبطانيّة، أخرجت من جيبها بيضة، كسرتها في الصّحن، وأخرجت ورقة من جيبها، غمستها بالماء وبمحاح البيضة، ثمّ نظّفت الصّحن من بقايا البيضة بمحرمة من قماش، وضعتها في جيبها الدّاخليّ عند صدرها، بعد ذلك فتحت الباب والشّبابيك، وهي تهلّل وتكبّر بأنّ الجنّ قد أخرجوا السّحر من البيضة التي في الصّحن دون أن تنكسر، وشرحت أنّ السّحر كان مخبّأ في فكّ إنسان كافر ميّت ومدفون. ففرحوا بذلك، وأثنوا على قدراتها الخارقة، دون أن يلتفتوا لي وأنا أروي لهم ما شاهدته! لم يكن العريس موجودا في تلك السّاعة، فأحضروا جارنا محمّد حسين جوهر، ليقرأ السّحر! وقبل أن يفتح الورقة قال لهم ضاحكا:
لا تصدّقوا هذه الأكاذيب.
وممّا كان مكتوبا في تلك الورقة: اسم العريس بجانب رسم لوجه رجل، ويقابله اسم العروس وبجانبه رسم لوجه امرأة، ومكتوب في السّطر الذي يلي” بجاه هالفكّ ما ينفكّ”. استمع محمّد جوهر لما قلت عمّا شاهدته، وقال لهم: انتبهوا لما يقوله جميل، لكنّ أحدا لم يأخذ بروايتي، ولا برأي الأستاذ جوهر.
ولمّا بقيت مصرّا على قول ما رأيت، التفتت الفتّاحة لوالدتي وقالت لها:
” ابنك ولد كافر والعياذ بالله، سكّتيه وإلأ سيضربه الجنّ الكافر، وسيعيش بقيّة حياته مجنونا إن لم يقتلوه.”
حملتي أمّي وعادت بي إلى بيتنا القريب من المكان وهي ترتعد خوفا.
المهمّ أنّ مشكلة العريس لم تحلّ، وتطلّقت العروس، وتطلّقت شقيقة العريس التي كانت متزوّجة زواج بدل من شقيق العروس.
بعد ذلك ببضعة سنوات تزوّج ابن عمّي وأنجب ثمانية أبناء.
الشّيخة بنت شيخ العرب
كنت في حوالي السّابعة من العمر، عندما جاء رجل طويل القامة يرتدي القمبازوالعباءة، تحتهما سروال تقليديّ طويل، يضع كوفيّة وعقالا على رأسه، شعره الأشيب يصل إلى رقبته، على وجهه وشفته العليا شعرات متناثرة، في حزامه شبريّة وفي يده عصا، كانت مضاربنا عند البيادر في “المخبيّة”، رحّب به أبي قائلا:
أهلا بالشّيخ “أبو فلان”.
استعار منّا المقصّ الذي يجزّون به أصواف الأغنام بداية كلّ صيف، احتسى القهوة وانصرف شاكرا.
بدا لي صوت الشّيخ ناعما كما أصوات النّساء، سألت والدي عن أسباب ذلك، وعن عدم انتظام شارب ذلك “الشّيخ”، لكنّه لم يجبني.
بعد ذلك بحوالي أسبوع، طلب والدي منّي أن أذهب إلى بيت ذلك الشّيخ لاسترداد المقصّ، أشار إلى ثلاثة بيوت شَعَرٍ في “ثغرة رهوة” وقال:
البيت الأوسط هو بيت الشّيخ.
ذهبت إلى البيت المقصود، وعلى بعد أمتار منه ناديت:
يا شيخ “أبو فلان”.
فجاءني الصّوت: أهلا بك يا ولدي، دونك الشِّقّ “المضافة” وهي المكان المخصّص للضّيوف وللسّهر.
كان “الشّيخ” يستحمّ “بطشت” معدنيّ في “الصّهوة” –المكان المخصّص للنّساء وللمبيت- فنظرت إليه بعفويّة وبراءة الأطفال من فتحة صغيرة عند المدخل، وهالني أنّ للشّيخ ثديين يتدلّيان على صدره، أوجست خيفة من ذلك، لكنّ الشّيخ طمأنني عندما قال:
انتظرني قليلا يا ولدي، فانتظرته في المضافة، بعد دقائق قليلة انتهى الشّيخ من الاستحمام، خرج إليّ بكامل ملابسه الرّجّاليّة، في يده صينيّة شاي عليها كأسان، قدّم لي كأسا ووضع الثّانية أمامه، عندما احتسيت كأسي، أعطاني الشّيخ المقصّ، وانصرفت، عندما وصلت أبي قلت له:
الشّيخ أبو فلان امرأة وليس رجلا!
سألني الوالد: كيف عرفت؟
فسردت له ما رأيت من جسم الشّيخ الذي كان يستحمّ.
ضحك الوالد قهقهة وهو يقول لي:
لا تتكلّم بهذا الكلام، لأنّ الشّيخ يغضب ممّن يقولونه!
عدت إلى البيت ورويت لأمّي ما رأيته من الشّيخ، فضحكت هي الأخرى وهي تضمّني إلى صدرها وتقبّلني، حكت لي قصّة الشّيخ، وهي أنّه امرأة فعلا، كان أبوها شيخ قبيلة، توفّي ولم ينجب غيرها، فقرّرت أن لا تغلق “مضافته” التي كان يستقبل فيها الضّيوف والمتخاصمين، ولأنّ الأعراف القبليّة لا تسمح للنّساء بحلّ الخصومات، فقد قرّرت بنت الشّيخ وبتشجيع من والدتها أن تعزف عن الزّواج وأن ترتدي ملابس الرّجال! وأن تعتبر نفسها رجلا يسدّ الفراغ الذي تركه والدها، مرّت السّنون، وتوفّيت والدتها، وبقيت وحيدة في البيت. وقطيع أغنامها يرعاه رجل من أقاربها يسكن هو وأسرته في بيت مجاور لها.
التّيس الشّاطر!
عندما وصلت الصّفّ الرّابع، طلب منّا معلّم العربيّة أن نكتب موضوع إنشاء عن “طاعة الوالدين”، واستلم دفاتر الانشاء منّا، وبعد يومين كان الجّوّ ماطرا، والمعلّم مناوب في ساحة المدرسة، مررت بجانبه فأمسك بي وسألني بلهجة غاضبة:
من كتب لك موضوع الانشاء أمّك أم أبوك؟
فأجبته ببراءة الطّفولة: والله أنا يا أستاذ.
انهال عليّ ضربا وهو يقول:
غشّاش وتقسم بالله كاذبا!
– يبدو أنّني في ذلك العمر لم أكن أعرف أنّ أبي وأمّي كانا أمّيّين، خصوصا وأنّ كلّ واحد منهما كان يطلب منّي أن أحضر كتابي وأن أقرأ درسي أمامه؛ ليعرف أنّني فاهم لدرسي أم لا!- اقترب منّا معلّم التّربية الدينيّة وأمسك زميله وهو يسأله:
هذا طالب مؤدّب ومجتهد لماذا تضربه؟
فأجابه إنّه غشاش كتب أحدهم له موضوع الانشاء، ويقسم كاذبا بأنّه هو من كتبه.
فقال له مدرّس التربية الاسلاميّة:
خذه معك إلى غرفة المعلّمين واطلب منه أن يكتب موضوعا أمامك، وستتأكّد أنّه قادر على الكتابة.
اصطحبني المعلّم إلى غرفة المعلّمين، أعطاني ورقة وقلما، وقال لي غاضبا:
أكتب ما تشاء.
وقفت بجانب الشّبّاك، وضعت الورقة على عتبة النّافذة وكتبت، كانت الأمطار تتساقط بنعومة، رذاذها ينساب على زجاج النّافذة أمامي، وصفت المنظر الجميل، وبعض الطّلبة الذين كانوا يتراكضون في السّاحة، وكيف يحاول بعضهم الاحتماء بجدار الغرفة الخارجيّ، وضعت عنوانا للموضوع “يوم ماطر” كتبت صفحتين سطرا بعد سطر، أعطيت الورقة للمعلّم، قرأها ويبدو أنّه أعجب بما كتبت، فكافأني بكفّ على رقبتي وهو يقول:
” هذا كاين شاطر يا تيس”! انصرف وعد إلى صفّك.
ورغم ذلك انصرفت سعيدا؛ لأنّني شعرت بأنّ ذلك المعلّم قد صدّقني، وأنّه أعجب بما كتبت.
في ذلك العام وأنا في الصّفّ الرّابع الابتدائيّ، كنت أدّخر مصروفي اليوميّ الذي لم يتجاوز نصف قرش”تعريفة” وعند نهاية الأسبوع –يوم الجمعة-أذهب إلى القدس مشيا على الأقدام، وأدخلها من باب المغاربة مارّا بقرية سلوان، أواصل طريقي إلى سوق باب خان الزّيت حيث مكتبة الأندلس، وأعطي صاحبها مدّخراتي التي لا تتجاوز ثلاثة قروش، طالبا أن يبيعني كتابا، أحمل كتابي وأعود سعيدا إلى البيت لأطالعه، وأضعه في صندوق خشبيّ كان يستعمل لبيع الخضار، ومركون في زاوية من زوايا المخزن، الذي كان ثلثا مساحته معبّأ بشوالات القمح والشّعير والعدس ممّا تنتجه أرضنا. أذكر أنّ أوّل كتاب اشتريته هو قصّة “احمد المدلّل”، مع التّأكيد أنّ صاحب المكتبة هو من اختاره لي. وقد عرفت الرّجل لاحقا، واسمه فوزي يوسف، فتذكّرني وقال لي بأنّه كان يعطيني كتابا حسب عمري بما تيسّر لي من قروش بغضّ النّظر عن سعر الكتاب، لأنّه شعر بشغفي بالمطالعة، وأراد تشجيعي، فشكرت له ذلك.
راعي الخراف
أمحلت البلاد في العام 1958، فلم تتساقط أمطار تكفي للزّراعة وملء الآبار بالمياه، ممّا اضطر أصحاب المواشي للرّحيل بها إلى أماكن تتوافر فيها مياه الشّرب والمراعي، وفي صيف ذلك العام انتقل قطيع أغنامنا إلى منطقة “فصايل” في الأغوار، في حين ترك الوالد عندنا في جبل المكبّر حوالي ثلاثين خروفا في عمر الفطام ولدت صيفا، وعندما لحق الوالد بالرّاعي حاملا له المؤونة، أخذ الرّاعي إجازة لمدّة 48 ساعة، لكنّه لم يعد، ممّا اضطر الوالد للبقاء مع الأغنام شهرا كاملا حتّى وجد راعيا آخر، وفي غياب الوالد كنّا نعلف الخراف ونضعها ليلا في مخزن ونغلق الباب والنّوافذ عليها، وهذا جهل مطبق في التّعامل مع الغنم البياض، فهي لا تطيق العيش في أماكن مغلقة، وتبقى أثناء فصل الشّتاء البارد في الهواء الطّلق دون أن تتأثّر، فصوفها يحميها من المطر ومن البرد، وفي هذه الفترة هزلت الخراف بشكل لافت، شارفت على النّفوق، وعندما رآها الوالد في هذه الحالة قرّر ترحيلها إلى أرضنا في “حبلة المكانس” في الشّيخ سعد الامتداد الجنوبيّ لجبل المكبّر، وهناك بنوا بيتا من الخيش لتستظلّ به الخراف وقت الظّهيرة، بنوا البيت قرب كهوف كان يسكنها المرحوم محمد سلامة زحايكة وأبناؤه، كنت أنا راعي هذه الخراف، أسقيها من بئر العمّ جميل خليل السلحوت، وأرعاها نهارا، وأنام معها ليلا، أنام ليلي الطّويل خائفا، أخاف الأفاعي والحيوانات المفترسة، فالمنطقة خالية من الأبنية، وشبه خالية من السّكّان، أنتظر شروق الشّمس بلهفة، كانوا يرسلون لي الطّعام يوميّا مع أخويّ طه وابراهيم، اللذين كانا يطلّان عليّ من مسافة تبعد عنّي مالا يقلّ عن مائتي متر، يضعان لي الطّعام ويهربان كي لا أتركهما مع الخراف، وذات يوم أتتني المرحومة زوجة يوسف سلامة تحمل لي صحن بطّيخ، كنت مستلقيا في “خربوش الخيش” لمّا أطلّت عليّ طلبت منّي أن أقف وأصل إليها بسرعة فائقة، وعندما وصلتها لفتت انتباهي إلى أفعى سوداء يزيد طولها عن المتر، تقف على بعد أقلّ من مترين عن رأسي، ضربتْ المرأة حجارة على الأفعى التي هربت واختبأت تحت حجارة في الوادي بجانب”الخربوش”، فجاء حماها وقتل تلك الأفعى.
بقيت مع الخراف مدّة شهر كامل دون استحمام أو تغيير ملابس، ولم ينقذني من البقاء في ذلك المكان سوى افتتاح العام الدّراسيّ، فأعادوني أنا والخراف إلى بيتنا في جبل المكبّر، لكنّ الخراف لم تعد تنام في المخزن.
يوم كُسرت يدي اليسرى وسفر أخي محمّد إلى البرازيل
عندما أنهيت الصّفّ الخامس الابتدائيّ، انحبست أمطار السّماء في ذلك العام، جفّت الآبار من قلّة المياه، كانوا يرسلوننا نحن الأطفال لجلب المياه من بئر أيّوب في قرية سلوان المجاورة، يضعون لي ولأخويّ طه وابراهيم أربع جالونات معدنيّة –سعة الواحد منها عشرون لترا- على بغل، ومثلها على حمار، لنعبّئها ماء من بئر أيوب في سلوان، نمتطي الدّابّتين، ونسير ومعنا علبة لنملأ الجالونات وهي على ظهر الدّواب، لأنّنا لا نقوى على تحميلها ثانية لو أنزلناها عند تعبئتها، نصطفّ على الدّور لكثرة من يردون بئر أيّوب لملء آنيتهم، ولكسب الوقت كان بعض النّساء والرّجال ممّن يردون البئر الذي كان مزوّدا “بماتور” لسحب المياه، وعلى جانب من البناء القائم على البئر هناك عدد من صنابير الماء، يشفقون علينا فيُنزلون ” جالوناتنا” يعبّؤونها، ويعيدون تحميلها لنا.
وفي 7-8- 1960 امتطيت البغل بدون “حِلس” وذهبت لأسقيه من بير أيّوب، بعد أن أردفت ابن عمّي صالح خلفي، وعلى بعد عدّة مئات من الأمتار وبينما كنت “أرْبِع” على البغل، سقط ابن عمّي من خلفي وهو ممسك بي، فجرّني معه، لأسقط على كوعيّ بين قائمتي البغل الذي وقف ولم يتحرّك، حتّى قمت ووقفت على قدميّ، رأيت يدي اليسرى وقد أصبحت زاوية قائمة يمتدّ منها عظم الكوع ويكاد يخترق الجلد، صرخت من شدّة الألم، ممّا أفزع صاحبة البيت المجاور المرحومة عليا بشارة هلسة، زوجة الشّيخ علي حجازي، التي خرجت تستطلع الأمر، فأمسكت بيدي وقامت بإعادة العظم مكانه وهي تردّد:
“خلينا نصححها والضربة سخنه”
وفي الواقع قامت بتصحيحها قدر استطاعتها، وضعتها في منديل وعلّقتها برقبتي، عدت إلى البيت باكيا من الألم، وهناك استقبلوني بالبهدلات والشّتائم، فاختبأت تحت سرير كانوا يضعون عليه الفرشات واللّحُف والبسط الصّوفيّة.
حضر الأقارب والأصدقاء لتوديع أخي محمّد الذي سيسافر في اليوم التّالي إلى البرازيل تاركا خلفه زوجته وطفله كمال ابن الثّالثة من عمره، كنت منزويا تحت سرير معدني، تعلوه الفرشات والبسط الصّوفية، ويدي المكسورة ممدودة بجانبي، لا أستطيع تحريكها… أبكي بصمت مرغما، أبكي من الألم، وخوفا من الوالد الذي غضب غضبا شديدا، عندما رأى يدي، لم يتعاطف معي أحد، أو بالأحرى لم أسمع كلمة عطف، كلّ ما سمعته هو(لا ردّه الله…ولد غضيب) والنّساء المودّعات يملأن الغرفة، في حين يجلس المودّعون الرّجال على البرندة المكشوفة، ودّعني أخي محمّد بأن قبّلني بهدوء، بكى وبكى معه جميع الحضور وبكيت أنا أيضا….فهذا أوّل المسافرين إلى بلاد الغربة من أبناء العائلة، السّفر إلى بلاد أخرى في تلك السّنين كان غريبا ومستهجنا في البلدة بشكل عامّ، بضعة أشخاص فقط سافروا للدّراسة في جامعات بعض الدّول العربيّة، أمّا السّفر إلى بلاد أجنبيّة فهذا أمر غريب ومستهجن، والسّفر بالطّائرة كان يثير الرّعب في قلوب أناس كانت الدّواب هي وسيلة النّقل الوحيدة التي يستعملونها، أمّا السّفر في السّفن فهو أمر مرعب حقا، كان كبار السّنّ يجتمعون ويتحدّثون في الموضوع، ومنهم المرحوم عمّي محمّد الذي كان يملك خيالا خصبا وقدرة عجيبة على حفظ ما يسمعه، كان يحفظ السّيرة الهلاليّة، سيرة عنترة، والزير سالم عن ظاهر قلب بعدما سمعها في شبابه من حكواتيّ في مقهى زعترة في باب العمود في القدس القديمة، يحكيها لنا بطريقة تمثيليّة…صوته هادئ ناعم ذو إيحاء في المواقف العاديّة والمفرحة، يعلو ويصخب في الانتصارات، يحزن ويبكي في المواقف الصّعبة، كان معجبا بشخصيّة أبي زيد الهلاليّ والزناتي خليفة، وبشخصيتي عنترة والزّير سالم.
تحدّث عمّي بما كان يسمعه عن حيتان ضخمة جدّا تعيش في البحار، وتستطيع ابتلاع السّفن! لكنّه طمأن الجميع بأنّ محمّدا سيصل إلى البرازيل سالما معافى، ولن تستطيع الحيتان ابتلاع السّفينة التي تقلّه، لأنّ السّفن في البحار محميّة بمناشير ضخمة مثبتّة في أسفلها، وما أن ينقضّ الحوت الضّخم عليها بقوّة هائلة ليبتلعها، حتّى تشقّه إلى نصفين! تأتي الأسماك الأخرى لتفترسه، وينزل بعض السّبّاحين من السّفينة؛ ليحملوا أجزاء منه طعاما للمسافرين على ظهر السّفينة، فنقطة ضعف هذا الحوت العملاق هي في قوّته الهائلة، ولو أنه كان يتقدم الى السّفن بهدوء لاستطاع ابتلاعها من مقدمتها أو مؤخّرتها، فيتغذّى على ما فيها من بشر ثم يلفظها كومة من حديد في قاع البحر؛ لأنّها اعتدت على مملكته البحريّة، ولما سألته قبل أن تكسر يدي بيوم عمّا ستفعله المناشير في بطنه بعد أن يبتلعها قال لي:
“أنت كثير غلبه يا ولدّ عند ما يبلعها تصطدم بأسنانه الحادّة فتتكسّر مثلما تقصف عود تين يابس، تتفتّت وتغرق في البحر”.
استمعنا الى القدرات العجيبة للحيتان ونحن نرتجف خوفا! ونحمد الله أنّنا نعيش على اليابسة بعيدا عن حياة البحار المرعبة، وعندما سأل أحدهم عمّن سيتغلب الضّبع أم الحوت اذا ما التقيا؟ أجاب العمّ محمّد:
“كِيف بدهم يلتقوا يا فصيح وهذا في البرّ وذاك في البحر؟” فضحك الجميع.
وأضاف العمّ بأنّه سمع من أحد معارفه من أبناء قرية بيت حنينا الذي سافر إلى أمريكا بالباخرة، أنّه شاهد في عرض البحر سمكا يقفز في الهواء ثم يعود إلى البحر، حجمه أكبر من حجم كبش الغنم! فسبّح الحضور بقدرة الخالق. وأضاف العمّ محمّد بأنّ البحر كبير جدّا، وحجمه يزيد على مساحة فلسطين كاملة!
أخي محمّد درس حتّى الصّف الخامس الابتدائيّ في كليّة النّهضة في حيّ البقعة الذي يشكل امتداد جبل المكبر الى الجهة الغربيّة، وقد وقع الحيّ تحت سيطرة اسرائيل عام 1948 عام النّكبة، وهو يعرف بضع كلمات انجليزيّة تعلّمها في المدرسة، كانت موضع فخر لأبي الذي يرى أنّ ابنه “معه لسان انجليزي” لكنّ التّساؤل كان حول اللغة التي يتكلّمها شعب البرازيل؟ وهل يوجد في العالم غير اللغتين العربيّة والانجليزيّة؟ فأكّد لهم عمّي محمّد أنّه توجد لغة أخرى للسّود! فقد كان السّنغاليون الذين يخدمون في جيش الانتداب البريطانيّ يتكلّمون لغة غير الانجليزي! فهلّل وكبّر الحضور لهذه المعلومة!
ما علينا، سافر الأخ محمّد إلى البرازيل، والرّسالة الأولى التي وصلت منه كانت بعد ثلاثة أشهر، وكانت مقدّمتها تبدأ بـ”سلام سليم أرقّ من النّسيم، تغدو وتروح من فؤاد مجروح، إلى منية القلب وعزيز الرّوح والدي العزيز حفظه الله” ويختتمها بـ” وإن جاز حسن سؤالكم عنّا فأنا بخير والحمد لله، ولا ينقصني سوى مشاهدتكم، والتّحدث إليكم، وسلامي إلى كلّ من يسأل عنّي بطرفكم”.
رسالته الأولى كانت أكثر من ثلاثين صفحة، شرح فيها بالتّفصيل المملّ منذ خروجة بسيارة تاكسي إلى بيروت حتّى وصوله إلى البرازيل على ظهر سفينة، وتحدّث أنّه يعمل بائع حقيبة متجوّل، وأنّ البرازيل بلد ثريّ وخصب، لكن عملة هذه البلاد رخيصة عند تحويلها إلى الدّولار.
الرّسالة قُرئت عشرات المرّات وسط دموع الشّوق والحزن على الفراق! وعمّي المرحوم موسى ألزمني بقراءتها له عشرات المرّات، بحيث أستطيع أن أزعم بأنّني لا أزال أحفظها عن ظاهر قلب حتّى أيّامنا هذه-بعد سبعة وخمسين عاما-، ويبدو أنّ عمّي موسى –رحمه الله- كان يريد معرفة الأحوال في البرازيل كي يرسل ابنه المرحوم اسماعيل إليها، وهذا ما حصل، فقد سافر اسماعيل إلى البرازيل في بداية كانون الثّاني-يناير 1961، تاركا خلفه زوجته وابنه محمّدا وابنته محمديّة طفلين أكبرهما في الرّابعة من عمره، وافتتح أخي محمّد وابن عمّي اسماعيل محليّ نوفوتيه بعد عامين من سفرهما.
عندما سافر أخي أحمد الى البرازيل في صيف 1965 بعد أن أنهى الثّانويّة العامّة، عمل مع الأخ محمّد الذي افتتح له محلا آخر، لم يرغب محمّد واسماعيل البقاء في البرازيل، وخطّطا للعودة إلى البلاد في صيف العام 1967، لكنّ حرب حزيران 1967 وما تمخّضت عنه من احتلال حال دون ذلك، عاد ابن العمّ اسماعيل في صيف العام 1970 ضمن نطاق ما يسمّى قانون جمع شمل العائلات، وبقي في البلدة الى أن توفّاه الله في ربيع العام 2008، أمّا الأخ محمّد فقد عاد في صيف العام 1972 على أمل السّفر إلى الولايات المتّحدة، وقد تحقّق له ذلك في أكتوبر 1977، حيث استقرّ في “بورتوريكو”؛ لأنّها ناطقة باللغة الاسبانيّة التي تعلّمها في البرازيل، ونجح هناك حيث يملك عدّة محلّات نوفوتيه، ولا يزال هناك هو وأبناؤه وأحفاده، أمّا الأخ أحمد فقد سافر عام 1969 من البرازيل إلى هيوستن في ولاية تكساس الأمريكيّة، بعد أن حصل له ابن العمّ محمد موسى شقيق اسماعيل على قبول في جامعة هيوستن، وابن العمّ محمد موسى اندلعت حرب حزيران 1967 وهو وأخي محمّد”أبو سمرا” يعملان مدرّسين في المملكة السّعوديّة منذ العام 1962، فسافر الى أمريكا ودرس هندسة الكهرباء في جامعة هيوستن، وتزوّج من أمريكية ولا يزال يعيش هناك، وهو رجل أعمال ناجح جدّا، في حين سافر أخي أخي “أبو سمرا” إلى بريطانيا ودرس إدارة الأعمال، أمّا أخي أحمد فقد درس الصّيدلة، وبعدها انتقل للتّجارة ونجح نجاحا باهرا فيها.
وفي اليوم التّالي لسفر أخي محمّد إلى البرازيل بدأ علاج يدي، حيث جاؤوا بجارتنا المرحومة صبحة العبد أرملة المرحوم حمدان سرور الملقب بـ “البلهيدي” والذي كان بيته مفتوحا لعبد القادر الحسيني ورفاقه من جماعة الجهاد المقدّس، كانت المرحومة امرأة فاضلة تقوم بتدليك يدي، وتتثاءب وتقول بأنّ يدي ستشفى إذا تثاءبتْ أثناء التّدليك! وبعد أكثر من ثلاثة أشهر زال الورم والألم من يدي، لكنّ رأس عظم الكوع بقي زائغا من مكانه، وبقيت يدي ضعيفة حتّى الآن، مع أنّني أستطيع تحريكها كيفما أشاء.
بائع الأسكيمو:
كان بعض الأطفال التّلاميذ من جيلي وممّن يكبرونني بعدّة سنوات يحملون “طبليّات” ويبيعون “الأسكيمو” في عطلة المدرسة الصّيفيّة، ذهبت مع بعض الأولاد لأعمل مثلهم، وصلنا المصدر وهو عبارة عن بقّالة صغيرة في حارة السّعديّة في القدس القديمة، تقع قريبا من مسجد المئذنة الحمراء، وتلك “البضاعة” كانت عبارة عن ثلج متجمّد مصبوغ بألوان متعدّدة تغري الأطفال، معمول على شكل قطع “البوظة” القائمة على عود خشبيّ، أخذت طبليّة تتّسع لخمس وعشرين قطعة، ثمن القطعة “تعريفة” أي نصف قرش أردنيّ، إذا بعتها ستكون أجرتي خمسة قروش، والباقي لصاحب المحلّ، حملت الطّبليّة وعدت بها إلى البيت مرورا بقرية سلوان، دون أن يشتري أحد منّي ولو قطعة واحدة، وعندما رآني الوالد –رحمه الله- وبّخني على ذلك، وزّع كلّ ما في الطّبليّة على الحضور من نساء وبنات وأولاد، وكانت القطعة الأولى من نصيبي، ثمّ أعطاني عشرين قرشا، طلب منّي أن أستقلّ الباص وأعيد “الطّبليّة” لصاحبها، حذّرني من مغبّة هكذا عمل أو أيّ عمل آخر في ذلك العمر، حملت الطّبليّة وعدت بها مشيا على الأقدام؛ لأوفّر قرشا أجرة الباص، سلّمتها لصاحبها والغريب أنّني عدت إلى البيت في الباص.
مترك السّادس الابتدائيّ
في زمننا وهو غير بعيد، كان التّعليم الالزاميّ حتّى المرحلة الابتدائيّة- السّادس الابتدائيّ- ومع ذلك لم يكن هناك ترفيع تلقائيّ، ورسوب الطّلاب في الصّفوف كان ملحوظا ومعروفا للقاصي وللدّاني، ونظرا لزيادة عدد الطّلاب، وعدم وجود مدارس لاستيعابهم، وضعوا امتحانا عامّا لنهاية كلّ مرحلة تعليميّة، فكان “مترك السّادس الابتدائيّ، ومترك الثّالث الاعداديّ” للخلاص من آلاف الطلبة الذين يرسبون في هذا الامتحان، وقد اجتزنا “مترك السّادس” للعام الدّراسيّ 1960-1961 في المدرسة العمريّة داخل أسوار القدس القديمة، في طريق الآلام قرب باب الأسباط، وهي ضمن الرّواق الشّماليّ للمسجد الأقصى، لم نكن نعرف تلك المدرسة، فاصطحبنا المدير إليها أيّام الامتحان.
عندما ظهرت نتائج الامتحان كان من مدرستنا طالبان من الأوائل، كنت واحدا منهما، وجرى احتفال في مدرسة المطران تحت اشراف ورعاية مديريّة التّربية والتعليم في القدس؛ لتكريم الطلبة المتفوّقين من المحافظة على مستوى المملكة، والعشرة الأوائل من المحافظة، وبحضور مدراء المدارس في المحافظة، وضعت الجهة المنظّمة على المنصّة التي يجلس عليها ثلاثة أشخاص منهم مدير مدرستنا المرحوم محمّد خليل حمادة، أمام كلّ واحد منهم زجاجة “كازوز” وخمس قطع بسكويت ملفوفة بنايلون شفّاف، أشفق المدير عليّ أنا وزميلي وأعطى كلّ واحد منّا قطعة بسكويت، كما جعلنا نرتشف ملء الفم من زجاجة “الكازوز”، وبعد الخطب الرّنّانة كانت جائزة كلّ واحد منّا طابة ملوّنّة ثمنها أقلّ من قرشين أردنيّين، وقلم حبر ناشف سعره مشابه لسعر الطّابة.
عيني مرّة أخرى
عدت إلى البيت في غاية السّعادة، على أمل أن أحظى بمكافأة أو كلمة ثناء من والديّ وأسرتي، لكنّني فوجئت بهم مجتمعين ويتحدّثون عنّي، لم أسمع كلمة ثناء، ولم ألمس شعورا بالفرح، بل تحدّث أبي بلهجة تطغى عليها عاطفة الحزن، فهو يشفق على حالي، وممّا قاله أنّه قد تحدّث مع إمام المسجد المجاور عن مصيري، فنصحه الإمام بأن يزوّجني من فتاة ناضجة؛ كي تساعدني على تكاليف الحياة، وأن يمنحني عددا من الأغنام، وأن يسجّل باسمي أرضا دون إخوتي، كي أعيش حياتي! فالتّعليم لن يفيدني شيئا؛ لأنّني بعين واحدة. كنت أجلس بائسا قريبا من والدتي وجدّتي لأمّي التي كانت في زيارتنا، والتي سمعتها تهمس لأمّي:” مسكين هالولد، خلّي ذهباتك له لوحده”!
انسالت دموعي على وجنتيّ، حزنا على حالي، قلبي يكاد ينزف دما، لأنّهم يتعاملون معي كإنسان ناقص ليس كبقيّة البشر، لم أستوعب ذلك، ولم أستطع الدّفاع عن نفسي. أمّي هي الأخرى كانت تبكي بصمت، تمسح دموعها كي لا أراها. وبعد ذلك وجّه أبي كلامه لي وقال:
اسمع يا ولد، سنزوّجك فلانة، وهي حاذقة وقويّة البنية، تجيد حلب الغنم، والعمل في الأرض، لن تستفيد شيئا من التّعليم، وإن شاء الله سيرزقك الله أبناء وستعلّمهم، فلا تضيّع عمرك سدى في المدارس.
وفلانة هذه قريبة لنا تكبرني بثماني سنوات، وقتئذ كنت لا أعرف ماذا يعني الزّواج، وربّما لم أكن قد وصلت سنّ البلوغ في حينه.
قلت بصوت مكسور ذليل: أريد أن أتعلّم.
وممّا أثار غيظي وزادني حزنا على أحزاني، أنّ أربعة من إخوتي الذين يكبرونني عمرا، كانوا في المدارس، ولم يكن أيّ منهم مجتهدا مثلي، فتساءلت عن سبب ذلك بصوت مسموع، وجاءني الرّدّ:
أنت لست مثلهم، فأنت أعور بعين واحدة!
يا إلهي كيف أصبحت عيني المفقودة عارا عليّ؟ ازددت بكاء واعتزلت مجلسهم، ذهبت إلى مخزن الحبوب حيث كنت أنام وحدي، وأبكي حزنا على حالي دون أن يراني أحد.
علمت لاحقا أنّ أبي قرّر في غيابي: الولد جاهل، ويظهر أنّه لا يعرف معنى الزّواج، فبنيته نحيلة وضعيفة رغم طول قامته، دعونا نتركه في المدرسة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى حتّى يشتدّ عوده خلال هذه السّنوات، وعندها سنزوّجه.
العمل في حفريات الآثار
كانت دائرة الآثار البريطانيّة تقوم بحفريّات عن الآثار في سلوان وأريحا منذ عشرينات القرن العشرين، وفي قرية سلوان التي لا يفصلها عن سور القدس من الجهة الجنوبيّة وعن محراب المسجد الأقصى سوى شارع، تتمّ فوق العين الفوقا، في المنحدر الذي يخلو من الأبنية مقابل “طنطورة فرعون”، وهذه الحفريّات التي كانت تتمّ صيفا وتشرف عليها عالمة الآثار البريطانيّة “كاثرين كينيون”، يرافقها عدد من أساتذة الآثار وطلاب الآثار في عدد من الجامعات الأوروبيّة. وقد اعتادت أن تشغّل فيها رجالا مسنّين وطلّاب مدارس، والتّعليمات تقضي بأن لا يوضع في “القفاف” سوى حفنة من التّراب المحفور، كي يظهر جليّا ما فيه، وقد انتشرت إشاعة مفادها أن سبب تشغيلهم للمسنّين وللأطفال هو شفقتهم عليهم، ومحاولتهم مساعدتهم ماليّا، في حين كان السبّب الحقيقيّ هو أنّ ضربات المسنّين والأطفال بالفأس ليست قويّة، وبالتّالي لن ينكسر أيّ شيء مدفون في الأرض، يضاف إلى ذلك أنّ المسنّين والأطفال قد لا يخفون شيئا ممّا قد يجدونه! وفي داخل الحفريّات كان يتمّ استعمال “المسطرين” بهدوء ونعومة، ويتمّ جمع أيّ قطعة فخّاريّة توجد في المكان، وقد عملت في تلك الحفريّات عندما أنهيت الصّفّ الإعداديّ الأوّل. شقيقي ابراهيم سبقني في العمل بسنة، كانت أجرة العامل العاديّ اليوميّة 25 قرشا، وعامل الفأس 30 قرشا، في حين كان عامل “المسطرين” يتقاضى 35 قرشا، ولم يكن العمل مرهقا حتّى للأطفال.
في كتاب لها عن تلك الحفريّات أكدّت كاثرين كينيون أنّها كانت تبحث عمّا يسمّى “مدينة داود” لكنّها لم تجد شيئا منها، وأنّ كلّ ما وجدته هو بقايا من الحضارة اليبوسيّة، كما وجدت بقايا القصور الأمويّة، لكنّها لم تجد ما يشير لأيّ أثر يهوديّ.
ما علينا، كنّا ننام بعد غروب الشّمس بقليل، فلا يوجد كهرباء ولا تلفزيون أو مذياع، وفي الصّيف كنا ننام على البرندة التي هي عبارة عن سطح المخزنين الواقعين أمام بيتنا، ومن يستيقظ منّا يوقظ الآخرين، فنذهب إلى عين سلوان مهما كان الوقت، فلا يوجد ساعات لنعرف الوقت، أحيانا كنّا نصل عين سلوان التّحتا قبل العاشرة مساء، ونلهو ونلعب ونسبح في مياه العين، حيث كان المزارعون في قرية سلوان يغلقون قناة الماء التي تخرج من العين، حتّى تتجمّع المياه والتي كانت ترتفع إلى متر تقريبا، ليسقوا بها خضرواتهم صباح اليوم التّالي، كان حيّ البستان والوادي يكاد يخلو من الأبنية حتّى جسر حيّ الصّلعة الذي يشكّل الحدّ الفاصل بين أراضي سلوان وأراضي السّواحرة، وحيّ البستان كان مزروعا بالتّين الذي كنّا نسطو عليه ونلتهم ما يتيسّر لنا من ثماره، اشتهرت قرية سلوان في تلك السّنين بزراعة السّلق، حتّى ضربوا به المثل الذي يقول:”مثل اللي جاي يبيع السّلق لأهل سلوان”.
المهمّ أنّنا كنّا نمضي ما تبقّى من ليلتنا في العين، ومن يغلبه النّعاس كان ينام متّكأ على إحدى الدّرجات، التي تنزل إلى بركة المياه عند نهاية دهليز العين الذي يمتدّ من العين “الفوقا إلى “التّحتا”، وقد قطعت هذا الدّهليز الذي يشبه الخندق المرتفع بين الصّخور التي تخرج المياه من جنباته، قطعته أكثر من مرّة بصحبة عدد من أبناء جيلي مشيا على القدمين، على ضوء سراج يشتعل بالكاز”.
عند صلاة الفجر يأتي الشّيخ عمر يوسف القراعين إمام المسجد المبني فوق “عين سلوان التّحتا” وهو رجل طويل القامة ذو مهابة، يطرح السّلام ويقول لنا:
هيّا يا أولاد، ارتدوا ملابسكم واتبعوني إلى الجامع للصّلاة، فيستجيب له بعض منّا ويتبعونه للصّلاة خلفه.
العمل يبدأ في الآثار عند السّابعة والنّصف صباحا، فنذهب إلى مكان العمل قبل ذلك بنصف ساعة، من قُبلوا بالعمل يبدأون دوامهم، ومن لم يُقبلوا يعرضون أنفسهم أمام “مس كينيون” ومرافقها المرحوم “أبو محمّد غزلان”، ولها الخيار في انتقاء من تريد منهم، والباقي يعودون إلى بيوتهم، ليعاودوا الكّرّة في الليلة القادمة.
رعي الأغنام في مطار قلنديا
أثناء دراستي في الصّفّ الاعداديّ الثّاني، ذهبت عصر يوم خميس إلى مضاربنا التي كانت قريبة من مطار القدس”قلنديا” من الجهة الجنوبيّة، كان مربّو الأغنام قد قصّوا الأسلاك الشّائكة التي تحيط بالمطار، قصّوها عند التقائها بالأرض بين زاويتين من الزّوايا الحديديّة التي تحمل الأسلاك، يرفعونها ليلا، يدخلون أغنامهم منها لترعى الأعشاب في حرم المطار، ويعودون من حيث دخلوا بعد بضع ساعات، رافقت أنا وأخي طه الرّاعي لنساعده في رفع الأسلاك الشّائكة عند المكان الذي قُصّت منه لتدخل الأغنام وترعى في حرم المطار، استهوانا الأمر ودخلنا مع الأغنام، وجدنا أمامنا عدّة قطعان أغنام أخرى، بعد مرور حوالي ساعة من الزّمن، جاءت دوريّة من شرطة حراسة المطار، هرب البعض ومنهم راعي أغنامنا الذي اختبأ في عبّارة لتصريف مياه الأمطار، ألقوا القبض على أربعة منّا، أنا، أخي طه، والمرحومين محمد حسن أبو دهيم، والعمّ أمين خليل السلحوت، قادونا تحت الضرب بالعصيّ إلى مخفر الشّرطة في بناية المطار، وهناك انهالوا علينا ضربا دون رحمة، بعد حوالي عشر دقائق تقيّأ المرحومان أبو دهيم والسلحوت، واستمرّا بالتّقيّؤ، فتخوّف رجال الشّرطة من امكانية أن يكونوا قد ألحقوا بهما إصابات قاتلة، فأطلقوا سراحيهما دون شروط، -وتبيّن لي لاحقا أنّ سبب تقيّؤهما هو أنّ كلّ واحد منهما قد ابتلع ملء قبضة يده من دخّان”الهيشي” المفروم الذي في جيبه، وبهذا خدعوا الشّرطة لتطلق سراحهم- بقيت وأخي طه في المخفر حتّى ساعات الصّباح، حيث تمّ نقلنا إلى سجن “القشلة” عند باب الخليل في القدس القديمة، بعد التّحقيق معنا وضعونا مع معتقلين – بتهمة تعاطي المخدّرات والبعض منهم بتهمة السّرقة-، في غرفة واسعة أمامها ممرّ مسقوف بعرض حوالي مترين، ومحاط بشبكة من الأسلاك الشّائكة. بعد ساعات العصر جاء ضابط، وأخرجنا من الغرفة إلى البرندة، وهو يقول لشرطيّين يرافقانه: ” حرام يظل الأولاد مع الحشّاشين واللصوص”، نمنا ليلتنا في البرندة، وعند ساعات صباح يوم السّبت، تمّ استدعاؤنا إلى مكتب الضّابط، حيث وجدنا هناك مختار حامولتنا الشّيخ حسين ابراهيم شقير، الذي تكفّلنا وخرجنا معه، اصطحبنا معه إلى مطعم حيث تناولنا وجبة الفطور المكوّنة من الحمّص والفلافل، أعطى كلّ واحد منّا خمسة قروش، فاستقلّينا الباص وعدنا إلى البيت في جبل المكبّر. بعد ذلك قرأت في إحدى الصّحف خبرا منقولا عن صحف أجنبيّة، ويفيد بأنّ شركات الطّيران تشكو بأن روث المواشي يعلق بإطارات عجلات طائراتها التي تحطّ في مطار القدس.
تسيّب الطلاب من المدارس
حتّى ستّينات القرن العشرين كان عدد تلاميذ مدرسة السّواحرة الغربيّة الابتدائيّة للبنين يتراوح ما بين 280-300 تلميذ، -الآن في العام الدّراسيّ 2017-2018 يبلغ عدد الطالبات والطلاب من الرّوضة حتّى الثّانوية العامّة عشرة آلاف وبضع مئات، يضاف إليهم بضع مئات يدرسون في مدارس خاصّة خارج البلدة-.
في تلك المرحلة وبسبب الفقر المدقع كان عدد من التّلاميذ عندما يصل الصّفّ الخامس أو السّادس الابتدائيّ يجبر على ترك المدرسة؛ ليبحث عن عمل يساعد في إعالة أسرته، وجزء من هؤلاء كان يترك المدرسة لرسوبه في الصّفّ، يضاف إلى ذلك جهل أولياء أمورهم، وعدم فهمهم لأهمّيّة التعليم. كان العمل السّائد وقتئذ لهؤلاء الأطفال هو أن يشتري له ذووه”طبليّة” لمسح الأحذية؛ ليعمل ماسحا للأحذية في شوارع وأسواق القدس، رغم محدوديّة الدّخل من هذا العمل، والتي قد لا تصل لعشرة قروش أردنيّة في اليوم الواحد، لكنّ الأهل بحاجة إلى هكذا مبلغ! ونسبة التّلاميذ الذين كانوا يتركون المدرسة قد تصل إلى 60% أو تزيد، والتّشديد في عمليّة الرّسوب والنّجاح في الصّفوف خصوصا في الصّفوف الابتدائيّة كان سلاحا ذا حدّين، فمن جهة هو يدفع التّلاميذ إلى الاجتهاد، ومن جهة أخرى قد يكون الرّسوب سببا في تركهم للمدرسة، عندما درست في الصّفّ الأوّل الابتدائيّ في العام الدّراسيّ 1955-1956 كان عدد تلاميذ الصّفّ 63 تلميذا، أنهى الثّانويّة العامّة منّا عام 1966-1967 دون رسوب ستّة أشخاص فقط. وتسرب حوالي 60% منهم، والباقون رسبوا في مراحل مختلفة، ومن مآسي الرّسوب أنّ بعض تلاميذ الصّفّ الأوّل الابتدائيّ كان يرسب مرّتين في هذا الصّف، أي يمضي ثلاث سنوات في الأوّل الابتدائيّ.
ومن المحزن في النّظام التّعليميّ في تلك السّنوات أنّ بعض المعلّمين كان يكتب في خانة الملاحظات في الشّهادة المدرسيّة للتّلميذ” لا فائدة ترجى منه”! دون أن يدرك أنّه بهذه العبارة قد قضى على المستقبل التّعليميّ لذلك الطّفل.
ومن طرائف الرّسوب وتكراره ما يرويه الأستاذ طاهر النّمّري، الذي أكمل دراسة التّاريخ في الجامعة بدايات ستّينات القرن العشرين، وعاد ليعمل مدرّسا في المدرسة الرّشيديّة الثّانوية في القدس التي تخرّج منها، وعندما دخل أحد الصّفوف معلّما للمرّة الأولى ووقف أمام الطّلاب، ناداه أحد زملائه ممّن رسبوا سنوات ليجلس بجانبه، ظنّا منه أنّه لا يزال طالبا لم يكمل المدرسة.
الزّواج المبكّر
شكّل الزّواج المبكّر للبنات والبنين ظاهرة ملحوظة في تلك المرحلة، ولا تزال بقاياها موجودة حتّى يومنا هذا وإن بشكل نادر، ومن أبناء جيلنا هناك من تزوّجوا قبل أن يبلغوا الخامسة عشرة من أعمارهم، في حين هناك طفلات زوّجهنّ ذووهن قبل هذا العمر بسنتين أو ثلاث سنوات، وبعض من أبناء جيلي تزوّج عندما أنهى الصّفّ السّادس الابتدائيّ. أحد أبناء صفّي الذي يكبرني بعامين، ودرست معه في صفّ واحد لرسوبه، ترك المدرسة عندما أنهينا الصّفّ الخامس الابتدائيّ بناء على رغبة وإلحاح ذويه، الذين سارعوا إلى تزويجه كونه يتيم الأب، “لينجب طفلا يحمل اسم أبيه المتوفّى!”
ومن الطّريف أنّني تزوجت في حزيران –يونيو-العام 1981 انا وابنه في يوم واحد!
ويلاحظ أنّ الزّواج المبكر كان يستهدف البنات أكثر من الأبناء، وكثير من نساء تلك المرحلة أصبحن جدّات في بدايات الثّلاثينات من أعمارهنّ!
ومن قصص الزّواج المبكّر المحزنة التي أعرفها، أنّ طفلة لم تبلغ الثّالثة عشرة من عمرها، كانت صغيرة الحجم، فرفض المأذون الشّرعيّ في البلدة أن يعمل عقد زواج لها إلا بإذن من قاضي المحكمة الشّرعيّة في القدس، فألبسوها الثّوب التّقليديّ المطرّز، وانتعلت حذاء ذا كعب عال، اصطحبوها هي والعريس الذي يكبرها بثلاثة أعوام إلى المحكمة الشّرعيّة، وهناك دخل جدّها لأبيها على القاضي الشّرعيّ طالبا أن يكون وحده مع القاضي، وقال للقاضي:
“يا سيّدي ربنا دعا إلى السّتر، وهذه البنت حامل من هذا الولد، ولا بدّ من تزويجهما قبل أن يظهر الحمل وتحصل فضيحة ستكون عواقبها وخيمة!”
وهنا لم يجد القاضي مناصا من عقد زواجهما! وهذه الحادثة كانت موضع فخر بذكاء الجدّ الذي عرف كيف يخدع القاضي الشّرعيّ!
******
أغاني الأطفال
مع أنّني وأبناء جيلي عشنا طفولة تعيسة بكلّ المقاييس، أو بالأحرى لم نعش مرحلة الطّفولة، ولم نشعر بها، فقد كان الكبار يعتبرون الطّفل رجلا من يوم ولادته، ومن ذلك قولهم عند التّهنئة بالمولود الجديد: ” مبروك العريس” وبالبنت إذا وُجد من يهنّئ بها: “مبروكه العروس”، لكن مخاطبة الأطفال الذّكور بأنّهم رجال كانت تلاحقهم في مراحل أعمارهم المختلفة! كما كانوا يكلّفونهم بأعمال فوق قدراتهم في مراحل عمريّة مبكرة، كأن يُكلّف الطّفل ابن خمس سنوات برعي قطيع من الخراف التي لا تقوى لصغر عمرها على مرافقة أمّهاتها إلى المرعى، أو لعزلها عن أمّهاتها كي يحلبوا الأمّهات قبل أن يرضعها صغارها. وطبعا في هكذا حالات يكون المرعى قريبا من البيت.
وبرغم ذلك كانت للأطفال طقوس من المرح النّسبيّ، فكانت لهم أغانيهم وألعابهم الخاصّة، ومن أغاني الأطفال التي جمعتها أنا والدّكتور محمّد شحادة، ونشرناها في كتابنا “صور من الأدب الشّعبيّ الفلسطينيّ” وصدر عام 1982 عن منشورات الرّواد في القدس مع التأكيد بأنّ أغاني الأطفال تقسم إلى قسمين:
قسم يغنيه الأطفال أثناء اللهو واللعب، ويردّدون الأغاني بأنفسهم.
وقسم ثان تغنيه أمّهاتهم لهم وهو المسمّى هدهدة.
وسوف نلاحظ بأنّ القسم الذي يغنّيه الأطفال، يقتصر على الأولاد دون البنات؛ لأنّ الأسرة العربيّة بشكل عامّ، والأسرة الرّيفيّة على وجه الخصوص، ما فتئت أسرة ذكوريّة لكونها ترتبط بجذور قبليّة، فالعائلة تقاس أهمّيّتها وقوّة نفوذها ، بقدر ما فيها من رجال، كونهم يقومون بحمايتها وردع الأذى والشّرور عن حماها، وفي البادية والرّيف نرى أنّ الأب بحاجة إلى الأبناء الذّكور، كي يساعدوه في أعماله، وفي بعض الأوساط المتخلّفة اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا، سواء كان ذلك في مجتمعنا، أو في غيره من المجتمعات العربيّة، ما زالوا لا يعتبرون البنت خلفا، إذ قد يترامى إلى مسامعك دعاء بالخلف لإمرأة أو رجل، وفي بيته عدد أصابع اليد من البنات، والمرأة غير المثقّفة أو المتعلّمة- مع الأسف- تقرّ بهذا الواقع المرير، وهذا القانون الموجّه ضدّ طبيعة التّطوّر البشريّ، فتجدها تميّز بين أبنائها وبناتها، وهي إن كانت متعلّمة، أو تفتّحت عيونها على الثّقافة، ملزمة بإقرار ذلك ، لتتمسّك بزوجها، فتبعد بذلك شبح الطّلاق عنها، وتستمرّ في الحياة الزوجيّة، ورغم كلّ هذا، تبقى مسألة استمرار حياتها الزّوجيّة مرهونة بولادتها لابن ذكر، وكم من امرأة راحت ضحيّة هي وأطفالها؛ لأنّها انجبتهم بناتا، أو لكونها عاقرا، علما أنّ العلم أثبت أنّ الرّجل هو المسؤول عن إنجاب الولد أو البنت، “مثلما تزرع تحصد”.
وسأورد هنا عددا من أغاني الأطفال كما كنّا نغنّيها أنا وأبناء جيلي في بلدتنا “السّواحرة، وعلى القاريء لهذه الأغاني الانتباه بأنّها باللهجة المحكيّة “العامّيّة” وهي أقرب إلى اللهجة البدوية.
ومن الأغاني التي كنّا نغنّيها في طفولتنا في موسم الحصاد، هذه الأغنيات :
حيّه حوّت
في البير دوّت
وِشْ دوّاها
شيخٍ جاها
سحب الدّبّوس
من هالكربوس
وتولّاها
ويجب أن نلفت الانتباه، إلى أنّ هذه الأغنية، يغنّيها الحصّادون أيضا في الموسم ذاته، ومن أغاني الأطفال في موسم الشّتاء :
شمّست شميسهْ على عروقْ عيشهْ
عيشه في المغارهْ حلبت قطّهْ وفارهْ
أجا البِسْ كبهن نقرته صرارهْ
راحت تعوص لامها سوّت لها فطيرهْ
قد بابِ الصّيرهْ والصّيرهْ ما وسعتها
بزّ الكلبهْ عْصابِتْها
ويزيد الأطفال في مرحهم، وابتهاجهم وصخب ضحكاتهم اللطيفة البريئة، فيغيّرون الجنس في البيت الأخير، عاكسين الكلمة الأولى فيه. وهذه أغنية شتويّة من الأغاني التي يردّدها الأطفال :
يا ربّي تشتّي واروح عند ستّي
تعمل لي فطيرهْ واكلها وأنام
* * *
وامطري وزيدي بيتنا حديدي
بيتنا شَعْرِ الغنمْ وعمنا عبد الله
ورزقنا على الله
* * *
وامطري وزيدي وبيتنا حديدي
وعمنا عبد الله ورزقنا على الله
* * *
وامطري يا مطرهْ عَ عروق الشّجرهْ
وكان حين يأتي قائد فلسطيني لزيارة مضاربهم، يغنّي له الأطفال مرحّبين بقدومه:
يا حمامات المدن طُلّن عليه وارعدن
وان أجانا أبو غازي”عبدالقار الحسيني” شوشحن له بالرّدن
والأطفال أشقياء لا يتركون العجائز بحالهنّ، فيما وصلن إليه من العمر، فيروحون يستهزؤون بهنّ، فحين كانوا يرون عجوزا، تضع الحنّاء على شعرها الأشيب، ينتقدون هذا العمل بأغانيهم، فيصرخون فيما يشبه المظاهرة : وبتشجيع من الرّجال:
دِبّوا العجايز في البيرْ ودبّوا وراهن خنزيرْ
والخنزيرْ ما بكفاهنْ لَطْعِ”روث” البقر حنّاهنّ
كما أنّهم يستغفلون كبار السّنّ، ويسرقون حاجياتهم :
طحت طحت نازل وعمّرت المنازل
لقيت الشّايب نايم حملته ودبّيته
وشربت من زيته، زيته طعم حِنّا
******
شواشي ابن عمّي حلف يوخذ امّي
وامّي مغربيّهْ دقّه محلبيّه
ويا ما أحلى دقّاتها ع الشّجر خبّتها
واجا عمّي وسرقها ولبّسني من حلقها
وحلقها شقلي بقلي ومن حسنه طيّر عقلي
وعندما يخلع الطفل أسنان الحليب، يرميها للقمر في الليل، ويطلب منه، أن يعطيه أسنانا ناصعة البياض، لامعة كالنّجوم ، مستقيمة سوية لا اعوجاج فيها .
يا قمرنا يا جدع يللي مخرخش في الودع
بناتك خمسه سته يلعبن على الدّكه
فيهنْ وحدهْ جاريهْ تطبخ في الصّنّاريّهْ
واطعمتني وما رضيتْ قَلَعتْ سنّي وجيت
شيل الله يا احمد حسن يا حواكير البصل
ويا اللي معنقر طاقيته، خللي البيت وراعيته
وكنّا نردّد أغاني تحمل التّعقيد اللفظيّ واللغويّ، ونتراهن على من يستطيع ترديدها .
طِحْتْ أدِبّْ وطلعتْ أدِبّْ
لقيت الدِّبّْ بوكلْ في الّلبّْ
طردت الدِّبّْ وأكلتِ الّلبّْ
نطّيت عن الّسبع زروب
وجيت ع الزّرب الفوقاني
ومن ذلك أيضا المراهنة على ترديد ، مثل هذه الجمل ذات الحروف المتكرّرة وشديدة الشّبه، فنضحك حين يكون من الصّعب على الواحد منّا ترديد هذه الجمل بسرعة شديدة ولعدّة مرّات دون توقّف، ونقهقه أكثر، حين يقع أحدنا في خطأ لغوي من ذلك :
خيط حرير على حيط خليل
خشبات الحبس خمس خشبات وخشبه
شجرة نتش، جيت انتشها، وما انتتشتش
مسمار احرد ابرد في طيني غزّ
وللأطفال أغانيهم التي تحمل في ثناياها روح الدّعابة :
بلا برم بلا برم
الحجّة طاحت في الكرم
أجا البِسّ رفع ذنبته
والصّرارة طقرته
لبشارة يا حجّ سعيد
والدّيك طلّق مرته
* * *
خرفتك خريرفه في ذانك شريريفه
فيها وعواع الوادي فيها مية ( 100) صيّادي
فيها نعجتنا الغرّا جابت توم طلياني
قلت مالك يا طلي؟ قال السّيف ذابحني
قلت ما لك يا سيف؟ قال النّار تصليني
قلت مالك يا نار؟ قالت السّيل طافيني
قلت مالك يا سيل؟ قال العشب نابتني
قلت مالك يا عشب؟ قال الخيل ترعاني
قلت مالك يا خيل؟ قالت الشّبّ راكبني
قلت مالك يا شبّ؟ قال الموت غالبني
قلت مالك يا موت؟ قال الرّبّ مرسلني
قلت مالك يا ربّ قال الموت ما عَنّه فوت
* * *
أوبى يا امّ احمد أوبى وقولي لحمد
أوبي خالي عصر راح راح ع مصر
واشترى لي مشط مشّطت راسي
طال لي قمله نيني نيني يا قمله
يامّ احمد قولي لاحمد جحش احمد روّح ع الدّار
* * *
بين حربتنا وحصاني حربتنا ها لمجليّه
قطعت راس زيديّه
* * *
برجم برجم حمامات… على الزّرقا مِلْتمّات
يلعن أبوكم يا هتيمات… ما عرفتوا تربّوا البنات
ربّاهن حسن قعدان… في ايده حربه وفيده زان
في ايده مطرق الرّمان… قطع راس زيديّه
زيديّه بنت السّلطان…. صفّتها لولو ومرجان
طاحوا الفقرا ع الجامع… لقوا بنيّة مدحوله
قالوا فيش نغطيها…. قالوا بورقة الليفه
والليفه مع الرّاعي… والرّاعي بيدة بيضه
والبيضه مع الجاجه… والجاجة بدها علفه
والعلفه في الصّندوق…. والصّندوق بدّه مفتاح
والمفتاح مع ابو صلاح… راح يجيب لنا مفتاح
يا قلايد يا ملاح
قصبه متقصبه ع البحر متننصبه
حاديها يا باديها ذنيب القط فاسيها
* * *
يا عمّي يا احمد واعطيني شبريّه
تلحق خيل السّلطان تلحق خيل السّلطان
أوّل قتلت الواحد الثّاني قتلت الميّه “100”
وكانت لنا أغنياتنا التي تسخر من النّاس الذين يبالغون في كلامهم، وينسجون القصص الخياليّة من الأمور البسيطة، بكلمات أخرى، مثل هذه الأغنيات تستهزئ من أولئك الذين يصنعون كما يقول المثل الشّعبيّ من البحر مقاثي.
أرنبنا اسم الله عليه نايم وِمْسبّل ذينيه
جابر يلله يحرق والديه وحْرَمْنا من الشّيخ ارنب
أرنبنا في الحاكوره مقرمع كلّ البندورهْ
جابر ضربه فاشورهْ قضت على الشّيخ أرنبْ
قلْ يومْ رَوَّحْ سعيد ولاقى الأرنب شهيد
قال لِمّوا البواريد تنوخذ ثار الأرنب
وأجت الدّولهْ والدّرك مقسّمين أربع فِرَقْ
جابر ملعون الطّرقْ وأجرم في حقّ الأرنب
ونزل الضّابطْ والشّاويش وعملوا ع الأرنبْ تفتيش
وانت يا جابر لا تحكيشْ وادفع … حق الأرنبْ
يا ابن عمّي يا سعيدْ وانت قرابه مش بعيد
واصبر عليّ لبعد العيد تنحوِّش حقّ الأرنب
ومن الجورة ودير ياسين جين النّسوان يعزّين
حسّبنه ها الحجّ أمين واثريته الشّيخ أرنب
أجت صفيّهْ وأنيسهْ عِمْلِنْ للأرنب ونيسه
وعملن للأرنب ونيسه عملوا له رزّ وجريشه
ومن الأغاني التي كنّا نغنّيها:
يا رايح عَ الشّجرهْ
جِبْ لي معك بقرهْ
حلابة العشرهْ
تحلب وتسقيني
يا ربّ تنجيني
شوفوا شوفوا يا ولادْ
ربّانا شيخ الشّبابْ
اللي عيونه سود سود
مكحّلات براس العود
********
حدّوثه بدّوثه، طِلْع الشّيخ عَ التّوتهْ
والتّوته بدها فاسْ، والفاسْ عند الحدّاد
والحدّادْ بِدُّهْ بيضهْ، والبيضهْ عند الجاجهْ
والجاجهْ بدها علف، والعلف في الطّاحونهْ
والطاحونهْ مْسكّرّهْ، فيها ميّهْ مْعكّرَهْ
******
حطّوا مقص على مقص، سبع عرايس تنزفّْ
حطوا منخل على منخل، سبع عرايس تدخل
******
يا فاطمه…. يا عونك
وين الجمل؟… بالقنطره
شو بيوكِل؟…. حبّ الذّرهْ
شو بيشرب؟….. قطر النّدى
هالباب بيفتح؟ ما بفتحْ
هالباب بفتح؟ ما بفتح
هالباب بفتح؟….بفتح…بغلق
ليلة عرسك…يا فلان
لا كرشه ولا مصران
******
ومن الأغاني التي كانت تغنيها البنات الطفلات:
بدنا نعجن العجين
هاتوا لجن هاتوا طحين
وملح وميّه وخميره
وندعك ندعك بالايدين
ولما تخلص العجنة بنردّدها
نريّحها ونقطّعها ونكوبجها
وبالشّوبك عالطبليّة وبنفردها
بتصير كماجة وتخمر وبنخبزها
ما أزكاها مخبوزه بالطّابون
منفوخة متل الطّابه وأعلى شويّه
وإذا بنوكل خبز حاف بشهيّه
بنشبع وبنعرض لكتاف القويّه
ويا عيني عالمناقيش مع الزّعتر
كن العجينه قراقيش مع السّكر
هاي قصّة خبز العيله وكيف بتحضر
بدنا نغني ونحفظها تا نكبر
حدريجه بدريجه… من حيها لبيها
قالت لي معلمتي… جيبي زيت وبصل
وقع الكوز وانكسر… حلفتني معلمتي
لتعلقني بالشّجر… والشّجر مليان عروق
خبي رِجْلِككْ…. منيح يا عروس
يا أمّ الحلق… والدّبوس
وهناك أغان احتفاليّة بقدوم العيد كعيد الفطر وعيد الأضحى، فالعيد مناسبة هامّة للأطفال، فقد يحصل البعض منهم على كسوة جديدة، كما هي مناسبة لأكل اللحوم التي لم تكن تتوفّر لهم إلا في المناسبات والأعياد، ومن الأغاني التي كنّا نردّدها في طفولتنا:
بكرة العيد وبنعيد… بنذبح بقرة السّيّد
والشّقرا ما فيها دم….غير نذبح بنت العمّ
بكره العيد يا مسعود… دارت الميّه في العود
يا سعيد ويا سعيد… اليوم الوقفه بكره العيد
بكره العيد من حقّه… بنقطع راسك يا سقّا
بكره العيد والثّاني… بنقطع راس أبو هاني
بكره العيد والثّالث… بنقطع راس أبو فارس
******
أغاني الهدهدة
مقابل أغاني الأطفال، كانت هناك أغاني “الهدهدة” التي تغنّيها الأمّهات والجدّات لأطفالهن رغم انشغالهنّ بأكثر من عمل، وضيق وقتهنّ، إلا أنّهن كنّ يحرصن على إسعاد أطفالهنّ كلّما حانت لهنّ فرصة، فيشعرون بالرّاحة والطمأنينة، ويصغون إليهن باهتمام شديد، حتّى أنّ من يبكي منهم يتوقف عن البكاء، أو يستبدله بابتسامة عذبة تدخل الفرحة إلى قلب والدته وقلوب الآخرين، وقد انتبهت إلى ذلك دور الحضانة الحديثة،- ومنها دار الحضانة التّابعة لجمعيّة إنعاش الأسرة في مدينة البيرة – كما أنّ دور الحضانة في بعض الدّول الأوروبيّة ومنها المانيا قد انتبهت إلى هذا الموضوع أيضا، فلجأوا إلى تسجيل أغاني الهدهدة بأصوات الأمّهات على أشرطة وفتحها في غرف الأطفال، وأثبتت بالتّجربة ردود فعل إيجابيّة لدى الأطفال، وقد انتبهت الأمّهات الفلسطينيّات إلى هذه القضية منذ آلاف السّنين، وللمولود الجديد فرحة عند الأسرة الشّعبيّة الفلسطينيّة، حيث تقام الأفراح بمناسبة قدومه، ويُغنّون له، وسننقل في هذا الموضوع بعض الأغاني التي تردّدها الأمّهات ومنهنّ أمّي لأطفالهنّ، كما سمعتها وسجّلتها في منطقة عرب السّواحرة قضاء القدس الشّريف، كونها المنطقة التي ولدت وأعيش فيها، مع التّأكيد على غنى موروثنا الشّعبيّ في مختلف أرجاء بلادنا فلسطين، مع دعوتي لأبناء شعبنا أن يسجلوا الموروث الشّعبيّ لشعبنا، كونه معرض للضّياع لأسباب كثيرة، لسنا في مجال بحثها هنا، ومن الأغاني التي تقال عند ولادة مولود جديد:
لولا الولد ما جينا حِلّو الكيس واعطونا
واعطونا حيلوان صحنين بقــــــــلاوة
جاي علينا جايه فيــــــــدنا العصايه
نضرب الحوّايه ورغيفين شاميّات
ورغيفين حلبيّات
حيّ الله ي بلاد الشّام فيها الخوخ والرّمان
واطلعنا ع البوبعي والشمع دبوبعـــــــي
يخلّيه لأمّه آمين يخليه لأخته أمين
يخليه لجميع السّامعين
* * *
يا طوق صدري لك زمان مرحرح
عودة من الله ي الحبايب تفرح
* * *
طلّ القمر من شرقا ومغزغز ريش
ي الولد حبيب امّه ويا ريته يعيش
طلّ القمر من شرقا ويا حليله
طلّ والولد حبيب امّه ويا ريته يظل
* * *
والعبي يا لعّيبه واعتلي يا قمر
زفّي الولد يا امّه تحت ظلّ الشّجر
والعبي يا لعّيبه واعتلي يا نجوم
زفي الولد يا امّه تحت ظل الكروم
أمّا النّسوة اللواتي المهنّئات فكنّ يُغنّين :
شجرة قرنفل دوبها اللّي نوّرت
الحمد لله ويا الحبيبه طَهّرت
شجرة قرنفل دوبها اللي بانت
والحمد لله ويا الحبيبه نالت
* * *
والسّمسم الأخضر جلّل الحيطان
يا ميمة الولد روحي ع الدّكان
هاتي اللطالس لّبْسي الصّبيان
هاتي اللطاسس ما شِكِل مع شكل
هاتي اللطالس كل شكل لحاله
* * *
واسم الله ع الولد اسم الله عليه
هاتوا حنين الورد رُشّوا عليه
* * *
هاي ويا كلكم اولاد
هاي ويا خرز في قلاده
هاي ويا كل يوم نطهر واحد
هاي ويا نظل ع هالعاده
* * *
في ايده اليمين تفّاحه الولد ع الطراحة فيده اليمين تفّاحه
يا ابن الدّلال والرّاحه الله يخليك لامّك يا ابن الدّلال والرّاحه
في ايده اليمين شبريّه الولد ع الجنّبيّه فيده اليمين شبريــــّـه
يا ابن الدّلال والغيّه الله يخليك لامّك يا ابن الدّلال والغيّه
* * *
الحمد الك يا ربّي الحمد الك يا ربّي
الله يخليلها ابنها أبو رقبه ينط ويخرى في العتبه
* * *
وتغنّي الأمّ لطفلها :
هيه لله هيه لله سمن وعسل في الجرّه
لوكل أنا وأختي وبنرمي الولد لبرّه
* * *
يا تمر هندي ع عروق القمح والحمد لله يا قليبي فرح
* * *
يا قمرنا يا بو هليله تعال، بات عندنا الليله
تذبح لك عجل وعجيله
* * *
نام يا حبيبي نام تذبحلك طير الحمام
لا تردّي يا حمامه أنا بكذب ع الولد تينام
* * *
يا حمامة الوادي هاتي النّوم لولادي
يا حمامة البحرين هاتي النّوم للعينين
* * *
يا حمام يا حمام وين الولد ينام
تحت ظلّ القطيفه فوق ريش النّعام
* * *
يا حمام بروس العلالي رقى ما حسّيت الحبيب يرد النّقى
يا حمام بروس العلالي يصيح ما ظنّيت الحبيب يفارق صحيح
يا غزال السّهل يا سميح اليدين يعلم الله انّك سليتني عن الوالدين
* * *
درب الخلا يا غزالي لا يصيدونك
اوعك تطوف في السّهل وتسبل عيونك
* * *
روحي يا جاجه وتعي جاجـــــــــه
الله يخلينا الولد يكبر ويجيب الحاجه
روحي يا صوصه وتعي يا صوصه
الله يخلينا الولد يكبر ويجيب الخوصه
* * *
ونامي يا عين الولد نامي تذبحلك جوز الحمام
تراك يا حمام تتعوّق بنضحك ع الولد تينام
* * *
يا عين الولد نامي يا ملانه نوم
في عين عدوّك لأدقّ البصل والثوم
وهذه الأغنية تبين لنا مدى مفاخرة الأم بابنها الذكر:
والزّبره زبرة عطــــــــــا نايمه تحت الغطـــــا
ولا تحسدي يا حاســـــــده وهذا ربي اللي عطـى
والزبره زباريــــــــــــــها والرّحمن امباريهـــــا
والدار اللي هي فيهــــــــا بتطب البركه فيهـــــــا
* * *
أمّا الختان “الطّهور” فله أغان كثيرة، منها :
يا تمر هندي ع عروق الشّجر والحمد لله يا قليبي أنا انجبر
شجرة قرنفل دوبها اللي نوّرت والحمد لله ي الحبيبه طهّرت
خاطري بزفّه في باب الواد يا قمر ضوّي لي على الأولاد
خاطري بزفّه في البساتين يا قمر ضوّي لي ع المطاهير
والغناء في حفلة ختان طهور الطفل، واجب على قريباته بالدّرجة الأولى :
واحنا الصّبايا دوبنا لفينـــــــــــا في صخرة الله والحرم صلّينا
واجب عليكن وانتن بنات عمّاته الولد تطهّر ترقصن بحياته
واجب عليكن يا نسوان عمامه الولد تطهر ترقصن قدّامه
* * *
في طفولتنا كان الغناء في الختان تخصّصا للنّساء، أمّا الرّجال فلا يفعلون ذلك إلا في حالات نادرة، كأن يتأخر الانجاب لسنوات طويلة، أو أن يولد الابن الذّكر لأحدهم بعد عدد من البنات، وفي انشادهن تطلب النّساء الخير والبركة للمُطهّر، ويتمنّين له الصّحّة والعافية :
الله يجيرك يا مطهــــــــر يللي بتطهّر من حالك
ويا اللّي طهّرت الولد الله يسلّم شمالـك
* * *
الله يجيرك يا مطهّــر يللي بتطهّر ع هونك
ويا اللي طهّرت الولد الله يسلّم يمينـــــــــــك
وهن، لا يردن أن يتألّم الطفل أثناء عمليّة الختان الجراحيّة، ولذا يطلبن من المطهّر أن يكون موسه حادّا حتى لا يؤلم الطفل، فيأخذ الصّغير بالصّراخ والبكاء، ويمنّين الرّجل ببدلة مقابل عمله، ويُحلفنه بالله وهن يقلن فيما يشبه الأغاني الممدودة “التراويد” :
بالله يا شلبي وبالله عليـــــــــــــــــــــــك سنّ مواسك وخفّف ايديـــــــك
وِنْ ضحك ها الولد ونا لخلع عليك وِنْ عيّط ها الولد أنا لزعل عليك
* * *
طهروا لي الولد وناولوه لخاله ي دموع المدلّل نقطت على ذياله
طهروا لي الولد وناولوه لعمّه ي دموع المدلّل نقّطت على كمّه
* * *
واجانا المطهّر وأصله من الخليل واشري للمطهّر بدله من حرير
واجانا مطهّر واصله من القدس واشرى للمطهّر من زين الّلبِس
* * *
طهره يا مطهّر بموس هالمصري والولد لمدلل خلّوه لما العصر
طهره يا مطهر بموس هالقلام و الولد لمدلّل خلّوه لما ينام
* * *
في حين كان في القدس تاجر يدعى الكاشف، وكان أهالي البلد يشترون منه الأقمشة وخاصّة للأفراح، حيث كانت العادة، أن يشتري أهل الولد بدلة جديدة لطفلهم المختون:
طهروا لي الولدع القش الناشف وهات له يا بيّه بدله من الكاشف
وهذه الأغنية تدلّ على مدى قيمة الابن عند والديه والمقربين منه :
طهروا لي الولد ع القش المبلول وهات له يا بيّه بدله من اسطنبول
* * *
والعبي يا لعيبه واعتلي يا قمر خاطري زف المطهّر تحت ظلّ الشّجر
* * *
يا امّ المطهر مبارك ما عملتي لُه والجوخ الاحمر من التّاجر قطعتي لُه
* * *
في القنّيّه يا زارعات الورد في القنّيّه يا ميمتي يمّه
في العلّيّه يا مطهر الصّبيان في العلّيّه يا ميمتي يمّه
في القناني يا زارعات الورد في القناني يا ميمتي يمّه
في العلالي يا مطهر الصّبيان في العلالي يا ميمتي يمّه
* * *
رحلت غادى عرب ولبو فلان رحلت غادى
في حيناوى الوادي يا عشب نابت في حيناوى الوادي
* * *
لا تطهروا ها الولد لما يجين خالاته
يِجِبْن الذّهب واللولو ويقطبن على جيباته
* * *
غيره ما بريد، طهروا لي الولد غيره ما بريد
يا دمعة عيونه، يا نخل الجريد، يا دمعة عيونه
غيره ما بِدّى ، طهروا لي الولد غيره ما بِدّى
يا نخل الورد، يا دمعة عينه، يا نخل الـــــــورد
* * *
ع المينا وعلى المينا يا مراكب ودّينا
ع المينا وعلى المينا يا مراكب القدس
لولا طهورك يا ولد ما لبسنا هالّلبس
ع المينا وعلى المينا يا مراكب عمّان
لولا طهورك يا ولد ما لبسنا هالذّهبان
ع المينا وعلى المينا يا مراكب الكويت
لولا طهورك يا ولد ما لبسنا هالجاكيت
* * *
وانا جاي أهنّي دار خالي فلانه زغرتي وأنا بهاهي
وأنا جاي أهنّي دار عمّي فلانه زغرتي وأنا بأغني
* * *
عبر عليّ الشلبي وأنا بغربل قمحي
واصبر علي يا شلبي لمنّي أتمّم فرحي
عبر عليّ الشلبي وأنا بغربل فولي
صبرك علي يا شلبي لمنّي أتمّم طهوري
وترحّب أمّ المُطهر بصديقاتها من النّساء :
الدّار داري والبيوت بيوتــــــــي
الولد اتطهّر ي الحبيبه فوتي
الدّار داري والمطارح مطرحي
الولد اتطهّر ي الحبيبه وافرحي
* * *
ع الكروم يا عنب ع الكروم
في طهور الولد نساهر النّجوم
ع الدوالي يا عنب ع الدّوالي
في طهور الولد نسهر الليالي
* * *
وأغاني الختان يذكر فيها الكبار أيضا، من أقارب المختون وأصدقاء أهله :
الولد نايم على تخته ذبل يوم غطيته
طلب منّي سيجاره يقصف عمري ما عطيته
وتجدر الاشارة أنّ العادة جرت، أن يطهّر أبناء العائلة مجتمعين، واذا صادف وكانت إحدى النّساء حاملا، فإنّهم كانوا ينتظرونها حتى تضع حملها، آخذين بعين الاعتبار أنّها قد تضع مولودا ذكرا، فيلحق بمجموعة الأطفال الذين سيتم ختانهم. كما كانت العادة أن تنحر الأغنام يوم الختان. واستمرّت هذه العادة وبشكل جزئي حتّى أواخر الخمسينات من القرن العشرين، لكنّها ما لبثت أن تلاشت، لأنّ الأطفال يُختنون بعد الولادة مباشرة في المستشفيات.
ألعاب الطفولة
لم تكن ألعاب الأطفال معروفة لدى الأهالي، لذا فإن الأطفال ابتكروا ألعابهم الشّعبيّة التي لا تكلّف الأهالي شيئا، وسأعدّد بعض هذه الألعاب دون الخوض في تفصيلاتها، لأنّني أرى أنّ مكانها ليس في هذه الصّفحات من سيرتي:
الطّابة، المباطحة، السبع “صرارات”حجارة، البنانير “الجلول”، الاكس، القرعة بإخفاء صرارة (حصاة صغيرة) في اليد، القرعة بالنقود، القرعة بالقدم، لعبة شدّ الحبل، لعبة المطاقشة (خميس البيض)، لعبة ياعمّي وين الطريق، لعبة نط الحبلة، لعبة عسكر وحرامية، لعبة الحاكم والجلاد، لعبة طاق طاق طاقية، لعبة الكال أو الكالات (الحصوة)، لعبة الشعبة أو المغيطة، لعبة المقليعة، لعبة الحصان، السّيّارة.
************
الغيلان والعفاريت
يلاحظ في طفولتنا أنّه ونتيجة للجهل السّائد، فإنّ الخرافة كانت منتشرة بشكل واسع. كانت تحاك قصص مرعبة عن الغيلان، الجنّ والعفاريت، الرّصد، وغيرها من المسمّيات، فلا تكاد تجد بئرا أو كهفا قديما إلا وحيكت حوله حكايات مرعبة، تجعل الأطفال ينامون وهم يرتجفون رعبا، عندما يسمعون الكبار يتسامرون بسردها. وهم يحذّرون الأطفال من مغبّة الاقتراب من تلك الأماكن.
ومن الحوادث التي عشتها وشاهدتها وشهدت عليها، أنّه عندما كنت في العاشرة من عمري، جاءنا ضيوف عند ساعات المساء، فذبح لهم الوالد –رحمه الله- خروفا، وكان الأولاد من جيلنا ينزلون مساء إلى واد ذياب الذي يبعد حوالي مئة متر عن بيتنا، وهو مزروع بالعنب، يلعبون ويتسامرون، وبصبيانيّة يحاول كلّ منهم أن يسرق قطف عنب من الكروم المجاورة التي تغيّب أبناؤها عن الحضور مع الصّبيان، وفي الحاجب الصّخري المحيط بأرضنا هناك كهف كبير قديم، سمعنا عنه عشرات الحكايات المرعبة، ومنها أنّ هناك من أقسموا أنّهم رأوا فيه امرأة عظيمة الجسم عارية الجسد يمتدّ شعرها كالخيمة، ويبلغ طول ثدييها أكثر من متر، تحاول إغراء من يمرّ بها، فتمسك ثديها وتمدّه إليه، وإذا ما اقترب منها فإنّها تبتلعه لقمة واحدة.
وأوعز أبي لي ولأخي طه الذي يكبرني بعامين، أن نذهب لحراسة كَرْمِنا من الأطفال الذين تجمّعوا في الجهة المقابلة لبيتنا، فذهبنا مرغمين وخاطرنا في وجبة شهيّة من لحم الخروف الذي ذُبح قِرى للضّيوف، ذهبنا وفي ذهن أخي طه خطّة تجبر الأطفال على الهروب من منطقة الكروم، فقد اصطحب معه سراجا، وقال لي بأن أذهب للجلوس مع أولئك الأطفال، وأن أنتبه للكهف حيث سيشعل السّراج عند بابه بعد عدّة دقائق؛ وأن ألفت انتباه الأطفال إلى ذلك الضّوء، حيث سأهرب عائدا إلى بيتنا وأنا أصرخ متظاهرا بالخوف، وسيهرب الأطفال الآخرون خوفا من العفاريت العملاقة التي تسكنه، وهذا ما حصل.
وصادف أن رأى ذلك الضّوء أحد الرّجال المسنّين السّاكنين في الجهة المقابلة لبيتنا، عندما خرج صدفة من بيته لقضاء حاجته فرأى الضوء أمام الكهف، وشاهد الأطفال الهاربين، وذات يوم عندما كنت طالبا في التّوجيهي، وبينما كان الرّجال يتحدّثون عن الأماكن “المرصودة” ذكر تلك الحادثة، فسردت لهم القصّة الحقيقيّة التي كنت طرفا فيها وشاهدا عليها، فالتفت إليّ وقال بلهجة عاتبة:
اسمع يا عمّي، أنت ولد محترم، وعيب عليك أن تكذب! فهذا ما شاهدتُه.
بعينيّ.
ولم أستطع أن أقنعه أو أقنع غيره بالقصّة الحقيقيّة.
ومن اللافت عندما أضيئت شوارع البلدة بالكهرباء في سبعينات القرن العشرين، أنّ تلك الخرافات قد انتهت، وما عاد لها ذكر؛ لأنّ المنطقة أصبحت مكشوفة لهم، ولم يعد مكان للتّهيّؤات.
لكنّها ما زالت موجودة في مناطق البراري التي يسكنها مربّو الأغنام، ولم تصلها الكهرباء. والحديث يطول عن حكايات الرّعب التي حاكتها الذّاكرة الشّعبيّة حول أماكن كثيرة في البلدة.
اللعب مع العقارب
عندما كنّا نصعد صيفا إلى قمّة جبل المنطار، وهو الجبل الأعلى في براري السّواحرة، ومن قمّته يرى المرء مدن القدس، بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا، وعددا من القرى، كما يمكن رؤية مقام النّبي موسى، والضّفة الشّرقيّة من الأردنّ، ومنها جبال مؤاب جنوب البحر الميّت، كما أنّ البحر الميّت يبدو من قمّة الجبل كصحن فضّيّ عملاق.
عند قمّة ذلك الجبل تتواجد العقارب بكثرة، وغالبا ما تختبئ تحت الحجارة الرّقيقة، كان كلّ منّا يجمع عددا من العقارب، ثمّ نضعها في مساحة صغيرة، فتبدأ بالقتال، ومن الطّريف أنّها كانت تقتل بعضها بعضا، ومن تصمد حتّى النّهاية ولا تجد عقربا تقاتله، كانت ترفع ذنبها وتنحني به تجاه رأسها وتلدغ ذاتها فتموت هي الأخرى.
والغريب أنّ الكبار لم يردعونا أو ينصحونا لترك تلك اللعبة الخطيرة.
ويجدر الذّكر هنا أنّ البعض كان يلجأ إلى شواء عقرب على صاج الخبز حتّى يتفحّم، ويطعمونه للأطفال الرّضع ظنّا منهم أن ذلك يخلق مناعة عند الطّفل من سمّ العقارب.
كما أنّ هناك من كان يعتقد أنّه يمكن شواء الأفعى وأكلها بعد أن يقطع شبرا من عند رأسها ومثله من ذنبها، معتقدين أنّ السّمّ يتواجد في تلك المنطقتين.
محاربة الدبابير:
الدّبور: “حَشَرَةٌ مِنْ فَصيلَةِ الزُّنْبورِيَّاتِ، لكلّ منها جناحان غشائيّان، لَسْعُها أَليمٌ ، أَنْواعُها عَديدَةٌ”. وهذه الحشرات تنتشر في الخلاء وعند أحواض مياه الآبار، كنّا نتسّلح بقطعة من التّنك غالبا ما تكون من أحد الجانبين العلويّ أو السّفليّ لتنكة صدئة ملقاة على قارعة الطريق، أو قطعة من الكرتون أو الخشب غير سميكة، وبمساحة حوالي 30×30سم قد تزيد أو تنقص، نحملها بأيدينا ونلوّح بها في الهواء حيث توجد الدّبابير” الزّنابير” فتلتطم بالدّبّور بقوة، وعندما يسقط، كنّا نخلع رأسه ونرميه، وأحيانا كنا نخلع جسم الدّبور من المنطقة التي تضيق بعد الصّدر، فيبقى حيّا. وكنّا نتعرّض للسعاتها المؤلمة، حيث يتورّم مكان اللسعة. ومن طريف ما حصل معنا ذات يوم، أنّ داود علي المصري الذي يكبرني بعامين قد وضع لنا خطّة لمحاربة الدّبابير، تتمثّل بأن يقوم بنبش عشّها بعصا، فتخرج مذعورة وتحلّق باحثة عمّن هاجمها، وطلب منّا أن ننبطح على ظهورنا، وأن نقتلها وهي تحلّق فوقنا، وعندما نبش عشّ الدّبابير فاعت بأعداد كبيرة، فانبطح وألقى رأسه عند عشّها، وتعرّض لمئات اللسعات في وجهه وراحتي يديه، رأسه ورقبته، فهرع الكبار على صراخه، ونقلوه إلى مستشفى “الهوسبيس” في القدس القديمة، كان رأسه منفوخا كالطّبل من الورم، اختفت عيناه، أنفه وفمه وسط الورم، مكث في المستشفى حوالي أسبوعين حتّى تعافى، ولو تأخّروا في نقله للمستشفى لمات.
الحاوي وقدراته العجيبة!
وفي تلك المرحلة كان من يسمّونه الحاوي، حيث يأتي بأفعى غير سامّة- كما أعتقد الآن-، ويلفّها حول رقبة الطفل ويقرأ بعض التّعاويذ وهذا ما حصل معي، حيث لفّ الأفعى على رقبتي وأنا أصرخ وأرتجف خوفا، ويدفعون له قرشا أردنيّا واحدا أجرة مقابل هذا العمل، ظنّا منهم أنّ من “يحويه الحاوي” سيحميه من الأفاعي مستقبلا. ويبدو أنّ ما جرى معي قد أصابني بالخوف الشّديد “فوبيا” من الأفاعي، لا زلت أعاني منها حتّى يومنا هذا.
ومن الطّريف أنّ ذلك الحاوي، وبينما كان يقوم “بعمله” عند مضارب جماعة من عرب العبيديّة، خرجت أفعى من صيرة الغنم، وطلبوا منه أن يقبض عليها، واستجاب لطلبهم، فلدغته ومات جرّاء ذلك. لكنّهم بقوا يصدّقون الحاوي وقدراته العجيبة في السّيطرة على الأفاعي!
******
في المرحلة الاعداديّة
لم تكن في بلدتنا أيّام دراستنا مدارس إعداديّة لا للبنات ولا للبنين، لذا فتلاميذ السّواحرة الغربيّة يلتحقون بمدرسة صورباهر الإعدادية للبنين، في حين تلتحق البنات بمدرسة بنات سلوان، أمّا أبناء السّواحرة الشّرقيّة فكانوا يدرسون المرحلة الإعداديّة في مدرسة الشّهيد عبد القادر الحسيني في سلوان، – بعد وقوع القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي في حزيران 1967، جرى تغيير اسم المدرسة إلى “مدرسة سلوان الإعداديّة”-، وبعضهم درسوا في مدرسة أبو ديس الاعداديّة.
شكّل انتقالنا إلى مدرسة صورباهر قفزة نوعيّة في أكثر من جانب، فالمدرسة بناء واحد على شكل زاوية قائمة، لا صفوف مستأجرة، الغرف الصّفّيّة واسعة، يجلس على كلّ مقعد طالبان فقط، هناك ملعب يصطفّ به الطّلاب صباحا، ويصلح لبعض الألعاب مثل كرة اليد، وهناك وحدة مراحيض أيضا.
تقع المدرسة غرب القرية، محاذية للمنطقة منزوعة السّلاح “المنطقة الحرام”.
الكندرة الأولى:
انتقلنا وشقيقي ابراهيم إلى مدرسة صورباهر في العام الدّراسيّ 1961-1962، ودرسنا في صفّ واحد، أوّل امتياز حصلنا عليه من الأسرة هو تفصيل “كندرة” لكلّ واحد منّا، لم تكن هناك أحذية جاهزة سوى صنادل الكاوتشوك، والبساطير المستوردة لاستعمالات الجيش وقوى الأمن، والأحذية المستعملة التي تباع في سوق الباشورة، وتأتي من خلال “البُكَج” التي كانت توزّعها وكالة غوث اللاجئين على المخيّمات والقرى الأماميّة.
وبانتعالنا “الكندرة” ودّعنا عالم انتعال صنادل الكاوتشوك. لكن ولسوء حظّي لم تكتمل فرحتي بالكندرة الأولى التي انتعلتها، فقد انطعجت من جانب كعب كلّ فردة منها، ليخرج كعباي منها، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى الألفة بين قدميّ وبين الصّنادل، وأنّني لم أعتد على انتعال حذاء غير الصّندل. لكنّ الأهل عزوا ذلك إلى سبب آخر، وحاولوا اقناعي به، وهو أنّ هناك اعوجاجا وتشويها خَلْقيّا في قدميّ! لكن ذلك لم يحصل مع الحذاء الثّاني الذي انتعلته بعد عام، فاقتنعوا بأنّ قدميّ سليمان لا اعوجاج فيهما.
كنّا نذهب إلى مدرسة صورباهر ونعود منها سيرا على الأقدام صيفا وشتاء.
ورغم كلّ الحرمان الذي عشناه فقد كنّا متفوّقين في الدّراسة، ونحظى باحترام وتقدير معلّمينا ومديرنا.
كما كنّا نسطو على الأشجار في صورباهر خصوصا اللوزيّات ونسرق من ثمارها. كان الأهالي يشكوننا إلى مدير المدرسة المرحوم داود وهبه، الذي كان يغضّ النّظر عنّا في الغالب، وكأنّه كان يشفق علينا. وأحيانا كانوا يعرفون أسماءنا من خلال أبنائهم الذين يدرسون معنا، فيقدّم بعضهم شكوى لمخفر الفرسان الذي كان في القرية، فيأتي رئيس المخفر، ويأخذنا من المدرسة، وهناك يجلدنا بكرباج الخيل، ثمّ يجبرنا على كنس وغسل المخفر بما في ذلك مربط الخيول.
موضوع التّعبير مرّة أخرى
في مدرسة صورباهر شكّل موضوع التّعبير لي مشكلة أخرى، فعندما قرأ معلّم اللغة العربيّة أوّل موضوع إنشاء كتبته، اتّهمني بأنّ شخصا آخر هو من كتب الموضوع لي، ولمّا أكّدت له أنّني أنا كتبته، صفعني على وجهي ولم يقتنع بذلك، لكنّه ما لبث أن اقتنع بعد أن ثبت له بأنّني أعشق لغتي العربيّة، ومتفوّق بدروسي.
خطبة أميرة ابنة عمّي موسى
تصغرني أميرة بنت عمّي موسى ببضعة أشهر، وكنّا نعيش في بيتين متلاصقين، خطبها الكاتب المرحوم خليل حسين سلامة المعروف بخليل السّواحري 1940-2006 عندما كانت تلميذة في الأوّل الاعداديّ، وكان وقتها يعمل معلم مدرسة. تزوّجا بعد أن أنهت أميرة عامها الدّراسيّ.
عندما كان خليل يزور خطيبته، كان يحمل معه أكثر من كتاب وصحيفة ذلك اليوم، كنت آخذ منه صحيفة “الجهاد” التي كانت تصدر في القدس قبل الاحتلال وأقرأها، وأمسك واحدا من المجموعات القصصيّة التي كان يحملها، وأقرأ قصّة منه أو أكثر، فانتبه لي وقال:
هل تقرأ أم مجرّد فضول؟
فأجبته بأنّني أقرأ وأحبّ أن أطالع.
أمسك خليل بيده مجموعة قصصيّة للأديب محمود سيف الدّين الإيراني وقال:
سأعطيك هذه المجموعة القصصيّة؛ لتقرأها بشرط أن تحافظ عليها وعلى نظافتها، وأن تعيدها لي غدا صباحا. فأخذتها إلى مخزن الحبوب حيث أنام، لم أنم حتّى أكملت قراءتها على ضوء لامبة الكاز، أعدتها إليه صباح اليوم التّالي، فأخذ يسألني عن القصّة الأولى في المجموعة، وكما يبدو أنّه قرأها قبلي، وناقشني بها، بعدها قال بأنّه سيأتيني كلّ أسبوع بكتابين، مع التّأكيد على شرط المحافظة عليهما، وأن أعيدها إليه عند استلامي للكتابين القادمين، وهذا ما حصل، وقد استفدت كثيرا من تلك الكتب.
أرضنا لا تنبت فيها الأشجار!
لفت انتباهي وانتباه غيري كثرة الأشجار المثمرة في قرية صورباهر، ومنها اللوزيّات بأنواعها: “كاللوز، البرقوق، المشمش”، العنب والتّين، في حين كانت زراعة الأشجار في بلدتنا تكاد تكون شبه معدومة، فعدا عن بضع عشرات من أشجار الزّيتون المعمّرة في واد شقير، كانت هناك سبع كروم للعنب في واد ذياب على بعد عشرات الأمتار من بيتنا، منها واحد لنا، وهناك بضع عشرات متناثرة من التّين حول بعض البيوت، منها بضع شجرات في محيط بيتنا.
كنت أسأل أبي ومجايليه، واستمرّيت في السّؤال لاحقا عن سبب عدم زراعة الأشجار المثمرة في بلدتنا وكان الجواب:
الأشجار تنبت في أرض الفلاحين ولا تنبت في أرضنا! كانوا على قناعة تامّة بذلك، ولم ينتبهوا لجهلهم بزراعة الأشجار وكيفيّة العناية بها، فاتّهموا الأرض بأنّ الأشجار لا تنبت فيها.
لكنّ جيلنا انتبه لذلك وزرع مئات آلاف الأشجار المختلفة، كما زرعت حدائق الورود أمام البيوت، وعمليّة الحفاظ على الأشجار والورود لاقت عراقيل كثيرة في البداية، نتيجة للعقليّة الرّعويّة التي ترسّخت لدى جيل الآباء والأجداد؛ لأنّ القيمة للماشية والدّواب وليس لأيّ نوع من الأشجار والورود.
وللأمانة التّاريخيّة فإنّ أحدا لا يستطيع أن ينكر فضل ودور المرحوم داود علي أحمد عبده، الذي اتّفّق في أواخر خمسينات القرن العشرين مع موظفين كبار في وزارة الزّراعة الأردنيّة؛ لتشجير أراضي عرب السّواحرة برعاية الوزارة وتحمّلها تكاليف ذلك، وتحت إشراف مهندسين زراعيّين، لكنّه واجه معارضة واسعة من الأهالي، وبصعوبة استطاع تشجير جزء من أراضي عائلته -عائلة عبده- إحدى عائلات حامولة العويسات في منطقة “الخارجة” في جبل المكبر، حيث زرعت بالزّيتون والبرقوق وبطريقة هندسيّة لافتة.
اسمي في الصّحافة
وأنا في الصّفّ الثّاني الاعداديّ بعثت خاطرة عبر البريد لصحيفة تصدر في مدينة القدس، ونشرتها تحت باب “بأقلام القرّاء”، أعطاني العدد الذي نشرت فيه خاطرتي معلّم اللغة الانجليزية عادل ناصر، وأثنى عليّ ونصحني بالاستمرار في الكتابة، كدت أطير فرحا لرؤية اسمي في صحيفة، وواصلت الكتابة، وواصل الأستاذ عادل ناصر إعطائي عدد الصّحيفة الذي تنشر خاطرتي فيه. وحظيت باحترام معلّمي وطلاب المدرسة.
في المنطقة الحرام
في فصل الرّبيع كنّا- أبناء السّواحرة- نقتحم المنطقة الحرام الفاصلة بين قرية صورباهر واسرائيل، نقتحمها بحثا عن الزّعتر والجعدة الخضراء، نقطفها فنأكل منها ونحمل الباقي معنا إلى بيوتنا، كان أفراد من الحرس الوطنيّ الأردنيّ يتصدّون لنا ويطردوننا من المنطقة؛ لأنّ فيها حقول ألغام، لكنّنا لم نصدّق ذلك.
بعد سنوات وبعد وقوع المنطقة تحت الاحتلال في حرب حزيران 1967 دخلها المرحوم أحمد علي حسين عبده مع قطيع أغنامه، فانفجرت بعض الألغام، فخسر أحد قدميه وعددا من أغنامه.
وبما أنّنا لم نرتدع عن دخول تلك المنطقة الخطيرة، اضطر الجيش إلى وضع عدد من الجنود على أطرافها، في “فرصة الغداء” التي كانت تمتدّ لساعة ونصف، ليمنعنا من دخولها حفاظا على حياتنا.
حصّة الرّياضة
كان مدير المدرسة داود وهبة –رحمه الله- رياضيّا، بحيث كان ينزل للعب مع التّلاميذ في حصّة الرّياضة، وقد فرض على الطلاب أن يرتدوا سراويل رياضيّة قصيرة، في ذلك الوقت أخذنا أبي أنا وشقيقي ابراهيم، وأخانا أحمد الذي كان في الصّفّ الثّالث الاعداديّ، إلى خيّاط في القدس، وفصّل لكلّ واحد منّا بنطال رياضة قصير، من قماش “كاكي” أبيض، وعلى جانبه الأيمن من الخلف جيب، كنّا مميّزين بين الطلاب جميعهم بتلك البناطيل، التي طلب المدير ومعلّم الرّياضة أن يشتري كلّ تلميذ بنطالا شبيها لها، لكنّ ذلك لم يتحقّق.
بعض التّلاميذ وضعوا جيبا لسراويلهم الدّاخليّة المصنوعة من قماش “المالطي” رخيص الثّمن، أو من خريطة الطّحين الأمريكيّة، ظنّا منهم أنّ الجيب سيوهم المدير بأنّ “الكلسون” بنطال! وذات يوم أمسك المدير “ببنطال” أحدهم وسحبه من “دكّته” المطّاطيّة إلى الخلف؛ ليرى إذا ما كان يوجد تحته سروال داخليّ، ولمّا لم يجد شيئا تحته، بصق على مؤخّرة ذلك الطالب وهو يشتم من خلّفوه.
انج سعد فقد هلك سعيد
في منتصف شهر آذار-مارس- 1962 لم يعد أخي أحمد يلتزم بالدّوام المدرسيّ، بعد أن ضمن أنّه قد تمّ تسجيله لامتحان “مترك الاعدادي”، فغضب مدير المدرسة غضبا شديدا جرّاء ذلك، لأنّ النّظام التّعليمي يلزم طلبة الصّف الثّالث الاعداديّ على الدّوام حتّى منتصف شهر أيّار-مايو-، فطردني المدير أنا وشقيقي ابراهيم كي نحضر أخانا أحمد للدّوام، كان أبي وأمّي يسكنان البراري مع الأغنام، ولا نملك أيّ سلطة لاجبار أخينا أحمد على أيّ شيء، وفي صباح اليوم التّالي، وبينما كان طلّاب المدرسة في الاصطفاف الصّباحيّ، اقترب المدير من شقيقي ابراهيم وسأله:
أين أخوك أحمد؟
– لم يستجب لنا ولم يحضر.
فانهال المدير شتما وضربا على ابراهيم وطرده من المدرسة، وعندما اتّجه نحوي هربت، وخرجت من ملعب المدرسة وهو يركض خلفي، وعندما عاد إلى هدوئه، تسلّلت إلى غرفة الإدارة، طرقت الباب، وتكلّمت معه دون أن أدخل، فقلت له:
لو سمحت اسمعني، وبعد ذلك اعمل ما تشاء.
بقي جالسا على كرسيّه واستمع فقلت له:
أمّنا وأبونا في البرّيّة مع الغنم، وأحمد أكبر منّا عمرا وقوّة، هو يضربنا في البيت، وأنت تضربنا في المدرسة، فماذا يمكننا فعله ولم نفعله؟
عاد إلى هدوئه بطريقة لافتة، ابتسم لي وقال:
لا حول ولا قوّة إلا بالله، اذهب أنت وأخوك ابراهيم إلى صفّكما.
بين الكبير والصّغير
بعد شهرين من دوامنا المدرسيّ في مدرسة صورباهر، وكان مدير المدرسة يعلم مادّتي التّربية الاسلاميّة والجغرافيا لطلّاب المرحلة الاعداديّة، جاء طالب من الصّفّ الثّالث الاعداديّ إلى صفّنا “الأوّل الاعداديّ” واستأذن من معلم الرّياضيّات قائلا:
المدير يريد “السّلحوت الصّغير” يعني يريدني أنا، ذهبت معه إلى الصّف الثّالث الاعداديّ، وكان المدير واقفا بجانب اللوح وأخي أحمد يقف بجانبه، كتب لي على اللوح القسطنطينيّة، وكتب بجانبها Constantinople
وطلب منّي أن أقرأ الكلمتين العربيّة والانجليزيّة، فقرأتهما، ثمّ كتب بجانبها استانبول، وطلب منّي أن أردّد الكلمات الثلاثة عشر مرّات ففعلت، ثمّ انهال ضربا على أخي أحمد؛ لأنّه كان يتلعثم بقراءة كلمة “القسطنطينيّة”! وكانت هذه الحادثة سببا كافيا؛ ليضربني أخي أحمد ضربا مبرحا أثناء عودتنا من المدرسة وفي البيت؛ لأنّه اعتبرني سببا في ضرب المعلّم له! وهذه ورطة أوقعني بها المدير دون ذنب منّي.
والشّيء نفسه حصل عندما كان المعلّمون في الصّف يوجّه الواحد منهم السّؤال لأخي ابراهيم الذي يكبرني بعام بقوله له: سلحوت كبير، وإذا لم يعرف الإجابة يحوّل السّؤال إليّ بعده مباشرة بقوله: سلحوت صغير، وعندما أعرف الجواب يعاقب المعلّم أخي ابراهيم بالضّرب، وهذا عرّضني مرّات كثيرة “للثّأر” منّي! وطريقة المعلّمين هذه بالسّؤال عانيت منها في الصّف الأوّل الابتدائيّ مع أخي طه أيضا، وبقيت أعاني منها حتّى نهاية المرحلة الاعداديّة، حيث درست في المدرحلة الثّانويّة للمرّة الأولى في صفّ دراسيّ لا إخوة لي فيه.
الالتزام بالدّوام
درسنا المرحلة الاعداديّة كاملة في مدرسة صورباهر، كنّا نذهب إلى المدرسة ونعود منها مشيا على الأقدام في تقلّبات الطّقس جميعها، علما أنّ باصات جنوب الضّفّة “بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا، الخليل، قرى العرقوب”، جميعها تمرّ من الشّارع في طريقها إلى القدس، أو عائدة منها، فالقدس هي المركز، ومنها يجري السّفر إلى المدن الأخرى ومنها عمّان، أجرة الباص للرّاكب من جبل المكبّر إلى صورباهر أو بالعكس كانت قرشا أردنيّا واحدا، بعض الآباء ومنهم أبي كانوا أغنياء نسبيّا، لكنّهم يريدون أن يشبّ أبناؤهم وقد اعتادوا قسوة الحياة، أو على رأيهم “نحن نربّي رجالا”، ومع ذلك لم نتأخّر يوما ولو لدقيقة واحدة عن الحصّة الأولى، وفي الأيّام الماطرة كنّا نصل المدرسة وملابسنا تقطر ماء.
كانت في السّابعة من صباح كلّ يوم اثنين تمرّ شاحنة تموين للجيش الأردنيّ في طريقها إلى الجنوب مارّة بالمكبر وصورباهر، وتعود في حدود السّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر، يشفق علينا سائقها والضّابط الذي يجلس بجانبه، فتتوقّف لنا وتقّلنا في صندوقها المفتوح من الخلف، الذي كانت تتكدّس فيه ذبائح مجمّدة، ملفوفة بخرق بيضاء شفّافة، وفي الأسبوع الأوّل من التحاقي بمدرسة صورباهر، ركبت في صندوق تلك السّيارة، واتّكأت على الذّبائح، فاكتسى بنطالي “الكاكي” بزيوت الشّحوم، واكتسى بنطالي من الخلف ببقعة زيت لم تذهب بالغسيل، أو بالأحرى أنّ الأهل لم يكونوا على دراية بموادّ الغسيل التي تزيل الزّيوت. وأكملت عامي الدّراسيّ بذلك البنطال، حتّى بات من يراني يظنّ أنّي أتبوّل بملابسي، لم أغيّر ذلك البنطال لعدم وجود بديل له. واللافت أنّ طلابا ممّن سبقوني في الدّراسة بسنوات، قد مرّوا بالتّجربة نفسها، لكنّهم لم يحذّروني منها!
ولادة شقيقي داود
منذ دراستي في الصّف الأوّل الابتدائيّ، وأمّي ترافق أبي مع الغنم في البراري، ونبقى أنا وشقيقي ابراهيم برعاية زوجة أبي، كانوا يذهبون إلى البرّيّة، ويسكنون بيت الشَّعَر في حدود منتصف شهر تشرين الثّاني-نوفمبر- مع بداية موسم ولادة الأغنام، ويعودون منها في شهر حزيران بعد أن ينتهي موسم الحليب، وتبقى الأغنام في البراري مع الرّاعي، وفي 30 كانون الثّاني –يناير- 1963 أنجبت والدتي شقيقي داود في “جوفة المنطار” أمام “مغارة الشّاعر” التي اعتدنا السّكن أمامها، حيث توجد “صيرة” للأغنام أمام المغارة، وسبب اختيار هذا المكان هو قربه من آبار المياه مثل “بئر المنطار، البطانه، السّوق، والخرما”، التي نملك الجزء الأكبر منها، كما أنّها تقع في التواء جبليّ يحميها من الرّياح العاصفة شتاء، كان يسكن قريبا منّا الخال علي علان شقير، وعبدالله علي سلامة شقيرات، أنجبت أمّي شقيقي دواد وهي تغربل “التّبن” لتنقيته من “الموص” الذي يتسبّب بأمراض الرّئة للمواشي، ولدته وهي وحيدة قبل أن تصل إليها جارتاها، اللتين قطعتا “سُرّة” المولود. كانت الفرحة كبيرة بمولد داود، لأنّه جاء بعد خمس بنات متتاليات، في مجتمع ذكوريّ لا يحبّذ ولادة البنات، وحفاظا على حياة المولود الجديد، تمّ استبدال أمّي بزوجة أبي، فعادت والدتي إلى بيتنا الحجريّ في جبل المكبّر، لترعى طلاب وطالبات المدارس من أبنائها وأبناء ضرّتها. ولفرحة أبي بداود، -علما أنّه كان لديها ولدان قبل داود- فإنّه أصبح يكنّي أمّي بـ “أمّ داود” مع أنّ داود هو ابنها الثّالث، تماما مثلما كان يكنّي زوجته الأولى “أمّ أحمد” مع أنّ أحمد هو ابنها الثّالث أيضا.
أنا والذّئب:
عندما كان شقيقي داود ابن سنة تقريبا، أصابه مرض صاحبه ارتفاع بحرارة جسمه، أخذوه إلى طبيب تخرّج من الجامعة حديثا، فأعطاه دواء جعل حالته الصّحّيّة تزداد سوءا، تغلّبت عليه الحرارة فطرحته بشكل يشبه الغيبوبة، خافوا عليه من الموت في غياب الوالد، فأرسلوني بعد عودتي من المدرسة لإخبار الوالد بحالة داود، وصلت مضاربنا في “جوفة المنطار” بعد غروب الشّمس، أخبرت الوالد بأنّ داود في مرحلة حرجة جدّا، فلطم كفّا على كفّ، ولسوء حظّي فقد وجدت الرّاعي في إجازة، وقد غادر المكان قبل وصولي بدقائق قليلة، كان موسم ولادة الأغنام، وقد أنجبت إحداها خروفا، والخروف الأوّل جرت العادة أن نذبحه للعائلة في فصل الرّبيع، أعطاني الوالد التّعليمات بكيفية الحفاظ على الأغنام التي سأنام معها، مقابل “صيرتها” هناك مكان جرى تسهيله كمكان نوم للرّاعي، الفراش كيس خيش، الغطاء بطّانية مخاطة على شكل عباءة، والوسادة ” حِلْس” الحمار، ربط الوالد الخروف الوليد بحلس الحمار؛ ليكون قريبا منّي هو ووالدته، لأنّ الذّئب عندما يسطو على القطيع يحمل واحدا من الخراف الصّغيرة ليستطيع الهرب به، انتعلت بسطارا ونمت دون أن أخلعه –حسب التّعليمات- وعليّ أن أكون حذرا حتّى لا يغافلني الذّئب ويفتك بالقطيع، تمتم الوالد ببعض التّعاويذ والرّقى لتحمي الأغنام من الذّئاب، ثمّ امتطى البغل وعاد مسرعا إلى البيت في جبل المكبّر، استيقظت في الصّباح بقدمين متعبتين وقد هدّهما البسطار، لم أجد الخروف، فقد اختطفه الذّئب دون أن أستيقظ على ذلك.
وعندما عاد ابن العمّ ابراهيم موسى من عمله، حمل داود إلى مستشفى الأطفال في حارة السّعديّة في القدس، أعطوه هناك دواء، فتحسّنت حالته سريعا، وفي اليوم التّالي تعافى تماما، فعاد الوالد إلى الأغنام، وعندما لم يجد الخروف قال ساخرا: “مليح ما خطفك الذّيب انت والخروف”.
مترك الثّالث الإعداديّ
لا أعرف بالضّبط فلسفة وزارة التّربية والتّعليم في تلك المرحلة، وما كانت تهدف إليه بعمل امتحان عامّ في نهاية المرحلتين الابتدائيّة والإعداديّة، حيث يتوقّف أو ينتهي المستقبل التّعليميّ للطالب الذي لا يحالفه الحظّ بالنّجاح فيهما، فلم يكن السّوق بحاجة إلى أيد عاملة ليتمّ رفده بها، بل العكس هو الصّحيح، حيث كانت البطالة متفشّية.
صحيح أنّ قانون التّعليم الالزامي ابتدأ بالمرحلة الابتدائيّة، ثمّ تطوّر ليشمل المرحلة الاعداديّة، إلى أن وصل في أيّامنا هذه إلى الى نهاية المرحلة الثّانويّة، مع أنّه لم يكن ولا يزال هناك تطبيق لهذا القانون، فهناك أشخاص لم يكملوا مرحلة التّعليم الالزامي، ولكلّ أسبابه التي تتراوح بين الجهل والتّخلّف الاجتماعيّ، وبين الوضع الاقتصاديّ للأسرة. إلا أنّه في تقديري أنّ الحكومات كانت معنيّة بالتّخلص من تعليم جزء من الطلبة لأوضاع اقتصاديّة أيضا، والتي تتمثّل بالنّقص الحادّ في غرف التّدريس، وما يتبع ذلك من رواتب المعلّمين ومتطلّبّات العمليّة التّعليميّة.
المهمّ أنّني وأخي ابراهيم وطلّاب صفّنا في مدرسة صورباهر الاعداديّة للبنين، خصّصوا لنا قاعة لتقديم امتحان “مترك” الثّالث الاعدادي في مدرسة الفرير، الواقعة عند الباب الجديد داخل سور القدس القديمة، لم يكن الوصول إلى تلك المدرسة ممكنا من خارج السّور عن طريق باب العمود أو من باب الخليل، مع أنّ المسافة بين البابين وبين الباب الجديد أقلّ من مائتي متر، لأنّ الجانب الغربيّ من سور القدس حيث يقع باب الخليل، وما بين باب العمود ومنطقة الباب الجديد من الجهة الشّماليّة كانت تحت السّيطرة الاسرائيليّة، وكان البابان “الجديد وباب الخليل” مغلقان بالإسمنت منذ نكبة الشّعب الفلسطينيّ في العام 1948. كان هناك سور يمتدّ شمالا من جانب باب العمود شمالا حتّى نهاية شارع المصرارة، وبارتفاع حوالي خمسة أمتار، ليشكّل حدّا فاصلا بين الجانبين العربيّ والاسرائيليّ،- هدمه الاسرائيليّون مباشرة بعد وقوع القدس الشّرقيّة تحت الاحتلال في حرب حزيران 1967-.
لذا فإنّ أقرب طريق للوصول إلى مدرسة الفرير كانت من باب العمود، أو من باب المغاربة، ومن هناك عبر حارة النّصارى.
ومن ساحة تلك المدرسة كنّا نصعد إلى سور القدس، نقف أمام “الطّلّاقات” الموجودة في السّور، ننظر إلى ما بات يعرف بعد النّكبة بالقدس الغربيّة، الواقعة تحت السّيطرة الاسرائيليّة. كان الجنود الأردنيّون الذين يحرسون المنطقة يمنعوننا من ذلك، بحجّة الأمن العامّ والشّخصيّ.
اجتزنا الامتحان ولم يرسب من صفّنا أحد، وكنت أنا من الطّلبة المتفوّقين على مستوى المملكة.
المرحلة الثّانويّة
لم تكن في القرى مدارس ثانويّة باستثناء قرية بدّو شمال غرب القدس، حيث توجد فيها مدرسة الملك غازي الثّانويّة التي يدرس فيها أبناء قرى تلك المنطقة، لذا فغالبيّة أبناء القرى يتوجّهون للمدن لإكمال تعليمهم الثّانويّ، وفي مدينة القدس كانت المدرسة الرّشيديّة الثّانويّة للبنين، كما كانت هناك مدرستان ثانويّتان خاصّتان، هما المدرسة الابراهيميّة لصاحبها المرحوم نهاد أبو غربيّة، والمدرسة القبطيّة التي تتبع للكنيسة القبطيّة، والأخيرتان كانتا تدرّسان المنهاج المصريّ، وهناك مدرسة أخرى هي “المعهد العلميّ الاسلاميّ” وهي تتبع وزارة الأوقاف، كما كانت مدارس خاصّة تابعة للكنائس مثل: الفرير والمطران للبنين، وشميت وراهبات الورديّة للبنات، يدرس فيها أبناء وبنات الأثرياء لأنّها تتقاضى رسوما مرتفعة. مع التّذكير بوجود المدرسة المأمونيّة الثّانويّة للبنات، ومدرسة دار الطّفل العربيّ التي كانت ولا تزال تشمل المراحل التّعليميّة جميعها.
عيني مرّة ثالثة
رغم أنّني كنت من الأوائل في “مترك الاعداديّة” إلا أنّ ذلك لم يعجب أبي –رحمه الله-، فرغم حرصه على تعليم أبنائه الذّكور جميعهم ما دامت لديهم القدرة على التّعليم، إلا أنّ خسارتي لعيني قد شكّلت عقدة له أكثر منّي أنا، فقد كان يتمنّى صادقا بأنّه لو خسر هو عينه وبقيت عيني أنا لكان أهون عليه، لكنّه كان على قناعة تامّة بأنّ التّعليم لن ينفعني بشيء بسبب فقداني لعيني اليسرى، ومن شدّة حبّه لي، وحرصه على مستقبلي -حسب قناعاته-
فقد عاد مرّة أخرى إلى فكرة زواجي، وأن يعطيني عددا من الأغنام ومساحات من الأرض الزّراعيّة يكفي لتوفير العيش الكريم لي، ومن منطلقاته هذه سمعته يقول لأمّي تعقيبا على تفوّقي بمترك الاعداديّة:
” والله لو بدنا إيّاه يتعلّم ما نجح”!
آلمني قوله هذا إلى درجة البكاء على حالتي، تساءلت عن سبب قناعاتهم تلك؟ فأنا لم أعتبر نفسي يوما أقلّ من الآخرين، وفقداني لعيني اليسرى لم يقف حاجزا بيني وبين التّفوّق في المدرسة.
تزوّجتْ قريبتي التي تكبرني بثماني سنوات وأنا في الصّفّ الأوّل الاعداديّ، وهي التي عرضوا عليّ الزّواج منها بعد أن أنهيت الصّفّ السّادس الابتدائيّ، فعرض عليّ أبي أن أختار واحدة من بنات البلدة، صار يعدّد لي أسماء بعض البنات التي تتوفّر فيهنّ الجهامة، والبنية القويّة، لأنّه يريدها لي عاملا يساعدني على الحياة أكثر منها زوجة.
رفضت فكرة ترك المدرسة أو الزوّاج مهما كلّفني ذلك، فأنا أريد أن أكمل تعليمي.
ويبدو أنّ الموقف المضادّ لتعليمي شكلّ حافزا لي للتّمسّك بالمدرسة، فبدأت العقوبات ضدّي لاجباري على ترك المدرسة والقبول بالزّواج.
العقوبات كي أترك المدرسة
كانت رسوم التّسجيل السّنويّة في المدارس الثّانويّة ربع دينار أردنيّ، اشترى أبي لأخي أحمد الذي كان في التّوجيهيّة، ولشقيقي ابراهيم كسوة بداية العام الدّراسيّ، وأعطاهما الرّسوم المدرسيّة ومصروفا يوميّا، لكنّه لم يبتع لي كسوة، ولم يدفع لي الرّسوم المدرسيّة مثلهما، رفض أن يعطيني الرّسوم كورقة ضغط عليّ لترك المدرسة، علما أنّني عملت في العطلة الصّيفيّة في الآثار في سلوان، بثلاثين قرشا يوميّا، كنت كما بقيّة عمّال الآثار نقبض كلّ أسبوعين مرّة، وأعطي ما أقبضه لأبي.
كظمت غضبي وحزني وألمي ودموعي وجراح قلبي الغائرة، ومشيت إلى المدرسة الرّشيديّة، لكنّ المدير طردني مع مجموعة من الطّلاب الذين لم يدفعوا الرّسوم! طردنا وهو يهدّد وفي يده عصا:
لن يدخل المدرسة طالب واحد دون أن يدفع الرّسوم.
عدت إلى البيت حزينا، وتوسّلت لأمّي، لأنّني كنت أشعر بحنانها وعطفها عليّ، كي تدبّر لي ربع الدّينار، فردّت عليّ بدموعها وهي تقول:
“مِنْ وين أجيبهن يمّه؟”
لكنّني لم أيأس، فعدت في اليوم الثّاني والثّالث إلى المدرسة الرّشيديّة دون جدوى، في اليوم الرّابع لم أجد أمام غرفة الإدارة أيّ طالب غيري، فتشجّعت ودخلت غرفة الإدارة رغم محاولة “الفرّاش” الذي يقف أمام الإدارة منعي، شرحت للمدير قصّتي وأنا أبكي وقلت له في النّهاية:
أريد أن أتعلّم، ووالله سأدفعها عندما أعمل في العطلة الصّيفيّة القادمة.
فردّ عليّ غاضبا:
انصرف فقد مرّ عليّ نصّابون كثيرون!
خرجت خائبا من غرفة إدارة المدرسة، بكيت حالي، فقد سدّت كلّ الطّرق أمامي، جلست على رصيف الشّارع أمام المدرسة الرّشيديّة، لم أستطع منع نفسي من البكاء، فقد شعرت بالذّلّ والإهانة، لم يرحمني أو يساعدني أحد، ضاقت بي الدّنيا على سعتها، فكّرت كثيرا بالهروب من منطقة القدس كلّها إلى منطقة لا يعرفني فيها أحد، وأن أبحث عن عمل هناك. راودتني فكرة السّفر إلى مدينة العقبة الأردنيّة، حيث كان نفر ممّن أعرفهم من أبناء البلدة يعملون هناك في البناء بأجرة يوميّة تصل إلى نصف دينار يوميّا، ولم يمنعني من تنفيذ فكرتي سوى أنّني لا أملك أجرة المواصلات لتلك المدينة.
إلى المعهد العلميّ الاسلاميّ
على غير موعد مرّ بي طالب من قريتي مفصول من المدرسة الرّشيديّة لتكرار رسوبه في الصّف الأوّل الثّانويّ، ولمّا أجبته عن سبب بكائي وحزني قال لي:
أنّه أنهى الصّفّ الأوّل الثّانويّ في مدرسة دينيّة تعطي ثلاثة دنانير ونصف راتبا شهريّا لكلّ طالب من طلّابها، ويعمل من يتخرّج منها إمام مسجد، وهي تعطي شهادة ثانويّة شرعيّة، ويستطيع خريجوها الالتحاق بالجامعات لدراسة الشّريعة أو اللغة العربيّة، فما رأيك أن تلتحق بها؟
لم أحتج إلى وقت للتّفكير، فقد وجدتها فرصتي الوحيدة السّانحة أمامي، مشى معي إلى أن أوصلني باب المدرسة الواقعة في باب السّلسلة خارج المسجد الأقصى، أوصلني هناك ولم يدخل معي؛ لأنّه كان متغيّبا عن الدّوام المدرسيّ.
عبرت بوّابة المدرسة المهيبة، والتي تشبه بوّابات سور القدس، في واجهتها المقابلة للباب الرّئيسيّ محراب مزركش بالفسيفساء، وهو يطلّ مباشرة على حائط البراق- الحائط الغربيّ للمسجد الأقصى- والبناية كلّها محاذية للمسجد الأقصى، بل إنّ حائطها الشّرقيّ جزء من رواق المسجد الأقصى الغربيّ، أمام المحراب مصلّى مفروش بالحصر، على كلّ من يمينه ويساره غرفة واسعة، في وسط البناية بهو واسع يمتدّ شرقا وغربا، في وسطه نافورة قديمة لا تعمل، وفي نهاية جهته الغربيّة غرفة، وقبلها وحدة حمّامات، على يسار الدّاخل من البوّابة الرّئيسيّة غرفة مستحدثة تستعمل كغرفة للإدارة وللمعلّمين، ومن جهتها الشّرقيّة غرفة أخرى قديمة.
وفوقه طابق بنفس المساحة كانت على بابه لافتة مكتوب عليها ” مقرّ المؤتمر الاسلامي”.
دخلت غرفة المدير المرحوم عبد القادر قدّورة، وهو من أصول جزائريّة، طرحت عليه السّلام، فردّ التّحيّة بأحسن منها، رحبّ بي، وقفت أمامه لأطلب منه أن يسجّلني في المدرسة، لكنّه قال لي قبل أن أنطق بأيّ كلمة وهو يشير بيده إلى كرسيّ:
تفضّل اجلس يا ابني.
فشعرت بالاطمئنان وارتحت نفسيّا.
ولمّا أعلمته بما أريد، شجّعني وسألني:
هل لديك شهادة تثبت نجاحك بمترك الاعداديّة؟
فأجبته: نعم لديّ لكنّها في البيت.
فقال لا يهمّ، أحضرها معك صباح غد مع شهادة ميلادك.
سجّل اسمي أمامه، ثمّ وقف أمام خزانة كتب، أخرج لي كتب المنهاج المقرّرة للصّفّ الأوّل الثّانويّ، سلّمني إيّاها، ثمّ اصطحبني إلى غرفة الصّفّ الدّراسيّ، وأدخلني فيها وهو يقول للمعلّم:
هذا طالب جديد.
في الصّفّ كان طالبان من الجزء الشّرقي من قريتي هما سعود محمد قاسم السّرخي ويوسف محمد أحمد جعفر، جلست بجانب أحدهما، وبعد عدّة أيّام التحق بنا طالب آخر من جبل المكبّر هو خضر عبدالله أبو اصبع، وثلاثتهم تركوا المدرسة قبل نهاية العام الدّراسيّ.
عدت بعد انتهاء الدّوام المدرسيّ إلى البيت وأنا أحمل كتبي فرحا، شرحت لأسرتي عن المدرسة التي التحقت بها، فتقبّل أبي ذلك قبولا حسنا، فمن الممكن أن يعمل المرء إماما لمسجد إذا كان بعين واحدة أو كفيفا.
المنهاج الدّراسيّ
كان هدف وزارة الأوقاف من تأسيس هكذا مدرسة، هو إيجاد أئمّة للمساجد، مؤهّلين إلى حدّ ما، حتّى لو بتعليمهم المرحلة الثّانوية؛ ليكونوا بديلين لأئمّة المساجد أشباه الأمّيّين من خرّيجي الكتاتيب، وإن لم تخنّي الذّاكرة فإنّ المدرسة تأسّست في العام 1958م، وصاحب تخريج الفوج الأوّل منها تأسيس معهد شرعيّ متوسّط في عمّان، الدّراسة فيه لمدّة سنتين، وما لبث أن تحوّل إلى كلّيّة جامعيّة ألحقت بالجامعة الأردنيّة في عمّان.
ولتحقيق الأهداف التي تأسّست من أجلها المدرسة، فقد طبّقوا عليها المنهاج المعمول به في المدارس الشّرعيّة لجامعة الأزهر في القاهرة. وهذا المنهاج يعتمد التّركيز على المواضيع الشّرعيّة واللغة العربيّة، فكانت هناك كتب شرعيّة مثل: ” حفظ أجزاء من القرآن غيبا، وترتيله وتجويده، الوعظ والارشاد، أصول الفقه حسب مذهب الإمام أبي حنيفة، رسالة التّوحيد، علم المنطق وغيرها، وفي اللغة العربيّة كان المقرّر كتاب النّحو ” شرح شذور الذّهب” للسّنة الأولى، و”ألفيّة بن مالك” للسّنتين الثّانية والثّالثة، إضافة إلى كتاب “المطالعة والنّصوص” المعمول به في المدارس الحكوميّة”. كما كانت هناك حصّة للتّعبير، لكن لم يكن هناك أيّ تعليم للموادّ العلميّة لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك لم يكن هناك تعليم للغة الأجنبيّة “الانجليزيّة”، ممّا حرم الطّلاب من الحصول على الثّانويّة العامّة “التّوجيهي” حسب نظام التّعليم الرّسميّ، واكتفت المدرسة بأن يحصل خريجوها على “الثّانويّة الشّرعيّة” التّي تؤهّلهم للالتحاق بكلّيّة الشّريعة، أو بكلّيّات الآداب لدراسة اللغة العربيّة وآدابها في جامعة الأزهر، أو أن يكتفي الطالب الخرّيج بالثّانويّة الشّرعيّة، ويعمل كإمام مسجد.
ولأهمّيّة “التّوجيهي” في حياة الطّالب، ولتأهيله لدخول الجامعة ودراسة ما يريد، فقد انتبه القائمون على المدرسة لذلك، فأضافوا إلى المنهاج اللغة الانجليزيّة لطلاب السّنة الأولى “الأوّل الثّانويّ” اعتبارا من العام الدّراسيّ 1964-1965، أيّ الفوج الذي كنت أنا فيه، لندرسه أيضا في السّنتين اللاحقتين، كما قرّروا للسّنتين الثّانية والثّالثة المواد العلميّة المقرّرة للفرع الأدبيّ، حسب المنهاج الحكوميّ المعمول به، وفي السّنة الثّالثة أضافوا موادّ التّاريخ العربيّ والقضيّة الفلسطينيّة، الجغرافيا والفلسفة.
والحقّ يقال بأنّ خريجي هذه المدرسة قد اكتسبوا قوّة لافتة في اللغة العربيّة، إضافة إلى التّفقّه بأمور الدّين. فكتاب النّحو على سبيل المثال “شرح شذور الذّهب”، الذي درسته في تلك المدرسة، لمؤلّفه العالم اللغويّ جمال الدّين أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن الشَّيْخ جمال الدّين يُوسُف بن أَحْمد بن عبد الله بن هِشَام الْأنْصَارِيّ، كان مقرّرا لطلبة اللغة العربيّة في السّنة الثّالثة في جامعة بيروت العربيّة التي درست فيها.
ولتمييز المدرسة عن بقيّة المدارس فقد أسموها ” المعهد العلميّ الاسلاميّ”، بعد وقوع القدس تحت الاحتلال الاسرائيليّ في حرب حزيران 1967، جرى تغيير اسم المدرسة إلى ثانويّة الأقصى الشّرعيّة، كما جرى تأسيس مدرسة أخرى للبنات، وافتتحت فروع أخرى للمدرسة في مناطق أخرى مثل نابلس وجنين. كما جرت تغييرات على المنهاج الذي أصبح مطابقا للمنهاج الحكوميّ.
ومّما جاء في الموسوعة الفلسطينيّة:
“تقع المدرسة التنكزيّة في مدينة القدس، عند باب الحرم الشريف، وهو الباب المعروف بباب السلسلة. وقد أتمّ بناءها سنة 729هـ/1328م الأمير تنكز بن عبد الله الملكي الناصري الملقب بأبي سعيد نائب المماليك على بلاد الشام.
وقد مرّت على هذه المدرسة عدّة عهود. فقبل أن تكون مدرسة كانت خانقاه للصّوفيّة، ثم دارا للحديث فدارا للأيتام. ولم تصبح مدرسة مشهورة إلا في عهد المماليك عندها أنهى بناءها الأمير تنكز، فأصبحت تعرف باسمه. ثم اتّخذها دارا لسكن القضاة والنّواب في شرعيّة وبقيت كذلك حتّى أوائل عهد الاحتلال البريطانيّ، فاتّخذها مدرسة لتعليم الفقه الإسلامي.
في هذه المدرسة كتابات منقوشة فوق الباب الشّماليّ وفي داخلها. فعلى الباب الشّمالي الكلمات التّالية: “بسم الله الرحمن الرحيم، أنشأ هذا المكان المبارك راجيا ثواب الله وعفوه المقرّ الكريم السّيفي تنكز المالكيّ النّاصريّ عفا الله عنه وأثابه، وذلك في شهور سنة تسع وعشرين وسبعمائة”.
أمّا النّقش الموجود في داخلها فيقول:” البيت الحرام أوّل مسجد وضع على وجه الأرض، واختار لعبادته مواطن الاقامة السّنن والفرض، وجعل هذا المسجد جار المسجد الأقصى ونعم الجار الطّاهر، وأجرى لبنّائيه جزيل الثّناء والثّواب الوافر، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). اختار لعمارة بيوته من رضي فعله وقوله وأطال بالسّعد والبذل طوله”. وهذا النّقش يدلّ بوضوح على أنّه كان في هذه المدرسة مسجد.
وتذكر المراجع الكثير من كبار العلماء المقدسيّين الذين درسوا في هذه المدرسة. كما كان لها في القدس أوقاف، منها “نصف الحمّام المعروف بحمّام العين، والكائن بسوق باب القطانين، وقف على المدرسة التّنكزية والنصف الآخر وقف على الصّخرة”.
وفي سنة 1969م، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيليّ بالاستيلاء على البناء،
و”ضمن إجراءاته في تغيير معالم القدس وتهويدها بتحويل مصلى المدرسة التّنكزية – الواقع ضمن حدود المسجد الأقصى والمشمولة ضمن الجدار الغربي للمسجد الأقصى – إلى كنيس يهودي”.
وانتقلت مدرسة ثانوية الأقصى الشّرعيّة إلى الرّواق الشّمالي للمسجد الأقصى، قريبا من باب الأسباط.
الجبّة والعمامة
واللافت في هذه المدرسة أنّها كانت تجبر طلّابها على ارتداء الجبّة ووضع العمامة، في حين لم يكن ذلك مطبّقا على المدرّسين. ممّا كان يتسبّب باحراج لبعض الطّلبة، خصوصا أصحاب القامات القصيرة، فالنّاس لم يعتادوا رؤية “شيوخ فتيان” لم يلتحوا بعد بالجبّة والعمامة. لذا فقد لجأ البعض وأنا منهم إلى وضع جبّته وعمامته في مكان قريب خارج المدرسة، يرتديهما عندما يذهب إلى المدرسة ويودعهما عندما يغادرها. وقد كنّا نضع الجبّة والعمامة في مطعم “أبو الذّيب” القريب.
لكنّ الطّلاب جميعهم تقريبا اكتسبوا لقب “شيخ”، بسبب ارتداء الجبّة والعمامة، وأنا منهم طبعا.
معلّمو المدرسة
كانت الهيئة التّدريسيّة مؤلّفة من نخبة مؤهّلّة من خرّيجي الجامعات، ومنهم: مدير المدرسة المرحوم عبدالقادر قدّورة، وهو من أصول جزائريّة كما ذكرنا سابقا، وهو خرّيج جامعة الأزهر، وبعد حرب حزيران عمل موجّها تربويّا في السّعوديّة.
معلّم اللغة العربيّة الأستاذ عكرمة سعيد صبري، خرّيج لغة عربيّة من جامعة بغداد، والذي شغل بعد حرب عام 1967، منصب مدير المدرسة، وبعدها مديرا لدائرة الوعظ والارشاد في أوقاف القدس، وأكمل دراسته الجامعيّة في الشّريعة حتّى حصل على شهادة الأستاذيّة “الدّكتوراة”، وهو أحد خطباء المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة العلميّة الاسلاميّة في القدس. وبعد قيام السّلطة الفلسطينيّة شغل منصب مفتي القدس والدّيار الفلسطينيّة ما بين 1994-2006.
معلّم الانجليزيّة الأستاذ المرحوم ماجد سرحان من حلحول، ويحمل ليسانس لغة انجليزيةّ، نزح في حرب حزيران إلى الأردنّ وعمل مقدّم برامج في القسم العربيّ بهيئة الإذاعة البريطانيّة حتّى وفاته. كان يعلّم أيضا في المدرسة الرّشيديّة الثّانويّة، لم يكن متديّنا وكان يحمل فكرا قوميّا ومحبوبا من الطّلاب.
معلّم الفقه الأستاذ المرحوم ياسين أحمد ابراهيم من إحدى قرى مدينة اربد في شمال الأردنّ، ويحمل شهادة ليسانس في الشّريعة من جامعة دمشق، واصل تعليمه الجامّعيّ بعد حرب حزيران أيضا، حتّى حصل على شهادة الأستاذيّة “الدّكتوراة”، وشغل منصب عميد كلّيّة الشّريعة في الجامعة الأردنّيّة في عمّان.
الأستاذ المرحوم شحادة ذيب حمدان من قباطية، حاصل على ماجستير في أصول الفقه من جامعة الأزهر، وكان –رحمه الله- كفيفا، ويتميّز بذكاء خارق.
طلاب المعهد
كان الطّلاب خليطا من أماكن مختلفة، وأغلبيّتهم كانوا من قرى رام الله، ومن قرى محافظة اربد في شمال الضّفّة الشّرقيّة. كانوا يستأجرون بيوتا في حارة الشّرف أو سلوان، على مقربة من باب المغاربة، ويعودون إلى بيوت ذويهم عصر كلّ يوم خميس؛ ليعودوا للدّوام المدرسيّ صباح كلّ سبت.
وممّن تخرّجوا من هذه المدرسة فضيلة الشّيخ محمّد حسين خطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والدّيار الفلسطينيّة منذ العام 2006.
في مقر الصّحيفة
فرصة الغداء أثناء الدّوام المدرسيّ “ساعة ونصف” كنت وبعض الزملاء نجوب أسواق القدس القديمة وحاراتها، زرنا مساجدها، كنائسها، زواياها، تكاياها، أديرتها، مشينا على الجزء المتاح من سورها، فكلّ حجر وكلّ شبر في القدس يشهد على عبق تاريخ المدينة، ويدلّل على عروبتها، وهذه المدينة الفريدة تسحر من يدخلها، فلا تشبع عيناه من غرف ما يستطيع من جمالها، فهي من أقدس وأقدم المدن في العالم، بناها اليبوسيّون العرب قبل أكثر من ستّة آلاف عام، كلّ بناء فيها له تاريخ، واشتهرت بأنّها مركز اشعاع حضاريّ، علميّ اقتصاديّ، عدا أنّها أقرب نقطة إلى السّماء، بل هي بوّابته، من مسجدها الأقصى عرج خاتم الأنبياء إلى السّماء في معجزة الاسراء والمعراج، وهي العاصمة السّياسيّة، الدّينيّة، الثّقافيّة والاقتصاديّة للشّعب الفلسطيني ودولته العتيدة، وفيها كنيسة القيامة التي يرقد فيها السّيّد المسيح عليه السّلام حسب المعتقد المسيحيّ.
أوّل مكان تجوّلنا في جنباته كان المسجد الأقصى المجاور لمدرستنا، صلّينا في المسجد العظيم، وتوقّفنا عند كلّ معلم في باحاته وساحاته، بعد أن انتهينا من الأقصى زرنا كنيسة القيامة، ومسجد عمر القائم قبالة مدخلها، أمضينا ساعات فيها، وبعدها زرنا مختلف المساجد والكنائس التّاريخيّة.
ذات يوم كتبت خاطرة، وقرّرت أن أرسلها بيدي إلى الصّحيفة التي كانت تنشر لي تحت باب “بأقلام القرّاء”؛ لأوفّر ثمن طابع البريد “قرشا ونصف القرش”، دخلت مكتب الصّحيفة بثقة تامّة، سألت عن رئيس التّحرير مباشرة دون معرفتي باسمه، فقال لي أحدهم:
ماذا تريد منه يا ابني؟
فأجبت: أنا فلان وأكتب في الصّحيفة.
طرق الرّجل باب غرفة، وأخبر من فيها باسمي وطلبي، فسمعت صوت أحدهم يقول له: أدخله.
طرحت السّلام، وقلت لهم: أنا فلان.
قبل أن أنهي حديثي، انفرطوا ضاحكين قهقهة، عندما رأوني فتى صغيرا، فنادى أحدهم على الرّجل الذي أدخلني قائلا:
أبو علي خذه وأخرجه!
أمسك الرّجل بي ودفعني إلى الخارج، فخرجت مهزوما حائرا، لكنّني لم أيأس، فقد بعثت “خاطرتي” بالبريد، لكنّهم لم ينشروها ولم ينشروا لي غيرها لبضعة أشهر. بعدها بحوالي أربعة أشهر، بعثت لهم ما رفضوا نشره باسم “جميل حسين” وحسين هو اسم أبي، فنشروه! واستمرّيت بالكتابة تحت هذا الاسم حتّى عام 1975، عندما عملت في صحيفة الفجر المقدسيّة، فتساءل رئيس التّحرير بشير البرغوثي عن صاحب الاسم، ولمّا عرف أنّني صاحب الاسم استغرب ذلك، وسألني عن أسبابي، فرويت له ما جرى معي.
فقال: الخطأ ليس في اسمك ولا فيما تكتبه، الخطأ في ذلك”الحم……..” الذي تعامل معك بهذه الفجاجة. وبعدها عدت للنّشر باسمي الأوّل واسم عائلتي.
المذياع العجيب
بعد أن أنهى أخي المرحوم محمّد “أبو سمرا” المرحلة الثّانويّة في العام الدّراسيّ 1961-1962، عمل هو وابن العمّ محمّد موسى مدرّسين في السّعوديّة، وكان المرحوم ابن العمّ موسى محمّد قد سبقهم إلى العمل مدرّسا في السّعوديّة عام 1958 في مدرسة خاصّة في مدينة جدّة، يملكها المرحوم جميل بركات من القدس، حيث عمل لمدّة سنتين، وبعدها تعاقد مع وزارة التّربية والتّعليم السّعوديّة.
عندما عاد أخي محمّد من السّعوديّة لقضاء العطلة الصّيفيّة في البلاد، أحضر معه مذياعا “راديو” يعمل على بطاريّتين متوسّطتي الحجم، وكان ابن العمّ المرحوم ابراهيم موسى، الذي كان يعمل حينها لاقط أخبار في الإذاعة الأردنيّة في عمّان، قد اشترى قبل ذلك بحوالي أربع سنوات مذياعا بحجم الصّندوق ويعمل على بطّاريّة سيّارة، ونصب له لاقطا “أنتينا” على سطح البيت، وعندما عاد والده المرحوم عمّي موسى ورأى المذياع، غضب وأرغى وأزبد وهو يصرخ به:
كيف تأتي براديو وأخوك محمّد في المدرسة؟ هل تريده أن يرسب؟” وأجبره على إعادة الرّاديو لمن باعه إيّاه.
شكّل الرّاديو الذي أحضره أخي محمّد من السّعوديّة قفزة نوعيّة في بيتنا، فقد كنّا نلتفّ جميعنا حوله، نستمع للأخبار، ولخطابات الرّئيس المصريّ جمال عبد النّاصر، ولأغاني سميرة توفيق وعبده موسى.
وعندما كنت في الصّفّ الثّالث الاعداديّ، وبينما كنت أستمع للمذياع ليلا وبدون إضاءة أحّرك مؤشّره من موجة إلى أخرى، ومن محطّة إذاعيّة إلى أخرى، وإذا بي أسمع:
هنا إذاعة موسكو باللغة العربيّة، برنامج صندوق البريد، تعلن إذاعة موسكو باللغة العربيّة ومن خلال برنامج صندوق البريد عن مسابقة للفتيات والفتيان العرب في كتابة القصّة القصيرة، وسيحصل الفائز على جائزة عبارة عن جهاز تلفزيون، أو جهاز تصوير من طراز كوزموس، وذكروا رقم صندوق بريد في موسكو؛ لاستقبال مشاركة من يرغبون بالمشاركة.
كتبت قصّة طفوليّة ساذجة بعنوان “البقرة والفلاح”. وبعد حوالي ثلاثة أشهر أعلنوا النّتائج، كانت المفاجأة أنّني الفائز الأوّل، وطلبوا منّي أن أختار الجائزة بين التّلفزيون وجهاز التّصوير.
لم نكن وقتذاك نعرف التّلفزيون، كنّا نسمع به لكنّنا لم نره، فكتبت لهم، بأنّني أريد جهاز تصوير، ولا أريد التّلفزيون لعدم وجود كهرباء في قريتنا!
كانوا يردّون كتابة على رسائلي عدا عن بثّها إذاعيّا، وفي الرّسالة الأولى التي استلمتها منهم وجدت صورا لرائدي الفضاء السوفياتيّين فالنتينا تريشكوفا ويوري جاجارين، أوّل من اخترقا الجاذبيّة الأرضيّة، وحلّقا في الفضاء الخارجيّ، وكانا مدار حديث وسائل الاعلام العالميّة، ومن ضمنها العربيّة، وفي الرّسالة الثّانية طلبت منهم طوابع سوفييتيّة، حيث أنّني من هواة جمع الطّوابع، فأرسلوا لي لائحتين كلّ منهما مكوّنة من خمسين طابعا، لا أزال أحتفظ بواحدة منها حتّى يومنا هذا، في حين أخذ الثّانية الصّديق الدّكتور محمّد شقير. كما طلبت منهم أن يرسلوا لي شروط القبول في الجامعات السّوفييتيّة، فأرسلوا لي شروط القبول باللغة الرّوسيّة، فكتبت لهم ببراءة تامّة، بأنّه لا يوجد في بلادنا من يعرفون اللغة الرّوسيّة، وتمنّيت عليهم أن يرسلوا ترجمة لها بالعربيّة أو الانجليزيّة، فأرسلوا نسخة بالانجليزيّة، لم أفهم منها شيئا.
كنت أستلم الرّسائل مفتوحة من أحد جوانبها ومغلقة بلاصق، ولم يعن ذلك لي شيئا في حينه.
مضت عدّة أشهر ولم أستلم الجائزة، فكتبت لهم متسائلا عن سبب تأخيرها، وكنت قد التحقت في المعهد العلميّ الإسلاميّ. فجاءني الرّدّ غير المتوقّع.
مطلوب للتّحقيق!
كنّا نتناول غداءنا بعد ظهر يوم، وإذا بشرطيّ يدخل البيت ويسأل:
أين جميل؟
دعاه أبي ليتناول طعامه معنا، لكنّه رفض ذلك، ورفض أن يتركني أكمل طعامي، أمسك بيدي وقادني إلى مخفر الشّرطة الكائن في قمّة جبل المكبّر، في بيت مستأجر من المرحوم الشّيخ حسين ابراهيم شقير، شيخ ومختار حامولتنا “الشقيرات” –جرى هدم البناء بعد احتلال عام 1967-.
وهناك أخبروني بأنّني مطلوب للمخابرات في القدس، ولا يعلمون سببا لذلك. كانوا يريدون احتجازي حتّى صباح اليوم التّالي، وعندما رآني المرحوم أحمد حسين جوهر صاحب بقالة ومقهى مجاورة للمخفر، وقّع على كفالة بأن يحضرني صباح اليوم التّالي إذا أطلقوا سراحي تلك الليلة، فعدت إلى البيت وأنا لا أعرف سببا لذلك.
في اليوم التّالي وصلت المخفر بصحبة كفيلي، فأخذني شرطيّ واستقلّينا باصا حتّى القدس ويدي اليمنى مكبّلة بيده اليسرى، وهناك سلّمني في مبني المحافظة الكائن في شارع صلاح الدّين.
مشيت معه حائرا، فأنا لم أعمل أيّ جنحة تستحقّ ذلك، طلب منّي شرطيّ أن أنتظر في الممرّ في الطّابق الثّاني، فوقفت مشدوها، مرّ بي رجل بلباس مدنيّ قويّ البنية مفتول العضلات، سألني عن اسمي، وعندما سمع اسمي صفعني صفعة قويّة على وجههي لم أتوقّعها، فطرحني أرضا، ثمّ اقتادني إلى غرفة لا نوافذ فيها، أغلق الباب عليّ، شعرت بالخوف وازددت حيرة في تفسير ما يجري لي. بعد دقائق قليلة، جاء شرطيّ وقيّد يديّ “بكلبشة” إلى الخلف، طلب منّي أن أتبعه، في السّاحة أمام مبنى المحافظة طلب منّي أن أجلس في صندوق جيب شرطيّ يفتح بابه من الخلف، وله مقعدان جانبيّان، جلست على المقعد اليمين، بعد أن ربط “القيد” بعمود معدنيّ خلفي، صندوق السّيارة مفتوح على المقعد الأمامي حيث السّائق الذي جلس بجانبه ضابط شرطة، والذي أخبرني بدوره أنّني مطلوب للمخابرات في عمّان، انطلقت السّيارة بنا، وكلّما كانت تمرّ بالتفاف في الشّارع، كنت أميل إلى الأمام بطريقة لافتة، ممّا يتسبّب لي بألم في اليدين، فانتبه الشّرطيّ السّائق لذلك، وقال للضّابط:
شو رايك نغيّر قيده إلى الأمام كي لا يتأذّى من حركة السّيّارة، وكي يعتمد على يديه في تثبيت نفسه عند الالتفاف؟
فوافق الضّابط بعد نقاش قصير.
لم أكن وقتذاك قد دخلت أيّ مدينة غير القدس، سوى مدينة أريحا التي دخلتها في الرّحلات المدرسيّة ونحن في طريقنا إلى البحر الميّت.
انتابتني هواجس ومخاوف كثيرة، لكنّني كنت متأكدا من وجود خطأ ما، اجتزنا نهر الأردنّ إلى الضّفّة الشّرقية، وفي بلدة الكرامة توقّفت السّيارة بناء على طلب الضّابط لشراء ساندويشات، فسألني الشّرطيّ السّائق:
معك فلوس؟
فأجبته بأنّني أملك قرشا واحدا.
فقال: “خلّيه معك”.
اشترى ساندويش فلافل” وزجاجة كازوز لكلّ منّا، أعطاني ساندويش وزجاجة “كازوز” وبدا لي أنّه يشفق عليّ ويتعاطف معي، فشعرت بنوع من الطّمأنينة.
وصلنا إلى مبنى المخابرات في عمّان، وهناك سلّماني لهم، أعطاني أحدهم رقما وقال لي، عندما تسمع هذا الرّقم تأتي، طلب منّي الجلوس في “براكس” أمام المبنى بعد تحذيري من مغبّة الحديث مع أيّ شخص، حيث يوجد عدد من الرّجال، ينادونهم بالأرقام أيضا.
بعد عدّة دقائق سمعت اسمي فوقفت واتّجهت إلى المنادي، فطلب منّي الدّخول إلى المبنى لمقابلة “الباشا”! في الممرّ رأيت رجلا نحيفا متوسّط القامة يرتدي بدلة وربطة عنق يتمشّى في الممرّ، تجاوزته ظنّا منّي أنّ الباشا لا بدّ وأن يكون في الطابق الثّاني، وفي آخر الممرّ وأنا أبحث عن بيت الدّرج كان رجل طويل القامة، ممتلئ الجسم: فسألني:
إلى أين؟
فأجبت: إلى الباشا.
فدفعني بقوّة من حيث أتيت، فتناولني الرّجل الأوّل، وطلب منّي الدّخول في غرفة، فيها سريران معدنّيان مفروشان، بينهما صندوق خشبيّ، عليه صندوق كرتونيّ مفتوح، فيه عدّة “كاميرات”، على جانبه العلويّ مكتوب اسمي وعنواني. على ظهر الصّندوق رسائلي التي كنت أبعثها لاذاعة موسكو بخط يدي، وصور للرّسائل التي كنت أستلمها. لمّا رأيت ذلك عرفت سبب استدعائي.
جلس الرّجل على السّرير قبالتي، شرع يسألني عن اسمي كاملا، تاريخ ميلادي، أسماء إخوتي وتاريخ ميلاد كلّ منهم، اسم مدرستي، هل سأكمل تعليمي الجامعيّ؟ وأين؟ وماذا سأدرس؟ كان الرّجل مهذّبا في كلامه وأسئلته.
وبعد ذلك قال لي:
أتينا بك إلى هنا لأنّك ولد محترم! ولم نرسلك إلى سجن المحطّة ولا إلى غيره من مراكز التّحقيق، فكن صادقا معي وإلّا.
فوعدته بذلك.
وإذا به يفاجئني بالسّؤال التّالي:
ما هي علاقتك بالحزب الشّيوعيّ الأردنيّ؟
وللحقيقة وللأمانة التّاريخيّة لم أكن وقتئذ أعلم إن كان هناك حزب شيوعيّ أردنيّ أم لا، ولم أسمع بوجود أحزاب شيوعيّة إلا في روسيا والصّين. ولم أكن أميّز بين الشّيوعيّة والمذهب الشّيعيّ!
صعقني بسؤاله هذا، فأجبته مقسما بأنّني لم أعلم بوجود حزب شيوعيّ أردنيّ إلا منه، ولا أعلم بوجود أحزاب في الأردنّ، بل إنّني وقتذاك لا أعرف ما معنى كلمة حزب!
بعد ذلك سألني عن سبب مراسلتي لإذاعة موسكو باللغة العربيّة؟
فأجبته: لا أدري، لكنّني كنت أتمنّى الفوز بالجائزة.
وعندها طلب منّي أن أكتب لإذاعة موسكو بخطّ يدي، أخبرهم بها أنّني استلمت الجائزة مع الشّكر، فكتبت.
أخذ منّي الرّسالة واحتفظ بها عنده، وحذّرني من مغبّة العودة لمراسلة تلك الإذاعة، فوعدته بذلك.
ويبدو أنّ الرّجل اقتنع بجهلي وسذاجتي، فأتى لي بورقتين لتعبئّة الفراغ فيهما، بعد تعبئة الاسم ومكان الولادة وتاريخها، والمهنة.
وكان السّؤال الأوّل كالتّالي:
نحن نعلم أنّك عضو في الحزب الشّيوعيّ الأردنيّ، متى انتسبت للحزب…………..من نظّمك فيه؟……….متى …..وأين…….؟
صمتّ قليلا وسألته:
كيف سأجيب على هذه الأسئلة وأنا لا علاقة لي بما فيها؟
فقال لي اكتب في الفراغ: لا علاقة لي بالحزب الشّيوعي الأردني، فكتبت.
ثمّ وضع “شحطة” بالفراغات الأخرى.
بعد ذلك سألني: هل أنت على استعداد لاستنكار الحزب الشّيوعيّ؟
فأجبته: نعم، لكن كيف؟
فأملى عليّ: أنا الموقّع اسمي أدناه، أستنكر الحزب الشّيوعيّ الأردنيّ الهدّام، وأعلن ولائي واخلاصي لجلالة الملك المعظّم ولحكومته الرّشيدة، فكتبت ذلك.
أبقى الجائزة عنده، وأذن لي بالخروج وهو يؤكّد عليّ بعدم العودة لمراسلة إذاعة موسكو.
خرجت من المبنى وأنا لا أعلم أين أنا! مشيت على غير هدى وأنا أحمد ربّي على الخلاص من هذه الورطة، سألت المارّة عن موقف الباصات التي تسافر إلى القدس، فكانوا يصفون لي الشّوارع، ويبدو أنّني ضللت الطّريق حتى وجدت نفسي في واد السّير أمام بناية مكتوب عليها لافتة تقول “شركة السّجائر الأردنيّة” سألت أحد المسنّين هناك فقال لي:
انتظر هنا، فالباصات تمرّ من هذا الشّارع، فانتظرت عدّة دقائق وإذا بباص بيت ساحور-القدس عمّان يمرّ أمامي، أشرت له بيدي فتوقّف، قلت للسّائق أنّني لا أملك إلا قرشا واحدا، وسأعطيه ما تبقّى عندما أصل جبل المكبّر، -كانت الأجرة خمسة قروش-، فوافق مراقب التّذاكر “الكونترول” الذي كان وجهه معروفا لديّ واسمه “حنّا”، وعندما وصلنا جبل المكبّر أمسك بي “الكونترول” من قبّة قميصي ونزل معي، فرآه المرحوم أحمد حسين جوهر وصاح به:
ليش ماسك هذا الولد هيك؟
فأجابه بأنّه تبقّى عليه أربعة قروش من أجرة الباص.
فقذف له المرحوم أحمد جوهر “شلن” خمسة قروش، وهو يقول:
خذها وانصرف.
في اليوم التّالي سألني مدير المدرسة:
لماذا غبت بالأمس؟
فأخبرته بما جرى معي.
ضحك ضحكة ساخرة وقال:
اذهب إلى صفّك.
فهمت من ضحكة المدير أنّه يسخر من هذه التّهمة، لكنّه لم يضف شيئا.
في الفرصة الصّباحيّة أمسك بي معلّم اللغة الانجليزيّة المرحوم ماجد سرحان، وسألني باهتمام شديد عمّا جرى معي بالأمس، فأخبرته بما حصل.
******
حائط البراق
“يبلغ الطول الأصليّ للحائط ،ثمانية وخمسين مترا، ويبلغ ارتفاعه عشرين مترا، ويضم خمسة وعشرين مدماكا من الحجارة السّفلية منها هي الأقدم، ويبلغ عمق الحائط المدفون تحت سطح الأرض نحو ثلث الحائط الظاهر فوقه، أمّا الرّصيف الموجود أمام الحائط حاليا فيرتفع عن مستوى سطح البحر نحو سبعمائة وثمانية أمتار، وبعد الاحتلال الصّهيوني لمدينة القدس في حزيران 1967 تم إجراء حفريّات في المنطقة المواجهة للحائط، بهدف إظهار الجزء المخفي منه وكشف طبقات الحجارة المطمورة، واتّضح أنّ الحائط القديم يتكوّن من سبع طبقات حجريّة يعود تشكيلها إلى فترة حكم هيردوس الأدومي، ما بين عامي سبعة وثلاثين وأربعة قبل الميلاد، وهناك أربع طبقات حجريّة يعود تشكيلها إلى العصر الرّوماني الأوّل، أمّا الحجارة في القسم العلويّ من الحائط فقد أقيمت في العهد البيزنطيّ، فيما أقيمت أقسام أخرى بعد الفتح العربيّ الإسلاميّ لبيت المقدس، استمرّت الحفريّات التي قام بها الصّهاينة قرابة عامين، وتسببت في هدم العشرات من العقارات والأبنية الوقفية بحجّة كشف السّاحة أمام الحائط، الذي أصبح طوله عند الصّهاينة نحو ثلاثمائة وستين مترا، ويرون أن طوله الكلّيّ يقع على امتداد الجدار الغربيّ للحرم القدسيّ، والبالغ طوله نحو أربعمائة وواحد وتسعين مترا.”
يعلو مقرّ مدرستنا “المعهد العلميّ الاسلاميّ” حائط البراق من الجهة الشّماليّة، وهذا المقر جزء من المدرسة التّنكزيّة، التي أقيمت في العصر الأيّوبيّ، يوجد أمام حائط البراق ممرّ بعرض 3-4 أمتار، يليها مسجد وعدد من البيوت القديمة المبنيّة من العهدين الأيّوبيّ والمملوكيّ، – جرى هدمها وتجريفها جميعها مع البيوت والمدارس التّاريخيّة في حارتي الشّرف والمغاربة، يبلغ عددها 1012 بيتا، بعد وقوع القدس تحت الاحتلال الاسرائيليّ في حرب حزيران 1967مباشرة، كما جرى تجريف الأرض أمام حائط البراق على عمق يزيد على عشرة أمتار، إضافة إلى الأنفاق التي جرى حفرها تحت المسجد الأقصى وباحاته.
كنّا ننظر السّيّاح الأجانب من شبابيك المدرسة الجنوبيّة، ونرى بعضهم يتلفّت إلى جانبيه وخلفه ليطمئنّ بأنّ أحدا لا يراقبه، ثمّ يضع ورقة في أحد شقوق الحائط، لم ندرك يومها سبب زيارتهم لهذا الحائط، ولا سبب وضعهم الرّسائل في شقوقه، لكنّنا تأكّدنا بعد احتلال المدينة أنّ اليهود يعتبرونه “حائط المبكى”، الذي يؤدّون صلواتهم أمامه. وأنّ السّيّاح الذين كنّا نراهم أمام الحائط قبل الاحتلال كانوا يهودا، يحملون جنسيّات أجنبيّة مختلفة، ويدخلون المدينة المقدّسة كسيّاح أجانب.
ومعروف أنّ هذا الحائط قد شهد اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
رحلة مدرسيّة
أثناء دراستنا الثّانويّة، وفي فصل الرّبيع رتّبّت المدرسة لنا رحلة مدرسيّة لمدّة أربعة أيّام وثلاث ليال، جمعوا من كلّ طالب نصف دينار، وما تبقّى غطّته وزارة الأوقاف، في اليوم الأوّل سافرنا إلى عمّان، مررنا بطرفها دون توقّف، وواصلنا طريقنا إلى مدينة جرش الأثريّة، تجوّلنا في المنطقة الأثريّة حوالي ساعتين، وهناك تناولنا طعام الغداء، ثمّ واصلنا المسير شمالا إلى مدينة عجلون، نزلنا ضيوفا على دار المعلّمين فيها، قبل الغروب صعدنا إلى قلعة الرّبض، ومنها يمكن رؤية أضواء مدينة القدس. وقتئذ كانت عجلون مدينة صغيرة شبيهة بالقرى، لا اكتظاظ فيها.
في اليوم الثّاني توجّهنا إلى اربد، مررنا بها سريعا، ثمّ اتّجهنا إلى الحمّة الأردنيّة، قرب أمّ قيس، استحمّ البعض منّا في البركة الدّائريّة المقامة عند رأس النّبع، حيث يوجد فندق صغير، كانت تجلس أمامه أسرتان لبنانيّتان جاءتا للرّاحة والاستجمام والاستطباب بالمياه المعدنيّة الحارّة. ثمّ واصلنا رحلتنا إلى مدينة البتراء، وفي الطّريق الصّحروايّ بين عمّان ومعان، توقّف باص الرّحلة لعطب أصابه، حاول السّائق ومرافقه اصلاح العطب دون جدوى، فذهب مساعد السّائق مع شاحنة قادمة من العقبة إلى عمّان لإحضار “ميكانيكي”، نزلنا من الباص في تلك المنطقة الصّحراويّة التي تكثر فيها العقارب، انتشر الطّلاب في المنطقة، كانوا يشيرون لبعض الشّاحنات؛ ليطلبوا من السّائق ماء للشّرب.
تواجد في المنطقة قطيع من الجمال، واحدة من النّوق في رأسها “رَسَن”، أمسكت برسنها وأنختها؛ لنمتطيها ونتصوّر بجانبها، كان بحوزتي “كاميرا” لأخي أحمد، لم تكن الأفلام الملوّنة معروفة بعد، امتطى أحد زملائي وهو من قريتي النّاقة، وبينما هي تقف على قوائمها، أصيب بالرّعب وسقط عنها فتهشّم وجهه، وسالت منه دماء خفيفة، ومع ذلك التقطت له صورة وأنا أضحك، ضحكت رغم أنّ إصابته شكّلت لي صدمة لمعلومة كنت أسمعها من كبار السّنّ وصدقتها في حينه، فقد كانوا يروون لنا أنّ الجمل حيوان مبارك، وأنّه يذكر اسم الله على من يسقط عنه! وبالتّالي فإنّه لا يصاب بأذى!
مشيت وزميلي على الشّارع باتّجاه الجنوب، كان المطر يتساقط رذاذا خفيفا، وعلى بعد حوالي كيلومتر من باص الرّحلة، مرّت بنا سيّارة مكشوفة قادمة من الجنوب، فيها شخص يرتدي لباس البحر. توقّف بجانبنا وسأل:
إيش تعملون يا عيال؟
فقلنا أنّنا طلاب في رحلة مدرسيّة، وأنّ الباص قد تعطّل، وأشرنا إلى الباص الذي يظهر من بعد.
طلبنا منه ماء للشّرب، فأعطانا قربة ماؤها بارد، شربنا فقال لنا:
اركبوا معي في السّيّارة.
جلست أنا بجانبه، وجلس زميلي في المقعد الخلفيّ، لاحظت وجود مسدّس في جيب للسّيارة بين المقعدين الأماميّين، فوق منفضة السّجائر، نظرت إلى الرّجل الذي انتبه لي، فسألني:
هل تعرفني؟
فأجبته: نعم أنت الأمير حسن.
ابتسم وقال: بل أنا الأمير محمّد.
أوقف الأمير سيّارته بمحاذاة الباص، اقترب مدير المدرسة منه وصافحه دون أن ينزل الأمير من سيّارته، وسأله الأمير:
ماذا ستعملون؟
فأجاب المدير: ذهب مساعد السّائق إلى عمّان لإحضار “ميكانيكي” من عمّان.
وعاد الأمير يسأل: وإذا تأخّر، أو وصل ولم يستطع إصلاح الباص، ماذا ستفعلون؟
ارتبك المدير ولم يجد جوابا.
وأضاف الأمير: هذه منطقة صحراويّة، فيها وحوش مفترسة، إذا اختطف أحدها أحد التّلاميذ ماذا سنقول لك؟ وواصل قائلا:
على كلّ سأبعث لكم الآن باصا، لتكملوا رحلتكم.
قال ذلك وغادر.
ويبدو أنّ الأمير اتّصل لاسلكيّا بالجهاز الذي كان أمامه، ووصل إلينا باص سياحيّ قبل أن يعود مساعد السّائق.
استقلّينا الباص، وضعنا حقائبنا في مقاعده الخلفيّة لحمايتها من رذاذ المطر، وواصلنا رحلتنا إلى البتراء، حيث وصلناها مساء ونزلنا في مدرسة وادي موسى، القريبة من مدخل مدينة البتراء، حيث استقبلنا مدير المدرسة وعدد من الأهالي، وشاركونا الغناء الزّجليّ الذي قاده الطالب توفيق محمّد مصطفى من قرية نعلين قرب رام الله.
كانت هناك بيوت قائمة في وادي موسى، ولاحظنا هناك زراعة بعض الخضار التي تروى من عين الماء في الوادي.
عند مدخل مدينة البتراء هناك فندق صغير، وبعض الرّجال يقفون بجانب دوابّهم “خيول، بغال وحمير” يؤجّرونها لبعض السّيّاح الذين يؤمّون مدينة البتراء التّاريخيّة العجيبة المنحوتة في الصّخور الملوّنة.
في ساعات صباح اليوم الثّالث تجوّلنا في البتراء حتّى ساعات ما بعد الظّهر.
أكثر ما لفت انتباهي في مدينة العجائب البتراء “الخزنة” التي تنتصب أمامها أعمدة ملوّنة منحوتة في الصّخر، وكذلك المدرّج المسرحيّ المنحوت في الصّخر، مع التّأكيد أنّ كلّ ما في المدينة عجيب مدهش.
عند العصر واصلنا طريقنا إلى مدينة العقبة، ونمنا في مسجدها؛ لأنّ المدرسة التي تمّ التّنسيق معها كي ننام فيها لم يكن فيها أحد. المدينة كانت صغيرة جدّا، ميناؤها صغير أيضا، صباح اليوم الرّابع نسّق مدير المدرسة ومعلّموها مع سلطة الميناء، فسمحوا لنا بدخول الميناء، والصّعود إلى سفينة تجاريّة كانت تنزل حمولتها على رصيف الميناء.
في العقبة رأينا البحر للمرّة الأولى، مع أنّ خليج العقبة لضيقه لا يعطي صورة حقيقيّة للبحار التي لا نهاية لها، فمنطقة أمّ الرّشراش على الجانب الغربيّ للخليج كانت أمامنا.
كانت هناك مسابح على شاطئ البحر، أغلبيّة من يتواجدون فيها سيّاح أجانب. لم نستحمّ في البحر” لأنّ أيّا منّا لم يكن معه لباس بحر”مايوه”، ولم يحاول أيّ منّا أن يشتريه؛ لأسباب لا أعرفها حتّى يومي هذا.
عند الظّهيرة عدنا إلى القدس، وأعاد لنا المعلّمون نصف الدّينار الذي دفعناه، بعد أن اقتطعوا خمسة قروش أو عشرة- لا أذكر بالضّبط- أجرة للباص الذي أصابه العطب، أمّا الباص السّياحيّ فقد دفع أجرته الأمير محمّد كما أخبرنا السّائق.
أنا والسّينما
في العام 1965 ثارت عاصفة اعلاميّة حول الفلم السّينمائيّ الغنائيّ “بيّاع الخواتم” بطولة فيروز ونصري شمس الدّين، الذي فاز بعدّة جوائز، ومحور الضّجة تمحور حول الفلم عندما عرض في دور السّينما المصريّة، لأنّ المشاهدين المصريّين لم يفهموا اللهجة اللبنانيّة، ممّا استلزم وضع “ترجمة” لكلماته بالعربيّة الفصحى، فشاهدت الفلم الذي عرض في سينما النّزهة في القدس، التي تستعمل منذ العام 1984م مقرّا للمسرح الوطنيّ الفلسطيني”الحكواتيّ”.
وبعد ذلك بأشهر شاهدت في نفس السّينما فلما هنديّا اسمه “ولدي” بسبب الضّجة الاعلاميّة حول الفلم؛ لأنّه خرج عن المألوف، وفاز بعدّة جوائز دوليّة، وملخّص قصّة الفلم تدور حول شابّ يتيم الأب ووحيد أمّه أحبّ شابّة، وبعد تخطّي الحواجز التي حالت دون زواجهما، تعرّضت الفتاة إلى حادث طرق فقطعت ساقها، فرفضت الزّواج من حبيبها رغم حبّها الشّديد له، فقد رأت نفسها أنّها لم تعد كفؤة للزّواج منه، ممّا اضطرّه إلى قطع ساقه كي توافق حبيبته على الزّواج منه، ولمّا علمت والدته التي كانت تنتظر زواجه بما فعله، استلّت مسدّسا وأطلقت الرّصاص على ابنها فقتلته.
ولسوء حظّي فقد شاهد الفلم معي شخص من قريتي يكبرني بثمانية أعوام، فأخبر والدي أنّه شاهدني في السّينما، ممّا عرّضني إلى توبيخ لفظيّ؛ لأنّ والدي لم يكن يعرف شيئا عن السينما، ويعتبرها مكانا للانحراف.
ربطة العنق والقميص البرازيلي
في عام 1964 عاد أحد أبناء قريتنا من البرازيل، وأرسل لنا أخي الأكبر محمّد معه بعض الهدايا، منها “دزّينة” ربطات عنق رفيعة لا يصل عرض الواحدة منها ثلاثة سنتمير، لم يكن في عائلتنا من يضع ربطات عنق سوى ابن عمّي ابراهيم موسى، أخذت واحدة منها وربطها لي، ومنها قميص برازيليّ أنيق “نص كم” له أربعة جيوب مرسل لي، مخرّم مع ثنيات، ويعتبر فخرا لصناعة الملابس البرازيليّة، وهو لا يزال يباع في الأسواق الأوروبّيّة والأمريكيّة حتّى هذه الأيّام، وكنت قد ابتعت قميصا أبيض اللون، فوضعت ربطة العنق في بيتنا، فرآني أبي وأمسكني بها وشدّها على رقبتي وهو يقول:
“هذه لا يلبسها إلا دكتور أو معلم! وأنت لا دكتور ولا معلم” فإيّاك أن تخرج بها أمام النّاس وتفضحنا”! وخوفا من “الفضيحة العائليّة” أعدتها لابن عمّي.
في صباح اليوم الثّاني ذهبت إلى المدرسة “المعهد العلميّ الاسلاميّ”، مختالا كالطّاؤوس بقميمصي البرازيليّ الفاخر، لكنّ فرحتي بذاك القميص لم تكتمل، فقد عنّفني أحد المعلّمين، وحذّرني من مغبّة ارتداء هذا القميص الخليع مرّة ثانية!
ومن راتبي في تلك المدرسة فصّلت بنطالين من قماش “هيلد” البريطاني، وبنطالا لشقيقي ابراهيم” ثمن كلّ بنطال ديناران، دفعت ثمنها بالتّقسيط” دينارا كلّ شهر”. كما ابتعت قميصين فاخرين ماركة “C.J.C.”.
بدايات التّغيير
بعد التحاقي بـ “المعهد العلميّ الاسلاميّ” بدأ التّغيير الإيجابيّ في مواقف الأسرة تجاهي، فالوالد –رحمه الله- الذي كان قلقا على مستقبلي المعيشيّ، كوني بعين واحدة، وأراد تزويجي في سنّ مبكرة، وانصافي عن إخوتي الآخرين بإعطائي قطيعا من الغنم، وجزءا من الأراضي الواسعة التي يمتلكها، ليس كراهية بي وإنمّا من شدّة حبّه لي، وحرصه عليّ-حسب مفاهيمه-، ولمّا تيقّن بأنّه يمكنني العمل كإمام لمسجد له راتب مضمون بعد انهائي المرحلة الثّانويّة، أصبح يشجّعني على مواصلة الدّراسة والاجتهاد، وأبدى استعداده للموافقة على تعليميّ في الجامعة، لأستلم منصبا رفيعا كقاض شرعيّ مثلا.
وصارت كلمتي مسموعة في الأسرة؛ لأنّني مجتهد ونبيه –حسب تعبير والدي-.
ازدادت ثقتي بنفسي، فأصبحت أجالس -دون تردّد- الرّجال ليس من يرتادون بيتنا فقط لأكثر من سبب، بل في بيوت بعض وجهاء الحامولة والمعارف، وكوني أعيش في مجتمع عشائريّ، له عاداته وتقاليده وتحكمه الأعراف العشائريّة، فقد تعلّمت هذه الأعراف دون عناء، خصوصا ما يتعلّق بحلّ الخصومات.
ومع أنّ العرف والعادة لا تسمح للأبناء بالحديث بوجود آبائهم أو من هم أكبر منهم سنّا من أبناء العائلة، إلا أنّني أصبحت أشارك فيما يدور من أحاديث كوني”شيخ”ّ! وفي طريقي لأصبح “عالما” وإماما لمسجد!
ووالدي –رحمه الله- كان إنسانا عاطفيّا، يحبّ أبناءه بطريقة لافتة، ويحرص على تعليم من ينجح منهم. لذا فعندما وصلت أنا وشقيقي ابراهيم نهاية المرحلة الثّانويّة، فقد فصّل لكلّ منّا بدلة من الجوخ البريطانيّ، وكان شديد الفخر بنا.
لم يكن الوالد يوما بخيلا علينا، بل بالعكس فقد كان كريما معنا ومع الآخرين، حتّى أنّهم كانوا يضربون المثل بكرمه، فطوال حياتنا كان يتوفّر لنا خبز القمح البلديّ من نتاج أرضنا، وفي مرحلة الضّائقة الاقتصاديّة ما بين 1948-1952، لم نعش تلك الضّائقة، فمخزون القمح لدينا كان يكفينا لخمس سنوات على الأقلّ، والحليب ومشتقّاته “لبن، جبنة، سمن بلدي” كانت متوفّرة على مدار العام. كان الوالد يشتري السّكّر والرزّ المصريّ بشوالات زنة كلّ واحد منها مئة كغم. كما كان يشتري لنا العجوة العراقيّة المعبّأة بأكياس من جريد النّخيل” تسمّى “كفير”، و”القطّين” بشوالات. وعندما كان يذهب إلى القدس كان يأتينا بالخضار والفواكه. وفي موسم البّطيخ والشّمام كان يحضرها لنا بكثرة، كما كان يذبح لنا خروفا عندما نطلب ذلك.
لكنّه لم يكن كغالبيّة أبناء جيله يؤمنون بتعليم البنات. وكان التّمييز بين الأبناء والبنات ظاهرة اجتماعيّة واضحة للعيان، فنمط الحياة لم يواكب العصر، وأبناء البلدة تحكمهم أعراف القبيلة، وحياة البداوة التي لا تعرف الاستقرار.
العمل غير المأجور
تمارس النّساء والأطفال حتّى يومنا هذا أعمالا منزليّة، وأخرى غيرها قد تحتاج وقتا وجهدا أكثر من العمل المأجور، وقد تتفاوت هذه الأعمال بين بيئة وأسرة وأخرى غيرها، وإن كانت أعباء المنزل جميعها تلقى على عاتق النّساء، ولنأخذ قريتنا عرب السّواحرة نموذجا لذلك، وبالتّحديد في فترة طفولتي في خمسينات القرن العشرين، فمن كانوا يربّون الأغنام كانت النّساء من يقمن بحلبها وتصنيع حليبها إلى أجبان وألبان وغيرها، ومن يفلحون الأرض بالحبوب كانت النّساء والأطفال يشاركون في تنظيف الحقول من الأعشاب الضّارة، وفي الحصاد، وفي دراسة الحبوب على الدّواب، و”كربلتها وغربلتها”، ومن كانوا يعتاشون على زراعة الخضروات المرويّة بمياه “وادي الدّيماس” التي هي عبارة عن المياه السّائبة من مجاري مدينة القدس، كانت النّساء والأطفال يشاركون في زراعتها، ريّها، قطفها، وبعض النّساء كنّ يقمن بعمليّة بيعها في أسواق القدس للحصول على سعر أعلى من سعر بيعها بالجملة في الحسبة، وبعض النّساء كنّ يزرعن الأراضي المحيطة ببيوتهن زراعات بعليّة لسدّ احتياجات الأسرة، كالبصل، الثّوم، البندورة، الفجل، ومقاثي الفقوس والكوسا.
كان الأطفال يعملون في العطل الصّيفيّة في التّنقيب عن الآثار في قرية سلوان المجاورة كما أسلفنا، وفي المراحل العمريّة المختلفة كان الأطفال يشاركون في رعي الخراف والأغنام.
شاركت بأكثر من عمل في مراحل طفولتي المختلفة، فقد رعيت الخراف والأغنام لأيّام، وشاركت بمواسم الحصاد ودراسة الحبوب ونقلها هي وأتبانها من البيدر إلى أماكن التّخزين. عند اقترابي من سنّ الخامسة عشرة شاركت في حراثة الأرض على البغل، وكان الأهالي يرون في عمل الأطفال تدريبا لهم على تلك الأعمال؛ ليحترفوها عندما يكبرون. أمّا الأطفال الذين تسرّبوا من المدارس في مراحل عمريّة مختلفة فقد احترفوا تلك الأعمال فور تركهم المدرسة، ومنهم من احترف أعمال البناء خصوصا “الطراشة والدّهان”.
معركة السّموع والمظاهرات
صباح 13 تشرين الثّاني –نوفمبر- 1966 شنّت إسرائيل هجوما واسعا على قرية السّمّوع قضاء الخليل، وقد تصدّت لها القوّات الأردنيّة ببسالة، وألحقت بها خسائر فادحة منها اسقاط ثلاث طائرات اسرائيليّة، مقابل طائرتين أردنيّتين، استشهد قائد إحداهما وهو الملازم أوّل موفّق بدر السّلطي، كما استشهد حوالي خمسة عشر جنديّا أردنيّا.
في أعقاب تلك المعركة خرجت مظاهرات صاخبة في مختلف مدن الضّفّة الغربيّة، وبعض المدن في الضّفّة الشّرقيّة، مطالبة بالثّأر، وكانت تهتف بحياة الرّئيس المصريّ جمال عبد الناصر، وتطالب بتحرير فلسطين.
وقد شاركت مع ثلاثة طلاب آخرين من مدرستنا في تلك المظاهرات ونحن نرتدي الجبّة والعمامة. كانت تتصدّر نشرات الأخبار في وسائل الاعلام المصريّة خصوصا صوت العرب:” رجال الدّين يقودون المظاهرات في القدس”! وهذه الأخبار كانت تشكّل دافعا لنا لمواصلة التّظاهر.
ولامتصاص الغضب الشّعبيّ صدرت الأوامر بتدريب طلبة المدارس الثّانويّين على السّلاح، وفعلا تمّ تدريبهم على استعمال البندقيّة و “البرنّ” الانجليزيّة، التي خاضت فيها بريطانيا الحرب العالميّة الأولى.
وقد أظهر ذلك العدوان الاسرائيليّ النّوايا الاسرائيليّة بالتّخطيط لحرب قادمة في المنطقة، وهذا ما كان في حرب حزيران 1967.
امتحان الثّانويّة العامّة –التّوجيهي-
في نهاية –أيّار- 1967 تقدّمنا لامتحان التّوجيهي الحكوميّ، وبعده بأسبوعين سنجتاز الامتحان العامّ للثّانويّة الشّرعيّة، كانت المنطقة تعيش أجواء حرب، حيث تمّ حشد الجيوش، ووسائل الاعلام تبثّ الأناشيد الحربيّة، والخطب الرّنّانة.
قاعة الامتحان المخصّصة لمدرستنا في المدرسة العمريّة، نفس القاعة التي اجتزنا فيها “مترك السّادس الابتدائيّ”.
صباح الخامس من حزيران، الذي يصادف عيد ميلادي الثّامن عشر –حسب ما هو مسجّل بشهادة ميلادي- ونحن في قاعة الامتحان، طلب المراقبون منّا فور دخولنا قاعة الامتحان في الثّامنة صباحا أن نحاول انهاء أجوبتنا بسرعة فائقة، لكنّهم لم يخبرونا أنّ الحرب اندلعت على الجبهة المصريّة، كنّا نسمع بوضوح نداءات الدّفاع المدنيّ عبر مكبّرات الصّوت المحمولة على سيّارات تجوب شوارع المدينة وتنادي:
“على المواطنين جميعهم اخلاء الشّوارع، والعودة إلى بيوتهم بالسّرعة الممكنة.” فأصبح معلوما لدينا أنّ الحرب قد اندلعت.
أنهيت إجاباتي وخرجت من القاعة، قريبا من مدخل المدرسة هناك مقهى صغير، صوت المذياع منه يرتفع معلنا سقوط 23 طائرة حربيّة اسرائيليّة أغارت على المطارات المصريّة. خرجت من باب المغاربة بعد أن منعنا رجال الشّرطة عند باب العمود من الوصول إلى محطّة الباصات، لأنّ حركة المرور توقّفت وشوارع المدينة تكاد تكون خالية من المارّة ومن السّيّارات أيضا. عدت إلى البيت مشيا على الأقدام مع عدد من طالبات وطلاب أبناء قريتنا، مرورا بسلوان.
بدأنا نستمع للأخبار، وكان “صوت العرب من القاهرة” هو المحطّة الاذاعيّة المحبّبة لدينا.
عند العاشرة صباحا اشتعلت الحرب على الجبهة الأردنيّة، دارت المعارك الطّاحنة في جنين والقدس، وأصبح جبل المكبّر ساحة حرب.
وسط لعلعة الرّصاص وهدير المدافع، وعند ساعات المساء أعلن النّاطق العسكريّ الأردنيّ أنّ الأوامر صدرت للجيش بالانسحاب إلى خطّ الدّفاع الثّاني، ولم نعرف أنّ ذلك الخطّ هو نهر الأردنّ إلا في الأيّام اللاحقة. هربنا إلى البراري، فقريتنا إحدى القرى الأماميّة، وفيها جرت معركة حيث واجه الجنود الأردنيّون المسلّحون بالبنادق ببسالة الدّبّابات اللاسرائيلية، وتعرّضوا للقصف من الطّيران الاسرائيليّ، وسقط منهم عشرات الشّهداء.
هرب عشرات آلاف البشر من القدس والقرى المجاورة إلى البراري أيضا، الطّيران الاسرائيليّ يجوب أجواء المنطقة ليل نهار، يلقي بحممه على الدّروع والسّيّارات العسكريّة. بعض المواطنين واصلوا طريقهم شرقا باتّجاه الضّفّة الشّرقيّة.
تأكّدنا أنّ الهزيمة قد حلّت، خصوصا بعد اعلان الرّئيس المصري جمال عبد النّاصر استقالته في 9 حزيران معلنا مسؤوليّته عن الهزيمة، لكنّ عاد وسحبها استجابة لملايين المتظاهرين، الذين خرجوا مطالبين بعودته.
كانت الهزيمة صادمة للجميع، فأكثر النّاس تشاؤما كانوا يتوقّعون أنّه إن لم يتمّ تحرير المحتلّ من فلسطين في نكبة العام 1948، فإنّه يستحيل على اسرائيل أن تحتّلّ أراضي جديدة، بل إنّ أحدا لم يفكّر بأنّ اسرائيل ستحتّل أراض جديدة.
لم ينزح من أبناء قريتنا إلى الضّفّة الشّرقيّة سوى من كانوا يعملون فيها أو في دول الخليج أو مغتربين في دول أخرى، فلحقت بهم أسرهم، كما انقطعت السّبل بطلاب الجامعات الذين كانوا يدرسون في جامعات عربيّة وأجنبيّة. والفضل في عدم نزوحنا الجماعيّ يعود للشّيخ حسين ابراهيم شقير مختارنا، الذي كان يقول للمواطنين:
هذه حرب بين دول و”من يترك داره يقلّ مقداره”، وقال بأنّ هناك فلسطينيّين بقوا في ديارهم عام 1948، ولا يزالون يعيشون فيها.
كما أنّ اسراع اسرائيل في الاعلان عن وصول جيشها إلى نهر الأردنّ، ونسفها للجسور كان له دور أيضا في منع النّزوح، مع أنّ الحكومة الاسرائيليّة استغلّت حالة الهلع بين النّاس؛ لتتخلّص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيّين، تماما مثلما فعلت في حرب العام 1948، فكان باصات شركة “إيجد” التي تحتكر حركة المواصلات العامّة في اسرائيل، تجوب شوارع المدن والقرى بصحبة دوريّات عسكريّة، معلنة استعدادها لنقل المواطنين إلى نهر الأردنّ مجّانا.
بدأت جرّافات الاحتلال بهدم حارتي المغاربة والشّرف المحاذيتين لحائط البراق، الحائط الغربيّ للمسجد الأقصى قبل سكوت هدير المدافع، تمهيدا لبناء حيّ يهوديّ في المكان داخل أسوار القدس القديمة.
ما علينا، اندلعت الحرب وقد تبقّى على طلبة التّوجيهي مادّتي التّاريخ والفلسفة، ولاحقا أعلنت وزارة التّربية والتعليم إعفاء الطلبة منهما. الصدمة كبيرة جدّا وتفوق الخيال، وألحقت الضّرر بالمواطنين جميعهم، فعدا عن الخسائر البشريّة والمادّيّة التي نتجت عن الحرب، فإنّ نتائجها النّفسيّة كانت ظاهرة للجميع، فخسارة الوطن لا تعادلها خسارة أخرى فقد أصبحت فلسطين التّاريخيّة من بحرها إلى نهرها تحت الاحتلال، إضافة إلى صحراء سيناء المصريّة ومرتفعات الجولان السّوريّة، ومزارع شبعا اللبنانيّة.
أكثر المتضرّرين من الحرب هم أبناء جيلنا، الذين تحطّمت كلّ طموحاتهم في استكمال تحصيلهم الجامعيّ، وبناء مستقبل كنّا نحلم به. كنت أبني آمالا بأن أستكمل دراستي الجامعيّة، وأن أدرس اللغة العربيّة وآدابها. وقْعُ الهزيمة عليّ كان أكبر من قدرتي على الاحتمال، كنت أصعد إلى قمّة جبل المنطار وأنظر إلى القدس باكيا، أنام ليلي باكيا، أحلم أحلاما سوداويّة مزعجة لا نهاية لها، قرّرت العودة إلى بيتنا في جبل المكبّر، عدت بعد أسبوع من انتهاء الحرب برفقة والدي الذي جاء ليأخذ حمولة البغل من الطّحين، الرّز، العدس وأشياء أخرى، انتظارا لدراسة المحصول على البيادر في البرّيّة. رفعنا سروال أبي الأبيض على زاوية حبل الغسيل أمام بيتنا، دلالة على الاستسلام، عاد أبي إلى البرّيّة وبقيت في البيت وحدي، نمت ليلتي وحدي قلقا، في اليوم التّالي عدت ثانية إلى البرّية.
قمنا بدراسة محصولنا من الحبوب على الدّواب، ورجعنا إلى بيتنا في المكبّر جميعنا. سمعنا نتائج التّوجيهي من الإذاعة الأردنيّة في عمّان، حيث نجحنا أنا وشقيقي ابراهيم.
راجعت مدرستي بخصوص امتحان الثّانويّة الشّرعيّة العامّ، فوضعت إدارة المدرسة الجديدة بقيادة الأستاذ عكرمة سعيد صبري برنامجا لمن تبقّى من الطلاب في الأراضي المحتلّة. اجتزت الامتحان بتفوّق رغم الظّروف السّيّئة المحيطة، وهذا أهّلني للالتحاق بكلّيّة الشّريعة في الجامعة الأردنيّة كمنحة دراسيّة، لكنّ الجسور مغلقة، فعمّان أصبحت بعيدة عنا رغم قربها، والوصول إليها بات شبه مستحيل، ووجدت نفسي بين خيارين هما:
الالتحاق بالجامعة ومغادرة الوطن. أو البقاء في الوطن حتّى ينتهي الاحتلال، فاخترت البقاء في الوطن، فأن تكون في قفص لا أبواب له خير من أن تصبح مشرّدا، وبدأت عذاباتنا وامتهان كرامتنا، واستباحة حياتنا منذ ذلك التّاريخ، لكنّني لم أتخلّ ولو للحظة عن حلمي باستكمال تعليمي الجامعي.
ملحق: ألعاب الأطفال
لم تكن ألعاب الأطفال معروفة لدى الأهالي، لذا فإن الأطفال ابتدعوا ألعابهم الشّعبيّة التي لا تكلّف الأهالي شيئا، ومن هذه الألعاب التي لعبتها أو شاركت بها:
– الطّابة:
لم تتوفّر لنا طابات للعب، علما أنّ هناك طابات يتراوح سعرها بين نصف قرش أردني إلى قرشين، وكنّا نصنع طابتنا من قطع القماش الملقاة في “المزابل”، حيث تجمع وتطوى بشكل دائريّ، وغالبا ما تكون في بقايا كلسات “جورب مهترئ”، ويوضع فيها حجر لتصبح ثقيلة.
المباطحة:
كان الأطفال يمارسون بعض الألعاب الرّياضيّة التي تبعث فيهم نشوة الرّجولة وتفرغ الطاقات الكامنة فيهم، مثل لعبة المباطحة (وهي محاولة طرح الخصم أرضا)، ويتبارون فيما بينهم في رفع حجر ثقيل، أو رمي حجر إلى مسافة بعيدة، أو التّصويب نحو هدف بارز ومحاولة إصابته، أو تسلّق (سنسلة) أو جدار عال، أو الجري بسرعة فائقة، أو القفز عن جدار عال.
– السبع “صرارات”حجارة:
كنّا نجمع سبع قطع حجرية ونضعها فوق بعضها البعض، ويهدمها أحد اللاعبين “بالطّابة” ويحاول الفريق بناءها مرّة أخرى وهكذا.
– البنانير “الجلول”: وهي كرات زجاجيّة دائريّة.
– الإكس: كنّا نرسم على أرض منبسطة ستّ مربّعات، كلّ ثلاثة منها بجانب، ونأتي بحجر رقيق” شحفة” يدفعها اللاعب منّا بأصابع قدمه وهو يحجل على قدم واحدة، ويمرّ بها المربّعات الستّة دون أن تقف على أيّ من خطوط المربّعات، وإذا ما توقّفت على خطّ من خطوط أيّ مربّع فإنّه يخسر، وهذه لعبة كانت البنات يمارسنها أكثر من الأولاد.
– القرعة بإخفاء صرارة (حصاة صغيرة) في اليد:
يقوم أحد الأطفال بإخفاء صرارة (حصاة صغيرة) صغيرة في إحدى يديه خلف ظهره، حتى لا يرى الخصم أين سيضعها؛ ويضمّ يديه بإحكام ويمدّهما إلى الأمام، ويطلب من زميله معرفة اليد التي يخفي فيها الصّرارة؛ فإذا عرفها كان الدّور له، وإذا أخطأ كان الدّور لزميله، وهو الذي يبدأ باللعب أوّلا.
– القرعة بالنقود:
وتتمّ بنفس الطريقة التي ذكرناها أعلاه، ولكن بدل الحجر تستخدم قطعة نقود؛ ويحدّد الفريق الخصم وجه العملة، ويلقي الطفل قطعة النقود إلى الأعلى، لتسقط على الأرض؛ فإذا كان وجه العملة هو الذي اختاره الفريق الخصم، يكون هو صاحب الدّور باللعب؛ وإذا كان الوجه الآخر، يكون الدّور للفريق الثاني.
كما يمكن أن تتم هذه القرعة بأن يلقي الطفل قطعة النّقود إلى الأعلى، ويتلقّفها بين يديه، ثم يفتح يده فتظهر قطعة النّقود على راحة كفّه. ويرى الفريقان أيّ وجه من وجهيها إلى الأعلى، ويحدّدون تبعا لذلك الفريق الذي وقع عليه الاختيار.
– القرعة بالقدم:
تجرى هذه القرعة لاختيار الفريق الذي سيبدأ باللعب. يتقدّم طفل من كل فريق، ويقفان قبالة بعضهما البعض، ويتركان بينهما مسافة لا تزيد عن خمسة أمتار، وفي آن واحد يبدأ الطفلان بالتّقارب أحدهما نحو الآخر بخطوات متبادلة، بحيث يخطو كلّ واحد منهم خطوة بالقدم إلى الأمام، واضعا قدمه الخلفيّة أمام قدمه الأماميّة، بحيث يلامس عقب القدم اليمنى مقدّمة القدم اليسرى، ثم ينقل القدم اليسرى إلى الأمام، ليلامس عقب القدم اليسرى مقدّمة القدم اليمنى، وهكذا تتكرّر الخطوات حتّى الخطوة الأخيرة، فإن بقى للذي دوره في الخطوة الأخيرة مسافة كافية؛ ليضع قدمه فيها يكون هو الفائز، وفريقه الذي يبدأ باللعب. وإذا لم تتبقّ مسافة كافية ليضع قدمه فيها، ووطأت قدمه قدم زميله، يكون هو الخاسر؛ وفريق زميله هو الفائز، وهو الذي يبدأ باللعب.
– شدّ الحبل:
تعتمد هذه اللعبة على قوة العضلات وحفظ التّوازن، ويمارسها الأطفال الذّكور في ساعات النّهار في الحارة أو في ساحة عامّة أو في ملعب المدرسة، ولا يقلّ عددهم عن 10 لاعبين، وأعمارهم فوق 12 عاما، وأدواتها حبل سميك وطويل.
كنّا ننقسم إلى فريقين متساويين، يقف الفريق الأوّل إلى جهة اليمين؛ بينما يقف الثّاني مقابله (إلى جهة اليسار). يتمّ رسم خطّ فاصل طولي في منتصف المسافة بين الفريقين؛ ويقف الفريقان على بعد متماثل من الخطّ الفاصل، وهو مترين تقريبا، وتشكل منطقة النّفوذ لكلّ فريق. يمسك كل لاعب من الفريق أحد طرفي الحبل ويضعه تحت ذراعه؛ بينما يسمك الفريق الآخر بالطّرف الثّاني للحبل، ويوضع منتصف الحبل فوق الخطّ الفاصل.
يقوم الحكم أو من في حكمه بإعطاء إشارة البدء باللعب، ويبدأ كلّ فريق على الفور بشدّ الحبل بكلّ قوّة إلى جهته، ويتعالى هتاف وصياح الأطفال المتفرّجين، وهم يشجّعون كلا الفريقين. يستمرّ الطرفان في شدّ الحبل كلّ من جهته، حتّى ينجح أحدهما بسحب الفريق الآخر باتّجاهه، وعندما يتجاوز الفريق (المسحوب) خطّ الوسط، ويدخل منطقة سيطرة الخصم، يكون هو الخاسر، والفريق الثّاني (السّاحب) هو الفائز.
– مطاقشة البيض:
كانت أمّهاتنا يربّين الدّجاج البلديّ البيّاض، بما يكفي حاجة البيت من البيض، والبعض كان لديهم فائض في الانتاج للبيع، وفي حال رقدت الدّجاجة على البيض وتفقيس صيصان جديدة، كنّا نذبح الدّيكة ونأكل لحومها، باستثناء ديك واحد يبقى ذَكَرا للدّجاجات، كنّا نأخذ بضع بيضات ونلتقي مع أطفال الجيران والحارة، الذين يأتي كلّ واحد منهم ببضع بيضات من بيته، لنلعب بها لعبة “المطاقشة”، وطريقة لعبة “مطاقشة البيض”، هي أن يضرب أحد الأطفال بيضته ببيضة الطفل الآخر، مثلا رأس البيضة برأس بيضة أخرى، أو قاع البيضة بقاع بيضة أخرى وهكذا؛ فإذا طقش أحد الأطفال بيضة الخصم) أي كسرها، صارت البيضة المكسورة من حق الطفل الذي كسرها، على أن تبقى بيضته (بيضة الطفل الفائز) سليمة؛ فإذا انكسرت بيضته هو أيضا، خسر حقّه في بيضة الخصم، أي اعتبر الطفلان متعادلين.
وتمارس اللعبة بفنّيّة ودراية عالية، من خلال معرفة كلّ لاعب أضعف الأماكن وأصلبها في قشرة البيض، والزّاوية التي يجب أن يضرب بها بيضة الخصم.
– ياعمّي وين الطريق:
هذه اللعبة كنّا نلعبها أولادا وبنات من الجنسين البنات والأولاد. حيث نربط عيني اللاعب الذي وقع عليه الاختيار بمحرمة أو قطعة من القماش لمنعه من الرؤية، ويأخذ هذا اللاعب بترديد:
– ياعمّى وين الطريق؟
– فيجيبه الجميع:
– قدّامك حجر وإبريق.
– ياعمّى وين الطريق؟
– قدّامك حجر وإبريق.
ويحاول الطفل معصوب العينين الإمساك بأحد اللاعبين الذين يدورون حوله، ويتنقلّون من مكان لآخر، مصدرين أصواتا بقصد ارباكه واستفزازه، وإظهار عدم قدرته على الإمساك بهم، ويتتبّع الأصوات والحركات الصّادرة عن رفاقه، ويحاول الإمساك بأحدهم معتمدا على مصدر الأصوات، ويسترق النّظر من تحت غطاء العين؛ ليرى أقرب الأطفال إليه، كي ينقضّ عليه بلمح البصر. ولا تحلّ المحرمة أو قطعة القماش عن عين اللاعب إلاّ إذا استطاع أن يمسك بأحدهم؛ ليحلّ محلّه في المطاردة. فإن نجح في ذلك، نزعت العصبة عن عينيه، وجعلت على عينيّ الطفل الممسوك، لتبدأ اللعبة من جديد.
– نطّ الحبل:
كنّا في طفولتنا نمارسها أولادا، وإن كانت تستهوي البنات أكثر من الأولاد، يقف اثنان بصورة متقابلة وجها لوجه، يمسك كلّ واحدة منهم بأحد طرفي الحبل؛ بينما يقف الثّالث في منتصف المسافة بينهما. يبدأ المتقابلان بتحريك الحبل بشكل دائريّ باتجاه عقارب السّاعة (من اليسار إلى اليمين) بحيث يمرّ في كلّ مرّة من فوق رأس اللاعب الذي يقف في الوسط ومن تحت قدميه، ويبدأ هذا اللاعب بالقفز؛ ليسمح للحبل بالمرور من تحت قدميه، والانحناء عندما يمرّ من فوق رأسه، وعند كلّ دورة للحبل يردّد الممسكان بالحبل كلمات مثل: “حدره بدره عمّي قال لي عد لعشره…واحد، اثنين…ثلاثه……عشره” ويتكرّر ذلك في كلّ مرّة، وإذا ما اصطدم الحبل بساق اللاعب أثناء مروره من تحته، فإنّه يخسر دوره ليدخل لاعبا غيره. ومن الممكن أن لا يقف اللاعب الثّالث في الوسط، وإنّما يقفز إلى منتصف الحبل بعد أن يقوم الممسكان بالحبل بتحريكه. وإذا ما تعب اللاعب الذي يقفز فوق الحبل وأراد أن يأخذ قسطا من الرّاحة، فيحق له أن يخرج من منطقة القفز لكن دون أن يتعثّر، ويحلّ مكانه لاعب آخر، وبذلك يحتفظ بدوره ليعيد اللعب مرّة ثانية بعد الاستراحة.
كما يمكن أن يمارس اللاعب هذه اللعبة وحده، حيث يمسك بكلتا يديه طرفي الحبل، ويقوم بتحريكه بشكل دائري من اليسار إلى اليمين، ويمرّره في كلّ مرة فوق رأسه ومن تحت قدميه… وهكذا.
ولعبة نطّ الحبل غالبا ما كانت تمارسها البنات.
– عسكر وحرامية:
يلعبها الأطفال الذّكور في الغالب، وتقوم على مبدأ الصّراع بين الخير والشّرّ. تتكون اللعبة من فريقين متساويين في العدد.
تحدّد منطقة اللعب، التي سيتمّ فيها مطاردة “الحراميّة” الهاربين، والتي لا يجوز تجاوزها والذّهاب إلى أبعد منها، كما يُحدّد أحد اللاعبين المكان الذي سيكون بمثابة سجن للحراميّة عند إلقاء القبض عليهم، وقد يكون ذلك جدارا أو دائرة ترسم على الأرض، أو توضع بعض الحجارة بشكل مربّع أو دائريّ، لتكون هي السّجن، ويكون على السّجن حارس أو أكثر من العسكر يحرسونه، ويمنعون الحراميّة من الاقتراب منه، لئلا يقوموا بتحرير زملائهم المسجونين.
كنّا ننقسم إلى فريقين، يقوم أحدهما بدور العسكر ويقوم الآخر بدور الحراميّة. وتجرى القرعة بينهما لتحديد من سيكون فريق العسكر، ومن سيكون فريق الحراميّة. يقوم فريق الحرامية بسرقة أيّ شيء من أحد أفراد الفريق الآخر “العسكر” كقميص أحدهم، ويهربون في كلّ اتجاه، لإرباك العسكر، وتشتيت تركيزهم. بعد ذلك يصدر قائد العسكر الأمر بإلقاء القبض على الحراميّة، ووضعهم في السّجن، فيبدأ العسكر بملاحقة الحراميّة والبحث عنهم في مخابئهم ومطاردتهم من مكان لآخر، ويستخدم العسكر أيديهم بشكل مسدّسات، أو يحملون قطعا خشبية أو معدنيّة تمثّل المسدّسات، وقد يصدرون أصواتا تشبه صوت اطلاق النار؛ فإذا تمكّن أحد العساكر من الإمساك بأحد الحراميّة، وضعه في السّجن، بينما يحاول رفاقه إخراجه منه، ويحرص الحارس أن لا يقترب أحد الحراميّة من السّجن؛ لأنّه إذا نجح واقترب ولمس أحد المساجين اعتبر محرّرا. وقد ينجح أحد الحراميّة (منتهزا فرصة انشغال الحارس في تعقّب أحد الحراميّة ومنعه من الاقتراب من السّجن) بتخليص أحد زملائه المسجونين بسحبه خارج السجن، ويعتبر عندئذ طليقا محرّرا. ويستطيع الحرامي إخراج عدّة لاعبين مرّة واحدة إذا استطاع سحبهم خارج دائرة السّجن. وقد يحدث أثناء محاولة الحرامي تخليص زميله من السّجن أن يُلقي الحارس القبض عليه أيضا، فيصبح هو الآخر سجينا كزميله.
وإذا فشل العسكر في وضع الحراميّة جميعهم في السّجن، اعتبروا خاسرين، وعاودوا ملاحقة الحراميّة مرّة ثانية؛ أمّا إذا نجح العسكر في وضع الحرامية جميعهم في السّجن، فذلك انتصار لهم، وهزيمة للحراميّة. ويتمّ تبادل الأدوار بين الفريقين؛ حيث يصبح فريق العسكر هم الحراميّة، وفريق الحراميّة هم العسكر، وهكذا تستمرّ اللعبة.
– الحاكم، اللصّ، الجلاد والمجلود:
تحتاج هذه اللعبة إلى أربعة أشخاص، كنّا نجلس على الأرض بشكل دائرة في ساحة البيت أو في الحارة أو في الخلاء.
يتم تحضير أربع قصاصات من الورق، ونكتب على كلّ منها كلمة من الآتية:”حاكم، جلاد، لص، ومجلود “. يبدأ اللعب أحد الأطفال بعد إجراء القرعة، ويقوم برمي الأوراق بعد طيّها في الهواء؛ فيتخاطف اللاعبون كل واحد ورقة، ومن تكون “ورقة المجلود” من نصيبه يقوم الحاكم بإصدار الأمر إلى الجلاد بضربه بمسطرة أو “كشاط”عدد الضربات التي يحكم بها الحاكم، ويحدّد الحاكم نوع الضّرب، فيقول خفيف، أو متوسّط، أو ضربا مؤلما. ويمكن أن يصدر الحاكم حكما غير الجلد، كأن يطلب من اللاعب بدلا من الجلد أن يقوم بأداء عمل ما، مثل الطلب منه الذّهاب لإحضار الحطب… إلخ. وهذا طبعا يتمّ الاتّفاق عليه قبل البدء باللعبة.
– طاق طاق طاقية:
كنّا نلعب هذه اللعبة أولادا وبنات، وبعد سنّ العاشرة غالبا ما كان كلّ جنس يلعبها مع أبناء جنسه.
عند ممارسة اللعبة، كنّا نجلس على الأرض بشكل دائريّ، ويقوم من وقع عليه الاختيار بالدّوران حول الفتيان الجالسين، وهو يحمل بيده طاقيّة أو محرمة (منديل) ويدور دورة كاملة وهو يردّد:
“طاق طاق طاقية، طاقيتين بعليِّة
رن رن يا جرس، حوّل واركب عَ الفرس”.
وطيلة دورانه لا يجوز للأطفال الجالسين الالتفات أو النّظر إلى الخلف. وأثناء دورانه يختار من الجالسين في الدائرة أحد الفتية، وبخفّة يد ودون أن يشعر بها أحد يقوم بوضع الطاقية وراء ظهر الفتى الذي اختاره، ويسرع بالدّوران حتى يبتعد عن هذا الفتى تحسّبا من أن يشعر بوضعها ويلحقه يضربه بها. وإذا انتبه الطفل الجالس في الدّائرة عند وضع زميله الطاقيّة وراء ظهره، التقطها في الحال ونهض مسرعا ولحق بزميله؛ ليضربه بها قبل أن يكمل الدّوران حول الحلقة الدّائريّة؛ وإذا أفلح زميله في الوصول إلى المكان الذي نهض منه وجلس مكانه قبل أن يمسك به أو يضربه بالطاقيّة اعتبر خاسرا؛ ويأخذ دور زميله بالدّوران حول الفتيان الجالسين في الدّائرة؛ أمّا إذا لحق به وضربه بالطاقية فيعتبر هو فائزا وزميله خارجا من اللعبة، ويجلس في وسط الدّائرة، ويصبح هو صاحب الدّور بدل زميله الخاسر. وإذا أكمل الفتى الدّوران حول رفاقه دون أن ينتبه مَنْ وضعت خلفه الطّاقية، فإنّه عندما يصله يلتقط الطاقية من وراء ظهره ويضربه بها على رأسه، فينهض في الحال ويلف حول رفاقه الجالسين في الدّائرة، عقابا له على عدم انتباهه، مع الأخذ بترديد عبارة:
طاق طاق طاقية.
رن رن يا جرس.
حول واركب ع الفرس.
وهكذا تستمر اللعبة.
الكال:
الكال مفرد كالات، والكالات معناها “الحجارة الصّغيرة تعتمد هذه اللعبة على مهارة الرّمي واللقف وخفّة الحركة، وتُستخدم فيها خمس قطع حجارة صغيرة “حصوات”.
لهذه اللعبة قواعد مختلفة وطرق عديدة، وإن كانت جميعها تتشابه من حيث طريقة الآداء. تلعبها البنات الصغيرات بشكل مبسّط، بينما تلعبها الفتيات الكبيرات بشكل أكثر تعقيدا. وطريقة اللعب التالية كانت من أكثر الطرق انتشارا بين البنات:
تجلس البنات على الأرض أو على مصطبة أو على بساط أو حصير. تبدأ اللعبة عن طريق القرعة، وتقوم البنت صاحبة الدّور برمي أربعة حصوات على الأرض أو على المصطبة، وتبقي حصاة واحدة في يدها. تقوم بالتقاط إحدى الحصوات وقذفها إلى أعلى، وقبل أن تلقف الحصاة السّاقطة من أعلى، تكون قد التقطت حصاة أخرى من الأرض؛ فيصبح في يدها حصوتان. تعيد البنت الكرة مرة ثانية وترمي بالحصاة إلى أعلى، وتلتقط حصاة ثانية من الأرض؛ فيصبح في يدها ثلاث حصوات. وفي المرة الثالثة تلقي بالحصاة إلى أعلى وتلتقط الحصاة الرابعة من الأرض؛ فيصبح عندئذٍ في يدها خمس حصوات.
فإذا نجحت اللاعبة في ذلك، كانت هي الفائزة بالدّور، وإذا سقطت إحدى الحصوات على الأرض أثناء اللعب، فإنّ اللاعبة تخسر دورها في اللعب، وينتقل إلى إحدى زميلاتها. وفي نهاية اللعب، تكون البنت الفائزة من أحرزت نقاطا أكثر من غيرها.
لعبة الشّعبة أو المغيطة:
الشّعبة أو النّقيفة أو المغّيطة أو الجبّادة لعبة قديمة من ألعاب الأطفال الذّكور. والشّعبة عبارة عن شريطين رفيعين من المطّاط متساويان في الطّول حوالي 30 سم، وبعرض ما بين 1- 1.5 سم، تقصّ عادة من الإطار الدّاخليّ للدّرّاجات الهوائيّة، ويتمّ قطع عود ذي شعبتين على شكل حرف”Y ” بالانجليزية من غصن شجرة رفيع عند نقطة تفرّع الغصن. ثم تقصّ قطعة من الجلد بطول 8 سم وبعرض 4 سم، ويتم شقّها من طرفيها، بحيث يكون الشقّ بعرض وسمك شريط المطاط، ثم يربط كلّ طرف للمطّاط في الشّق في طرفي الجلدة، بينما يثبت الطّرف الأخر لكلا شريطي المطاط على طرفي الشّعبة من أعلى، ويتمّ ربطهما بإحكام.
يختار الطفل حجارة صغيرة مناسبة، وشبه دائريّة. يضع الطّفل الحجر في وسط الجلدة، ويمسكها بإصبعيه الإبهام والسّبابة من إحدى يديه؛ بينما يمسك الطّرف السّفليّ من الشّعبة بيده الأخرى. يصوّب نحو هدف محدّد ويجعله في وسط الشّعبة الأعلى منها. يشدّ الشّعبة إلى أقصى امتداد إلى الأمام، في الاتّجاه المعاكس للجلدة التي بها الحجر، بينما تبقى اليد التي تمسك الجلدة ثابتة، وفي اللحظة المناسبة يحرّر الجلدة من اليد التي تمسك بها (خاصّة إذا كان الهدف متحركا) مع إبقاء اليد الأخرى التي تمسك بالشّعبة ثابتة، فيندفع الحجر بقوّة باتّجاه الهدف المحدّد؛ فإذا كان التّصويب جيّدا وموجّها بالشّكل الصّحيح نحو مركز الهدف، فإنّه ينجح في إصابة الهدف؛ وإذا لم يكن التّسديد صحيحا، أو لم تثبت اليد التي يمسك بها الشّعبة نتيجة لردّ الفعل النّاتج عن تحرير الجلدة وانطلاق الحجر، فإنّه يفشل في الإصابة. وهذا بالطبع يعتمد على مدى مهارة اللاعب في التّسديد والإصابة.
واستخدم الأطفال الشّعبة كأداة لصيد العصافير والطّيور، وللتّنافس فيما بينهم على إصابة أهداف محددة، أو لإطلاق الحجر إلى أبعد مسافة يستطيع أحدهم الوصول إليها دون الآخرين، محاولا إظهار مهارته وإمكانياته ومواهبه في ذلك. كما استخدمها الأطفال لتراشق الحجارة فيما بينهم، خاصة مع أطفال من حارة مجاورة، عند نشوب خلاف معهم.
– المقليعة:
من ألعاب الأطفال الذّكور. يتنافس فيها الأطفال على إصابة هدف معين.
أجزاؤها: حبلان رفيعان، وجلدة عريضة.
يتمّ إحضار شريطين أو حبلين رفيعين من القماش أو من خيطان الصوف المجدولة، يكون طولهما بين 40-80 سم، وقطعة من الجلد بطول 10-12 سم وبعرض 4-6 سم، تثقب من طرفيها ويربط طرفي الحبلين بها. يتم عمل عُقدة في نهاية كلّ حبل، ليسهل تثبيتهما عند التّلويح بهما بشكل دائريّ. توضع إحدى العقدتين بين إصبعي السّبابة والوسطى، بينما يمسك اللاعب الحبل الثّاني بقبضة يده؛ ليسهل تحريره عند الوصول إلى اللحظة المناسبة لقذف الحجر، يمسك اللاعب الرامي الحبلين بشكل طولي، ويضع حجرا في الجلدة، وهو مركز استقرار الحجر. ويتناسب طول الحبل تناسبا طرديّا مع طول المسافة بين اللاعب الرّامي والهدف المقصود؛ وكلّما كانت المسافة أكبر تطلب أن يكون الحبل أطول؛ وبالعكس؛ ويجب أن يكون طولهما مناسبا لطول الطِّفل.
وتعتمد قوة انطلاق الحجر على وزنه، وعلى قوة الرّامي، وطول أذرع المقلاع، وسرعة التّلويح.
يقف اللاعب قبالة الهدف المحدّد، ويمسك بطرفي الحبلين جيّدا؛ بينما تتدلّى الجلدة إلى أسفل بفعل ثقل الحجر، ويبدأ اللاعب بالتّلويح بشكل دائريّ وبشكل متسارع؛ حيث يكون في البداية بطيئا ومن أسفل إلى أعلى؛ ورويدا رويدا، تزداد السّرعة، ويبدأ اللاعب الانحناء بذراعه تدريجيّا والتّحول إلى التّلويح الأفقيّ، أي فوق رأس اللاعب، ويستمرّ في التّلويح عدّة مرّات مع ازدياد السّرعة؛ وبعد التّلويح عدّة مرّات، وفي لحظة معينة وحسب تقدير وخبرة ومهارة اللاعب، من حيث دقّة التّسديد وكفاية القوّة الدّافعة، التي تحقّق أكبر قوّة لانطلاق الحجر، يحرّر الرامي أحد الحبلين بطريقة فنّيّة، دافعا الحجر بقوة كبيرة إلى الأمام باتّجاه الهدف المقصود.
– الحصان:
يلعبها الذّكور من الأطفال في الحارة أو في فناء البيت في عمر أقلّ من سبع سنوات. حيث يأخذ كلّ طفل منّا عصا طويلة وعصا أخرى صغيرة، ويمسك بأحد طرفي العصا الكبيرة بيده اليسرى ويضعها بين رجليه، بينما يبقى طرف العصا الآخر يجرُّ على الأرض. وتمثل العصا الطويلة حصانا يركبه الطفل، بينما العصا القصيرة تكون بمثابة السّوط التي يضرب به الحصان.
ونقلّد في هذه اللعبة ركوب الحصان وهي (العصا الطويلة)، ونضربه بالسّوط (العصا القصيرة) ونحن نقول:… دي … دي… دي (وهي كلمة لزجر الخيل).
وقد يمارس الطفل هذه اللعبة أحيانا لوحده في فناء بيته.
ويجدر التّنويه هنا بأنّ أبناء جيلنا ومن سبقونا، وقليل من لاحقينا، كانوا يتعوّدون ركوب الحمير والبغال والخيل منذ نعومة أظفارهم، لكن من كانوا في سنّ ما قبل الخامسة، فقد كانوا يمتطون هذه الدّواب أمام أو خلف أحد والديهم أو أقاربهم.
وكان الفتيان يشاركون الرّاشدين في سباقات شبه أسبوعيّة، ومن يخسر من الكبار يذبح شاة ويعمل وليمة للمتسابقين على شرف الفائز الأوّل حتّى لو كان طفلا.
السّيّارة:
كنّا نبحث عن أسلاك بسمك مليمتر واحد تقريبا، لنعمل منها سيّارة بأربع عجلات، ثمّ نعمل لها مقودا بعصا يمسكها الواحد منّا بيده وهو واقف، ليحرّك بها سيّارته التي تكون أمامه، وإذا ما أردنا زيادة وزن السّيّارة، كنّا نضع بين العجلين الأماميّين وبين الخلفيّين علبة سردين نملأها بالتّراب.
السّيجة:
تشبه لعبة السيجة إلى حد بعيد لعبة “الشطرنج” المعروفة، ومازالت حتى الآن تصارع من أجل البقاء، إذ يمارسها الكبار الشباب أو كبار السن في جو تحفه الألفة والمحبة. وتبدأ اللعبة باجتماع اللاعبين الذين يشكلون مجموعات ثنائية، حيث تجد مجموعات على شكل حلقات مكوّنة من لاعبين وجمهور، من خمسة إلى ستة أشخاص للحلقة الواحدة؛ يتابعون مجريات اللعبة، ويتبادلون الخطط والآراء، ويتنقلون من حلقة إلى أخرى لمتابعة مجريات لعبة “السّيجة”مع احتفاظ الجميع بالهدوء الذي يميّز هذه اللعبة؛ حيث يخيم السّكون والتّفكير على الجمهور واللاعبين.
يمارس هذه اللعبة في العادة شخصان، وتتكوّن من 24 حجرا لكلّ لاعب مقسمة إلى اللونين الأبيض والأسود، ويبدأ اللاعبان اللعبة على التّراب من خلال مربع 7×7، في كلّ خطّ أفقي أو عموديّ سبع حُفَر صغيرة. لعبة السيجة مشابهه للعبة الشطرنج من حيث المقابلة وجها لوجه؛ لكنّها تختلف في القوانين والصعوبة في المراوغة والخطط، وتنتهي بأكل السيجة الأكثر، حيث أن اللعبة تعتمد على الذكاء في نزول الحجر في المكان المناسب ومحاصرة الخصم.، وقد يلعبونها في مربّع 5× 5، ولكلّ لاعب 12 حجرا، وغالبا ما كان أحدهم يستعمل حصوات صغيرة، والآخر يستعمل “بَعَرَ” الأغنام الجافّ.
“انتهى”
كانون ثاني –يناير 2018
جميل السلحوت:
– جميل حسين ابراهيم السلحوت
– مولود في جبل المكبر – القدس بتاريخ 5 حزيران1949 ويقيم فيه.
– حاصل على ليسانس أدب عربي من جامعة بيروت العربية.
– عمل مدرسا للغة العربية في المدرسة الرشيدية الثانوية في القدس من 1-9-1977 وحتى 28-2-1990.
– اعتقل من 19-3-1969 وحتى 20-4-1970وخضع بعدها للأقامة الجبرية لمدة ستة شهور.
– عمل محررا في الصحافة من عام 1974-1998في صحف ومجلات الفجر، الكاتب، الشراع، العودة، مع الناس، ورئيس تحرير لصحيفة الصدى الأسبوعية. ورئيس تحرير لمجلة”مع الناس”
– عضو مؤسس لإتحاد الكتاب الفلسطينيين، وعضو هيئته الادارية المنتخب لأكثر من دورة.
– عضو مؤسس لاتحاد الصحفيين الفلسطينيين، وعضو هيئته الادارية المنتخب لأكثر من دورة.
– عمل مديرا للعلاقات العامة في محافظة القدس في السلطة الفلسطينية من شباط 1998 وحتى بداية حزيران 2009.
– عضو مجلس أمناء لأكثر من مؤسسة ثقافية منها: المسرح الوطني الفلسطيني.
– منحته وزارة الثقافة الفلسطينية لقب”شخصية القدس الثقافية للعام 2012″.
– أحد المؤسسين الرئيسيين لندوة اليوم السابع الثقافية الأسبوعية الدورية في المسرح الوطني الفلسطيني والمستمرة منذ آذار العام 1991وحتى الآن.
– جرى تكريمه من عشرات المؤسسات منها: وزارة الثقافة، محافظة القدس، جامعة القدس، بلديّة طولكرم ومكتبتها، المسرح الوطني الفلسطيني، ندوة اليوم السابع، جمعيّة الصداقة والأخوّة الفلسطينيّة الجزائرية، نادي جبل المكبر، دار الجندي للنشر والتوزيع، مبادرة الشباب في جبل المكبر، ملتقى المثقفين المقدسي، جمعية يوم القدس-عمّان، جامعة عبد القادر الجزائريّ، في مدينة قسنطينة الجزائريّة، المجلس الملّي الأرثوذكسي في حيفا.
شارك في عدّة مؤتمرات ولقاءات منها:
– مؤتمر “مخاطر هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين”- حزيران 1990 – عمّان- الأردنّ.
– أسبوع فلسطين الثقافي في احتفالية “الرياض عاصمة الثقافة العربية للعام 2009.”
– أسبوع الثقافة الفلسطيني في احتفالية الجزائر “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية للعام 2015″.
– ملتقى الرواية العربية، رام الله-فلسطين، أيّار-مايو-2017؟
الإصدارات
الأعمال الرّوائيّة
– ظلام النهار-رواية، دار الجندي للطباعة والنشر- القدس –أيلول 2010.
– جنة الجحيم-رواية – دار الجندي للطباعة والنشر- القدس-حزيران 2011.
– هوان النعيم. رواية- دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس-كانون ثاني-يناير-2012.
– برد الصيف-رواية- دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس- آذار-مارس- 2013.
– العسف-رواية-دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس 2014
– أميرة- رواية- دار الجندي للنشر والتوزيع- القدس 2014.
– زمن وضحة- رواية- مكتبة كل شيء- حيفا 2015.
– رولا-رواية- دار الجندي للنّشر والتّوزيع- القدس 2016.
– عذارى في وجه العاصفة-رواية- مكتبة كل شيء-حيفا 2017
– نسيم الشوق-رواية-مكتبة كل شيء-حيفا 2018.
روايات اليافعين
– عشّ الدّبابير-رواية للفتيات والفتيان-منشورات دار الهدى-كفر قرع، تمّوز-يوليو- ٢٠٠٧.
– الحصاد-رواية لليافعين، منشورات الزيزفونة لثقافة الطفل، ٢٠١٤، ببيتونيا-فلسطين.
– البلاد العجيبة- رواية لليافعين- مكتبة كل شيء- حيفا 2014.
– لنّوش”-رواية لليافعين. دار الجندي للنّشر والتوزيع،القدس،2016.
– “اللفتاوية” رواية لليافعين. دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس 2017.
قصص للأطفال
– المخاض، مجموعة قصصيّة للأطفال، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيّين- القدس،1989.
– الغول، قصّة للأطفال، منشورات ثقافة الطفل الفلسطيني-رام الله 2007.
– كلب البراري، مجموعة قصصيّة للأطفال، منشورات غدير،القدس2009.
– الأحفاد الطّيّبون، قصّة للأطفال، منشورات الزّيزفونة لثقافة الطفل، بيتونيا-فلسطين 2016.
– باسل يتعلم الكتابة، قصّة للأطفال، منشورات الزّيزفونة لتنمية ثقافة الطّفل، بيتونيا، فلسطين، 2017.
أبحاث في التّراث.
– شيء من الصراع الطبقي في الحكاية الفلسطينية .منشورات صلاح الدين – القدس 1978.
– صور من الأدب الشعبي الفلسطيني – مشترك مع د. محمد شحادة. منشورات الرواد- القدس 1982.
– مضامين اجتماعية في الحكاية الفلسطينية .منشورات دار الكاتب – القدس-1983.
– القضاء العشائريّ. منشورات دار الاسوار – عكا 1988.
بحث:
– معاناة الأطفال المقدسيّيين تحت الاحتلال، مشترك مع ايمان مصاروة. منشورات مركز القدس للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، القدس 2002
– ثقافة الهبل وتقديس الجهل، منشورات مكتبة كل شيء- جيفا،2017.
أدب ساخر:
– حمار الشيخ.منشورات اتحاد الشباب الفلسطيني -رام الله2000.
– أنا وحماري .منشورات دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع – القدس2003.
أدب الرّحلات
– كنت هناك، من أدب الرّحلات، منشورات وزارة الثّقافة، رام الله-فلسطين، تشرين أوّل-اكتوبر-2012.
– في بلاد العمّ سام، من أدب الرّحلات، منشورات مكتبة كل شيء-حيفا 2016 .
يوميّات
– يوميّات الحزن الدّامي، يوميات،منشورات مكتبة كل شيء الحيفاويّة-حيفا-2016.
أعدّ وحرّر الكتب التّسجيليّة التّالية لندوة اليوم السّابع في المسرح الوطنيّ الفلسطينيّ – الحكواتي سابقا – في القدس :
– يبوس. منشورات المسرح الوطني الفلسطيني – القدس 1997.
– ايلياء. منشورات المسرح الوطني الفلسطيني – القدس تموز 1998.
– قراءات لنماذج من أدب الأطفال. منشورات المسرح الوطني الفلسطيني – القدس كانون اول 2004.
– في أدب الأطفال .منشورات المسرح الوطني الفلسطيني – القدس تموز 2006.
– الحصاد الماتع لندوة اليوم السابع. دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس كانون ثاني-يناير- 2012.
– أدب السجون. دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس-شباط-فبراير-2012.
– نصف الحاضر وكلّ المستقبل.دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس-آذار-مارس-2012.
– أبو الفنون. دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس نيسان 2012.
– حارسة نارنا المقدسة- دار الجندي للنشر والتوزيع- القدس. أيار 2012
– بيارق الكلام لمدينة السلام- دار الجندي للنشر والتوزيع- القدس- ايار 2012.
– نور الغسق- دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس 2013.
– من نوافذ الابداع- دار الجندي للنشر والتوزيع- القدس 2013.
– مدينة الوديان-دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس 2014.