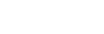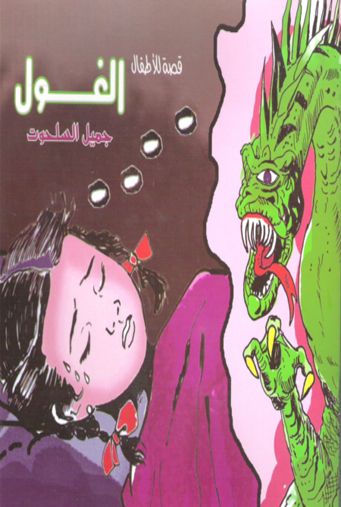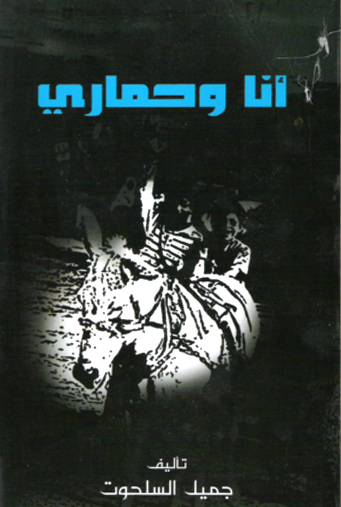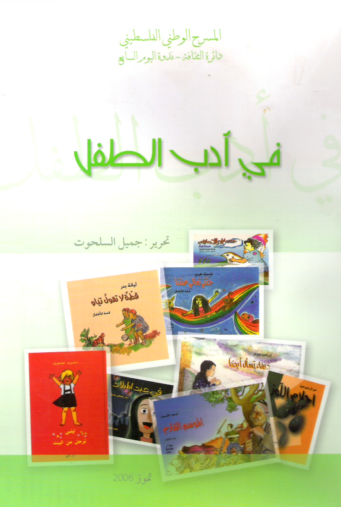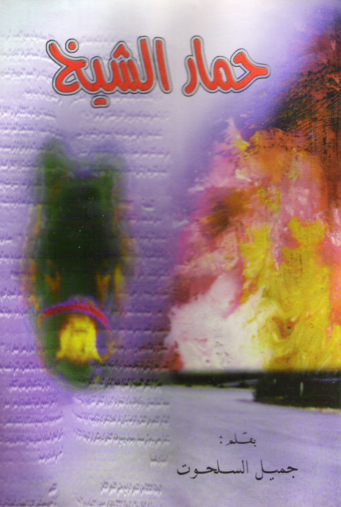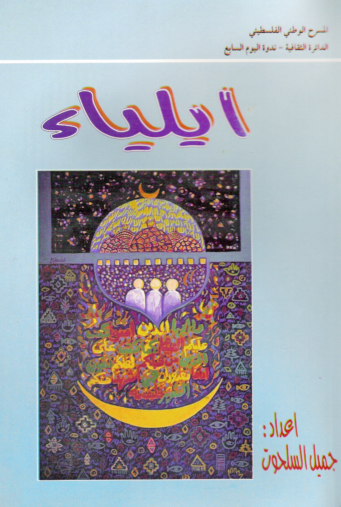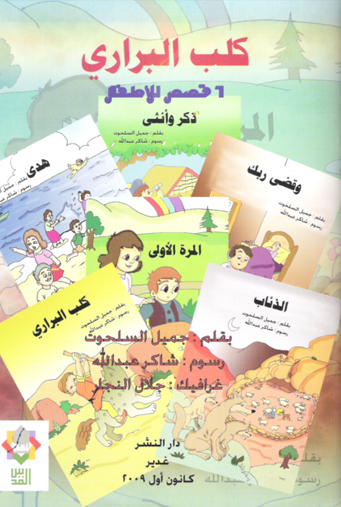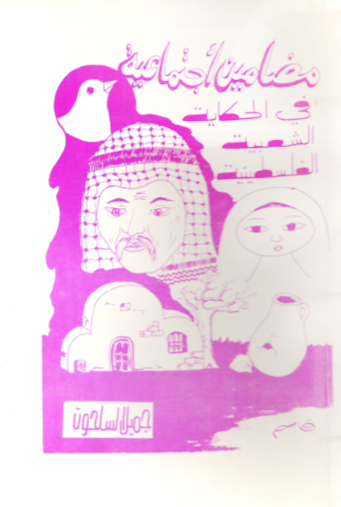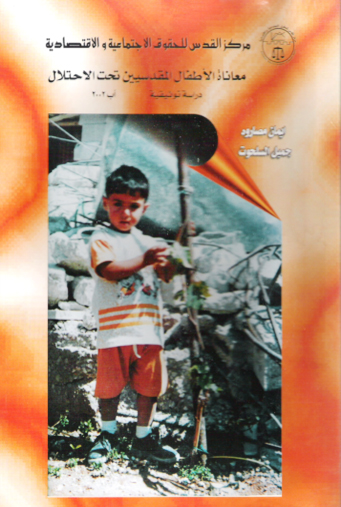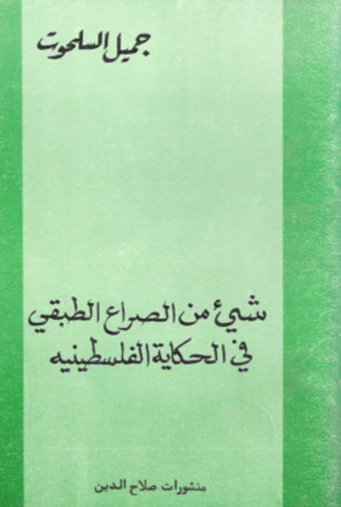القدس 6-11-2025 من ديمة جمعة السّمان
ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية المقدسية الأسبوعية رواية ” غربة” للكاتب الفلسطيني فوزي نجاجرة.
ابتدأت مديرة الندوة ديمة جمعة السمان بالترحيب بالكاتب فوزي نجاجرة وبرواد الندوة وقالت:
نلتقي الليلة لمناقشة رواية «غُربة»، وهي العمل السادس للكاتب فوزي نجاجرة، الصادرة حديثاً عن دار دجلة في العاصمة الأردنية عمان للعام 2025 والتي تقع.في 285 صفحة من القطع المتوسط.
وأضافت: في هذا العمل يواصل الكاتب مشروعه السردي الذي يتناول قضايا الإنسان الفلسطيني من زوايا اجتماعية ونفسية وإنسانية، بلغة واقعية تنقل وجع الغربة وتفاصيل الحياة اليومية بصدق وتجرد. نرحب بضيفنا الكاتب فوزي نجاجرة، المولود في الخامس من أيلول عام 1959 في قرية نحالين قرب بيت لحم، والمقيم حالياً في بيت صفافا بمنطقة القدس.
عمل في مجال التعليم لمدة خمسة عشر عاماً في مؤسسات بيت لحم والقدس ووكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وتقاعد عام 2018. يحمل شهادة البكالوريوس في التربية الابتدائية من جامعة بيت لحم، ودبلوم التربية الخاصة.
عرف عن الكاتب انشغاله المبكر بالأدب، إذ كتب الشعر في ثمانينيات القرن الماضي، ونشر قصائده في صحف الفجر والشعب والقدس، بتشجيع من الأديب الراحل علي الخليلي، قبل أن يتوقف لفترة، ثم يعود إلى الساحة الأدبية من بوابة الرواية.
تعرّض خلال مسيرته لاعتقالات متفرقة، كان أطولها في معتقل النقب عام 1989 لمدة ستة أشهر. أصدر حتى اليوم ست روايات هي: 1. حكايات فالح – 2021 2. الصومعة – 2021 3. ستشرق الشمس ثانية – 2022 4. رقصة التوت – 2023 5. أمضي أم أعود؟ – 2024 6. غُربة – 2025 كما شارك في تأليف خمسة كتب أدبية عربية مشتركة صدرت في الجزائر، وقد تُرجم بعضها إلى اللغتين الإنجليزية واليونانية. وهو الآن يضع اللمسات الأخيرة على رواية جديدة ما زالت في طور المخطوطة.
وأضافت مديرة الندوة السمان: الرواية عمل يحمل في طيّاته فكرة إنسانية عميقة، إذ يحاول أن يتوغّل في دهاليز النفس الفلسطينية التي تتأرجح بين الاغتراب عن الوطن والاغتراب عن الذات.
الفكرة في جوهرها نبيلة، تحاول أن تكشف الغربة المركّبة التي يعيشها الإنسان، رجلاً كان أم امرأة، في مجتمع تتنازعه التقاليد والاحتلال وضغوط الحياة.
يقدّم الكاتب صوراً واقعية لقهر المرأة، ولمعاناتها في بيئة ذكورية تقيّدها باسم العادات والدين والمجتمع، ويُظهر التناقضات التي تعيشها، ما بين حاجتها إلى الحرية وخوفها من فقدان الانتماء. في هذه الفكرة الإنسانية يكمن جوهر الرواية وقيمتها، فهي تحاول أن تلامس الواقع بصدق وأن تنحاز إلى الإنسان المقهور.
لكن ما يُحزن فعلاً هو أن هذه الفكرة الثرية ضاعت في لغة ركيكة، وأسلوب يعاني من فوضى لغوية واضحة. السرد يأتي متقطّعاً، والجمل تفتقر إلى الترابط المنطقي، كأن الكاتب لم يراجع نصّه أو لم يُعنَ بجمال اللغة التي تحمل فكرته. اللغة الهزيلة أفقدت الرواية كثيراً من بريقها، وجعلت القارئ يتعثّر في العبارات بدل أن يغوص في المعنى.
الأسوأ من ذلك هو الخلط غير المبرر بين الفصحى والعامية، دون أي مبرر فني أو نفسي. الانتقال بين المستويين اللغويين يتمّ بلا منطق، فيشعر القارئ أحياناً أنه أمام نصّ غير مكتمل أو غير منقّح. كأن الكاتب أراد أن يجعل العمل واقعياً فجاءت النتيجة عشوائية أكثر منها مقصودة. رغم ذلك، لا يمكن إنكار أن الرواية تفتح نوافذ مهمة على قضايا اجتماعية وإنسانية متشابكة: مكانة المرأة، سلطة العادات، التناقض بين المظهر والتديّن، وصراع الفرد مع ذاته ومجتمعه. هذه القضايا تشكّل نواة فكرية قوية، لكنها تحتاج إلى لغة قادرة على حملها، وصياغة تحترم عمقها. “غربة” تُذكّر القارئ بأن الأفكار الجيدة وحدها لا تصنع رواية ناجحة، وأن الجمال الأدبي لا يقوم على الموضوع فقط، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها.
كانت الرواية قادرة أن تكون عملاً مميزاً، لو أنّ الكاتب منحها عناية لغوية تليق بعمقها الإنساني. وتبقى رواية “غربة” عملاً مهمّ الفكرة، ضعيف التعبير، بين نضج المعنى وسقوط المبنى.
وقالت د. منى أبو حمدية:
أولاً: التقديم العام
رواية “غُربة” عمل سردي إنساني عميق يغوص في التجربة الفلسطينية المعاصرة من خلال منظورٍ ذاتيّ يتقاطع فيه الهمّ الفردي بالهمّ الجمعي.
يُقدّم الكاتب نصاً متين البنية، تلتقي فيه الواقعية الاجتماعية بالنزعة الوجودية، حيث تتحول الغربة من حالةٍ مكانية إلى حالةٍ نفسية ووجودية تحاصر الإنسان في وطنه وفي ذاته في آنٍ واحد.
ثانياً: البنية السردية
يعتمد الكاتب بنيةً سردية خطّية متقطعة بضمير المتكلم، مما يمنح النص صدقاً وجدانيا وعمقا اعترافياً.
تتحول الذاكرة إلى فضاءٍ للحوار بين الماضي والحاضر، وبين التجربة الشخصية والوجع الجمعي، عبر مشاهد تستند إلى تقنية الاسترجاع (الفلاش باك) التي تمنح الرواية بعدا نفسيا وتأملياً.
ثالثاً: الثيمات المركزية
1. الغربة الوجودية:
تتجاوز الغربة معناها المكاني لتصبح غربةً عن الذات والهوية. يعيش البطل في وطنه كغريبٍ منبوذ، مطرود من دفء العائلة والمجتمع.
2. الحرية والكرامة:
تتجلى في وعي البطل بعد السجن والقهر، حين يدرك أن الحرية تبدأ من الداخل، من رفض الخضوع والخوف.
3. المرأة كرمز إنساني:
الأمّ، الأخت، الحبيبة — ثلاثية أنثوية تمثل الحنان والأرض والأمل. المرأة في الرواية ليست كائناً ثانويا، بل رمز المقاومة والحب والبقاء.
4. الجهل والقهر الاجتماعي:
يكشف الكاتب تناقضات المجتمع القروي الفلسطيني، حيث تُرتكب الجرائم باسم التقاليد، ويُقهر الإنسان باسم الدين أو العائلة.
رابعاً: اللغة والأسلوب
لغة “غُربة” تجمع بين الشاعرية والتقريرية. فهي لغة مشحونة بالعاطفة والرمز، دون أن تفقد وضوحها وارتباطها بالواقع.
تكثر فيها العبارات التأملية مثل:
«كنت أعيش غربة حقيقية عن كل ما حولي، عن نفسي، عن وجهي في المرآة، حتى صار الوطن وجعًا لا يُرى.»
توظيف الصور البلاغية يضفي على السرد بعداً انسانياً شفافاً، يجعل القارئ يعيش التجربة لا يسمعها فقط.
خامساً: الشخصيات
• الراوي/محمود: بطل الرواية، يمثّل الإنسان الفلسطيني الباحث عن ذاته وسط الانكسارات، يواجه اليُتم والظلم ويكبر في وعيه حتى يدرك أن الغربة داخله لا حوله.
• الأم (نهلة): رمز الوطن والحنان، تُجبر على الزواج القسري، وتقاوم حتى الموت، لتصبح شهيدة الكرامة والحرية.
• العم (عمسيى): رمز السلطة الأبوية القاسية والجهل المتوارث.
• الجد (الشيخ محمد): يمثل الحكمة والإيمان والاتزان، لكنه ايضاً عاجز أمام الواقع القاسي.
• الطفلة صِمّة: الأخت الصغيرة، رمز البراءة والذاكرة التي تُذكّر البطل بإنسانيته رغم القهر.
سادساً: الزمن والمكان
يتوزع الزمن بين الماضي (ذكريات الطفولة) والحاضر (رحلة النضوج والوعي)، في تداخل يجعل الأحداث غير خطية بل تأملية.
أما المكان فيتحرك من القرية إلى المدينة إلى السجن، حتى يتحول الوطن نفسه إلى فضاءٍ منفى، حيث يعيش الإنسان غريباً بين أهله.
سابعاً: البعد الفلسفي والرمزي
يتجاوز النص حدود الواقعية إلى بعدٍ فلسفي عميق، إذ تتحول الغربة إلى سؤال وجودي:
هل الغربة قدر أم اختيار؟
يقدّم الكاتب إجابةً ضمنية مفادها أن الغربة تنشأ حين يُفقد الإنسان صوته، وحين يختار الصمت بدل المواجهة.
هنا تتقاطع الرواية مع الفكر الوجودي الإنساني الذي يرى أن الإنسان مسؤول عن حريته ومعناه.
ثامناً: البعد الاجتماعي والسياسي
الرواية مرآة لواقعٍ فلسطينيّ تتشابك فيه السياسة بالاجتماع.
تعكس أزمة الهوية في ظل الاحتلال والتهميش، وتنتقد الفساد والجهل والظلم الطبقي.
لكنها أيضاً وثيقة وعيٍ اجتماعي تدعو إلى التنوير والتعليم والكرامة بوصفها طريق الخلاص من الغربة.
تاسعاً: التقييم النقدي العام
تُعد “غُربة” من الروايات الواقعية الحديثة التي تمزج بين السيرة الذاتية والرمز الإنساني.
قوتها في صدقها النفسي وشجاعتها في نقد الواقع الاجتماعي.
أما لغتها فمزيج من العفوية والعمق، تُحاكي القارئ بلغته اليومية، لكنها تترك فيه اثراً فلسفياً طويل المدى.
رغم امتداد الأحداث، فإن البناء محكم، والشخصيات متطورة، والنهاية مفتوحة تتيح التأويل.
إنها رواية الوعي والوجع في آنٍ واحد، تحوّل المعاناة إلى درس في الصمود والحرية.
عاشراً: الخاتمة
“غُربة” ليست عن مكان بعيد، بل عن المنفى الداخلي الذي يسكننا جميعاً .
هي شهادة أدبية على وجع الإنسان الفلسطيني في رحلته من الخضوع إلى الوعي، ومن الألم إلى الأمل.
رواية تكتب الذات الفلسطينية وهي تواجه مجتمعها وتاريخها، وتعلن أن الكلمة مقاومة، وأن الحلم هو آخر ما يُنتزع من الإنسان.
بالمجمل هي رواية تُقرأ بالقلب قبل العين، لأنها تكتب الإنسان في لحظة اغترابه القصوى، وتعيد له حقّه في أن يحلم.
ملخّص الرواية
تبدأ الرواية بطفولة الراوي الذي يفقد والده في حادث مؤلم، فتبقى الأم “نهلة” تكافح لتربية طفليها (محمود وصِمّة).
تتعرض لضغطٍ من إخوتها لإجبارها على الزواج من أخ زوجها القاسي “عمسيى”، لكنها ترفض، لتلقى حتفها في صراعٍ دمويٍّ ظالم.
يفقد الطفلان الأم، ويبدآن رحلة التيه واليُتم في بيت الجد العجوز “الشيخ محمد” الذي يمنحهما شيئا من الأمان، لكنه لا يستطيع حمايتهما من قسوة العم وزوجته.
ينمو البطل وسط القهر، ويتعلم الحلاقة كمهنة تحفظ كرامته، ويبدأ في تأمل الناس والحياة من موقعه كحلاق القرية.
من خلال هذه التجربة، يبدأ رحلة الوعي والنضوج، فيكتشف أن الغربة الحقيقية ليست في البعد عن المكان، بل في انكسار الروح وسط مجتمعٍ قاسٍ.
وفي النهاية، يدرك أن خلاص الإنسان لا يكون إلا بالمعرفة والإيمان بالذات، وأن الوعي هو الطريق الوحيد للتحرر من الغربة والظلم.
أبرز الرموز والدلالات
• الأم: رمز الوطن والرحمة المفقودة.
• العم: تجسيد السلطة الجاهلة القمعية.
• الجد: الوعي الروحي والاتزان الإيماني.
• الأخت الصغيرة: البراءة والذاكرة.
• المكان: الوطن الذي تحوّل إلى سجنٍ كبير.
• الغربة: الحالة الوجودية التي تختصر مصير الإنسان الفلسطيني.
الرسالة الجوهرية
يقدّم فوزي بدر نجاجرة في “غُربة” رؤيةً أدبية إنسانية عميقة، تؤكد أن الحرية تبدأ من الوعي، وأن الغربة ليست قدراً بل نتيجة لسكوتنا عن الظلم.
إنها روايةٌ عن الإنسان في أقصى درجات ضعفه، لكنها ايضاً عن قدرته على النهوض من الرماد.
رواية “غُربة” تحمل أهمية وجمالية خاصة لأنها تمزج بين الصدق الإنساني والوعي الاجتماعي في سردٍ مؤثر يكشف وجع الفلسطيني وغربته داخل وطنه.
أهميتها تنبع من قدرتها على تحويل التجربة الفردية إلى رمزٍ إنساني عام، فهي لا تروي قصة بطل واحد، بل حكاية جيلٍ بأكمله يعيش القهر والبحث عن الكرامة.
أما جماليتها فتتجلى في لغتها الشعرية البسيطة التي تنبع من القلب وتخاطب الوجدان، وفي عمقها النفسي والفلسفي الذي يجعل القارئ يشارك البطل تأملاته وألمه وأمله.
إنها رواية تؤنسن الغربة وتحوّل الوجع إلى فعل وعيٍ وجمال، فتبقى حاضرة في الذاكرة كعمل أدبي صادق ومضيء.
وقالت د. رفيقة أبو غوش:
اختار الرّوائي نجاجرة عنوان الرّواية “غربة”؛ نظرًا للشّعور بالغربة الدّائمة، للبطل محمود سواء في وطنه، وبين أهله وأقرابائه؛ لدرجة فقد فيه معنى الانتماء، والاتّصال بذاته وبالعالم أجمع. نجد الغربة بواقعها النّفسي والرّوحي، حيث يعيش البطل حياة متناقضة بالانتماء، والبحث عنه بعد الفقد، بل البحث عن الذّات؛ مستخدمًا لغة رمزيّة وتأمّليّة. “أنا أعيش غربة حقيقيّة عن كلّ ما هو موجودفي وطني، هل انا مخطئ والكل مُحق؟… فكفرت بالإنسان وبالمجتمع وبكل ثقافتنا كافّة عربيّة وإسلاميّة”. صفحة 120.
انتصر الكاتب لفئة المهمّشين، والفقراء، والمظلومين، والضّعفاء، والمقهورين في المجتمع الفلسطيني؛ فأبرز الكاتب الصّراعات (الخارجيّة) الاجتماعيّة، والسّباسيّة، والطبقيّة، والعائليّة، الّتي مثّلت تلك الفئات؛ بالإضافة للصّراعات الدّاخليّة (النّفسيّة) الّتي خاضها البطل محمود بينه وبين نفسه، أثناء مسيرة حياته، صراعات بين الواقع والذّاكرة. والشّعور بضياع الهويّة والنتماء، الغربة داخل النّفس وليس داخل الحيّز الجغرافي فحسب. “لماذا أنا كما أنا هذه الأيّام؟” “ببساطة كهذه الذّكريات تعيدني إلى معرفة حقيقتي، وتجعلني أفكّر بذاتي، وأتعرّف عليها أكثر” و “أجزم بكل يقين أنّي في اللامكان واللا زمان” صفحة 139.
هذه الصّراعات خلقت حوارًا ذاتيّا (المونولوغ) عكس الصّراع النّفسي للبطل؛ برأيي هذا الحوار أثرى من قيمة الرّواية، وجعلها أكثر مصداقيّة.
هذا الأسلوب التّقني في السّرد، يُقرّب القارئ من تجربة البطل الشّعوريّة، والتّماهي معه، وتفهّم مشاعره، ومن ثمّ الاقتناع بها، كما استخدم الكاتب تقنيّة الاسترجاع – الفلاش باك، والتردّد ما بين الماضي والحاضر.
استخدم الكاتب عربيّة أدبيّة فصحى سلسة، لا تعقيد فيه، تجمع ما بين الرّصانة والبساطة؛ لا تخلو الرّواية من استخدام المحسّنات البديعيّة، والتّشبيهات. دمج الكاتب اللّهجة العاميّة الفلسطينيّة، دون المبالغة فيها، وبما تتلائم مع الأحداث الّتي تتطلّب ذلك، فاستخدم الأمثال العاميّة أحيانًا، داعمًا فيها اقوال، وتمّ ترجمة بعض المصطلحات العاميّة في هامش الرّواية؛ ليسهل على القارئ العربي فهم الرّواية.
النساء في رواية “غُربة”: عمد الرّوائي نجاجرة باختيار معظم بطلات روايته من النّساء؛ كبطلات يلعبن أدوارًا مختلفة تمثّل الأحداث المؤلمة الّتي قصد الكاتب إبرازها.
الشخصيّة الأولى: السيّدة نهلة، وهي والدة البطل محمود، وهي كانت أرملة ولديها أطفال: محمود ووصفيّة؛ حيث حاول أخوتها إجبارها بالزّواج من سلفها (أخ زوجها) كزوجة ثانية، لكنها رفضت رفضًا باتّا؛ وعندما حض أخوتها مع المأذون لتزويجها غصبًا عنها، دخلت غرفتها وانتحرت.
الشّخصيّة الثّانية؛ صفيّة وهي أخت محمود يتيمة الأبوين، والّتي تمّ إجبارها على الزّواج في جيل مبكّر؛ وتبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، وفُرض عليها الزّواج من ابن اخ زوجة عمّها عيسى القاسية، وبتدبير منها. كان الزّوج قاسيًا، لا يعمل، ولا يُقدّر زوجته، بل يضربها ويُعنّفها. أنجبت منه أربعة أطفال. عمل مع أخيها محمود، فسرق أمواله وخانه بالعمل.
الشخصيّة الثّالثة: شهيرة مديرة المدرسة، من عائلة ارستقراطيّة، بلغت سن الأربعين؛ رافضة الزّواج؛ بسبب رفض عائلتها تزويجها من أشخاص ينتمون لطبقة أدنى منهم، فكانت سيّدة متعلّمة، ومثقّفة؛ وساهمت في تشغيل محمود البطل، فوقع بحبّها، وتواعدا على الزّواج، على الرغم من فارق السّن بينهما، وهي تكبره بخمسة عشر عامًا؛ لكن القدر اختارها، يوم زفافها، فارقت الحياة من شدّة صدمتها!. برأيي الشّخصي بأنّ سبب الوفاة ليس مقنعًا للقارئ، وفيها خيبة أمل غير متوقّعة.
الشّخصية الرّابعة: آمينة يتيمة الوالدين، عمرها ثمانية وعشرون عامًا، وهي أرملة شهيد قُتل برصاصة طائشة من الاحتلال، وعملت مع محمود في تربية وبيع الدّجاج، فكانت مخلصة في عملها؛ وتسبّبت في در الأرباح على مصلحة محمود، بينما تعرّضت للقذف والتّشهير بها في مجتمعها، ومحاولة أحدهم الاعتداء عليها. أحبّها محمود ويادلته نفس المشاعر، فتزوّجا؛ فكانت أمينة مستشارة ومساعدة لزوجها في كافّة أعماله، حتّى وصل القمّة، ورزقا بولدين.
الشخصيّة الخامسة: سمرابنة العشرين، والدها أسير، وتعيل أسرتها؛ وهي صديقة أمينة، وعملت معها في.تربية وبيع الدّجاج.
يبدو لي بأنّ اختيار الكاتب للشّخصيّات النّسائيّة، يرمز لدلالة الوطن؛ وعرض شرائحه المختلفة، والّتي تعرّضت وما زالت تتعرّض للتهميش، والفقر، والظلم، والفقدان، والقهر، والتّعذيب؛ في ظلّ الاحتلال.
لا بدّ من ذكر المكان الذي اختاره الكاتب مركزًا؛ لإدارة أحداث الرّواية، فكانت القرية باسم قرية الحرافيش”، يبدو بأنّ هنالك دلالة رمزيّة من هذا الاختيار، على غرار رواية الحرافيش للرّوائي نجيب محفوظ، والتي ترمز للطّبقة الشّعبيّة، والّتي تمثّل الصّراع الأبدي بين الظّلم، وبين العدالة، وبين القوّة والحق. هنا في رواية الكاتب نجاجرة “الحرافيش” ترمز إلى وجدان الشّعب؛ الفلسطينيين البسطاء، أولئك يصنعون معنى الصّمود اليومي رغم الغربة والقهر. قرية الحرافيش قرية من الممكن ان تكون أي قرية فلسطينيّة، وليس بالتّحديد قرية معيّة، فهي رمز للإنسان البسيط الّذي يعيش الغربة في وطنه، ولكنّه يظل متمسّكًا بكرامته وأحلامه. بالإضافة لقرية الحرافيش، ذكر الكاتب مدينة السّلام أيضًا؛ كمدينة تتركّز فيها الحضارة والتّطوّر، لدرجة أنشأ فيها مصنعًا كبيرًا؛ لخدمة المجتمع.
أنّ زمن الرّواية غير واضح تمامًا، ولكن ممكن الإستدلال به، عند وجود الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة والعمل والتّعليم، ممّا يشير إلى فترة ما بعد عام 1967. يبدو بأنّ الكاتب لا يُركّز على التّواريخ الدّقسقة بقدر ما يُصوّر زمن الغربة النّفسيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة؛ حيث يشعر الإنسان أنّ لغربة ليست فقط مكانيّة بل وجوديّة يعيشها في وطنه وبين أهله.
أثرى الكاتب روايته باقتباسات متعدّدة: من رواية ذاكرة الجسج، للرّوائيّة أحلام مستغانمي، “ما اتعسهم في غناهم وفي فقدهم، في صعودهم السّريع، وفي انحدرهم المفجع” صفحة 114؛ كذلك ورد اقتباس لقصيدة الشّاعر أحمد رامي “حيّرت قلبي معاك”؛ بالإضافة لقصيدة نزار قبّاني قائلًا: “عندما يتخلّى عنك الجميع، ولا يهتم لك أحد، لا تكن كالقطّ لمّا أصبح وحيدًا صارقويّا”. صفحة 80. برأيي الشّخصي: تعتبر هذه الاقتباسات وغيرها أقوالًا داعمة للسّرد الرّولئي، ودليلًا على سعة ثقافة الكاتب، وقدرته على دمجها في روايته.
أنهى الكاتب سرد أحداث الرّواية، بنهاية تراجيديّة مؤلمة؛ بصورة قاتمة يطغى عليها خيبة الأمل، واليأس؛ وذلك عندما أنشأ محمود وزوجته مصنعأ فخمًا في مدينة السّلام، وأقاما احتفالًا عظيمًا، حضره شخصيّات من كافّة المستويات الاجتماعيّة؛ إلّا أن الاحتلال أطلق النيران على المحتفلين، وتمّ حرق المصنع، وحُرق من حُرق، بالإضافة لإصابات بالغة بين الحاضرين. كتبت النهاية بلغة رمزيّة حزينة، حيث يسود صمت ثقيل يوحي بانطفاء الحياة، او بانتهاء مرحلة الوجود، موتًا روحيّا. يبدو بأانّ الكاتب ترك المصير غامضًا؛ ليعبّر عن استمرار المأساة الفلسطينيّة، وكأنّ الغربة نفسها لا تموت، بل تتوارثها الأجيال المُتعاقبة. برأيي الشّخصي، حبّذا لو كانت فُسحة أمل، وتفاؤل؛ لتشحن الهمم، وتدفع الإنسان لفلسطيني نحو الأمام.
خلاصة القول: رواية “غربة” رواية جديرة بالقراء، فهي ملحمة فلسطينيّة إنسانيّة، وسياسيّة؛ وهي مرآة، ترفع صوت كافّة الشعوب: المُهمّشة، والمظلومة، والفقيرة، من فئات الشّعب الفلسطيني؛ بل لكافّة المُعذّبين والمُهمّشين في الأرض أيضًا؛ كما أهدى الكاتب لهم إبداعه هذا، هذه الرّواية تُضاف للرّويات الفلسطينيّة القيّمة، وتستحقّ أرشفتها، وترجمتها للغات أجنبيّة مختلفة، وتوزيعها على المكتبات العربيّة.
وقالت هدى أبو غوش:
إنّ القارئ لرواية”غربة” يتذكر بيت الشّعر “وظُلمُ ذوي القُربى أشدُّ مضاضةَ -على المرءٖ من وَقعِ الحسام المهندٖ”،ونودّ لو نستطيع أن نغمض أعيننا؛لنقول هذا لا يحدث في مجتمعنا،ولكن هيهات للحقيقة أن تنام، ما دام القلم يكشف عن الأسرار دون خوف.
في رواية”غربة” يُظهر بطل الرّواية “محمود”مشاعر الغربة التي يعيشها هو وأخته صفية في ظلّ مجتمعه الذي ظلمه،فالغربة ليست في البعد عن الوطن،ولكنها موجودة داخلنا،في أعماق القلب ،في الناحية النّفسية،والعاطفية ،السياسيةوالاجتماعية.
ينتصر الأديب في روايته للأرامل واليتامى،ويصور السّلطة الذكورية في المجتمع وأثرها على الشخصيات.
تتجلّى غربة محمود في فقدانه هويته،وكرامته الإنسانية،وفي تمزقه الدّاخلي في صراعه مع المجتمع أثناء مواجهته الصعوبات التّي حلّت بالعائلة.
كانت غربة محمود الاجتماعية في فقده للبيئة الآمنة،بسبب ظلم ذوي القربى،فقد كان الأعمام والأخوال سلبيين تجاه الأطفال اليتامى (محمود،وصفية)في عدم احتوائهم عاطفيا واجتماعيا واقتصاديا،ولذا فإنه كان يشعر بالوحدة ،كان الجدّ الكبير بالسّن الذي تجاوز التّسعين يتكفل برعايتهم!
تلك الغربة سببت له مشاعر العجز في عدم استطاعته حماية أمه( بسبب سنه الصغير) التي دافعت عن نفسها في رفضها الزواج من عيسى أخو زوجها المتوفى،وبالتالي تمّ الاعتداء عليها من قبل إخوتها،وانتحارها بعد صراخ الرّفض والوجع.
أيضا،نجد العجز في إيجاد حلّ لمنع زواج أخته صفية القاصرة ابنة الثالثة عشرة،التّي تزوجت رغما عنها من خليل صاحب الأخلاق السّيئة الذي يكبرها بخمسة عشرة عاما،والغربة هي أيضا، في الفقر العاطفي،فقد نسي أنه إنسان يحتاج للحب،فعلاقته العاطفية مع المديرة “شهيرة” كانت غير عقلانية ولا منطقية،حين قرر أن يتزوج مديرته في المدرسة، والتي بادرته مشاعر العاطفة بالرغم أنها تكبره بسنوات كثيرة وفي عمر أمه،محمود كان جائع للحب، الذي وجده عند المديرة ،ونلاحظ مدى انفعاله المؤثر حين بكى يصف حالته التي بحث عنها،بمعنى آخر، حالة الحب التي اجتاحته هي تعويض نفسي وعاطفي عن برودة المجتمع القاسي الذي لم يرحم ظروف عائلته(اليتم،الظلم)، لكنه بالنهاية لم ير النور بسبب وفاة المديرة.
لا تقتصر الغربة على محمود فقط،فقط كانت أيضا عند شهيرة بشكل جزئي،من الناحية العاطفية.وعند صفية بشكل كبير مثل محمود.
من جهة أخرى كانت الغربة محفزا لمحمود من أجل النهوض بنفسه،وتحويل غربته لإستقرار، سكن، وأمن،وذلك من خلال تطويرنفسه،في تعلمه،وثمّ اقتصاديا مثل:مشروع مصنع الدجاج.
في نهاية الرّواية،نجد أن محمود وجد نفسه التي يبحث عنها من خلال الأمن العاطفي في علاقته مع زوجته حليمة التّي أحبها،وفي الناحية الاجتماعية من خلال بناء شجرة العائلة الآمنة التي افتقدها في طفولته،فأصبح الخال،والأب،الخ.الوحدة تبدلت بحضرة العائلة إلى مشاعر دافئة وحاضنة اجتماعيا.أمّا من الناحية السّياسية فقد ظلّت غربة الفلسطيني وحده أمام ظلم الاحتلال.
يمرّر الأديب نجاجرة من خلال هذه الرّواية صرخة قوية في وجه المجتمع المنافق دينيا واجتماعيا في عدم تطبيقه لحقوق اليتيم من حيث مراعاته والاهتمام به،وفي الظلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع،بمعنى آخر”الإنفصام الديني” كما ورد على لسان محمود.أثار الأديب نجاجرة مسألة تزويج القاصرات في المجتمع،وإستغلال الطبقات الفقيرة،التّحرش الجنسي،الإشاعات الكاذبة الفاسدة،والحرمان العاطفي.
اختار الأديب فوزي نجاجرة،اسم قرية “الحرافيش” والحرافيش في اللّغة هي سفالة الناس وأرذالهم،وعلاقة الحرافيش بالرّواية مرتبط بتعامل أخوال وأعمام محمود إليه بصورة سيئة وتصوّر سفلتهم تجاه عائلته.
أمّا مدينة السّلام تبدو رمزا لميناء الرّوح المتعبة التي يبحث عنها كلّ من محمود، صفية،الأرامل، واليتامى.
جاءت أغلب الشّخصيات النسائية تحمل الصفات الإيجابية،بمقارنة بالشخصيات الذكورية كانت معظمها سلبية.
أسماء الشّخصيات-
حليمة-من الحلم والصبر،كانت صابرة رغم الأذى والعنف من قبل المجتمع.
صفية-من الصفاء والنقاء،كان قلبها نقي تحملت زوجها عيسى.
شهيرة- رغم شهرتها كمديرة وغناها لكنها كانت فقيرة العاطفة،وحيدة.
محمود-كان من الشاكرين لنعم الله،يحب مساعدة الآخرين.خليل-اسم لم يكن مناسبا؛ بسبب صفاته السّيئة،فهو غير وفيّ.
كانت العاطفة حزينة،والأحداث مأساوية،واللون الأسود يخيم على معظم الرّواية، جاء سرد الرّواية بضمير المتكلّم على لسان محمود، وبعض الرّواة، من أجل الإفصاح عن مشاعرهم، وأسرارهم الدّفينة.اقتبس الأديب بعض أقوال الفلاسفة،والكتاب،كما واستخدم الأمثال وأبيات الشّعر،أمّا اللّغة فكانت سهلة،بسيطة،انسيابية.
طغت على الرّواية سواد علاقة ذوي القربى ببعضهم البعض،لم يرحموا اليتامى والأرملة.وتبدو علاقة محمود بأعمامه وأخواله انقطعت للأبد.والسؤال الذي يطرح ألم تتغير الظروف بعد كلّ هذه السّنين الطويلة!هل ماتت الإنسانية في كلّ الأقارب ؟
أم هي إشارة أنّ مجتمعنا في خطر!
سؤال آخر-كيف للجدّ المسّن الذي تجاوز التّسعين عاما أن يراعي الأيتام ؟بالرغم ممّا ذكر عن صحته الجيدة ونشاطه.
ورد في الرّواية جملة “إعلان بالفيس بوك”ممّا يشير إلى أن الرّواية حدثت في الحاضر المتحضر والمتطور،والسؤال أين القانون في المجتمع،أين المؤسسات الإجتماعية؟هل شاركوا في تزويج القاصر؟لم يكن أي دور للمؤسسات في الرّواية.
جاء مشهد الطائرة،ورؤية جدّ محمود لياسر عرفات مقحما في الرّواية.
وقالت وفاء داري:
من يقرأ روايات الروائي الفلسطيني “فوزي نجاجرة “، يلمس انتصاره لقضايا المرأة والمجتمع وتسليط الضوء على المسكوت عنه. كما تتجلى الوطنية في سطوره وبين كلماته من خلال كشف معاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال. ومن هنا تأتي القراءة التحليلية لرواية “غُربة” الصادرة عن دار دجلة للنشر والتوزيع في 285 صفحة. بطل الرواية محمود، يتيم الأب، وأخته صفية منذ الطفولة. بعد عامين يفقدان الأم أيضًا، لتبدأ رحلة المعاناة. لم يترك الكاتب فسحة استراحة بين طيات فصول روايته للقارئ، في وتيرة تصاعدية مستمرة من حل عقدة لتبدأ حبكة العقدة الأخرى ليكون التشويق سيد المواقف. رغم شحنات الواقع المرير التي تتخلل سردية الرواية؛ فهل تُعد الرواية تراجيدية بجدارة تعبّر عن حتمية الوجع الإنساني، أم أنها تنزلق نحو السوداوية حيث يغدو الألم خيارًا وجوديًا ووعيًا باللاجدوى؟
العنوان: ترمز ” غُرية” الى عزلة البطل محمود بعد فقد والديه، إذ يعيش غربةً مزدوجة داخل مجتمعه وذاته، باحثًا عن معنى للانتماء والنجاة.
صورة الغلاف: تظهر السفينة في عرض البحر، في مشهدٍ يوحي برحلة تيه في محيطٍ كوني، توحي بغربة الإنسان في المجهول. ولربما لا تنسجم تمامًا مع سردية الرواية الاجتماعية الواقعية ذات الطابع القروي المأساوي.
الشخصيات (البطل محمود والشخصيات المحورية): عمَّه عيسى وزوجته، جدّه محمد، صفية أخته، الصديق جميل، صديق والد البطل ناجي صبري، المديرة شهيرة، زوجة البطل حليمة. الى جانب شخصيات أخرى مساعدة.
تبدأ رحلة البطل محمود وأخته صفية مع المعاناة من العم عيسى وزوجته لتصل يد الجبروت صفية في عمر الثالثة عشرة، في عملية صفقة زواج مقابل دونم أرض لابن البلدة الذي يكبرها بخمسة عشرة عامًا، للتنقل المعاناة الى يد الزوج.. ليبقى البطل يعاني هو الآخر من الضرب والشتم وإهانة يومية تسبق وجبات الطعام، بل وتحلّ محلّها. حتى تأتي فكرة شيطانية لمحمود وهو في الرابعة عشر للخلاص من عمه وزوجته. في لحظة تتقاطع فيها البراءة مع المكر الطفولي، يخبر محمود زوجة عمّه كذبًا بوفاة زوجها، فتخرج إلى الشارع مذعورة لتُدهس بسيارة وتموت في الحال. ثم يعود ليخبر عمَّه عيسى بوفاة زوجته، فيُصدم ويسقط ميتًا هو الآخر، لتتحقق فكرة الخلاص كما تخيّلها الفتى في سويعاتٍ تحاكي سخرية القدر. بفعل محمود وطريقته في الخلاص منهما يضعنا البطل – بل الكاتب أمام مساحة للتفكير والتأمل في دوافعنا الإنسانية، وفي مواجهة مع ذواتنا وحقيقتنا ودوافعنا. فهل الغاية تبرّر الوسيلة؟ أم هو تفكير وجودي وفعل مستحق؟ أم الفعل غير محسوب المآل؟!
لم تنتهِ معاناة البطل محمود بعد الخلاص من ظلم عمَّه وزوجته، بل بدأت في أوجه أخرى كثيرة بداية يذهب للعيش مع جده لأبيه يعمل حلاق ليكمل دراسة في التربية، يعاني في محاولة إصلاح حياة أخته صفية ومعاناتها مع زوجها. يُكوِّن صداقة مع زملائه في المرحلة الجامعية (صالح، خالد، جميل، عبد الهادي، ليث)، لم يصمد منها في وجه المواقف سوى صداقته مع جميل. من خلال هذه الصداقة استطاع أن يتصالح مع الحياة. يعاني البطل محمود من قلة الشواغر بعد تخرجه. وما أن يحصل على وظيفة معلّم حتى يفقدها بسبب الفساد في مطبخ وأروقة وزارة التربية والتعليم على يد زميلٍ في العمل “ماجد”، ليتم فصله.. وما أن يحصل على وظيفة اخيرًا وتهدأ سريرته ويجد حب عمره مع مديرة المدرسة، وهي أكبر من أمة في محاولة لتعويض نقص عانى منه منذ طفولته عن حنان الأم، لكنه يخسر هذا الحب بموت حبيبته في يوم زفافهما، نهاية الفصل السابع. رغم أنها صادمة فهي أيضًا مختلفة، يتقوقع على نفسه يستقيل من عمله. ليبدأ رحلة استقلال جديدة، متنقلًا من وظيفة إلى مشروع تجاريّ (مزرعة دواجن). وطبعًا لا يدع الروائي نجاجرة مجال للاستراحة فيأخذنا معه في أحداث تصاعدية جديدة ما ليبث أن تنتهي لتبدأ أخرى. الا أنه يجد حبًا آخر ليستقر في حياةٍ زوجية ويرزق الأبناء ليعيش حياة أسرية ليفرح القارئ كما البطل في هذا الاستقرار. لكن هذا الفرح لا يلبث أن يتبدد، كهدوءٍ يسبق عاصفةٍ. لتأتي النهاية بالطامة الكبرى على البطل محمود في نهاية شبة مفتوحة بحرق المزرعة والمصنع على يد شرطة الاحتلال.
الأسلوب الأدبي واللغوي
كتب فوزي نجاجرة رواية غُربة بضمير المتكلم، جاعلًا من البطل محمود مرآةً تعكس تيارًا متدفقًا من الوعي الداخلي. جاء السرد خطيًا في الظاهر، وفي الجوهر تكمن سردية الاسترجاع. يتشظّى نفسيًا عبر تداعيات الذاكرة وتأملات الذات. سمح الكاتب لأصوات أخرى أن تتحدث بضمير المتكلم، مانحًا الرواية بعدًا حواريًا غنيًا. لغته سهلةٌ في ظاهرها، لكنها مكثفةٌ، عميقة الإيحاء، كما في قوله (ص75): “فتح عمي عيسى عينيه فتحة تتسع لمثلي ولعشرة من أمثالي، ولم يتفوه بكلمة.”
القصائد النثرية الحداثية: اعتمد نجاجرة توظيف القصائد النثرية داخل النسيج السردي، لتكون صدى للعاطفة الداخلية للشخصيات. هذه المقاطع الشعرية القصيرة، مثل ما جاء على لسان صفية (ص67): “تعبت من روحي وسئمت، من حكمة الفؤاد الحزين، ومن صمت النفس، ومن الظلم والظالمين “الخ، تمثل ذروة الوجع الأنثوي في الرواية، وتكشف عن توتر اللغة بين السرد والشعر.
رمزية الاقتباسات ودلالاتها: يوظف الكاتب اقتباسات ومقولات مأثورة تشي بثقافة واسعة، كما في قوله (ص71): “عندما يتخلى عنك الجميع… كن كالذئب كلما أصبح وحيدًا ازداد قوة.” لنزار قباني، أو في استحضاره لجبران خليل جبران (ص13): «يتحدثون في ظهري ويبتسمون في وجهي…». هذه الاقتباسات تشكّل طبقة رمزية تضيف بعدًا فلسفيًا وتأمليًا للنص، فيما يعكس ذكر (جحا جابر ورامبو الحبشة – ص76) هو لقب يُطلق أحيانًا على الكاتب الإريتري “حجي جابر”، في إشارة مجازية تعكس جرأته في الكتابة عن القضايا المسكوت عنها. أما “رامبو” المعروف بالتمرد والمقاومة، للدلالة على قوة طرحه الأدبي وجرأته السياسية والفكرية، جرأة وجاجرة جاءت في مقاربة المسكوت عنه، واتساع أفق التناصّ الثقافي بين المحلي والإنساني.
الثيمات والرسائل ونقاط القوة:
تتعدد الثيمات في رواية غُربة لتغطي أبعادًا اجتماعية ووطنية وفكرية عميقة. يسلّط فوزي نجاجرة الضوء على المسكوت عنه من الظواهر الاجتماعية، كمعاناة الأيتام وظلم الأقارب كما داء في سردية الرواية: “لقد استغلنا عمنا بصورة بشعة بعد فقدنا لأمنا ولم يرحمنا، فكثيرٍا كان يضربنا ضربًا مبرحًا دون سبب”(ص44)، كذلك تطرق الكاتب لظاهرة وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من حقّها في الاختيار كما في قصة شهيرة. كما يتناول نظرة المجتمع الظالمة للأرملة من خلال مشهد تحرش سعدون بحليمة (ص240)، كاشفًا هشاشة القيم الأخلاقية في مجتمعٍ مأزوم.
وطنيًا، يضيء الكاتب على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال (ص110)، مقدّمًا خطابًا إنسانيًا متعاليًا على الشعارات، يعبّر عن الألم الفلسطيني من الداخل. كما يوظف عامل السخرية والمفارقات (ص133) ليحوّل المأساة إلى تراجيديا سوداء تكشف زيف الخطاب الديني والاجتماعي.
وفي محور الفساد الوظيفي، يعرّي نجاجرة البيروقراطية المقيتة والوساطة والرشاوى (172ص)، مبرزًا رمزية “منفضة السائر” كاستعارة فلسفية عن انقياد الإنسان للسلطة.
على الصعيد الوجودي، يضع الكاتب أبطاله أمام أسئلة فلسفية عن المعنى والغاية والكرامة (ص144)، بين المطرقة والسندان، بين الممكن والمأمول. كما يرسم صورة نقدية لجيلٍ تائهٍ فارغ المضمون، غارق في التكنولوجيا، فاقدٍ لهدفه الإنساني. وفي المقابل، يكرّس حضور الهوية والتراث عبر الأمثال الشعبية (ص242–243) والأزياء الفلسطينية التقليدية (ص36، ص262)، لتبقى الذاكرة الجمعية حاضرة في مواجهة الاندثار. وأخيرًا، يشير الكاتب إلى رمزية الوفاء الوطني باستحضار شخصية القائد ياسر عرفات (ص96)، في لفتةٍ تحمل عرفانًا وتذكيرًا بجذور النضال الفلسطيني
على الرغم من القيمة الإبداعية العالية لرواية غُربة واتساع رؤيتها الإنسانية والاجتماعية، فإن القراءة النقدية الدقيقة تكشف عن بعض الملاحظات الشكلية والفنية التي لا تمسّ جوهر العمل، لكنها تستحق الإشارة إليها بوصفها فرصًا للتحسين.
أول هذه الملاحظات تتعلق بالواقعية السردية في تصوير الجد، الذي بلغ من العمر ما يقارب المئة عام، وظل قادرًا على رعاية أحفاده والسفر إلى رام الله (ص94)؛ وهو تفصيل قد يضعف منطق السرد الواقعي. كذلك جاء الجانب العاطفي متأخرًا في النسيج الروائي (ص182)، إذ لم يخض البطل تجربة حب حقيقية إلا في سن الرابعة والثلاثين، ولو توزعت هذه التجربة على مراحل الرواية لخلقت توازنًا عاطفيًا يكسرحدة التراجيديا. أما الاقتباسات الأدبية من كتاب آخرين، مثل (أحلام مستغانمي – عابر سبيل، ص109)، فقد بدت غير ضرورية في بعض المواضع، لأن خيال نجاجرة السردي كان قادرًا على إنتاج رموزه الذاتية دون الحاجة إلى إسناد خارجي. كما يُلاحظ إدراج عناصر غير لازمة في عملٍ روائي كصفحة الفهرست أو المراجع، وهو ما يتنافى مع الطابع الإبداعي الأدبي. وفي بعض المقاطع، تراجع الوصف المكاني والتفصيل البيئي مقارنة ببداية الرواية الغنية بالحياة الريفية، ما أحدث تفاوتًا في الإيقاع السردي.
ومع ذلك، تبقى هذه الملاحظات تفاصيل شكلية طفيفة لا تقلّل من جودة العمل ولا من قوته الإنسانية، بل تؤكد وعي الكاتب بطبيعة الرواية الواقعية التي تسعى إلى التقاط تفاصيل الحياة الفلسطينية في صراعها بين القهر والأمل وتظل النهاية، رغم واقعيتها الرمزية وصدمتها، شبه مفتوحة على احتمالات أقل مأساوية كان يمكن أن تمنح البطل فسحة إنصافٍ بعد معاناة طويلة وشحنات الوجع التي تراكمت في سردية الرواية.
في الختام: يمكن القول إن رواية غُربة للروائي فوزي نجاجرة قدّمت نصًا إنسانيًا متين البنية، متعدّد الطبقات، جمع بين الواقعية الاجتماعية والرمزية الوطنية. ورغم اكتمالها من حيث البناء والحبكة، ربما كانت بحاجة إلى نهاية تُنصف البطل بعد مسار طويل من المعاناة، وتمنحه فسحةً من العدالة أو التعويض الرمزي. غير أنّ اختيار الكاتب لنهاية مأساوية باحتراق المزرعة والمصنع على يد الاحتلال يظلّ منسجمًا مع رؤيته الواقعية الصادقة، ويمنح النص بعدًا رمزيًا عميقًا يربط بين المأساة الفردية والمأساة الجمعية للشعب الفلسطيني. إنها نهاية مفتوحة على الألم، لكنها أيضًا مفتوحة على الذاكرة والمقاومة والأمل في بقاء الإنسان رغم الغُربة.
وقالت نزهة أبو غوش:
يركّز الكاتب نجاجرة على كيفية تشكّل المجتمع داخل النص، والعلاقات السلطوية، والآليات الاجتماعية التي تنتج القهر، مع إبراز الرموز والدلالات. البنية الاجتماعية في رواية “غُربة” تقوم رواية “غُربة” على بنية اجتماعية متداخلة، تُظهر المجتمع الفلسطيني لا بوصفه كُتلة واحدة متماسكة، بل باعتباره طبقات من العلاقات والقيم التي تتصارع داخل البيت الواحد. البنية الاجتماعية في الرواية ليست خلفية للأحداث، بل هي الحدث نفسه؛ فهي التي تُنتج الألم، وتشكّل تصرّفات الشخصيات، وتعيد تعريف مفهومي: الانتماء والغربة. المجتمع كسلطة لا كحاضنة في الرواية، العائلة لا تُقدَّم كـ “ملاذ”، بل كـ مؤسسة ضبط اجتماعي، تُعيد تدوير العادات، وتفرضها بالقوة على الأضعف: الأرملة تُعامَل كـ “عار قابل للانفلات”، فيجب ضبطها بالزواج. الأطفال يُعاملون كإضافات، لا كذوات. القرابة تُصبح، لا رابط دم، بل أداة رقابة. هكذا تتحوّل القرية، التي يفترض بها أن تكون مجتمع حماية، إلى مجتمع محاكمة. العُرف فوق العدالة من اللحظات المفصلية في الرواية أن القرابة لا تنحاز للحق، بل للعُرف. هذا يظهر بوضوح في معاملة نهلة: لا أحد يسأل عن رغبتها. الكل يتصرّف وفق ما يريده “الناس” لا ما يحتاجه الإنسان. وهنا يشتغل الكاتب على كشف أخطر آليات القمع الاجتماعي: التبرير باسم الجماعة. فالمجتمع لا يرى نفسه ظالمًا، بل “يحفظ الشرف”. وهنا تتجلى مفارقة الرواية: من يُفترض أنه السند هو الجلاد. الذكورية كمنظومة لا كأفراد الذكورية في “غُربة” ليست موقفًا فرديًا، بل نظامًا متجذّرًا، تشارك فيه النساء أحيانًا بالصمت أو القبول، ويُربّى عليه الأطفال قبل الرجال. العم ليس وحيدًا في المنظومة، بل جزء من بنية أكبر تشرّع تسلّطه. الأم أو الجارة أو العجوز قد تتحوّل إلى حارسة للقهر حين تقول: “ما بصير”. بذلك يكشف الكاتب أن الظلم الاجتماعي لا يقوم بالضرورة على شخص شرير، بل على نظام اجتماعي كامل ينتج الظلم بشكل طبيعي. الطفولة أكبر ضحية للبنية الاجتماعية في الرواية، الطفل ليس شخصية ثانوية بل برهان حي على فشل المجتمع. الأطفال يُربّون على الخوف والطاعة لا على الحب والحرية. المجتمع لا يسرق طفولتهم فقط، بل يورّث لهم مسبقًا أدوار الظالم والمظلوم. لذلك، الطفولة هنا ليست مرحلة عمرية، بل مرآة مكشوفة لزيف ادعاءات “الرحمة العائلية”. المرأة – من ضحية إلى كاشفة الرواية لا تكتب عن امرأة ضعيفة، بل عن امرأة أُضعِفَت. نهلة ليست رمزًا للانكسار، بل مرآة تكشف آلية القهر. وجودها داخل الرواية هو تفكيك للمعادلة الاجتماعية القائمة على: الطاعة = شرف الاعتراض = فضيحة وتحويلها إلى سؤال لاذع: لماذا يصبح الحفاظ على “السمعة” أهم من الحفاظ على إنسان؟ المجتمع الذي يُشبه الاحتلال من أهم أفكار الرواية الضمنية: ليس الاحتلال فقط من يقتل الحياة، بل هناك احتلال داخلي أخطر: احتلال العائلة لجسد المرأة، واحتلال العرف لروح الإنسان. الكاتب يجعل القارئ يرى أن الحرية لا تبدأ من رفع العلم، بل من رفع الظلم في البيت. العائلة مؤسسة ضبط قهرية. القرية مجتمع محاكمة لا حماية.
وقالت د. سيما صيرفي:
بعد قراءتي لرواية “غُربة” أحسست أنها نابعة من وجدانٍ صادق، ومكتوبة بتنهيدات الألم الفلسطيني ، وبملامح بيتٍ فقد عماده، وبتحدي امرأة لمجتمع لا يرحم.
كما سمعت عن الكاتب بتحرياتي المتواضعة، أستطيع أن أتوقع أن الرواية تشبه صاحبها في صدقه ودفء انفعاله، وربما لا تشبهه في انحيازها إلى العفوية أكثر من انحيازها إلى الصنعة الأدبية.
أنا إنسانة لا أقرأ عن الشاشة صفحات كثيرة، وأعترف أنني حاولت قراءة هذه الرواية من ملف محوسب اضطرارًا، ووضعت نفسي تحت تجربة الانجذاب، وأعترف أن هذه الرواية الوحيدة التي استطعت الانجذاب إليها وأن أكمل قراءتها من خلف شاشة وخلال ساعات فقط.
الصراحة أنني رأيت الكاتبَ “نجاجرة” يسير على خطٍّ زمنيّ متدرّج، ويستعمل أسلوب السيرة الذاتية التي تخاطب القارئ من خلال تجربة للشخصيات تُروى من العمق الداخلي، وتنقل القارئ إلى فضاء القهر الاجتماعي والذكوري، فالأم “نهلة” تجسد المرأة التي تصون كرامتها وسط الحصار، والعم “عيسى” يمثل نموذجًا للسلطة الجاهلة التي تخلط العرف بالدين ، فقد استغل زوجة أخيه وطفليها، محمودًا وصفية.
تُحسب للرواية جرأتُها في مواجهة القهر الأسري، وربطها صورة الأب الغائب بالعائلة المتسلطة، كما تمتاز بتصويرٍ نفسي دقيق للحزن، والخوف، والتمرد.
رأيتُ أن الرواية مشحونة بالعاطفة، وهذا جيد أحيانًا، لكنه أثَّر بشكل واضح على النص فجعله محتاجًا إلى مراجعة لغوية شاملة، فقد وردت أخطاء نحوية وإملائية متكررة، ففي الصفحات 21-23 على سبيل المثال نرى عدة هفوات: ففي جملة “إنه أمرًا خرافيًا” نُصب خبر إنّ وصفته كذلك بدلًا من رفعِهما، وكُتبت جملة “مائتي متر” بألف زائدة بدل “مئتي متر” ، وسقطت الهمزة من كلمة “آخر” فكُتبت “أخر”، وسقط حرف العطف في قول: “الدماء تنزف من فمها، أنفها وأذنيها”، ووُضِع فراغ زائد بعد كلمة “تُصدم”، وكتبت النقطة داخل قوسيّ الاقتباس بعد كلمة “لكما”. هذه نبذة في ثلاث صفحات فقط، فكيف لو نقحنا جميع الصفحات.
كذلك نلحظ تكرار علامات الترقيم، كاستعمال “؟؟؟” بدل علامة واحدة في عدّة أماكن في الرواية، وهذا خطأ.
ومن الملاحظ أيضًا خلط الفصحى بالعامية في الحوار، كقول أحدهم: “أنا مش موافقة على الزواج منه” بعد جملة فصحى تمامًا. هذا التداخل اللغوي يُربك النغمة العامة للنص، وكان الأجدر أن يعتمد الكاتب نهجًا موحّدًا، فالفصحى المبسطة وحدها قادرة على حفظ نغمة السرد وهيبته.
أريد تسليط الضوء على خطأ يكرَره أدباء كبار، وليس الكاتب فوزي وحده، وهو حذف واو العطف حين تتعدد المعطوفات، وحصرها في آخر معطوف فقط، كما ورد في بعض المقاطع عند سرد الأسماء والصفات في الرواية. أذكر أنّ الأسلوبّ العربي الأصيل يقتضي ذكر الواو بين كل معطوفين، كما في قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
“هو الأول والآخر والظاهر والباطن”. صدق العليّ القدير.
وفي بيت المتنبي:
“الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ”
فحذف الواو أسلوب دخيل من اللغات اللاتينية، لا من فصاحة العربية. وهذا المبدأ في ضبط العطف والترقيم كان سيُكسب النص وضوحًا وجمالًا أكبر، خاصة في المقاطع التي تتوالى فيها الأوصاف والأفعال في رواية الكاتب فوزي.
نقطة إضافيّة لمستُها في الرواية تتعلّق بتألق النص الذي يتطرق إلى الوصف، وفي ضعفه حين يفسِّر. فالوصف في الرواية حيّ نابض، كما في قول الكاتب: “كنت أرى وجه أمي في كل امرأة تمشي على الأرض، وأسمع أنفاسها في الريح”، وفي مواضع أخرى يغلبه التهويل، فيتحوّل الألم إلى مشهد ميلودرامي، كما في قول الكاتب: “بكيتُ حتى تشققَت صدور الجبالِ من صراخي”. لهذا فإنّ التوازن بين الصدق والعاطفة هو ما تحتاجه الرواية في طبعة مقبلة.
الحوار كثيرًا ما يتّخذ طابعًا مباشرًا، يشرح أكثر مما يكشف، الأمر الذي اختبرتُه من قراءتي الأولى للرواية- قراءة سريعة، فكان يكفيني أن أقرأ أولَ الفقرة أو ربما الصفحة وآخرَها لأعلم أن الكاتب مازال يصف ولم تفوتني أي معلومة مهمة في الأحداث.
الشخصيات ليست متساوية في الميزان، فشخصية الأم مرسومة بعمق، بينما تبقى الشخصيات الثانوية مثل “بديعة” و”الخال” و”عيسى” مكررة النبرة، وسطحية لا تتطور ، ولا تكتسب دوافعَ جديدة.
رغم النقاط المذكورة في رأيي، إلّا أن هذه الرواية مهمّة وسيكون لها صدًى، لتمتعها بصدقها وواقعيّتها الوطنيّة.
وقالت م. إيناس أبو شلباية:
تتحدث الروايه عن عائلة حمدي محمد وزوجته نهله وطفليهما محمود وصفيه.
مات حمدي في حادث سير في القدس، وانتحرت الأم بعد محاولة أخوتها اجبارها على الزواج.
فانتقل الطفلين للعيش مع جدهم االشيخ محمد الذي لم يتزوج بعد زوجته .
وكانت زوجة عمهم عيسى وزوجته بديعه يستغلانهما في رعايه الأغنام، ويحرمونهم من الطعام.
محمود وعلى صغر سنه كان يحلق لجده شعره وذقنه، وعندما اتقن هذه الحرفه صار حلاقا لمشايخ الزاويه مما در عليه دخلا جيدا كطفل ولقب بمحمود الحلاق.
وبعد عشر سنوات وعندما بلغت اخته ربيعها الثالث عشر قررت بديعه زوجه عمه محمود تزويجها الي ابن اخوها خليل، الذي أغرى عمته بدونم أرض إن تم الزواج، وقد كان عاطلا عن العمل وسيء السمعة، الا انهم زوجوها رغم معارضة أخيها وجدها.
واستمر محمود في حياته وقرر ان يكمل دراسته الثانويه والجامعيه ويتعلم السياقة.
فينتقل من مهنة إلى أخرى، بعد معاناة كبيرة، وكان قد أدرك حجم ( الواسطة) وأهميتها، حتى لو لم يكن المتقدم للوظيفة كفؤا لمنصبه.
وبعدها تزوج وأنجب الأطفال، واستطاع أن يبني عملا مستقلا بعد أن كره الوظيفة والعمل لدى الآخرين.
بنى مزرعة كبيرة ونجحت نجاحا باهرا.. وأراد التوسع وتطوير المزرعة، وذلك بعد ان قرر بناء مصنعا للكرتون والتغليف، وتنتهي الرواية عند حفل افتتاح المصنع، إذ احترق المصنع بما فيه من أجهزة.. وترك الكاتب النهاية مفتوحة.
لغة الرواية بسيطة وسلسة، تبين حال الفلسطيني المعذب في ارضه والذي يشعر بالاغتراب من ويلات الفقر والجهل والطمع والفساد.
الرواية رغم كل ما ورد فيها من ألم وعذاب إلا أنني رأيت فيها بعض الأمل.
فكان محمود وصفية يتجاوزان سويا كل المصاعب، واستمرا بالحياة، فلم ينقطع الرجاء بانتظار غد أفضل.
لعلهم لا يدركون ان العالم كبير وان هنالك اشياء كثيره في هذا العالم ممكن أن يتعلمها الانسان.
غير ان سنوات طويله من الاستعمار والاحتلال جعلت الفرد في هذه البلاد ينصبّ اهتمامه على الحصول على لقمه العيش والحصول على سقف يقيه حر الصيف وبرد الشتاء، بالإضافة إلى تعليم الأبناء، للحصول على شهادة تضمن لهم عملا يعتاشون منه.
ويبقى السؤال هنا، هل سيعيدون بناء المصنع بعد أن اتهمته النيران.. ويكملون حياتهم، بانتظار مستقبل أفضل؟