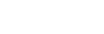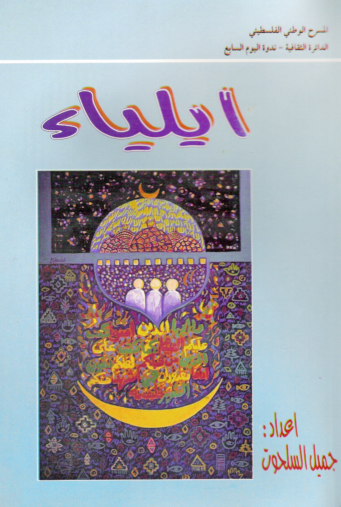اصابة طفل بثلاث رصاصات بحفلة عرس في منطقة بيت جالا في الايام القليلة الماضية ، ليس حدثا فريدا من نوعه،فقد حصلت قبله حوادث مشابهة وكانت نتائجها اكثر مأساوية ،ومع ذلك فانه لم توضع حتى الآن حدود لهذه الجرائم التي تحصد أرواحا أو تشوه اجسادا لا ذنب لها.
وليس خافيا على احد انه يجري منذ مدة جدل واسع في الأراضي الفلسطينية حول ما يسمى “فوضى السلاح” و”الأنفلات الأمني” الذي ينغص حياة المواطنين، بل ويقلبها الى جحيم لا يطاق.
ويقترن ذلك بالحديث عن “سلاح المقاومة” وبغض النظر عن الاجتهادات المتفاوتة ما بين تأييد المقاومة السلمية للاحتلال، أو المقاومة المسلحة إلا أن فوضى السلاح تشكل عبئا وخطرا على المواطن الفلسطيني نفسه، وتضعف من هيبة السلطة الوطنية أمام هذا المواطن، بل إن تعدد “السلطات” التي تفرض هيمنتها على الشارع تحت تهديد السلاح أوقعتنا ولا تزال توقعنا في “مطّبات” سياسية، تبعدنا عن الاستقلال والتحرر الوطني، وتضعنا أمام العالم وكأننا غير قادرين على حكم أنفسنا.
ومواطننا الذي هو الضحية الأولى لهذا الانفلات الناتج عن “فوضى السلاح” هو نفسه يحب المظاهر المسلحة و”الطخطخة” اذا ما ابتعدت عنه وعن مكان سكناه، وحبّ اقتناء السلاح الناري واطلاق الرصاص ليس حكرا على الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل هو موجود عند الشعوب العربية الأخرى، حتى أن التقارير الصحفية أفادت أنه في اليمن وحدها يوجد تسعة ملايين قطعة سلاح بين أيدي المواطنين، وأنها تستعمل في النزاعات الشخصية والعائلية والقبلية.
ومن السهل جدا مشاهدة أشخاص في العواصم والمدن العربية يتمنطقون بالمسدسات أو البنادق بمختلف أنواعها كمظهر من مظاهر “الوجاهة” حسب المفاهيم العشائرية والقبلية، ومن السهل جدا على أي مشاهد في مختلف أرجاء المعمورة أن يشاهد على الفضائيات العربية بعض الأغاني الشعبية التراثية ومقدموها يتوشحون بالمسدسات، او يرفعون البنادق أو السيوف، وهم يرقصون ويدبكون ويغنون، وهذه المظاهر لا تشاهد في الأراضي الفلسطينية بشكل علني نظرا لوجود الاحتلال الذي يطلق جنوده النار على كل حامل للسلاح.
وحبّ اقتناء السلاح واطلاق الرصاص في “الهواء” هو ظاهرة تكاد تكون تخصصا يعربيا في مختلف المناسبات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا ما تعذر وجود السلاح الناري القاتل كما هو الحال في بعض المناطق الفلسطينية، فإن المفرقعات هي البديل الجاهز والمتوفر في الأسواق وفي متناول أيدي الجميع.
ومن المناسبات التي يطلق فيها الرصاص حفلات الأعراس، والنجاح في الجامعة وحتى النجاح في الثانوية العامة “التوجيهي” وعند ولادة طفل ذكر عند بعض الأسر التي تأخرت في الانجاب، أو أن أبناءهم من الاناث فقط وولد لهم ابن ذكر، وعند الختان، وعند النجاح في الانتخابات كانتخابات المجالس الطلابية في المعاهد والجامعات، أو انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات المجالس النيابية، وعند عودة الغائبين من سفر، بمن فيهم عودة حجاج بيت الله الحرام الذين لا تزيد غيبتهم عن أسبوعين، أو عند زيارة قائد سياسي او حزبي لمنطقة من المناطق، أو صباحية العرس “لانتصارات” العريس على العروس ولعذريتها، وهذه جميعها مناسبات مفرحة حسب ثقافتنا الشعبية، أما اطلاق النار بين الاخوة المتخاصمين – والذين قد يتخاصمون على أمور تافهة –أو استعمال السلاح للسطو فهذه قضية يطول الحديث فيها.
ولكن القاسم المشترك بين جميع هذه المناسبات هو وقوع ضحايا بين قتيل وجريح من مختلف الأعمار، ومن الجنسين ذكورا واناثا، فحوادث كثيرة قتل فيها العريس او العروس او الخريج او المختون او احد الحضور، فينقلب الفرح الى مأتم، ونودع الضحية بالزغاريد والأهازيج واطلاق النار أيضا، ونعتبر مصرع الضحية قضاء وقدرا، ونشرب القهوة “السادة” عن روحه و”نبوس” لحية وليّ أمره الذي يبدي تسامحا كبيرا نتغنى به في الصحافة، لتكرر فعلتنا مرات ومرات،أو نعتبره شهيدا ان كان محسوبا على أحد ذوي النفوذ،ونتغنى ببطولاته التي يخلقها خيالنا الشرقي، وننتظر بعدها ضحايا جددا أيضا.
أمّا ما تتسبب به ثقافة “الطخطخة” من رعب وازعاج للنساء والأطفال والشيوخ والمرضى فحد ّث ولا حرج؟
وحتى سلاح “المقاومة” واطلاق الرصاص في الهواء، فهل هو من اجل الاستعراضات أمام ووسط المواطنين المسالمين أم لأسباب أخرى؟؟
يبقى أن نقول أن النتائج السلبية المترتبة على ثقافة “الطخطخة” كثيرة وخطيرة، وعلى الحكومات ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية أن تضع حدا حاسما لها لنحمي حياة مواطنينا، ولنظهر كشعب متحضر يستحق الحرية والاستقلال.