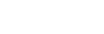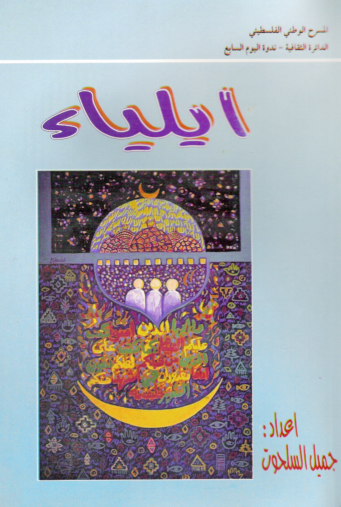القدس: 5-3-2015 ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية في المسرح الوطني الفلسطيني رواية الأطفال”الحصاد” للأديب المقدسي جميل السلحوت، وتقع الرواية التي قدّم لها الدكتور الأديب طارق البكري في 46 صفحة من الحجم المتوسط، وصدرت بداية العام 2015 عن منشورات جمعية الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل في رام الله.
ابراهيم جوهر:
الحصاد– رواية متعة السؤال وضرورة العمل
اكتنزت رواية (الحصاد) للأديب جميل السلحوت بمجموعة من أسماء النباتات البرية والأماكن الجغرافية التي تعرّف القارئ على بلاده. كما اهتمت الرّواية بالسّؤال وسيلة للمعرفة ودلالة على تفتّح الطّفل المدفوع بحب الاكتشاف الباحث عن إجابات فيها المنطق والاقناع.
وقد كانت قيمة العمل في الأرض وحبها والعناية بها من أول الرّواية حتّى نهايتها قيمة تكرّرت بقصديّة التعليم والتّكرار؛ لتدفع الجيل للعناية بالأرض التي توفّر لمن يعتني بها المتعة والربح والسعادة.
يلفت الانتباه في (الحصاد) لغة السّرد الخبريّة البسيطة التي تدرج بانسيابيّة، وهي تقدّم أحداثها وشخصيّاتها وكيفيّة التّعامل مع بعض المزروعات والأطعمة وكيفيّة تصنيعها.
هذه رواية واقع أبطاله من الأطفال الذين يكتشفون الحياة بأنفسهم، فيسألون لكن بعض أسئلتهم تظلّ مرجأة إلى حين يكبرون.
ولم يغب الاحتلال عن رواية الحصاد فجنوده يمنعون المصلّين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وجرّافاته تجرّف الأرض ومؤسّساته الاستيطانية تبني المستوطنات التي تبلع براءة القرية وأر-ضها واقتصادها.
إنها دعوة للحفاظ على الأرض بالعمل لأنّ الذي لا يعمل لا يأكل.
عبدالله دعيس:
لا يعشق الأرض إلا من داعبت أنامله ذرّات ترابها، واشتم عبق تربتها بعد هطول زخّات المطر عليها. ولا يمكن أن يحبّ الأرض إلا من تمرّغ بتربتها؛ حملها بيديه وجعلها تهطل على جسده، فأصبح التّراب والتّبر عنده سيّان، واندمجت روحه بروح الأرض، وتناغمت حركاته مع نباتاتها التي تربو إذا اهتزت ذرات التراب. فلا يمكن لأحد أن يدّعي حب الوطن إذا انعزل عن تراب الوطن. فالشّهداء هم أولئك الذين خرجوا من هذه التّربة ثم عادوا إليها واندمجوا في أديمها عندما دعتهم لنصرتها.
يحاول الكاتب، في هذا الكتاب الموجه للأطفال، أن ينمّي لديهم حبّ الوطن والارتباط به، وأن يلفت نظرهم إلى العدوّ المتربّص بهم وبوطنهم ويشحذ هممهم نحو مقاومة هذا العدوّ. لكنّه لا يفعل ذلك مباشرة، وإنما يبدأ بترسيخ حبّ الأرض لدى الأطفال، عن طريق إظهار العمل في الأرض كمتعة كبيرة لا تضاهيها متعة أخرى. يحمل أرواحهم لتعيش تلك اللحظات التي يختلط فيها عرق الإنسان مع أديم الأرض؛ يعمل ويكون العمل لذّة، يعطي ويكون العطاء همّة عالية، يتعب لكنّ التّعب ليس ممزوجا بالملل بل بالمتعة، ويكون مقدمة للحصول على خيرات الأرض.
يتنقل الكاتب خلال المواسم الزراعيّة المختلفة، يعطي لكلّ منها شكلها المحبب الممتع: فمن حراثة الأرض والطفل الذي يتوق لدفع المحراث إلى زراعة الحبوب والبقول، ثم زراعة الخضروات، ثم موسم الحصاد وقطف الخضروات. ولا ينسى الكاتب جمال الطبيعة والنباتات البرّيّة التي تزّيّنها، وتلك التي تشكّل غذاء للإنسان الذي يعرف أسرارها.
يقود الكاتب عائلة الطفل محمود والطفلة رباب في رحلة ممتعة في أحضان الطبيعة، يصفها بدقة متناهية بكلّ تفصيلاتها، يجعل الطفل القارئ لها يحلّق في هذا العالم الممتع، ويتوق إلى هذه الرّحلة بعيدا عن الأماكن المعتادة للرّحلات. تفكّر المدرّسة أن تقوم برحلة مشابهة لطلابها، ولكن هل ستستطيع المدرّسة القيام بتلك الرّحلة في العام الدراسيّ القادم كما خططت لها. ينتظر القارئ بشغف، لكنّه يدرك في نهاية الرّواية أنّ ذلك لن يحدث، فتلك الأرض تجرفها آليات الاحتلال قبل نهاية العام.
لا يفوت الكاتب أن يصطحب الطفل محمود إلى المسجد الأقصى، فيربطه بالقدس كما ربطه بالأرض، لكنّه لا يستطيع دخول المسجد عندما يصدّه ووالده جنود الاحتلال. وهنا يتنبه الطفل إلى خطورة هذا المحتل الغاصب، الذي يقطع طريق المؤمنين، ثم ما يلبث أن يعتدي على الأرض وتلتهمها مغتصباته.
وهنا يقود الكاتب الطفل ليتساءل عن الفرق بين أبناء الوطن وبين الأعداء. الأعداء يعيشون على هذه الأرض التي اغتصبوها من أصحابها، ولكن هل هم مرتبطون بها؟ هل يشمّ الطفل اليهوديّ تراب الوطن كما يشتمه أطفالنا؟ هل يأكل اليهوديّ الخبّيزة والذُبّيح ويستخرج الفريكة من القمح الأخضر؟ كلّ هذه التساؤلات تجعل الطفل أكثر ارتباطا بأرضه، وأكثر إصرارا على إخراج هذا العدوّ الذي لا ينتمي إليها ولا يفهمها.
هذه الرّواية، وبهذا الأسلوب، تفوق كثيرا منهاج التربية الوطنيّة التي يضطّر فيه التلاميذ لحفظ عدد كبير من النباتات البرّيّة والأماكن التي لم يروها ولم يعلموا قيمتها لدى الإنسان الفلسطينيّ. فالفرق بين الفلسطينيّ والصهيونيّ هو الارتباط بهذه الأرض وتناغمه معها وفهمه لها وفهمها له، وكأنّهما شيء واحد، أمّا ذاك الدّخيل فهو يستغلّ كرمها إذا زرعها ويدمّرها، ويبقى غريبا عنها حتى ولو ولد فيها.
في هذا الكتاب، يعرّف الكاتب الأطفال بكثير من النباتات البرّيّة التي تنمو في فلسطين واستعمالاتها، فهو يذكر الخبّيزة و الذَبّيح والحمّيض والعكّوب والهندبة والحويرنة وغيرها من النباتات البرّيّة. ثم يعرّف الأطفال ببعض الأدوات التي كانت تستعمل في الرّيف مثل المحراث والفأس والمنكوش والصّاج وخريطة القماش والسّقا وغيرها.
ولا يفوت الكاتب التّعريض ببعض القضايا الاجتماعيّة، فهو يشير إلى عمل المرأة المتواصل في الحقل والبيت، وعدم إعانة الرّجل لها حتى ولو كان لديه الوقت والقدرة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك التّفريق في المعاملة بين الأولاد والبنات. فالكاتب لا يريد للأطفال أن يغفلوا عن هذه الحقائق، أو أن يتخيّلوا أن العالم الذي أخذهم الكاتب إليه هو عام خياليّ يبتعد عن الواقعية.
الكتاب يخلو من الرّسومات المعتادة في كتب الأطفال. قد يكون للرّسومات دور كبير في دفع الطفل لقراءة الكتاب، ومساعدته في فهم محتواه. لكنّ افتقار الرّواية للرّسومات يترك المجال للطفل ليتخيل الأرض كما يشاء، وهذا يضيف متعة إلى القراءة، ولا يوجد رسومات تضاهي الخيال الخصب.
ينهي الكاتب روايته بطريقة ذكيّة جدّا، فبعد أن يربط الأطفال بالأرض ويحبّبهم بها ويجعلهم يتوقون لزيارتها ومداعبة ذرّات ترابها، وينتظرون العام القادم بلهفة حتى يرتحلون إليهـا، تأتي آليات الأعداء وتبدأ بتجريفها لتوسيع المستعمرات الصهيونيّة، فيدمّرون الحلم البريء الذي نشأ في نفس الطفل. فينهض الطفل ليذود عن هذا الثّرى الطاهر ويعيد للطبيعة بهجتها عندما يعود الحق إلى أصحابه.
وقال محمد عمر يوسف القراعين:
بدأت من التقديم، فاذا به قطعة أدبيّة فنيّة من مقدّم محترف له الحق فيما قاله، ثمّ انتقلت إلى سيرة الكاتب الذّاتيّة، فوجدته يستحق هذا الاطراء لما كتب من الأعمال، فتشوّقت لقراءة الرّواية، حيث حاول المؤلف فيها تحقيق أهداف ثقافيّة وتعليميّة وتعريفيّة وسياسيّة، نجح فيها بالنّزول إلى مستوى طفل المرحلة الابتدائيّة المتوسّطة، وارتفع بمستوى هذا الطفل بتزويده وأمثاله بمعلومات جغرافيّة مناسبة لجيله من الأطفال، مثل خِرَبِ البريّة: جنجس، والخلايل، أمّ الرّتم ليتعرّف عليها أطفال السّواحرة، والقرى والمدن المحيطة، صورباهر، الشّيخ سعد، العبيديّة، بيت لحم وغيرها،؛ وليتعرّف عليها جميع الأطفال من القرّاء على موقعها من السّواحرة.
نجح شيخنا بربط الانسان بالأرض الطيّبة وزراعتها، والتّركيز على فكرة “اخدم أرضك تخدمك” وتعطيك من خيراتها، كان مزارعا ناجحا رفيقا بالحيوانات، كالشّنّارة التي تحتضن صغارها بالتنبيه إلى عدم ترويعها، والتخفيف من شعور الحزن للنّعجة التي يؤخذ حملها للذّبح، مع أنّني أفضل التّشجيع على الذّبح في المسلخ المراقب صحيّا، كما أذكى عند الأطفال الشّعور بوطأة الاحتلال ورفضه، وبذلك لم ينس شيئا ممّا تقوم به العائلة الزّراعيّة المثاليّة.
أمّا الملاحظات التي كنت خرجت بها كقارئ فسأبدأها باللغة، ولا أقصد لغة الرّواية، فهي مناسبة ورائعة، ما أقصده يتعلّق بتشكيل أواخر الكلمات وخاصّة الأسماء، فهل هو محمودٌ أو محمودُ، وسعيدٌ أو سعيدُ، وعبدُ الملك أم عبدَ الملك أو عبدِ الملك على سبيل المثال؟ فقد تكون أخطاء مطبعيّة أو زلّة لغويّة، فليت أواخر الكلمات العربية أسماء أو أفعالا كانت ساكنة كغيرها في اللغات الشّرقيّة أو الغربيّة، كما نستعمل في النّدوات الاعلامية والصحافيّة؛ ليسهل ذلك على المتعلمين عربا وأجانب، فنقول محمودْ سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو منادى، وما الضّير في ذلك؟
وإلى بطل الرّواية أبو محمود فهو ملاك ميسور الحال، له أطيان، يُشغّل عشرة عمّال لحصد العدس فقط، فما بالكم بالشّعير والقمح والكرسنّة، تعاونه زوجته النّشيطة في كلّ شيء، في الزّراعة والفلاحة والحصاد وأعمال البيت وحلب النّعاج، وعمل الجبنة والعناية بالأطفال، تعمل كدينمو أكثر من النّحلة على رأي الكاتب، ممّا يبرز دور المرأة في الحياة العمليّة، ولكنّه تركها بدون مساعدة، من حماة أو بنت حماة، أو ابنة صبيّة أو من يساعدها كأنها”غرّة ديّة”. هذا كان مألوفا في القرية، ولكن رفقا بالقوارير، كما أنّه لا يليق بزوجة شيخ العرب، التي تهبّ كثيرات لمساعدتها مثل زوجة العمدة مثلا. وهنا تظهر ذكوريّة “أبو محمود” وحتى ابنه محمود الذي يردّ على أخته رباب عندما طلبت منه المساعدة، متعللا بأن أعمال المنزل تخصّ النّساء، وهو يشابه أباه الذي يجلس وصحبه تحت عريشة العنب، يأكلون الفقوس والبصل الأخضر ويلعبون السّيجة. حتى أنّ سياق الرّواية جعل المعلمة لا تعطي جوابا لرباب عن سبب وجود حصّة تدبير منزليّ للطالبات دون الطّلاب. مثل تلك الأسئلة التي تركت بدون جواب حتى يكبر الطلاب، ربمّا أو حتما عند المؤلف تفسير.
وعلى كلّ حال، فيما كنت مغتبطا بأنّ أبا محمود كوفئ على تعبه وجهده بغزارة المحصول ووفرة الانتاج، حدثت مفاجأة وهي أنّ نادى صوت عند الفجر أن الجرّافات تقلع شجرا…تهدم جدرا…وتعيث بما عمّروه فسادا.
صمت أبو محمود من هول الصّدمة، ولم ينبس ببنت شفة ولا حتى بإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.
وكتب محمود شقير:
بلغة سهلة، وبأسلوب سلس يكتب جميل السلحوت رواية “الحصاد” المكرسة للأطفال. وهي في الوقت نفسه تشكل مادة أدبية يمكن لليافعين وللكبار أن يستمتعوا بقراءتها.
تشتمل الرواية على عرض مسهب للحياة اليومية لأسرة فلسطينية، عن مشاعر الحب التي تسود بين أفرادها، وعن ارتباطها الحميم بالأرض وبالمكان، وعن تفاعلها معهما باعتبارهما أساس الهوية والإنتماء، ومصدر الرزق والعيش الكريم. في الرواية كذلك تركيز على الزراعة وعلى الطيور والحيوانات التي تعرفها البيئة الفلسطينية، وفيها إشارات إلى الاحتلال ومخاطره وممارساته التعسفية ضد الناس ومقدساتهم الدينية، وضد الأرض والمكان الذي هو مكانهم وهو في الوقت نفسه وطنهم الذي لا وطن لهم سواه.
أما الفئة المستهدفة التي تتوجه إليها الرواية، فهي التي من عمْر محمود وكذلك من عمْر رباب، حيث يتماهى معهما من هم في مثل عمريهما، وينفتح الأفق أمام الأطفال من هذه الفئة العمرية نحو مزيد من التعلق بالوطن، ونحو مزيد من الإلمام بحقائق الطبيعة الفلسطينية بأشجارها ومحاصيلها الزراعية وبطيورها وحيواناتها المختلفة.
ومن القضايا الإيجابية في الرواية، التركيز على التعلم من خلال طرح الأسئلة، وهو الأمر الذي مارسه الطفلان محمود ورباب حين كانا يطرحان الأسئلة للحصول على إجابات، وكذلك عن طريق الممارسة العملية وهما يعملان مع أبيهما وأمهما في الأرض. ولا يقلل من قيمة الرواية تأجيل الإجابة عن بعض الأسئلة إلى أن يكبر الطفلان، بما يعني أن النمو مقترن بتحصيل مزيد من المعرفة، وبما يعني أننا نظل نتعلم ونحن صغار وكذلك ونحن كبار.
في الرواية إبراز لدور المرأة ولعملها الدؤوب في البيت وفي الحقل. والفكرة التي تقول إن ربة البيت عاطلة من العمل فكرة خاطئة، فهي تعمل في البيت وخارجه وتقوم بمهام كثيرة، وقد أبرزتها الرواية بشكل جيد، بما يشكل دفاعا صحيحا عن المرأة. وفي الرواية نقد لترفع الرجل الشرقي عن العمل في البيت إلى جانب زوجته، وهو نقد صحيح.
رواية جيدة، جديرة بالتقدير، متمنياً للأديب جميل السلحوت الصحة ودوام العطاء.
وكتب الشاعر رفعت زيتون:
الحصاد رواية الرسائل التربوية
صدرت رواية “الحصاد” للكاتب جميل السلحوت للأطفال عام 2014 عن منشورات الزيزفونة في بيتونيا – رام الله.
رواية التوجيه والرسائل التربوية للأهل، وكيف يجب أن يكون تعاملهم مع الأطفال، فالأب والأمّ ملتصقان روحيّا بالطّفل الذي يسأل فيجيبان ويفسّران ويوجّهان.
ومن الرّسائل التربوية التي يريد الكاتب إرسالها للأهل:
– الحرص على الأبناء – فالأب والأمّ ظهرا في صورة الرّاعي الحاني، بينما نرى عكس هذه الصّورة في المجتمع، فهناك من يرسل الأطفال للعمل في المهن الخطرة جسديّا عليهم من أجل حفنة من المال. فالحرص كان موجودا دائما وهذا يساهم في البناء الصّحيح لجسم الطفل.
– التوجيه – والتوجيه يكون في سياسة( افعل ولا تفعل) مع تبيان أسباب الفعل أو عدمه وهذا يساهم في البناء التربويّ للطفل.
– حسن الاستماع: وجدنا الأب معلّما للطفل ومجيبا عن كلّ أسئلته دونما تذمّر أو انزعاج، وهذا يساهم في بناء الطفل من ناحية علميّة ومعرفيّة.
حسن الصّحبة: وجدنا الأب والأمّ صديقين مبتسمين دائما للطفل، وهذا يملأ لديه بعض الفراغ رغم أن هذا لا يكفي، فهو أيضا بحاجة لأقرانه، لكنّ وجود الأب والأمّ في هذه المرحلة كأصدقاء يخفف من اختلاطه مع الكثير من الأصدقاء، فيصبح أكثر انتقائيّة في ذلك، وهذا التّواجد للوالدين يساهم في البناء النّفسي للطفل.
– الدعم المعنوي- وجدنا الوالدين يعزّزان توجّهات الطفل في بعض الأمور حتى في الأمور التي لا يستطيعها، فمثلا يحاول الطفل أن يحمل الفأس فلا يستطيع، فلا تغلق الأمّ عليه الأبواب بل تحاول أن تخلق البديل بأن تجلب له فأسا صغيرة تناسب حجمه وقدراته، وهذا يساهم ببناء الثّقة بالنّفس لدى الطفل، ولعلّ هذه من أهم الأمور في بناء الشخصيّة المبدعة في المستقبل.
– الجانب السّلوكي – ركّز الكاتب على فكرة السّلوك الصّحيح، وفيه عدم التّهاون أمام السّلوك غير الصّحيح، فعندما خطف محمود الطّير من بين صغاره وأفزعهم قامت أمّه على الفور بتوبيخه على سلوكه غير الصّحيح، موجّهة إيّاه الى الفعل الصّائب، وأثنت عليه عندما صوّب نفسه.
هذه بعض النّواحي التّربويّة التّي حملتها تلك الرّسائل عبر سطور الكاتب.
وعندما نكتب رواية للأطفال يجب أن يكون كلُّ حرف فيها في مكانه ، ومدروسا بدقّة وإلّا كانت النّتيجة عكسيّة. ومن هنا تأتي قيمة العمل الأدبيّ في كمّ المعلومات والمواضيع ونوعيتها واختيار الألفاظ والمستوى المناسب لهذا العمل الأدبي.
ومن الإشارات والمواضيع التي أكسبت الرّواية قيمة أكبر ما يلي:
– الإشارة إلى المسجد الأقصى والحثّ على الصلاة فيه – الكاتب هنا تحدّث عن المسجد الأقصى، والذّهاب إليه للصّلاة خصوصا في أيّام الجمعة، الأطفال سوف يقرأون فتتعزّز لديهم فكرة الصّلاة والتّعلق بالمسجد الأقصى، في هذا الوقت العصيب الذي يتعرّض له المسجد لتلك الهجمة الشّرسة للسّيطرة عليه. ولي هنا ملاحظة على الكاتب الذي جعل الوالد يأخذ ابنه للصّلاة في المسجد الأقصى ولم يأخذ ابنته، بينما ساوى بينهما في فكرة الرّكوب على الحمار والسّير مشيا على الأقدام ،ولا أدري لماذا قفز إلى ذهني كاتبنا الكبير محمود شقير الذي لو كان حاضرا لجعل الوالد يأخذ البنت قبل الولد رغما عن أنف المجتمع.
ومع أن الكاتب قد أنصف الأمّ في وصف ما تقوم به من أعمال في البيت ليل نهار، إلا أنّ ذلك لم يشفع له بعدم المساواة بين البنت والولد في زيارة الأقصى.
– الإشارة إلى الأماكن – الكاتب يصف الطّريق إلى المسجد الأقصى ذاكرا أسماء الأماكن والقرى والشّوارع، حتى ترتسم هذه الأماكن في ذهن الطفل القارئ، حتى ولو كان سكنه بعيدا عن القدس، وربما هو ممنوع من دخول مدينته. وكان الوصف إلى حدّ ما دقيقا بحيث ترتسم الصّور أمامه، ولكنّه لم يدخل بالتّفاصيل الدّقيقة للمكان.
– الإشارة إلى حبّ الأرض – الكاتب تحدّث عن الزّراعة والفلاحة والأرض، وكان الحديث من خلال الحوار مع الطفل وبمشاركته ووجوده، وهذا أكثر تأثيرا على الطّفل القارئ من أن يلقن الكاتب لوحده الأطفال حبّ الأرض. فالطّفل يعلم الطّفل بشكل أسرع وأكثر تأثيرا. وهذا استخدام ذكي لتمرير الفكرة يحسب للكاتب.
– الإشارة إلى الوضع السّياسيّ – لم يخفِ الكاتب عن الأطفال الوضع السياسيّ في البلد، فتحدّث عن الاحتلال وعن الحواجز أيضا بالحوار مع الطّفل، وهذه إضافة ذكيّة أخرى. لقد راعي الكاتب عقل الطّفل الصّغير وطبعا عقل أقرانه من القرّاء الصّغار، فلم يثقل عليهم بالمعلومات السّياسة ثقيلة الظلّ والمستعصية على فهم العامّة فها هو يقول لإبنه “عندما تكبر ستفهم ذلك يا محمود”، فهو من ناحية وضعهم في الحالة العامّة ولم يدخل في التّفاصيل المرهقة.
– الإشارات المعلوماتيّة – أضاف الكاتب بعض المعلومات عن أساليب الزّراعة
ليتعلمها الأطفال ذاكرا بعض أسماء النباتات، والتي ربّما يسمع البعض منّا أسماءها
لأوّل مرة، وكمثال على ذلك نبتة الذّبيح التي أسمع بها للمرّة الأولى. وكذلك المعلومة عن تصرّف الحيوان عند فقد صغيره.
كذلك ذكر بعض أسماء المستوطنات، وذكر أسماء أصحاب مالكي الأرض الحقيقيّين مثل،
مستوطنة كيدار المقامة على بيدر العبد في منطقة الخلايل.
– الإشارة إلى وسائل الإعلام وتأثيرها – فقد تحدّث الكاتب عن المسلسلات
الهادفة التي يسمح للأطفال في سنّ معيّنة مشاهدتها، كتلك التي علمت الأطفال
أن من لا يعمل لا يأكل، كما قال الحكيم للكسول في المسلسل. وهذه إشارة تربويّة هامّة للأهل لكي ينتبهوا لهذا الجانب الخطير الذي هو وسائل الإعلام والاتصال.
– الإشارة إلى ضرورة التّرفيه – أخذت الرّحلة في البرّيّة حيّزا لا بأس به من رواية الكاتب جميل السلحوت بكلّ تفاصيلها، ولا أظنّها تأتي إلا في سياق تلك الرّسائل والإشارات التي ساقتها الرّواية، فالتّرفيه خارج البيت ضروريّ للصّحة النّفسيّة للأطفال وكذلك للكبار على حد سواء، وهناك من يحرمون أنفسهم وأبناءهم من ذلك، وهناك الأسوء كالذين يرفهون عن أنفسهم ويحرمون أبناءهم، هذه الرّحلة لم تقتصر على التّرفيه فحسب بل كذلك على المعرفة، فالأطفال تعرّفوا على المناطق وأنواع النباتات والطيور وغيرها.
– التعاون بين الأسرة والمدرسة في عملية البناء – فما حدث بعد الرّحلة التّرفيهيّة من المدرسة في السّماح للطفلة أن تتحدث عن رحلتها أمام زميلاتها، وكذلك اقتراح الرّحلات المدرسيّة والتعاون مع أولياء الأمور، كلّ ذلك يشير إلى أنّ هذه العمليّة التّربويّة والتّعليميّة إنّما هي عمليّة مشتركة بين المؤسّستين، مؤسّسة الأسرة ومؤسّسة المدرسة.
الرواية لم تكن فقط توجيهيّة تربويّة، بل كانت رواية اجتماعيّة وسياسيّة. فقصة منع الجنود لأبي محمود من دخول الأقصى للصّلاة، وضياع ابنه منه، وعودته للصّلاة في الشّارع، قصّة تتكرّر كلّ يوم، إمّا على مداخل الأقصى أو على الحواجز العسكريّة والبوّابات والمعابر التي قطعت أوصال الوطن.
كذلك فقد اشتملت الرواية على الكثير من العادات وأسلوب الحياة اليوميّة في المجتمع الريفي الفلسطينيّ، في عمليّة الطّهي والتّخزين والمواد المستخدمة، والبيع والشّراء وأساليب الزّراعة والحصاد وغيرها.
فالحصاد رواية ريفيّة بامتياز، وفيها عبق البراري ورائحة الحقول وأصوات الحيوانات والصباحات الباكرة، وجلسات العائلة في المساء.
إذن نحن أمام رواية بأحداثها وشخوصها وحوارها وصراعها، وفيها التّشويق والزّمان والمكان بشذى الرّيف والشّرق والأصالة.
وقالت ديمة السّمّان:
رواية (الحصاد).. لون أدبي أصيل.. تشتم فيها رائحة الأرض
بين الحصاد والحصار حرف واحد.. كما ذكر مقدّم الرّواية الدكتور طارق البكري.. ولكن شتّان بين ما فعلت الدّال وتفعل الرّاء… الفرق شاسع.. الأولى صمود وبناء.. والثّانية هدم ودمار.
رواية الحصاد.. لون أدبيّ أصيل.. تشتمّ فيها رائحة الأرض.. تدخل القاريء بيت الفلاح الفلسطيني البسيط الأصيل الذي يركض على رزق عياله.. متمسّكا بكبريائه وشموخه.. عزيز النّفس.. أصالته اكتسبها من رائحة تراب أرضه.. واستعار من صخورها صلابة مواقفه بتمسّكه بالأرض والوطن.
رواية تصف خيرات الأرض.. تصف حبّ الفلاح وعشقه لأرضه.. هو يفترش ترابها ويلتحف سماءها.. يورّث أطفاله حبّ الأرض ويحثّهم على التّمسك بها.. فالأرض كالعرض.. لا تنازل عنها أبدا.
تفنّن الكاتب بوصف القرية.. وحياة القرويين وأطفالهم الذين يكبرون سويا مع خيرات الأرض. جميلة هي القرية.. حياتها.. بساطة أهلها.. أصالتهم تنبع من الجذور.
أحبّ القاريء عائلة أبي محمود.. أعجب بالأمّ والأب.. وبطريقتهم في التّعامل مع أبنائهم. كم هي راقية هذه الأسرة.. حكمة الأبوين ووسع صدرهما كان لافتا للنّظر.. إجاباتهم على أسئلة اطفالهم تستحق من القاريء وقفة تحليل.. فبعض الإجابات كانت تربويّة تعليميّة.. فيها العلم والمعرفة والرّفق والرحمة والتوجيه التّربويّ السليم.. وجزء منها جاءت محمولة على تنهيدة بحجم الوجع الفلسطيني: ( عندما تكبر ستفهم).. تكرّرت هذه الاجابة من الأبوين ومعلّمة الأطفال في المدرسة.. جواب رفضه الطّفل.. وشعر بتهرب الكبار من الاجابة.. قد تكون الاجابة أكبر من استيعاب الطفل.. وقد يكون السبب تجنب الكبار فتح جروح وصلت حدّ التّقرح.. ولكنّها بجميع الأحوال يرفضها الأطفال شكلا ومضمونا.
جعل الكاتب القاريء يحبّ القرية.. ويتمنّى أن يكون أحد أفراد عائلة أبي محمود. فهي نموذج للعائلة التي تعرف كيف تسعد أفرادها.. وكلّ من يعيش معها.. حتّى مواشيها.
لم يغفل الكاتب أن يوجه نقدا عميقا للمجتمع الذي يربّي أبناءه على توزيع الأدوار بين الرّجل والمرأة بشكل غير منصف لصالح الرّجل.. بحيث تقتصر أعمال البيت على المرأة.. ولا يمدّ الرّجل لها يد العون بحجّة أنّه ( رجل).. أعمال البيت تمسّ رجولته.. تصل حدّ كرامته وكبريائه.. أمّا المرأة فتشارك الرّجل بالعمل عن طيب خاطر.
أن يصف الكاتب مرحلة لا يزال يعيشها.. ويكون القاريء أحد أفرادها ويستمتع بقراءتها.. ويتأثّر بها.. فهذا من المؤكّد لصالح الكاتب.
فبعد أن أحبّ القاريء القرية.. ورآها جنّة على الأرض.. صدمته كلمات الكاتب في نهاية الرّواية.. وهو يراها تنزف.. (جرّافات المستوطنين تجرف الأراضي الزّراعيّة) تجرف جنان الأرض! فزاد كرهه وحقده على الاحتلال.
كانت رسالة من الكاتب.. لا شكّ أنّها وصلت بامتياز.
وكتب عزّ الدّين السّعد:
رواية الحصاد المكتوبة لكنان الحفيد وجيله تخطّ البسمة، وتمنح مساحات شاسعة من المعرفة الزراعية الفلسطينية التي تحاكي المكان، وتعانق المحراث والحارث والرجل والطفل والفتى والفتاة وعمود الدّار الأمّ.
في هذه الرّواية يشتغل كلّ من الشّخوص بمجاله واضحا ساردا ارادته للعمل، واضعا نصب عينيه استمرارية حياة وادعة، في أفقها بعض ما يجري في حوض المدينة المقدّسة ومسجدها الأقصى ويؤجل الرّاوي والأب بنفسه الخوض في تفسير عقدة الاحتلال؛ ليبقي على الفتى واخته الكبرى على وعي ما بما يحدث حولهما، لكن الحصار الزّمني لا يحول دون استمرار دوران الزّمن لمواسم الفلاح من حراثة وعزق وبذار، وانتقال مع تصاعد المواسم نحو الشّتاء، فالرّبيع فالصّيف بالتعامل مع الكنّار وزرع البصل وشتل البندورة والبامية، والانتقال للفريكة والسّعادة بشيّها على النّار، والتهامها والتّلذّذ بطعمها رغم وجود الّلحم المنزليّ من قطيع الغنم البيتيّ … رواية معلومات تدريسيّة عن الزّراعة والمزروعات ونقل أسماء أماكن في أراضي عرب السّواحرة جنوب القدس، وتفاعل رصين متأنّ للشّخوص تنقلك الى الحقل البعيد – ولماذا هو بعيد؟
لأنّ الزّراعة تكون في الحقول البعيدة عن مكان السّكن، وتخصيص الشّجر للأماكن القريبة … وسرد أنواع البقول والمزروعات والخيرات المتوفّرة لدى الفلّاح، من حليب وأجبان وألبان وأنواع أخرى، والاستفادة من كلّ مساحة من الحقول والتّراب للفقّوس والبصل والحبوب على اختلاف أنواعها.
تفاعل الأطفال ومعلّماتهم وكأنّ باقي الأطفال بلا أراض ! هل رباب وأخوتها تذهب لحقلهم في رحلة؟ … ثم هل هو حلم الكاتب بأن يكون وضع الفلّاح الفلسطينيّ حقا في رغد من العيش؟ أم هو مجرّد تصوير لمنح المعومات الفلاحيّة برونق روائيّ بعيد عن الواقع؟ قد يصدّق الجيل الحديث ما جاء في الرّواية من واقع الرّغد وسعة العيش، وهو عكس للواقع المرّ الذي عاشه ويعيشه الفلّاح الفلسطينيّ من ضنك وملاحقات وضرائب على الأرض والمزروعات، وصعوبة في تسويق أهمّ المنتوجات الفلسطينيّة من زيت وزيتون وحمضيّات وورود ناهيك عن مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال.
أصحّ الأقوال ” لقطف الثمار من الأرض مباشرة متعة لا يعرفها إلّا من مارسها، وطعم الثمار في الحقول يختلف عنه في السّوق”
” من لا يعمل لا يأكل”
وفقك الله شيخنا جميل السلحوت دوماً بمنح القراء زبدة الفكر والمعلومة، وزادك الله ثراء لغويا تعبويا يمنح الأجيال المعرفة وسعة المدارك.
أمّا رولا غانم فقد قالت:
الحصاد رواية تعمق علاقة الإنسان بالأرض
تدور أحداث الرواية في جبل المكبر بلد الكاتب الذي له حضور قوي في معظم رواياته. وشكلت الأرض محور هذه الرواية، إن الانتماء إلى الوطن هو الذي دفع الكاتب إلى جلب أنظار الأطفال إلى الأرض؛ لأنها تؤكد على هوية الإنسان الفلسطيني وعلى وجوده، وهذا الجيل هو الجيل الصاعد الذي نعوّل عليه كثيرا، فجميل جدا أن نغرس فيه حبّ الوطن،
وأن نلفت انتباهه لما يجري حوله من ممارسات قمعية تمارس من قبل المحتلين والمستوطنين بهدف اقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه؛ للاستيلاء عليها واستيطانها. والأرض أغلى ما يملكه الإنسان فهي تمنحه الحبّ والأمن والرّزق، والكاتب ركّز على القطاع الزّراعيّ كونه جزء أساسيّ من النسيج الاقتصادي، ويلبّي الحاجات الغذائية للشّعب الفلسطينيّ، ونلاحظ من خلال الرّواية بأنّ الفلسطينيّ يستطيع أن يكتفي ذاتيا من خلال الاقتصاد المنزليّ، وأن يعتمد على الأرض بشكل كليّ، فها هي أمّ محمود توفّر احتياجات البيت، بل وتخزن للمواسم القادمة من خيرات هذه الأرض، وركز الكاتب على المزارع أيضا باعتباره خطّ الدّفاع الأوّل عن الأرض. وقد اصطحبنا الكاتب في رحلة مع عائلة أبي محمود الفلسطينيّة حيث البساطة والدفء وتراث الأجداد، ذاكرا لنا أسماء المحاصيل الزراعيّة من خبّيزة، قمح، شعير، عدس، كرسنة، حمّيض، ذبّيح وعكوب….الخ.
وتغرس هذه الرّواية في الفتيان والفتيات الكثير من القيم والعقائد، فالولد يقلد والده ويذهب للصّلاة في المسجد الأقصى، ومن القيم التربويّة الواردة في الرّواية :الإيثار فأمّ محمود تؤثر زوجها وأولادها على نفسها، والولد يؤثر أخته على نفسه، فهي تركب وهو يمشي على قدميه، ومن القيم الكرم الذي طال الطّير والحيوان، وعشق الأرض، فالأولاد يعملون في الأرض بشغف، ناهيكم عن التّعاون، فجميعهم يد واحدة، وإن تكاسل الزّوج أبو محمود ملقيا على زوجته معظم الأعباء، وهذا ليس غريبا عن الرجل الشرقيّ والمحتمع الذّكوريّ.
صورة المرأة في الرّواية مشرقة للغاية، فهي تعطي بلا حدود، وتعمل ليل نهار، داخل البيت وخارجة، تنكش وتزرع وتحصد وتحلب وتعدّ الطعام وتغسل وتنظف، وتدبّر أمور البيت، وتحنو على زوجها وأبنائها، وكأنّي بالكاتب يهدف إلى لفت الانتباه إلى دور وتضحيات المرأة، والمسؤوليّات التي تقع على عاتقها، في حين يعتقد البعض أنّ ربّة البيت لا تعمل!
ويلاحظ أنّ هذه الرّواية تلفت الانتباه إلى جمال وطننا، وكثرة خيراته، وبالتّالي يجب أن توجّه الرّحلات المدرسية إلى المناطق الزّراعية، حيث جمال الطبيعة وخيراتها؛ وليعرف التلاميذ وطنهم بشكل مباشر.
ولم تخل الرّواية من المنغصات، فلطالما عانى الإنسان الفلسطينيّ وخصوصا المقدسيّ من الإحتلال، ومعاناته تجسّدت من خلال منعه من الصّلاة في المسجد الأقصى، والاستيلاء على أرضه مصدر رزقه. والكاتب أراد أن يوصل رسالة تهدف إلى التّشجيع على الزّراعة باعتبارها مجدية ماديّا، فالأرض تعطي من يعتني بها ويزرعها، رغم المعيقات التي يقوم بها المستوطنون من استيلاء على الأرض ومن تجريف.
استخدم الكاتب لغة بسيطة سهلة خدمت النّصّ، ووظف التّراث من خلال دمج بعض الأغاني الشعبيّة التي كان يغنّيها العامل في موسم الحصاد؛ للتّشجيع على العمل. كما أنّ السّرد الرّوائي الانسيابيّ في هذه الرّواية طرح العديد من الأسئلة؛ للفت انتباه الناشئة لأجوبتها، بل والدّعوة إلى البحث والتّفكير.
ملاحظة: وقع الناشر في خطأ هو أن الرّواية للأطفال، كما جاء على غلافها الخارجي، وعلى الصفحة الثانية، وجاء على صفحتها الأولى بخط أسود كبير أنّها للفتيات والفتيان.
وكتبت رفيقة أبو غوش:
تضمَّنت الرواية عددًا من الأهداف التربويَّة الهامَّة، تهدف إلى إكساب قيم أخلاقيَّة، وتعليميَّة، وتربويَّة، تحثُّ الأبناء على الارتباط بالأرض، والانتماء للوطن، تكسب قيمة التعاون، والرأفة بالحيوان؛ “اللهم اطعمنا، واطعم طيورنا” صفحة 8؛ والاهتمام بحماية البيئة تعريف بأسماء، ووظائف النباتات المستعملة في البلاد. الاهتمام بحياة الفلاحة، تعريف بأسماء ومواقع جغرافيَّة للأماكن في القدس وأكنافها، والمعاناة التي تواجه العائلات البعيدة عن المدينة، تعكس دور المرأة والأعباء الثقيلة المحمَّلة على أكتافها؛ كما تحث على التعاون الجماعي والأسري، واهتم الكاتب في توضيح عادات الأسر الفلسطينيَّة المكتفيَّة اقتصاديًّا، اكتفاءً ذاتيَّا، بتخزين المؤن للأعوام القادمة، وطرق تخزينها.
تناسب الرواية جيل الفتيان، والفتيات، أكثر من جيل الاطفال، نظرًا لاحتوائها على كلمات صعبة بعيدة كل البعد عن حياتهم اليوميَّة.
لا أجد بأن هنالك ضرورة لإضافة التقديم، والتي لخَّصت الرواية تقريبًا، حبَّذا لو خلت الرواية من التقديم، مع احترامي الكبير لكاتب هذه التقديم الرائع، كاتب أدب الأطفال الشهير الدكتور طارق البكري، كما أنني لا أجد ضرورة، في إدراج السيرة الذاتيَّة للكاتب في نهاية الرواية.
تعتبر اللغة في الرواية سلسة، ومكثَّفة فيها ثروة لغوية غنيَّة جدًّا، وغير مألوفة، وخاصَّة المعاني المتعلقة بحياة الفلاحة والزراعة والحصاد.
اهتم الكاتب بالتشكيل الكامل، وإظهار علامات الترقيم، بطريقة صحيحة بإتقان تام، إلا انه لا أرى بضرورة التشكيل، فيما لو كانت الرواية مُعدَّة للفتيان، والفتيات.
احتوت الرواية على محسنات بديعيَّة جميلة: “اصبحت حقول الشعير في منتصف أيَّار صفراء ذهبيَّة، فقد حان حصادها، تموج مع نسمات الهواء، كحفل كبير راقص على انغام سيمفونيَّة أبدعتها الطبيعة، واستغلَّتها طيور مختلفة الأشكال والألوان. تغوص فيها مغرِّدة، وتغادرها وقدِ امتلأت حواصيلها بما تنبت الارض” ص 37.
أسلوب الرواية: اعتمد الكاتب على أسلوب السرد المباشر، والحوار بين أبطال الرواية؛ لإظهار الرسالة التربويَّة، أو التعليميَّة بواسطتها، خلت الرواية من الحبكة، والتي هي من اهم عناصر الرواية؛ مما تفقد الرواية عنصر التشويق.
حبَّذا لو كانت الحبكة، كما وردت في نهاية الرواية: “استيقظ الأهالي فزعين على صوت مآذن المساجد تنادي بأنَّ جرَّافات المستوطنين تجرف الاراضي”، يبدو أنَّ الكاتب عمد لإظهار الحياة كما هي في الحقيقة. تفتقر الرواية للخيال، والذي هو عنصر هام في كتابة القصص للأطفال.
هذه الرواية هامَّة جدًّا لطلاب المدارس؛ لتعليمهم مهارات الزراعة في موسم الحصاد، وكل ما يتعلق بالحياة الريفيَّة؛ لذا انصح باقتنائها في مكتبات المدارس.
اهتم الكاتب بكتابة الامثال الشعبيَّة، والأغاني التي يرددها العمال أثناء الحصاد، كما ورد ص : 39-38. “منجلي يا من جلاه راح للصايغ جلاهِ
ما جلاه إلا بعلبه يا ريت العلبة عزاه
وما الى ذلك.
وُفِّق الكاتب في اختيار العنوان المناسب، الذي يوحي بالاستمراريَّة، والتفاؤل في الحياة، كالمثل القائل: “من زرع حصد”. الحصاد يعني النماء، وهو يرمز لحياة الفلاحين، المكافحين من اجل لقمة العيش.
صورة الغلاف: صورة الغلاف عبارة عن سنبلة واحدة فقط، وهي رمز للعطاء، الذي لا حدود له، كما ورد في قوله تعالى: “﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾، سورة البقرة.
حبَّذا لو كان عدد كبير من السنبلات، لأن الحصاد يشمل الجميع.
وقالت رائدة أبو الصويّ:
وجدت في هذه الرّواية الكثير من المفاهيم والمصطلحات الضّروريّة لتنمية قدرات الطفل على التّفكير والاجتهاد، وترسيخ حبّ الأرض في قلب وعقل الأطفال منذ الصّغر. بطل الرواية محمود يرمز الى جيل كامل من أطفال الوطن، استمتعت كثيرا وأنا أقرأ ما جاء في الرّواية من تفاصيل دقيقة جدا، غالبيتنا مررنا بها في مرحلة الطفولة، وضعها الاستاذ جميل في قالب جميل في هذه الرّواية، تصوير الأرض وباطنها عندما تشقّ سكّة المحراث قلبها لزراعة حبوب البذار، وكيف تضمها في بطنها، قديما كنت أسمع أن الأرض أمّنا، والنّخلة عمّتنا، وفي هذه الرّواية تأكدت ممّا سمعت، تصوير بعض الحركات التي نمرّ عليها مرور الكرام، مع أنّنا جميعنا مررنا بها في مرحلة الطفولة، عندما قام محمود بالوقوف على رؤوس أصابع قدميه ليقنع والده بالسّماح له باستخدام المحراث، علاقة الانسان بالأرض والتّربة… السلاسل الحجريّة التي تحيط بالأراضي الزراعيّة، وتقليد محمود لوالده في وضع رمز للدّفاع عن الأرض، رض الانسان غالية وتستحقّ أن يحيطها بالحجارة خطّ الدّفاع الأوّل .استمتعت عندما ذهبت مع محمود ووالده يوم الجمعة خلف البغل، ونعفنا بذور العدس بانتظام، ودعاء والد محمود:اللهم اطعمنا واطعم الطير. وتوضيح كلّ عمل يقوم بعمله والد محمود له بطريقة عقلانية، يعطي الفعل وسبب الفعل ونتيجة الفعل، في الرّواية الكثير من آداب السّلوك مع الأرض والطير والحيوان، وطريقة التعامل المثالية بين الآباء والأبناء، في الرّواية وصف للمناطق في القدس الشريف ومناطق تاريخيّة، مثلا في صفحة 24 عندما ذكر الكاتب منطقة الضُّحضاح في برّية السّواحرة، ومنطقة جنْجِس الخربة الأثرية المرتفعة، التي تحتوي على آبلر مياه وآثار بيزنطية. جبل الزيتون الذي يحتضن القدس القديمة من جهة الشّرق كان حاضرا، وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وجبل المكبر وامتداده جبل الشيخ سعد، وجنوب جبل المكبر قرية صور باهر…صورة البحر الميّت في الجنوب ووصفها الرائع من قبل الكاتب عندما قال: واذا ما التفتَ إلى الجنوب الشّرقيّ فإنّه سيرى جانبا من البحر الميّت… تتلألأ مياهُهُ كصحن فضّيّ عظيم، وخلفه تمتد جبال مؤاب الأردنيّة شامخة، ما أروعها من رواية يستمتع القاريء الكبير قبل الصّغير بكلّ فقرة من فقراتها، ويستفيد منها الكثير الكثير، في نهاية الرّواية أعجبتني صورة أمّ محمود عندما أشعلت النار تحت سنابل القمح، ثم فركتها بيديها لتستخرج بذور الفريكة، رواية أديبنا تستحق أن يقتنيها كلّ أبنائنا وبناتنا لما تحتويه من معلومات قيمة جدا وممتعة، يجب أن يكون لدينا المام بها.
وقال جمعة السمان:
رواية تربويّة توثيقيّة تعليميّة اجتماعيّة هادفة.. كتبت بأسلوب راقٍ.. بحيث يكون للمعلومة التي تصل إلى ذهن الفتى الخلود.
قرأت جميع روايات الكاتب جميل السلحوت.. لأجد أنّ هذه الرواية تتفوّق على جميع رواياته.. رغم أن تلك الروايات كانت توثيقيّة.. تصلح لتكون مراجع لأحداث القضيّة الفلسطينيّة.. منذ عهد الانتداب البريطانيّ حتى يومنا هذا مع الاحتلال الاسرائيليّ.
امتازت هذه الرّواية بأمانة وصدق وصف المجتمع القرويّ الفلسطينيّ، بعد أن استطاع الكاتب بأسلوبه الرّائع أن يدخلنا إلى أحد بيوت القرية الفلسطينيّة.. لنعيش الكرم والتعاون والحبّ ورقيّ الخلق والتعامل الأسريّ بين أفرادها.. وقد كان ذلك جليّا واضحا في الحوار بين الأب وابنه محمود.
كان الكاتب ذكيّا جدّا في طرح الأسئلة التي كان يوجّهها الابن لأبيه؛ ليجعل الكاتب من كلّ سؤال جوابا.. يشرح فيه القضيّة الفلسطينيّة..وعسف الاحتلال الاسرائيليّ.. لتبقى مأساة الشعب الفلسطينيّ خالدة في أذهان براعم أبناء الوطن.. تحثّهم وتوقظ في صدر الغافي منهم العمل من أجل تحرير الوطن.
أشدّ على يد الكاتب.. وأشجّع على مثل هذه الرّوايات… لتنصف فتياننا.. وتحثّهم على تحمّل مسؤوليّاتهم.. والقيام بواجباتهم نحو وطنهم. قد علمنا التّاريخ أنّ الفتيان دوما هم رأس حربة تحرير الأوطان..فهم الأمل.. وهم العمل.. وهم رجال الغد الفاعل.
وقالت سوسن عابدين الحشيم:
الرواية هادفة للأطفال تحثهم على حب الارض وعشق ترابها… تحكي قصة عائلة فلسطينية واطفالها محمود ورباب… ما يزرعه الآباء يحصده الأبناء، هكذا كانت هذه العائلة التي زرعت حبّ الوطن في قلوب أطفالها حيث كانت تلقنهم وتعلمهم كيفية
العناية بأرضهم ورعايتها، هدف الكاتب الى توضيح قضية الأرض بأسلوب سلس وسهل يناسب الأطفال وبطريقة مشوقة باستخدامه الحوار بين أفراد العائلة…كما استخدم صيغة الأسئلة التي كانت ترواد الطفل في ذهنه ويسألها لوالديه، فيجيبان عليها بطريقة مقنعة نوعا ما، كانت بعضها “عندما تكبر ستفهم كل شيء” لكن الطفل الفلسطيني لم يكن صغيرا أبدا فهو ليس كغيره من أطفال العالم، هو يرى ويشاهد ويسمع ويعيش كلّ جرائم الاحتلال من هدم البيوت وقتل الأطفال والشباب، واعتقالات وحصار ومداهمات واقتحامات البيوت ومصادرة الأراضي، عاش زمنا مليئا بالمآسي فها هو يمرّ من الحواجز، ويرى جنودا مدججين بالأسلحة يطلقون الرصاص القاتل للشباب والأطفال، يحاول الكاتب أن يعطي الصورة المثالية لهذه العائلة التي تمثل أيّ عائلة تعيش على أرضها تزرعها وتأكل من ثمارها، الأرض تعطي من يرعاها ويزرعها، فهذه العائلة التي تتمسك بأرضها وتحافظ عليها، الأب وحبه وشغله وعنايته بكلّ ما يربطه بأرضه من أشجار وعصافير، والأمّ التي تفلح وتزرع وكل ما تقوم به اتجاه أرضهم، تعلم اطفالها حب الأرض مما ينتج عن هذا الحب التعلق بها وعدم التفريط بها، وهذا ما أراده الكاتب من كتابته لرواية الحصاد، فالحصاد أكيد والنصر قريب ما دام أطفالنا في أرضهم يزرعون ويحصدون.
.