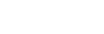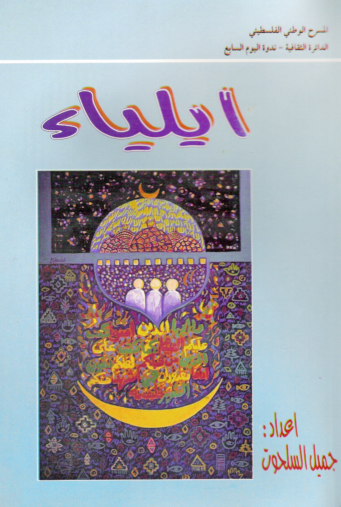القدس: 3-3-2016 من رنا القنبر- ناقشت ندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس رواية “بورسلان” للكاتب أيمن عبوشي، صدرت الرواية التي تقع في 194 صفحة من الحجم المتوسط عام 1915عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس.
بدأ النقاش ابراهيم جوهر فقال:
رواية الواقع المتشظّي في موازاة الفانتازيا حين تجتمعان معا في شخص واحد وحالة وحيدة.
في “بورسلان” – المادة الهشّة سريعة العطب والتشظّي- تحمل الشخصية نقيضها وشبيهها الموازي في الفكر والسلوك، في قالب من الحيرة والأسئلة والاغتراب؛ لتصير إلى الحطام لأنها لا تستحق الحياة.
ما السبيل للخلاص؟
سؤال الكاتب غير المطروح تصريحا؛ لأنه اكتفى بالتلميح بعد جولة من العذاب والخيال والتوازي وحمل الأضداد.
هذه رواية الواقع في أقسى حالاته قتامة وضياعا بإنسانه التائه، وهو لا يعرف ذاته ومساره. إنّها تفجّر أسئلة تحضّ على التغيير والعودة إلى الأصل الإنساني غير الملتبس.
محمد عمر يوسف القراعين:
رواية بورسلان” والرّبيع العربيّ
عندما قرأت رواية “بورسلان” لأيمن عبوش والصادرة عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس، تبادر لذهني هذا البيت من الشعر
أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد
والبيت يضرب مثلا على التعقيد المعنوي في البلاغة، لأن الأصل أن نقول: وأبوك محمد وأنت الثقلان. بعض الأفلام تبدأ بحكم قضائي تتسلسل الأحداث بعده، لتصل إلى نتيجة تبرر تنفيذ الحكم بالبراءة أو التجريم. أمّا في هذه الرّواية المعقدة، فالتّحقيق يستمر إلى ما لا نهاية، في ارتفاع وانخفاض، اعتقال وتحرير بالصدفة لقيام الثورة، إعادة اعتقال وإطلاق سراح لبطل ثوري يقود إلى منصب رفيع، وأخيرا إقامة جبرية مخففة، تؤدي في النّهاية إلى تصفية.
قد يكون ذلك الوزير، بطل أو موضع الحوارات، الذي جرى التحقيق معه بتهمة انتحال شخصية رجل بارز، أستاذا جامعيا، دكتورا في العلاج الطبيعي، ألحقوه بالمخابرات كوظيفة ثانية يكتب التقارير بحرفية، مصابا برهاب الارتياب، لديه انفصام بالشخصية، لأنه يكتب تقارير عن زملائه، يكره نفسه ورائحته النتنة، ويحلم بأن يخرج منها هاربا، وتركها في البيت مصابة بالأنفلوانزا، (دكتور جيكل ومستر هايد). ولكونه كتب تقريرا عن أحد المتنفذين، جاء مع زبانيته إلى شقة الدكتور، فأشبعه ضربا وحرّم عليه البقاء في المنطقة. هذا الاستفزاز جعله يلفق له تهمة اغتيال الرئيس، “إن الذبابة تدمي مقلة الأسد”. ومن ناحية أخرى قد يكون كما صرح للمقدم فضل، أنه نشأ متشردا، لأن والده الظالم طرده من البيت، يتسول من الناس في الشوارع بلا إثباتات، بينما عاش أخوه التوأم مع والده، وصار على ما هو عليه، والصدفة جاءت به إلى بيت شقيقه الخاوي، يسأل عنه لا أكثر بعد غياب.
أحداث الرواية مرتبة لتركيبها على أي من الشخصيتين قتل وسرق الشيخ عزمي الذي يبيع الفول النابت، سواء كان توأم القيادي في الجهاز، الذي ألقي القبض عليه، وتم اعتقاله بسبب زيارته العفوية لبيت أخيه التوأم، أو أستاذ الجامعة المصاب بانفصام الشخصية والتخيلات، والمطرود من شقته، الذي رسم خطة اغتيال رئيس الدولة، وألصقها برجل السردين. المهم أن أحدهما عذب في السجن، وبقي رهن الاعتقال، إلى أن قامت الثورة، وهبّ الشباب لتطهير المعتقل، وفتح العنابر والزنازين، لأنّ الشعب يريد إسقاط النظام، فخرج من القبو محمولا فوق الأكتاف معتقلا سياسيا.
ولكن الرياح لا تجري دائما كما تشتهي السفن، فبعد أن استعاد بطاقته الشخصية، وعمل محاسبا في مطعم أعيد إلى المعتقل، على أنه من رجال العهد البائد، كان شارك في قمع مظاهرات حصلت قبل سنوات، إلى أن تم إخراجه على يد مرجي باشا رئيس الحزب المعارض، كمعتقل منسي في أقبية النظام البائد، على أن يلتحق بالحزب. عين وزيرا للتعليم العالي، وتمرغ في النعمة إلى أن دارت الدوائر وشنت الصحافة حملة شرسة ضده، واتهم بانتحال شخصية رجل بارز، كانت تمّت تصفيته حسب معلومات جهاز المخابرات، ففرضت عليه إقامة جبرية، ومن ثم التخلص منه. لا يصح إلا الصحيح حتى في الزمن الرديء، والبورسلان كالخزف سهل الانكسار.
قصة الرواية مشوقة مع تعقيداتها، وبمقدار ما هي مسلية، إلا أنها رمزية هادفة، تحاول لملمة صور تنطلق مما حدث حولنا في زمن ما أطلق عليه الربيع العربي، مع الفرق بيت توقيت الخيال والواقع، الذي خرج فيه الشباب الثائر في أربع دول عربية، ينادون أن الشعب يريد إسقاط النظام، ممّا أدّى إلى سقوط رؤساء، وتطهير سجون لأنها تشير إلى قهر النظام السابق أو البائد. المعتقلون عادة يخرجون إلى سدّة الحكم، إذا كانت تدعمهم أحزاب كما حدث مع وزيرنا، لذلك لم يكن الوضع في روايتنا استثناء، “والثورة تأكل أبناءها” لم يأت هذا التعبير اعتباطا، فالمنتصر على حق، والمهزوم هو الخائن. مظاهرات الشباب واعتصاماتهم في الميادين أسقطت زين العابدين في تونس، ومبارك ومرسي في مصر؛ لأن الجيش كان عنصرا هامّا، حيث تخلى عنهم، فيما لم تنجح الثورة في سوريا وليبيا، لأنّ الجيش ظل مع النظام.
الرواية تبسط الأمور حين تشير إلى الوضع قبل الثورة، وكيف أن الرؤساء يبدأون أوّل الأمر صادقين ونزيهين، ولكن الحاشية تحول الدولة إلى إقطاعية تديرها العائلة وبعض المحظيين، كأن الرؤساء مغلوبون على أمرهم. كما يصف الكاتب التعذيب في السّجون أيام العهد البائد، والعهد الجديد قد يصبح بائدا له سوءاته، فرضا الناس غاية لا تدرك، والناس يرحبون بفرصة انفراج تتيح لهم التعبير، وإبداء الرأي، فالكلّ يُنظر. تدور الحلقة، وتتصارع الأحزاب وتتم التسويات حتى لا تسيء فهمهم الدولة حامية الديموقراطية، ممّا يشير إلى التدخلات الخارجية العالمية والإقليمية التي حولت الربيع العربي إلى نقمة.
وأخيرا تركز الرواية على انتهازية الحزب المعارض، الذي جاء رئيسه من الخارج، وركب موجة الثورة واختار دمية تخدم فترة مرحلية، ليحرقها ويصفيها إذا فقدت لمعانها، والحجة جاهزة يعزوها لمؤامرة داخلية، أو عملية جماعة متطرفة، ويمكن إلهاء الناس بملهاة جديدة. هذا يظهر الوجه السيء للأحزاب، وهو الرائج مع الأسف عند الناس، فهل الحال دائما هكذا؟ في حين أن أحزاب تونس أظهرت الوجه المشرق، عندما اتفق النهضة ونداء تونس على المشاركة، وعدم الاستئثار بالسلطة، فقادوا السفينة إلى بر الأمان.
وقال عبد الله دعيس:
بورسلان وصناعة “الديمقراطية”!
قد تكتنفنا الحيرة عندما ننظر إلى ما يدور في العالم العربيّ من أحداث وما مرّ به خلال قرن من الزمان. نحاول أن نفهم، لكنّنا قد نكتشف في النّهاية أنّ ما رأيناه لم يكن إلا وهما، وأنّ الأمور تجري بطريقة مغايرة لما نعتقد أو نستطيع أن نحلّل؛ فنحن ننظر من خارج المشهد، ونستقي معلوماتنا غالبا من وسائل الإعلام أو مّما نسمع من تحليلات وآراء، فمثلنا كالذي ينظر إلى الدّنيا من خلال مرآة خادعة؛ لا تعكس الحقيقة بتاتا، ولا يدري ما يدور خلف المرآة من أحداث. يحاول الكاتب أيمن العبّوشي في روايته أن يخترق هذا الجدار السميك، وينطلق إلى العالم القابع خلف تلك المرآة القاتمة ليقرّب للمتلقّي الصّورة، ويضع بين يديه طرف الخيط الذي قد يقوده إلى فهم الواقع المعقّد الذي عشناه ونعيشه.
يحاول الكاتب أن يكشف ما يجري خلف الكواليس المعتمة بطريقة ممتعة جميلة وحيلة ذكيّة، فهو يستغلّ تحقيقا يجري مع وزير في إحدى الحكومات بتهمة انتحال شخصيّة رجل مهمّ، ليكشف هذا الوزير عن الأصابع الخفيّة التي تحيك بالخفاء بمهارة، وتفصّل ما تشاء لجماهير قد تخدعها وسائل الإعلام وتوجّهها كما تريد. ويخلق الكاتب شخصيّة الوزير أو (الدكتور) كما يسمّيه أحيانا، لتمثّل قطاعا كبيرا من السّياسيّين الذين يحكمون العالم. فهذا الوزير نتِنَ الرائحة، لا تفارقه تلك الرائحة التي تشبه رائحة السردين الفاسد مهما غمر نفسه بأنواع العطور الفاخرة. فإن كانت رائحة هذا الوزير بيّنة تزكم الأنوف، فروائح السّياسيّين الفاسدين يستطيع كلّ ذي بصيرة شمّها بقلبه قبل أنفه، مهما حاولوا أن يبهرجوا صورهم عن طريق وسائل الإعلام الأسود التي يديرونها بأيديهم، ولكن، أنّى للكذب أن يطمس الحقيقة؟ وأنّى للعمى أن يطمس البصيرة؟ ولهذا الوزير شخصيّة مضطربة وتاريخ عائلة موغل بالجنون والأمراض النفسيّة، وكذلك هم حكاما: أوليس من الجنون أن نبيع الأوطان بثمن بخس ونرهن أنفسنا وخيراتنا ومقدرات شعوبنا في أيدي الأعداء؟ أوليس من الجنون أن يكون هدفهم وأسمى ما يتمنونه أن لا يفارقوا كرسيّا حتّى ولو تمرّغت أنوفهم في وحل الذلّ والمهانة؟
ويبدع الكاتب عندما يبتدع شخصيّة شبيه الدكتور (المستنسخ) الذي يظهر له فجأة، ويختلط الأمر عليه حتّى لا يستطيع أن يعرف نفسه. ونرى الدكتور يصبح اثنين: أحدهما يعذّب الآخر، والآخر يحيك المؤامرات ليوقع بنفسه! بهذه الطّريقة، يكشف لنا الكاتب حقيقة أنفس أولئك السّياسيّين الذين يميلون في كلّ اتجاه ويسعون نحو مجدهم الشخصيّ بأي طريقة كانت ومن أي سبيل، لا تهمهم الوسيلة ولا تهمهم مصلحة وطن ولا أمّة، يتقلّبون كجلد الحرباء، وينهشون كأنياب الأفعى، ويميلون حيث تأخذهم الأنواء. يقفون حائطا منيعا حاميا للطّاغية عندما تكون مصالحهم في كنفه، ويركبون ظهور الجماهير عندما يهبّون مطالبين بحقوقهم، ويتسلقون جهودهم، ويغيّرون أقنعة وجوههم؛ ليعودوا مرّة أخرى لجَلد الظهور التي حملتهم، ولكن بسوط جديد، عادة ما يكون أشدّ إيلاما ولو تغيّرت الأسماء والوجوه.
ويقود الباشا التحقيق مع الوزير الفاسد، وهو الذي أتى به أول الأمر لكرسيّ الوزارة. يمثّل الباشا بكلّ عنجهيّته رجال الأعمال المتنفّذين في البلاد، والعملاء الذين لا يخطون خطوة بغير تعليمات واضحة من سفارات الدّول العظمى، ينتقون أبناء الذوات وأصحاب المصالح والمتسلّقين والوصوليّين، ويرفعونهم على رقاب الشّعب ويمنحوهم ألقابا؛ ليحققوا جاها ذاتيّا ويذللوا الطريق لمن أتى بهم من دول الاستعمار؛ لينهبوا الثروات ويُثروا الشركات والقلّة المتصدّرة للاقتصاد العالميّ، ولو على حساب عرق ودماء شعوب بأكملها. يتذرّعون بالديمقراطية أحيانا ليعيدوا إنتاج دكتاتوريّات أشدّ تسلطا وأكثر قمعا من التي سبقتها.
وإنْ كانت ديمقراطيتهم زائفة واضح زيفها، فهي ليست أسوأ من ديمقراطيّات الدول الكبرى التي تدعمهم وتتغنّى بالحريّة والمساواة. فالشعوب الغربيّة أيضا تقع تحت تأثير وسائل إعلام متمرّسة بالكذب والتضليل، والتي ترفع ثلّة من المنتفعين الذين تصنعهم الشركات الكبرى وأصحاب المصالح إلى سدّة الحكم، ويظنّ الشعب أنّه هو الذي ينتخب هؤلاء وأنّهم يمثّلونه، ولا يعي حجم التضليل الذي مورس عليه ليضع بطاقات الانتخاب في الصناديق تماما كما أملت له وسائل الإعلام، وليكون اختياره تماما كما أراد أولئك المتسلّطون.
فإن كان مرجي باشا والوزير نتن الرائحة يعيشون في بلد عربيّ، فإن هناك كثيرين أمثالهم أيضا يعيشون في البلاد الغربية ولا يختلفون عنهم شيئا، وإن كانت الشعوب العربيّة تصرّ على العبودية وتستعذبها ولا تطيق الانعتاق منها، فإنّ الشعوب الغربيّة تعيش في ذلّ من نوع آخر وعبوديةّ أخرى، ليست لرجال المخابرات وأمن الدّولة كما في البلاد العربيّة، وإنما عبودية للمرابين والتجّار ورجال الأعمال وأصحاب الشهوات، الذين يربطونهم بحبل الديون ويقودونهم به، وبحبل جماعات الضغط وأقلامهم المأجورة التي تستعبد عقولهم وتأخذها حيث تشاء.
لم يعط الكاتب أسماء لمعظم شخصيّاته، ولم يسمّ الأماكن ولم يحدّد الزمان؛ لأن هؤلاء الشخصيات موجودون في كل مكان، وهم في كلّ قطر، وهذه الأحداث تتكرّر في كل عصر وحقبة من الزمان، فالقارئ يستطيع أن يسقط هذه الأحداث على المكان الذي يعيش فيه أو على التاريخ القريب والبعيد للدّول العربيّة، ويشعر أنّ الكاتب يقوم بتوصيفها دون زيْف، لذلك فإن الكاتب أحسن صنعا عندما ترك المكان والزمان غير واضحين.
نلاحظ أن الشخصيّات النسائيّة في الرواية تكاد تكون معدومة، فأبطالها جميعا من الرّجال. ربما قصد الكاتب أن يبيّن أن الرّجال هم الذين يسيّرون الأمور، وهم الذين يصنعون الأحداث ويحمون الطغيان ويمارسونه، وهو محقّ في هذا، إلا أن للمرأة دورا كبيرا في صناعة السّياسيّين؛ فهي المربية لأولئك، وهي أيضا التي تربّي الشعب الجاهل والخانع الذي يسهل خداعه.
وكذلك فإن الكاتب جعل جميع شخصيّاته شرّيرة فلم نلمح شخصية طيبة أبدا، حتّى الشّيخ عزمي الذي كان يشقى ببيع الفول، وعطف على الدكتور (الوزير) الذي لا يستحق العطف والحنوّ، ثمّ كان مصيره أن يدفن حيّا بيد من آواه. لا يستطيع القارئ أن يتعاطف معه بتاتا، فقد كان شخصيّة سلبيّة يعيش حياة الفقر والعناء بينما يُخفي الأموال الطائلة على سطح كوخه، والتي وقعت في يد الدكتور الخائن واستخدمها ليتسلق مرّة أخرى إلى دور السيادة والقيادة، وكأن هذا العجوز يمثّل الشعب الخانع الضعيف الذي يستطيع أن يغيّر ولكنّه ينخدع بسهولة ليصبح مطيّة للمتسلقين الذين يدفنونه وهو على قيد الحياة.
بعد أن ننتهي من الرواية نعيد النظر إلى غلافها، فنرى ذاك التمثال المحطّم، وننظر إليه مرّة أخرى لنرى العبيد يعيدون ترميمه وبنائه ويهبّون إلى عبادته من جديد.
وقالت رنا القنبر:
يدخلنا الكاتب في صراع بين ” الآنا” و “الآنا” الآخر في روايته. اختارالكاتب عنوان روايته ” بورسلان” ليلخص أحداث الرواية وبطلها الضعيف الذي أخفى هشاشته بإفعاله الماكرة حتى سقط وتهشم، وأصبح فتاتا لا قيمة له .
فالوزير الذي حاول نكران نفسه، وجد نفسه يمتثل أمام لجنة تحقيق، ويسرد روايته مدافعًا عن نفسه ومكانته الاجتماعية المرموقة، أو التي ادّعى أنّها كذلك؛ ليتماشى مع المجتمع المخملي، موضحًا بأنّه كان مجرد رئيسًا لقسم التربية الرياضية، وخادمًا للوطن أوكلت إليه مهمة سرية وهي كتابة التقارير، وكان مخلصًا لعمله محبًا للنظام ورجالاته، فحاول أن يكون ملمًا بالفن التشكيلي والموسيقى العريقة؛ للتواصل مع المجتمع المرموق ذي الأجواء الباريسية الفاخرة، فارتدى أفخر الملابس والأحذية قبل أن يصاب بوعكة صحية ألمّت به، وجعلته طريح الفراش، ليفاجأ بعد ذلك بوجود شخص آخر طبق الأصل عنه في بيته يعبث بمحتوياته، ويأكل من طبقه ويشبهه في كلّ شيء، حتى رائحته النتّنه التي ظن نفسه أنّه تخلص منها، وبأنّ ” المستنسخ” كان يحاول النيل منه وسلبه مكانته الاجتماعية والقضاء عليه، ليفكر الآخر بحياكة مكيدة للاطاحة به والتخلص منه إلى الأبد، ليعود إلى منزله وحياته الاجتماعية، محمّلا مسؤولية كل ما حدث معه بعد ذلك للرجل القادم من العدم، فوجد نفسه ينتقم من ذاته، ويطيح بها الى قعر الجحيم، ويدخل نفسه في دهاليز السجون والتحقيقات والتعذيب، سالبًا نفسه بنفسه حياته، فلم يكن “المستنسخ” إلا وليد ضعفه وخيباته، ولم يكن سوى نفسه الوصولية الوضيعة.
“الثورة يصنعها الشرفاء، ويستغلها ويرثها الأوغاد”
يأخذنا الكاتب الى عالم ليس ببعيد عنّا، بل يحيط بنا من كل جانب .. عالم السياسة وقوة النفوذ والهيمنة والاغتيالات، فالسمك الكبير يأكل السمك الصغير لا محالة، لم ينس الكاتب ما يسمى “بالربيع العربي” بل وضعنا في عمق أحداثه وصراعاته الدموية، التي باتت معروفة فيما بعد، بعد معارك استنزفت عقل وقلب المواطن العربيّ، الذي أصبح يعيش في ظلّ الفوضى والشك وخيبة الأمل، ولم يدرك أنّ عالم السياسة لا يوجد في قاموسه معنى لكلمة حرية، فلم تكن إلا شعارًا يخدع بها جيلاً حالمًا ملّ الفقر والتعاسة طامحًا بالتغيير، فاختلط كلّ شيء وانتشرت الفوضى، كانتشار النار في الهشيم، فاختلط الحابل بالنابل، والشريف بالخائن ومدّعو الوطنية والمتسلقين على أكتاف البسطاء، الذين خيّل اليهم أنّهم أمام ديمقراطية عادلة صنعوها بأيديهم في انتصارهم الوهميّ، بعد سقوط أنظمتهم، فوجدوا أنفسهم بين فكيّ الثعبان من جديد بإختلاف المسميّات وبعباءة جديدة ليس إلا.. ولم يحصدوا سوى المزيد من القتل والدمار وسلب الحريات .
يتحول بطل الرواية من قاتل ووصولي عديم المعرفة إلى بطلٍ ثوري ورمزًا للثورة،وبعد ذلك وزيرًا للتعليم العالي بعد سقوط النظام، وتشكيل الحكومة الانتقالية ..فلم يستطع ذلك الوزير وهو يسرد تفاصيل ماحدث معه اخفاء نرجسيته وساديته المفرطة، والتلذذ بأفعاله القبيحة مبررًا ذلك بأنّه لمصلحة الوطن ..”فخائن تائب أفضل من مناضل ملّه الناس ” ويا ليته تاب، فاستمرّ بعنجهيته متباهيًا حتى بعد إقالته من منصبه وإحالته إلى التقاعد .
” ما أسهل أن يحملوك على أكتفاهم “!
عبارة قالها الوزير المتّهم ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ الانسانية، مفتخرًا بخداعه للجميع وتقمصه دور الوطني الذي يعشق الحرية، ويكره الظلم والاستبداد، وهو الذي لطالما انتمى لصميم النظام البائد، أمّا لجنة التحقيق فلم تكن سوى مسرحية ساخرة ليست غريبة عليّنا، وكيف لا وهو صنيع الحزب الذي يترأس كباره لجنة التحقيق التي مَثُل أمامها، وأداة كانت تعمل لصالحه، فكان التخلص منه أمرًا محتومًا، وذلك لمصلحة الحزب التي اعتبره آفة بقاؤها سيطيح بهم كأجحار الدومينو واحد تلو الآخر، ولكن الانسان عدو نفسه، وكان الوزير ضحية نفسه، ضحية رجل السردين ذي الرائحة النتنة، التي بقيت حتى بعد مقتله وتهشيم عظامه، فظلت الرائحة تفوح بالأجواء معلنة أنّها باقية مهما حاول صاحبها الهرب منها، لم يعرف الكاتب عن الزّمان والمكان تاركًا للقارىء تلك المهمة السهلة، فالزّمان هو زمن الفيسبوك، وما يعرف بالربيع العربي والصحافة الصفراء، التي كان لها الدور الأكبر في خداعنا، وبثّ سمومها لصالح انتماءاتها السياسية، أمّا عن المكان فهو وطننا العربي ..امتازت الرواية بالتشويق والغموض، وباسلوب فني جميل وعمق فلسفي، وسرد مباشر، وامتازت أيضًا بالحبكة القوية، حيث تناولت قضايا كثيرة متتالية في عالم السياسة.
وقال نمر القدومي:
رواية “بورسلان” .. والفساد السّياسيّ
عند انهيار القيم الإنسانيّة داخل النّفس البشريّة، ونشوب حرب دامية مع الرّوح الداخليّة، يُصبح ميزان المحاسبة يتأرجح ما بين الخير والنّزوات الشّريرة. متاهة الجسد هو مسّ من الجنون تتبعه كارثة ومصيبة، ويوشك الإنتقام من الذّات وقتلها الوسيلة البائسة الوحيدة، وأحيانًا يخرج الإنسان عن طوعه ويصاب بإنفصام في الشّخصيّة. رواية “بورسلان” السّياسيّة الإجتماعيّة للكاتب “أيمن عبوشي” الصّادرة عن دار الجندي للنّشر والتوزيع في القدس لعام 2015، والتي تقع في 194 صفحة من القطع المتوسّط، هذه الرّواية بدأت أحداثها في مكتب النّائب العام حيث التّحقيق جارٍ مع وزير التّعليم العالي بتهمة إنتحال شخصيّة، وتقمّصه دورًا مهمّا في الحكومة عن طريق التّزوير.
الكاتب “العبوشي” يستخدم أسلوب السّرد الرّوائيّ من ناحية، ويُتيح لشخصيّة الوزير الرئيسيّة التّحدث عن نفسه مع بعض الحوارات بينه وبين شخصيّات ثانويّة في الرّواية من ناحية أخرى. كما أنَّ الكاتب لم يذكر إسم الوزير، أو حتّى إسم المكان الذي إحتضن الأحداث، إلاّ أنَّ القارئ المُطّلِع سيُدرك في الحال إلى أين ستقودنا مجريات القصّة. كان معاليه يعيش وحيدا، ولكنّه كان يحمل معه رائحة كريهة تُنغّص عليه معيشته، وتحمله على الضّجر الدّائم منها. في إحدى الليالي وَجَدَ شخصا في شقّته يُشبهه ويتصرّف مثله تماما، وكأنّه مُستنسَخ عنه روحا وقلبا وقالبا، ليبدأ صراع وقتال وحديث وجِدال بينهما، إلى أن إنتهى به المطاف هربا إلى الشّوارع والأحياء الفقيرة النّائية خوفا من القتل. أمّا هذا المُستنسَخ، والذي أسماه الوزير “رجل السّردين”، لأنَّ الرّائحة إنتقلت إليه كلّيًا، أخذ مكانه في العمل الوزاريّ، وأخذ كذلك شقّته. شعور بالإنتقام وإرتكاب الجريمة أصاب معاليه، لكن كيف له أن يقتل نفسه، وهو أنا، وأنا هو؟ جارت عليه الدّنيا فترة من الزّمن تعرف خلالها على الشّيخ ” عزمي” بائع الفول المُتجوّل، وقد أواه الأخير في خرابة يسكن فيها. لم يحفظ العهد وخان المعروف، ودفن هذا الشّيخ حيّا دون رحمة بعد أن إكتشف أنَّ بحوزته أموالا كثيرة، فسرقه وغادر المكان.
الكاتب هنا ينجح في إظهار شخصيّتين شبيهتين ومتناقضتين في المبدأ، وعلى القارئ أن يبدأ بالتّمييز بينهما، مع أنّهما شخص واحد ذو بصمة واحدة، إلاّ أننا نتكلّم عن الرّوح التي تسكنهما. يُصبح “رجل السّردين” مواليا للنظام والفساد ضد الشّعب، ومعاليه تشتعل في داخله نار الإنتقام، وذلك الوسواس القهريّ الذي انتابه، وهو الأخير أصلًا يعلم جميع أسرار وخفايا النّظام، لأنّه كان يعمل جاسوسا خاصًّا لرأس الهرم السّياسيّ. إستطاع أن يوقع بالشّبيه بتهمة النيّة لإغتيال الزّعامة، فيُسجن ويُعدم بطريقة بشعة.
عنصر التّشويق في الرّواية ما زال في أوجه ويبقى يتنقّل معنا، وعاطفتنا مُنصبّة على معاليه، كيف سيعود لحياته وهو ميت في نظر الحكومة! نجد أنَّ الكاتب كغيره من عامّة النّاس، فتح باب الإنتقاد السّياسيّ، ونَبَش عفن السّلطة الحاكمة، هذا الباب المُتآكل تفوح منه رائحة فساد نتنة لا تخفى على العيان. تتوالى الأحداث الجانبيّة إلى أن يُمسك به النّظام، ليواجه شرّ تعذيب وتنكيل في أبشع صور يُظهرها الكاتب عن سابق معلومات واردة من داخل السّجون. إنفجار الثّورات كان الفرج والأمل الذي لم يتوقّعه، فيخرج حرّا طليقًا كبطل ثورة، منتصبًا على أكتاف الجماهير، وتبقى حياته على شفا هاوية تائهًا ما بين الولاء للنّظام الفاسد، وبين مناهضة الإنقلاب، وذلك الإحراج الأمنيّ والسّياسيّ. “العبوشي” يولج في روايته دور الصّحافة، كسلطة رابعة في الدّولة، ترفع مَن تشاء وتُذلّ مَن تشاء، فكان الحظ من نصيبه وعُيّن وزيرًا للتعليم العاليّ. يعود بنا الكاتب إلى مكتب النّائب العام حيث البداية والتّحقيق، وخفقان معاليه في تبرئة نفسه من تهمة الإنتحال، فيستقيل مع ضمانات العيش براتب تقاعديّ وبيت ومركبة. غلاف الرّواية تعلوه صورة تمثال من البورسلان المُحطّم، وممّا لا شكَّ فيه للّوهلة الأولى، نشعر بدواخلنا نوعا من عدم الإرتياح، فكانت بالفعل تلك النّهاية المأساويّة لحياة معالي الوزير حين إنفجرت مركبته وتطاير أشلاء. وتُعاود تلك الرّائحة تغزو أجواء المكان وتُريع المُعزّين، في لفتة ذكيّة من الكاتب بأنَّ الظُلم أصبح مُتوارثًا بين النّاس! ولو قُدّر لهذا الوزير أن يعرف مصيره المحتوم، لنقش على تابوته كلمة “هَزُلَتْ” بدلا من جدران السّجن.
الحياديّة في الرأي كانت من سمات الكاتب، والصّورة الخياليّة التي إبتدعها أحدثت إضطرابا وتفاعلا غير مسبوق النّظير. وقد ظهرت الحبكة في أماكن متعدّدة تبعا للأحداث الدّراميّة المتلاحقة في الرّواية، ناهيك عن الكلمات المُستخدمة ذات المعاني المباشرة، واستحواذ فِكر القارئ ببعض النّصوص الحكيمة التي تُعطي مدلولات عميقة لطابع الإنسانيّة والحياة.
وكتبت رائدة أبو الصوي:
رواية سياسية من الوزن الثقيل .
تبحر بالقاريء في أمواج عالية تقذف بالمياه المالحة جدا؛ لتدمع العين من حالنا في الوطن العربي .وما أشبه اليوم باﻷمس.
رأس الهرم في غالبية بلادنا العربية يوجد في بطانته وصوليون ومتسلقون وظلمة .
اختيار الكاتب للعنوان (بورسلان ) فيه اغواء للقاريء للدخول الى النص والأبحار فيه.
البورسلان هو مادة طبيعية 100% من بودرة “الكاولين ”
هي صنف خاص من الطين الأبيض، يتم ضغطها وتجفيفها تحت درجات حرارة عالية (1300 درجة مئوية) فينتج سطح قليل المسامية عالي الكثافة والمقاومة .
الكاتب أيمن العبوشي فتح الأبواب المغلقة ورفع الستار وعلى المكشوف طرح أحداث الرواية بمنتهى الشفافية .
أحداث الرواية حصلت في زمن غير محدد وكذلك الأماكن .
مع أن القاريء الذكي الذي يربط الأحداث بما يحدث حاليا في الوطن العربي يستطيع أن يجد الكثيرين ممن يشبهون الشخصية الرئيسية في الرواية” لا يستحق أن أطلق عليه لقب بطل الرواية حتى لا يتشوه لقب بطل”
وزير التعليم العالي الدكتور (رجل السردين) عدم اختيار أي اسم لهذه الشخصية من قبل الكاتب لفتة ناجحة جدا؛ لأن النفس الطيبة تنفر من هذه الشخصيات ولو أن الكاتب أطلق اسم على تلك الشخصية أضعف الرواية .
الحدث الرئيسي كان في جلسة التحقيق السرية بحضور مرجي باشا (الحاكم ) والنائب العام والكاتب . التهمة التي وجهت للوزير هي انتحال شخصية رجل بارز؛ كي يتقلد منصب وزير التعليم العالي، والعقدة أن الحاكم خائف من الخصوم الذين يراقبون حكومته ويتصيدون أي انتهاك أو تجاوز لأطاحته عن سدة الحكم؛ يخاف أن يسحبه رجل السردين معه اذا سقط .
ساعات من دون توقف وسرد متواصل أتعبنا به الكاتب ،وجدت في (رجل السردين ) بعض الشبه من بطل رواية (زوجة رجل مهم ) الفيلم المصري الذي انتج عام 1987 للكاتب رؤوف توفيق، وقام بالدور الرئيسي فيه الفنان المصري الراحل أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين .
رائحة الوزير النتنة ظلت ترافقه كظله الى أن أدخل الكاتب الأنا، وهذا الأنا ربما يرمز الى أن الفساد متوارث، يذهب فاسد ويظهر فاسدا، الرائحة الكريهة تتوارث مع المناصب الرفيعة خصوصا اذا كان الشخص متسلق وغير كفؤ كالشخصية الرئيسية في الرواية.
قتل الوزير لبائع الفول الشيخ عزمي في منتهى الظلم وقسوة القلب، الشيخ عزمي يرمز الى الشعب المقهور على أمره المكبوت، سرقه ودفنه بالتراب وهو حي دون أي ذرة من الرحمة، وهذا الموقف يدل على أن الوزير مريض نفسيا(مجنون رسمي) وهذا الموقف ربما حدث نتيجة التنشئة الأجتماعية السيئة للوزير في طفولته، ذكر ذلك الكاتب في بداية الرواية عندما تحدث رجل السردين عن الرجل العجوز (والده) ووضعه في دار المسنين؛ لأن والده كان ظالما وقاسي القلب، مما جاء في الرواية ص (41) كان والده يلف طرف الحزام حول كفه تاركا المشبك الحديدي الثقيل يرقص في الهواء مثل حية رقطاء، كان يجلده ويلقي به في ركن من غرفة معتمة .
التنشئة الأجتماعية لها أكبر الأثر في تكوين شخصية الأنسان، وتلك نقطة جميل جدا اثارتها في هذه الرواية .
نهاية الرواية مدهشة وفيها ربط بين العنوان والنهاية .
البورسلان ينتج عن احتراق بودرة الكاولين تحت درجة حرارة 1300 درجة مئوية، ورجل السردين احترق بدرجة حرارة عالية جدا منطلقة من قنبلة ناسفة أذابت جسده، أشار الكاتب بصورة غير مباشرة الى الطريقة المناسبة للوصول الى سدة الحكم، وهي التأني والتفكير والأجتهاد للوصول الى المناصب التي تسعى لخدمة الوطن، وجاء بالنص (مات العديد بسبب قنبلة ناسفة أجهز الحريق على البقية، وأذابت الحرارة العالية جسد الوزير السابق، فكان معالي الدكتور أول الضحايا، تبخر جسده في درجة حرارة عالية، أو ربما ذاب في الأسمنت والحديد المنصهر، ليتجمد مع الكتلة الصلبة، ويعود جزءا من خرسانة استقرت على الأرض، وظلت معلما للرصيف، ومطبا تهديء السيارات من سرعتها قبل أن تعتليه، لتعبر الى نهاية الشارع .
تلك الرسالة التي أراد أن يرسلها لنا الكاتب وهي أن التاريخ لا يرحم، وما من ظالم الا سيبلى بأظلم منه.
وشارك في النقاش عدد من الحضور منهم: سهير زلوم، ديانا أبو عيّاش، طارق السيّد وجميل السلحوت.