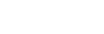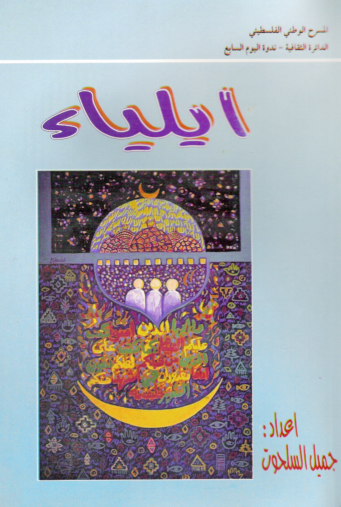القدس: 26-5-2022- من ديمة جمعة السمان- ناقشت ندوة اليوم السابع الثّقافيّة الأسبوعيّة رواية” احتضار عند حافّة الذّاكرة” للكاتب الفلسطيني د. احمد الحرباوي، تقع الرواية الصادرة عام 2022 عن دار “هاشيت أنطوان ” في 136 صفحة من الحم المتوسّط.
افتتحت الأمسية مديرة النّدوة ديمة جمعة السّمّان فقالت:
احتضار عند حافة الذاكرة.. رواية توثيقية كتبت ما لم يكتبه التاريخ
(إلى مدينة سرق الوشاة رداءها ووضعوه فوق سرير مُدنّس، ليوهمونا بأنّنا أولاد الخطيئة، نحن أبناءها المُجهَضين إلا من الأمل، سنبقى نبحث عن ملامحنا، المُبعثرة حتّى في احتضارنا عند حافة الذاكرة).
كلمات أهدى الروائي أحمد الحرباوي من خلالها روايته لمدينته خليل الرحمن، المسرح الّتي تجري عليها أحداث روايته هذه.
ويذكر الكاتب في المقدمة السبب الذي جعله يوثق تلك المرحلة الحرجة على المستوى السياسي والاجتماعي في فلسطين منذ عام 1914- 1953.
يقول الكاتب: وُلدت فكرة الرواية خلال بحث عن أغاني المدينة التراثية في ذاكرة سيّداتها. دلالات الأغنيات كشفت عن بنية تحوّلات رهيبة في المدينة في تلك الحقبة، خلقت الدافع لكتابة هذه الرواية، التي استمرّت، بحثًا وكتابة، عامين من الزمن.
ما الرسالة التي أراد أن يوصلها الكاتب من خلال عمله الروائي؟
أراد أن يقول أن الأرض التي كانت بيتا للفلسطينيين بكل ما يحملون من اختلافات بالفكر والعقائد أصبحت وعدا ممن لا يملك إلى من لا يستحق. كانت البلاد تعيش بسلام وأمان تحتضن كل من عليها بوئام ومحبة، فتحولت إلى قضية اغتصاب أرض وإبادة شعب ونزاعات مستمرة عكست نفسها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ففجرتها. إذ كانت تحاك المؤامرات من خلال الجهات الأجنبية التي تحالفت، فعززت الطائفية والعنصرية التي عذّت الصراعات وأصبح من الصعب السيطرة عليها.
رواية رصدت التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الخليل تحديدا ” أنموذجا” لبلاد الشام، منذ نهايات حكم العثمانيين، تلك الحقبة التي سميت بالسفر برلك، والتي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية فوصفت “بالرّجل المريض”، إلى التهيئة لوعد بلفور، إلى عام النكبة وتبعاتها.
رواية توثيقية كتبت بلغة سردية جميلة، حبكها الكاتب حبكة قوية شيّقة، أنسنت القضية.
رسم شخوصها بعناية، فأعطى كل منها حقها، إذ كانت كل شخصية من الشخوص لها دور أساس في تحريك الأحداث وتطورها بسلاسة مقنعة.
حقبة تاريخية مؤلمة سجلها الكاتب كي لا ننسى. ومع هذا الكم الكبير من الوجع، لا زال الأمل يطل من بين السطور، يذكّر بوجوده، فلا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة.
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
هذه الرواية تنتصر للذاكرة الجمعية، تحضن المكان، وتصوّر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية خلال حقبة زمنية بين الأعوام 1914و1953 إبان الحكم العثماني في بلاد الشّام، من خلال عدسة ومخيلة الرّوائي الفلسطيني أحمد الحرباوي، الذي ينبش التّاريخ بضمير الغائب بأسلوب جميل سلس، يشير إلى براعة الرّوائي في سرده المتقن، فيستحضر عدّة شخصيات متعددة القوميات من عرب ويهود ومسيحية (ليئا وإيلي، الحاخام، ليلى، المختار، ميسون).
تدور أحداث الرّواية حول محاولة الانقلاب على مخططات الحكومة العثمانية في تأييدها للصهيونية، وملاحقة الشبان الذين يعملون ضدّ الدولة، وعدم الرضوخ للتجنيد الاجباري، مّما أدّى إلى زجّهم في القطار لمواصلة تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو بما يعرف “السفربرلك”وكان من بين المحكومين الثوريين التاجر، المختار،وإيلي اليهودي الذي خرج عن سياسة طائفته، وترك زوجته ليئا وحيدة في الخليل تعاني الفقد إلى أن أنجبت طفلتها ليلى، وثمّ ماتت.
لقد أحسن الكاتب في توثيق الذاكرة من خلال الوصف المشبع الدقيق والعميق، بإسهاب يعمل على غرس الصورة في مخيلة القارىء، فقد بيّن صورة الظلم من قبل عصمت الأفندي الإقطاعي، واستغلاله الجنسي للنساء الفقيرات، مثل لمياء التي فقدت أهلها وبقيت وحيدة، وتلذّذه بمشهد دعس النساء فوق العنب بأقدامهمن.
أمّا من الناحية الاقتصادية فقد برزت صور الفقر والجوع خاصة عند الغجر، صور جعلتنا نستذكر مشاهد حالة اللاجئين، وهم ينتظرون دورهم من أجل الماء أو الطعام كما حدث ويحدث في حاضرنا، أتقن الرّوائي في تصويره مشهد الانتظار،وصورة لمياء وهي تحمل الطفلة ليئا التي يرثى لحالتها المأساوية في الحصول على الماء عاجلا قبل الطعام. أمّا من الناحية السّياسية، فقد ظهرت الصور المؤلمة للبكاء والفقد والموت والدّم وصور الرّحيل نحو الإعدام، واستخدم الرّوائي الحرباوي لقطة سينمائية لمشهد بطيء يسلط الضوء على نظرات إيلي وهو يبحث عن زوجته، وهو يرى لمياء والطفلة ليلى ويبتسم دون أن يعي أنها ابنته. مشهد جميل يثير عاطفة القارىء.
أتقن الروائي وصف المكان، حارة القزازين وحارة اليهود في الخليل وربطه بعادات المجتمع، ووصف ملابس النساء والأمثال الشعبية، اللغة العامية والأغاني والأهازيج، وذكر الصحف التي كانت تصدر، وقد جاءت الأهازيج بشكل لافت في الرّواية، لا سيما وأنّ فكرة الرّواية جاءت من خلال بحث الرّوائي المتخصص في علم السوسيولوجيا، لتراث أجداده في ذلك الموضوع، ومن هنا جاءت دلالات الأهازيج في الكشف عن هموم المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن الرّوائي الحرباوي ذيّل روايته بالهوامش؛ ليفسر بعض الكلمات أو المصطلحات، وهذا يدلّ على جهوده الكبيرة في إيصال المعلومات بشكل دقيق وصحيح.
جاءت النهاية وقد مرت الأعوام وكبرت ليلى، وأصبحت لمياء تحتضر عند حافة الذكريات، والموت وتكتب المذكرات، لحفظ الذاكرة الفلسطينية.
فكانت وصيتها الأخيرة لليلى التي تحمل دلالات رمزية، أو رسالة لليهود الذين عاشوا في فلسطين، لا تظلموا وتصدقوا الأكاذيب، لذا قالت لمياء لها” كل الحكايات التي تروى عن الماضي مدنسة وغير حقيقية.”
ومع تلك النهاية أستذكر “عائدإلى حيفا”، فهل نحن أمام الجزء الثاني من الرّواية لنشهد عودة ليئا إلى الخليل كمستوطنة أو حاكمة؟ وهل ستعترف بحق أهل الخليل وفلسطين عامة في العيش بحرية في وطنهم بلا حواجز أو جيش غاصب؟
وقالت نزهة الرّملاوي:
لا شك أن الروائي الحاصل على دكتوراة في مجال سوسيولوجيا الرواية والأنثروبولوجيا الثقافية، وفي مختبر السرديات الفلسطيني، قد اعتنى بسرد الأحداث من خلال فصولها الثلاثة عشرة اعتناء كبيرا، وأخذ على عاتقه أن يدوّن الأحداث التاريخية الحقيقية بكل شفافية بعيدا عن الخيال، وبمعالجة أدبية جميلة، تعهد الكاتب بأن ينقل وقائع المجتمع كواجب وطني وتاريخيّ بكلّ حبّ الى الأجيال كي لا تنسى، بالرغم مما تحتاجه الرواية التوثيقية والمعاناة والمشقة التي تلازم الكاتب لإخراجها، حاجاته إلى التدقيق وتوظيف الرواية بتقنيات سردية وحوارات ملائمة للحدث، تعبر عن الأحداث بشفافية وعمق وحيادية، وذلك من خلال رحلة البحث في الذاكرة الشفوية، ومن خلال أغان شعبية ألفتها نسوة مبدعات في المدينة، تواكب الأحداث فتغني فرحا، وتنوح حزنا في مواويلها، فنسمعها باكية متألمة.. قوية لا تعلن عن خوفها، لذا وجدنا أن الأغنية الشعبية كانت مصدر إلهام للكاتب، نتجت عن دلالات سياسية وتحولات اجتماعية وثّقت الأحداث قبل أن تحتضر الذاكرة وتذوب في حفرة النسيان.
ويُعلمنا عن أحداث كادت أن تكون غير معلومة أو معروفة لنا لم توثّقها المدينة، ويكشف لنا ما خبأته العقود الطويلة من سير وحكايات وأحداث تاريخية، ربطت وحبكت بطريقة أدبية لافتة شائقة، أقنعتنا وشدّتنا إلى مواصلة القراءة، حيث اللغة الجميلة السلسة بما فيها من استعارات وتشبيهات، ذات الأفكار العميقة والأحداث المتنوعة المترابطة.
أخذتنا الرواية وجالت بنا في زوايا كثيرة كان أهمها التعايش السلمي الذي لازم الطوائف المختلفة في فلسطين، ولم يعكّر صفوها إلا الدخلاء الآتين من الغرب الحاملين مبادئ الصهيونية؛ لإقامة وطن قوميّ لليهود فيها على حساب أهلها الأصليين.
تمثلت تفاصيل التعايش بين عائلة يهودية فلسطينية خرجت عن الأعراف التلمودية فكفرت من قبل الحاخام الذي خصّص يوم السبت من أجل الحديث عن هيرتزل وأحلام الدولة اليهودية، حينها شعر إيلي بالخطر، بعد أن افتضح أمر العلاقة القويّة التي تربط الاتحاديّين وناشطي الحركة الصهيونية، وأخذ يحاربهم بجانب الوطنيين لأجل وطن ينتمي إليه ويعيش فيه، لذا لجأ الحاخام إلى تكفيره وتكفير زوجته، ولم يسمح لجسد ليئا ان يدفن في المدافن اليهودية، وفي نفس الوقت كان إيلي ملاحقا من قبل حكومة الأتراك الجديدة المؤيدة للصهيونية، فاقتادوه كما الآخرين لمقاصل الاعدام.
لا بد وأن نعي أن تعاليم الحاخام كانت نواة لخضوع المدينة واستباحتها من قبل المستوطنين المتطرفين، الذين يعيثون فسادا وخرابا بالبلدة القديمة ومقدساتها وسرقة جبالها التي أصبحت مستوطنات متشابكة.
وصف الكاتب المجتمع المتنوع في مدينة الخليل وأطرافها، من مدنيين بمن فيهم المخاتير والنساء والإقطاعيين وذوي النفوذ، وقرويين وغجر ورهبان ويهود، كما وفق الكاتب بنقل شخوصه بين الأماكن وتدوينها، فعرج بنا على الحارات القديمة كحارة القزازين والشيخ بكا والتكية والجبال والكنيسة والمسجد والكرنتينا ولوزا، والقدس وبيروت وغيرها من المواقع التي أحيت ماض جميل للمدينة.
اتسمت الرواية برصد بعض الكلمات باللهجة الخليلية وتعريفها للقارئ، وتعريفهم بالمصطلحات والمعاني والعادات والتقاليد التي كانت سائدة، والحكايات الشعبية كحكاية الغولة وأبو رجل مسلوخة.
استعان الكاتب بهوامش لتوضيح المعاني والكلمات والمصطلحات في الرواية.
امتازت الرواية بتغطية ما كان كان يجري في قصور الأفندية والإقطاعيين وممارساتهم القاسية على الخدم، والاعتداء على النسوة وتشغيلهن في المزارع مقابل بعض المال أو الغذاء إثر غياب رجالهن وآبائهن في حرب البلقان.
وصفت الرواية الحال الاقتصادي للمدينة، فكان حالها كحال المدن الأخرى في كل البلاد، فقر وبطالة ومعاناة وأمراض وحروب، وفي الوقت ذاته رصد لنا الحال الزراعي والتجاري في المدينة.
أظهر الكاتب التعايش الطائفي حينما وزع (ايلي) اليهودي منشورات ضد الدولة التي تؤيد الصهيونية والهجرات اليهودية إلى فلسطين ويرافقه المختار المسلم.
وأظهر الكاتب ذلك التعايش في مدينة الخليل بين عائلة يهودية ومسلمة، بيّنت أن أسرة المختار أخذت على عاتقها تربية بنت اليهودي (ايلي)، الذي حكم عليه بالاعدام مع المختار، ولم يعرف أن له ابنة ولدت أثناء اختفائه مع المتمردين، ولم يعلم عن موت زوجته أيضا، وبقيت طفلته اليتيمة برعاية عائلة المختار المسلمة، وتطرقت الرواية إلى امرأة مسلمة انتصرت لإنسانيتها فأرضعت (ليلى)، تلك الطفلة ابنة جارتها اليهودية، وإلى أوضاع الغجر وحمايتهم للمياء الهاربة، والتي تبنّت ابنة اليهودي (ليلى)، التي رافقت المعلمة بريجيتا التي جاءت في إرسالية روسية وبعثة تبشيرية، وقد احتوت ألمها وساعدتها على الهروب من المدينة كمسيحية، وموتها في الغربة.
اذن نحن أمام خليط من البشر في مجتمع كأي مجتمع ينشد الأمن والسلام في اجواء مشحونة بالحروب والمؤامرات.
برع الراوي في وصف مشاعر شخصياته وتحركاتهم ولباسهم، ووصف الأحداث والعادات والتقاليد المجتمعية السائدة في ذلك الزمن، وتطرق الى الأدوات والأقمشة المستخدمة ومكان استيرادها كالستائر والأواني والبريموس.
امتازت الرواية بتوثيق بعض الأحداث السياسية وتأثيرها على مجريات الرواية، كعملية التجنيد وإعدام المنشقّين، واجتماعات القناصل والمخاتير، والوعود، والمؤامرات، والتحالفات بين دول غربية وإمبراطورية تلتقط آخر أنفاسها نتيجة الحروب والاخلال بها من قبل الحركات التركية (حكومة الاتحاد والترقي)، التي نادت بهدم الخلافة الإسلامية وإحلال العلمانية، وتواطئها مع الحركة الصهيونية، والحركات القومية العربية المؤيدة أو المعارضة التي تحالفت مع الغرب وأعلنت الثورة.
امتازت الرواية بخاصيّة التوثيق، حيث اعتمد الكاتب على الوقائع الحقيقية، وعبر من خلال السرد باللهجة العامية عن الواقع المعيشي، والطبقية بين المجتمع المدني والريفي، كما ورد في الصفحة (25) من الرواية “بدي ألعن أبوها بنت الفلاحة عاملة حالها مدنية وستّها خواجاية.”
تأخذنا الرواية الى العام 1953 العام الذي ماتت فيه لمياء المسلمة، تركت لربيبتها ليلى اليهودية وصية حثتها بها أن تذهب إلى (لوزا) في مدينة الخليل – وهي منطقة فيها قبور الرومان – وتحرر والدة لمياء من المدافن الموجودة قرب قصر عمار لتدفن في منطقة (الكرنتينا).
والسؤال الذي يطرح نفسه:
هل عادت ليلى لتنفذ الوصية وتنقل الرفاة الى الكرنتينا، أم عادت مع آلاف الروس ( القادمين الجدد ) كقوة بشرية؛ لتزيد من التغير الديمغرافي لصالح الدولة اليهودية على حساب الشعب الفلسطينيّ المهجّر؟
هل تعلمت لمياء القراءة والكتابة وعاشت كمسيحية أو كمسلمة مختفية إثر قمع حرية العبادة والحروب العالمية الدائرة في الغرب في ذلك الزمن؟
هل حقا لمياء فتاة من مدينة الخليل خدمت في قصور الإقطاعيين وأقنعتها بريجيتا بالهروب، أليس لها عائلة ممتدة غير أخوالها الذين رحلوا إلى الكرك؟ أم رمز هروبها إلى تغيير في الواقع المجتمعي والسياسي؟ وهل وجدت الأمان في المجتمع الروسي الذي أرهقته الحروب؟
هل حقا كان هناك دور للرهبان والحاخامات في تشكّل اللجان الشعبية،
أم هم اليد المساعدة للصهيونية والحكومة التركية الجديدة؟
هل حقا كانت المعلمة (بريجيتا) اليد المساعدة للمياء، أم كانت أداة وصل لتحكم الإرساليات التبشيرية وبسط سيادتها في فلسطين؟
شكرا لمجهود الكاتب المبذول من أجل انتصار المدينة وموروثها وثقافتها وذاكرة أهلها قبل أن تحتضر.
وقالت رفيقة عثمان:
قسّم الكاتب روايته إلى أحد عشر فصلا، وفق التسلسل الزّمنكي.
اعتمد الكاتب الحرباوي في روايته، على روايات نسائيّة شفويّة فلسطينيّة، استلهم واستشهد روايته من أفواههن في مدينة خليل الرّحمن، فأهدى نصوصه للنساء الجدّات الرّاحلات، اللّواتي شاركن في تزويده بالمعلومات، والأحداث التّاريخيّة التي عايشنها في عصرهن.
تعتبر الرّواية من الصنف الأدبي للرّوايات التّاريخيّة؛ وتأريخا لحقبة زمنيّة محدودة، وهي فترة نهاية الحكم العثماني في فلسطين، لغاية عام 1953؛ فنسج الكاتب روايته من الأحداث الّتي استشهد بها بأقوال النساء اللّواتي قدّم لهنّ الإهداء في بداية الرّواية. بهذا التزم الكاتب بذكر الزّمان والمكان الذّي تحدّد في فلسطين بالخليل والقدس والدّولة العثمانيّة وبيروت.
في هذه الرّواية وصف الحرباوي الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة في مدينة الخليل، في عهد الحكم التركي؛ فهي حياة الفقر والجوع والمهانة والذّل، فكانت حياة صعبة جدّا، كما ورد صفحة 107 ” في كل حارة كانت هناك دورية عسكريّة مهمّتها جمع المطلوبين للحرب. بدت الحارات فارغة من سكّانها؛ لأنّ العائلات هربت بعيدا إلى الجبال من الجنود قبل الجراد، لم يبق لهم شيء يستحق بقاءهم من أجله، فالجوع والفقر أهلكا الكثيرين، قطع الحلفاء كل ّ خطوط الإمدادات التي كانت تمد العثمانيين بالذّخيرة والقمح، فكان الحصار البحري هو أشد ّما فتك بكافّة موانئ بلاد الشام وسكانها.”
اختار الكاتب عددا محدودا من شخصيّات أبطال الرواية، مثل: المختار وزوجته ميسون، وإيلي وزوجته ليئا وابنتهما ليلى، وجيهة ابنة عم ميسون، ولمياء التي خدمت في قصر الأفندي ، والّتي تبنّت ليلى وراعتها لغاية وفاتها؛ كلك بريجيتا يهوديّة الأصل، لكنها امتلكت وثائق تثبت بأنّها مسيحيّة وروسيّة الأصل، بالإضافة لشخصيّة شوقي الأفندي، ورئيس البوليس العثماني.
يبدو لي بأنّ الكاتب ركّز اهتمامه على شخصيّات البطولة اليهودية إيلي وزوجته ليئا وابنتهما ليلى، وشخصيّة بريجيتا، بالإضافة لشخصيّة المغنيّة اليهوديّة خيزران عبده، القادمة من حلب والمقيمة في القدس؛ وشخصيّة يعقوب غزلان الصّايغ اليهودي من القدس وعمل في سوق الذّهب وهو مصاحب لجماعة الوكالة ليهوديّة.
برأيي إنّ إدخال الشّخصيّات اليهوديّة في الرواية، باستشهاد وتوثيق رواياتهم من أفواه النّساء الفلسطينيّات في الخليل، يساهم في دعم وتعزيز الرواية الإسرائيليّة في أحقيّة وجود اليهود في الخليل، ولهم الأحقيّة في امتلاك الأماكن المُقدّسة، وغيرها من الأماكن، ومناصفتها مع السّكّان الفلسطينيين الأصليين. على الرّغم من وجود التنوّع الدّيني بهذه المدينة، في تلك الفترة، والتعايش بسلام فيما بينها، ومواجهة نفس المصير، سلّط الكاتب روايته على تلك الفئة، وكانت شخصيّة أيلي وزوجته اللذين أنجبا بنتًا دون أن يراها أبواها، فأمّها ماتت بعد ولادتها، وأبوها عاش مطاردًا من الجيش التّركي، والوكالة اليهوديّة؛ فعاشت ابنتهما ليلى في أحضان نساء مسلمات، وآخرهن كانت لمياء التي خدمت في قصر الأفندي، حتّى وافتها المنيّة.
كان من المُمكن توسيع الأحداث الدّائرة في أحداث المدينة أعلاه، بتسليط الضّوء على المجتمع السّائد بالمدينة.
اختار الحرباوي عنوان الرّواية كما ورد في نهاية الرّواية صفحة 131، عندما كانت لمياء مريضة وتحتضر، “أمسكت بدفترها الذي خطّت على صفحته الأولى عنوانا بخط رشيق “احتضار على حافّة الذّاكرة” ” عليكِ قراءة هذه المذكّرات؛ كي لا تموتي احتضارا عند حافّة الذكريات” وكتبت إهداء في الصّفحته الثانية، إلى العزيزة ليلى…”.
إنّ نشر هذه الرّواية تزامن مع وجود الصّراعات اليوميّة في عصرنا الحالي، في الدّفاع عن الأرض والأماكن المُقدّسة في الخليل، وإثبات أحقيّتها للفلسطينيين، وحمايتها من المستوطنين الّذين احتلوا مقدّساتها وبيوتها، وما زالوا يفعلون حتّى يومنا هذا.
وقالت خولة سالم:
جاءت الرواية بغلاف جميل يتناسب وموضوع السرد، ثلاث بتلات خضراء اللون لها انعكاس أغمق بقليل أو أقرب للأسود إلى حد ما، على صفحة من مياه بحر ربما، وكأن الغلاف يشي بما في الرواية من سرد حزين قاتم، وكأن البتلات الثلاث هن بطلات الرواية “ليقا اليهودية وانعكاسها ليلى، ميسون المسلمة وانعكاسها وجيهة، ثم لمياء وبريجيتا وتبادل الأدوار بينهما. يأخذك الراوي لحقبة من تاريخ المدينة المنكوبة خليل الرحمن بين عامي 1914 و 1915 وهي نهاية الحكم العثماني في البلاد، أو نهاية دولة عرفت بالرجل المريض في آخر أيامها، فقد عانت الخليل كما كل فلسطين ويلات تسلط وظلم لم يسبق له مثيل في تاريخها، بحيث لم تنجح الذاكرة المضرجة بالوجع من نسيانها، فجاءت الرواية موثقة لأحداث حقيقية خلال رحلة البحث في الذاكرة الشفوية للمدينة.
تحكي الرواية وجع المرأة الفلسطينية والخليلية تحديدا جراء ممارسات “الأفندية” زمن الحكم العثماني، من الاعتداء عليهن وتشغيلهن في مزارع الإقطاعيين مقابل بعض المال أو الغذاء لسد جوعهن، وجوع أطفالهن في غياب الرجال في الحرب، ومما ورد في التراث الشفوي أناشيد فيها من الوجع الكثير، فجاء على سبيل المثال لا الحصر: ” يا مدعسة قطوفك بكعاب الحنة، عين الأفندي ما بترحم، تعب ما تشمري ع الرمانة ليغار من العنب …ص 48.
جاء السرد حزينا فهو يروي تفاصيل التجنيد الاجباري لمن يبلغ من الرجال، إلى سحب الرجال القادرين على الخدمة من بيوتهم عنوة؛ ليشاركوا في حرب البلقان ، وإن قصرت العوائل في دفع الضرائب مقابل عدم الخدمة في الجيش، فإنها تتعرض لأبشع أنواع العبودية والاستغلال وشتى أنواع الفقر والعوز. تسرد الرواية بشكل تفصيلي كيف أن هناك العديد ممن رفضوا التجنيد، وأعدموا لمناهضتهم الحكم في تلك الآونة، وكيف أن الأطياف الدينية على اختلافها شاركت في مقاومة التجنيد الاجباري ورفض ممارساته، فكان اليهودي والمسيحي جنبا إلى جنب مع المسلم؛ ليتعرضوا لذات المصير من القتل والإعدام، ومن يرفض الخدمة يساق للإعدام كما حصل مع كل المختار، إيلي وآخرين ، ممن عارضوا الحكم التركي، وانتموا لتنظيمات مناوئة. الرواية تسرد من خلال فصولها الثلاثة عشرة تفاصيل التعايش بيت عائلة يهودية فلسطينية تناهض الحكم التركي، وعائلات فلسطينية خليلية تتقاسم الحياة اليومية بكل تفاصيلها الموجعة، بل أن أسرة المختار أخذت على عاتقها تربية بنت اليهودي “إيلي” الذي لاقى نفس مصير المختار، وبقيت طفلته اليتيمة التي لم يعرف وهو يساق للإعدام بأن زوجته “ليقا” أنجبت طفلة، وهي الآن برعاية عائلة المختار المسلمة.
تتوالى أحداث الرواية في وصف تفاصيل حياة طفلة إيلي وليقا بعد رحيل المختار وزوجته، وانتقال رعايتها لوجيهة ابنة عمها لزوجة المختار، ثم إعطائها للغجر خوفا من كلام الناس بسبب تربية يهودية في بيت مسلم، تفاصيل متتابعة تنتقل فيها الطفلة إلى لمياء الهاربة من تسلط الإقطاعي وظلمه، فتتمسك لمياء بالطفلة وتغادر معها هربا باتجاه ولاية روسية من خلال الإرساليات؛ لتعيش خارج فلسطين، بحيث تعتبر لمياء أن الطفلة ابنتها، وتتكفل بتربيتها بعيدا عن بيئة الظلم والفقر، فتقرر من خلال بريجيتا ( التي تعمل ضمن إرسالية فرنسية تعمل في البلاد ) السفر للخارج تقفز الرواية الى عام 1953 لتوثيق نهاية الرواية برحيل لمياء وتركها وصية لليلى.
تحكي فيها جزءا من ماضيهما وتوصيها بالذهاب الى الخليل وتحديدا منطقة لوزا، وتحرر جثة أمّها من قبور الرومان في مدافن قرب قصر عمار؛ لتدفن في منطقة الكرنتينا حسب وصيتها. ينتهي السرد بتوثيق احتضار” لمياء” الخليلية المسلمة الأمّ المربية ل”ليلى ” الخليلية اليهودية، فكان الاحتضار على حافة ما رشح من الذاكرة بعد الاغتراب والفقد ومغادرة الحياة في أبعد بقعة عن الخليل.
يمكن اعتبار الرواية توثيقية حقيقية لما مرت به خليل الرحمن مع توأمها القدس من ظلم الحكم العثماني للبلاد، ورحلة السفربرلك وما تبعها من مآسي واعدامات طالت الكل الفلسطيني على اختلاف مذاهبه الدينية، دون أدنى مراعاة لإنسانية الفلسطيني المعارض لحكم إسطنبول، فجاءت الرواية توثق الحياة اليومية وعمق الروابط الاجتماعية والترابط الإنساني قبل الاحتلال الذي قطع أوصال المدينة كما باقي المدن، حتى غدا حاضرها مختلفا كليا عما ورد في السرد، إلا أن أسماء المناطق وتوصيفها ودقة تفاصيل أحداثها يؤكد صحة الشواهد، ويدعم صدقها. يمكن اعتبار الرواية جزءا من الموروث الثقافي والحكايات الشعبية المتوارثة عن نهايات الحجم العثماني في البلاد، ولم تكن الخليل وحدها التي تعرضت لهكذا قضايا، نتمنى على الكاتب أن يتم توثيق باقي الحكايات في فصول أو أجزاء أخرى من ذات الرواية عن تلك الحقبة الزمنية. لغة الرواية سلسلة وسهلة ، وتكاد تخلو من الأخطاء النحوية، الا من خطأ مطبعي واحد السطر 3 ص 23.
من عنوان ” احتضار عند حافّة الذّاكرة” يمكن أن نفهم، بأنّ الرسالة موجّهة إلى ليلى؛ لتعرف ما خبّأته لمياء من أسرار وذكريات، حول حياتها وانتسابها لوالدين يهوديين، لم تعرفهما بعد ولادتها.
احتضار على حافّة الذّاكرة، ربّما قصد الكاتب أيضا، بأنّه اقتنص الروايات الشّفويّة من أفواه النّساء الفلسطينيّات قبل رحيلهن، وسرد روايتهن وذكرياتهن عن الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة في مدينة الخليل، قبل أن تُفتَقد، والّتي كادت أن تُنسى.
لغة الرّواية سهلة وسلسة وهي محكومة بالزمنكيّة، وتضمّنت شرحا للكلمات والمصطلحات الغريبة المستعملة في هوامش الصّفحات، برأيي هذا التوثيق في الرّواية لبعض المصطلحات، وشرحها في الهوامش، ليس معهودا في السّرد الرّوائي، ربّما لو خصّص الكاتب صفحة في نهاية الرّواية لهذا الشرح؛ لأنّ التوثيق يخص الأبحاث العلميّة فقط بالتّنصيص والتّوثيق.
الرواية تخلّلها الخيال، واستخدمه الكاتب الحرباوي كتقنيّة؛ لإيصال هدفه من تأريخ مرحلة زمنيّة عاصرها الفلسطينيّون، دامجا ما بين الواقع والخيال. لا شك بأنّ كاتبنا نجح في توظيف تقنياته الأساسيّة (الزّمان والمكان والخيال واللّغة والشّخصيّات)، في ترسيخ وتصوير المرحلة التاريخيّة الواقعيّة للعصر التركي، والتأثير على عاطفة القارئ وعقله في الانجذاب والتشوّق نحو قراءة الرّواية بتواصل؛ أفضل بكثير من قراءة مقالة علميّة تصف الواقع التّاريخي المذكور أعلاه.
“الرّواية وإن كانت ليست كتابة توثيقيّة بالمفهوم المباشر، إلّا أنّها قادرة على توثيق أمور عدّة من أهمّها المكان والزّمان” (الرّواية الفلسطينيّة بين التّوثيق والخيال، رياض كامل: 2016).
طغت عاطفة الحزن والبؤس على النّصّ الرّوائيّ؛ انعكاسًا للأحوال الاجتماعيّة البائسة الّتي عاصرها الفلسطينيّون في تلك المرحلة.
وقالت نزهة أبو غوش:
في عمله الرّوائي هذا اختار الكاتب شخصيّات متعدّدة من أجناس مختلفة؛ من أجل بناء عمله الرّوائي، لقد اختار الزّمان والمكان؛ فهي رواية توثّق أحداثا في مدينة الخليل في أواخر الخلافة العثمانيّة. أظهر فيها أشياء وأحداثا خاصّة سادت المجتمع، في ظلّ حكومة جائرة تنهب ثروات الشّرق، وترسلها إِلى الآستانا واستنبول؛ لبناء حضارة غنيّة تنعم بالرفاهية والذهب والقصور وغيرها، بينما يموت الشّعب هنا قهرا وذلّا وفقرا، يرجو لقمة تسدّ جوعه.
تشابكت الشخصيّات وتفاعلت بأحداث مختلفة في بنائها الروائي؛ لتخرج برواية جميلة ” ذاكرة على حافّة الانتظار.”
أحببت أن أتحدّث عن بعض الشخصيات، محاولة تحليلها من النّاحية الاجتماعيّة والسّياسيّة والنفسيّة، والتنويه لما ترمز إليه كلّ شخصيّة، بحسب فهمي لها واستنتاجاتي من سياق الأحداث في الرواية.
شخصيّة إيلي: شخصيّة يهوديّة غير ثابتة، أو متغيّرة. كان حلمه أن يعيش وزوجته في أوروبا في برلين أوفي باريس؛ فهناك سيسكنان في حيّ نظيف، وبيت دافئ، كما كان يعد زوجته دائما. نفهم من ذلك بأنّه كاره للحياة في فلسطين، بالذات في مدينة الخليل، هذا يعني بأنّه غير منتم لهذه المدينة، رغم أنّه حاول التّعايش فيها. هي أيضا شخصيّة خائفة جدّا من أن يفكّر بكيان صهيوني بدل وجود العثمانيين؛ بل هو مستحيل، تماما بعكس الحاخام الّذي كان يخطّط ويرسم؛ من أجل ذلك سرّا.
بدت نفسيّة إِيلي مضطربة خاصّة بعد فقده لزوجته. لم يأبه للمشنقة بعد شعوره باليأس. كما نجد في شخصيّته التّناقض، في حين كان يخطّط للهروب إِلى أوروبا، كان يوزّع المنشورات لمناهضة الحكم التّركي، وجمعيّة ” تركيا الفتاة” والوقوف مع المختار والاتّحاديّين؛ من أجل إجلاء العثمانيين من البلاد، حتّى حكم عليه بالإعدام وبات مطاردا من قبل الحكومة التركيّة. هنا يمكننا التّساؤل: من أجل ماذا كانت تضحيته بحياته؟ أهي من أجل مجاراة البيئة الّتي يعيش بها، فبالتّالي هو مجرور خلف المختار؛ أم هو يهوديّ بعيد النّظر يخطّط لإزالة الخلافة العثمانيّة؛ من أجل قيام الدولة الصهيونيّة، وهذا ما أراه بعيدا عنه. هو رمز لليهوديّ المذبذب.
أمّا شخصيّة الحاخام فهي شخصيّة قويّة ترسم لمستقبل وأحلام مصوّرة في رأس العقل الصّهيوني، يعمل على التهيئة لها من خلال الدّين، حيث خطاباته المتكرّرة أيّام السّبت في الكنيس، ومن خلال التّموين الماديّ للمناهضين للحكم؛ من أجل كسبهم في صفوف اليهود. كان يشعر دائما بالتهديد؛ خوف انكشاف أمره. هو رمز للرّجل المغتصِب للأرض.
أمّا شخصيّة لمياء، فهي رمز للشّخصيّة المستعبدة في المجتمع الطّبقي في زمن الخلافة العثمانيّة في الوطن العربيّ؛ حيث القهر والاغتصاب، والإذلال. كانت تعيش بنفسيّة مرهقة معذّبة، وبذاكرة لا تفارقها أبدا، حيث كانت والدتها خادمة للأسياد، وماتت بطريقة مؤلمة تحت أرجل الفرس؛ ودفنت في قبور الرومان، وليس في قبور المسلمين. كانت حافّة احتضارها تحمل تلك الذّاكرة المؤلمة.
هي أيضا شخصيّة تحمل صفة الانسانيّة، حيث تبنّت الطّفلة ليلى ابنة اليهودي إِيلي، في الوقت الّذي رفضها الجميع، عرب مدينة الخليل ويهودها. هي أيضا رمز للإنسان المتسلّق الّذي يريد أن يصل للأعلى من خلال الآخرين- بريجتا- المرأة الرّوسيّىة المبشّرة للدّين المسيحي والّتي علّمتها اللغة الرّوسيّة، وبالتّالي أصرّت هي على تعليمها لليلى، وأبعدتها عن تعلّم اللغة العربيّة، هنا يمكن أن نعتبرها رمزا للمرأة المذبذبة الشخصيّة في ظلّ مجتمع ظالم ومستبدّ.
أمّا شخصيّة ليلى، فهي تعبّر عن شخصيّة اليهوديّ الضّائع التّائه المشرّد غير المعترف به من قبل المجتمعات الأخرى في كافّة أنحاء العالم. فهو يعيش بنفسيّة معقّدة ولا يشعر بالأمان. أمّا شخصيّة ليئة الأمّ الّتي فقدت حياتها عند الولادة، فهي رمز للضحيّة الّتي تضيع تحت الأقدام من الجوانب كافّة.
أمّا شخصيّة المختار، فهي رمز الشخصيّة الذّكوريّة المتسلّطة في ذلك الزّمان، بعيد عن التّقوى والدّين، يسعى نحو اللهو والمجون، وتعدّد النّساء. يجري خلف الاتّحاديين لمناهضة الحكم، لكنّه إنسان مقاد وليس قائدا، مثله كباقي أغلب المخاتير إِبان الحكم العثماني في فلسطين. دائما يشعر بتهديد منصبه، فنجده ذا نفسيّة مذبذبة يفقد الثّقة بالآخرين.
شخّصيّة ميسون، فهي الشخصيّة النمطيّة للمرأة العربيّة المحكومة بظلّ الرّجل المتسلّط. تحمل أعباء الأسرة، وهمومها مدى حياتها. تعيش بنفسيّة متعبة لا تثق بزوجها، ولا بأيّ امرأة من حوله.
وقالت مريم حمد:
تنفرد الرواية بوصفها جنسا أدبيا يجمع ميزتين معا: أحدهما آتية من الفنون الزمانية، والأخرى قادمة من الفنون المكانية، إذ ليس هناك جنس أدبي أشد التصاقا بالحياة من القص الروائي. وقد اعتنى الكاتب في روايته بالزمان والمكان معا؛ لينتج لنا نصا أدبيا يصف به المشاهد الحياتية بطريقة سلسة بسيطة وقريبة من القارئ المثقف أو العادي.
وبين قطبي الزمان والمكان، يُشيّد الكاتب خطابه الروائي بطريقة يجمع فيها بين الزمان والمكان بطريقة متلازمة، بلغة رشيقة وسهلة تصل لقلب القارئ، وتتيح له رسم مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية آنذاك. جاء النص الروائي لرواية احتضار عند حافة الذكرة منفتحا على العالم الروائي التخيلي للكاتب، وكذلك موثقا للأحداث التاريخية والاجتماعية الواقعية التي درات في الفترة التي كانت فيه الدولة العثمانية بأخر أوقاتها في فلسطين.
دّون الروائي الأحداث التي دارت في تلك المرحلة الزمنية بكل شفافية وواقعية؛ ليعيد للذاكرة الفلسطينية واقعا اجتماعيا غيّبه الاحتلال والنكسات المتتالية على أرض فلسطين، واستطاع توظيف الرواية بجرأة سردية وحيادية تعكس الواقع المعيش للمكان والزمان.
تداخل الواقع المعيشي والتخيلي في الرواية بشكل رائع، واستطاع بذلك الكاتب خلق جوّ يُشعر المتلقي بواقعية الأحداث بطريقة جعل الزمان والمكان ممتزجان معا، وما تخلل النص من وصف للحارات والأماكن والأكلات والأحوال الاقتصادية والإقطاع والمجاعات، وكذلك التنوع الثقافي والديني للمدينة في ذلك الوقت كما وربط مدينة الخليل بالمدن الهامة كبيروت ودمشق والقدس.
أبدع الكاتب بتوثيق التاريخ بطريقة ممتعة وشائقة، وقد وظّف الأغاني الشعبية والكلمات العامية لرصد الصورة المعيشية التي كانت تدور في ذاك الزمان والمكان، تطرق لتفاصيل عدة من بينها تغليف العنب في الكروم التي اشتهرت بها مدينة الخليل، وتناوله في فصل الشتاء وخلال موسم الثلج والبرد.
لم يقتصر هذا العمل على جمالية الخطاب والحوار ورسم الشخصيات، ولكن اعتمدت على التوثيق الذي يحتاج إلى قراءة لمصادر مختلفة، ساهمت برسم صورة تمزج بين الواقع والخيال، بطريقة جميلة جدا، تدلّ أيضا على اهتمام الكاتب بجوانب ثقافية عديدة، كالبحث في الوثائق، والإستماع لأحاديث الكبار، وكذلك الحياة الخاصة بالمرأة، بما في ذلك المعاناة؛ لتوثيق الأحداث بتوليفة جمالية ومميزة.
استطاع الكاتب استغلال كل المكونات الزمانية والمكانية؛ ليؤدي رسالته الحكائية بتسلسل بديع ومكثّف يدمج ما بين العامية والفصحى؛ لخلق رواية بشخصيات أدت وظيفتها الروائية على أكمل وجه، وساهمت بشكل كبير في التأثير على وصف الأحداث والشخصيات.
رغم قساوة الأحداث والمجاعات والقسوة والبطش والإعدامات والسجون، التي كانت سائدة في ذاك الوقت، إلا أن الكاتب استطاع نقل المتلقي لأجواء مبهجة تعكس الواقع الفلسطيني آنذاك، وحول المكان من مُدرك حسيّ إلى مدرك نفسي، واصفا البيت والأثاث والزخارف وربطها بمدلولاتها الاجتماعية، كما كشف عن شبكة الارتباطات العاطفية والنفسية بين الشخصيات والأمكنة.
لم يخلط الكاتب بين الأزمنة رغم أنه تناول الماضي والمستقبل وتقاربت ثلاثية الزمن تقاربا كبيرا بتوزيع الأحداث في مساحات سردية، تشعر القارئ بالتسلسل في الأحداث والزمان مطعما كل هذا التسلسل بسرد بديع يصف به الواقع المعاش.
في الختام تطرق الكاتب لجوانب إنسانية حساسة تخص المرأة التي تهب وتمنح وتهب الحياة، وكذلك استطاع بأن يلفت نظر القارئ لأصحاب الديانات الأخرى المسيحية واليهودية التي عاشت بفلسطين، مسلطا الضوء على كونهم جزء من تاريخ مدينة الخليل بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، واستطاع أن يفصل بين الإنسان كإنسان رغم اختلاف فكره وعقيدته، وبين المستعمر المغتصب للأرض والإنسان.
ومن المغرب كتب الأديب حسن المصلوحي:
لن أذيع سرا إذا قلت بأن الذاكرة من منظور معين هي الهوية، وهي ما يكون بها الإنسان هو-هو رغم تبدل الأزمة والأمكنة والأحداث، كما أصرّ على ذلك “جول لاشوليي”، إنها وفق هذا الاعتبار نحن ونحن هي، وأي محاولة لبناء ذات جديدة كل الجدة على أنقاضها يعتبر إبحارا قاتلا ضد التيار، وانتحارا من على حافة خطيرة نحو هاوية سحيقة، يبتلعنا فيها النسيان، فبدون ذاكرة تغزو الفجوات حياتنا فتتفتت الذات وتتيه في هذا الكون المترامي.
لذلك استوقفني بداية عنوان الرواية، وطرحت أكثر من سؤال وأنا أحاورها قبل أن أستمرئ قراءتها وأغوص في تفاصيلها، ترى كيف يكون طعم الاحتضار حين يكون عند حافة الذاكرة؟ ألا يكون انتحارا؟ ثم لماذا اعتبر الكاتب ضمنيا أنه للذاكرة حافة؟ أسئلة و أخرى طرحتها ثم رحت أقلب صفحات هذا المنجز واحدة تلو أخرى، بحثا عن جواب أو أجوبة أو على الأقل إشارات. فوجدتني في سفر يمتد لقرابة قرن من الزمان و يزيد…عود إلى زمن انقضى ولم يعد موجودا الآن إلا كتاريخ دونه القوي في قراطيسه الخاصة، وبالمقابل حكايات وأغنيات ما زالت جارية على ألسن الأبواب والحارات والروابي من قبل النسوة.
رَجْعٌ إلى حيث كان المكان يحتضن المكان، وينشدان للوجوه الشاحبة أن ههنا دب الكثير من البشر، كثير من الظلم والجور والاستقواء والمخمصة، وكثير من الوجع والغصب والحرمان، وقليل من الأمان والرحمة والقبلات! قرأتُ هذا السفر وكأني أرتل الماضي الذي لا يموت. شهادة دامغة على تاريخ فلسطين الحرة قبل أن تدنس نعال المحتلين والقوادين والوشاة وأبناء الخطيئة كنائسها ومساجدها وأديرتها، خاناتها وحاناتها وملامح أهلها البريئة، نساؤها وهن يغزلن الصوف جنب السواقي ورجالها وهم يحرثون الأرض المتاخمة للجبال. الأرض الأرض ! آه على وجع الأرض.
إن هاته الرواية كما انطبعت في خاطري تعبير عن راو مخاتل، انسل من بين جموع الناس المحتشدين حول المصيبة، وعاد عبر دهاليز وأقبية القدس ويافا وحيفا وغزة و الخليل… إلى حيث تقيم فلسطين، وإلى حيث ولد أعداؤها، إلى نسل الكرامة والهامات العالية وإلى نسل الخيانة والوقيعة، انسحب الكاتب إلى الوراء، إلى هنالك حيث يهوديان، أحدهما قرر الغدر تحت رنين القطع الذهبية، وآخر حمل كفنه راية مرفرفة، تعلن أن لا نامت أعين الجبناء، وثالث على الهامش بلا لون ولا شكل، أرهبه الاختيار فأفسح لنفسه الدنيئة المجال؛ لتلهث خلف الغواية أينما وجدت. إنه الفرق بين سقراط الذي قرر ألا يصمت وحثالة الأثينيين ممن تفرجوا عليه بغبطة، وهو يُجرّع السم، لا لشيء إلا لأنه لم يرض أن يغلق فمه ويتحول إلا إمعة.
رواية حِجاجٍ واحتجاج، فما كتبه البحراوي ورد كاعتراض على هاته “الفلسطين” التي كفر بها القريب قبل البعيد، وكأني به ينادي القارئ: هات يدك واتبعني حتى أريك فلسطين كما لم ترها من قبل، هناك حيث يهودية بعينين زرقاوين أحبت يهوديا بقوام رشيق، جمعتهما الثورة ضد الظلم، وقلبان ينبضان للإنسان لا لغيره، فلعنا الحاخام والكنيس واحتفلا بالحب دينا وديدنا، ولمّا دنا الموت قررت الزوجة ألا مكان أأمن لرضيعتها أكثر من يد مسلمة. وما أعمقها من صورة حين تنتقل القضية في طريقها للنجاة من حشى يهودية إلى حضن مسلمة حان]، بين ليئا وإيلي ثم ميسون والمختار ووجيهة ولمياء فبريجيتا، بين يهودية ومسيحية وإسلام، عهد صادق بين موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، فتمكنت البنت-القضية من الخلاص في مستنقع الفقر والقهر والقتل والاستغلال من القريب قبل البعيد، من خلّصها؟ لا يهم، كلهم خلّصوها.
إنها فسيفساء الإنسانية التي لا تحتاج لشيء غير قلب طاهر لا يكيد ولا يغدر، وروح مثل جبال الجليل ترفض الركوع في زمن الخنوع.
لم يستهوني كثيرا التركيز على ما هو تقني في هاته الرواية، فهي التي جاءت تشريحا للأحداث ورتقا للوقائع رغم أنها ليست عملا تاريخيا أكاديميا، وردت فلسفة تأملية عميقة رغم أنها لم تكتب للفلاسفة، جاءت رواية بحث وتساؤل واستقصاء وتعرية رغم أنها لم تكن بحثا صحفيا استقصائيا.
ولكم عجبت من كم التفاصيل الدقيقة التي دونها الكاتب، وللحظة تساءلت: ألا يكون قد عاش بين هؤلاء الناس؟ أليس حريا به لكي يكتب ما كتب أن يكون قد ورث ذاكرة أجداده واستأثر بها؟ ألا يكون هذا وحي السابقين للاحقين مزفوفا في هودج الاخلاص لا بل التماهي؟
و في الرواية أيضا حمولة عاطفية بالغة القوة، إذ لم أتمالك نفسي؛ ليترقرق الدمع في عيني وأنا أعيش مشهد طفلة تتقاذفها الأيادي، وتتبرم من غوثها أثداء اليهوديات والمسلمات والمسيحيات على حد سواء، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، بين البينين، بين التنكر والتنصل من الاصطفاف إلى جانب الإنسان وبين ثقافة كسيحة تغذيها الخرافة و الأفكار الجاهزة و الأحكام المسبقة.
و لأن قدر الحب أن ينتصر، انتفض ثدي وجيهة وأعلنت أمام الجميع أن الحليب لله والحياة لله، وأن الانسان أسمى من الأفكار ومن الأديان ومن يتاجرون بها، ولنفس السبب قطعت ليئا سرة بنتها وأهدتها لزوجة المختار، فسيل تراب يهودي يؤتي أكله على أرض المسلمين والمسيحيين، لأجل السلام والمحبة والتلاقي، وليس كما آمن البعض بألّا تلاقيا، فماذا كان حريا بنا أن نفعل لو كنا مكانها؟ أن تلاقينا ملتقيات الوحدة؟ أم تفرقنا مفترقات الخصوصيات المريضة؟
لا مرية في القول أن الرواية احتفاء خاص أصيل بالأرض والمكان، جوهري هو المكان في هذا المنجز المتفرد، ومن غير فلسطين العراقة تحتضن الأحداث ولشخوص، تشهد أنه ههنا أقام بعيد ظنناه قريبا وعدو ظنناه أخا، جعل الحال ضنكا والماء آسنا والرغيف أسودا ! من هنالك تعلمنا أن ليس لفلسطين غير أهلها، غير أبناء الثرى الذين لعبوا في بساتينها وروابيها أطفالا صغارا.
وقد تكون الشاكلة التي صورت بها الرواية التواجد العثماني بما اعتراه وقتها من جور وشوفينية وهمجية محط انتقاد البعض ممن تعجز عقولهم عن التناول الموضوعي، لكنها جرس ينادينا للحظة تأمل نضع فيها الجميع موضع شك، حتى أنفسنا إن تطلب الأمر ذلك، فالناس فيها ليسوا ملائكة يمشون فوق الأرض، الإنسان فيها خيّر وشرير، شريف وخائن، مناضل ومنبطح، إنسان وحيوان… إنها فلسطين الأرض الأم، سرة العالم، حيث المعترك، حيث تجري سنة التدافع بين الناس، فإمّا أن تكون من أهل الحق، وإمّا من أهل الباطل، ويا لها من مفارقة، بين جثث معلقة في المشانق بهامات مرفوعة للسماء، ورؤوس ذليلة ترقب المشهد.
من قال أن الموت فناء؟ من قال أن إيلي وزوجته ماتا؟ وأن المختار وزوجته وبريجيتا ولمياء قد ماتوا؟ و أن الأرض ماتت؟
وهنا لا بد لي أن أتوقف عند صورة الغلاف؛ إنها تعبير عن سنة الانبعاث الكامنة في طبيعة الأشياء، سنة الكون وقدر الموجودات. زنابق تعلو الماء توقا للأعالي، راسمة ظلا بالأسفل كأنها الجذور، كأنها الماضي الذي كانته قبل أن تناطح السماء.
لقد خلدت ليلى كل هؤلاء، كل من ألقمها لقمة أو سقاها جغمة… كلهم عاشوا فيها وهي الشاهدة على همِّ فلسطين، هي وارثة السر من لمياء التي فقدت والدها فاستعبدوها، فقررت الرحيل من الاستغلال والامتهان، قررت ألا تعصر بقدميها الحافيتين نبيذا معتقا لزناة التاريخ والعدالة، قررت أن تهرب بهما بعيدا بعيدا حيث الحرية وحيث الحياة.
ولا غرابة أن يختار الكاتب أن يكون الوليد -مربط الفرس- طفلة، فما همه منها إلا ذاك الرحم الذي سيكبر ذات يوم أبلج؛ لينجب المستقبل، ليلد من يحمل الحقيقة في الجينات، ويصدح بها على مسامع الكون أن كانت بهاته الأرض حياة قبل أن يغزوها زبانية الموت.
كان للقطار رمزيتان متناقضتان تماما، ومتوحدتان في الآن نفسه، فهو الذي يسير بالأحرار إلى المشانق، وهو الذي يقطع بفلسطين وذاكرتها أرض الموت نحو الخلاص، هو الشيطان اللعين والملاك الأمين في ذات الوقت، وهو أيضا من يسوق هؤلاء، ويهرب تلك لأجل القضية، فالتاريخ يحتاج دائما لقرابين من أطهر ما يكون من البشر، وما أعلاها من مكانة أن يناديك التاريخ؛ لتسجل نفسك في أنصع صفحاته بين الكبار وليس في سلة مهملة على الهامش بين الجلادين والقوادين والبصاصين.
قطع بنا الكاتب المحيط، بعيدا عن حبيبة فقدت ملامحها، لم يكن ذاك الإبحار هربا، بل نجاة بالذاكرة، رغم رغبة لمياء في النسيان، إلا أنه كان عصيا عليها. قررت أن ترحل وتحمل معها ليلى، ما تبقى من الحب والجمال والتسامح، وقبل أن تموت أظهرت صدرها تأسيا بأمهات فلسطين طلبا لدعوة مستجابة، تنزل من السماء مدرارة كثدي كريم يطفح حليبا زلالا في أفواه أطفال جياع، تضرعت بالحياة لواهب الحياة طمعا في رب لا تهمه الإثنيات ولا يعيقه المكان والزمان، وتركت الموضع مفتوحا … بأن تعود الأرض لسابق عهدها، بأن يسود الحب والخير وأن يحتضن الناس بعضهم بعضا… وأوصت الحب والجمال بأن يرجع، نذرا صادقا لكي يعيد الحياة لبلد قتلته الأحقاد، أوصت ليلى بأن تعود لترسم بعينيها الزرقاوتين وجدائلها الذهبية أزقة القدس والخليل وحيفا، وكل زقاق في فلسطين بألوان الحب والحياة والإنسانية، أوصتها خيرا بتراب الوطن وأمواته الذين ماتوا ودفنوا في الهامش… إنها وصية تختزن كل الحب لهذا الوطن الحبيب المغروس في فؤادها. أوصتها على المنبوذين والمهانين والمكرهين على كسر عظامهم لأجل أناس أعدموا الرحمة بداخلهم.
فهل يعود الحب إلى مهبط الحياة؟
هذا ما لم يجب عليه الكاتب، فقرر أن يطرح السؤال وكفى، ويترك للأيام مهمة الإجابة.