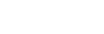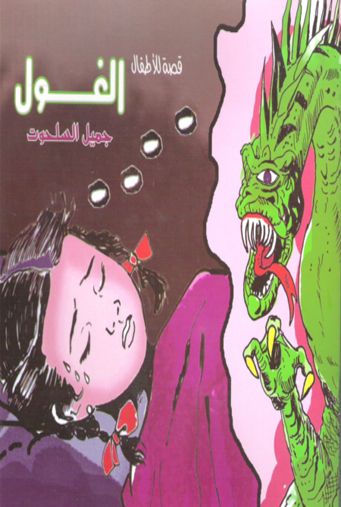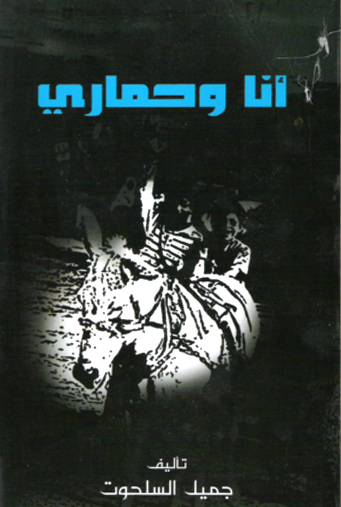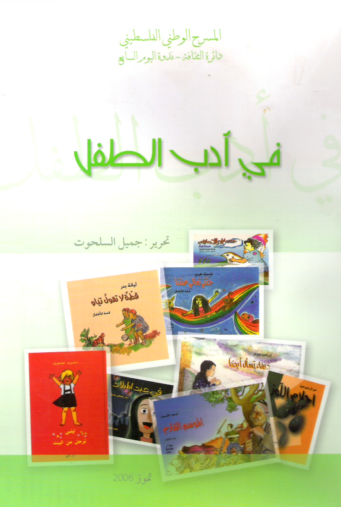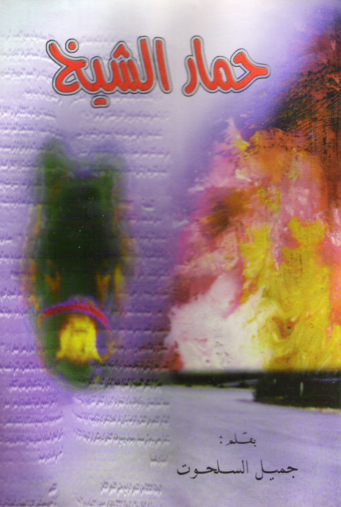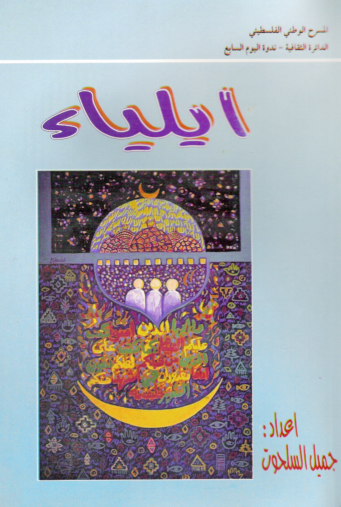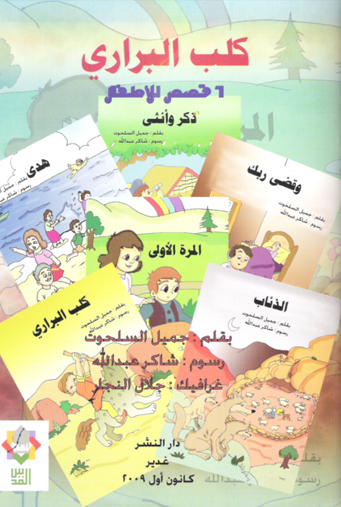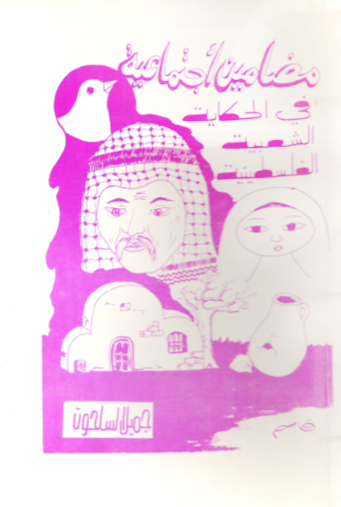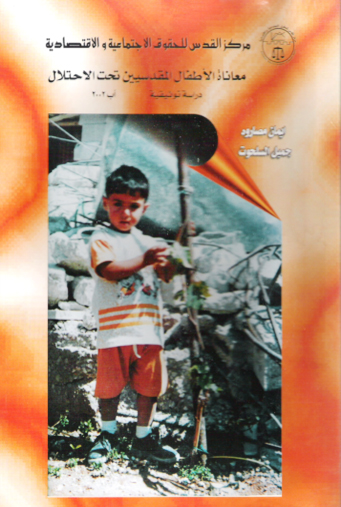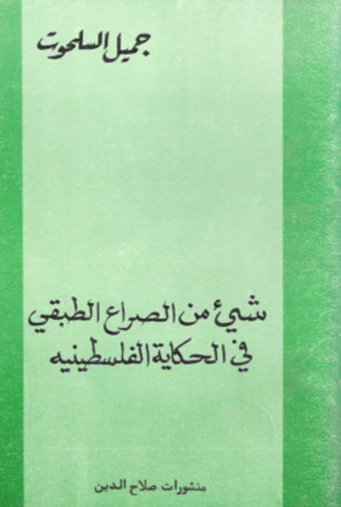دراسة نقدية في رواية جميل السلحوت وديمة جمعة السمان
عن مكتبة كل شيء في حيفا صدرت عام ٢٠٢٣م رواية” الأرملة” للأديبين المقدسيىن جميل السلحوت وديمة جمعة السّمان، وتقع الرّواية التي صمّمها وأخرجها شربل الياس في ٢٢٨ صفحة من الحجم المتوسّط.
وقد ترجمها إلى الفرنسية رغيوي قويدر، ودقّق التّرجمة رضوان صحباتو ودهري حمداوي، وصمّم غلافها زكريا رقاب، وتقع الرواية في 300 صفحة من الحجم المتوسّط. وصدرت عام ٢٠٢٤عن دار الأمير للتّرجمة والنشر والتوزيع في مرسيلية- فرنسا.
تمهيد
تُعدّ رواية «الأرملة» (2023 – مكتبة كل شيء، حيفا) إحدى أهم المحاولات الروائية الحديثة التي تجمع بين السرد النسوي الفلسطيني والوعي الوطني المقدسي في لحظة إنسانية حرجة.
العمل مشترك بين جميل السلحوت، وهو من أبرز كتّاب الواقعية الفلسطينية المعاصرة، وديمة جمعة السمان التي تمتاز بكتابة ذات نزعة وجدانية أنثوية عميقة.
يتجلّى في هذا العمل التحام الصوتين الذكوري والأنثوي في رواية واحدة، كأنها شهادة مزدوجة على الموت والحياة، وعلى المرأة والوطن.
أوّلا: العنوان بوصفه بوابة دلالية
العنوان «الأرملة» لا يصف حالة اجتماعية فحسب، بل يؤسّس ثيمة كبرى عن المرأة التي تُحرم من الحياة باسم الموت.
الاسم مفرد، لكن ظلاله تمتدّ إلى كلّ النساء اللواتي فقدن أزواجهنّ أو أوطانهنّ.
اختيار الكلمة دون تعريف («الأرملة» لا «أرملة») يضفي عليها بعدًا كونيًا، يجعل وردة رمزًا لكل امرأة محاطة بعزلة الفقد.
إلا أن هذا العنوان، رغم عمقه، قد يوحي منذ البداية بحدٍّ اجتماعي ضيق، إذ لا يهيّئ القارئ لحجم البعد الوطني الذي يتفجّر لاحقًا في الرواية.
هنا كان يمكن للكاتبين أن يختارا عنوانًا أكثر تركيبًا مثل «أرملة القدس» أو «وردة تحت الماء»، كي يعكس المضمون المزدوج: الحزن الخاص والمأساة العامة.
ثانيا: البناء الدرامي بين الواقعية والتوثيق
تبدأ الرواية بمشهد بصري أخّاذ:
امرأة تستحمّ، الماء يتدفّق على جسدها في لقطات مشهدية عالية الحسّ السينمائي. هذه البداية هي الأجمل فنيًا في النص كله، لأنها تقدّم وردة في ذروة الحياة، قبل لحظة الانكسار.
لكن مع تقدّم السرد، يتحوّل البناء إلى أسلوب توثيقي متتابع، تتداخل فيه الأخبار والأحداث السياسية (افتتاح نفق الحشمونائيم، انتفاضة القدس) مع السرد العائلي.
هذا يُضعف الإيقاع الفني أحيانًا، إذ تنتقل الرواية من التوتر النفسي الداخلي إلى السرد الخارجي الخبري دون تمهيد درامي كافٍ.
كان بالإمكان تحقيق توازنٍ أفضل بين الواقعية التسجيلية والحسّ الروائي الداخلي، خصوصًا في فصول الجنازة والعزاء الطويلة التي طغى فيها الحوار الفقهي على التحليل الشعوري.
ثالثا: الشخصيات… من الفقد إلى الفكرة
وردة ليست مجرد أرملة؛ إنها كائن حيّ يقاتل كي يظل حيًا.
في شخصيتها تتقاطع الأنوثة والمقاومة.
بعد موت زوجها، تمرّ بمراحل الإنكار والانهيار ثمّ الوعي، لتتحول إلى رمز للمرأة المقدسية التي تعيد تعريف معنى الحياة.
عودة، رغم موته المبكر، يبقى حاضرا عبر ذاكرة الجسد والروح، ليصبح ظلّا روحيّا أكثر من كونه شخصية فاعلة.
إلا أن شخصيته تظل مثالية إلى حدٍّ يفقدها التناقض الإنساني الضروري في الفنّ؛ فهو الزوج الحبيب، الأب المثالي، الشهيد شبه الكامل. وهنا تقع الرواية في فخّ التقديس المفرط الذي يقلّل من واقعية التجربة.
أبو عودة وأبو عبد الرحمن يقدّمان البعد الجيلي للتجربة الفلسطينية؛ الأبوان اللذان يختصران تاريخا من النكبات والحروب والذكريات. الحوار بينهما يذكّر بأسلوب الواقعية الاجتماعية في الأدب الروسي، إذ يتحوّل الأب إلى ضمير جماعي.
رابعا: القدس – الشخصية الثالثة في الرواية
لا تُكتب هذه الرواية عن الأرملة بقدر ما تُكتب عن المدينة الأرملة نفسها: القدس. المكان هنا ليس ديكورًا بل كيان روحيّ حيّ، تتنفسه اللغة في كل مشهد. باب العمود، المقاصد، مقبرة اليوسفية، المئذنة الحمراء… كلها تتحوّل إلى رموز دينية ووطنية، وإلى ذاكرة متشابكة مع الجسد الأنثوي لوردة.
من أجمل ما في النص أن القدس تُقدّم بصيغة أنثى ثانية؛ مدينة تشبه وردة: محاصَرة، حزينة، لكنها تقاوم وتلد الحياة رغم الموت.
خامسا: البنية اللغوية والأسلوب
لغة الرواية مزيج بين الواقعية التعبيرية والبيانية الشعرية.
يبدع الكاتبان في تصوير المشاهد الجسدية والعاطفية الأولى، بلغة جريئة دون ابتذال، ثمّ ينتقلان إلى حوار شعبي واقعي قريب من الحياة اليومية.
لكن في المقابل، يغلب على بعض الفصول الطابع الخطابي أو الوعظي، خصوصًا في مقاطع الواعظة زينب والحوارات الدينية.
تتحوّل اللغة إلى منبر تعليمي أكثر من كونها سردًا فنّيًا، ما يفقد السرد بعض شفافيته.
يبدو أحيانًا أن الكاتبين أرادا الجمع بين الرسالة الدينية والرسالة الوطنية والرسالة الإنسانية، فازدحم النصّ بالمقاصد على حساب العمق النفسي. ومع ذلك، تبقى الجمل التي تصف وردة في لحظات الصحو والجنون، وفي علاقتها بالذاكرة والعطر والماء، من أجمل ما كُتب في الأدب الفلسطيني الحديث.
سادسا: ثيمة الموت بين الفردي والجمعي
يُدهشك كيف يستطيع الكاتبان جعل موت فردي بسيط يتحوّل إلى موت جماعي للمدينة وللأمة.
حين يُدفن عودة في المقبرة اليوسفية، تندلع المظاهرات في الأقصى، كأنّ رحيله أشعل انتفاضة الذاكرة. الربط بين الحداد الشخصي والحداد الوطني ذكيّ ومؤلم في آن، لكنه في بعض المواضع بدا مباشرا أكثر من اللازم، كأنّ الرسالة أرادت أن تُقال بوضوح بدل أن تُشعَر.
سابعا: الزمان كقوس فجيعة
الزمن في الرواية متدرّج من لحظة الحياة إلى لحظة السكون، ثم إلى لحظة التحدي. الزمن الشخصي (أيام وردة بعد الوفاة) يتوازى مع الزمن السياسي (أيام الحصار والانتفاضة).
بهذا الأسلوب، يخلق الكاتبان إيقاعًا مزدوجًا للزمن، لكنه في النصف الثاني من الرواية يتباطأ بسبب الإفراط في الاستطراد والتكرار.
كان يمكن تقليص بعض المشاهد التوضيحية دون أن يختلّ البعد الدلالي، فالرواية تميل إلى التوسّع التقريري الذي يُضعف التوتر الدرامي.
ثامنا: الحوار الداخلي وصوت المرأة
الصفحات التي تُظهر وردة وهي تفكّر بصمتها أو تواجه جسدها وعزلتها من أعمق ما في الرواية.
لكن هذا الصوت الذاتي يتراجع لاحقا أمام هيمنة الأصوات الخارجية (الإمام – الجارة – الشقيقة – الواعظة)، فيتحوّل النصّ إلى مسرح أصوات اجتماعية.
كان يمكن إعطاء وردة مساحات تأملية أطول تكشف عمقها النفسي، كما فعلت نوال السعداوي في «امرأة عند نقطة الصفر» أو ليلى العثمان في «المرأة والقطة».
ومع ذلك، فإن صورة وردة تبقى أحد أجمل النماذج النسائية في الرواية الفلسطينية الحديثة؛ امرأة تتدرّب على النهوض ببطء، من تحت ركام الحبّ والواجب والدين والمجتمع.
تاسعا: جمالية التواطؤ بين كاتبين
ما يميز «الأرملة» أنها ليست رواية كاتب واحد؛ إنها كتابة مزدوجة بتوقيعين مختلفين، ومع ذلك جاءت متماسكة.
ربما ساعد التناغم بين السلحوت الواقعي والسمان العاطفية في خلق توازن بين الوعي الاجتماعي والعاطفي. إلا أن التفاوت في النبرة واضح أحيانًا:
فالفصول الأولى والثالثة أكثر حرارة وصدقًا وجدانيًا (يُرجَّح أنها بقلم السمان)، بينما الفصول التي تتناول المجتمع والعادات جاءت أكثر تحليلًا موضوعيًا (بصوت السلحوت).
لكنّ هذا التنوع في النبرة منح الرواية ثراءً لونيّا أكثر من كونه خللا.
عاشرا: الضعف الفني مقابل القيمة الإنسانية
من منظور نقدي محض، يمكن تلخيص أبرز مواطن الضعف الفني في الرواية كما يلي:
الاستطراد المفرط في بعض الفصول (الوعظ الديني، الحوارات الاجتماعية).
غياب الذروة الدرامية الواضحة؛ إذ تنتهي الرواية دون صراع حاسم أو تحوّل جذري في مصير البطلة.
المثالية الزائدة في رسم الشخصيات، خصوصًا صورة الزوج «عودة».
إغراق بعض المقاطع في السرد الإخباري الذي يشبه المقال الصحفي أكثر من السرد الأدبي.
لكن في المقابل، فإن هذه الملاحظات لا تُقلّل من القيمة الكبيرة للعمل، بل تشير إلى طبيعة مشروع أدبي يريد أن يقول الحقيقة أكثر مما يريد أن يبهِر فنياً.
خاتمة: الأرملة رواية النهوض من تحت الركام
في النهاية، «الأرملة» ليست مجرد قصة امرأة فقدت زوجها، بل هي رواية مجتمع فقد اتزانه، ووطن يعيش في عدّة لا تنتهي.
هي عمل يزاوج بين الألم الشخصي والوجع الجمعي، بين الماء الذي يغسل الجسد والدم الذي يغسل الأرض.
جميل السلحوت وديمة جمعة السمان قدّما هنا عملا صادقا، إنسانيًا، ووطنيًا، فيه من الواقعية صدقها، ومن الرمز عمقها، ومن الشعر رهافته.
ورغم ما فيه من هنّات سردية، فإنه يستحق أن يُقرأ، وأن يُدرّس بوصفه شهادة على أن الرواية الفلسطينية ما زالت قادرة على توليد الحياة من قلب الموت
19-10-2025