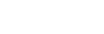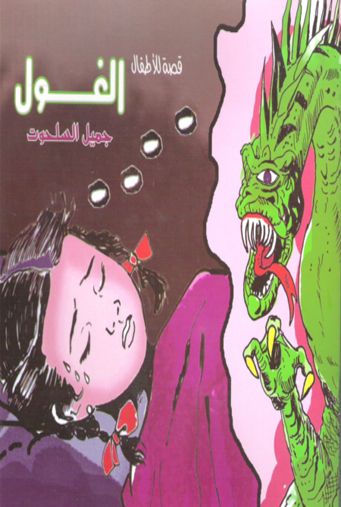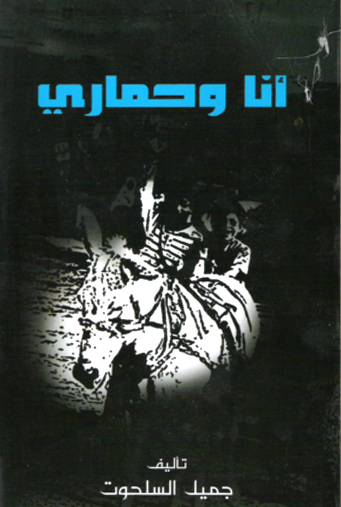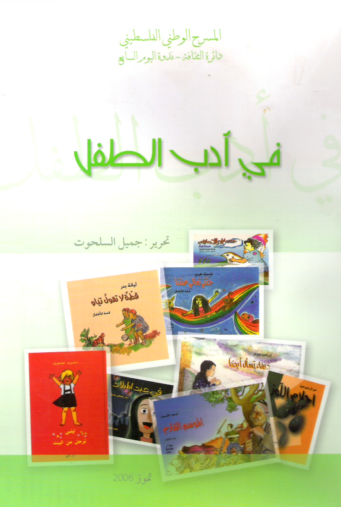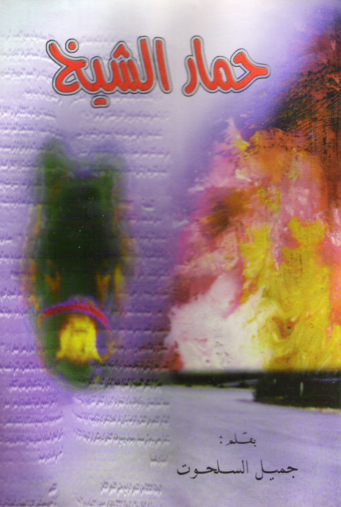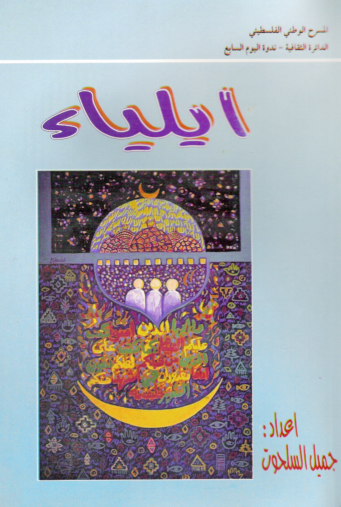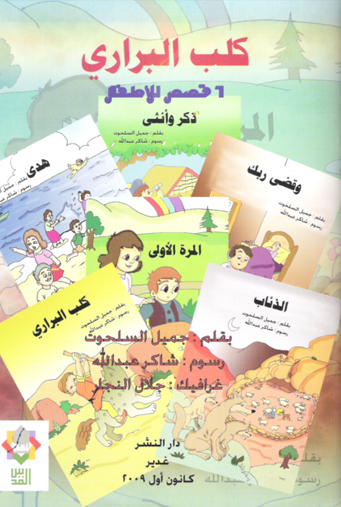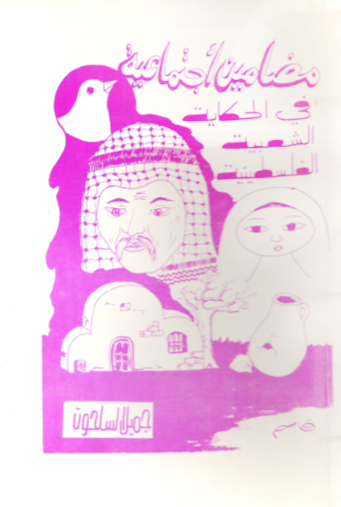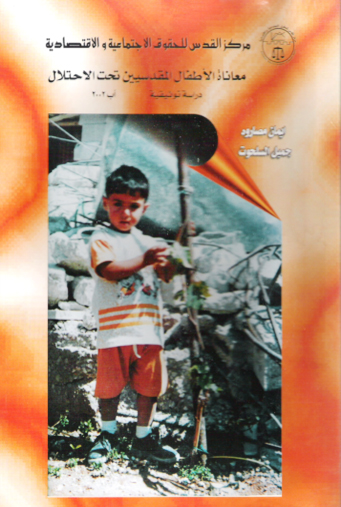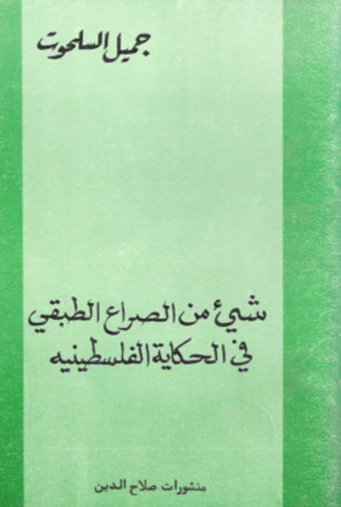صدرت عام ٢٠٢٠ رواية “الخاصرة الرّخوة للأديب المقدسيّ جميل السلحوت عن مكتبة كل شيء في حيفا.
أولا: رواية تُشبه جرحنا الجمعي
في روايته «الخاصرة الرخوة»، لا يكتب جميل السلحوت عن امرأة واحدة، بل عن وطنٍ بكامله يتأرجح بين الخوف والعار، بين الدين والذنب، بين الموروث والكرامة.
الرواية تُعرّي البنية العميقة لمجتمعٍ عربيٍّ يمارس استعمارا داخليا ضد نسائه، بينما يرفع الشعارات الكبرى عن الحرية والمقاومة.
فجمانة — بطلة الرواية — ليست شخصية خيالية، بل وجه آخر لكل فتاةٍ فلسطينية أو عربية حوصرت باسم الفضيلة، فصمتت كي لا تُدان، ثم صارت الصمت نفسه تهمة جديدة.
منذ الصفحات الأولى، يضعنا السلحوت أمام معادلة موجعة:
“نحارب الاحتلال الخارجي، لكننا نصنع احتلالا داخليّا أشد قسوة.”
ثانيا: من مشهد الخطبة إلى لحظة الاغتصاب تطور درامي يفضح السلطة.
يبني السلحوت روايته عبر تصعيدٍ سردي ذكيّ: يبدأ بالبساطة المألوفة -” جاهة”، أب، إمام، بنات في البيت، حديث عن الستر- ثم يُحوّل المألوف إلى مأساة.
حين ترفض جمانة الزواج المبكر، يُقال لها:” البنت ما إلها رأي؛.
وحين توافق مكرهة، تُغتصب بعد العقد باسم “الحق الشرعي”.
الكاتب لا يرفع صوته، بل يجعل الحدث نفسه يصرخ؛ لأن الجريمة المغلّفة بالشرع لا تحتاج إلى صوت مرتفع، بل إلى ضمير حيّ.
الرواية هنا ليست عن “ذكرٍ يظلم أنثى”، بل عن نظام ثقافيّ يزوّر الأخلاق. كل شخصية تُشارك في الجريمة — الأب الذي يسكت ضميره باسم الخوف، الإمام الذي يبرّر باسم النص، الأمّ التي تبرّر باسم العرف، والمجتمع الذي يغسل يديه باسم الله.
ثالثا: علم النفس في الرواية – المرأة ككائن يتنفس الذنب.
يُعيد السلحوت تشكيل جمانة من الداخل. هي ليست ضحية جاهلة، بل مثقفة تعرف أنها تُغتصب مرّتين: مرّة بالجسد، ومرة بالمعنى.
كل “نصيحة” تُقال لها تُغرس في وعيها كخطيئة، وكل آيةٍتُتلى أمامها تُحوَّل من وعدٍ بالرحمة إلى سيف على رقبتها.
في التحليل النفسي، ما تعيشه جمانة هو ما يسميه” لاكان” الاغتراب الرمزي:
أن تفقد قدرتك على تعريف نفسك لأن الآخر (الأب، الزوج، المجتمع) هو من يملك اللغة التي تُسمّيك.
وحين لا تملك المرأة لغتها، تصبح مجرد “خاصرة رخوة” في خطاب الجماعة.
رابعا: تفكيك الخطاب الديني – حين يتحوّل النص إلى أداة هيمنة
من أعظم جرأة السلحوت أنه لا يهاجم الدين، بل يهاجم احتكار تفسيره.
في مشهدٍ بالغ الرمزية، يحضر الإمام ليبارك الزواج ويقول إن “الستر فريضة”، فيسلب الكلمة من البنت ويمنحها للجماعة.
لكن الكاتب يُقلب المعادلة: يجعل القارئ يرى أن “السّتر” في الرواية ليس سوى دفنٍ للوعي.
هنا تتجلى براعة السلحوت في تفكيك الخطاب: هو يفضح كيف يُنتقى من النصّ ما يخدم السيطرة، بينما تُغيب المقاصد الكبرى للرحمة والكرامة والمودة.
بهذا المعنى، «الخاصرة الرخوة» ليست فقط نصّا أدبيّا، بل نقد لفقه الحياة اليومي الذي يُحوّل الأخلاق إلى قوانين تأديب، ويُصادر الحريّة باسم الفضيلة.
خامسا: البنية الرمزية – بين الجسد والقدس، بين الحلال والوجع.
الرموز في الرواية تعمل كشبكةٍ فكرية متكاملة;
الرمز
الدلالة
العمق الفلسفي
الخاصرة الرخوة
موضع ضعف الأنثى
نقطة انهيار الوعي الجمعي الذي يخاف مواجهة ذاته.
القدس
فضاء المقدّس المقهور
الجسد/الوطن كلاهما يُغتصب تحت راية الطهر
العقد الشرعي
قناع الهيمنة
الشرعية التي تفقد معناها الأخلاقي حين تغيب العدالة
الجامعة
فضاء الوعي المكبوت
المعرفة كتهديدٍ لبنية القهر
القبلة القسرية
العلامة الأولى للاغتصاب المقدس
العلاقة بين العنف والحلال في الثقافة الذكورية
هذه الرموز تُشكّل شبكة من المرآة المزدوجة: كل مشهد اجتماعي في الرواية يعكس واقعًا سياسيًا.
فالمرأة هنا ليست “الخاصرة” فحسب، بل جبهة الوعي الأولى في معركة التحرّر.
سادسا: الأسلوب واللغة – بلاغة الوجع وصدق الشهادة
لغة السلحوت ليست شعرية، لكنها مشحونة بطاقة صدقٍ مذهلة.
هو يكتب كما يتنفس الغضب. جمله قصيرة كطلقاتٍ مكتومة، يخلط بين السرد والاعتراف، بين القهر والصمت.
وكل سطرٍ في الرواية يبدو كأنه يُكتب بالدم لا بالحبر.
أسلوبه يقترب من الواقعية الأخلاقية الجديدة: واقعية لا تكتفي بالوصف، بل تُدين، وتفضح، وتُحاكم.
سابعا: فلسفة الرواية – من ملكية الجسد إلى حرية الروح
في العمق، هذه الرواية ليست عن زواجٍ قسريّ، بل عن معركة الإنسان ضد التشييء.
إنها بيان ضد تحويل المرأة إلى “أرضٍ تزرع”، وضد تحويل الزواج إلى عقد ملكية.
السلحوت يسأل القارئ — من خلال جمانة — سؤالًا أخلاقيًا قاطعًا:
“إن كان الحلال يُذلّ، فبأي حقٍّ ندعوه حلالًا؟”
وهنا تكمن عبقرية النص: أنه يُنقّي فكرة الدين من أوحال التسلّط، فيعيد الإنسان إلى جوهر العلاقة الإلهية — الرحمة لا القهر، الاختيار لا الإكراه، الوعي لا الخضوع.
✨ ثامنا: أهمية الرواية اليوم – لأننا ما زلنا نحاكم المرأة على جسدها.
«الخاصرة الرخوة» عملٌ يتجاوز الأدب إلى الاجتماع والسياسة واللاهوت. هو مرآة زمنٍ عربيٍّ يقدّس الشرف أكثر مما يحترم الإنسان. وفي زمنٍ تتجدد فيه جرائم “الشرف” وتُقتل النساء تحت مسمّى الفضيلة، تبدو الرواية أشبه بإنذارٍ ثقافيّ يقول لنا:
“إن لم نحرّر المرأة من خوفها، فلن نتحرّر نحن من هزيمتنا.”
خاتمة: الكلمة التي تُنقذ الحياة
ليست “الخاصرة الرخوة” رواية عن امرأةٍ تُجلد، بل عن الوعي حين يبدأ بالتمرّد.
حين تُدرك جمانة أن صمتها شراكة في الجريمة، تختار الكلام.
وحين تتكلّم، تبدأ المعجزة: تتحوّل الأنثى من موضوعٍ للحديث إلى صاحبة حديثٍ.
وهذا هو النصر الحقيقي الذي تمنحه الرواية: أن تكتب المرأة مصيرها، لا يُكتب عنها.
“الستر الذي لا يترك للروح أن تتنفس… ليس عفةً، بل قبرٌ مؤجل.”
١٤-١٠-٢٠٢٥