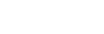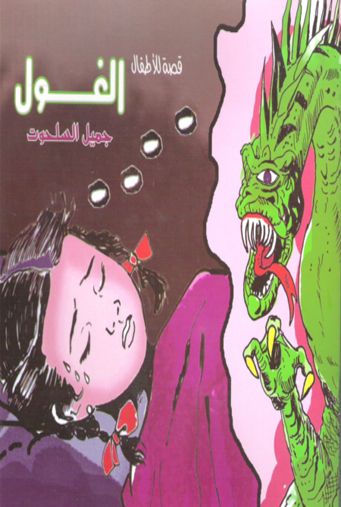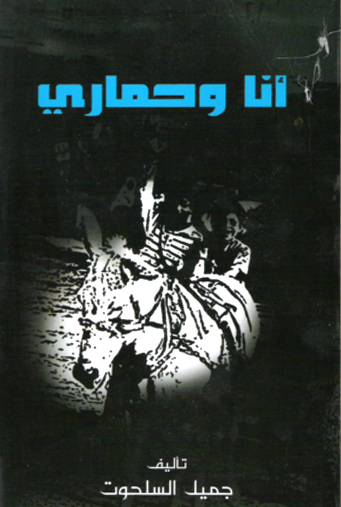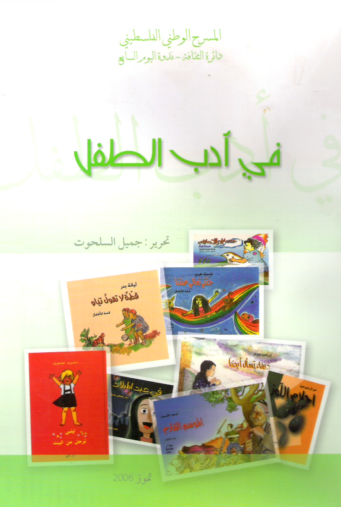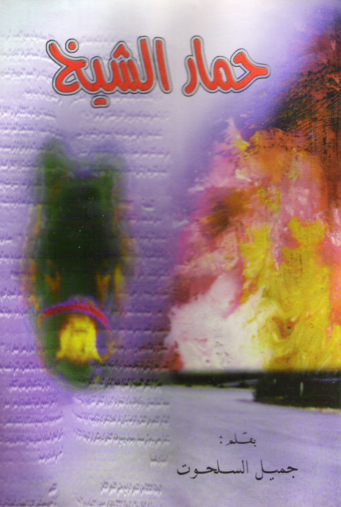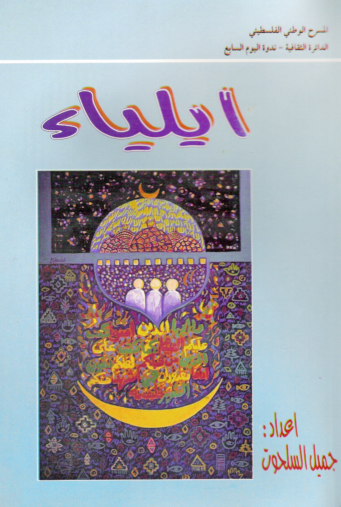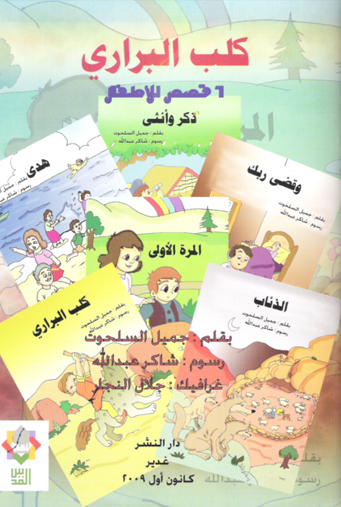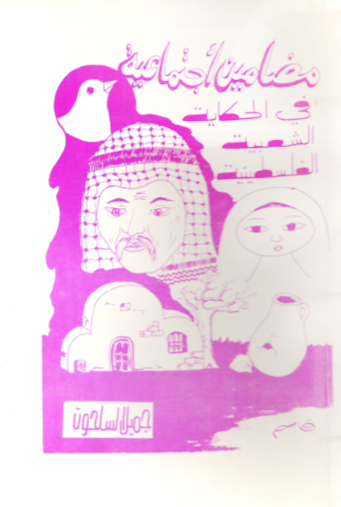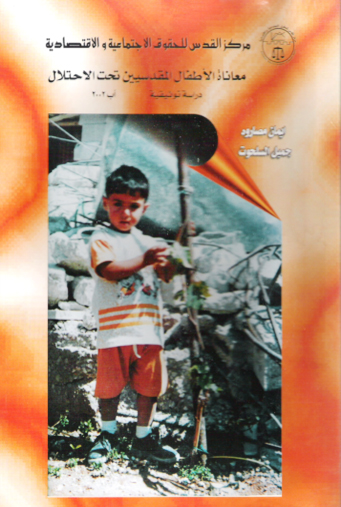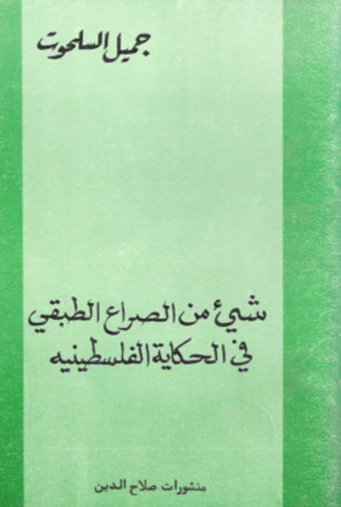صدرت عام ٢٠١٣ رواية “برد الصيف” لجميل السلحوت عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس، وهي الجزء الرّابع من مسلسله الرّوائيّ “درب الآلام الفلسطينيّ” المكوّن ستّة أجزاء.
مفتتح: بين الفصول والوجدان
في كل أدبٍ فلسطينيّ صادق، هناك فصولٌ تتناوبها النار والثلج.
لكن في برد الصيف، لا يعود الفصل مجرّد خلفية مناخية، بل حالة وجود.
جميل السلحوت، هذا الحارس الأمين لذاكرة القدس، لا يكتب روايةً بقدر ما يُشيّد مرثيةً حيّة عن الإنسان حين يتحوّل البقاء نفسه إلى اختبار أخلاقي.
إنه لا يسرد الألم — بل يُعيد تشكيله كفعل معرفة، كوعي جديد بأن الوجع ليس عدوًّا، بل معلّمًا قاسياً.
1. بين حرارة الاحتلال وبرودة الوعي
حين يكتب السلحوت “برد الصيف”، فهو يقيم معادلة حرارية معكوسة: في قلب الجحيم يسكن الصقيع، وفي ذروة الضوء يكمن العتم.
العنوان ليس وصفاً للفصل، بل تشخيصٌ لحالةٍ روحية يعيشها الفلسطينيّ منذ النكبة الأولى حتى اللحظة.
ففي عالمٍ تشتعل فيه الحرائق السياسية، لا يجد الإنسان الفلسطيني سوى “البرودة” كوسيلة نجاة — برودة الأعصاب، برودة الوجدان أحيانًا، لأن السخونة الدائمة تعني الاحتراق.
وهكذا يصبح البردُ شكلاً من أشكال الحكمة: آلية دفاعٍ وجودية ضد الجنون.
2. خليل الأكتع: الإنسان المعلَّق بين الحرية والخوف
خليل ليس بطلًا خارقًا، بل كائنٌ متصدّعٌ بكرامةٍ صلبة.
هو ابن بيئةٍ تُقدّس الصبر لكنها لا تُكافئه، ابن وطنٍ يطالبه العالم بالهدوء وهو ينزف.
يمشي خليل على الحافة — حافة الجدار، حافة الخيانة، حافة اليأس.
لكنه لا يسقط، لأن سقوطه سيكون تنازلاً عن إنسانيته، لا عن ترابه.
هو صورة الفلسطينيّ الذي صار وعيه عبئًا عليه: يرى كل شيء، ويدرك أن الإدراك نفسه نوعٌ من السجن.
3. أبو سالم: حين تتحوّل النجاة إلى خيانة
أبو سالم ليس خائنًا بالمعنى الكلاسيكي، بل ضحية من نوعٍ آخر: ضحية الخوف المزمن.
الخوف الذي يحوّل الضمير إلى عملة، والكرامة إلى ترف.
السلحوت لا يُدين الرجل — بل يعريه ببطء، كما تُعرَّى الروح أمام مرآتها.
يُقدّمه لا ليحاكمه القارئ، بل ليحاكم نفسه من خلاله:
كم من أبي سالم يسكننا نحن حين نختار السلامة على الحقيقة؟
كم مرّة قبلنا نصف الكرامة كي لا نخسر كلَّ الحياة؟
4. القدس: أنثى تُغتصب وتُقاوم في صمت
في “برد الصيف”، تتحوّل القدس من مكانٍ إلى جسدٍ حيّ يتنفس، ينزف، ويغفر.
هي ليست مدينة في النصّ، بل كائنٌ أنثويّ تُمارَس عليه كل أشكال الانتهاك، ومع ذلك يظلّ يحتفظ بسرّه الأنثويّ المقدّس — سرّ القدرة على البقاء.
القدس عند السلحوت ليست المآذن والقباب فقط، بل تلك التفاصيل الصغيرة:
فتاة تمرّ بالحاجز مبتسمة رغم الذل، طفل يبيع النعناع في الطريق، عجوزٌ تصلي عند جدارٍ مسروق.
كلّ هؤلاء هم ملامح جسدٍ واحدٍ اسمه القدس.
هكذا يجعل الكاتب من المكان بطلاً صامتًا، ومن الصمت نفسه لغة مقاومة.
5. البنية السردية: الواقعة تتحوّل إلى اختبارٍ أخلاقي
ما يميّز السلحوت أنه لا يكتب التاريخ من أعلاه، بل من “نقطة احتكاكه بالإنسان”.
يُعيد للواقعة – مهما كانت صغيرة – معناها الأخلاقيّ.
عند الحاجز، لا يهم من فتّش مَن، بل من بقي واقفًا في عينيه وهُويته.
في البيت، لا يهم إن سقط الجدار، بل إن بقي الحنين قائماً بين الجدران.
الرواية سلسلة اختباراتٍ أخلاقية، كلّ فصلٍ منها سؤال:
هل يستطيع الإنسان أن يظلّ إنسانًا حين يُعامل كرقم؟
وهل تبقى الكرامة ممكنة حين تصبح النجاة هي الخيانة؟
6. اللغة: براغماتية الشعر وشفافية الألم
لغة السلحوت تشبه حجارة القدس: بسيطة، متينة، لا تحتاج إلى زخارف.
إنه يكتب بعين الصحفيّ وقلب الشاعر: لغة تقطّر التجربة دون ادّعاء.
في كل سطر نسمع إيقاع النفس المقدسية — نصف فصحى، نصف عامية، كلّها صدق.
هذه اللغة تحفر، لا تلمّع.
هي كالفأس في يد فلاحٍ يعرف أن الحراثة هي شكلٌ من أشكال الصلاة.
7. علم النفس الفلسطينيّ: البرد كآلية نجاة
حين يصبح الاحتلال نمط حياة، يتحوّل الدفاع النفسي إلى فلسفة.
“البرد” في الرواية هو الانفصال الضروريّ عن الألم كي لا يموت المرء فيه.
خليل وأبو سالم والنساء الصامتات جميعًا يعيشون ما يمكن أن نسمّيه “تجميد الإحساس” – ليس لأنهم لا يشعرون، بل لأنهم لو شعروا بالكامل لانكسروا.
هكذا يكشف السلحوت عن الجانب النفسي للمأساة:
أن تكون فلسطينيًّا يعني أن تتعلّم فنّ التحمّل دون تبلّد، والصمت دون خضوع.
8. الجندر والمجتمع: حين تتحوّل العادات إلى أسوار
السلحوت يكتب أيضًا عن الاحتلال الذي يسكن داخلنا.
عن النساء اللواتي تُحاصَر أجسادهنّ باسم العرف، بينما يُغتصب الوطن باسم “القدر”.
عن البنات اللواتي يُزففن قبل أن يحلمن، لأن “الظروف صعبة”.
بهذا يوسّع السلحوت معنى الاحتلال: لا جنديًّا على الحاجز فحسب، بل منظومةَ خوفٍ جماعية تُمارَس داخل البيوت.
إنه يكتب الرواية كمن يضع مرآة أمام المجتمع ليقول له:
قبل أن تحرّر الأرض، حرّر الإنسان الذي عليها.
9. الرمزية العميقة: من الحاجز إلى الميتافيزيقا
الحاجز في الرواية ليس حاجزًا مادّيًا، بل حدٌّ بين الإنسان وصورته.
التحقيق ليس إجراءً أمنيًا، بل تجربة وجودية:
حين يُجرّدك الآخر من كل شيء — اسمك، جسدك، لغتك — فهل تبقى أنتَ؟
في هذا السؤال الفلسفي تكمن قوة السلحوت:
إنه يجعل من الاحتلال معملًا ميتافيزيقيًا للإنسان، يُعرّي طبقات النفس، ويكشف هشاشتنا وبهاءنا في آنٍ واحد.
10. الفلسفة الأخيرة: الإنسان كميدان للمعركة
«برد الصيف» لا تُعنى بالتحرير الجغرافي بقدر ما تهتم بتحرير الداخل.
فالحرية تبدأ حين نعيد تعريف الإنسان.
والسلحوت يُذكّرنا أن “الاحتلال” قد ينتهي بالسياسة، لكن “العبودية” لا تزول إلا بالتطهير الداخليّ.
يقول النص ضمنًا:
أن تكون فلسطينيًّا لا يعني أن تقاتل فقط، بل أن تظلّ قادرًا على الحبّ رغم أنف القسوة.
في زمنٍ يتجمّد فيه الحسّ الإنسانيّ من فرط العنف،
تأتي هذه الرواية لتذكّرنا أن الدفء الحقيقيّ هو القدرة على الشعور، لا على الانتقام.
خاتمة: الكتابة كشكلٍ من أشكال الصلاة
في النهاية، لا نقرأ «برد الصيف» لنفهم ما حدث، بل لنفهم كيف ننجو ونحن نعرف كل ما حدث.
هي ليست رواية تقرأها وتطويها، بل تجربة تسكنك مثل نداءٍ هادئٍ في ليلٍ بعيد.
جميل السلحوت هنا لا يكتب نصًّا فلسطينيًا فحسب؛ إنه يكتب تأمّلًا كونيًا في معنى البقاء.
ولذلك، حين نغلق الصفحة الأخيرة، لا نغادرها، بل نغادر أنفسنا قليلاً،
وقد صار فينا من الصقيع ما يكفي كي لا نحترق،
ومن الضوء ما يكفي كي لا نيأس.
٥-١٠-٢٠٢٥