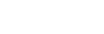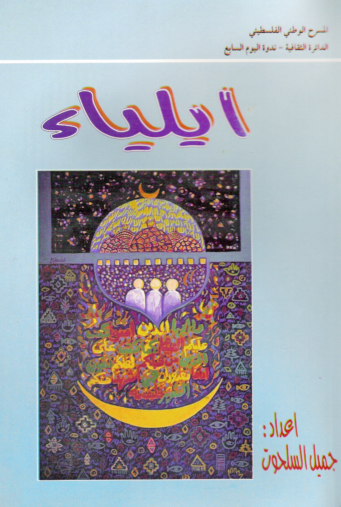القدس: 25-5-2023 من ديمة جمعة السمان– ناقشت ندوة ليوم السابع الثّقافية المقدسيّة رواية” مريم مريام” للأسير كميل أبو حنيش، وتقع الرّواية الصّادرة عام 2020 عن دار الآداب في بيروت في 263 صفحة من الحجم المتوسّط.
افتتحت الأمسية مديرة الندوة ديمة جمعة السمان فقالت:
أبدع الروائي الأسير كميل أبو حنيش بن قرية بيت دجن في رواية مريم مريام، إذ عكست الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقدّمت إجابة شافية وافية عن سؤالين يتم طرحهما دون أي إجابة مقنعة.
السؤال الأول: ما إمكانية التعايش السلمي بين الفلسطيني والإسرائيلي تحت سقف واحد؟
والسؤال الثاني: ما مدى رضا الشعب الفلسطيني عن اتفاقية أوسلو؟
قرأنا الإجابة بين السطور. أتت مقنعة وجليّة واضحة دون أي لبس؟ لا مجال للتعايش السلمي بين الذئب والحمل. وما كانت اتفاقية أوسلو سوى آخر مسمار في نعش أمل العودة إلى الوطن المسلوب.
أهدى الكاتب الرواية إلى الذين فضّلوا الموت عن الرحيل، إلى من قالوا نعم في وجه المستحيل، مسيح الشهداء، صديق الأسر والموت والفناء، رجل الموقف الأبيّ الذي لن نقبل فيه عزاء، عيسى عابد (أبو سريع) الفداء.
إلى من جعل الوطنَ جيشَه، ورفض أن يغتال الوطنُ بجيشهم.
وقد جاء تقديم الرواية بقلم نصير الأسرى، المحامي الحيفاوي حسن العبادي.
أجاد الكاتب في حبك الرواية، وربط الخيوط، واتباع أسلوب العودة بالذاكرة (الفلاش باك) التي أتت على ألسنة شهود عيان، فجاءت سلسة ومشوقة بكل تفاصيلها الدقيقة، كما قدّم معلومات تاريخية على لسان المناضل الفلسطيني أبو سريع، الذي كان أشبه بالموسوعة المتحركة، لا يعجز عن الإجابة عن أي سؤال يطرح عليه.
تتحدث الرواية عن الشاب إبراهيم، الذي عاش التيه بلا هوية تشكل له الشعور بالانتماء، وذلك على مدار عدد صفحات الرواية، إلى أن وجد الحقيقة واختار وجهته التي أراحت ضميره وصالحته مع ذاته.
فكيف لا يعيش الصراع الداخلي؟ فهو ابن اليهودية (شلوميت) ابنة مريام وآدم الذي قتل على أيدي الفلسطينيين بعد نكسة عام 1967. وكانت قد جاءت عائلتها من نيويورك، واستقرت في مستوطنة على أنقاض منازل المهجرين في صفورية بعد أن نجت من المحرقة بأعجوبة. أمّا والد إبراهيم فهو (الياس) الذي هجر من قرية صفورية عام 1948، وهو لا زال جنينا يسكن رحم أمّه مريم الفلسطينية، وابن محمود الذي سقط شهيدا وهو يدافع عن قريته صفورية قبل احتلالها. صفورية التي استبدل الاحتلال اسمها بِ تسيبوري بعد احتلالها، لمحو تاريخها وذكريات سكانها الأصليين قبل النكبة.
أمّا أخت إبراهيم (عنات) اليهودية، فهي ثمرة زواج أمه شلوميت وزوجها السابق اليهودي.
معادلة غريبة عجيبة، فمن عليه أن يتبع؟ وإلى أيّ معسكر ينتمي
عاش إبراهيم صراعا نفسيا مريرا. كان منبوذا من الطرفين. تعرض للتنمر من أقرانه. فقرر أن يبحث عن الحقيقة، ليجد نفسه ويتصالح مع ذاته.
وفي النهاية اختار أن يكون فلسطينيا، يدافع عن حق شعبه مظلوم، الذي عاش مرارة النكبة ووجع النكسة، وهُجّر من أرضه، وسلب حقه في العيش حرا في وطنه،
وممّا يذكر أن في الشريعة اليهودية يتبع الطفل ديانة أمّه! إلا أنّه قرر أن يخوض رحلة البحث عن الحقيقة. وقد كان لجامعة بيرزيت أكبر الأثر في اتخاذ قراره، إذ أشار الكاتب إلى دور الجامعة الهام في صقل شخصية كل من ينتمي إليها، وتشكيل هويته الوطنية الفلسطينية.
رواية أشبه بالملحمة، تناولت قضية شعب يتوق إلى الحرية، من خلال شخوص رسمها الكاتب بعناية، واختار أسماءها بذكاء، جعلها تتحدث عن ذكرياتها وآمالها وأحلامها ومشاعر الخذلان.
رواية لخّصت القضية، بلغة سليمة، وبطرح عميق، غاصت في دواخل الشخوص، وأخرجت مكنوناتها.
رواية أنصح بترجمتها إلى لغات العالم، كما آمل أن أراها مجسّدة على الشاشة الكبيرة فيلما، لينقل الحقيقة إلى العالم أجمع.
الحرية لأسير الحرية الأديب المبدع كميل أبو حنيش، ولأسرانا البواسل كافّة.
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
رواية”مريم مريام”هي رواية الفلسطيني الذي هجر من قريته عام 1948، وقد اختار الرّوائي الأسير كميل أبو حنيش قرية صفورية المهجرة قضاء الناصرة كمثال لتصوير الناحية النفسية عند الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وكصرخة حق في أنّ الفلسطيني ما زال يحفظ ذاكرة نكبته ووجعه، وإن تغيرت الأسماء والأماكن، فصفورية تحولت إلى اسم آخر”تسيبوري”بينما أهل صفورية سكنوا في الناصرة في حي الصفافرة.
الرواية رمزية، تعبر عن الناحية النفسية والعاطفية عند الفلسطيني في مواجهته للتغيرات والصعوبات التي حدثت ما بعد النكبة، الصراع النفسي في مسألة حق العودة لأهل صفورية، وتتمثل بشخصية مريم الفلسطينية التي فقدت أهلها وزوجها في الحرب، ورفضها المساومة والتنازل عن حقها، وبالمقابل يعرض الرّوائي حنيش من خلال شخصية مريام اليهودية قضية اليهودي، الذي سكن القرى المهجرة وهو مؤمن في حقه بالاستيلاء على الأرض والمكان، من منطلق ادعائه بوعد الرّب لهم وقضية الهولوكوست وعذابهم في المحرقة، وادعائهم بأن العرب من اختاروا الحرب.
نجد الناحية النفسية عند إلياس ابن مريم الذي يسترجع طفولته أثناء النكبة وبعدها وبين أطفال تسيبوري حيث الملابس النظيفة والبيوت الجميلة، وأيضا يبرز الرّوائي التوتر عند الفلسطيني والمفارقة الغريبة في مساهمة بناء العامل الفلسطيني للبيت اليهودي، وما زال الفلسطيني حتى يومنا هذا يعاني من هذا الصراع، ففي الرّواية يقوم إلياس ببناء قرميد لليهود في مسقط رأسه في صفورية (تسيبوري).
كما تتجلى الناحية النفسية في شخصية إبراهيم الذي يمثل الأجيال الشابة، وفي صراعه ما بين حكايا الماضي والواقع. وفي سؤال لماذا يجمع الحكايات يقول:
“أحتاجها لأجمع شتات روحي المبعثرة”
ففي نسيج الرّواية التي تبني من خيوط الزواج المختلط بين إلياس العربي ابن مريم وزواجه من شلوميت اليهودية ابنة مريام، تكمن تفاصيل الصراع، وقد أحسن الرّوائي في جعل الشخصيات المتعددة بين العائلتين وخارجها تبوح بوجهة نظرها في مسألة حق الملكية للأرض والمكان، ومدى انتمائمهما لهما. فالرّواية تبحث في قضية الهوية والانتماء، وتنتصر في النهاية لهوية إبراهيم الذي يقرر انتماءه لجدته مريم وليس لمريام، أيّ لحكاية الفلسطيني الحق، والرّواية بأسماء شخوصها هي دلالة على الناحية النفسية القائمة في الرواية، إبراهيم أو أبرم، شلوميت أو سلام، مريم -مريام.
تطرح الرّواية عدّة تساؤلات بالنسبة لقضية اللجوء، حقوق الفلسطيني الذي هجر من مكانه وأرضه، حول هل بإمكانية الفلسطيني الذي هجّر من أرضه وبيته أن يسامح من اغتصب أرضه؟ هل يستسلم الفلسطيني للأمر السياسي القاهر؟ جاء أسلوب الرّوائي كميل أبوحنيش سلسا وانسيابيا، بضمير المتكلم على لسان إبراهيم، وهو ينقل رواية النكبة من خلال جدته مريم، وقد كان الاسترجاع الفني (فلاش باك) حاضرا يعيد ويصور تفاصيل الحرب والصدمة، جاء السّرد ممتعا يشدّ القارىء بأسلوب مشوق وبثقافته الواسعة، أحسن في صقل شخصيات الرّواية من خلال خلق الصراع حول الهوية والانتماء والأرض، وصوّر حالة التوتر، والقهر لدى الفلسطيني في حنينه لحبات التّين في صفورية، كما استخدم الوصف الجميل في وصفه لقرية صفورية، وبين علاقة الفلسطيني المتينة بأرضه من خلال أسلوب المقارنة التي أجراها بين مريم ومريام.
رواية “مريم مريام”إضافة إبداعية للعمل الأدبي داخل سجون الاحتلال.
وكتب المحامي حسن عبّادي:
يسعدني أن أكون مرّة أخرى مع رواية مريم/مريام التي تربطني بها علاقة وجدانيّة خاصّة.
تحدّث صديقي الأديب صبحي فحماوي في روايته “سروال بلقيس” عن فلسطين وأيّام الزمن الجميل الحاضرة في ذاكرة اللاجئين كلّ الوقت، فصالحة السمراء تتحدّث عن أيّامها الجميلة في صفّورية، في بيت حجر نظيف وعِلِّيّة مُطلّة على بحر عكا تحرسه بيّارة، أيّام الدراسة والموسيقى الكلاسيكيّة الغربيّة، والنشيد الوطني الفلسطينيّ، وحمده تستذكر زوجها الشهيد وذكريات تلك الأيام وبلقيس تستحضر تلك الأيام على أمل أن تعود…قريبًا.
قال عاشق صفورية، المرحوم طه محمد علي: “صفورية هي من صنعت منّي شاعرًا”.
في الخامس من شهر كانون الأوّل عام 2018 رافقت إيفا(سميرة) حمده الزعتريّة بطريقنا خروجًا من الناصرة فسألتني عن بلدة صفّورية، فركنتُ السيارة لنطلّ عليها وتساءلتُ في أذنيها: “ما هو الأصعب، أن تنظر إليها صباح مساء وحُرمتَ منها أم أن تكون لاجئًا في الشتات، وكلاكما تحلم بالعودة إليها؟”.
وحين قرأت رواية “تذكرتان إلى صفّورية” لصديقي الروائي سليم البيك تساءلت: لماذا يكتب الجميع عن صفوريّة؟ ووجدت الجواب حين قرأت رواية “ستّي مدللة” لصديقي مصطفى عبد الفتاح، لأنّها الجنّة المفقودة.
تركَت ستّي مدلّلة قريتها صفورية قسرًا، هُجّرت إلى لبنان وعادت متسلّلة لتسكن في قرية كفر-مندا الواقعة على مرمى حجر من صفوريّتها، تنتظر تحقيق حلمها بالعودة. خذلها الجميع فهرِمت، أرادت أن تستنشق هواء بيتها وحديقتها … هواء صفورية. وصيّتها، وهي على فراش الموت، تسلّم مفتاح البيت الصفّوري لحفيدتها قائلة: “خذي يا صغيرتي هذا المفتاح، إنّه مفتاح بيتنا الكبير” حالمة بأن تُدفن هناك، مثلما فعلت الجدّة رُقيّة (بطلة رواية الطنطوريّة لرضوى عاشور) حين التقت حفيدتها على الجانب اللبنانيّ من السلك الشائك، تناولتها من فوق الأسلاك، قبّلتها، قامت بنزع المفتاح من عنقها، مفتاح دارهم في الطّنطورة الذي ورثته عن أمّها لتعلّقه بدورها على رقبة الطفلة، وهي تصرخ بصوت عال: “مفتاح دارنا يا حسن. هديّتي إلى رقيّة الصغيرة”.
قلت لكميل حين انتهيت من قراءة مسودّة الرواية، وكان عنوانها المقترح “أرض السماء” وأحداثها “صفّوريّة” بإمتياز: “صفّوري يطلّ على صفّورية المدمّرة من حيّ الصفافرة النصراويّ، عادة يورّثها الجدّ للحفيد، لا تبعُد مرمى البصر، ولكنّها سُلبَت منه إثر النكبة؛ صفوريّة أجمل مكان في العالم، فردوسًا مفقودًا يحلم أبناؤه باستعادته يومًا ما”.
أهلنا في الشتات والمنافي يعيشون هاجس العودة -عودةِ الروح الى الجسد. يلاحقهم كابوسٌ مزمن: الخوف أن يغادروا هذه الدنيا قبل تحقيق العودة… كلٌّ إلى “صفُّوريَّته”.
كميل صاحب رؤية ورؤيا؛ فكتب، حين سمعت الجدَّة مريم: “يا حجّة، عقبال العودة لصفُّوريَّة”، أجابت بلهفة واحتضان وقُبلة: “هذه أجمل أمنية أسمعها في حياتي، لم يقُلها لي أحد منذ سنوات بعيدة”.
نعم، لم ولن نرضى القبول بعودةٍ فرديَّة على شكلِ مِنَّةٍ من أحد. ولكلّ صفُّوريٍّ قبر ينتظره؛ ليُدفَن في تراب الوطن… في صفُّوريَّة.
كُتب الكثير عن صفوريّة، وكُتب عن الكويكات والطنطورة والشجرة، وحبّذا لو يكتب أدباؤنا عن باقي قرانا ومدننا المُهجّرة؛ لأنّه هناك ضرورة مُلحّة لدحض الرواية الصهيونية التي علّمونا إياها منذ الصغر. روايتنا الشفوية الصادقة مُهمّشَة ومُغيّبَة وآن الأوان لتدوينها، ولو عن طريق الأدب.
كان لي شرف توقيع الرواية نيابة عن كميل حين أشهرتها دار الآداب في معرض الكتاب الدولي في عمّان (وشاركتني زوجتي سميرة وكمال – أخو كميل).
همس لي كميل في إحدى اللقاءات في سجن ريمون/ صحراء النقب: “حلمي أن تُطلق روايتي الصفوريّة على أراضي صفورية”، وحقّقت له الحلم حين رتّبت مع اتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل-1948 ندوة هناك؛ ليفرح فرحة منقوصة، وكم كان يرغب أن يكون بيننا. حوّلنا صفوريّة المهجّرة إلى حلبة مصارعة، يتصارع فيها التاريخ الحقيقي والطبيعي مع التاريخ المزوّر والاصطناعي.
وها هو كميل يكمل الحلم بتواجده في القدس الغالية على قلوبنا.
قلتها مرارًا وتكرارًا؛ تحرير البلاد بتحرّر كافّة أسرانا. وتبقى الكتابة متنفّس لأسرانا…إلى حين..الحريّة للعزيز أبو حنيش وأسرى الحريّة.
وقال عبد المجيد جابر:
افتتاحية الرواية:
ففي روايتنا هذه نرى أن الشخصيات الرئيسة كمريم وأهلها وزوجها محمود وأهل صفورية كلُّهم، وليس هؤلاء فقط، بل شعب بأكمله تحالفت كل قوى الشر في الأرض عليه، وأغلب الشخوص ومَن لم يُقتل منهم كلهم قد خرجوا وهاجروا من وطن مسلوب، والقليل منهم من عاد لمرابعه، وتشبث بتراب وطنه، ولاقى ويلاقي الظلم والعسف والتهميش والذبح والتعذيب، والوحدة الوظيفيّة في المقدمة دليل على جودة افتتاحيّة الرواية وتماسكها. فالوحدة الوظيفيّة، مهما يكن شكلها، قادرة على تحديد مسار الرواية، وطبيعة السرد فيها، فضلاً عن إثارتها شغف القارئ، وحفزه إلى القراءة، والتمهيد لبناء الشخصيات واختراق الأمكنة الروائيّة.
الرمز
زواج الياس من شلوميت يرمز ويمثل التعايش المشترك بين العرب واليهود وتناسي الماضي والأحقاد، وهذا الرمز في الرواية هو ثمرة زواج الياس من شلوم أو شلوميت ابنة مريام، ولكن هذا التعايش لم يتحقق، ودليل ذلك أنْ كان من ثمرة ذلك الزواج الابن إبراهيم أو أبرم الذي قضى فترة شبابه في حيرة وتخبط وفقدان للهوية والانتماء، وفشل الابن في تقريب وجهات النظر بين جدتيه: مريم ابنة صفورية اللاجئة والحالمة بعودة الحق لأهله، وبين مريام الصهيونية الناجية من محرقة الهولكست والجاثمة والقاطنة على أنقاض بيت مريم، وتعتبر أن هذه الأرض هي أرض إسرائيل، وهي أرض الآباء والأجداد.
أهميَّة المكان
يمثل المكان في القصّ، عنصراً مهما من عناصر السرد الروائي، ليس لأنه الفضاء الأفقي للنص فقط، حيث تدور الأحداث، ويتحرك الأبطال في دوائر متقاطعة، وتتضح معالم شخصياتهم وتنمو وتتحول، بل لأن المكان في كل أبعاده الواقعية والمتخيلة يرتبط ارتباطاً وثيقا بالجانب الزمني والتاريخي للنص وشخوصه، بحيث ينتج عن التفاعل (الزماني- المكاني) منظومة سردية تنتظم في الشكل الروائي الذي تمّ اختياره لتقديم الأحداث والأشخاص، وتفاعلاتهم النفسية والحركية مع المكان.
ويقوم المكان في القصة – بوصفه عنصرًا يتميز بخصوصية – بعدة وظائف في السرد، لعل أهمها: تكوين إطار الحدث، وتحريك خيال القارئ لتصور الأمكنة، واستخدام المكان مع دلالته الرمزية ليكون مؤشراً للأحداث. بيد أن المكان يؤدي دوره البارز-عبر تحولاته المستمرة- في الكشف عن كينونة استمرار اللا ثبات.
صفورية
وهي تمثل “المكان” مكان كل مدينة أو بلدة احتلها الصهاينة بفعل البطش والقوة والغدر والمكيدة، ولقد بلغ تعدادها خمسمائة بلدة ومدينة دمّرها المحتل، كانت للفلسطيني مكان أليف ويصبح خلال النكبة بفعل المحتل مكان طارد، وفضاء أجواؤه ملوَّثة، تتشظّى فيه الروح، وتعاني اغتراباً حاداً من بعد تعلق وأنس وارتباط وحب، ومن خلال هذا الفضاء يقوم الكاتب بتصوير علاقات التمزّق والضياع والقلق والتوتر والغربة، وفقد جمال الطبيعة من ينابيع وأشجار غناء متنوعة، وجلسات ودّ وسمر وذكريات حلوة، كانت في وطن استبيح واحتل؛ بفعل الغدر والقوة الغاشمة التي استخدمها المحتل، فاستخدم كل أدوات الحرب بما فيها الطيران، فعاني الأهل من تقتيل وتشرِّيد وفقد وجزع ولجوء، فمعظم علاقات المدينة مع المحتل كما يصوّرها النص القصصي تفتقد إلى الحميمية والنبل، فالشخصية بعد اللجوء تشعر بالغربة والضياع والفقر والتشرّد واللاجئ يئن من وجع المحتل، وأهلها ومالكوها الأصليين لا يدخلونها إلا بتصريح عمل؛ ليعملوا فيها كعبيد إن بقوا في الداخل.
ويحمل الراوي وهو يصف جمال طبيعة صفورية عدسته التصويرية؛ ليمدنا بصور شتى كيف أن مريم قد اعتادت أن تقضي وقتها مع الصبايا في جلسات ما قبل الغروب، مع الصبايا في كروم الزيتون والأدغال، يحلمن بالبحر المترائي أمامهن… وبالطبيعة الجميلة التي تسكن روحها، والمتمثلة بأزهارها البرية، وبشجرة التين العسالي، تلك التينة التي كان يسبقها محمود الذي تزوج بها فيما بعد، وتظهر قدسية المكان من خلال الزمن وهو الفجر(هذا قبل النكبة واللجوء) وفي مسيرة فعاليات ذكرى الخمسين للنكبة، حيث يتقاطع الزمان بعد النكبة بخمسين عاماً بالمكان “صفورية”، تشارك مريم المسيرة إلى صفورية وهي على عكازتها، فحال وصولها للمكان صفورية أول ما تقف على شجرة التين العسالية وجدتها كبيرة وهرمة والأشواك تحتها بفعل الإهمال، فأخذت مريم تتلمس أغصان أوراقها بحفاوة وتُمسِّد عليها بقداسة، وتحدِّثها وتستنطقها بتحبُّب، وتعانقها كحبيب يعانق حبيباً بعد طول غياب، وأخذت تقتلع الأشواك أسفل منها وتبكيها وتنتحب… وبعد أيام يأتي بنحاس الصهيوني فيشوِّه المكان ويقتلع شجرة التين، كما يقتلع الصهاينة أشجار الزيتون للعرب، وكأنهم يقتلون كل الجمال والحنين والارتباط والذكريات في نفوس الفلسطينيين.
مستوطنة سيبوري والناصرة العليا
تمثل قيام الكيان الصهيوني أو ما يعرف بدولة (إسرائيل ) وهو كيان هجين غير شرعي، غريب يمتهن البطش والصلف والغرور والتزييف وطمس التاريخ والحضارة، هو كذلك بالضبط والتمام ، إنها تجميعة مستحيلة الاتزان من مكونات الدولة التي تبدو في ظاهرها القوة والمنعة والثبات والاستقرار ……..إنها كيان عديم الاستقرار؛ لأنه ليس شرعيا ولا يمتلك الحق التاريخي ولا الديني ولا الحضاري ولا الأخلاقي، ولا يمتلك المبرر الوجودي أصلا، هذا الكيان الركيك يتطلب وجوده دعما غير محدود من أعتى الكيانات الاستعمارية في العالم ، فلولا الأسلحة الغربية والأمريكية لما أمكن لهذا الكيان أن يدوم يوما واحدا، فبريطانيا أمدت الصهاينة بمئتي طائرة قبل أن تنسحب من فلسطين قبيل النكبة، ولولا المؤامرات والألاعيب الاقتصادية التدميرية للمحيط العربي لما كان هنالك اقتصاد ولا بيع ولا شراء داخل هذا الكيان.
والمستوطنات مكان سكن مَن وفد غريبا من أقطار العالم، وتمثل مكان منعة له وتخزين للسلاح، وهي البديل عن القرى والبلدات الفلسطينية.
البيت
وبيت مريم وبيت أهلها يمثلان كل بيت في فلسطين زمن النكبة؛ وجاء تصوير البيت كمكان مغلق اختياري، نابض بالحياة والألفة والدفء العاطفي. إن البيت القديم، بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكيّف الخيال، وعندما نفتقده نعود إليه بكامل خيالنا ورقة أحاسيسنا ودفء مشاعرنا.
والبيت يعتبر المكان الأليف الذي يتشبث بساكنه، ويصبح الرحم للجسد بجدرانه التي تتقارب، كما يمتلك تلك الرومانسية والحنين إلى زمن الماضي، فلا يوجد حالم واحد يستطيع أن يظل غير مبال وهو يطالع صورة البيت، وبفعل المحتل يصبح هذا المكان مقبرة ومكان فجيعة لساكنيه ليقتل فيه أو يُطرد منه، وهذا المكان الأليف الاختياري يصبح في النكبة مكاناً طاردا معادياً.
نبعة صفورية
تمثل جمال الطبيعة في فلسطين، وهي مصدر حياة وخير ونماء لدى الفلسطيني، والصهيوني يخفي جمال الطبيعة، ويتدخل فيها ويبني عليها خزان ماء.
الكروم في صفورية
تمثل الخصب والنماء والجمال والذكريات الجميلة، وملقى الأحبة والخلان في كل كرم وفي كل بلدة احتلها الصهاينة.
المخيم
أكواخ وبيوت بائسة من الصفيح والطين، تحمل اسم “حي الصفافرة” ويمثل مكان البؤس واللجوء القريب من أرض الجذور في الداخل، وهو تعبير عن النكبة والضياع والتشتت والتشظي وللأحلام الغربة والفجيعة، والفقر بعد غنى واكتفاء وتذكر صفورية والماضي الجميل فيها، وفي المخيم يتحدث الناس عن جذورهم وبلداتهم المسلوبة والمدمرة، ويحلمون بالعودة إليها، حيث أصبحت ذكرى وحلماً، أطفاله بائسون بأسمالهم البالية ووجوههم المغبرّة، وكبار السن تعلو وجوههم الحسرة والفجيعة والشعور بفقد كل عزيز ونفيس. و” حي الصفافرة” رمز للمخيمات وما آل إليه الفلسطيني من سكن بائس بُعيد نكبته….ويرمز مخيم الصفافرة “المكان” لكل مخيمات الداخل الفلسطيني.
ومن خلال المكان ورمزيته وتلاحم الشخصيات وارتباطها فيه، عبّر الكاتب عن كل ما يريد، مستخدماً الأساليب السردية المتنوّعة والمتعدّدة، منها الذاتي، ومنها أسلوب الراوي المفرد، والاسترجاع، والحوار، والمونولوج، إلى غير ذلك. وقد جاءت هذه الأساليب السرديّة الدقيقة تخدم المكان والحدث معاً، وأظهرت ميزة الأصالة والخصوصية للمكان.
مخيم عين الحلوة
وهذا المخيم في لبنان رمز لكل مخيمات الشتات واللجوء، ومَن عانى من الظلم والفقر والحرمان والخذلان والبؤس والفواجع، وهو مكان جاذب للاجئين الفلسطينيين ممن فقدوا أرضهم وملكهم وعائلاتهم كعادل أخي مريم، وللمقاتلين الفلسطينيين ممن نفذت ذخيرتهم، كممدوح الذي رافق عادل في رحلة اللجوء والغربة والبؤس والفقد والضياع، ويرمز هذا المخيم لكل مخيمات اللجوء خارج الوطن.
معتقل أوشفيتز
هذا المعتقل يمثل الفكر الأوروبي المعادي للبشرية، هو شكل من أشكال العنصرية واللا آدمية، وهو مكان مذبحة فقراء اليهود في ألمانيا وليس أغنيائهم والمبالغ في عددهم، ومن القرن السابع عشر تعرض اليهود في أوروبا لسبع مذابح في أوروبا، وينسى اليهود أعداءهم الحقيقيين وتمتد أيديهم لغدر من كان يعينهم من العرب والمسلمين، والمصلحة ونكران الجميل يمثلان الفكر الصهيوني، الذي لم يضع بيضه في سلة واحدة، بل كان قسم منهم مع الحلفاء والآخر مع الألمان؛ لضمان الربح في كلا الحالتين، والفكر الصهيوني لا يحسّ بالبشرية ولا بأوجاعها، وقبلوا أن يمارسوا الذبح بحق الفلسطينيين الذين تعاطفوا معهم، نعم، اليهود في أوروبا ضحية والأوروبي جلاداً، ولا يحق للضحية أن تمارس جلد من تعاطف معها، وإن كان ولا بدّ فثأرهم في أوروبا وليس في فلسطين، فآدم الذي يمثل الصهيونية ومعانيها ووزرها وظلمها، والذي نجا من مذبحة أوشفيتز وأبيد كل أهله هناك، واستقبلته فلسطين وتعاطف معه أهلها، يأتي إليها صهيونيا متعصبا متحمساً للفكر الهمجي، ويعمل في الجيش، ويقاتل الفلسطينيين بشراسة، وهذا هو ردّ الجميل، والغريب أن اليهودي الضحية في أوروبا يصبح جلاداً في فلسطين، ومثاله في الرواية بنحاس أخ لمريام.. ومريام الناجية الوحيدة من تلك المذبحة تأتي لفلسطين وتسكن بيت مريم الفلسطينية، البيت الذي أصبح خلال النكبة قبرا لكل عائلة مريم وزوجها محمود.
غور الأردن
يرمز للمكان الذي احتله الصهاينة عام 1967م، وغدا اليوم مكان صراع، فهو المدخل للضحية لاسترجاع حقها، ومكان محبب للصهيوني لإراقة دم الثائر الفلسطيني وبناء المستوطنات، وفيه قتل آدم وهو يطارد الفلسطينيين.
الناصرة
ترمز لعبق الدين والتاريخ وعيسى -عليه السلام-، وترمز للمدن الفلسطينية ذات الطابع الديني والتعايش السلمي، والتآلف بين المسلمين والمسيحيين… وزمن النكبة تصبح الناصرة مكان جاذباً، وكنائسها مكاناً آمناً للعرب.
أوسلو
ويتسع فضاء الرواية ليصل إلى أوسلو “المكان”، التي تمثل الاتفاق المهين بين منظمة التحرير وبين إسرائيل، وتحاول إسرائيل في هذا الاتفاق إلى إخضاع كل صوت فلسطيني مقاوم، والحصول بالمفاوضات على ما لم تستطع بالوصول إليه في الحرب، مستخدمة أسلوب الخداع والمكر والابتزاز، ويعود عادل المفقود من عائلة مريم، وهو أخوها زائراً لأخته مريم من مخيم عين الحلوة في لبنان إلى فلسطين صمن من عادوا بحسي اتفاق أوسلو، ويلتقي بأخته مريم بعد رحلة غياب قصري قاسية وفظيعة ..رحلة شقاء في اللجوء، ورحلة الحرب وأحلام الرجوع والخسارات. ..يصل الناصرة سراً، فهو محسوب على السلطة الفلسطينية.
جامعة بير زيت
ويتسع فضاء الرواية ويصل جامعة بير زيت في الضفة الغربية، ويمثل “المكان” نجاح إبراهيم في العثور على نفسه وعلى هويته المنتسبة للمكان بكل جراحاتها وآلامها وتاريخها، فيجد فيها امتداداً شعبياً لأهالي الجليل والمثلث والنقب ولصفورية ولأهله، وفي هذا المكان استطاع إبراهيم الانفكاك من عقدته بأن أمه يهودية، في جو الجامعة “المكان” ، ساعده القطب الطلابي التقدمي، بهويته اليسارية، وتنوع المشارب السياسية والفكرية في الجامعة “المكان” ، والتقائه في المكان “الجامعة” بعيسى أبي سريع، الذي ساعده في استئصال مشاعر حيرته من أعماقه وشعوره بالاغتراب و وتوهانه في الانتماء.
وفي الجامعة يتعانق الزمان عام 1998 والمكان في الجامعة بقيام المظاهرات والاشتباك مع قوات المحتل في ذكرى يوم الأرض، والجامعة “المكان” تمثل مشرباً فكرياً حضارياً تعليمياً تثقيفاً.
المستشفى
مكان علاج إبراهيم في الناصرة من حادث سير، ويمثل هذا المكان التقاء الأضداد بزيارتهم لإبراهيم، الذي اعتقد أنها فرصة مواتية للصلح بين الجدتين مريم الفلسطينية ومريام الصهيونية، وبين والده الياس وجدته مريم وبين عنات ووالدتها مريام، ولم يتم الصلح مثلما لن يتم الصلح بين الصهاينة والفلسطينيين، فلا يمكن الجمع بين من اعتدى واحتُلَّت أراضيه، وبين من قام بالاحتلال، وقد جاء من أقاصي المعمورة.
وفي مستشفى رام الله يلفظ أبو سريع الثائر، صاحب العقل الكبير أنفاسه الأخيرة، وهو الذي فكّ حيرة إبراهيم في تخبطه بانتمائه، والذي أصيب في مدخل رام الله الشمالي إثر مصادمات مع الجيش الإسرائيلي، وهذا المكان “مدخل مدينة رام الله” يرمز لما يلاقيه الفلسطيني من حصار، وسجن كبير، وبوَّابات أسرٍ في مُدنه وقراه، فهاهي العاصمة المزعومة للسلطة الوطنية الفلسطينية تُطوّق وتُستباح..
جنوب لبنان عام 2000
انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار عام 2000 م، بعد احتلال دام قرابة 18 عاما متواصلاً. وعاد الجيش الإسرائيلي إلى نشر قواته من جديد على طول الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، ومكللّا بالشعور بالهزيمة تنتابه لأول مرة، ما انعكس سلبا على معنويات الجيش ومواطنيه. وهذا المكان يرمز إلى إمكانية دحر إسرائيل مستقبلاً.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اجتاح لبنان في العام 1982
الضفة وغزة
الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى، والمكان الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، ويقترن الزمان بالمكان، فلقد اندلعت في 28 سبتمبر 2000م، بعد تعنّت إسرائيل وعدم تجاوبها للسلام الذي هو أصلاً يصب في صالحها، وتوقفت فعلياً في 8 فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ، والذي جمع الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، وتميزت هذه الانتفاضة مقارنة بسابقتها بكثرة المواجهات المسلحة وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، راح ضحيتها حوالي 4412 فلسطينيًا و48322 جريحًا. وأمّا خسائر الجيش الإسرائيلي تعدادها 334 قتيلاً ومن المستوطنين 735 قتيلاً، وليصبح مجموع القتلى والجرحى الإسرائيليين 1069 قتيلاً و4500 جريحاً، ومرت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلالها بعدّة اجتياحات إسرائيلية، منها عملية الدرع الواقي وأمطار الصيف والرصاص المصبوب. وهنا يقترن الزمان بالمكان.
نيويورك
المكان نيويورك، والزمان الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ، وتمثل المكيدة الأمريكية للاستيلاء على كل من العراق وأفغانستان، وإخضاع العرب والمسلمين وسلب خيراتهم.
المكتبة
مكتبة شلوميت أو سلام اليهودية وليست الصهيونية، وشلوميت هي زوجة الياس بن محمود الذي استشهد وقبره في صفورية، وشلوميت هي أم إبراهيم، والمكتبة “المكان” وما تحويه من كتب ورسومات وتعليقات تدلل على أن شلوميت اليهودية ليست صهيونية، وهي على درجة كبيرة من الوعي والإنسانية.
والرواية تختلف عن الكثير من الروايات: في الصياغة وجودة الترقيم، وندرة الأخطاء، لكنني سأسجل هنا بعض أخطائها القليلة تلافياً لتكرارها في الطباعات المستقبلية:
الأخطاء اللغوية
هناك أخطاء لغوية وفي علامات الترقيم.
وقالت نزهة أبو غوش:
عند قراءتنا للرواية نجد أنّنا نعيش مع شخصيّات الرّواية في صراع متواصل من البداية حتّى النهاية. لقد صاغ الكاتب روايته بصيغة الأنا على لسان الرّاوي إبراهيم.
الرّواية تضعنا في موقف المتسائلين من بدايتها، حتّى نهايتها:
“كيف لإنسان أن يعيش في فضاءين متعاديين طوال مراحل حياته؟ “الشخصيّة المركزيّة، إبراهيم أو (أبرام) ولد لأب عربيّ، وأمّ يهوديّة؛ الجدّة الأولى مريم والثانية مريام؛ وله أخت، عنات من طرف والدته (شلوميت).
الأولى هجّرت من قريتها صفّوريا، من قبل الاحتلال، بعد أن فقدت أهلها تحت الرّكام؛ والثانية قادمة من ألمانيا بعد أن فقدت أهلها في محرقة النّازيّة (الهولوكست). والمفارقة، أنّ مريام عاشت في بيت مريم المحتلّ.
نجد هنا أنّ الكاتب قد عرض مأساتين حقيقيّتين؛ من أجل أن يشتدّ الصّراع في الرّواية، ويتوسّع، وبالتّالي يشدّ ذهن القارئ، ويدع هناك مجالا للتّساؤل والتّفكير والحيرة.
قضى إبراهيم طفولته متألّما بين زملائه من كلا المعسكرين، فهو (يهوديّ حقير لأمّ شر… ) في المعسكر الأوّل، و(عرفي) حقير لأب عربي) وأخت يهوديّة، في المعسكر الثّاني.
لقد عكس الكاتب صورة مرّة قاتمة لحياة إنسان يعيش في هذه البيئة، بين حضارتين، وثقافتين مختلفتين سياسيّا واجتماعيّا ودينيّا.
أرى أنّ الكاتب قد أرهق تلك الشخصيّة حتّى النّخاع. كيف لإبراهيم أن يختار: الجدّة مريم صاحبة الأرض المسلوبة، والمرأة الحنونة ذات الحضن الدّافئ؛ أم تلك المرأة الرّاقية التي تعزف الألحان الجميلة، وترسم اللوحات الرّائعة، الهاربة من المحرقة العنصريّة وفي نفس الوقت محتلّة لبيت أجداده، وتعيش فوق رفاتهم؟
هل أراد الكاتب أن يضعنا في زاوية الاختيار الصّعب، ومن خلال تلك الشّخصيّة علينا أن نتعايش بين المعسكرين المتناقضين، ونتقبّل الواقع كما هو؛ كي نعيش حياتنا بسلام وطمأنينة؟ وهل نجح في تحقيق ذلك؟ وهل الحلّ السّلمي ممكن، أم مستحيل؟
عرض الرّاوي كلّ الحروب والأزمات الّتي حدثت في المنطقة: القتل والتّدمير والتفجير، والانتقامات، والسجون؛ حتّى عملية السّلام ( أوسلو) الّتي عقدت بين الطّرفين، وفشلها فيما بعد.
لم يصل الرّاوي إلى قرار: لأيّ الطّرفين ينتمي؟ وكيف عليه أن يتحمّل تقريع أخته له عندما تسيل دماء اليهوديّ؟ وكيف به أن يتقبّل سيلان دماء العربيّ؟
إنّ كلّ تلك المتناقضات قد أوقعت الراوي في أزمة نفسيّة صعبة؛ لقد اكتأب وحطّم وكسّر وصرخ، وعاتب والديه، وأنّبهما على انجابه على هذه الحياة المملوءة بكل هذه المتناقضات. وقد رفض الزّواج أيضا؛ كي لا ينجب أبناء يتعذّبون مثله.
أرى أنّ الحالة النفسيّة التي وصل إليها إبراهيم، هي نتيجة طبيعيّة لكلّ ما مرّ عليه.
كان على الكاتب هنا أن يخرج شخصيّته من أزمته، ويوصله إلى قرار يوصله لشاطئ الأمان، ويدعه أن يعيش حياة أكثر هدوءا؛ لذلك نجده قد عمل بصورة ذكيّة خلال الرّواية على أن يتّصل مع جدّته مريم بشكل متواصل، يسمعها ويتعاطف مع كلّ حرف نابع من قلبها المتألّم المقهور المتشوّق للعودة إلى صفورية؛ فنجده متعاطفا معها، وقريبا منها، يشكو لها ألمه وهمّه بكلّ أريحيّة، بعكس والده الياس، ووالدته، شلوميت، الّذي كان بعيدا عنهما؛ كما أنّه قد أوصله إلى صديق يدعى، أبو سريع، في جامعة بير زيت؛ والّذي علّمه حبّ الانتماء للوطن، وخاصّة حين استشهاده في احدى المظاهرات، فصار يشارك همّ الوطن، ويمشي في المسيرات والاحتجاجات.
لقد اختار الكاتب لشخصيّته أن يميل نحو الجدّة مريم ويحبّها أكثر من مريام؛ لأنّها تحمل قضيّة، أمّا مريام فرغم انكسارها والمحرقة الّتي قضت على كلّ أهلها وشعبها، فلم تشفع لها عنده. هنا نلحظ انحياز الكاتب؛ لأنّ عمل الكاتب الرّوائي يعكس رؤيته، وفلسفته، وقناعاته وتجاربه الذّاتيّة؛ لكنّي أرى أنّ انحيازه كان مباشرا، حيث كان بمقدوره أن يصنع حدثا مثيرا منطقيّا يضطرّ البطل على الاختيار والانحياز.
من خلال الأسلوب اللغوي الحواري، استطاع الكاتب حنيش أن يخلق صراعا لشخصيّاته، وبالتّالي انفرجت عنها الإثارة في شخصيّة مريم ومريام وإبراهيم؛ أمّا شخصيتا شلوميت وإلياس فلم تبدو عليهما الإثارة، حيث كانا رمزا للحياديّة، والاستسلام لكلّ ما يحدث، رغبة منهما للحياة بسلام ومحبّة بعيدا عن المعسكرين المتحاربين. يمكن أن نصوّر تلك العلاقة ما بين الزوجين، بأنّها علاقة إنسانيّة بحتة؛ رغم أنّ الأبناء اعتبرا أنّ هذا شيء من الإهمال لهما.
من خلال الحوار، استطاع الكاتب كميل حنيش أن يبرز الضّعف الإنساني بشكل عام. فالإنسان ضعيف مهما بلغ من القوّة، سواء في المعسكر الأوّل أو الثاني.
يقول الرّاوي في صفحة 262″ أصغي لصهيل الأزمنة في روحي، فأنعتق من أكاذيب التّاريخ، وأوهامه وأساطيره؛ وأنتمي للمكان”.
يرى الكاتب أنّ الإحساس الإنساني الوجودي، هو الأعمق من أيّ شيء آخر في هذه الحياة، ويرى أنّ الزّمن لن يموت ص244. ربّما هي فلسفة قد تبنّاها الكاتب حول الزّمن.
وكأنّي أرى بالكاتب الأسير خلال سنوات أسره، الواحد والعشرين عاما حتّى الآن؛ قد جعلته يتصالح مع الزّمن. ويتمنّى أن ينتهي هذا الصّراع بين المعسكرين.
وقالت رفيقة عثمان:
تزامنت كاتبة قراءتي حول رواية كميل أبو حنيش، مع دخوله في السّنة الواحدة والعشرين لأسره في المُعتقلات الإسرائيليّة.(15.5.2023).
في رواية “مريم مريام” اختار الكاتب حنيش عددًا من الشّخصيّات المختلفة من شخصيّات فلسطينيّة، وشخصيّات يهوديّة الأصل.
قام الكاتب بتحريك هذه الشّخصيّات؛ ليعبّر عن الفكرة الرئيسيّة الّتي دارت في خُلده.
سرد الكاتب روايته على لسان الرّاوي إبراهيم أو أبرام، وهو ابن لوالدين مختلفي الجنسيّة: الوالد ينتمي للجّنسيّة الفلسطينيّة، والوالدة تنتمي لوالدين يهوديين من المهاجرين الجُدد، بعد نجاة الجدّة من أوشفيتس. العائلة اليهوديّة تتمثّل في: مريام الجدّة من طرف الأمّ والجد آدم، أمّه تًدعى شلوميت؛ بينما العائلة الفلسطينيّة تتمثل في الجدّة مريام وزوجها محمود. شلوميت وبنتها عنات من زوج يهودي سابق، وهي متزوّجة الآن من إلياس أو أيليا؛ فأنجبا ابنهما إبراهيم بطل الرّواية.
من خلال هذ الشّخصيّات سرد كاتبنا روايته المُثقلة بالصّراعات، النفسيّة، والاجتماعيّة والسّياسيّة؛ ونجح الكاتب في تصوير هذه الصّراعات الدّاخليّة المدفونة في نفسيّة الرّاوي، والصّراعات الخارجيّة؛ النّاجمة عن الأحداث السيّاسيّة، والاجتماعيّة خلال فترة زمنيّة معيّنة منذ النكبة عام 1948 إلى ما بعد الحادي عشر من سيبتمبر أي عام (2001).
كان للمكان الحظ الأوفر في الرّواية، وبؤرة الصّراع، حيث دار الحديث حول قرية صفّوريّة المُدمّرة والمُهجّرة؛ الّتي هُجّر منها الفلسطينيّون قسرًا، وخاصّةً عائلة مريم ومحمود الّذي استشهد دفاعًا عن قرية صفورية، وعاشت مريم مع ابنها في مدينة النّاصرة، في حارة (الصّفافرة).
من المفارقة الغريبة، بأنّ جدّة إبراهيم مريام أم شلوميت ( والدة إبراهيم- أبراهام)، وابنها بنحاس المُتطرّف؛ عاشت في صفوريّة بعد أن تحوّلت إلى مستوطَنة يهوديّة تحت اسم جديد (تسيبوري)، والّتي أقيمت بنفس المكان على أنقاض قبر الشّهيد جد ابراهيم وعائلته المدفونين جماعيّا.
إنّ القارئ لرواية أبو حنيش، لا يطرأ على باله، بأن كاتبنا مُعتقل منذ قرابة العشرين عامًا لدرجة يخاله القارئ بأنّه يسرد رواية كسيرة ذاتيّة عايشها الكاتب، نظرًا للإتقان المتنهاهي في التركيب الفنّي للرواية، واستخدام اللّغة القويّة والرّصينة، والّتي حلّق الكاتب من خلالها بالتخيّل الذّاتي، أثناء أسره في المعتقلات الإسرائيليّة؛ فهذه الرّواية تمثّل نوعًا من الأدب المُقاوم (أدب السّجون) الّذي يعبّر عن التحدّي ومقاومة السّجان، والحريّة الفكريّة الّتي يتحلّى بها الأسير (الكاتب)، على الرّغم من المُضايقات الّتي يعاني منها السّجناء؛ إلّا أنها أصبحت الكتابة والتّعبيرعن الذّات، أداةً لقهر السّجّان، والحفاظ على كينونته وهويّته وطنيّته، في ظل إطار مظلم وقاسٍ.
إنّ رواية “مريم مريام” رواية تروي درامة فلسطينيّة، على غرار درامة (التغريبة الفلسطينيّة)، هذه الرّواية تُعتبر نموذجًا، لكافّة القُرى المُدمّرة والمُهجّرة منذ النّكبة؛ ووصف المُعاناة، الّتي واجهت وتواجه الإنسان الفلسطيني، والّذي يتوق للعودة لبلده، ويحمل الحنين بين ضلوعه، ويسطّر أحلامه المستقبليّة.
إنّ اختيار الكاتب للعنوان ” مريم مريام” ليس عبثيًّا، يبد بأنّ الكاتب هدف لبث الدّلالات الرّمزيّة، لما يعنيه هذا الإسم؛ وأنّ اسم مريم مُستخدم في كافّة الدّيانات: في القرآن الكريم، والإنجيل، والتّوراة. قال تعالى: “وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاكِ وطهّركِ على نساء العالمين”. “واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيّا فاتّخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا عليها روحًا تتمثّل لها بشرًا سويّا” سورة مريم 17. بينما مريم اليهوديّة هي اخت موسى وهارون، وفي الدّيانة المسيحيّة، هي القدّيسة مريم “واسم العذراء مريم، سلام لك أيّتها المُنعم عليها” بحسب الإنجيل لوقا. (ويكبيديا). إنّ اسم مريم او مريام، حمل دلالات رمزيّة؛ يث كل شخصيّة من الشّخصيّتين في الرّواية، مثّلت وطنها، فالمرأة في الأدب ترمز إلى الوطن. إنّ مريم الفلسطينيّة رمزت لفلسطين، ومريام اليهوديّة رمزت لليهوديّة؛ ووصف الكاتب صعوبة الانحياز لإحداهما؛ إلّا أنّ البطل انحاز لمريم ولوطنه، عندما شارك في الانتفاضة الثّانية، وبالمظاهرات الجامعيّة ضد الاحتلال. ذكر الكاتب صفحة 149 “عقدتي مع مريم ومريام إنّهما كانتا رمزيين لسرديتين”. رفضت مريم اتّفاقيّة أوسلو، وعرفت بأنّ العودة لصفورية مستحيلة. “اليوم أدرك أنّني لن أعود إطلاقًا إلى صفورية، لقد تهاوى الحلم الكبير”.
هل أراد الكاتب أن يرمز لنا بأنّ البشر متساوون، مهما اختلفت دياناتهم وأعراقهم.! ” الإنسانيّة ليست جينات، بل هي تاريخ، وهويّة إنسانيّة، الإنسان ليس مجرّد جبين وعرق ودين وثقافة، إنّه إنسان أوّلًا وأخيرًا”. صفحة 142. تكرّر السرد حول الانتماء الإنساني، عندما قفز عبسى أبي السريع صديق ابراهيم المُفضّل، صفحة 145 “وهتف قائلًا: “إنّ الانتماءات العرقيّة والقوميّة والطّائقيّة ليست هي الأساس، إنّها انتماءات تخيّليّة وزائفة، وتحجب الهويّة الإنسانيّة المشتركة للبشر؛ أمّا الانتماء الإنساني فهو الارتقاء بالأرض والأعمق والأكثر صدقًا، وانسجامها مع النّفس البشريّة، الّتي لا تلوّثها أوبئة الانتماءات الأخرى”. تبدو رسالة الكاتب هنا بأنّه مهما كانت رابطة القرابة والدّم قويّة؛ إلّا أنّ الانتماء للأرض والوطن يظل هو الأقوى والأهم. هذا ال (موتيف) حول فكرة الإنسانيّة تكرّرت مرارًا؛ فهي دلالات لأهميّتها في نفس الكاتب.
استطرد الرّوائي في استخدام التّناص، بكافّة أشكاله: منه الدّيني، والشّعر، والأقوال لأدباء وحكماء أجانب وعرب؛ فظهر التّناص-والاقتباس مُكثّفًا خاصّة في الفصل الأخير من الرّواية، عندما قرأ الرّاوي (ابراهيم) ما كتبته والدته بعد وفاتها، وحفظته في دفتر مذكّراتها مقتبسة أقوالًا لها علاقة بالسّلام والمساواة والعدالة. برأيي الخاص بأنّ هذا التّناص والاقتباس كانا مكثّفين ومبالغ فيهما.
اهتم الكاتب باستخدام لغة التّضاد مثلًا: ( ثنائيّة الفرح والفجيعة – الخواء والامتلاء – العدم والوجود – الغياب والحضور) كذلك عندما اكتشف إبراهيم اللّوحات الّتي رسمتها أمه؛ حيث عبّرت ومزجت بألوانها القديم والجديد -العرب واليهود – الموت مع الحياة – الحزن مع الفرح – ظلال الماضي مع إضاءات خافتة غير مطمئنة نحو المستقبل).
كل مواصفات التّضاد الواردة أعلاه بالرّواية، توحي بمدى وتيرة الصّراع النّفسي، الذي عانى منها البطل إبراهيم؛ نحو تذبذب الهويّة، والحياة المشروخة لنصفين مختلفين تمامًا، ” أشعر بفقدان الهويّة” صفحة 135؛ هذا الحال أرهق إبراهيم لحد اليأس أحيانًا.
برز الصّراع الدرامي في الرّواية، بأشكاله وأصنافه المختلفة، مثل الصّراع الدّاخلي، والصّراع الخارجي؛ من حيث الصّراع الإنساني، والاجتماعي، والصّراع على الهويّة الذّاتيّة، والصّراع النّفسي، ناهيك عن الصّراع السّياسي وهو المُسبّب الأساسي لباقي الصّراعات السّابقة. وصف الكاتب الصّراعات الذّاتيّة، الّتي خالجت نفسه، ما بين انتماء الرّاوي إبراهيم لوطنه فلسطين، وما بين المشاعر الإنسانيّة؛ الّتي رافقته طوال حياته؛ إلّا أنّ تأثير حياة الجدّة مريم، كان قويًّا جدّا، بينما معاملة الجدّة اليهوديّة مريام، كانت معاملة جيّدة أيضًا، وأحبّها؛ وكان من الصّعب الفصل بين الانتماء للوطن، والانتماء العائلي بآنٍ واحد. تلك الصّراعات الإنسانيّة، والعلاقات الأسريّة، خلقت حالة من التذبذب بالهويّة الشّخصيّة، ممّا سبّبت لدى إبراهيم؛ الاضطرابات النفسيّة، والاكتئاب، والنّقمة على الوالدين ( إلياس وشولميت). كما ورد على لسان البطل صفحة 233 ” تتكدّس في نفسي المشاعر المتصارعة، وتتنافر في رأسي آلاف الخواطر”. في صفحة 234 ذكر ” أنا بؤرة الأزمنة والتقاء الدّيانات والتّاريخ والصّراعات”، وفي صفحة 135 ” أشعر بققدان الهويّة”؛ وتمثّل الصّراع الدّاخلي كما ذكر على لسان البطل صفحة 114 ” وأنا أعجز عن حسم أمري، وأي درب أسلك للبحث عن ذاتي المُعذّبة، يا لحياتي وتعقيداتها!”. كما لاحظنا بأنّ الكاتب استخدم الحوار الذّاتي؛ للتعبير عن خلجات نفس الرّاوي، وما ينتابها من صراعات تتشكّل للوصول إلى النهاية الُمرضية الّتي يهدف إليها الكاتب.
أنهى الكاتب روايته، بأنّ البطل مثّل جسرًا للسّلام، ولم يعبره أحد، حيث لم ينجح في ربط علاقات سويّة مع أفراد أسرتيه: الفلسطينيّة، واليهوديّة؛ وهذا مؤشّر لانعدام السّلام بين الطّرفين حتّى الآن. كما أنّ الرّاوي، وصف مشاعره الحزينة بعد وفاة شلوميت والدته، عندما قرأ بعض المقالات والمُذكّرات الّتي وقعت بين يديه؛ ليتأكّد من رغبة والديه في إحلال السّلام بين الشّعبين، وأبدى البطل إبراهيم تعاطفه نحو المقالات الإنسانيّة، والّتي تُركّز على إنسانيّة الإنسان؛ لكن رسالة الكاتب كانت واضحة في نهاية سطور الرّواية، عندما زار البطل (إبراهيم) قبر جدّته مريم قائلًا: “السّلام عليكِ يا مريم.. وأنت ترقدين تحت قبّة السّماء.. لك أن تطمئِنّي.. لقد عثرت على نفسي.. ووجدت طريقي.. بعد رحلة التّيه الطّويلة… في منحي الحياة الشّاسعة. أنا ثمرة الأزمنة في هذا المكان… أصغي لصهيل الأزمنة في روحي.. ما تعتّق من أكاذيب التّاريخ”. في هذه الرّواية انتصر الرّوائي للرّواية الفلسطينيّة الحقيقيّة، ونفى روايات التّاريخ الزّائفة.
من جانب آخر انتصر الكاتب للإنسانيّة كما ورد صفحة 142 ” الإنسان ليس جينات، بل هو تاريخ وهويّة إنسانيّة، الإنسانيّة ليست مجرّد جين وعرق ودين وثقافة، إنّه إنسان أوّلًا وأخيرًا”؛ وأراد الكاتب أن يؤكّد قضيّة الانتماء، على لسان البطل أبو سريع صفحة 145 ” انّ الانتماءات العرقيّة والقوميّة والطّائفيّة ليست هي الأساس، إنّها انتماءات تخيّليّة وزائفة، وتحجب الهويّة الإنسانيّة المشتركة للبشر، أمّا الانتماء الإنساني فهو الانتماء للأرض الأعمق والأكثر صدقًا وانسجامًا مع النّفس البشريّة، الّتي لا تُلوّثها أوبئة الانتماءات الأخرى”. استشهد الكاتب بمقولة لجيفارا قائلًا: ” أينما وجد الظّلم فذاك وطني” صفحة 146.
إبراهيم الرّاوي وهو ابن لزوجين من ديانتين مختلفتين، ومن حضارتين متعاديتين؛ (فلسطينيّة ويهوديّة)، لم ينجح إبراهيم بالتوفيق بينهما خلال حياته، حاور نفسه متحسّرًا؛ لعدم استغلال هذه العلاقة في تطوير عجلة السلام بين العائلتين. “أنا لست حفيدهما المشترك فحسب، بل أنا بؤرة التقاء الأزمنة والأديان والتّاريخ والصّراعات. أنا البحر الذي لو أمكنهما عبوره لكان التّاريخ يدخل حقبة أخرى مغايرة”. صفحة 234. تساؤلات عديدة تُساور القارئ لهذه الرّواية: تُرى! هل هذه المقولة تُعتبر دلالة على رغبة الروائي أبوحنيش، بإيجاد الطريق إلى السّلام؟ أم هي مجرّد فانتازيا يسردها كااتبنا الأسير أبوحنيش؟
سرد الرّوائي روايته، بضمير الأنا، على لسان البطل إبراهيم، هذا السّرد يوحي بمصداقيته، ومدى تماهي الكاتب مع الاحداث.
تُرى هل هنالك تمازج حقيقي بين شخصيتيّ: الرّاوي إبراهيم والرّوائي الأسير كميل أبوحنيش؟
في هذه الرّواية يتفاجأ القارئ من الأحداث والشّخصيّات التي اختارها الرّوائي، بل ناقضت الأفكار النمطيّة المُتوقّعة من الأدب المُقاوم، لأسير فلسطيني محكوم عليه بالمؤبّد، فيه نمط مختلف ومُغاير لروايات الأسرى القابعين في سجون الاحتلال؛ يتمتّع الكاتب في هذه الرّواية بفكر متجدّد وجريء.
وكتب الدكتور محمد عبدالسلام كريّم:
من هي مريم/ مريام هل هما جدّتا الدم لهذا الطفل القادم من تناقض الأحلام وسيوف الإدعاءات. “أنا ابن الأزمنة بتلاقيها الساحر” كما قال ابراهيم في الصفحة 13.
إن بطاقة التعريف الفسيفسائية التي يحملها بطل الرواية تجوب بك عميقاً خارج حدود النصّ، في جمال طرحٍ أخّاذٍ يتجاوز أنّنا كنا وما نزال وسنبقى طرفاً، من الطرفين.
تناول الكاتب في روايته قرية ” صفورية” الجليلية، والتي وصفها كما لو أنّها جنة، حتى حين تحوّلت إلى خراب، فكانت روحاً حاضرة وشخصية لا تقلّ اهمية عن أي من شخصيات الرواية.
” كنت أهطل شوقاً إلى صفّورية” ص 32
أمّا الزمان فهو سنوات النكبة التي لم تنقضِ بعد، والتي عالجها الكاتب من زاويتين متقابلتين لا تلتقيان، إلا في مساحة ضيقة محرّمة كالتي وقعت لوالد بطل الرواية وأمّه. حيث تزوجا محاولين تدوير زوايا لا تدوّر، والبحث عن نقاط التقاء لا يمكن أن تقع بين جلّاد وضحية.
فمريام اليهودية الفارّة من المعتقلات النازية، في مواجهة مريم المطرودة من قريتها التي لا تبعد عنها أكثر من مسافة تحديقة بصر.
والجد محمود الذي استشهد على أرض صفّورية الشهيدة، في مواجهة الجد الضابط الذي قتله الفدائيون، في الأغوار.
والدان من دينين مختلفين وخلفية اضطهاد تناوبت فيها الضحية لتغدو سفّاحاً، وهو ما بين ألمٍ وألمٍ يبحث عن هوية.
جدة جميلة بعينين زرقاوين وأخرى بآلام السنين القاسية، وهو ضائعٌ في البحث عن هويته، بين صفورية المهدّمة، والمستوطنة التي أقيمت عليها ” تسيبوري”، وبين حيّ الصفافرة في الناصرة التي تقبع قريباً.
يتدحرج الحدث ليعلّق عيوننا على صفحات الرواية التي تمثلنا، بلغة متقنةٍ جميلةٍ معبّرة، ونحن وأبطال الرواية نعاني ” النكبة ونحن على قارعة الانتظار. ص 32.
انتابني وأنا أقرأ الرواية حزنٌ مزدوجٌ، ترافق مع كتابتي عن الفترة ذاتها في مدينة لا تبعد كثيراً عن صفورية، الآلام نفسها وجراح في مواطن أخرى. ألم الانتزاع أو الاستبدال، ألم الأمل في عودة لم تتحقق مع إمكانية تحقق شروطها الفيزيائية.
فحين يقول الكاتب ” أحتاجها لأجمع شتات روحي المبعثرة… ما قيمة المرء إن لم يعرف حكايات أهله خصوصاً إن كانت تحمل كل تلك الإثارات الرهيبة” ص 61
فهو يقف بك ليقول لهذا الأمر كتبت، وإن كنت أرى في الأمر غير ذلك.
أسرني تدفق المشاعر الهاربة منّي ومن آلاف اللاجئين لأصطدم في الطرف الآخر، بدوف، ولد سعيد في ” عائد إلى حيفا”. حاولت الهروب فاصطدمت باللا حول ولا قوة التي عشناها منذ ولادتنا.
النصّ مليء بالمعلومات التي اختارها الكاتب؛ ليبرهن عن خبرة ويفيد فيها من لا يعرف، والصور المبطّنة جميلة ولعلّي وجدت في ” استئصال رحم شلوميت” دلالة على عدم تكرار ما وقع بين معتقدين لن يلتقيا، في هذه الحياة الدنيا.
ف ” عنات كانت ثمرة لزواج، وكانت متزوجة ّباليهودي، بينما أنا كنت ثمرة لزواجها بالعربي” ص 96
وصف الكاتب الألم والصراع الذي عاشه، بطريقة اختزلها بـ “اليهود يعربونني، والعرب يهودونني وأنا لا أعرف من أنا”.
حاول الكاتب عن طريق أبي سريع، أن يوغل في الميثيولوجيا فتحدث عن الآلهة عند الكنعانيين واليهود وغيرهم، تحدّث عن تلاقح الحضارات، عن مفاهيم الوطن والطائفة والهوية والصراع وغير ذلك في حوارات (سريعة) غنية، بلغة رصينة، شطح فيها ليصف حال جدّته أمام صفّورية وقارنها بالشاعر الجاهلي حين يقف على الأطلال، ولكن من موقفين أحدهما خارج قصيدته، والآخر أسيرٌ فيها” ص 160
أتقن الكاتب القفزمن جهة إلى أخرى ومن جبهة إلى أخرى، ولا تملك وأنت تقرأ إلا أن تقفز فتكون على الغلاف وبين صفحاته، ليكون ما بينك وبين النصّ سطور طويلة إلا أنّها في غاية الاتقان والامتاع.
وقالت د.روز اليوسف شعبان:
في أسلوب شائق ولغة تفيض بالمشاعر والأحاسيس، يصوّر لنا الكاتب العلاقة المركّبة لبطل الرواية ابراهيم بين جدّتيه مريم ومريام أو بين مريمين: مريم العربية جدّته والدة أبيه ومريام اليهوديّة والدة أمّه، وهو بينهما يشعر بالضياع وفقدان الهوية والانتماء. وهو من خلال هذه العلاقة المركّبة يروي لنا كيف سقطت صفورية وانتكبت عندما احتلها الجيش الإسرائيليّ عام 1948، وكيف تشرّد أهلها وظلّوا يحلمون بالعودة إليها، وينظرون إلى سهولها من شرفات بيوتهم الجديدة في حيّ الصفافرة في الناصرة.
إلياس والد إبراهيم هو ابن الشهيد محمود الذي استشهد وهو يدافع عن بلدته صفوريّة أثناء احتلالها من قبل الجيش الإسرائيليّ، تزوّج الياس والد إبراهيم من شلوميت اليهودية التي تعيش في صفوريّة في بيت بني على أنقاض بيت أهله، ورغم هذه المفارقة الغريبة إلا أنه وقع في غرام شلوميت حين جاء إلى بيت أهلها ليصلح لهم قرميد البيت، كما وقعت شلوميت في غرامه.
كانت شلوميت امرأة مطلقة ولها ابنة اسمها شطريت، وقد عارض أهلها وأهل إلياس هذا الزواج الغريب وقاطعوهما. أمّا شطريت بنت شلوميت فعاشت مع جدّتها مريام لترعاها، وكانت والدتها تزورها مرّة في الأسبوع.
حاول ابراهيم أن يقرّب المريمين من بعضهما البعض، فهما جدّتاه وأحبّ الجدتين لكنه كان يميل لمريم العربية أكثر. لكنّه فشل في مهمته، فمريم العربية فقدت زوجها محمود في الحرب عام 1948، كما قتل كلّ أهلها وهدم بيتها، وطرد سكان صفورية من بلدتهم وانتقلوا للعيش في الناصرة في حيّ الصفافرة الذي تسمّى باسمهم.
أمّا مريام فهي ناجية من المحرقة النازية، قدمت الى إسرائيل بعد قيام الدولة وسكنت في صفورية.
تمثّل مريم العربية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي خسر وطنه وبات لاجئًا في داخل فلسطين وخارجها، أمّا مريام فتمثل الشعب اليهودي الذي يؤمن أن فلسطين أرضه التاريخية التي وعدهم بها الرب.
بين المريمين يعيش ابراهيم حالة من الضياع والتشرذم وفقدان الهوية والانتماء. يقول إبراهيم:” بدأت أشعر بالضياع منذ أن بدأ وعيي يلتقط المفردات أو المشاهد والايماءات، بقيت الأسئلة تعصف برأسي وأهمّها: ما الفرق بين اليهوديّ والعربيّ؟ لماذا يعاملني اليهود والعرب بشكل مختلف؟ في أحسن أحوالي اليهود يعرّبونني والعرب يهوّدونني وأنا لا أعرف من أنا! هكذا نشأت بطفولة معطوبة تملأها التشوّهات ويعوزها الانتساب الحقيقيّ”. ص96-.98
يتابع ابراهيم تعليمه الجامعيّ ويختار جامعة بير زيت وفيها بدأت هويته تتشكّل، خاصة بعد تعرّفه على العامل عيسى الملقّب (أبو سريع)، الذي زودّه بالكثير من المعلومات عن الشعب الفلسطيني واليهودي وتاريخ فلسطين والأسباط ومملكة يهودا ومملكة إسرائيل وغيرها. يصل ابراهيم الى استنتاج حول موقفه من المريمين وهو بذلك يشكّل هويته وانتماءه يقول:” مريم في الضمير ليس لأنها جدّتي الأحب، وإنما لأنها تلخّص قضيّة إنسانيّة، بينما مريام في القلب أحبّها لأنها جدّتي، لكنّها ليست لها أيّة قضية، لأنه ليس لها أي مكان في الضمير”.ص149.
فإبراهيم إذن رغم قناعته بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، إلا أنه رأى نفسه كما قال هو:” أنا بؤرة التقاء الأزمنة والأديان والتاريخ والصراعات، أنا الجسر الذي لو أمكنهما عبوره لكان التاريخ يدخل حقبة أخرى مغايرة”.ص234.
لكن المريمين لم تتمكنا من عبور الجسر، ولم يدخل التاريخ في حقبة أخرى مغايرة.
أمّا إبراهيم فقد انفصل عن والديه وقاطعهما واتهمهما بأنّهما السبب في حالة التشرذم والضياع التي يحياها، صحيح أنهما أصرّا على الزواج ليبنيا جسرًا من التعايش بين الشعبين، لكنّهما تقوقعا وانغلقا على نفسيهما و خسرا عائلتيهما كما خسرا أبناءهما.
بعد وفاة المريمين ووفاة والديّ إبراهيم، وجد إبراهيم نفسه يتأمل القبور ويردّد للموتى وللعالم:
السلام عليك يا مريم
لقد عصرت على نفسي
ووجدت طريقي
بعد رحلة التيه الطويلة
هنا على هذه الأرض
ظهرت أرقى الثقافات
وعبرت الامبراطوريّات
هنا مكثوا
وهنا اندثروا
أنا ابن مريم
أنا ثمرة الأزمنة في أرض السماء
صلّي لسمائك من أجلنا جميعا
في حياتنا وفي ساعة موتنا
آمين
من هذه الصلاة تتضح لنا رغبة الكاتب في العيش بمحبة وسلام وتفاهم، وهذا لن يحدث الا بعد أن يتصالح الإنسان مع نفسه ومع هويته وانتمائه.
تُعرّف الهُويّة وفق ويكبيديا؛” هي مزيج من الخصائص الاجتماعيّة والثقافيّة التي يتقاسمها الأفراد ويمكن على أساسها التميّيز بين مجموعة وأخرى، كما تُعرّف أنها مجموعة الانتماءات التي ينتمي إليها الفرد وتحدّد سلوكه أو كيفيّة إدراكه لنفسه”.
أمّا مجمع اللغة العربية فقد عرّف الهوية بأنها:” مجموعة مركّبات يقوم الانسان بواسطتها بتعريف نفسه، ويقوم الآخرون بتعريفه وفقها. تتشكّل الهويّة من مركبات موروثة ومركّبات مكتبسة، بعضها ثابت وبعضها متشكّل.( معجم المصطلحات والمفاهيم الأساسية في الإعلام، الهوية والمواطنة، تحرير مصطفى كبها، مجمع اللغة العربية، 2019، ص223).
أمّا الانتماء فقد عرّفه مجمع اللغة العربية بأنه:” شعور فرد أو مجموعة بالانتساب والمشاركة الوجدانيّة نحو عامل مكتّل كالوطن والشعب والحزب والأرض والهوية”.ص47
بناءً على هذه التعريفات نجد أن ابراهيم في بداية شبابه لم يشعر بانتسابه إلى أي شعب من الشعبين الفلسطيني واليهودي، فعامل الأرض والهوية لم يتشكّل في وجدانه، لكنّا رأينا أن هذا الوعي قد تشكل بعد التحاقه بجامعة بير زيت وتعرّفه على صديقه عيسى ومشاركته لأبناء الشعب الفلسطيني في مظاهرات يوم الأرض وإحياء النكبة.
ويبقى الوطن هو هذه الرقعة التي يشعر فيها الانسان بهويته وانتمائه
وحبّه لأشجارها وسهولها وسنابلها وزيتونها ورمّانها.
وأخيرا من وحي هذه الرواية أكتب هذه الكلمات
من أنا ؟
في غمرة ضياعي تساءلت:
من أنا؟
ما هويتي وانتمائي؟
أأنا إبراهيم بن محمود العربي الصفوريّ؟
ام أبرم بن شلوميت اليهوديّة؟
أأنا شجرة الزيتون المغروسة منذ آلاف السنين في سهول صفوريّة؟
أم ذلك اللحن الطارئ
المنبعث من بيانو جدتي مريام؟
أأنا تلك السنديانة التي تروي قصص البطولة والحنين؟
و هذه النخلة الراسخةُ
رغم عثرات السنين؟
أم ذلك الطائر الغريب
حلّق في سمائنا
يبحث عن بيت جديد؟
من أنا؟
ما هُويّتي وانتمائي؟
من أين تنبعث أحلامي؟
أتراها تلك القادمةُ في ثوب أنيق
وبشرة شقراء
وجسدٍ نحيل؟
أم تلك الراسخة في قلب السمراء
تفيض حبًّا وبهاء؟
أين أنت يا مريم؟
لقد تقت لحضنك لروايتك
لآهاتك
لمواويلك الحزينة
أبحث عنك في الظلال
بين أشجار الزيتون والسنديان
بين بقايا البيوت المهدومة
وفي جبال الجليل
وسهول صفورية
وينابيع الحنين
أتراك ستعودين؟
أم هي صلاتي ستصلك بعد حين؟
أنا إبراهيم يا جدتي مريم
بعد ضياعي جئتك لأخبرَك
أنني عثرت على ذاتي
على هويتي وانتمائي
سلامٌ عليك يا مريم
وسلامٌ عليكِ يا أرض الأحلام
والأمجاد
وسلام علينا جميعا
آمين!
ومن لبنان كتب عفيف قاووق:
يطل علينا الأديب الأسير كميل أو حنيش بروايته مريم مريام بما تحمله من إربكات وطروحات فكرية وسياسية أقل ما يقال فيها أنّها مثيرة للجدل. حاول الكاتب من خلالها التعرض لمسائل اللجوء والنكبة والحلول المقترحة، أو المتخيّلة لحل معضلة الشعب الفلسطيني، وذهب أبعد من ذلك إلى حد طرح تساؤل حول إمكانية أو قابلية التعايش المشترك بين الشعبين او بين العرب واليهود.
ينطلق الكاتب في روايته من بلدة صفُّوريّة التي تعرضت للقصف بالطائرات، وتم تهجير أهلها بالكامل، لجأ البعض منهم إلى شمال الناصرة وأقاموا في حيّ خاص بهم عرف بحي الصفافرة.
الرواية تعتمد أساسا على مريمتين مريم الفلسطينية العربية، ومريام اليهودية الأوروبية، وقد عمد الكاتب ولسبب ما إلى إبراز أوجه التشابه في العذابات والمعاناة لكل منهما، مريم العربية عاشت أحداث النكبة وشهدت على دمار بلدتها صفُّوريّة وقصفها بالطائرات وتهجير أهلها، وكذلك مريام اليهودية شهدت أحداث المحرقة وأسهبت في وصفها وما لاقاه اليهود من عمليات تصفية في معسكر أوشفيتز النازي، وكما أنّ مريم العربية قتل زوجها محمود على أيدي العصابات الصهيونية، كذلك فإن مريام فقدت زوجها آدم قتيلا في مواجهة الفدائيين الفلسطينيين، هذا التشابه ولو بشكل نسبي بين مأساة كل منهما كأن المُراد منه الولوج إلى فكرة التسامح والتلاقي، لذا كان المدخل لهذا الطرح هو الزواج الذي حصل بين إلياس ابن مريّم العربية وبين شلوميت ابنة مريام اليهودية، وكان من ثمرة هذا الزواج ولادة ابنهما ابراهيم أو أبرام. ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أنّه رغم التشابه الظاهر في ظروف هاتين المرأتين إلاّ أن هناك فرقا كبيرا بين ما انتهت إليه الأمور، فمريم العربيّة تحولت من مواطنة إلى لاجئة في بلدها غائبة حاضرة كما يقال، في حين أنّ مريام تحولت من شريدة أوروبية إلى مستوطنة ومغتصبة لبيت مريم في فلسطين.
بالعودة إلى زواج الياس وشلوميت والذي اعتبر بمثابة الحل وجسر التواصل وبداية التصالح بين الشعبين، فإنّ هذا الزواج برمزيته يشكل حلا فرديا، ولا يمكن التعويل عليه بالرغم من الإيحاءات السياسية التي حملها، لكنه أثبت عدم جدواه وعدم قابليته ليكون الحل المنشود، بدليل أنهما عاشا في عزلة تامة عن الجميع، ولم يلتفتا إلى ما يجري من تطورات سياسية، واكثر من ذلك أنجبا ابراهيم الذي عاش طفولة معطوبة تملأها التشوهات ويعوزها الإنتساب الحقيقي، وعانى طويلا من عقدة تعدد الهويات، فالبعض من أفراد أسرته بشقيَّها العربي واليهودي يعمل على تعريبه والبعض الآخر يجهد على تهويده.
لقد أبدع الكاتب في وصف المكان وخاصة بلدة صفُّوريَّة التي هي أجمل مكان في العالم، وتتربَّعُ فوق سفح جبلٍ، تلالها مكتظَّة بأشجار السَّرو والصنوبر والبلُّوط والتين والزيتون. تطالعك الناصرة من جهة الجنوب، ومن الشمال تجد ديرٌ للقدِّيسة حنَّا، وفي رأس البلدة تشمخ قرية ظاهر العمر. وكذلك عين الماء وشجرة التين العسالي والتي هي برأيي إحدى شخصيات الرواية. كما يذكرنا الكاتب ببعض ما تجود به البراري والجبال مثل الزعرور، التوت البرِّي، الزعتر، النرجس والحُميّض وغيرها من النباتات والأزهار.
تطرح الرواية فكرة الانتماء الإنساني وتقدّمُه على بقية الإنتماءات المتعددة كما قال عيسى أبو سريع:” إنّ الانتماءات العرقيَّة والدينيّة والقوميّة والطائفيّة ليست هي الاساس، إنّها انتماءات زائفة متخيَّلة وتحجب الهويّة الإنسانيَّة المشتركة للبشر، أمَّا الانتماء الإنساني فهو الانتماء الأرقى والأعمق والأكثر صدقاً وانسجاماً مع النفس البشريَّة”.
انطلاقا من هذه النظرة حول البعد الانساني وسموه، يمكن اعتبارالهوية بأنّها انتماء إنساني وأخلاقي ووجداني قبل كل شيء، أمّا الوطن فهو المسألة الثقافية والأخلاقية وهو الانحياز للهويّة الإنسانيَّة وللحب والعدل،وكما يقول تشي غيفارا “أينما وُجد الظلم فذاك موطني”.
هذه النظرة الإنسانية والدعوة إلى الانتماء الإنساني تبدو في جوهرها دعوة راقية تستحق التوقف عندها، ولكن يبقى السؤال هل يستطيع الإسرائيلي أن يرتقي إلى هذه الدعوة وأن يتخلى عن عنصريته وجبروته، ويعود إلى إنسانيته المفقودة، ويتوقف عن إقتلاع البشر والحجر من جذورهم وأيضا عن إقتلاع الشجر كما فعل بحماس عندما اقتلع شجرة التين العسالي رغبة منه في قطع كل ذكرى وأمل لمريم بهذه الأرض . الإجابة على هذا السؤال أظنها معروفة سلفا ولكن لا بد من طرحه.
وفي سعيّه لتوضيح الفكرة والعودة إلى الجذور الموحِدة فقد أحسن الكاتب في اخيار الأسماء وتوظيف معانيها في خدمة تلك الفكرة، مريم ومريام هما في الأصل واحد ويؤديان نفس المعنى الكنعاني القديم، الذي هو نتيجة زواج الإله مُر بالآلهة يّم فنشأ اسم مريم أو مريام، وأيضا إنّ اعتماد هذين الإسمين في الرواية فيه محاولة ربط غسم مريم بالتوحيد بين الديانات، من خلال الإشارة إلى مريم الممتلئة بنعمة الربّ ومباركة ثمرة بطنها يسوع الناصري، والتي خصّها القرآن الكريم بسورة من سوره. وكذلك جاء اختيار اسم ابراهيم وهو ثمرة زواج العربي من اليهودية دلالة أيضا على ان الشعبين يعودان في الأصل إلى جدّ واحد هو نبيينا إبراهيم. ناهيك عن تسمية زوجة الياس بشلوميت بمعنى السلام. كما قدمت الرواية شرحا مفصلا عن تاريخ اليهودية الصحيح وليس كما ورد في إدعاءاتهم.
قدّم لنا الكاتب بعضا من الحلول المطروحة سابقاً وحاليا لحل القضية، ومنها ما طرحته مريام على مريم بأن تعيد لها بيتها أو تمنحها التعويض الملائم، هذا الطرح أقل ما يقال فيه أنّه طرح مفخخ، وهو إشارة بشكل أو بآخر إلى ما طُرح ويُطرح في بعض المنتديات بمعنى عودة مجتزأة ومنقوصة لبعض من تم تهجيرهم، وتقطيع لأواصر النسيج الفلسطيني بحيث يعود الأصل وتمنع العودة على الفروع الذين سيبقون في أرض الشتات والمخيمات. لهذا كان رفض مريم لهذا الطرح حاسما جازماً.
واضح للجميع أنّ الرواية تتحدث عن أجيال ثلاثة، جيل مريم ومريام وجيل الياس وشلوميت وأخيرا جيل ابراهيم وعنّات.
لو أردنا التوغل في تحليل شخصيات هذه الأجيال ومن الجانب الفلسطيني تحديدا نجد ان جيل الأجداد المتمثل بالجدَّة مريّم، هو الجيل الأكثر إخلاصاً والتصاقاً بالأرض والقضية، تحدثنا الرواية كيف أن مريم جمعت ما في حوزتها من حليّ ذهبيَّة ووضعتُها في كفّ محمود، وقالت له بحسم: بِعْها واشترِ بثمنها بارودة. وهنا يبرز دور المرأة الفلسطينية المجاهدة والمُضَحيّة بكل ما تملك في سبيل العزة والكرامة، وأيضا تُبرز الرواية تعلق هذا الجيل جيل مريم بحق العودة والأمل بتحقيق هذا الحلم، لذا كان ما يشبه البروفة للعودة تمثلت في رحلة الربيع التي أقامتها مريم مع بقية النسوة للإطلالة على مشارف وتلال صفُّوريّة، وعادت من هناك بشتلة من شجرة التين العسالي لتزرعها في احواض الزرع في حي الصفافرة لتبقى الشاهد والشهيد على بقاء القضية حيّة في الوجدان. بالرغم من الفارق الكبير بين هذه الشتلة وتلك التينة، فهذه التينة هي الأصل أمّا هذه الشتلة فهي الفرع، التينة عنوان صمود لا تنفك تقاوم أمّا الشتلة فهي عنوان استسلام ولاجئة في حوض الزرع في حي الصفافرة كبقية اللاجئين.
أيضا فإن الجدّة مريّم تمتعت بمنسوب عالٍ من الوعيّ والثقافة السياسية لمدوامتها على تتبع نشرات الأخبار، وهي التي أصرّت على المشاركة في المظاهرات المنددة بالاحتلال ولم تنخدع يوما بالسلام المزعوم الذي أنتجته معاهدة أوسلو وكان تعليقها الأشد بلاغة وإيلاما: “اليوم فقط أدرك أنّي لن أعود إطلاقاً إلى صفُّوريّة؛ لقد تهاوى الحلم الكبير بعد أن أصبحت فلسطين هي الضفَّة وغزَّة فقط وهذا يعني أنَّنا بتنا خارج الحسابات.”. وكانت مؤمنة بمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وبأن بالعودة الى البلدات والبيوت تحتاج إلى حرب.
ولإثبات أحقيتها بهذه الأرض وبأن مريام مجرد طارئة ودخيلة على فلسطين جاءت من أقاصي الدنيا لتحتلَّ مكان مريم وتقيم سعادتها فوق حطامها وحطام أهلها تطلب مريم من حفيدها إبراهيم أن يسأل جدّته اليهودية مريام هل جرَّبت أن تقيم علاقة مع الطبيعة من حولها؟ هل تعرف ما ينبت في جبال القريّة؟ وهل باستطاعتها أن تسمّي نوعاً واحداً من أنواع النباتات والأشجار البريَّة؟.
وفيما يشبه إحدى سيناريوهات المفاوضات التي تصل دائما إلى الطريق المسدود، تبرز الرواية ما قام به ابراهيم من نقل رسائل تفاوضية بين جدتيّه العربية واليهودية للتوصل إلى نوع من التسامح والغفران والتعايش المشترك، وفي هذا الشأن تسأل مريم ماذا خسرت مريام بسببي لكي تسامحني أو تغفر لي ؟ ستقول لي إنّها خسرت زوجاً كان يقاتل الفدائيين الذين هجَّرهم من ديارهم؟ هل نحن من قتلنا أهلها وتسببنا في المحرقة؟ وهل هي على استعداد أن تخلي مكانها وتعيد لي بيتي مقابل التسامح والغفران؟ ليأتيها الجواب بلسان مريام معترفة بأحقية مريم بالبيت، ولكن أين سأذهب بعد ذلك؟ هل أغادر بيتي لأغدو لاجئة، وبمنطق المنتصر المتعجرف تقول إنّها الحرب، والعرب هم من اختاروا الحرب، فليتحملوا نتائجها، والمنتصر هو من يقرر مصير المهزوم.
الجيل الثاني الذي تحدثت عنه الرواية وهو جيل الأبناء وقد برزت منه فئة تدعو للتعايش والتسامح ونبذ الخلافات تمثل بكل من الياس وزوجته شلوميت، فئة يمكن القول عنها أنّها ارتضت الأمر الواقع والتطبيع الكامل، ونأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية والإيدلوجية دون أن تبذل أي مجهود او تطالب بحق.
أمّا الجيل الثالث فهو جيل الأحفاد، ومنه كان ابراهيم أو أبرام ضائعا بين انتمائين وهويتين عربية ويهودية وفي هذا إشارة ولو خفية إلى المخاطر التي تهدد الهوية الحقيقية للشعب الفلسطيني إذا ما جرى التمادي او التغاضي عن الخصوصيات الضامنة لهذه الهوية.
ختاما نقول هذه الرواية رواية سياسية وفكرية بامتياز حاولت البحث عن حل لمسألة الصراع القائم والأمل بمجيء يوم تستعاد فيه الحقوق والأرض، يوما يراه المحتل بعيدا ونراه قريباً بهمّة وسواعد الأبطال والمجاهدين