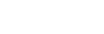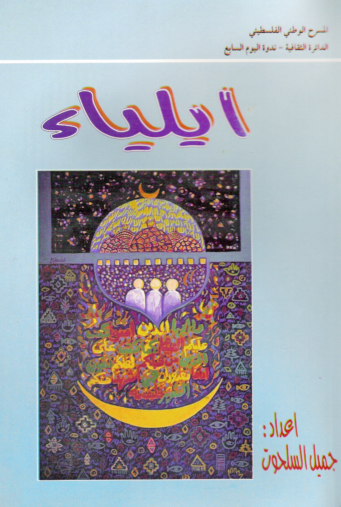القدس: 18-8-2016 من رنا القنبر: ناقشت ندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني كتاب “أسرار أبقتها القدس معي” للأديبة الفلسطينيّة الشّابة نسب أديب حسين، ويقع الكتاب الصادر عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس في 418 صفحة من الحجم المتوسّط، بتذييل للكاتبة والباحثة اللبنانيّة بيان نويهض الحوت، ولوحة غلاف رسمتها الكاتبة نفسها.
بدأ النّقاش ابراهيم جوهر فقال:
عناصر فنيّة في يوميات “نسب أديب حسين”:
عتبة النّص العنوان قبل الدّخول إلى متن العمل، وعنوان يوميات الكاتبة هنا “أسرار أبقتها القدس معي” يوحي بالعلاقة الحميمة بين القدس والكاتبة للدّرجة التي تأتمنها على أسرارها.
ثم هذا التّشويق الكامن في العنوان مما يدفع القارئ للتّعرف على هذه الأسرار. وقد تكوّنت جملة العنوان من أربع كلمات، والعدد 4 له دلالات وإيحاءات، منها:
زوايا المكان، وأضلاع البيت وعجلات السّيارة- المكان له جهاته الأربعة، والبيت له أبعاد أربعة والسيارة تسير وتنتقل حاملة الناس والأمانات في رحلة من نوع ما…
انطلقت الكاتبة من انغماسها في المكان والإنسان وتاريخ المدينة، ونظرت بعين الكاتبة إلى مستقبلها وحلمها بالكيفية التي تحب أن ترى القدس عليها.
وقد تعددت موضوعات اليوميات وتفاوت أسلوبها ، لكن الدارس يمكن أن يقف على خصائص أملتها كتابة اليومية، منها:
– السرد والإخبار بالإكثار من الأفعال.
– الوصف: للمكان والناس.
– التشبيه
– اللغة المطعمة بلغة البوح والمناجاة.
– الحوار الداخلي والخارجي والاسترجاع الفني.
– نقل أقوال المتحدثين والمتحدثات باللهجة المحكية، واختيار الجمل ذات الدلالة على المعاناة والطيبة والألم.
– الربط بين المدن والأماكن: الرامة والقدس ورام الله وبيت لحم، وغيرها.
– المزج بين التوثيق الواقعي لحياة يومية و النظرة الأدبية التي تفسّر وتعلّق وتستشرف.
– المقارنة والسؤال
– استخدام الحجة المنطقية وسيلة للرد.
– التكرار بهدف التوكيد: تكرار المشهد، وتكرار ضمير الملكية “ي”:
– الاستعانة بالبعد النفسي للّغة والموقف.
– المزج بين أساليب التعبير القصصي والخاطرة والقصيدة والتأريخ.
– إنهاء اليومية بسؤال أو تمنّ أو انتظار أو دمعة أو حيرة.
– التشويق المتحصّل من هذه العناصر جميعها وهو يقدّم القدس برؤية أخرى ويؤطّرها باللغة والعاطفة ويستخرج جمالها كما رصدته عين الكاتبة وقلمها.
– الاهتمام بالنّاس العاديين والمنسيين والمهمّشين ووضعهم في بؤرة الضوء.
– من واقع مهنتها صيدلانية تمزج الأدوية والمحاليل الكيماوية اكتسبت الكاتبة هذا الأسلوب في المزج بين مكوّنات القدس الرّوحية والاجتماعية والثّقافية والإنسانية بهذا الحب والوفاء والانتماء بعاطفة صادقة ولغة أدبية جميلة.
وقال نمر القدومي:
واقع .. وحُب .. وتحدّيات
تُشعلُ من ذاكرة الحِبر أوراقها، هي الماضي والمستقبل، هي الأحلام التي تحقّقت والتي لم تتحقّق، تكلّمت مع الهواء والتراب وذرّات الغبار، وتفاعلت بكفِّ يدها مع حجارة ورائحة المكان، وما تنفكُّ دمعتها تسيل على جدران الزّمان، وتشحن فتيل الانفجار في أعماقنا ودواخلنا. ما بين صورتكِ النّازفة وشرايينكِ الحائرة، تنام الأسرار .. تحُكُّ جلدكَ ألف رغبة، ويشنق على فمكِ السؤال، وتعيدين ترتيب الرّوح، مَن سيوقد نار الحضور ويسترجع لنا الأسوار! صوتها لا يتجاوز حلقها، وتبقى تنكمش الأديبة الفلسطينية “نسب أديب حسين” ابنة قرية “الرّامة” الجليليّة، تنكمش نحو فوّهة الزّمان خفيفة كالرّيشة لا يشبهها إلاّ صمتها، في يوميّاتها المشوّقة “أسرار أبقتها القدس معي.” لو لم يمت والدكِ وأنتِ طفلة، ماذا كنتِ ستكونين؟ فأجابت الأديبة .. هناك احتمال لأن أكون كاتبة، لكن لا أظن أني سأكون “نسب” التي هي اليوم، إنما شخصيّة أخرى وظروف مختلفة! فمن على شُرفتكِ ترقبين وتكتبين زوبعة الكلام، أثارتها خُطاهم أهل المدينة على الأرصفة والطرقات، وفي الزّقاق وتحت القناطر والقباب ، ويضربونهم هناك على مرأى عينيكِ، فيسقط العِطر من كفِّهم، والعِطر فاح أرجاء المكان؛ أحدهم يحمل جثّته ويمضي وفي يديه رصاصة قُتِل بها، تارة يبتسم وتارات أخرى يبكي، و”نسب” تُعيد ترتيب الأوجاع في يوميّاتها، فمرايا الوجوه تكثُر وبلسم الألم يتبدّد، ونموت في حضرة الحياة وعيوننا مفتوحة والقلب ينبض بهستيرية من غير العادة.
نستشعر بفرحة غامرة حين يعاودنا التّاريخ لنقرأ حركاته وحركاتنا، فرحته وإبتساماتنا، وقد نكون مضطرين غير ملومين على بعث الآلام والمآسي التي رسمتها الأيام الخوالي على وجوه أجدادنا وآبائنا، نعيشها بمرارة وشجاعة، بأمل يشوبه يأس، وحُب حياة وضراوة عيش. حضرت الأديبة وهي تواجه رهبة المكان وفيها تردّد من الغربة، إلاّ أنَّ ارتياحا فكريا وروحانيا سيطر على المشاعر والوجدان والإرادة، وإستطاعت أن تألف المستحيل في مدينة كلّها تناقضات وواقع مؤسف، لتبدأ علاقة عشق بين الإنسان والمكان. “نسب” حملت أوجاع الوطن وأوجاع سكان المدينة، فهي تمتلك حِسّا يقرّبها من أناس يحملون في دواخلهم الشيء الكثير، تتقرّب لأجل إشباع رغبات تضفي على حياتها كمالا روحانيا نستمد منه القوّة لمتابعة الحياة. فقد وضعت الأديبة نبضا للمدينة حتى تستطيع أن تشعر بها وتتجاوب مع نداءاتها السّعيدة والحزينة. جعلت “القدس” في مخيلتها كلوحة فنيّة تشكيليّة، يخترق نظرها جميع الخطوط والألوان والإنكسارات؛ ليستقر على جمالها وفقط جمالها السّماوي النقيّ حيث الوريد يتدفّق مِسكا.
كان للأديبة في يوميّاتها مع المدينة ذلك الجمال الفنيّ في الخيال وأسلوب الكتابة والبلاغات المجازيّة وسهولة اللغة، فقد سيطر المونولوج من حديث نفس ونجوى، بطريقة مؤثّرة استطاعت أن تجذبنا بدفء كلماتها وصدق مشاعرها، والتجوال يدا بيد في ثنايا الزّمن ورشفات قهوتها. “نسب” تشتاق المدينة بلوعة الأم لأطفالها، وتتذوّق كل خطوة على بلاطها وفي أسواقها، بطعم لم تشهده من قبل في حياتها. كان لها محطّتها الثّقافية عند عميد الصّحافة “أبو سلام دعنا” في كشكه التاريخيّ عند باب العمود، ومحطّة إنسانيّة عند البائعة المتجوّلة “أم طه” صاحبة اللسان المعسول. كذلك تجد الكاتبة في النّافورة في سوق أڤتيموس في البلدة القديمة محطة روحانيّة تُحاكيها، وتشكو لها أنينها، بحسب أنَّ هذه الزّاوية التّاريخية تعلم خفايا وأسرار المدينة، فلا غرابة أن تأتي “القدس” قريتها “الرّامة” وتعزّيها بوفاة عمّها الشّاعر “سميح القاسم”. إنَّ الأوضاع السّياسيّة تبقى تفرض نفسها على أهل المدينة، وبخاصة المثقّفين، الذين تصدّعت رؤيتهم المستقبليّة وخمدَ لهيب أحلامهم، في وقت لا زالت المدينة تكتم صرختها وتبحث عن فرح رقيق يختزل بعض الحزن في داخلها. أثارت الأديبة بعض المواضيع الحسّاسة وتكلّمت عنها بصراحة وجديّة. كذلك تحدّثت عن جلد الذّات في مدينة القدس وعدم إهتمام سكانها بتاريخها وحضارتها ومصالحها الأثريّة دون نظافة أو عناية، هذا بالإضافة إلى تسيّب الكثيرين من صغار السّن من المدارس من أجل العمل لصعوبة ظروف حياتهم. وصفت لنا الحرب النفسيّة في المدينة عندما تتزيّن على مدار العام لأجل إحتفالات الإحتلال وأعيادهم الكثيرة، ومحاولة إزالة الصبغة القوميّة والتّاريخيّة من أصحابها الأصليين.
حاولت “نسب” أن تبني من الكلمات في يوميّاتها عقدا ماسيّا تزيّن به جِيد المدينة المقدّسة، وتهدي سكانها نفحات من الأمل والصّبر والتّحلي بالعزيمة والقدرات لإيجاد الحياة والفرح. إنَّ عِشقها للمدينة أحدث تغييرا جذريّا في مسار حياتها العلميّة، فبعد اللقب الأول في الصّيدلة، اتجهت لدراسة اللقب الثاني في الدّراسات المقدسيّة. في إعتقادها أنَّ أهل المدينة تسيّطر عليهم نفس مضطربة وغير مستقرّة، بِيْدَ أنَّ العاطفة عند الكاتبة تشتدُّ وتهمد في ذِكر كل ما تراه عيناها؛ حدّثتنا عن الحركة الأدبية والتجاريّة، ووصفت لنا الأجواء الدّينيّة في الأقصى والقيامة، وأيضا رسمت لنا كل الحضارات التي توالت على المدينة، وذكّرتنا بأسماء الأماكن والطّرقات والأسرى والشّهداء، ومسار تسع سنوات من عمرها في زقاق وأسواق البلدة القديمة، وتغرق “نسب” في الدّموع كما السّحب المُثقّلة بالأمطار تروي وسادتها كل ليلة. إنها حفيدة “ملكي صادق” ملك يبوس إن صح لي التعبير، تتوق إلى عرشها الذي سيعود مع تحرير المدينة المقدسّة. هذه الملكة أبقت أسرارها مع أسراب حمائم لا تفارق بوابات المدينة والأسوار. أما في مسقط رأسها حيث تروي ماء الخلاصة تربة مولودها، جدّلت أديبتنا “نسب” لها وريدا نابضا يسير من قريتها “الرّامة” وجبل حيدر، صوب مدينتها الثانيّة ” القدس” وجبل المشارف.
وقال جميل السلحوت:
نسب أديب حسين، تنحدر من أسرة عريقة في قرية الرّامة الجليليّة، فهي بنت شقيق الأديب النّاقد نبيه القاسم، وابنة عمّ الشّاعر الكبير الرّاحل سميح القاسم. درست الصّيدلة في الجامعة العبريّة في القدس، وتدرس الآن في جامعة القدس للحصول على شهادة الماجستير في “دراسات مقدسيّة”.
وأديبتنا موهوبة منذ طفولتها، فقد صدرت لها رواية “الحياة الصّاخبة” وهي طالبة في المرحلة الثّانويّة، ورغم دراستها لعلم الصّيدلة، إلا أنّ ذلك لم يصرفها عن موهبتها الأدبيّة، لذا فقد شاركت ومنذ وصولها إلى القدس طلبا للعلم، في ندوة اليوم السّابع الثّقافية في المسرح الوطنيّ الفلسطينيّ في القدس، بدور فاعل ولافت، وكانت تشارك في النّقاشات الأدبيّة، وتكتب رأيها في الكتب التي ناقشتها النّدوة، وواصلت كتابتها للقصّة القصيرة، وصدرت لها مجموعتان قصصيّتان هما:
“مراوغة الجدران” و “أوراق مطر مسافر” وهاتان المجموعتان القصصيّتان لقيتا ردود فعل ايجابية من النّقّاد والمهتمّين، وواصلت كتاباتها القصصيّة، ممّا جعلها تفوز بجائزة نجاتي صدقي للقصّة القصيرة من وزارة الثّقافة الفلسطينيّة، ولتفوز في العام 2015 بجائزة “فلسطين للابداع الشّبابيّ.
ولم يتوقّف اهتمام أديبتنا الشّابة بالنّشاطات الثّقافيّة عند حدود ندوة اليوم السّابع فقط، بل تعدّتها إلى تأسيس نشاط ثقافيّ شهريّ شبابيّ آخر عام 2011، بالاشتراك مع المبدعة مروة السّيوري تحت اسم”دواة على السّور” حيث يجمعن المواهب الشّابّة، ويستمعن ويوجّهن ويرعين.
ولا يفوتنا هنا التّنويه بأنّ أديبتنا قد أسّست متحفا للتّراث الشّعبيّ الفلسطينيّ، في رواق بيتها في الرّامة، لتخليد ذكرى والدها المرحوم الدّكتور أديب حسين.
وها هي أديبتنا الرّائعة نسب أديب حسين تتحفنا باصدارها الجديد” أسرار أبقتها القدس معي” وهو عبارة عن يوميّاتها في السّنوات الثلاثة الأخيرة في القدس.
التّجريب: من المعروف أنّ الكتّاب الشّباب في غالبيّتهم، يبدأون مسيرتهم الأدبيّة مقلّدين لسابقيهم، وهناك كتّاب كثيرون كتبوا يوميّاتهم، أو شيئا من ذكرياتهم، عن أماكن بعينها، ومنهم من كتبوا يوميّاتهم عن القدس كالأديب الكبير محمود شقير والأديب ابراهيم جوهر، وبالتّأكيد فإنّ نسب أديب حسين قرأت ذلك، بل إنّها كتبت عن يوميّات الأديبين جوهر وشقير، لكنّها لم تقلّد أحدا، وقد خاضت مجال “التّجريب” لتأتينا بجديد، فالقدس تسكن روح وعقل أديبتنا قبل أن تسكن هي القدس، وهذا ليس غريبا على مدينة تاريخيّة عظيمة كالقدس العاصمة السّياسيّة، الدّينيّة، الثّقافيّة، الاقتصاديّة والحضاريّة للشّعب الفلسطينيّ ودولته العتيدة، تماما مثلما هو ليس غريبا على أديبتنا المعروفة بانتمائها لشعبها العربيّ الفلسطينيّ وقضاياه العادلة.
يقول الناقد إبراهيم فتحي: “يجعل التجريب الرّواية أكثر مرونة وحرّيّة وقدرة على التّطوّر وعلى نقد نفسها، كما يجدّد لغتها ويدخل عليها تعدّد الأصوات والانفتاح الدلاليّ والاحتكاك الحيّ بواقع متغيّر وبحاضر مفتوح النّهاية.”
ونسب أديب حسين التي تهيم عشقا بالقدس، دائمة التّجوال في حارات وأسواق وزقاق، ودور العبادة ومعالم القدس القديمة، تجوب المدينة تتمتّع بعبق تاريخها، متحسّرة على استلاب المدينة ومحاولات تزييف تاريخا، والعبث بجغرافيّتها، تراقب معالمها، وناسها، تدرس تاريخها، وتراقب حاضرها بوعي وعينان ثاقبتان لم تخطئا بوصلتهما. وفي يوميّاتها هذه كتبت رؤيتها من منظار شبابيّ مختلف، وكما يرى النّاقد المغربي محمد برادة “أنّ التّجريب لا يعني الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطيّة، ولا اقتباس وصفات وأشكال جرّبها آخرون في سياق مغاير.”
ونسب أديب حسين التي تسكنها القدس، استفادت من سكنها في القدس لما يزيد عن ثماني سنوات، خاضت التّجريب في يوميّاتها، وربّما لم تقصد ذلك، بل هذا هو ما تراه، ويعكس وعيها وموهبتها، وكما تقول الأديبة الجزائريّة شهرة بلغول:” يمكننا أن نحدّد مفهوم التّجريب في أنّه حركة واعية وموقف نقديّ من الحصيلة الثّقافيّة للأمّة، فهو ليس حركة عشوائيّة مبنيّة على الصّدفة، بل هو نتيجة حتميّة لتحوّلات الواقع وتغيّراته.”
وممّا لا شكّ أنّ يوميّات أديبتنا نسب أديب حسين تشكّل اضافة نوعيّة للرّواية الفلسطينيّة حول القدس، كما تشكّل إضافة نوعيّة للمكتبة الفلسطينيّة بشكل خاص، والعربيّة بشكل عام.
وكتب عبدالله دعيس:
ماذا همست القدس لنسب أديب حسين وهي تفتح ذراعيها لها وتحتضنها بين أضلعها المثقلة بالأحزان؟ هل ستبوح لنا نسب بهذه الأسرار التي أبقتها القدس معها، حينما وهبت نفسها لها، عاشقة نبض الحياة فيها، عازفة على وتر الفرح ليطغى على هالات الحزن التي أحاطتها منذ حطّت عليها غربان الاحتلال، وهزّتها هموم الخيانة والنكران؟ نعم، القدس تفرح، والقدس تحزن، والقدس تهمس وتتكلّم وتحتفي بأبنائها الأوفياء، وتصبر على عقوق الأشقياء، وتقف صابرة صامدة شامخة وهي تحسّ بوقع الجنود في أحشائها، وتوقن أنّهم ما هم إلا طارئ ما يلبث أن يزول كما زال كلّ من سبقهم من المحتلّين، وتبقى القدس بمحبّيها، تحدّثهم ويحدّثونها وهم يتمرّغون في نسائم قدسيّتها. القدس تتكلّم لغة لا يفهمها إلا من أحبّها، والكاتبة أحبّتها فأتقنت لغتها، وباتت تتسامر معها في حوار طويل، تبثّ كلّ منهما للأخرى شجونها، وتشاركها فرحها وهمومها.
هكذا رسمت الكاتبة نسب أديب حسين القدس لوحة جميلة خلّابة، ثمّ نفخت فيها الروح، وتوحّدت معها وراحت تناجيها وهي تسير في جنباتها، تستكشف كلّ حجر في سورها، وكلّ درب وزقاق وسوق ومسجد وكنيسة، وترتبط مع هؤلاء بطقوس قدسيّة، وتعود إليهم كلّ حين لتناجيهم ويناجونها، ثمّ يخطّ قلمها أسرارهم بلغة شاعريّة عذبة تشعّ بعاطفة المحبّة والشوق والارتباط بثرى الوطن، الذي جمعت نسب قطبيه معا حين وحّدها حبّ الرامة في أقصى الشمال بحبّ القدس قلب فلسطين، لتصبح فلسطين موحّدة في قلبها وإن فرقتها حواجز الاحتلال وأسواره، والحواجز التي بناها في نفوس أبنائها قبل ذلك. وأدركت الكاتبة أنّ “عشق المدن لا يقلّ لوعة عن العشق بين أيّ حبيبين.”
تستنطق نسب المدينة، ناسها وحجارتها، وتستخرج قصصهم التي تحكي آلامها وأفراحها، وترى في شوارع المدينة ما لا نراه مع أنّنا نذرعها صباح مساء. في كلّ ركن منها تصبح لها حكاية، وكلّ شخص يصبح مَعلما من معالمها تحاكيه وتستمع إليه؛ ليصبح جزءا من حياتها تفتقده عندما يغيب، فبائعة الخضار (أم طه) تصبح معلما من معالم المدينة تماما كما كان أبو سلام دعنا وبائع الصحف وصاحب المطعم ونادل المقهى وحارس حمّام العين. هؤلاء، كما القيامة والأقصى هم روح المدينة ولسانها الذي يبوح بما كتمته في صدرها على مدى القرون، هؤلاء هم الأصالة التي تجعل القدس راسخة مستعلية على كلّ طارئ وغريب ظنّ أنّه ملكها، ولكنّه لم يفهم يوما روحها ولم يدرك أنّ القدس لا يفهمها إلا من نبتت أجسادهم وأرواحهم من تراب هذا الوطن، وأكسبتهم شمسها سمرة جلودهم. فالجماد، في يوميات نسب، يصبح عاقلا يحسّ ويتحدّث، بينما يصبح الإنسان جمادا عندما تتبلّد مشاعره ويتنكّر لتاريخه وثقافته ويسير في فلك العدوّ.
تخطّ الكاتبة يوميّاتها وهي تتجوّل في القدس وترتاد مسارحها ومراكزها الثقافيّة أو تتّخذ مجلسا في إحدى مقاهيها. يعيش القارئ بين سطورها، تهزّه مشاعرها الجيّاشة، لكنّه ما أن يفرغ من قراءة الكتاب حتّى يكتشف أنّه تعلّم الكثير عن القدس: عن أماكنها، التي تُعرِّف الكاتبة بها وتذكر تاريخها بلغة محبّبة جذابة، وعن أحداثها على مدى عدد من السنوات. فهي تصف السور والأقصى والقيامة والمساجد والكنائس والأسواق، الأماكن التي يرتادها الزائرون والأماكن التي لا يرتادونها، بل يقودها حبّها للقدس لاستكشافها والسؤال عن تاريخها. وكما أنّها تذكر معظم الأحداث التي مرّت بها القدس خلال هذه السنوات، تذكر أسماء الشهداء وتفاعل القدس مع ما يدور في الوطن، وتعيش مع ابن الشهيد وأمّه وزوجته مشاعر الفقدان وشموخ التضحية. وتوثّق الأحداث الثقافيّة التي تزخر بها القدس، وخاصة فعاليات ندوة اليوم السابع ودواة على السّور، وتذكر أسماء العديد من الأدباء والشعراء والفنّانين، الذين ما زالوا يشعلون فتيل الثقافة في ليل المدينة.
والكاتبة تبثّ ما أودعته لها المدينة من همومها، فهي تتحسّس مشاكل الأهل بعين ناقدة وحسّ مرهف: فجدار الفصل يخنقها، والحواجز تقطّع أوصالها، وأطفالها لا يجدون مكانا للّعب أو الفرح بعيدا عن فوّهات بنادق الاحتلال وعذابات معتقلاتهم، والتجّار صامدون في دكاكينهم وقد أثقلتهم ضرائب الاحتلال وعزوف الناس عن بضائعهم. وتعدّد صنوف الإهانة والإذلال التي يعيشها أهل المدينة الذين يتعالون على جراحهم وينتصر حبّهم لها على سعيّ العدوّ لتهويدها وتهجيرهم منها، وتتساءل: (أي قدرة تحمل هذه المدينة، لتضع البلسم على جراحنا رغم نزيفها؟)
لكن، كيف ترى الكاتبة الآخر في يومياتها؟ تقول: (إنهم عابرون.. لن أسمح لهم أن يخطفوا فرحي.. ولن أقول لهم ماذا قالت لي اليوم المدينة.. فأمثالهم لا يفهمون..) الآخر هو الظلام الذي يلفّ المدينة حتّى ولو كان في وضح النّهار أو حاول أن يضيء أسوارها بالأنوار. (لأوّل مرّة أجدني أحدّق إلى النّور وأرى الظلام.) والآخر، أو أصحاب الجدائل السود، كما دأبت الكاتبة على وصفهم، يسرق الفرح من قلب المدينة، فهو يلاحق براءة الأطفال حتّى أنّه يمنع عرضا قد يدخل البهجة في نفوسهم. والآخر هو الشرطيّ والجنديّ وصاحب العمل الذي يعدّ الخطى ويتربّص بكل بارقة أمل قد تضفي شيئا من السعادة على أبناء المدينة، وهو الذي ينتهز كلّ فرصة ليزرع الفرقة بين أبناء الوطن ليبقى متحكّما بمصائرهم. وهو ليس جزءا من هذه المدينة ولا ينتمي إلى هذا الوطن، لذلك فإنّ الكاتبة تشير إليه دوما بالدخيل، وتعي أنّه لن يلبث أن يزول (فمن طبيعة الجسد أن يرفض جسما غريبا يتمّ زراعته فيه.)
ما بين عبق الماضي في البلدة القديمة في القدس، ونسائم الطبيعة الخلّابة ورائحة التراب في ظلّ أشجار الزيتون في سفوح الرّامة، تحلّق الكاتبة في ربوع الوطن وتطلّ عليه بعين عاشق وحسّ شاعر، تحاول أن تتناسى أوجاعه أحيانا لتعيش لحظات سعادة بصحبة زيتونات خلّة القصب أو نافورة سوق أفتيموس. ويعيش القارئ لهذا الكتاب البديع بكلّ مشاعره مع القدس التي حوّلتها الكاتبة بمهارة إلى كائن يحبّ ويعاتب، لكنّه يتعالى على الآلام والجراح، فيصبح قلبه مرهقا بالأوجاع، لكن هذه القلوب المرهقة هي التي ما زالت تضخّ الحياة في عروق المدينة. وتتساءل الكاتبة: (كيف تنقذ القلوب المرهقة ملامح المدن حين تذوي؟)
وقالت هدى خوجا:
لماذا يوميّات مع المدينة؟
لم تكتف الكاتبة بسكن المدينة لكنّ المدينة سكنتها، كيف حال القدس؟ يبقى السؤال معلّقا يلوح كلما عدت إلى قريتي أو اتصل أحد من الأقارب أو الأصدقاء بي، أتنهّد وأصمت إلى أن أقول” تحاول أن تكون بخير”ص”82، خطّت بقلمها أبهى العبارات، وللكلمات إيقاع منبعث، إبداع وجمال والبساطة عنوان الرّقيّ.
الهوامش والمراجع تفيد جدا طلبة العلم والدراسات العليا؛ والأبحاث في دراسات مقدسيّة.
احتوت اليوميّات على عدّة مواضيع كل موضوع يجذب أكثر؛ وله أهميّة ذات دلالة مع المدينة
ما بين دمعة وابتسامة خطّت الكلمات وجابت الطّرقات مثال ص248:
أعود وأقول لنفسي لا يجب أن يحوم الظّلام حول الفعل الثّقافي أيضا، نحتاج لأن نتأكّد أننا على قيد الحياة ” يجب أن لا نستسلم ”
تطرقت الكاتبة لبعض المشكلات الّتي تعاني منها القدس ومنها: الحصار على القدس وشحّ المردود المادي والاقتصادي، وتضييق الخناق على تجار البلدة القديمة بشكل خاص والقدس بشكل عام، والتسّرب من المدارس وقلّة الوعي، ومناقشة الوضع الاقتصادي والحراك الثّقافي الاجتماعي ،أيضا تمّن الإشارة إلى دواة على السّور ابنة ندوة اليوم السّابع، ما هو الرد على دعم خطّة الدّواة؟
زهرة بمناسبة يوم المرأة والتمنيّات بالتّوفيق !
ماذا يخفف الألم؟ ضمّة نعنع مع دعاء من أمّ طه ورشفة ثقافية مع العم أبي سلام. ولا تنسى الكاتبة الجوري للقدس ولتحظى به لا مفر أن تدمى يداك.
ما بين شجرة الخرّوب والزّيتون تتساءل الكاتبة “نسب” هل تحاول أن تصرخ المدينة، أو تبوح ما بداخلها أم تعجز أن تكون طبيعيّة.
على موعد مع المدينة والعصافير تحلّق وشعاع الشّمس على وشك الغياب.
يوميّات من القلب إلى القلب ، خطّت بعشق المدينة وقرأت من محبي المدينة.
وكتبت رفيقة عثمان:
السيرة الذَاتيَّة في حضرة القدس
ألم وأمل في حضرة القدس:
يحمل الكتاب عناوين متعدِّدة، ومختلفة، تندرج تحت عنوان يوميَّات، مع توثيق التواريخ للأحداث التي رافقت، وعاشتها كاتبتنا الشَّابَّة نسب؛ خلال فترة زمنيَّة تتراوح مدَتها ما بين السنوات 2012 ولغاية 2015.
إنَّ تصنيف النوع الأدبي لهذه النصوص، يُعتبر من السيرة الذاتيَّة، والمُذكّرات اليوميَّة المُطعَّمة بالحسِّ، ووضعتها الكاتبة في قالب أدبي شيِّق، بطريقة سرديَّة جميلة؛ بلغة فصحى سلسة، وسهلة لكَّافَّة المستويات، والأعمار، واللهجات. المحليَّة استخدام اللغة الفصحى في هذه النصوص، إلّا ما اقتضت الحاجة بما يتناسب مع لهجة أهل المدينة المقدسيَّة.
استخدمتِ الكاتبة أسلوبًا شيِّقًا، من خلال الراوي البطل هي نفسها الكاتبة، التي لامست الأحداث، والأماكن في، وأبرزتها في حلَّتها الجديدة، بوصفها الدَّقيق والجميل لهذه الأماكن التاريخيَّة؛ مستندةً على مصادر علميَّة موثَّقة بلغات مختلفة. لم تكتفِ الكاتبة بالمشاهدات العينيَّة، والجولات داخل المدينة؛ بل أعطت لهذه الأحداث مصداقيَّة، بتوثيقها من مصادر علميَّة مختلفة، هذا أقرب للبحث العلمي الأكاديمي؛ لتُعرِّف القرَّاء الغرباء، وتوسيع مداركهم حول الأماكن والاحداث التاريخيَّة التي مرَّت عبر العصور المتعاقبة، وتركت غبارها الثقيل على الجوهرة الثمينة.
تأرجح العاطفة ما بين الألم والأمل:
عبَّرتِ الكاتبة عن عواطفها بشكلٍ مباشر، وغير مباشر عن حبِّها بل عشقها للمدينة المقدَّسة، وتأرجحت عواطفها ما بين الألم والحسرة، وما بين الأمل والفرح، والابتسامة.
عكست كتابات النصوص الأدبيَّة، شخصيَّة الكاتبة الهادئة، والتي تتألَّم بصمت، وتكشف عن الجرح، والوجع بصمت، وتغار على الأماكن المُهملة داخل المدينة، ولم تحظَ باهتمام ساكنيها؛ وجعلت من الحوار الذاتي – المونولوج – اسلوبًا حواريَّا لذات الكاتبة عند مقارناتها، والمفارقات الموجودة ما بين الواقع المرير للقدس العتيقة، مع الواقع المستتب في الطرف الآخر من المدينة.
بين طيَّات الألم، سكن الأمل في روح الكاتبة، وكما كانت مصدرًا للأمل، كما عبّر عنها الكاتب إبراهيم جوهر: صفحة 254: ” قال العم إبراهيم جوهر أنَه يشعر بالأمل عندما يراني، ويرى متابعة حضوري الى ندوة اليوم السَّابع ومشاركتي فيها؛ ويرى حصاد عمل ندوة اليوم السَّابع بي، بإنتاجي الأدبي وابنة الدواة على السُّور، حفيدة اليوم السَّابع”. عبَّرت الكاتبة أيضًا عن شعورها بالأمل عند وجودها بين الأدباء والكتَّاب: “كم رغبت أن أقوم مرَّةً أخرى إلى المنصَّة؛ لأخبرهم (الأدباء والكتَّاب): كم أشعر بالأمل، وقدرة على الاستمرار والمضي قًدمًا كلَّما رأيتهم وحادثتهم.”. غمامة الحزن لم تنقشع ابدًا ” لكن وق صدر المدينة هم وحزن ثقيل، فأيُّ مطر سيروي قلوبنا العطشى لبريق أمل؟ وأيُّ مطر سيمسح هذا الحزن عن عيون مدينتنا؟”. ” قليل من النور، وكثير من الوجع”.
لم يكتنفِ الوجع من اجتياح قلب الكاتبة، بل عاشت بين وجعين وأكثر، طالت غيرتها وحزنها الوطن العربي، وبالأخص ما دار من أحداث في سوريا الحبيبة؛ كما ورد صفحة 257: عندما حدَّثتها زوجة السيِّد عماد منى سوريَّة الأصل، (عماد صاحب المقهى الثقافي الأوَّل في البلاد)، عن أوضاع أعلها بالشَّام منذ عشرة أعوام: “الشَّام لم تعد تشبه شام ذاكرته… حزن ينهض من رقدته في صدري …. وبين حين وآخر يعلو وجه حلمٍ جميل ببلد أحببته عن بعد، هو سوريا، وها هي ملامح الوجه تحترق مثلما احترقت لي أحلام كثيرة”. ” هذا الوطن يوجعني يا أمِّي” صفحة 213. عبَّرت الكاتبة عن الوجعين ما بين الرَّامة والقدس، كلاهما يسكنان روحها، وروحها تسكن في كليهما، والوجع ما بينهما لم يلتئم بعد! “تنفجر ينابيع الرامة في عيني وأنا أحثُ الخطى، أبحث عن ظلِّع وعن غياب وجهه قبل الغياب، أحد الوجعين في صدري هذا اليوم استفحل. فقد رحل سميح القاسم.” صفحة 166.
كان لندوة اليوم السَّابع، وخاصَّةً علاقتها بالأدباء المقدسيين، والمسرح الوطني الفلسطيني، أثرُ كبير على علاقة الكاتبة بهما: علاقة أدبيَّة وشخصيَّة حميمتان. تكرَّر هذا البوح في نصوص متعدِّدة؛ تتماهى مع جهودهم في إنهاض الحياة الثقافيَّة في المدينة، وهنا تحاور نفسها حو تعاطفها معهم متسائلةً: “كيف تُنقذ القلوب المُرهقة ملامح المدن حين تذوي؟” صفحة 256.
حضور الأماكن التاريخيَّة، والأثريَّة في النصوص الأدبيَّة:
حرصت الكاتبة على ذكر معظم الأماكن التي زارتها، وعرفتها في المدينة الحزينة، في الحفاظ على نظافتها، ومنحها الاهتمام الكافي؛ لصيانتها وجذب السيَّاح اليها؛ عندما وصفت باب قصر الست طنقش، كما ذكرت صفحة261: “ما أحزنني… هذا المكان يجب أن يكون سياحيًّا من الدرجة الأولى، هذا المكان جزء من التراث الإسلامي في المدينة”. كذلك بالنسبة لقلعة القدس، وأُطلق عليها اسم “قلعة داوود”، وغرها من الأماكن التي تمَّ تغيير أسمائها، وتنسيبها لغير أصحابها الأصليين.
حضور أسماء الأشخاص المقدسيين البارزين في يوميَّات الكاتبة نسب:
لم يغِب عن بال الكاتبة، استحضار أسماء الأعلام المقدسيَّة، والتي تسعى بالحفاظ على الصرح الثقافي، والحضاري لمدينة السَّلام. لا مجال لذكر كل الأسماء هنا؛ من كتَّاب، وفنَّانين، وشعراء، وممثِّلين، ورسَّامين، وآخرين اللذين تركوا بصماتهم الذهبيَّة.
الحزن والهموم على الثقافة المقدسيَّة، واللُّغة العربيَّة:
شغل بال الكاتبة مصير المسرح الوطني، ما بين إغلاقه، والبقاء عليه، وأحزنها الجهل وضياع الوطن بين أيدي الجهلاء، كما ذكرت صفحة 371: ” تحزنني هذه الجملة صديقتي المقدسيَّة لا تعرف الحكواتي وموقعه”.
لا بُدَّ للابتسامة أن تعلو على وجه المدينة، في إجراء أكبر سلسلة قراءة حول سور القدس الشريف” كما ورد صفحة 107.
خلاصة القول، نجحت كاتبتنا بأن تبوح بحزنها العميق، والألم نختلط بالأمل، وستظل الابتسامة تعلو، طالما هنالك كتَّاب وغيورون على القدس أمثال كاتبتنا الشابة نسب. هنيئا لها ولنا على هذا الإصدار الثمين، وآمل أن يتوفَّر في المدارس بين أيدي الطلاب.
وكتبت نزهة أبو غوش:
في كتابها عن أأسرار القدس، دوّنت الكاتبة نسب أديب حسين يوميّاتها في القدس الغربيّة والشّرقية، وبلدة الرّامة الجّليليّة منذ عام 2012 حتّى 2015.
نجد أنّها قد رسمت لنا خارطة واضحة المعالم عن القدس، بحاراتها وأزقّتها، وشوارعها، ومعالمها الأثريّة والدّينيّة. عن السّوق والعيادة والمقهى والمكتبة وبيوت الاصدقاء…وغيرها.
في يوميّاتها، حرصت نسب على أن تدخل طبيعة السّيّاسة بين كلّ مدينة من المدن الثّلاث : الرّامة/ القدس ؛ الشّرقيّة والقدس الغربيّة؛ لذا نجدها قد عقدت مقارنة بين الأحداث الّتي كانت تواجهها نحو: معاملة الطّفل هنا ومعاملته هناك. العلاقات بين الأشخاص. توجّه المحتلّ نحو المواطنين في المدينة الغربيّة، وتوجّهه في المدينة الشّرقيّة. توجّه الأجهزة الأمنيّة، التّفرقة العنصريّة الواضحة في كلّ شيء.
رصدت الكاتبة نسب حسين الأحداث من خلال لغة بسيطة غير معقّدة وبتلقائيّة واضحة؛ فبدت النّصوص للوهلة الأولى وكأنها ببساطتها سطحية لا عمق فيها، بينما عندما ننتهي من قراءة الأحداث نجد أن الكاتبة قد ذيّلت نصوصها بعبرة، أو تساؤل، أو فكرة تطرح بها تساؤلات تحتاج لجدل طويل، أو تطرح للقارئ تساؤلًا مبنيًّا على الاستنتاج البديهي؛ لذا فإِنّ نصوص “أسرار أبقتها القدس معي” تحمل في طيّاتها مغزى وعمقا .
احتلّت الثّقافة مساحة واضحة في يوميّات الكاتبة: ثقافة العربي في القدس الشّرقيّة، العادات والتّقاليد، المعايير، الأفراح الأتراح، المناسبات المختلفة؛ كذلك ثقافة أبناء الشّعب الدّرزي في بلدة الرّامة – بلد الكاتبة الأصلي- والّتي لا تختلف كثيرا عن باقي الشّعب العربي؛ وإِنّما أشياء قد فرضت عليهم ، ليس لها أيّ ذنب فيها ، نحو النّص الّذي ذكرت فيه بأنّ هناك من انتقد كونها درزيّة يذهب بعض أبناء شعبها للخدمة العسكريّة، مع المحتلّ؛ وهذا الشّيء لا يرضيها أبدا.
ظهرت الجوانب الانسانيّة واضحة في يوميّات الكاتبة من خلال معاملتها وتعاملها مع النّاس سواء كانوا عربًا أو غيرهم، أنّها بأحد نصوصها راحت تداعب طفلًا بريئًا بعمر سنة تقريبًا تحرّش بها، فأراد أحدهم تذكيرها بأنّ هذا الطّفل اليهوديّ سيصبح جنديًّا في المستقبل سوف يسألك عن الهويّة. فأكّدت له الكاتبة بأنّها لا تستطيع أن تتخلّى عن إنسانيّتها. هذا عدا عن المواقف الانسانيّة الكثيرة وتعاطفها مع الانسان في الشّارع والحارة وبائع الصّحف، العم عمير دعنا، وبائعة الخضار الّتي راحت تتلقّط منها الكاتبة ابتسامتها رغم كل شيء في المدينة المحتلّة، ربّما أشعرتها تلك الابتسامة بأنّ الدّنيا ما زالت بخير. علاقة الكاتبة بالعيادة، حيث عملها كصيدلانيّة ظهرت بها مدى انسانيّتها، ومدى معاناتها كإِنسانة عربيّة تعمل وسط شعب أرضخ شعبها للاحتلال والاذلال.
من خلال قراءتنا لنصوص نسب، لا نقدر إِلّا أن نتعاطف معها في كثير من المشاعر المؤثّرة، وأحيانًا توصلنا درجة ذرف دمعة ساخنة حين ذكرت والدها طبيب الأسنان الّذي فقدته وهي طفلة صغيرة، فراحت تنبش ذاكرتها حديثًا في خارج البلاد حيث دراسته، أو في مدينة القدس أيضًا. فكانت تلك الذّاكرة حزينة ومؤلمة تؤثّر بمشاعر القارئ.
رغم صغر سنّ الكاتبة نلحظ من خلال قراءتنا لنصوصها بأنها قد حملت هموم الوطن بأسره فوق كاهلها، كرجل قد تجاوز سنّ لثّمانين من عمره. حملت همّ القضّية، وهمّ القدس المدينة الأسيرة، وهمّ أطفالها وشهدائها، وعمّالها، وموظّفيها، وحواريها ومكان عبادتها. بين كلّ نصّ ونص كانت الكاتبة تذكّرنا ببلدتها الّتي تعتزّ بها كثيرًا وتفتخر بسكّانها وأقاربها ، نحو الشّاعر المرحوم سميح القاسم. بهذه الطّريقة نجد بأن الكاتبة قد صنعت عناقًا جغرافيًّا ومعنويًّا ما بين المدينتين رغم بعد المسافات.