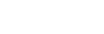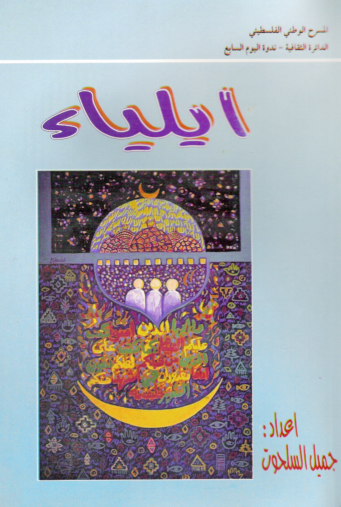القدس:2-2-2012 ناقشت ندوة اليوم السابع الأسبوعية الدورية في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، مجموعة(يوميات امرأة محاصرة) القصصية للأديبة الفلسطينية سما حسن المقيمة في قطاع غزة، والتي صدرت في الأسبوع الماضي عن منشورات دار الجندي للنشر والتوزيع-القدس في 154 صفحة من الحجم المتوسط، وتحوي 27 قصة.
بدأ النقاش جميل السلحوت فقال:
تدهشنا القاصّة الفلسطينية سما حسن مرة أخرى بمجموعتها القصصية الجديدة(يوميات امرأة محاصرة) الصادرة في أواخر كانون الثاني-يناير 2012عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس، فمجموعتها الأولى(مدينة الصمت) الصادرة عام 2008 عن منشورات أوغاريت في رام الله كانت لافتة بشكل كبير شكلا ومضمونا، وتأتي المجموعة الثانية لافتة هي الأخرى شكلا ومضمونا، فعنوان المجموعة(يوميات امرأة محاصرة)يدعو الى التفكر والتفكير، فالذي يعلم أن كاتبتنا تعيش في قطاع غزة المحاصر منذ حزيران 2006، يتبادر الى ذهنه أن الكاتبة تتحدث عن الحصار العسكري الذي يكتم أنفاس مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، وهو هنا غير مخطئ، فالحصار الإجرامي على قطاع غزة موجود هنا وهناك في بعض القصص، والغارات الجويّة والقصف الصاروخي والمدفعي وغيره من أسلحة القتل والدمار موجودة هي الأخرى، لكن الحصار الأكبر الذي تعيشه الكاتبة هو حصارها كامرأة، فهي محاصرة بدءا من اسمها الحقيقي الذي لا تستطيع البوح به، لأنها ستمنع من الكتابة الإبداعية لو فعلت ذلك، وأديبتنا هنا لا تعبر عن نفسها كإنسانة منفردة، بل هي تعبر عن مأساة بنات جنسها في مجتمعاتنا الذكورية التي تسلب المرأة إنسانيتها، وهي ليست استثناء بالطبع، وإذا ما عدنا الى الحقيقة المؤكدة بأن الكاتب يكتب شيئا من حياته أو سيرته الشخصية في إبداعاته، فسنجد أن الكاتبة هي الأخرى لها همومها المشتركة التي تتقاسمها مع بنات جنسها، وقد تأخذ المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية تحديدا خصوصية في الحصار، تزيد عن نساء البلدان الأخرى، كونها تعيش تحت احتلال يحبس أنفاسها ويحاصرها في أماكن تواجدها كافة، بما في ذلك بيتها الذي لا تستطيع أن تعيش فيه بأمن وأمان كبقية البشر. وهي محاصرة في قالب التقاليد والعادات المتخلفة، التي تجعل الأنثى في مرتبة أقل من شقيقها الذكر، فتعاني من التمييز منذ ولادتها، ويلاحقها الحصار في طفولتها المبكرة عندما تمنع من اللعب مع أقرانها الأطفال الذكور، ليأخذ الحصار أشكالا متعددة عندما تصل الى سن البلوغ، فقد يتم تزويجها ضد إرادتها، أو أن لا يكون لها رأي في اختيار الزوج، وعليها أن لا ترفض للزوج أمرا، ولا تقتصر طاعاتها للزوج فقط بل تتعداه الى أبناء أسرته كافة، خصوصا الحماة والحمى، وعليها تقع مسؤولية تربية الأبناء والعمل المنزلي، حتى وإن كانت موظفة بعمل يحتاج جهدا ووقتا أكثر مما يحتاجه عمل الزوج، أو عليها أيضا أن تعمل في حقول أسرة الزوج وغيرها بدون أجر….وهكذا. وكثير من النساء قد لا تتوافق مع الزوج، لكنها مجبرة على الرضوخ له، لأن خلاصها منه ليس سهلا، وعواقب الطلاق وخيمة في مجتمع له نظرته السلبية للمرأة المطلقة، وإذا ما تطلقت فإنها قد تحرم من حضانة أبنائها الأطفال، أو قد تحرم حتى من رؤيتهم واحتضانهم….الخ.
ويلاحظ انحياز الكاتبة لبنات جنسها من الصفحة الأولى في مجموعتها القصصية، والمتمثلة بالإهداء، حيث أهدت المجموعة الى:” روح أمّي الحبيبة الراحلة، شهيدة حصار قطاع غزة التي نسيها العالم….إلى ابنتي التي علمتني أن الحياة إرادة” وكأني بها تقول بأن معاناتي جزء من معاناة أمّي الراحلة، وأتمنى أن تغير إرادة جيل الشابات من جيل ابنتي المعادلة، وأن يتحررن من القيود التي كبلت الأمّهات والجدّات.
والقارئ لقصص سما حسن سيجد أنها امرأة تركز على حقوق المرأة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، فدائما ما نجد الجدّات والأجداد الذين يحدثون أحفادهم بشكل دائم عن أيّام العزّ في الديار التي تمّ تشريدهم منها، وهذا هو سبب حياة الذلّ والهوان الذي يعيشونه في مخيمات اللجوء، وهي تركز أيضا على حق شعبها في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعد التحرر من الاحتلال وكافة مخلفاته.
وسما حسن التي تملك موهبة القصّ الجميل، تملك لغة أدبية انسيابية، وأسلوبا مشوقا تحلق من خلاله في عالم القصّ الذي يجذب القارئ، لا تطرح أهداف قصتها بشكل مباشر، لأنها تعي جيدا أن ذلك بعيد عن الإبداع الأدبي، ولا يلقى قبولا عند المتلقي، لذا فهي تطرح المشكلة أو الحدث بطريقة فنية، فتسيطر على عاطفة القارئ، وتترك لذكائه فَهْْمَ ما بين السطور، وهذا هو الإبداع.
ولعل قصتها “الزوجة الثانية“ص13 تشي لنا بقدرتها على الفنّ القصصي، والزوجة الثانية”الضّرّة” هنا هي الصحيفة اليومية، المشترك زوجها فيها وتصله يوميا الى البيت، تثير حفيظة الزوجة التي ترى فيها ضرّتها، والقارئ لهذه القصة يتخطى أكثر من نصف القصّة وهو يحسب أن للزوجة ضرّة حقيقية، ليكتشف أن الحديث عن صحيفة تشغل الزوج الناشط سياسيا عن زوجته، وكأنّي بالقاصّة هنا تلفت انتباه الأزواج الذين تشغلهم أعمالهم واهتماماتهم عن بيوتهم، فلا ينتبهون لاحتياجات الزوجة والأبناء.
وفي قصّة“لا” التي تتصدر قصص المجموعة، نجد عبوديّة المرأة في مجتمعاتنا، هذه العبوديّة التي لا تسمح للمرأة بأن تقول”لا” التي هي أقصر الكلمات في لغتنا حسب تعبير الكاتبة، فهي تتمنى قولها، لكنها غير قادرة على فعل ذلك.
فالزوجة تبدأ يومها”تهرع الى الحمّام المصبوب بالإسمنت الرخيص، وتقف في”الطشت”، ثمّ تصب الماء فوق رأسها ثلاثا لتزيل بقايا زوجها عن جسدها، وتهرع لتعجن، وتخبز، وتعد الطعام للعائلة الكبيرة، حيث يذهبون للحقل القريب الذي يملكه والد زوجها، يظلون في عمل لا ينقطع، وهذا وهذه وتلك، لا يعرفون هتافا إلا باسمها:هاتي تعالي، احملي، ارفعي.” ص8
وبعد كل هذا فان”زوجها لا يرحمها، يوقع برجولته على جسدها المنهك كلّ ليلة، يكون متعبا أكثر منها” ص9 وهو” لا يتوقف عن ممارسة هذا العمل حتى مع بداية حملها” ص9
ولا يجد لها عذرا “لا شيء يمنعني من حقي، حتى لو كان القادم فارسا سيحرر فلسطين”ص9. وهي لا تملك أن تقول”لا” مما جعلها تتيقن”أن جسدها ليس ملكا لها، مثل يديها، هما ملك لتلك العائلة التي لا تعرف منها سوى يدين ورحم”ص12 وهذه ذروة المأساة حيث التعامل مع المرأة كيَدٍ عاملة ولتفريغ شهوات الزوج وللإنجاب.
وفي قصة”حلم واحد” تتجلى مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة والمآسي التي تصاحبه، فالأسرة المكونة من الجدة الأرملة، التي مات زوجها وهو يحلم بالعودة الى قريته وبيته، تاركا إياها مع ابن طفل لا يلبث أن يكبر، ويتزوج ويخلف إبنا لا يلبث هو الآخر أن يسقط شهيدا تاركا أرملة حاملا بطفل بعد زواجها بأربعة شهور، وتعيش الأسرة حياة الفقر والعوز، وعندما تذهب الكنّة لاستلام مخصصات الأسرة من وكالة غوث اللاجئين، يخبرها الموظف بأن”موعد تسلمكِ لمخصصاتكم بعد ثلاثة أيام، أي في اليوم الأول من العام الجديد”فتعود خائبة، وفي هذه الأثناء يشتري ابنها الطفل قطعة حلوى بنصف شاقل” منحته إياه جارتهم الثرية وهي تعرج على جدته لتطلب منها أن تلقط”الخوفة”لطفلها الرضيع”ص20، ملفوفة بصورة المائة دولار، فيحسبها عملة حقيقية، ويطير بها فرحا الى جدته، التي فرحت بها هي الأخرى معتقدة أن حفيدها عثر عليها في الطريق”فحدثت نفسها:ستكون مفاجأة لزوجة ابني، سوف أعطيها لها، وستكون حتما كافية لشراء أنبوبة غاز من تلك الأنابيب التي تسمع أنه يتم تهريبها عبر الأنفاق الى غزة التي أصبحت تمتلئ بيوتها برائحة الكاز والكيروسين”ص20. ولمّا أعطت الجدّة ورقة الحلوى لكنتها أمّ بلال”حملقت بها قليلا، ثمّ سرعان ما ضحكت ضحكة مريرة: هاي يا عمتي ورقة مزيفة من اللي بيحطوهم في حلوى الأطفال”ص25، غير أن الطفل الذي كان يحلم بتحقيق حلم جدته وأمّه بشراء أنبوبة غاز، لم يصدق أنها زائفة، وبقي مصرا على رأيه” والتحف الصغير فراشه ويده تطبق على الورقة، وبدأ يحاول النوم وهو يتخيل أنبوبة الغاز التي سيشتريها”ص25، ونامت الأسرة الصغيرة لتصحو على أصوات انفجارات تهز البيت” ولكن في لحظات لم يبق للبيت أي أثر. في الصباح وحين كان رجال الإسعاف يبحثون بين الأنقاض، عثروا على الكثير من الأشلاء الآدميّة المتناثرة، ومن بين الأشلاء عثروا على كفّ صغيرة لطفل صغير، ولكنها كانت مطبقة بقوّة على ورقة تبدو من بعيد كأنها..مائة دولار”ص26.
وسأكتفي بهذه النماذج القصصية الثلاثة، مع التأكيد على أن كل قصة في المجموعة تحمل حدثا داميا للقلوب وللأجساد، نابعا من معاناة شعبنا.
ويلاحظ أن سما حسن في مجموعتها القصصية هذه، وكما في مجموعتها الأولى”مدينة الصمت” تميل الى عدم ذكر أسماء أبطال قصصها، فهي إمّا تتكلم بلغة الأنا، أو بضمير الغائب، لتكون القصة أكثر حميمية، وأكثر شمولا، فأحداثها لا تقتصر على شخص بعينه.
يبقى أن نقول بأن سما حسن تثبت نفسها على ساحتنا الأدبية كقاصّة متميزة رغم كل معاناتها، ولربما تكون معاناتها سببا من أسباب أبداعها، فالإبداع قد يولد من رحم المعاناة.
وقالت نزهة أبو غوش:
نجحت الكاتبة سما حسن باختيارعنوان كتابها ” يوميّات امرأَة محاصرة”؛ لأَنّها فعلا إنسانة محاصرة، نفسيًّا، واجتماعيًّا، وأَمنيًّا، فجاء حصارها، حصارًا يغلّفه حصار داخل حصار داخل حصار.حصارها كأُنثى أوّلا من قبل المجتمع ككل، والرّجل بشكل خاص، لم تستطع الكاتبة سما أَن تفُكّ ولو جزءًا قليلا من حصارها، بل أَحكمت هذا الحصار على نفسها، فاختارت لنفسها اسمًا مستعارًا. أَمّا الحصار الثّاني، فهو حصار المجتمع الّذي يغلّفها بقوانينه ومعتقداته، ومعاييره الاجتماعيّة، والحصار الثّالث هو حصار كونها امرأة مهاجرة، وليست مواطنة أصليّة في المدينة، والحصار الأكبر هو حصار المحتل الّذي يجثم فوق قطاع غزّة والمدينة الّتي تقطنها.
قبل قراءَتي المجموعة القصصيّة توقّعت أَن تحطِّم الكاتبة سما في قصصها كلّ الدُّنيا، وتلعن التّقاليد والأعراف البالية الّتي يتمسّك بها المجتمع، توقّعت أن تتحدّى سلطة الرّجل عليها وجبروته، أَن تنقد الوضع السِّياسي المدمّر، والانقسام الفلسطيني البشع، وتلعن الاحتلال الجاثم على المدينة، وتتحدّاه بكلّ قوّتها، لكنّها لم تستغلْ من إخفاء اسمها هذه الامكانيّات، لكنّ الكاتبة استطاعت أَن تربط بين قصصها ال27 بمواضيع مشتركة تعبرّ بها عن آلام المرأَة في مجتمع اعتبرها من الدّرجة الأخيرة فيه، وموضوع آخر هو الإِنسان الفلسطيني المهجّر عن أَرضه.
من يقرأْ قصص الكاتبة سما حسن، يجد بها متعة وتشويقا، حيث تجذبك القصّة بأُسلوبها السّردي، وعباراتها الليّنة السّلسة، وتشعر بأَنّ القصّة واقعيّة بدرجة كبيرة؛ لأَنّها تصف واقعًا مرّا موجودًا على أَرض الواقع,
نجحت الكاتبة سما حسن في وصف الأحداث، والصُّور، والمشاعر بمعظم القصص، فكانت قضيّة الوصف هي القضيّة البارزة للمجموعة. وصف الطّالبة اللاجئة الّتي تشعر بالدّونية عن صديقاتها، استخدام الأمتعة والملابس المستعملة الّتي توزِّعها الأونروا، حتّى الكتب المدررسيّة المتّسخة والبالية، كذلك معاملة اللاجيء من قبل المعلّمين والمدراء، ” وأَذكر السؤال الثّاني الّذي سألني إِيّاه المعلم:
” هل أَنت مواطن أَم لاجيء؟”
ولمّا لم أَعرف الإِجابة، فقد سأَلني بسخرية:
” يعني يا شاطر..أُمّك بتروح على مركز التّموين وبتجيب سكّر وطحين ورز كل شهر والا لأ؟”
رددت بأن هززت رأسي للأَسفل، وتركت المعلم يسجِّل باقي البيانات.” الكتاب ص52″
الرّجل في قصص الكاتبة بدا في أَغلب الأحيان رجلا سلبيًّا جِدّا فهو متسلِّط، لا يأخذ برأي المرأة ولا يحسب لها أيّ حساب، حتّى في حقّها معارضته في ممارسة العلاقة معه، وقد بدا ذلك واضحًا في قصّة “لا” تلك الكلمة الصّغيرة جدّا الّتي لم تقدر على أن تقولها حتّى بينها وبين نفسها. بدا الرّجل أَيضًا إِنسانًا غدّارًا كما ظهر في قصّة” جلباب أَبي”و قصّة الوهم، حيث استغلّ الزّوج زوجته الكاتبة، المتعلمة طوال حياتهـا لتكتشف بعد وفاته من خلال دفتر يوميّاته بأَنّه كان يستهزئ بها وبتضحياتها من أَجله:
” أَخذت تقرأُ بعينين هلعتين سيلا من المبالغ الّتي حصل عليها زوجها منها بدون علمها…والأكثر مرارة كانت تقرأ الصِّفات التي ينعتها بها منها، مثلا: السّاذجة، والعبيطة، والسِّت الأديبة المغرورة” -الوهم ص 106-
في قصّة كاتبة مغمورة بدا غدر الرّجل بصورة أُخرى، حين دعاها لحفل كبير باعتبارها كاتبة مهمّة، وهناك تكتشف بأنّه يقيم حفلا سمّاه ” ندوة حول الكتّاب الفاشلين”
بدا الرّجل أَيضًا بصورة الإِنسان المرعب الّذي يصفع زوجته، ويضربها دون أَيّ اكتراث” ” أَصبحت أَخافه، أَخشاه، وأخشى أَن أَبقى معه بين جدران أَربعة. لقد رأيت حين ضربني وحشًا لا أَعرفه، وحشًا كان يستطيع أن يقتلني” – يا قلب لا تغفر ص 109- كما كان الرّجل مخيفًا ذا ردّة أَفعال مرعبة، حتى نتيجة لحدوث الأشياء العاديّة الّتي تحصل دائمًا، مثل وقوع طفلته على الأرض واتّساخ ملابسها، وزيارتها لبيت صديقه لكي تنظّف زوجته ملابس الأمّ والطّفلة، خوفها اضطّرّها لأن تكذب عليه – قصّة، كذبة نيسان- ص93
بدا الرّجل أيضًا بصورة الغبيّ، والعبيط، والعاطل عن العمل ينتظر أن تصرف زوجته عليه، كما في قصّة” اللعبة”. من خلال هذه الصُّور السّلبية الّتي وصفت بها الكاتبة الرّجل، يمكننا – ربّما – أَن نجد لها مبرّرًا لاختيارها اسمًا مستعارًا بدل اسمها الحقيقي.
يمكنني القول أَخيرًا بمدى قدرة الكاتبة على التّعبير اللغوي، واستخدام السُّخرية الأدبيّة، وإِظهار المفارقات في حياتنا، مثل قصّة ” علبة سكر”، حين ماتت الجدّة بسبب ارتفاع نسبة السُّكر في دمها، بينما تخلو علبتها من أَيّ ذرّة للسّكر. – علبة سكّر ص43-
أَرى أَن المباشرة، والسطحيّة غلبت على القصص، وقد خلت تمامًا من الرّمزيّة، ولوكان فيها القليل من العمق الفلسفي، لاكتمل إبداع الكاتبة .
وقال رفعت زيتون:
كان يكفيني ان أقرأ آخر خمس صفحات من المجموعة القصصية لأرى اللوحة كاملة بكل أو بأغلب ألوانها وأبعادها وظلالها التي أرادتها الكاتبة .
هذه الصفحات الخمس الأخيرة احتوت على ثلاث قصص قصيرة، وضعتها الكاتبة تحت عنوان واحد هو (من يوميات امرأة محاصرة في غزة) لخصت حالة الحصار هذه التي أرادتها الكاتبة حصارا ليس على إنسان قطاع غزة عموما، ولكن حصارا على نساء غزة خاصة، ففي القصة الأولى كانت البطلة هي تلميذة في مدرسة، تقوم بالدراسة ليلا على ضوء الشموع، وانتهى بها الحال إلى العمى، وفي القصة الثانية من ذات المجموعة، تحدثت عن الأمّ وكيف أن الحصار أودى بحياتها، ممّا أدخل الألم الى قلب ابنتها، ولازمها طوال حياتها، وفي القصة الثالثة من المجموعة ذاتها تحدثت عن سيدة وأطفالها، وكيف تحول انقطاع الكهرباء إلى معاناة يومية حتى في حضورها.
في هذه القصص الثلاث كما في كثير من القصص الأخرى، غيبت الكاتبة الرجل الغزيّ عن حالة الحصار، وكأنه كان خارجه يعيش في بحبوحة من العيش الرغيد، وربما تفهمنا بعض هذه القصص تجاوزا لتحدثها عن حالة خاصة من الحصار، وهي أثر الحصار على نساء غزة خاصة، ولكن ما لا يمكن أن نتفهمه، ولا يوجد له مبرر، ولا أساس هو جعل الرجل الغزيّ جزءا من هذا الحصار، بل ومكملا له. فالاحتلال يبدأ الحصار اقتصاديا وسياسيا، ليأتي بعد ذلك الرجل الغزيّ ليقوم بمهمة الحصار الجسدي والنفسي على المرأة. وهذا ظلم للرجل الغزيّ المناضل والشهيد والجريح، وفيه كل البعد عن الواقع والموضوعية، حتى في حالة خيانة الزوجة لزوجها حاولت أن تجد لها المبرر، وأن ترجع السبب لزوجها، وأكملت الصورة السيئة للرجل بأن جعلت الإبن وحشا ينهش جسد النساء انتقاما، فهل هذه هي الصورة الحقيقية لرجل غزة التي تريد الكاتبة أن تنقلها للعالم؟
لا أنكر أن الكاتبة قد تعرضت لكثير من القضايا التي يعيشها الغزيّ في حالة الحصار، كقضية اللاجئين ومعاناتهم، وقضية الممارسات السيئة ضد الأطفال، كما جاء في قصة (باب مغلق) وهذا يُحسب لها، ولو أنها جاءت بلغة بسيطة تكاد تخلو من الصور والتراكيب الإبداعية .
وبعيدا عن الاختلاف أو الاتفاق مع الكاتبة على طبيعة هذا الحصار، ومن هم ضحاياه؟ وما هي أسبابه؟ ومن هم مسببوه؟ فأقول للموضوعية أنها في بعض القصص كنت قاصة متمكنة من أدوات الكتابة القصصية بلغة جميلة،- رغم بساطتها- ونجحت في تشويق القارئ في بعض القصص، وجعلت القارئ يخرج زفرات الحزن عند قراءتها، كتلك القصة التي تحدثت عن الطفل والمئة دولار المزيفة، ونجحت كذلك بإخراج الضحكة تارة أخرى في قصص كقصة ( الزوجة الثانية) وقصة (بالجملة).
كان هناك بعض الخطأ المطبعي والنحوي، ولم يكن بالكثير.
وقد وجدت في بعض القصص إطالة لا داعي لها، ووددت لو أنها أنهت القصة في موقف سابق يصلح أكثر لختم القصة.
وكان هناك بعض التكرار للأفكار والجمل في بعض القصص، كما في قصتها الأولى (لا) وهذا يضعف المبنى العام للقصة.
وقال طارق السيد:
*يوما بعد يوم ،أتحول إلى امرأة محاصرة، خصوصا حين أخرج إلى السوق وأجد أحد السائقين يسكب زجاجة من زيت الطبخ الذي سبق استخدامه في داخل صهريج السيارة المعد للبنزين أصلا، وحين أستقل السيارة فأنا أختنق برائحة الزيت الكريه المنبعثة من مقدمة السيارة، وحين، أصل المكان المقصود يهتف السائق ممازحا (اللي انقلي ينزل)
مجموعة قصصية للكاتبة (سما حسن) تحمل عنوان(يوميات امرأة محاصرة) لفت انتباهي اسم الكاتبة الذي اختلط للوهلة الأولى مع عنوان المجموعة، لمساواته في الحجم والقرب في المساحة، وتقدم اسم الكاتبة على اسم المجموعة.
لوحة الغلاف للفنان البلجيكي ( بين جوسينز) الذي يظهر من خلال لوحته امرأة أوربية متقوقعة في عالم حلزوني يطل على نافذة في فن سريالي …المرأة الأوربية ذات الثوب الريفي الأوربي الذي يعود إلى القرون الوسطى، لا يمد بصلة إلى حصار امرأة عربية في قطاع غزة في الوقت الحالي …
أمّا بالنسبة للقصص المتنوعة التي غاصت الكاتبة في سردها/ فيبدو عليها الوضوح سواء في المعاني أو المصطلحات، والبعد عن أيّ إيحاء به لغز على الرغم من جمال الأفكار، التي أظهرت شريحة اللاجئين في قطاع غزة وسط الفقر الشديد، وتطرقت إلى أهم ما يتعرض إليه أللاجئ في صراعه مع الحياة.
وكان ذلك واضحا من خلال الأمثلة التالية:
(هل أنت مواطن أم لاجئ ؟) ص 52 السطر الخامس، كلمة لاجئ والخجل من الإجابة بالتعريف بهذه الكلمة …والعجوز البقال في نفس القصة الذي يبيع العدس الرديء للناس، والذي يحصل عليه من (الأونروا ) والأصل أن يوزع مجانا …
قضية اللون الأزرق الذي سبب للأطفال نوعا من الاكتئاب، وكأنهم يعيشون في دولة حدودها وراياتها زرقاء.
أمّا بالنسبة للون الدرامي الاجتماعي فإنه يظهر بوضوح في قصة ..علبة سكر..وقصة هنئوني أنا لاجئة …..وتعمقت المأساة في قصة حلم واحد.
القضية الأساسية التي غلبت على طابع القصص شخصية المرأة الفلسطينية المضطهدة سواء في الفراش كما في قصة (لا) أو اضطهاد سياسي كما في اللوحات التي وردت تحت عنوان (من يوميات امرأة محاصرة في غزة).
أو حتى اضطهاد عاطفي كما مرّ في (يا قلب لا تغفر)، ونجد شخصية المستغل في عالم المخيم في (عبيط المخيم) .
*الأسلوب في معظم القصص سردي وأقرب إلى أسلوب تلقين مادة أدبية على الرغم من جمال الأفكار، والقدرة في جذب القارئ من خلال بساطة المعاني وسلاستها، واستخدام بعض الألفاظ الغزيّة كما في قصة (نوع آخر)، الاستعارات والتشبيهات تكاد تكون شبه معدومة، حتى الألوان البديعية لم تستخدم في القصص، ووقعت الكاتبة في الفخ السردي المباشر، ولم تلتفت لتخصيص وجبة دسمة من لوحات وصور فنية .
النهاية في القصص كانت من نصيب الكاتبة، وكانت تختار النهاية بنفسها وكنت أتمنى لو تركت الكاتبة قصة ليغلقها القارئ بخياله.
وبعد ذلك جرى نقاش حول المجموعة، وقد اعتبر ابراهيم جوهر هذه المجموعة تراجعا في فنية القصّ عندما سما حسن، قياسا بمجموعتها الأولى(مدينة الصمت).