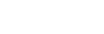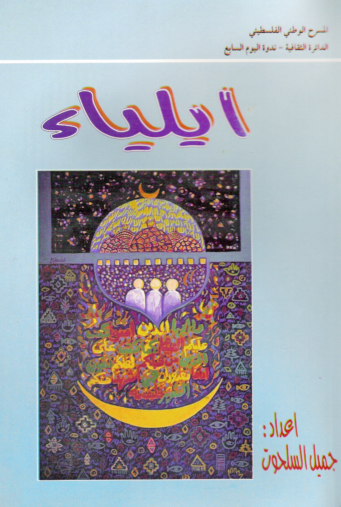القدس:1-8-2019 ناقشت ندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس رواية “كرنفال المدينة” للكاتبة المقدسيّة نزهة الرّملاوي. وتقع الرّواية الصّادرة عام 2019 عن دار الجندي للنّشر والتّوزيع في القدس في 223 صفحة من الحجم المتوسّط.
افتتحت الأمسية ديمة جمعة السمان فقالت:
النّصّ عبارة عن نسيج من لوحات أدبية متقنة وصفت واقع مدينة القدس المرير، ونقلت آهات مجتمعها الذي يعيش في حصار خنق أحلامهم، جعلهم يعيشون في حالة مستمرّة من التوتر والقلق، بعيدا عن الاستقرار. انتهاكات لا إنسانية يتفنّن بها الاحتلال الإسرائيلي، تضرب على أوتار أعصاب مشدودة، تنذر بخطر آت، فما عاد للصّبر مكان.
لوحات فنّيّة صنعت من كلمات، أطربتني شاعريتها، حروفها منتقاة، وصفها متقن من أجمل ما يكون.
لم تترك الكاتبة لا شاردة ولا واردة في القدس إلا وعرجت عليها، سجّلت الأحداث بدقة، كانت راويا أمينا، شعرت بمسؤولية الكاتب ودوره في نقل المعلومة التي يترفع عنها التاريخ في تسجيلاته.
ولكن حجم المعلومات كان كبيرا جدا، ضاقت به الرواية. تحدثت الكاتبة عن الجدار والحواجز والشّهداء والجرحى والأسرى وهدم البيوت والتعليم وأسرلة المناهج، وتغيير الاحتلال لأسماء المدارس التي تحمل أسماء مناضلين، وتطرقت إلى أساليب إسقاط كلّ من تسوّل له نفسه التّصدي للاحتلال، ووصفت أساليب التحقيق معهم في المعتقلات الإسرائيلية، وعرجت على ظاهرة بيع العقارات للاحتلال أو الاستيلاء عليها، وتحدثت عن البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك، ولم تنس القطار الخفيف الذي بنيت سكّته على أراض مصادرة، يربط بين المستوطنات ليسهل حركة التنقل بينها، وغيرها من ممارسات يومية للاحتلال ينكّل بسكانها الفلسطينيين الأصليين.
هذا الكمّ الهائل من المعلومات اضطر الكاتبة إلى ابتداع بعض “شخوص” في الرواية، أهملت رسم ملامحها، ولم تغص في أعماقها، ولم تعطها حقها، فلم تكن أكثر من أدوات “مؤقتة” لتمرير أحداث تريد الكاتبة زجّها في الرواية، وهذا ما يلاحظه القارىء بوضوح، ممّا يشعره أنّ همّ الكاتبة كان سرد المعلومات لا غير، وقد كان على حساب البناء الروائي.
كما أن الكاتبة اصطحبتنا أيضا في جولة سياحية طويلة، عرفتنا خلالها على الشوارع والحواري داخل بلدة القدس القديمة وخارجها، وقصدت أن تذكر أسماءها، ممّا يسجل لصالح الكاتبة التي كان هدفها تخليد أسماء المناطق التي يسعى الاحتلال إلى استبدالها بأخرى تدعم روايته المزوّرة. ولكن حتى هذا، جاء على حساب البناء الروائي. إذ أنها بالغت في تكثيف ذكر الأماكن. وأستطيع بكل ثقة أن أجزم أن ما ذكرته من حقائق موجعة، ومن تسمية أماكن، تستطيع الكاتبة تقسيمه على خمس روايات، لو أن الكاتبة راعت إعطاء الرواية حقها فنيا.
أتساءل هنا، أين الحبكة في الرواية؟ أين عنصر التشويق؟ وهل تنجح الرواية دون حبكة؟
” كرنفال المدينة” عبارة عن قطع فنية خامتها فخمة، وألوانها أصيلة، ولكن الكاتبة لم تحسن الربط بينها من جهة، ومن جهة أخرى يا حبذا لو أن الكاتبة استعانت بمدقق لغوي لتجنب الأخطاء اللغوية التي انتشرت في الرواية، ومع كل هذه الملاحظات، أنصح باقتناء رواية “كرنفال المدينة” لكل من يريد أن يتعرف على حياة المواطن المقدسي. فالرواية عبارة عن ملف كامل عنوانه معاناة المواطن المقدسي.
مع التأكيد أنّ أيّ عمل أدبي يكتب عن القدس، يعتبر إضافة للمكتبة العربية.
وقال سامي قرّة:
لا أريد أن أعطي رواية كرنفال المدينة أكثر ممّا تستحق، فهي رواية لا تقدّم الكثير من حيث المضمون، تتحدث عن حياة المخيم، وصعوبات التنقل والحركة، وعزل القدس، والقيمة الدينية والروحية للمدينة المقدسة، كما تقدم وصفا لأحياء المدينة وأزقتها ومساجدها وكنائسها، وهذه كلها مواضيع أصبحت بمثابة كليشيهات يُفرط المؤلفون الفلسطينيون في استخدامها، ولا تشير إلى فكر أصيل مبدع أو فكر يتسم بسعة الخيال. وتكاد الرواية تخلو من الحبكة المقنعة أو من الأحداث المتسلسلة التي تزداد في حدتها مع استمرارها على الرغم من قيام الشخصيات بأنشطة مختلفة. كما أن ظهور الشخصيات في الرواية يحدث فجأة، باستثناء شخصية ربحي وتامر في بداية الرواية، وكأنها تخرج من العدم أو بفعل فانوس سحري، فلا ندري من أين أتت أو ما دورها فيما يجري وإلى أين هي ذاهبة.
على الرغم من ذلك، أعتقد أن الكاتبة نزهة الرملاوي تقدّم في روايتها كرنفال المدينة خاصة في فصلها الأول نموذجا جيدا للمذهب التجريبي الواقعي في الرواية، الذي يتعدى حدود السرد التقليدي. فعندما نقرأ رواية كرنفال المدينة نشعر بعدم الارتياح؛ لأنها لا تخضع لمعايير السرد الروائي السائدة ولا تلتزم بها، وهي أيضا تصف المكان والزمان والأحداث بأسلوب أدبي لم نعتد عليه فنجد أنفسنا تائهين في أرض جديدة علينا اكتشافها والتأقلم على العيش فيها.
تضع الكاتبة شخصياتها ضمن سياق مكاني واجتماعي معيّن، وتراقب سلوكياتهم عن بعد. فهي لا تهتم فقط بسرد الحقائق ونقل الواقع، بل تهتم أيضا بإظهار تأثير ذلك الواقع على سلوك الشخصيات الفردي والجماعي. فهي لا تتدخل في أنماط سلوك الشخصيات بل تترك الشخصيات تتصرف بحرية وعلى طبيعتها ضمن ظروف معيّنة، لا تتحكم بسلوك الشخصيات فحسب بل تحدد أيضا مصيرها. فنرى الشخصيات لا حول لها ولا قدرة على تغيير واقعها، ممّا يجبرها على اتباع سلوكيات تساعدها على التأقلم مع ذلك الواقع.
منذ بداية الرواية تكشف لنا الكاتبة عن البيئة المكانية التي تعيش فيها شخصياتها، هي بيئة قاسية وحزينة وكئيبة وملوثة، هي بيئة “المخيم البائس خلف الجدار” وفي أزقته “تستنزف حاويات القمامة آخر أنفاس ليلها، لتخرج زفيرا ملوثّا من أعمدة دخان يتمدد على جدران أرهقتها الأوبئة” (ص 7). وفي مكان آخر من الرواية نجد الوصف التالي للمخيّم: “جبال من النفايات تنفث سمومها على الأرض … ما عادت بيوته مصفوفة بانتظام، اخترقها الاكتظاظ … عمّته الفوصى، اقتحمت ثورته يد العمالة والبطالة، فأمسى بؤرة مخدرات وأسلحة وفساد” (ص 34). بعد ذلك تنتقل الرواية إلى وصف الجدار والمعبر الذي يفصل مدينة القدس عن المخيم: معبر طويل يزدحم بالبشر، ذات أرصفة متهالكة، جدار يتجذر كعملاق في الأرض، “مغتصب يعيث تشويها بمدينتنا، يقهرها … دخيل أوغل تقسيما بالمكان” (ص 39). وعلى بوابات الجدار يقف الجنود ويمنعون الحشود من عبورها، يُنكلون بهم ويعتدوا عليهم.
ضمن هذا السياق تتحرك العديد من الشخصيات التي ترى نفسها أسيرة واقع مرير لا تستطيع تغييره أو التحكم به، ومع ذلك تحاول مقاومته لكنها تفشل. وهذا الواقع يفرض عليها أن تخوض تجارب حياتية قد لا تخوضها لو وُضعت في بيئة أو سياق آخر. فلنأخذ على سبيل المثال ربحي. فالواقع الذي يعيشه ربحي هو مصيدة يقع في شركها؛ فبعد أن كان مناضلا وبسبب ذلك تمّ إسقاطه “في وحل المسكرات والمخدرات، بعد أن مضى به الزمن وطنيا مكافحا” (ص 13) وتجريده من إنسانيته حتى أصبح قاسيا حتى النخاع، كما يصف نفسه. فلو لم يكن الاحتلال والمخيّم لكان ربحي بالتأكيد شخصية أخرى.
وكذلك الأمر فيما يرتبط بالشخصيات الأخرى، فنراها مجبرة على تقبل واقعها ومسايرته؛ لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا إزاءه. وهذا الواقع لا يروق لها بالطبع؛ لأنه يقيّد حريتهم ويحرمهم من إنسانيتهم. تامر مثلا يضطر للعمل عند الحاجز العسكري يبيع الوسائد، ويحاول وتقديم المساعدة للآخرين، وعينه ترنو في اشتياق إلى مدينة القدس التي لا يستطيع الوصول إليها بسبب المعبر العسكري. فهو يريد أن تتبدل الأحوال؛ كي يستطيع إكمال تعليمه والعمل بشهادته والتزوج من زينة التي يحبها والنأي عن المخيّم. لكن ما باليد حيلة، فشتان ما بين الحقيقة التي يعيشها والحلم الذي يحلم به. فالحقيقة موجعة وتفرض عليه حياة معينة وسلوكا معينا.
ومثل تامر، يرثي وهيب العائد من الخارج إلى الوطن حاله؛ لأنه يصطدم بواقع لم يكن يتوقعه. فكل شيء قد تغيّر لا سيما بناء الجدار “الذي يبدّد حلم أسراب العائدين”. تبددّت أحلامه وتساقطت أمنياته كأوراق الشجر في فصل الخريف. ومثل غيره عليه الانتظار والتأقلم مع ظروف بيئية لم يعتد عليها ولم يتوقعها.
للتخلص من الضغط النفسي والإرهاق وللتخفيف على الجموع التي تنتظر أمام الجدار والبوابات كي يدخلوا مدينة القدس، تُخرج أنطوانيت آلة الكمان، وتطلب من زميلاتها الاستعداد لتسلية الأطفال، وتتقمص نوال وريم دور المهرج. تبدأ أمل بالغناء كالطائر المغرد حتى نسي المنتظرون ألمهم، وبدأوا يشاركون في الغناء والرقص. في هذه اللحظة يتحول المشهد من مشهد درامي كئيب، إلى مشهد يملؤه الفرح والسرور. وقد يبدو مشهد مثل هذا غير اعتيادي أو حتى سريالي في ظل الظروف القائمة، لكنه يمنح المنتظرين بعضا من الحرية. ومن هنا يكتسب عنوان الرواية أهميته؛ لأن الكرنفال أصلا مخالف لما يُعتبر عاديا وطبيعيا. وعلى المستوى العاطفي يخلق الكرنفال شعورا بالوحدة بين الناس، فالكرنفال هو تعبير عن حياة ثانية للناس مغايرة للحياة السائدة، أي حياة الاحتلال والظلم وما ينتج عنها من بؤس وفقر ويأس.
لقد أدركت تريزا حاجة الحشد الكبير من الناس إلى الشفاء من واقع مؤلم فتقول: “ألم الناس من الانتظار الطويل، لا يقل ألما من مرضى يطول انتظارهم للشفاء” (ص 62). فتدرك أهمية الكرنفال وتدعوا زميلاتها وزملاتها لتوزيع القبعات الملوّنة على المتجمهرين ورسم أشكال ملوّنة، والقيام بحركات بهلوانية لإسعاد المنتظرين. كما تبدأ الكشافة بإطلاق الألحان والعزف في سماء المعبر. يضحك الأطفال ويصفق المنتظرون، وينسى الناس “ساعات اكتئابهم، وآلام وقوفهم، حين احتلقوا جوًا من المرح لدفع ملل لا نهاية له” (ص 63).
يتميز الكرنفال بنوع من الفكاهة والسخرية، ويعبر عن رفض السلطة، وكأنه يحاول الإطاحة بها. وهذه هي الرسالة التي يحملها الاحتفال أمام الجدار بالقرب من المعبر. ولتامر دوره في الكرنفال، وهذا الدور يظهر في غرفة التحقيق بعد إلقاء القبض عليه. ينظر تامر إلى المحققين باستعلاء، ويتظاهر بأنه أصمّ وأبكم. نقرأ: “أخذ تامر يمثل المشهد أمام المحقق، وزبد فمه يسيل على ذقنه، محركا حنكه إلى اليمين واليسار بطريقة ساخرة لافتة، توحي بضرب من الجنون” (ص 211). على الرغم من أن تامر هنا في موقف خطير إلا أنه لا يأبه للمحققين ويتظاهر بالجنون، وهذا التصرف أو السلوك يزيد من فكاهة المشهد وسخريته، وتكمن أهميته في أنه يعكس أدوار الشخصيات، فيُصبح تامر هو الذي يسيطر على الموقف، ويتلاعب بالمحققين كما يحلو له، فيما في واقع الأمر ينبغي أن المشهد عكس ذلك تماما. لكننا نرى في تصرف تامر رفضا للسلطة التي يمثلها المحققون ورفضا للتهديد الذي يمثلونه.
ملاحظة أخيرة: عند كتابة الرواية والشعر أعتقد أن على الكاتب عند الكتابة أن يوازن بين العاطفة والعقل؛ لأنه إذا تغلبت العاطفة على العقل يفقد الكاتب السيطرة على ما يكتب، ويقوده قلمه عبر متاهات فكرية ليس لها مخرج آمن، أمّا إذا تغلب الفكر على العاطفة فسيكون الناتج الأدبي عقيما لا حياة فيه. يبدو أن عاطفة الكاتبة نزهة الرملاوي ومحبتها للقدس قد قذفتها في بحر أمواجه عالية، لكنها تمكنت من التغلب عليها وإنقاذ نفسها من الغرق لكن بعناء كبير.
وقال عبدالله دعيس:
كرنفال المدينة؟ أيّ كرنفال وأيّ مدينة؟
عندما تُطلق الكاتبة نزهة الرّملاوي كلمة المدينة، فهي حتما تقصد القدس، تلك المدينة التي تسكن قلبها، وتنسج عنها الحكايات، وتكتب فيها خواطرها وأشواقها، وقد تجلّى هذا في كتابها السابق عشّاق المدينة. ومن يعرف الكاتبة، يعلم أنّ القدس تعيش في قلبها وتسكن روحها. إنّها القدس، سيراها القارئ بؤرة للكون تطلّ من غلاف الكتاب بقبّتها الذّهبيّة، وسيعيش القارئ بهجتها وحزنها، خلال الصّفحات ومع تتابع أحداث الرّواية.
قد يتساءل أحدهم: وأيّ كرنفال هذا في مدينة منكوبة؟ ومَن غير القدس يشعل أنوار الأعياد؟ وأيّ مدينة غير القدس يُحتفى بها في الأرض والسّماء؟ أليست هي مدينة الأنبياء ومدينة الشّهداء؟ وقد يتساءل آخر، وهل يشعر الأسير ببهجة العيد؟ فالأسير وإنّ كبّلت أطرافه وأوصدت عليه الأبواب، فإنّ روحه تنطلق لتحتفل بأعياد سماويّة، تفتح أمام ناظريه دروبا ورحابا واسعة، فإن كبّل الظالم جسده، فروحه لا تخضع للقيود. وكذلك القدس، وإن خنقها جدار الفصل، وكبّلت أطرافها الحواجز والبوّابات، وقهرت أبناءها بنادق الموت التي يمتشقها الغزاة، إلّا أنّ أبناءها يرسمون كلّ يوم لوحة جديدة للمجد في سمائها، ويقهرون أصوات البنادق لترتفع أصواتهم بالزغاريد، فترتدّ رصاصات الحقد غمّا في قلوب أعدائهم.
تَرقب الكاتبة ما يدور خلف حاجز قلنديا العسكريّ بعين الأسى، وتنقبض روحها ألما ككلّ من يمرّ بذاك المكان المفعم بالقهر والتّنكيل اليوميّ، لأهل المدينة المضطرين للانتقال عبره. لكنها ترى الناس والأحداث والأشياء بعين الكاتب، فلا تكتفي بسرد ما ترى، بل تغوص في أعماق الأشخاص الذين نراهم دائما هناك، وتنسج لكل واحد منهم حكاية، وتنقلنا إلى عالم آخر أتى منه هؤلاء، فهم ليسوا جزءا من الحاجز، بل بشر من لحم ودم، لهم عشقهم وأشواقهم وهمّهم ويحملون فوق كلّ ذلك همّ المدينة المكلومة. فاستطاعت الكاتبة أن تحوّل مشهدا مأساويّا إلى مسرح نابض بالحياة، وأن ترسم بقلمها قصصا وحكايات لشخصيات نمّر عليها دون أن نعيرها اهتماما، لتضعها في قالب إنسانيّ، وتعبّر عن ألم الإنسان الفلسطينيّ تحت الاحتلال من خلالها.
وفي القسم الثاني من الرّواية، تصطحب الكاتبة القارئ عبر أحياء القدس وأزقّتها، وتحشد الأحداث التي دارت في المدينة في الأعوام الماضية، لنراها متتابعة، وكأنّها تحصل أمام أعيننا في يوم وليلة. وتركّز الكاتبة على عدّة قضايا تقلق المقدسيّين، أهمها: فصل العائلات عن بعضها بسبب الجدار، وحرمان من يقطنون خارج الجدار من زيارة مدينتهم، والمعاناة والإذلال على حواجز العدو التي تفتقد لكلّ معاني الإنسانيّة والرحمة، والأسرى في سجون الاحتلال، واستهداف الشبّان والشّابّات وقتلهم بدم بارد، وسيطرة المستوطنين على البيوت وتسريب بعضها بطرق مشبوهة، وبناء المستوطنات، وغير ذلك من صنوف العذاب التي يوقعها المحتلّ بأهالي المدينة.
استطاعت الكاتبة أن تأخذ القارئ إلى الأجواء التي يعيشها المقدسيّون وتحمّله همومهم وأوجاعهم، دون أن تجرّدهم من إنسانيّتهم، فأظهرتهم بصورة من يحبّ الحياة ولا يدع الموت والظلم يزاحمه عليها، فتنطلق أفراحهم ومهرجاناتهم من رحم هذه المعاناة وفي أوجها.
استخدمت الكاتبة لغة أدبيّة بديعة، فابتعدت عن المباشرة، مع أنّ موضوع روايتها وتتابع الأحداث قد يسوق الكاتب إلى أسلوب التقرير الصحفيّ، إلا أنها كانت قادرة على النأي بنفسها عن ذلك، عن طريق الأسلوب الإنشائي واستخدام المحسّنات البديعيّة والصور. لكنّها بالغت أحيانا في ذلك، فبدت بعض التشبيهات والصور متكلّفة واضحة الصنعة. والرواية رغم قوّة لغتها ورزانتها وقدرة الكاتبة على التّعبير السليم، إلا أنها تزخر بالأخطاء اللغوية التي كان من الممكن تلافيها بقليل من المراجعة والتدبّر.
تدور الرّواية حول شخصيّة رئيسيّة واحدة، وهي شخصية تامر، بائع الوسائد على حاجز قلنديا، الذي استطاع تخطّي الجدار والانطلاق في رحلة بحث ملحميّة عن جذوره داخل مدينته التي عاش على أطرافها، ولم يستطع الوصول إليها من قبل. لكنّ الكاتبة تُدخل عددا كبيرا من الشّخصيّات الثّانويّة، وتعطيها أسماء، دون مقدمات، وبشكل مربك لا داعي له، ففي كلّ مكان يرتاده تامر، تظهر شخصيّات جديدة، ثم تختفي هذه الشخصيات بسرعة، ممّا يزيد في إرباك القارئ وحيرته. وعندما تُنطق الشخصيات في حوارها، تعكس شخصيّة الكاتبة وآراءها ولغتها، فنرى بائع الوسائد الغرّ الذي لم ينه دراسته ينطق بما لا يستطيعه المثقّفون.
وتبدع الكاتبة في تصوير المشاهد، فمن يقرأ الأحداث التي سردتها وما دار خلف حاجز قلنديا، يرى صورة حيّة تعجّ بالحركة والألوان والأصوات. فهي ترسم لوحة إنسانيّة جميلة مفعمة بالمشاعر والأحاسيس، بلغة جميلة تقود القارئ إلى ذاك العالم ليراه بعين أخرى، ويحسّ بما يدور فيه بكلّ مشاعره. ثمّ تقود القارئ في رحلة داخل المدينة، فتصوّر المدينة: ليلها ونهارها، فرحها وحزنها وانكسارها، بريشة فنّان حاذق عارف لدروب المدينة وأسواقها وأزقّتها.
لكنّ الكاتبة وهي تريد أنّ تظهر كلّ ما يحدث في المدينة، تزجّ بالكثير من الأحداث، والتي حدثت في أشهر وربما في سنوات متباعدة، تباعا، فتحصل في يوم وليلة أو عدة أيام. فالطفل الذي يخطفه المستوطنون ويحرقونه، والشبّان الذين يقتلون بدعوى محاولة طعن المستوطنين، إلى تسريبب العقارات، إلى وضع البوابات الإلكترونية على بوابات الأقصى وإزالتها، ونقل السفارة الامريكيّة إلى القدس وغيرها. كل هذه الأحداث تحدث أمام ناظري تامر في رحلته القصيرة في القدس. لم يكن هذه السّرد واقعيّا، وكان متسارع الوتيرة ثقيلا على قلب القارئ وأعصابه.
ويعيش القارئ مع الشخصيات بكليّتة، ويشعر بأحاسيسها، ويتألّم بألمها، ويتأوّه مع المدينة المكلومة، لكنّ الشخصيات نفسها لم تستطع الإفصاح عن مكنونات نفوسها في حوار داخلي، ربما بسبب تسارع الأحداث وتتابعها.
لا شكّ أنّ الكاتبة خبيرة في أحياء القدس وأماكنها، ووصفتها أيّما وصف، لكنّها رغم ذلك وقعت في بعض الأخطاء: فقبّة السلسلة مثلا هي شرقي قبة الصخرة، وليست داخل باب السلسلة كما ذكرت الكاتبة ص 141، وحيّ الأشقريّة هو أحد الأحياء الحديثة في بيت حنينا، وليس حيّا مسلوبا مثل الطالبيّة وحارة الشرف كما ذكرت الكاتبة ص 38.
أمّا زمن الرواية فهو غير واضح المعالم، فقد حشرت أحداث عدّة سنوات في أيام، وجمعت المشمش والعنب في موسم واحد، وأعياد المسلمين والمسيحيّن في وقت واحد، وجعلت الطلبة يذهبون إلى المدارس في تمّوز، وكذلك جعلت رأس السّنة الهجرية في تمّوز، مع أنّ هذا لم يحدث منذ عام 1990.
استطاعت الكاتبة بحقّ أن تصنع كرنفالا صاخبا، أضاء سماء القدس، وأخذ القارئ في رحلة علوية في سماء المدينة، وهبط به ليتجوّل في أحيائها، ثمّ عاد لينظر لمشهد البشر المتدافعين على حاجز قلنديا نظرة أخرى مغايرة، فكلّ منهم يحمل حكاية، وكلّ منهم يحمل هموم الوطن، وكلّ منهم يحمل ذكريات أرض ودار سلبت منه عنوة، وحلم لمستقبل يتفّس فيه نسيم الحريّة.
وكتب ابراهيم جوهر:
فيها لغة شعريّة جميلة لكنها أحيانا كثيرة اكتفت بهذه اللغة: إيقاعها واستعاراتها على حساب المعنى. هي قصة الاحتفال الإنساني بالمدينة رغم الحصاروالجداروالاحتلال ومنغّصاته.
حملت روح المعاناة ووثّقتها توثيقا أدبيا وتاريخيا لكنها ابتعدت قليلا أو كثيرا عن الأسلوب الأدبي الرّوائي لصالح الجري وراء توثيق معاناة المدينة وناسها.
جاء الحوار الخارجي ناطقا بلسان الكاتبة لا الشخصيات، فلا يظهر الحوار لغة المتحاور ولا ثقافته بل جاء بمستوى لغوي ونفسي واحد لينقل فكرة الكاتبة.
الرواية المكوّنة من فصلين ابتدأت فنيّا من الفصل الثاني، أمّا الفصل الأول فجاء على شكل قصص قصيرة لا رابط بينها إلّا في ذاك الخيط الذي يضمّ ألوان المعاناة ذات الوجوه المتعدّدة.
لفت انتباهي استخدام الكاتبة للـ”بصقة” سلاحا احتجاجيا على الجدار وعلى الآخر إذ تكرّرت أكثر من مرّة واحدة بطريقة غير مبرّرة. أمّا الأخطاء الكثيرة نحويا وصياغة وإملاء فقد باتت من سمات النّشر الورقي مؤخّرا بسبب عدم مراجعة المخطوط وما قبل النّشر.
يسجّل للكاتبة “نزهة الرملاوي” مواظبتها لنقل المدينة المقدّسة إلى الواجهة وسعيها الدائم لتطوير أسلوبها على أمل أن يكون إنتاجها القريب أكثر تأنّيا ومراجعة وفنّيّة.
وقال محمد موسى عويسات:
تعدّ هذه الرواية من الأدب المقدسيّ، الذي يتناول المدينة وهمومها ومصائبها وآمالها وآلامها، ويصوّرها محتلّة في أوضح صورة، ويوثّق جرائم المحتلّ بحقّها وحقّ أهلها، فما أحوجنا لمثل هذا الأدب، الذي ينضوي تحت شعار: اكتبوا عن القدس ولها وفيها. فمن القدس ومن قلب الأحداث، وللقدس مكانا وزمانا دون شريك لها، كانت هذه الرواية مهداة للمدينة المقدّسة. تناولت الكاتبة مبتدئة من أحد مخيمات القدس، ومن خلال شخصيّة الفتى تامر ابن المخيم، ابن أحد مناضلي القدس وشهدائها، أحداثًا جمّة وخطيره، وقعت زمانيّا في العقد الثاني من هذا القرن، وما زالت قائمة يعانيها الناس يوميّا، أولها كيد المحتلّ بهذا المخيّم بنشر المخدرات فيه، وكانت شخصيّة ربحي زوج أمّ تامر ذي التاريخ النضاليّ، تمثّل أنموذجا لمحاولات إسقاط الشباب في هذا المستنقع المخيف. ثم جاءت الكاتبة على الجدار الذي فصل المدينة عن محيطها وضواحيها، وشتّت أهلها، وحال بين الناس وأبنائهم، وأرحامهم، ومقدّساتهم، ومشافيهم، وأعمالهم، وكان من أعظم المصائب التي ابتلي بها الفلسطينيون، وسجّلت الكاتبة حادثة إغلاق المحتل للمعبر وترك الناس في حالة انتظار مذلّة قاسية في أجواء الحرّ القاتلة، وصوّرت بعض الحالات الإنسانيّة التي واجهها الاحتلال بوحشيّة، منها أن يفجأ المخاض امرأة، فيعرقل الجنود وصول عربة الإسعاف، فتضع حملها عند الحاجز، والتقطت عدسة الكاتبة أيضا صور القمع التي أقدم عليها المحتل لتفريق جموع الناس المطالبين بفتح المعبر لدخول المدينة، والذي أسفر عن جرحى وشهداء واختناقات، وغير ذلك. ثمّ من خلال تامر ونجاحه في تجاوز الجدار، أتت الكاتبة على حادثة الصبيّ باسم الذي اختطفته جماعة يهوديّة وأشربوه مادة حارقة ثمّ حرّقوه، وفي أثناء رحلة تامر إلى قلب المدينة ومروره بحيّ استيطانيّ في غربها عرّجت الكاتبة على الموازنة بين حال الأحياء اليهوديّة والخدمات التي تحظى بها، وبين حال الأحياء العربيّة في المدينة التي تحرم من تلك الخدمات. وتصوّر الكاتبة الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين على العمال العرب في حيّ المصرارة، وتأتي أيضا على ذكر الفلاحات بائعات الخضار على الأرصفة وإجراءات بلدية الاحتلال بحقّهنّ، وصوّرت حادثة اغتيال الجنود لأحد الفتية وتلفيق تهمة محاولته الطعن بإلقائهم سكينا بجوار جثّته، تلك السياسة التي كلّفت الشعب الفلسطيني عشرات الشهداء، وصوّرت الكاتبة قمع المحتلّ وإحباطة لاحتفال برأس السّنة الهجريّة في شارع صلاح الدين، وفي ثنايا القصّة أشارت الكاتبة إلى المعاناة الاقتصاديّة التي يكتوي بها أصحاب المحالّ التجاريّة في المدينة بسبب الاحتلال وإجراءاته، ثمّ تأتي على ذكر احتفال آخر لليهود يقام في الحائط الغربيّ في باب المغاربة، يتمتّع فيه المحتفلون بالحراسة والأمن، ثمّ تأتي على توثيق حادثة البوابات الإلكترونيّة التي حاول المحتلّ أن ينصبها على بوابات المسجد الأقصى فقاومه أهل القدس ونجحوا في إفشالها، فقد غصّت شوارع القدس وأزقّتها بالمصلين والمرابطين لما يقرب من أسبوعين، ووثّقت الكاتبة قضيّة خطيرة هي تسريب البيوت من بعض الخونة للمستوطنين، الذين يتسلّطون على مجاوري تلك البيوت، ومثّلتها حادثة قتل الصبيّ فؤاد. وفي الثنايا تعرّضت الكاتبة لقضيّة الاعتداء على المقابر، وقضية احتجاز جثث الشهداء في البرّادت لسنوات، وصوّرت حالة الخوف التي يعيشها المحتلّ من اختفاء أيّ فتى أو فقدانه، إذ يعدّونه إرهابيّا يريد تنفيذ عمليّة ضدّهم، وسياسة احتجاز أهل المطلوب حتى يحضر هذا المطلوب. وغيرها الكثير من التفاصيل.
ووثّقت الكاتبة من خلال هذه الأحداث أسماء الكثير من الشوارع والأحياء والأسواق والمساجد والمعالم العمرانيّة القائمة، أو التي هدمها المحتل من مثل حيّ الشرف والمغاربة وسوق الشّاي وسوق البطيخ، حاولت الكاتبة أن تربط بين المخيم وهذين الحيين الشرف والمغاربة، فسكان المخيم هم من هجّروا قسرا من هذين الحيّين. فكان حضور المكان في الرواية واضحا ومؤثّرا ومقصودا بتفاصيله وبعثت فيه الحياة من خلال الأحداث، أو الذاكرة والذكريات، ” ناداهم سوق العطّارين، تغلغل عبقه في أعماق تامر فشمّ رائحة جدّه بائع البهارات الذي رحل منذ سنين، حطّت أقدامهم في سوق اللحامين، وتنقّلت ما بين سوق الخواجات والقطّانين، استدرجهم سوق الحصر، وأفضى بهم إلى سوق البازار والباشورة… عصفت الأمكنة بخيالات الزائرين”.
امتازت شخصيات القصّة بالبساطة والعفويّة، وكلّها تحمل العفويّة الشعبيّة والألم، وصراعها الوحيد البارز الممتدّ والذي ظلّ محتدما هو مع المحتلّ.
وهكذا، بالأحداث والمكان والشخصيات، استطاعت الكاتبة أن تغوص بروايتها في بحر من الواقعيّة الثوثيقيّة الفنّيّة اللافتة. فبدت في غاية الحرص على نقل حقيقة الحياة في القدس في ظلّ هذا الاحتلال الجاثم على صدرها، بل ربّما جاء حرصها على حساب بعض الجوانب الفنّيّة، إذ كانت الأحداث متدافعة، آخذا بعضها بأعناق بعض، فغلبت عليها التقريرية.
العنوان:
وَسَمَت الكاتبة روايتها بـ (كرنفال المدينة)، وكلمة (كرنفال) إيطاليّة بمعنى الابتعاد عن اللحوم، وتطلق على احتفال دينيّ يسبق الصيام الكبير عند بعض الطوائف المسيحيّة، أو هي يونانيّة اسم للعربة التي كانت تحمل الصّنم أبولو وتطوف به بين الناس، ثمّ شاعت التسمية لتكون بمعنى احتفال واستعراض شعبيّ، يجمع بين السيرك والاحتفالات الشعبيّة التي تجوب الشوارع، وعادًة ما تكون هذه الاستعراضات في موسم الكرنفال. وتمنّيت لو استخدمت كلمة (مهرجان) مع أنّها أيضا ليست عربيّة بل هي فارسيّة أو هنديّة، أو غيرها من الكلمات العربيّة. على أيّة حال اتّخذت الكلمة في الرواية بعدا شعبيّا وتراجيديّا ولها دلالة دينيّة.
وأظنّ أنّ الكاتبة قد وفّقت في اختيار العنوان من جهتين: الأولى الواقعيّة، إذا سرى العنوان في عروق روايتها من البداية إلى النهاية، فهناك احتفالات ممتدّة عبر القصّة: إذ تحوّل منع الاحتلال الناس من دخول المدينة وإغلاقه للحاجز إلى احتفال انتهى بقمع وغاز وجرحى، ثمّ كان هناك احتفال برأس السنة الهجريّة وكشافة وطبول وهتاف وحشود في داخل المدينة في شارع صلاح الدين انتهى بالقمع والتفريق، وفي مقابل ذلك كان هناك احتفال دينيّ لدى اليهود في السّاحة الغربيّة من حائط البراق وكان محروسا محفودا آمنا مطمئنا، وكان الاحتفال الأعظم هو تجمّع الناس غير المنتهي في كلّ أنحاء المدينة لأداء الصلوات في الشوارع احتجاجا على وضع المحتلّ البوابات الإلكترونيّة لدى أبواب المسجد الأقصى، فهذا احتفال أيضا؛ لكون الاحتفال في اللغة هو الحشد الكبير من الناس بغض النظر عن القصد. وتنهي القصّة باحتفال لعودة تامر سالما من المدينة، ولعقد قرانه على زينة والذي أوحت الكاتبة بأنّه لم يتمّ، فهذه كلّها أحداث حقيقيّة تكاد تكون يوميّة .
الجهة الثانية من نجاح العنوان أنّ المعاناة التي يصحبها الإصرار والتحدّي، يمكن أن يصنع منها الفرح والبهجة المؤقّتة، ففي الاحتفال تحدّ ومقاومة، وفي الوقت نفسه تؤول الأفراح إلى أحزان وآلام، فالمدينة في واقع الأمر حزينة ولا مكان للأفراح، تقول الكاتبة: ” ساعات الإغلاق لا زالت قائمة هناك، الموت يدبّ بينهم، فناء جماعيّ للأفراح، في طقوس غريبة تباد” … وتختم: ” ثمّة مواسم لأعياد آتية، لا تليق أفراحها بعيدا عن المدينة”. فالأفراح في نظر الكاتبة هي أفراح المدينة يوم خلاصها من هذا المحتلّ. ولا يفوتنا هنا الدلالة الدينيّة لكلمة (كرنفال) التي تتناسب ومقام المدينة الديني.
اللغة:
استخدمت الكاتبة لغة فصيحة بسيطة، تخلّلتها بعض العبارات العامّيّة في الحوارات، وكان الجانب التصويريّ الفنيّ فيها واضحا وبخاصّة في المواطن التوصيفيّة، كقولها:” كتبت عشقها على الستائر، سلام على من رقّ له قلبي وآثر المغيب، فتحتُ كتاب شوقي، فوجدتك بين دفّتيه قمرا يضيء بطلعته الكلمات، يسابقني بدفء عطفه، ويسكب في قلبي سكونا بهيّا”. ورغم هذا يغلب على لغتها الأسلوب التقريريّ، الذي كثيرا ما كانت تقوم بها الكاتبة نفسها.
يلاحظ في هذه اللغة، بغض النظر عن بعض الأخطاء النحويّة والإملائية، وجود أخطاء تركيبيّة تشترك فيها الكاتبة مع كثيرين، مثل: (مريضة زهايمر)، كأنّها ترجمة من لغة أخرى، فالأصل مصابة بالخرف. حذف حرف الجرّ في فعل لا يتعدّى إلا به، مثال: (وانتهى به المطاف جانب وهيب) الأصل: إلى جانب وهيب،. (أوغل نظره لأعماق النافذة) الأصل في أعماق النافذة. (لتضيء في وجهه اسوداد الحياة) الأصل: لتمحو من وجهه اسوداد الحياة أو تبدّده. (ينظر وجوه الجنود) الأصل: في وجوه الجنود. (يعرفون بعضهم البعض) الأصل يعرف بعضهم بعضا. فلا تكون واو الجماعة ولا تعرّف بعض بأل. (واستند جذع شجرة) الأصل: استند على أو إلى جذع… (استبدلت ثيابه الأنيقة بكيس أسود) والصواب أن تدخل الباء على المتروك: استبدل بثيابه الأنيقة كيسا أسود. (تنفّس الصعداء) لا تعني أنّه استراح وأخذ نفسا عميقا بعد إرهاق، بل العكس، معناها أنّه يتنفّس بصعوبة وفي ضيق.
ويلاحظ وجود لازمات لفظيّة متكرّرة في الرواية بشكل غير مقصود من مثل: استند جذع، يستند حائط السّور، تستند الحائط وغيرها كثير… ومنها عبارة في دواخله، وعبارة بصق في وجه أو أرسل بصاقا…
تخلو لغة الكاتبة من الإيحائية، التي تترك للقارئ التفكّر والاحتماليّة، فكانت لغة تقريرية مباشرة.
ما يؤخذ على أحداث القصّة:
تقصّدت الكاتبة أن تجمع أكبر عدد من الأحداث التي تبرز همجيّة الاحتلال ومعاناة الناس في المدينة، وذلك من خلال رحلة التسلّل التي قام بها تامر إلى المدينة، وهذه لم تتسلسل في الوقت بشكل منطقيّ ومناسب، فمن هروبه من بيت أبي باسم إلى لجوئه لبيت أبي فؤاد بعد أن جلبه فؤاد من المسجد، وقعت أحداث كثيرة جدا في وقت قصير هو بعض ليلة ويوم وجزء من ليلة أخرى، فهذا تكثيف للأحداث لا يتناسب مع الوقت، ربّما كان لا بدّ من سعة زمنيّة تتفرّق فيها الأحداث.
هناك أحداث تبدو غير مناسبة منطقيّا، أو تتناقض مع الحالة النفسيّة لبعض الشخصيات، من مثل مرور تامر بحديقة المستوطنة وهو في حالة من الخوف، ويرى بأمّ عينه الدوريّات تجوب المكان، ولكنّه يتمدّد على العشب ويتقلّب، ” ضحك ثمّ كتم الضحكة، خاف أن تفضحه؛ فيأتيه الجنود، أخذ ينتقل من لعبة إلى أخرى، جلس على أرجوحة طار بجسده بالهواء … أحسّ أنّه ملك الدنيا” .
والحقّ أنّ كلّ هذه الملاحظات لا تبخس الكاتبة جهدها وعملها الجليل هذا. فقد وضعت بين يديّ القارئ رواية توثيقيّة مقدسيّة بامتياز.
وكتبت هدى عثمان أبوغوش:
بقلمهاالعاشق للقدس،وبأوراقها القلقة التّي ترتجف منذ بكر مجموعتها القصصيّة”عشّاق المدينة”، مازالت الكاتبة المقدسيّة نزهة الرّملاوي تحمل أوجاع مدينتها في روايتها الأولى “كرنفال المدينة”، وهنا نلاحظ مدى تعلّق الكاتبة العاطفي، بحيث جعلت المدينة مرة ثانية في عنوان روايتها التّي تتكون من فصليّن.
تدور أحداث الرّوايّة في الزمن الحاضر حيث وصفت الأحداث السّياسيّة الواقعيّة التي شهدتها مدينة القدس، وبيّنت صور الظلم من قبل المحتّل، وطرحت قضيّة العقبات، المشاكل، والاحباطات التّي تواجه المقدسيّ في حياته اليّوميّة والإجتماعيّة من خلال بطل الرّوايّة تامر، الّذي يسكن مع زوج أُمّه ربحي الأجرد الثمل المدمن في مخيّم قلنديا بعد وفاتها، واستيلائه على البيت الذي تركته أمّه، حيث يذهب إلى الحاجز؛ ليبيع الوسائد للمارّين هناك. وهنا تبدأ سلسلة الحكايات التّي تربطه بالشّخصيّات المتعددّة في الرّوايّة التّي يلتقيها وعلاقتها بالمدينة.
جاء السّرد بلغة ضمير الغائب هو على لسان الكاتبة، ولذا ظهر الفعل الماضي كثيرا، فبدت الشخصيّات مقيّدة غير متطورة، فالكاتبة انتقلت في سردها من شخصيّة إلى أُخرى لنقل علاقة كل واحدة منها بالمدينة وبوحها بأوجاعها، فخلقت مسافة بين القارئ وعدم تفاعله مع معظم الشخصيّات، حيث غلب الوصف الكثير للأحداث على حساب عمق الشخصيّة.
برزت العاطفة الحزينة في شخصيّة تامر وعلاقته بوالدته المتوفاة من خلال تخيّله العاطفي وحنينه الجارف لها، وشعوره بفقد الحنان التّي كانت تمنحه إيّاه.”في كلّ لحظات الإشتياق كان يقف أمام خزانة أمّه، يفتحها، يُخرج أشياءها، يُقبل ملابسها ويشمّ رائحتها…”.
أعجبني الخيال الإبداعي في نهايّة الرّوايّة حين تحررت أمّ تامر من قبرها وهي تمنح الأمل لتامر، وتبشّره بمستقبل مشرق.
جاءت الّلغة بسيطة وإنشائيّة وأكثرت من المحسنات البديعيّة. إستخدمت الكاتبة تكرار المفردات “المدينة، الجدار، البصقة، فصائل متناحرة، المعبر.
كرّرت جملة “افتحوا الأبواب” بالإشارة إلى الإختناق النفسي، الإجتماعي والسياسي الّذي يطوّق المدينة، جملة فيها صرخة للعالم تعني من يوقف العدوان وينقذ المدينة المعذّبة من سلاسل ظالمة تأبى الرّحيل.
طرحت الكاتبة التساؤلات الكثيرة التّي تعبّر عن غضب الإنسان الغريب في مدينته،”أين البيت الّذي كان والخلاّن”؟ “من يجدّد في وجه مدينتناالأمل والحياة”؟ ورغم مرارة المعاناة والعتمة، إلأّ أنّ الكاتبة تضيء شمعة الأمل في نهاية الرّوايّة”فوق أسوار القدس ،ثمّة أعياد آتيّة”.
أمّا رفيقة عثمان فقد قالت:
استلهمت الكاتبة أحداث الرواية ووقائعها من الواقع الفلسطيني، من أحداث اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة معا.
حيث كانت القدس سيّدة المكان والزمان، حاضرة على طول الخط القصصي، وخاضت الكاتبة في تفاصيل دقيقة، لا يعرفها سوى المقدسيين أنفسهم؛ على قول المثل: “أهل مكة أدرى بشعابها”، كذلك كما ذكر الأديب سلحوت مرارا؛ ” بأن الكاتب هو ابن بيئته”. من حسن الحظ بأن الكاتبة هنا مقدسيّة الأصل، نجحت بتعريفنا على أحداث عديدة مفصّلة، وأماكن كثيرة داخل القدس، بأسماء حاراتها وأزقّتها وزواياها، وأسوارها وحجارتها العتيقة بعبقها وتاريخها، وكل ما عجزت عن عرضه وسائل الإعلام.
سردت الكاتبة روايتها، باستخدام شخصيّات بطوليّة، تتمثّل في الشاب تامر، يتيم الأبوين، يعيش مع زوج أمّه القاسي، يعيشان في مخيم شعفاط.
حرَّكت الكاتبة الشخصيّة الرئيسّة، لتحريك الأحداث من خلال، دخول البطل تامر المعبر بالقفز عن الجدار، وتسلّله الى المدينة المقدّسة، وتجوّله بأنحائها هاربا من الجنود، وعلى لسانه عرضت الكاتبة عددا من الأحداث، وعواقبها الوخيمة.
استطاعت الكاتبة أن تغوص في أعماق المشاكل السياسيّة التي يعاني منها المقدسيّون بشكل خاص، تزاحمت الأحداث بداخل النصوص الأدبيّة، بصورة مكتظة، بلغة عربيّة فصحى، وزينة وجزلة؛ ناهيك عن الاستخدام المفرط بالمحسنات البديعيّة والصنعة اللغويّة، التي تميّزت بها الكاتبة، كذلك كما نهجت في كتابها الأوّل؛ ممّا حمّل عبئا على نصوص السرد.
من خلال السرد يبدو أنّ الكاتبة ضليعة ولديها قدرة فائقة بالتعبير الكتابي، والأفكار المتسلسلة . لم تغفل الكاتبة عن سرد المعاناة اليوميّة التي يواجهها المقدسيّون، وخاصّة الذين يعبرون المعبر يوميّا، من خلال الجدار الفاصل بين القدس والضفّة الغربيّة، وما يواجهونه من اغلاقات المعابر المفاجئة والتفتيشات المحرجة، ومنع الدخول، وإصدار التصاريح وما الى ذلك.
على الرغم من المعاناة اليوميّة، إلا أنّ الكاتبة أظهرت بطولة المواطنين الفلسطينيين الذين يتكيّفون مع الإوضاع، ويواجهون ذلك بصمودهم وعدم إظهار غضبهم، بل يفتعلون الفرح؛ كما الكرنڤال الذي ابتدأ أمام الحاجز بالمعبر؛ كما ورد صفحة 63 ” انطلق كرنڤال المدينة’ طارت البالونات الملوّنة، فوق الجدار الطويل، حملتها الطيور وجنحت للبعيد”.
لم تنسَ الكاتبة موضوع تسريب البيوت، واقتحام المستوطنين للبيوت المقدسيّة ومحاولات تهويدها؛ بل تطرقّت الى يهوديّة الدولة أيضا.
لفت انتباهي موضوع التعاون والتآخي بين المواطنين الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين؛ ممّا يبرز الوعي القائم لدى المقدسيين وعدم وجود العنصريّة بين الديانتين، هذا انعكاس للواقع الحقيقي الذي يميّز المقدسيين بكل فئاتهم.
كما ورد صفحة 289, “أهلّة وصلبان يُصَلُّون جنبا إلى جنب تحت شمس الحب والإيمان”.
تطرّقت الكاتبة لمبادرة حمل وقراءة كتاب بحلقة دائريّة بشرية، رمزا للبقاء والصمود.
استخدمت الكاتبة نزهة، وسائل التواصل الإلكترونيّة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ هذا دليل على دراية الكاتبة ومواكبتها للتقدم التكنولوجي الحديث، ومن الجدير بأنّ الكتّاب استخدموا قديما الرسائل البريدية الجويّة، والشفهيّة، إن الاستخدام الحديث يدل على حداثة الوقائع، فهذا يُحسب للكاتبة. كما ورد صفحة 76 “تؤرخ الزمان والمكان وترسلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
بالنسبة لزمن الرواية لم تحدده الكاتبة، ربما بقصد بأن الأحداث مستمرة كانت وما زالت، كما هي. تخلّل السرد المونولوج ( الحوار الذاتي)، كما ورد صفحة 49 ״ قال في نفسه: كنت أتمنّى أن أخذكم، أنام وأصحو فلا أجد لك أثرا”.
تمثّلت العاطفة بالامتزاج ما بين الحزن والفرح، وفقًا للأحداث.
وهنالك أمثلة عديدة، كما وبرز والحوار الخارجي أيضا.
بالنسبة لاختيار الكاتبة للعنوان، لفت انتباهي كلمة الكرنڤال، فبحثت القاموس عن أصل
الكلمة؛ وفق ويكبيديا ” الكرنڤال –
تعني ” استعراض شعبي يجمع ما بين السيرك والاحتفالات التي تجوب الشوارع Carnival
أصل الكلمة ايطاليّة ( Carnem ). و ( levara)
بمعنى الابتعاد عن اللحوم، ويعتبر الكرنڤال تقليدا كاثوليكيّا، ثم انتشرت الكرنڤالات بالعالم الغربي”.
يبدو العنوا جذّابا للوهلة الأولى، كلمة أجنبية ذات لحن موسيقي جميل، ربما قصدت الكاتبة بهذا الكرنڤال بعرض العلاقات المسيحيّة والإسلاميّة السمحة التي يتحلى بها الفلسطينيون بشكل عام.
برأيي لو اختارت الكاتبة عنوانا آخر، لمنح الرواية أهميّة، خاصّة لو كان له علاقة بالتراث، والأوضاع الاجتماعيّة، لا يصعب على الكاتبة ذلك، نظرا بضلوعها باللغة والحضارة .
نظرا لمكانة القدس العالية في نفس الكاتبة، اختتمت روايتها بقولها: “ثمّة مواسم لأعياد آتية … لا تليق أفراحها بعيدا عن المدينة”.
أرادت أن تضع القاريء في موقع تفاؤل وأمل، بما يتعلق بمدينة القدس، التي لا يليق بها إلا الأفراح، وبدونها لا يوجد فرح في قلوب الفلسطينيين.
بودّي أن أنوّه، ليس من الضروري أن تنشر دار النشر، مقدّمة عن الكتاب والكاتبة، سيعتبر ذلك دعاية لدار النشر، وأنا أحمّلها كل المسؤوليّة على الأخطاء العديدة الواردة بالنص.
حبّذا لو تتم رقابة جريئة، على دور النشر العربيّة التجاريّة والمستهترة في عقول القرّاء، ومنعها من النشر غير المسؤول، إلا بعد التحقّق من صلاحية الرواية لأيّ كاتب كان.
وقال جميل السلحوت:
هذا هو الإصدار الثّاني للكاتبة المقدسيّة نزهة الرّملاوي، فقد صدر لها عام 2017 مجموعة قصصية بعنوان عشّاق المدينة.
تعني كلمة كرنفال كما جاءت في معجم المعاني الجامع: جمعها كرنفالات:” احتفالات ومسيرات رقص وغناء ولهو، تقام عادة في الأسبوع الذي يسبق الصّوم الكبير لدى المسيحيّين.”
ومن يقرأ “الرّواية” سيعلم أنّ القدس الشّريف هي المقصودة “بالمدينة”، وهذا يرشدنا لتفسير العنوان بأنّه احتفالات ومسيرات الرّقص والغناء في القدس. علما أنّه لم يكن هناك رقص ولا غناء في النّص سوى مسيرة كشّافة بمناسبة الهجرة النّبويّة. وما تبقّى هي مظاهرات واحتجاجات يصاحبها القمع والقتل والاعتقالات والغازات الخانقة.
ويسجّل لصالح الكاتبة أنّها كتبت عن مدينة القدس، فالقدس تستحقّ منّا الكثير، وكلّنا مقصّرون بحق القدس وما تمثّله لنا كجزء من عقيدتنا، وكشاهد على حضارة آبائنا وأجدادنا.
ومّما يلفت الإنتباه أنّ الكاتبة قد وضعت فهرسا في آخر النّص، وضعت فيه أرقام تقسيم النّصّ إلى أبواب، أو أحداث والصّفحات التي تبدأ بها، علما أنّ الرّواية نصّ واحد كما هو متعارف عليه، والرّواية عادة تحمل أحداثا وقصصا وحكايات متعدّدة ومترابطة، فهل جاء وضع الفهرس كاعتراف من الكاتبة -دون أن تقصد ذلك- بأنّ النّصّ ليس رواية؟
وإذا ما اعتبرنا النّصّ رواية، فهل توفّرت فيه شروط البناء الرّوائيّ؟
تدور أحداث النّصّ عند معبر قلنديا، الواقع بين القدس ورام الله، وما يسبّبه هذا المعبر من مآسي للفلسطينيّين الذين يحاولون دخول مدينتهم المقدّسة.
يتحدّث النّص عن الطفل تامر وهو ابن لشهيد، تزوّجت والدته بعد استشهاد أبيه من “ربحي” السّجين الأمني السّابق، لكنّه أدمن لاحقا على الكحول والمخدّرات، فيسومها وطفلها سوء المعاملة والتّعنيف، ولا تلبث الأمّ أن يتوفّاها الله، ليبقى الطفل تحت رعاية زوج أمّه هذا، فيخرجه من المدرسة؛ ليتحوّل إلى شبه متسوّل من خلال بيع “الوسائد” عند المعبر الاحتلاليّ.
ويلاحظ في النّصّ أنّ الطّفل تامر قد ارتبط بعلاقة حبّ مع الطفلة “زين” بنت الجيران! فهل هناك علاقة حبّ بين طفلين؟ وللتّأكيد على طفولة الحبيبين “تامر وزينة”، جاء في صفحة 45 “بعد أن ساعد تامر وصديقه الأخرس حسن زائرين بحمل أغراضهم:” حظي تامر وصديقه حسن على لوحين من الشّوكلاتة، وبالونين ملوّنين.” فهل من يفرح ببالون ملوّن وقطعة شوكلاتة يكون مؤهّلا للحبّ؟ وكيف؟ وبعد ذلك جاء في الرّواية أنّ تامر ابن سبعة عشر عاما.
وتتوالى الأحداث وأثناء إغلاق المعبر، -وهذا يحدث كثيرا على أرض الواقع من قبل الاحتلال- يعتلي تامر جدار التّوسّع الاحتلاليّ رافعا العلم الفلسطينيّ، ووسط الغازات الخانقة والتّدافع بين المنتظرين عند المعبر يسقط تامر عن الجدار داخل حدود بلديّة القدس- حسب تقسيمات الاحتلال الإداريّة- فيلتقطه شخص “أبو باسم “وهو مغمى عليه ويأخذه لبيته، وهناك يبتبيّن أنّ يد تامر مكسورة، فيقوم صاحب البيت بتجبيرها! ويكرم هو وزوجته وفادته، وعندما تقترب دوريّة لشرطة الاحتلال ليلا من بيت أبي بسّام، يهرب تامر من نافذة البيت، لتطالبه أمّ باسم بالعودة وهي تقول له بعد أن عرفت منه اسم والده: أنا عمّتك! لكنّه لم يسمعها.
ويواصل تامر طريقه إلى القدس، وفي نهاية النّصّ يلتقي مع ابن عمّه، ويتعارفان عند مدفن العائلة في المقبرة اليوسفيّة أمام باب الأسباط، عندما وصل تامر إلى قبر والده الشّهيد وقبر جدّه، الذي توفّي قبل يومين من تلك الزّيارة، وبعد معاناة تامر الطّويلة الطويلة.
والسّؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعقل أن يترك الجدّ والأعمام الحفيد ابن الشّهيد في رعاية زوج أمّه السّكير مدمن المخدّرات؟ وهل لا يتواصلون معه خصوصا بعد وفاة والدته؟ وهل يعقل أن يترك المجتمع ابن شهيد؛ ليضيع في متاهات الحياة، حتّى بات لا يعرف أسرته؟ وهل الخيال في القصّ والرّويّ يصل إلى اللامعقول في الحديث عن وقائع حقيقيّة؟
وهل اختفاء باسم ابن عمّة تامر لمدّة شهرين، ليعود مقتولا لوالديه على أيدي مستوطنين متطرّفين يمرّ مرّا سريعا كما ورد في النّصّ. وكذلك الأمر بالنّسبة للشّهيد فؤاد الذي قتله المستوطنون في جوار بيتهم في القدس القديمة عندما، ابتاعوا بيتا من أحد العملاء؟ وهل يعقل أنّ الاحتلال المعروف بجرائمه يقوم باعتقال ربحي –زوج أمّ تامر- مدمن المخدّرات والكحول حتّى يسلّم تامر نفسه؟ وما الحكمة أن يكون تامر وفؤاد وحيدي والديهما؟ وحتّى الشّهيد باسم له أخ طالب جامعيّ لم يرد له ذكر سوى أنّه طالب جامعي يسكن قريبا من الجامعة!
وفي المحصّلة يمكننا القول بأنّ النّصّ ليس رواية، وإنّما هو مجموعة أحداث متناثرة سردُها متتابعة لا يجعل منها رواية متماسكة.
اللغة: جاء النّص بلغة فصيحة شعريّة فيها بلاغة، لكن فيها الكثير من الأخطاء اللغويّة والنّحويّة.
وقالت هدى خوجا:
صورة الغلاف مناسبة، احتفال كرنفال المدينة في الفضاء الجميل الأزرق مع العصافير والحمائم البيضاء. يرقصون ويمرحون ويطيرون في الجوّ، أملا في مواسم لأعياد قادمة وجميلة.
ودوما بانتظار كرنفال على أبواب المدينة، وهنا المدينة مدينة القدس لا محالة.
ويحلم الأطفال في كرنفال يضيء أبواب المدينة بالفرح والسّعادة والتّحليق عاليا في فضاء المدينة.” لعب قصي وناجي دور مهرجين صغيرين .. وراح باسل يطير في الهواء ويهبط بين النّاس، بحركات بهلوانيّة لإسعاد المنتظرين”ص63 وهذا مع خطّته صفحة وريشةالغلاف.
” انطلق كرنفال المدينة ، طارت البالونات الملوّنة، حلّقت فوق الجدار الطّوي ، حملتها الطّيور وجنحت للبعيد” ص 63، تبدأ الإهداء الكاتبة عاشقة المدينة إلى المدينة التي تعشقها إلى القدس الشّريف.
ركّزت الكاتبة في روايتها على موضوع الجدار والتّضحية والعمل من أجل المدينة وفداء المدينة وصمودها، احتوت على فصلين حيث كان الفصل الثّاني موفقا أكثر من الفصل الأوّل الذي كان به تكرار زائد. الفصل الثاني تناثر بشكل سريع وجميل مع كرنفال المدينة. احتوت على عدّة شخوص منها تامر ربحي ثريا زينة أم أحمدعائشة أمّ عاهد، أبو العبد أم لؤي ليزاأبو خليل نسرين سارة أم محمود عبير أنور لولو أبو باسم، أمّ باسم رسمية أميرة. الأسماء كانت تتوافق مع الشّخصية والأحداث.
وتظهر الأماكن واضحة كحب المدينة باب العامود وعبد الحميد والمحافظات القدس وبيت لحم والأسواق سوق افتيموس، وباب السلسلة وغيرها.
المكتبات منها المكتبة الخالديّة، والحارات حارة المغاربة، وتبقى المدينة بانتظار كرنفال الفرح والأعياد على أبواب المدينة.
وكتبت نزهة أبو غوش:
في روايتها كرنفال المدينة الّذي صدر حديثا تدهشنا الكاتبة بلغتها الشّعريّة المنمّقة بالمحسّنات البلاغيّة والتّشبيهات والاستعارات الّتي لا تكاد تخلو منها فقرة.
في لغتها الجميلة انطقت الكاتبة المخيّم، والشّمس والمعبر، الحاجز والأقصى، والحارات والأسواق والأزقّة والتّكايا، والمساجد، هنا يمكن أن نلاحط قدرة الكاتبة على استخدام لغتها الإيحائيّة في عملية الإسقاط على الأماكن، أي إسقاط الحالة النّفسيّة للأشخاص- الشخصيّات الرئيسيّة، والثانويّة- على الأماكن. فحين عاد بطل الرّواية إِلى المخيّم، ابتسم المخيّم، وحين تأزّم النّاس على الحاجز، بكى المكان.
” المنازل تئنّ من الوجع” ص167
” نزل تامر عن الصّخرة المقموعة” وحين حزن أهل المدينة، بكى القمر، وحين فرحوا ضحكت الشّمس؛ لذلك نشهد للكاتبة قدرتها الابداعيّة في البعد عن التّقريريّة المباشرة الّتي يرفضها الأسلوب الأدبي. يرى أغلب النّقاد بأنّ المبالغة في إدخال المحسّنات البلاغيّة وزحمتها في النّص، يمكن أن تضعفه؛ لأنّها تأتي على حساب الأحداث.
غلب على الرّواية الأسلوب العاطفي، حيث اكتنفها الحزن والأسى والألم والقهر نتيجة حياة الشّخصيّات تحت حكم الاحتلال المتسلّط، ونتيجة للقهر الّذي تواجهه المدينة – القدس- من تدمير وسجن وتهويد…كما اكتنفها الفرح الحذر الّذي يحمل الأمل.
الحبّ في رواية الرّملاوي مراهق خجول حذِر من خلف شبّاك وستائر مخمليّة تحمل في طيّاتها العشق. أرى بأنّ الكاتبة قد اكتفت بتعبير قليل وبسيط عن هذا الحبّ، ولم يكن الهدف، بل جاء في سياق الأحداث؛ ربّما هذا الحبّ كان دافعا قويّا لعودة البطل تامر إِلى المخيّم.
كانت الأحداث في رواية نزهة الرّملاوي متلاحقة ومترابطة ومكثّفة، شكّلت رواية ذات عناصر متكاملة من حيث امتداد الزمان وامتداد المكان، وتعدّد الشّخصيّات، وتعدّد الحبكات على مدار الرواية.
تذكّرنا الأحداث والحركة الدّيناميكيّة في الرّواية بالأُسلوب المسرحي، الّذي لا يتوقّف عن الحركة في المسرحيّة،” أصوات تتعالى في أرجاء الحارة ما سكتت، الجنود يطوّقونها، وجوه جديدة تزورها، أنوار الكشّافات تضيء المنازل، المقيمون بالجوار يقفون خلف الباب، يلومون، يصرخون، يشتمون يتوعّدون يبتهلون يصلّون…” ص163 قلّ الحوار في الرّواية، حيث اعتمدت الكاتبة على روي الأحداث ووصف الأماكن والشّخصيّات بنفسها، ولو أعطت مساحة أكبر للشخصيّات لكان أفضل.
لا شكّ بأنّ عنصر التّشويق كان حاضرا في الرّواية، حيث يتوجّب على القارئ من خلال الرّواية أن يلاحق بطلها الّذي تنقّل من مكان لآخر، وحين تأزّم به الموقف وقفز من على الجدار الفاصل؛ ليصل الجزء الثاني من مدينة القدس، يلاحقه بخوف وحذر وأمل وشوق.
من خلال قراءتنا للرّواية نشعر بأنّ الرّاوي لم يقف موقف المحايد، وبدا واضحا الانحياز لشعبه انعكاسا لشخصيّة الكاتب.
يمكن القول بأنّ الرّاوي كان متدخّلا في أحداث الرّواية ” قهقه الجدار ضاحكا وصدّ أصواتهم دون اكتراث.” ص 89.
استطاعت الكاتبة نزهة الرّملاوي أن تنسج خيوطها الحريريّة؛ لتصنع لنا كرنفال فرح يلاحق القدس، ويصمّم بأن لا فرح إلا بها. هي رواية القدس بامتياز.