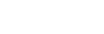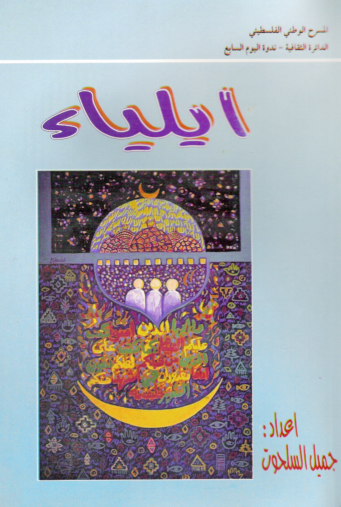نجاح التيارات الدينية في الانتخابات التشريعية في كل من تونس ومصر والمغرب، وقبلها في فلسطين، وقبلها في الجزائر، لم يكن قدرا إلهيا، بل لذلك أسبابه الدنيوية، والتي ارتسمت عذابات على أجساد الشعوب، وجغرافية الوطن، فالقوى الوطنية القومية واليسارية لم تحسن التعامل مع قضايا ومصالح شعوبها وأوطانها، وقد أخذ بعضها دوره في الحكم لعقود طويلة، وتحدثت في أدبياتها عن أمجاد وانتصارات في المجالات كافة، غير أن الشعوب على أرض الواقع لم تحصد إلا الخيبات والهزائم في مختلف المجالات، فالأحزاب القومية واليسارية والوطنية بشكل عام، كانت تطالب وهي في المعارضة، باطلاق الحريات، ونشر الديموقراطية، والاصلاحات في كافة المجالات، وبناء دولة القانون، وفصل السلطات الثلاث…والوحدة العربية، وتحرير فلسطين…الخ من الشعارات الرنانة، وعندما وصل بعضها الى الحكم بانقلابات عسكرية كما حصل في العراق وسوريا على سبيل المثال، عملت عكس الشعارات التي كانت ترفعها، وسادت فيها سياسة الحزب الحاكم الذي حظر الأحزاب الأخرى، أو حجّم بعضها وحظر البعض الآخر، وكمم الحريات وبطش وقتل واعتقل وعذب، ودمر البلاد وأهلك العباد، وتعامل مع الوطن وكأنه غنيمة للمتنفذين الحزبيين، فانتشر الفساد وعمّ الخراب.
ولعل جبهة التحرير الجزائرية خير مثال على ذلك، فلا أحد ينكر دورها وتضحياتها أثناء حرب التحرير ومقارعة المستعمر الفرنسي، وقادت الجزائر الى التحرر بتضحيات جسام زادت على المليون شهيد، وما أن انتهى الاستعمار الفرنسي، واستلمت جبهة التحرير الحكم، بدأت الصراعات على السلطة، وسرعان ما انقلب هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بيللا….وبعد وفاة هواري بومدين جرى اغتيال الرئيس بوضياف، لكن هذا الجبهة التي قادت الجزائر الى الاستقلال، وانفردت بحكم الشعب، ولم تطلق الحريات العامة، بما فيها حرية تشكيل الأحزاب، هي التي أوصلت الجزائر الى حرب أهلية في تسعينات القرن الماضي، تلك الحرب التي حصدت أرواح عشرات آلاف الجزائريين.
ولم يختلف الوضع كثيرا في مصر، فبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، واستلام الرئيس محمد أنور السادات دفة الرئاسة، لم يلبث وأن انقلب على مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، وعلى النهج الذي خطة الزعيم عبد الناصر، بل وصل الى درجة اعتقال بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة ومنهم ممثل اليسار الناصري المرحوم علي صبري، وكمّم هو الآخر الحريات، ومنع تشكيل الأحزاب، التي منعها سلفه عبد الناصر أيضا، ووصل الأمر بالرئيس السادات أن يهدد المعارضة، وبخطابات علنية وعبر وسائل الإعلام بـ”الفَرْمِ”-حفرمهم-. وعندما استلم حسني مبارك الرئاسة بعد اغتيال السادات، حكم مصر بقوانين الطوارئ، ورهن سيادة بلاده، ونهب وزبانيته اقتصادها، الى أن جعلها “خرابة” كما نقل هيكل عنه في احدى لقاءاته الخاصة به، بعد أن رسخ نظامه الطائفية والطبقية بشكل واضح. وجاءت ثورة الشباب المصري في 25 يناير 2011 لتخلص الشعب المصري من طغيانه.
ولم تكن أوضاع تونس أفضل من الأقطار الأخرى، فزين العابدين بن على انقلب على الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي قاد الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، وحرر بلاده من ذلك الاستعمار، وفرض عليه زين العابدين الإقامة الجبرية في بيته حتى وفاته، ومنع زين العابدين الحريات هو الآخر، وبطش ونكل وقتل واعتقل وعذب، ونهب هو وأفراد عائلته وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتها اقتصاد البلاد، الى أن أطاحت به ثورة الشباب التونسي.
ولم تكن الأوضاع في سوريا أحسن حالا، فقد انقلب حافظ الأسد على نور الدين الأتاسي، أي أن عسكريي حزب البعث انقلبوا على الجناح السياسي للحزب، وجرى أيضا تكميم الأفواه ومنع الأحزاب، وعدم تطوير الاقتصاد، ووصلت الأمور الى قصف حماة في العام 1981 بالطائرات والمدفعية الثقيلة، وقبل وفاة حافظ الأسد ابتدع الحكم الوراثي في الأنظمة الجمهورية، فخلفه ابنه بشار في الحكم.
وفي العراق أيضا انقلب الرئيس صدام حسين على سلفه احمد حسن البكر، وأجبره على التنحي، وقام بتصفيات قادة حزب البعث الذين كان يستشعر منهم خطرا على حكمه، وحظر هو الآخر الأحزاب، واضطهد الأكراد، وقتلهم، وقصف “حلبتشه” بالأسلحة الكيماوية، كما اضطهد ابناء الطائفة الشيعية، وقصف بعض مناطقهم في جنوب العراق بالأسلحة الكيماوية، حتى أن العراقيين أطلقوا على قريبه علي حسن المجيد لقب”علي الكيماوي” وتشرد أكثر من أربعة ملايين عراقي خارج حدود العراق، وشن حربا على ايران المجاورة استمرت حوالي ثماني سنوات، كما قام باحتلال الكويت في بدية شهر آب-أغسطس- عام 1990، مما شكل سببا للهجوم الأطلسي على العراق في يناير 1991، لتواصل الأحداث حتى العدوان الغاشم الذي أدى الى تدمير العراق واحتلاله في آذار 1993، وما كنا نتمنى للعراق العظيم ولشعبه العظيم ولا لصدام حسين هذه النهاية، ولا يُفهم من هذا تأييد غزو العراق واحتلاله، بل لتبيان أن حزب البعث بقيادة صدام حسين لم يحسن استعمال الحكم والسلطة.
أمّا معمر القذافي في ليبيا فقد طغى وتجبر منذ استلامه الحكم في الفاتح من سبتمبر 1969 وهدم ليبيا كدولة بلجانه الشعبية، وبكتابه الأخضر وما يحمله من سخافات، ووصل جنون الرجل الى درجة انه اعتبر نفسه فيلسوفا وقائدا أمميا، وأسس جامعة باسم الكتاب الأخضر، يحصل فيها الطلبة على الشهادات العليا-بما فيها الدكتوراة- في دراسة الكتاب الأخضر،وقمع الحريات واعتقل وقتل معارضيه، ودمر اقتصاد بلاده، ولم يتورع بوصف أبناء شعبه بـ”المقملين”و”الجرذان”. ولم يقم بأيّ تطوير للبلاد في فترة حكمه الذي استمر لاثنين وأربعين عاما، رغم ثراء ليبيا وارتفاع مداخيلها من النفط، بل على العكس هدم ما كان قائما، الى أن وصل الى نهايته المحتومة بثورة أبناء شعبه، بمساعدة حلف الناتو، الذي دمر هو الآخر ليبيا لا حبّا في الشعب الليبي، وانما طمعا في ليبيا وثرواتها.
أما في فلسطين، وبعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994، بعد اتفاقات أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع اسرائيل في سبتمبر-ايلول- 1993، فقد انفردت منظمة فتح بالسلطة، وإن جعلت متنفسا قليلا لغيرها -ورغم خصوصية الوضع الفلسطيني بسبب الاحتلال الذي أهلك البشر والشجر والحجر- وقد أعطت السلطة حرية العمل للأحزاب والتنظيمات القائمة، شريطة أن لا يشكل عملها تهديدا للسلطة، وسمحت بحرية الصحافة، وأجرت انتخابات ديموقراطية مرتين، واحدة في العام 1996، رغم معارضة بعض الفصائل لها مثل حماس والجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديموقراطية، لكنها ما لبثت أن شاركت في الانتخابات الثانية عام 2005 باستثناء الجهاد الاسلامي، ونتيجة للفساد في مؤسسات السلطة، وفي المؤسسات غير الحكومية التي يسيطر عليها حزبيون من الفصائل والأحزاب الوطنية، والتنافس بين مراكز النفوذ داخل حركة فتح التي تفتت أصوات ناخبيها بين قائمتها الحركية، وبين المرشحين من أبناء الحركة الذين خاضوا الانتخابات بشكل مستقل، ولأن فتح وبقية الفصائل الوطنية، لم يتلمسوا مشاكل الشعب وهمومه، واعتمدوا على الأمجاد السابقة، دون وعي لمتغيرات الواقع، ولعدم وجود شريك اسرائيلي للسلام في العملية التفاوضية، ولأسباب أخرى فقد فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ولم يتم تبادل السلطة بشكل سلس وعادي كما هو حال الدول الديموقراطية، وبدأت الصراعات على سلطة تحت الاحتلال لا تملك من السلطة إلا الإسم، الى أن انقلبت حماس في قطاع غزة، دون أن تدرك مخاطر ذلك على الشعب وعلى القضية، وأوصلت هذه الأوضاع الى اعتقالات السلطة في الضفة الغربية للناشطين من أنصار حماس، في حين اعتقلت حماس في قطاع غزة الناشطين من أبناء حركة فتح.
والذي لم يعد غريبا لدى المواطن العربي، أن الأنظمة التي كانت تصفها القوى القومية واليسارية “الثورية” بالأنظمة الرجعية والمتخلفة، لم تضطهد شعوبها مثلما فعلت الأنظمة”الثورية” وقامت بتطوير بلدانها واقتصادها أكثر من تلك الأنظمة”الثورية”.
وفي كل الأحوال لا يمكن تغييب دور العامل الخارجي، وما يمثله من ضغوطات لحماية مصالحهم ومصالح حليفتهم اسرائيل في المنطقة، إلا أن هذا لاينفي الانتباه الى مسؤولية القوى والأحزاب الوطنية والقومية، التي لم تستفد من أخطائها، ولا من أخطاء غيرها، فابتعدت عن شعوبها، وعن ثقافتها، مما دفع الشعوب الى الابتعاد عنها، بل ومعاقبتها عند صناديق الاقتراع، فصبت أصواتها لصالح القوى والتيارات الاسلامية.
4 شباط-فبراير-2012